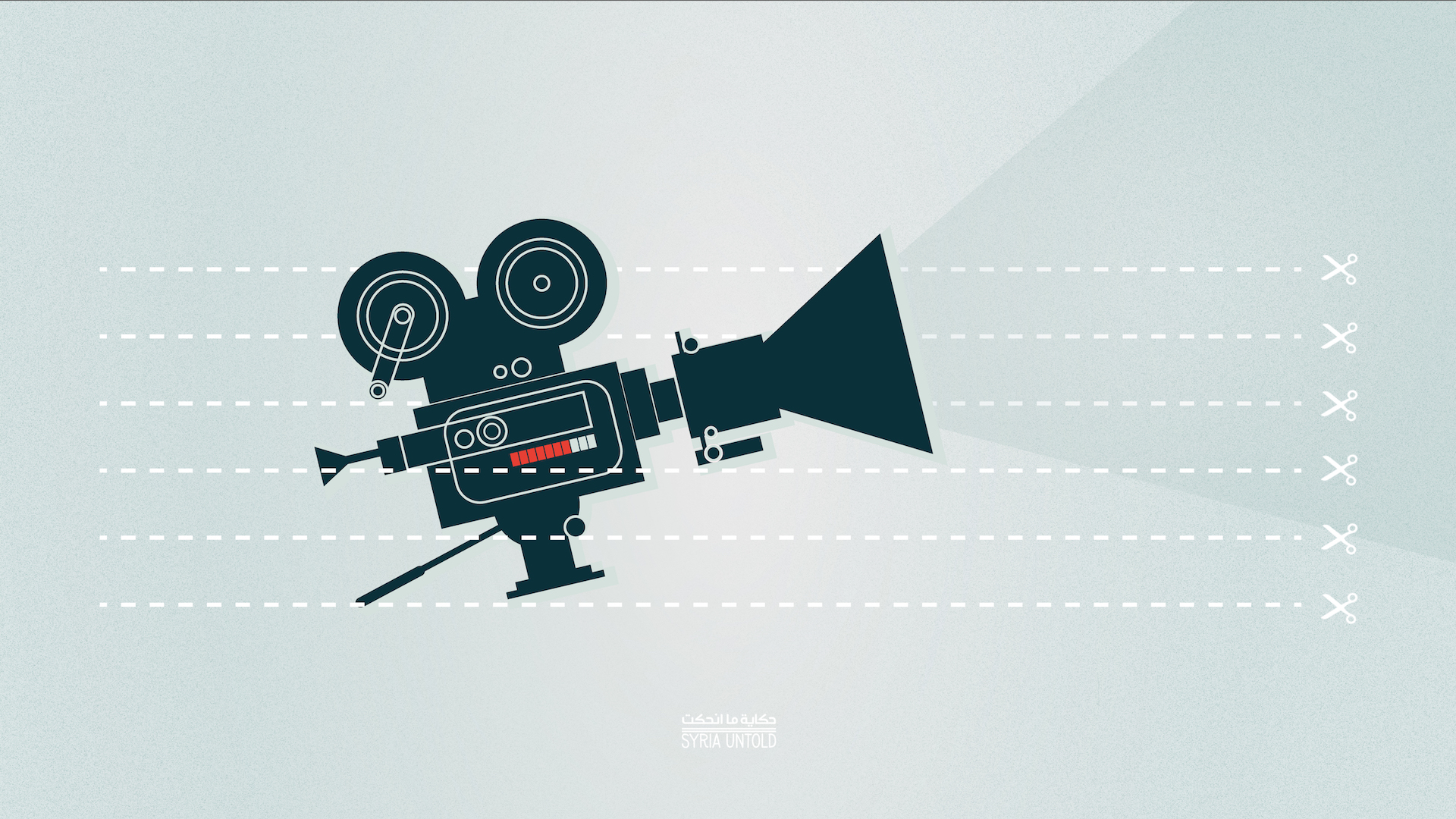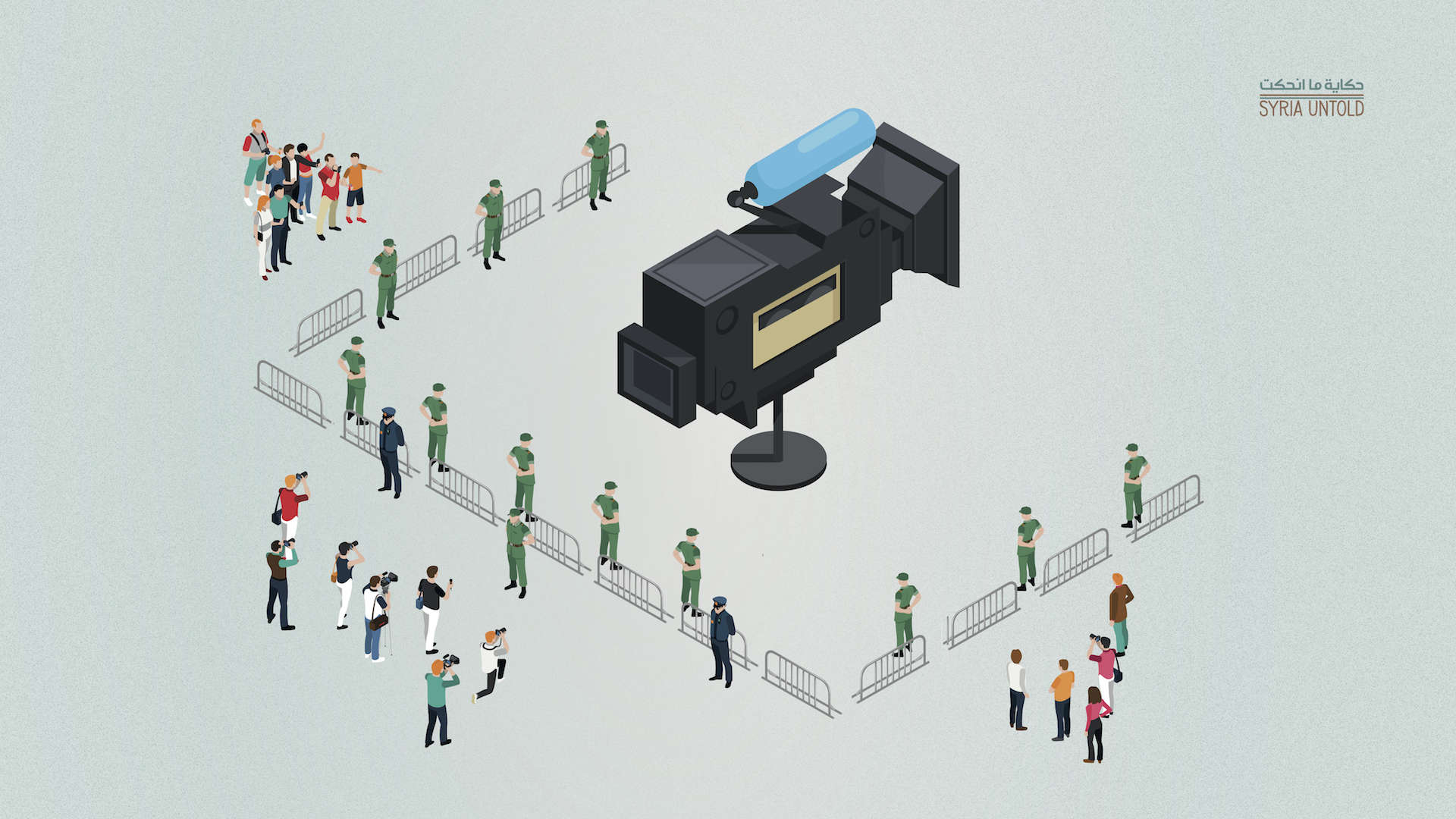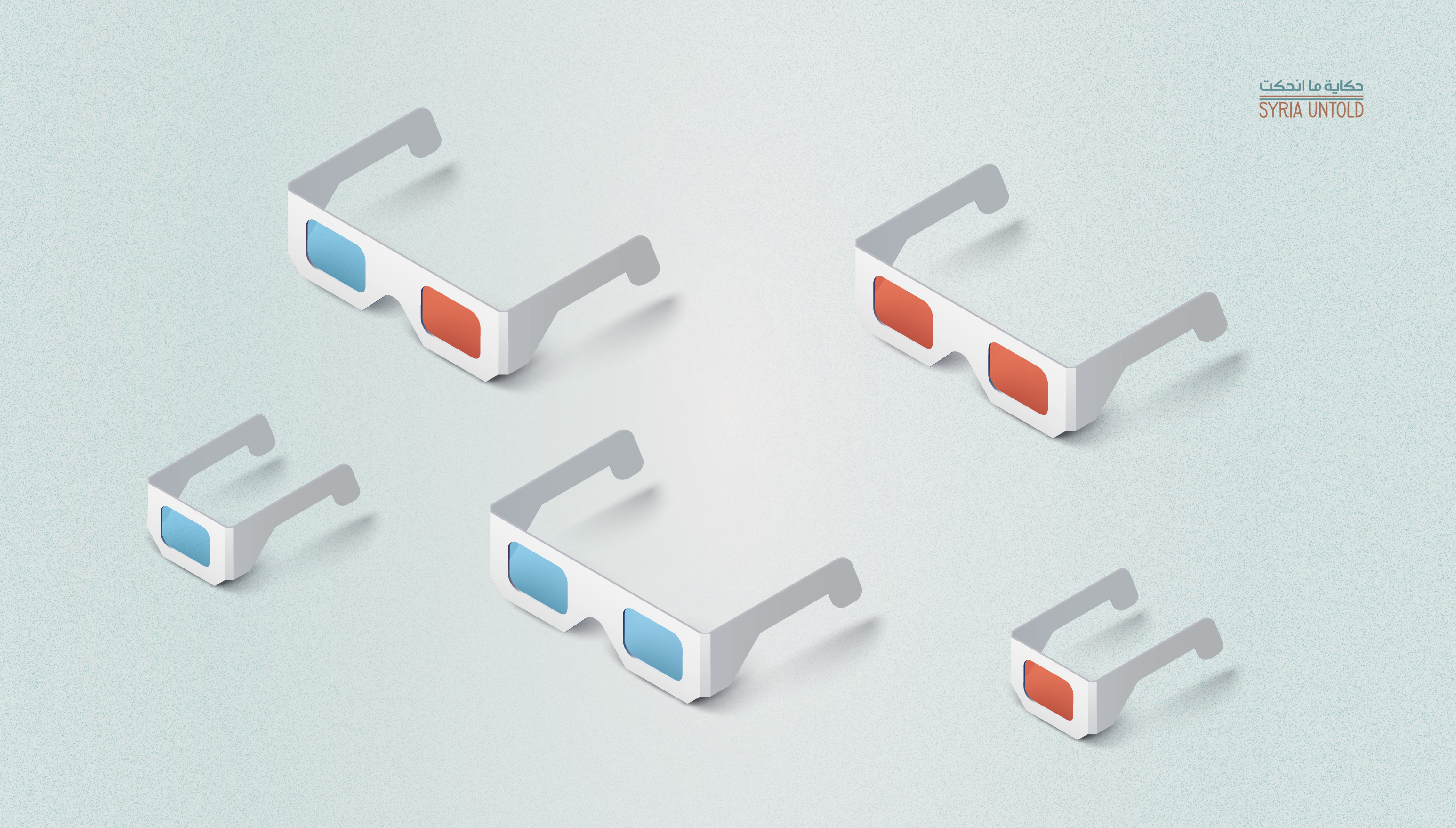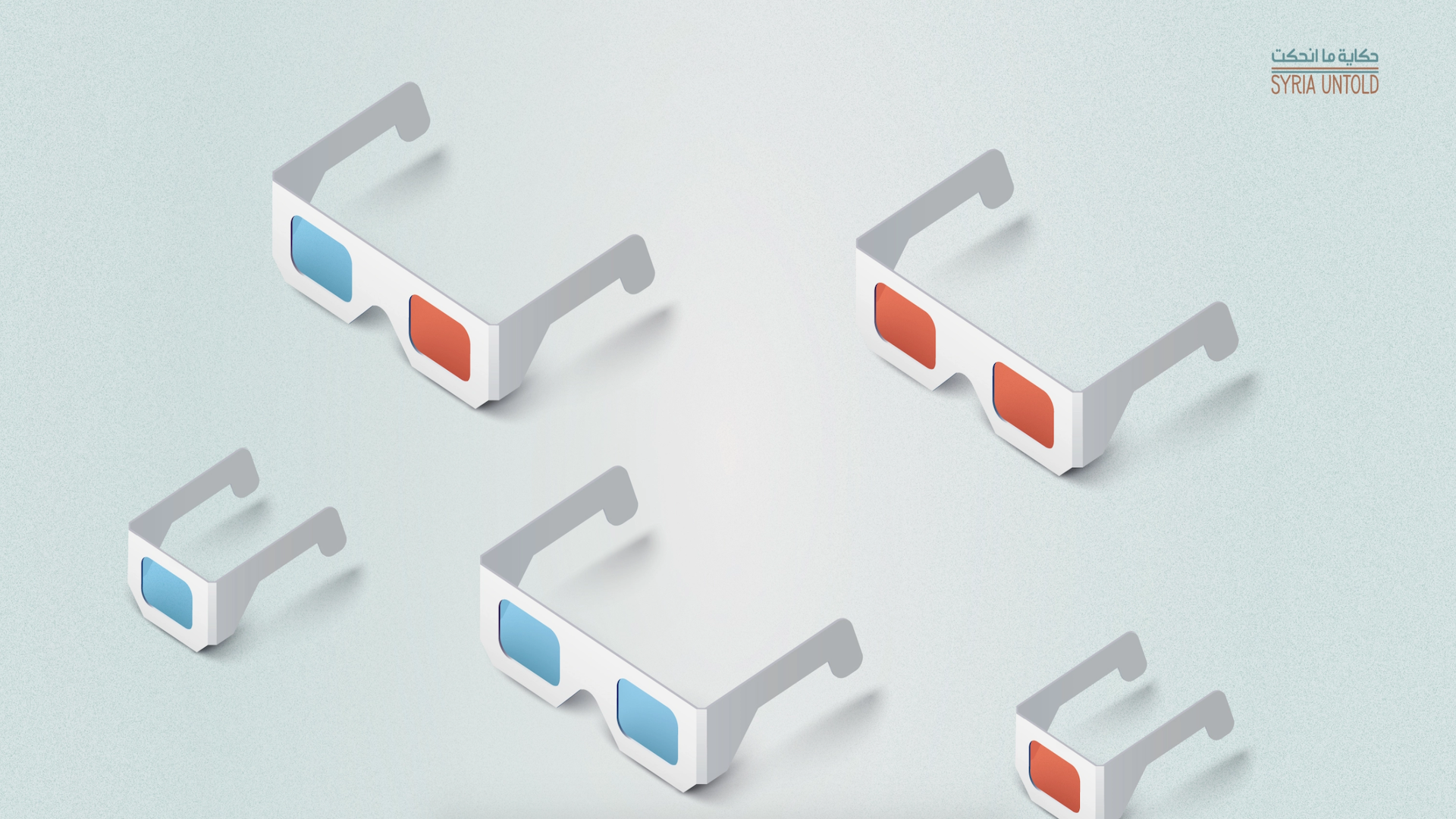شكّلت بداية عام ٢٠٢٠ محطة مهمة في صناعة الأفلام السورية. تم ترشيح فيلمين سوريين "إلى سما" لوعد الخطيب وإدوارد واتس (٢٠١٩) و"الكهف" لفراس فياض (٢٠١٩)، لجائزة الأوسكار عن فئة أفضل فيلم وثائقي. (وهذه هي المرة الثانية لفياض، إذ رُشّح فيلمه السابق "آخر الرجال في حلب"/٢٠١٨).
من النخبوية الأوروبية إلى العالمية
ساهمت هذه الترشيحات المرموقة في الأسواق العالمية بمغادرة هذه الأعمال دائرة مهرجانات النخب بأوروبا (عُرض "إلى سما" لأول مرة خلال مهرجان "كان" عام ٢٠١٩) وفتحت لهم طريقاً مثمراً وأكثر جاذبية، طريق نجح بجذب الجمهور إلى شباك التذاكر ومنصات وسائل الإعلام العالمية مثل نتفليكس وأمازون برايم.
يجب أن يكون هذا الخبر رائعًا بالنسبة لجميع العاملين في مجال ترويج وتنظيم الفنون والثقافة السورية. فسوريا في هوليوود، ووصلت إلى العالمية. يجب أن نحتفل، أليس كذلك؟
السينما السورية: الصورة في زمن التحولات (11)
شاهدت "إلى سما" لأول مرة في قاعة سينما بمئات المقاعد، وقد تمّ شغلها جميعًا، خلال مهرجان "ميد فيلم" في روما. كان العرض الأول ناجحاً تلاه تصفيق حاد. من الصعب ألا يتأثر المرء عاطفياً بفيلم يسلط الضوء على جميع أنواع الانتهاكات البشرية ضد المدنيين في سوريا، ويفعل ذلك من وجهة نظر شخصية، ولعلّها أقوى وجهة نظر ممكنة: فهي عن أم تحكي قصة بلدها المدمر لمولودتها الجديدة عبر رسالة حب. إن مفتاح نجاح "إلى سما" هو بالتحديد هذه القصة الشخصية جداً، والتي هي مع ذلك قصة عالمية: أم تقاتل من أجل حق أطفالها في العيش في بلد حر.
التزام الخطيب العاطفي هو أن تشرح لابنتها المستقبلية: لماذا قرر والداها البقاء في سوريا والقتال لتحرير البلاد من الحكم الاستبدادي لزعيم دمر مدن بأكملها بحجة القضاء على خطر "الإرهابيين"؟
مشهد يحرّك الجماهير أكثر من ألف تظاهرة
في إحدى هذه المناطق المدمرة، تحديداً في شرق حلب، تُنجب الخطيب سما، وفي الوقت نفسه تخلق صورًا واقعية جدًا لدرجة أن رغبة الحياة للمواطنين المحاصرين تبدو وكأنها تنبع مباشرة من الكاميرا وتتجه نحو الجمهور.
يحرك مشهد واحد من "إلى سما" قلوب ومشاعر الجماهير العالمية أكثر بكثير من ألف تظاهرة في الشارع، ومقالات افتتاحية، وكتب، ومقابلات تلفزيونية، وتجمعات عامة وورش عمل، والتي تبدو وكأنّها لم تنجح إلى الآن بتحسيس الجمهور الدولي تجاه محنة الثوار السوريين.

علاوة على ذلك، حملت الخطيب وزوجها حمزة، الطبيب الشاب الشجاع الذي يلعب دور البطولة في الفيلم أيضاً، شعار "توقفوا عن قصف المستشفيات" بشدة طوال الجولة الدولية للفيلم، على السجاد الأحمر من مهرجان كان إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار، وذلك لإخبار العالم عن معركتهما المستمرة من أجل سوريا، حتى وهما خارج البلاد ويحقّقان نجاحًا دوليًا. كل هذا يشير إلى أن "إلى سما" هو النموذج المثالي لفيلم فني هادف تمكّن من استقطاب الجمهور العالمي ونجح على شباك التذاكر.
لماذا؟ أسئلة لا بد منها
لماذا إذن، يتركني هذا الفيلم غير مقتنعة، لا بل باردة قليلاً، بصرف النظر عن التأثّر (المتوقع) الناتج عن كلمات امرأة تعبّر عن حبّها الأمومي في ظل حالة عنيفة من التأرجح بين الحياة والموت؟
السينما وسياسات الوصول (9)
25 شباط 2020
شعوري بعدم الارتياح ذو شقين. أولاً، لدي تحفّظ تجاه جماليات الفيلم، والذي ينتهي به المطاف ليصبح تحفّظ تجاه أخلاقياته أيضاً.
أسلوب تصوير الخطيب "باليد" وبشكل مهتز ومشوش، يأخذ المشاهد معها تحت الأرض. يتم نقلنا إلى حلب الشرقية. نحن هناك: تحت الحصار معها، نقاتل من أجل حياتنا، خائفين من أن الحياة سينتزعها منّا هجوم جوي قادم. نحن عالقون في أنفاق المستشفى المؤقت، لا مجال للهروب، يزداد خوفنا ورهاب الأماكن المغلقة.
ثم فجأة، نخرج إلى السطح، وكأننا نُمنح نفسًا عميقاً. تغادر الكاميرا الأنفاق تحت الأرض، تخرج، وترتفع فوق رؤوسنا. فجأة، ننعم بمشهد مذهل للمنطقة بصورة عالية الدقة مصوّرة بحرفية وبشكل مدهش من الطائرة المسيّرة. ضائعين في وسط هذا المنظر الجوي الرائع، نميل إلى نسيان المستشفى المؤقت والأنفاق وحياة البشر المختنقة التي تُستنزف من تحتها. نضيع في النظرة الجمالية المفرطة للمدينة المدمرة. "الحرب جميلة"، كما كتب ذات مرة الكاتب الأمريكي ديفيد شيلدز بشكل استفزازي. أليس كذلك؟
يضيف مشهد الطائرة المسيّرة هذا منحىً استعراضياً للفيلم، ويجعله يبدو وكأنه فيلم وثائقي سائد مناسب للاستهلاك على نيتفلكس وملائم للأذواق العالمية المماثلة. رغم أن إدراج هذه اللقطات الدرامية يجعل الفيلم أقرب إلى اللغة الجمالية للأفلام الوثائقية السائدة المعاصرة، وبالتالي أكثر قابلية للتسويق والبيع، إلا أنه، ونتيجة لذلك، يقوّض مصداقية السرد السينمائي. فتقنية الكاميرا المحمولة ووجهة النظر الشخصية قد بنت ثقة في قصة الخطيب، من خلال "تواجد" آلة التصوير والراوي هناك، ومن خلال "تواجدنا نحن هناك" معهم في تلك الأنفاق الخانقة. لكن اللقطات الجوية اللامعة التي التقطتها الكاميرات العالية الدقة التي تحملها الطائرات المسيّرة تحطم هذه الثقة ("لمن هذه الطائرات المسيّرة؟" و"من الذي دفع ثمنها؟" كلاهما سؤالين مشروعين يُطرحان بمجرد كسر الثقة).
هذا الاستسلام للجماليات السائدة يضحّي بأخلاقيات الفيلم ويقوّض مصداقيته "المحلية". مرة أخرى، يتم تحويل السرديات المحلية إلى سرديات تابعة. ويتم إخضاعها لضرورات الذوق السائد (الغربي). على هذه السرديات أن تندمج، إذا أرادت أن يتم بيعها واستهلاكها، وإحداث "تأثيراً" عالميّا.
السينما السورية والتكيف مع "السوق"
هذا بيان سياسي تُجبر السينما السورية على تبنيه والتكيّف معه إذا أرادت النجاح. على الأفلام السورية أن تقبل بأمور مثل جماليات الطائرات المسيّرة من أجل التغلب على المنافسة في السوق، حتى لو كان ذلك يؤثّر على مصداقية الفيلم أو الثقة التي لدينا، نحن كجمهور، تجاه المخرج. كما لو أن قوة الأزمة السورية بحد ذاتها ليست بكافية، وتتطلب مناظر جوية "محسّنة" لحرب الطائرات المسيّرة ذات التقنية العالية. كما لو أننا بحاجة إلى "الانغمار" في موقف أشبه بلعبة فيديو، و"الغمر" هي كلمة تشمل كل المفردات المثيرة والقابلة للتسويق التي تطبّق الآن على جميع الأشكال الإعلامية، من رواية القصص الإبداعية إلى الصحافة الواقعية، من أجل أن نصدّق أنه في الحقيقة هذه ليست لعبة فيديو على الإطلاق.
الجندر أيضا
غير أن عدم ارتياحي تجاه "إلى سما" لا ينحصر بعدم ارتياحي مع جماليّاته. بصفتي امرأة، أنا لست مرتاحة مع السياسات الجندرية للفيلم أيضًا.
اغتراب السينما السورية (8)
10 شباط 2020
من ناحية، يستفيد الفيلم من جنس المؤلّفة التابع. المرأة والأمومة هما المكوّنان الرئيسيان اللذان يتم على أساسهما نجاح الفيلم. لا يسعنا إلا أن نتعاطف مع المرأة؛ لا يسعنا إلا أن نتعاطف مع الأم. تشكل المرأة والأم استعارات عالمية تجعل الجمهور الدولي "يرى" ويتعاطف مع الخطيب وقضيّتها الإنسانية، ولكنّه يشتّت كل الأبعاد السياسية للانتفاضة السورية. فلا نرى النضال السياسي للشعب السوري. نحن نرى صراع الأم، أسوة بتركيز الرأسمالية النيوليبرالية على الذات، نشهد هنا على إبراز النضال الشخصي للفرد، وخسارة مسار كامل للنضال الجماعي والسياسي الأوسع، مما يجعل الفيلم مقنعًا عاطفيًا، ومع ذلك فارغًا سياسيًا في نفس الوقت.
يستغل "إلى سما" شخصية "المرأة" في نفس اللحظة التي يبدو فيها أنه يمنحها القوة، وتصبح المرأة والأمومة أدوات بيد الاستشراق الجديد الرقمي للاستغلال الاستعماري وأشكاله الأخرى الخفية.
المرأة والرجل الأبيض والاستشراق
من ناحية أخرى، يُظهر "إلى سما" إلى أي مدى لا تزال النساء، ولا سيما النساء الغير غربيات، خاضعات للتبعية الاستعمارية للذكور البيض. حقيقة أن الفيلم شارك في تأليفه المخرج الإنجليزي الأبيض، إدوارد واتس، والذي لم يؤلف حتى الآن سوى أعمال تليفزيونية للقنوات البريطانية مع عناوين مثيرة مثل "الهروب من داعش"، يشير وكأنه لا يمكن الوثوق بعمل الخطيب بما فيه الكفاية لجعل الفيلم ناجحًا دولياً.

نادرا ما تحدث واتس أو شرح علنا حيثيات مساهمته في الفيلم. في ظل حضوره الصامت، لا يمكن قراءة دور واتس في الفيلم إلا كولّي الأمر، وليس كنظير أو مشارك في التأليف. من المؤكد أن هذه المشكلة لا تقتصر على فيلم "إلى سما": هناك اتجاه في صناعة الأفلام السورية المعاصرة إلى تصويرها بالتعاون مع "نظير" غير سوري. أنا لست مرتاحة لما أراه كشكل من أشكال الاستشراق الجديد الذي يستغل صانعي الأفلام السوريين الذين يمكنهم الوصول إلى "الميدان"، لكنّهم بنظر الصناعات الإعلامية الغربية ليسوا على المستوى المطلوب لإنتاج روايات تعتبر مقنعة وقابلة للتسويق للجمهور العالمي. يصبح بذلك التأليف المشترك شكلًا أكثر نعومة من الإرث الاستعماري والوصاية الذكورية تجاه الأفراد التابعة والجندرية.
سينما جديدة في سوريا (7)
04 شباط 2020
بخصوص النساء ومفهوم القوة، لا يسعني إلا التفكير في امرأة أخرى: المخرجة السورية الكردية وئام سيماف بدرخان.
خلال العرض الأول لفيلم ماء الفضة، الفيلم الذي شاركت في إخراجه مع المخرج السوري الراسخ أسامة محمد، اعترض الكثيرون على تشييئها من قبل نظيرها الذكر، والذي هو أكثر شهرة. عالقًا في منفاه في باريس، كان محمد يطلب منها أن تكون الكاميرا "الميدانية" في حمص المحاصرة، بينما هو يوجّهها عن بُعد.
يبّين فيلم "ماء الفضة" هذا الاتفاق المهني والإنساني غير العادي؛ طوال الفيلم نرى العلاقة بين الاثنين تتكشف عبر الصور، في نوع من قصة حب مستحيلة، تتواصل بشكل غير طبيعي وقد تم تصويرها بين الحيرة والحجر. إن شفافية هذه العلاقة غير التقليدية التي تتكشف بفضل الكاميرا، وبسبب الكاميرا، تجعل كل من أسامة ووئام عنصرين فاعلين متساويين ليس فقط في تأليف وامتلاك صور الفيلم، ولكن أيضًا في مشاركة ألم جعلِ هذه الصور واقعاً.
ربما تكون هذه الشفافية هي التي تعيد المساواة بين شخصين لهما وضع ثقافي واجتماعي واقتصادي مختلف، وتجعلهما يتخطّيان بقوة آلامهم المشتركة.