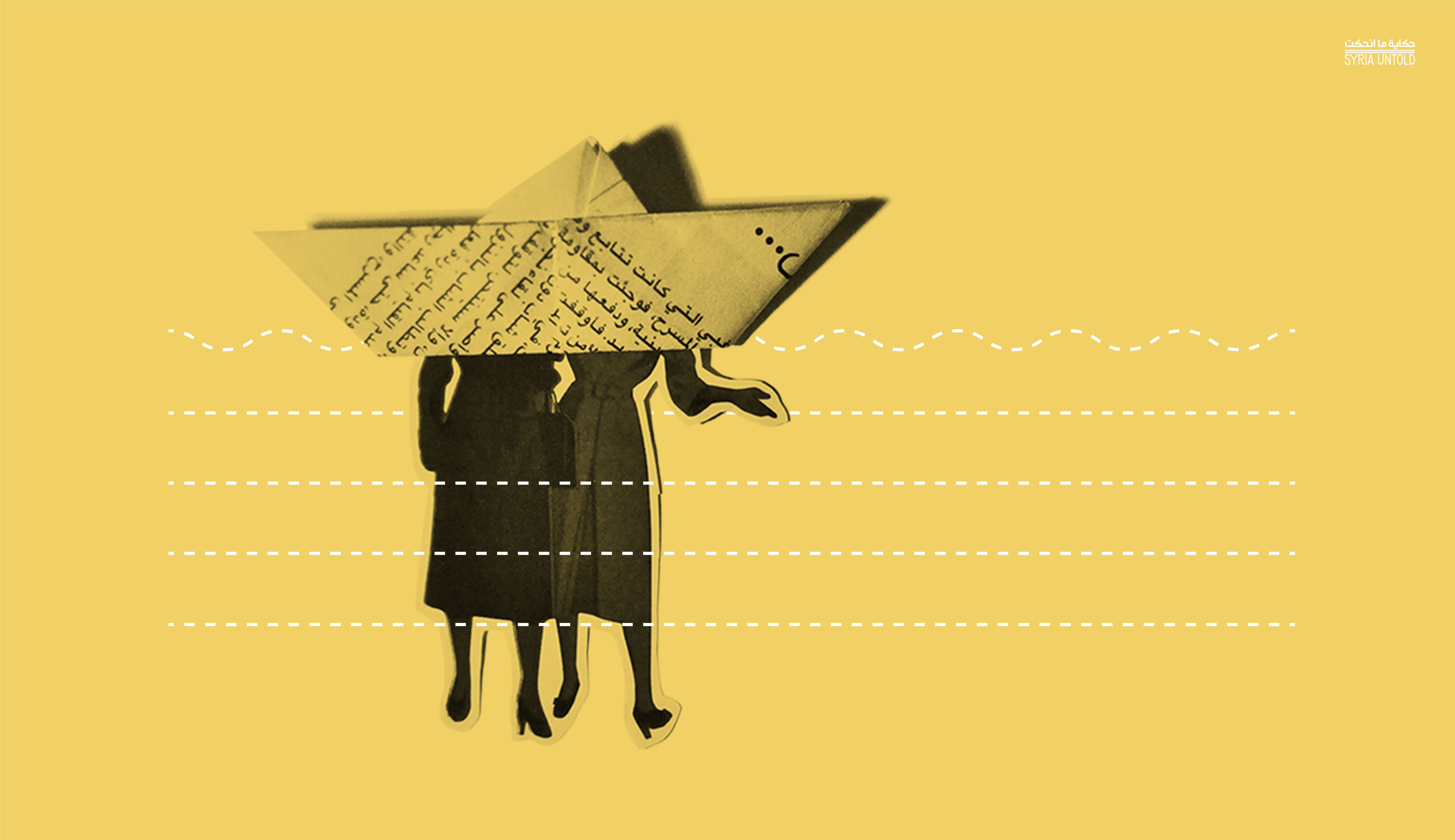يكتب المرء ويمحي ما كتبه، ثم يكتب ويمحي ثم يكتب معاندا تلك الممانعة الداخلية (وهي غير الممانعة التي أهلكت بيروت وأهلها بحجة المقاومة والصمود! حتى بات المرء يشعر بالخجل وهو يكتب هذه الكلمة ويود لو يحذفها)، وكأن القلم قبل القلب والروح يأبى أن يكتب نعيا لمدينة ماتت أو تموت، ساعيا لعدم الاعتراف وتصديق ما يقوله العقل البارد.
ومع ذلك، لا بد من الكتابة أخيرا، إذ لا بد من كلمة عزاء تقال، مهما كان "الألم ثقيلا والمصاب جليلا"، أليس هذا ما يقال في طقوس العزاء؟ ولكن مهلا: هل نحن في عزاء؟ عزاء من؟ بيروت أم أهلها أم أرواحنا ذاتها؟ من المعزّي ومن المعزّى؟
حصار بيروت ٢٠١٩
22 تموز 2019
يكفي أن نحدّق في هذا الوجع، هذا الألم، هذه الآه التي صدرت من قلوب كثيرين، هذا التعاطف الهائل، حتى ندرك أي مدينة ننعي؟ وأي مدينة نبكي؟ فهذا الإجماع على الحزن، الإجماع على الخوف، الإجماع على القلق، ليس إجماع من يتعاطف مع أي مدينة تتعرض لنكبة ما، بل هو إجماع صادر عن قلب محروق، عن قلب يعرف الضحية، يعرف شوارعها، أهلها، ناسها، مقاهيها، مدنها... إجماع نقرأه في عيون الأغنياء والفقراء، العمال والموظفين، السياح وعابري السبيل، المنفيين والمقيمين، المهاجرين والمنتظرين الهجرة، إذ لكل منهم حكايته مع بيروت، حكايته التي يرويها، حتى وإن خالطها الوجع، لا بد أن يجد كلمة فرح وخير تقال في هذه المدينة، مهما كانت تجربته فيها ومعها سيئة، ليس من مبدأ "اذكروا محاسن موتاكم" بل لأنها بيروت التي طالما تركت فرحها مشاعا للجميع، فكل من عاش في هذه المدينة مسّه فرحها وشغفها بالحياة، وكأنها امرأة خلقت لبث الفرح والسعادة لا غير، ساخرة من كل هذا التشاؤم الذي نعلنه، وربما هي تسخر اليوم من حديثنا حول موتها. هذه هي بيروت بكل تناقضاتها، تضحك من قلب الوجع، تسخر حتى وهي تبكي. هل يبكي الموتى؟
ولكن: لم هذا التشاؤم وهذا الحديث عن الموت؟ هل تموت المدن؟ هل يمكن لبيروت أن تموت؟ أليس الأمر مجرد تفجير عابر في سياق عابر؟ ألم تصمد بيروت في وجه الحرب الأهلية والاحتلال الإسرائيلي وتجار الحروب والموت؟ أم تنهض مرارا من موتها كطائر الفينيق كما يحلو لللبنانيين أن يتغنّوا دائما؟ ألم ننعيها سابقا كثيرا ثم عادت وكذّبت كل تنبؤاتنا الخرابية؟ فلم هذا النعيب إذن؟ ولم هذا التشاؤم؟ بل لم هذا الحديث عن موت بيروت من أصله؟
كل من يعرف بيروت ويزورها، يعرف جيدا أن هذا التفجير ليس مقدمة لما حصل، بل هو نتيجة، هو إعلان رسمي لموت لمدينة تموت أو ماتت منذ سنوات ببطء أمام ناظرينا، فيما يرفض كبرياءنا الاعتراف بموتها.
كل من يعرف بيروت ويزورها، يعرف جيدا أن هذا التفجير ليس مقدمة لما حصل، بل هو نتيجة، هو إعلان رسمي لموت لمدينة تموت أو ماتت منذ سنوات ببطء أمام ناظرينا، فيما يرفض كبرياءنا الاعتراف بموتها. نرفض إعلانه لأننا لا نحب أن نعلن موتنا، إذ من يعلن موته؟ من يرثي نفسه؟
ماتت بيروت، منذ دخل حزب الله الأرض السورية ليقتل أهله وناسه ويقف بجانب الدكتاتور القاتل ضد ثورة العزّل والأبرياء.
ماتت بيروت منذ أغلقت أبواب شارع الحمراء واحدا تلو الأخر بصمت، منذ أغلق مقهى كوفي بين، ومعه مقاهي ومحلات وسط البلد.
ماتت بيروت مذ غطّى الغبار والإهمال والزبالة والفساد كل ملامح المدينة التي كانت تضيء على كل العرب، حبا ومقاومة حقيقية قبل أن يصادر الدجالون المقاومة، والأهم، شغفا بالحياة، تلك الحياة التي تشرق في وجوه أبنائها الذين يقبلون على الحياة والفرح والحب بنهم قلّ نظيره وكأنهم يعيشون أبدا، رغم كل المآسي وضيق الحال والعوز والتحديات التي تحيط بهم.
ماتت بيروت، منذ بدأت ملامح الشمولية تظهر في سمائها، متمثلة بحادثة الممثل اللبناني زياد عيتاني واستدعاء الناشطين إلى أفرع المخابرات والأمن العام... هل حقا هذا يحدث في بيروت؟ أم أنه كان يحدث دوما دون أن ننتبه ونقرأ جيدا؟ هل علينا إعادة القراءة؟ هل علينا تبديل نظاراتنا؟
ماتت بيروت، منذ بدأت ملامح الشمولية تظهر في سمائها، متمثلة بحادثة الممثل اللبناني زياد عيتاني واستدعاء الناشطين إلى أفرع المخابرات والأمن العام... هل حقا هذا يحدث في بيروت؟
صحيح أن المدن تموت ولا تموت، وصحيح جدا أن بيروت ستلملم هزيمتها وتعود، وصحيح أن المدن لا تستسلم أبدا لطغاتها وملاليها وأمناء أحزابها الذين يرحلون كلهم إلى مزبلة التاريخ. إلا أن الصحيح أيضا أن المدن تموت حين تفقد بريقها، حين تفقد لونها، حين تصبح غريبة عن أبنائها، حين تجبرهم نحو الهجرة، حين تغلق دور نشرها، حين تنحط صحافتها، حين يغيب المثقفين عن آفاقها وشوارعها. وهذا هو حال بيروت، ليس مع الانفجار، بل قبله. فبيروت حبيبتنا، وخيمتنا التي نعرفها ماتت منذ "بطلت تكون" خيمة لمحبيها والمثقفين الهاربين إلى أفيائها من صحراء الدكتاتوريات وجمهوريات الملالي وممالك العار، العار الذي نقرأه اليوم في وجوه ولحى حكامها الذين يتنصلون من مسؤوليتهم عن مدينتهم، العار الذي ترسمه بيروت على وجوهنا جميعا لعدم قدرتنا على حمايتها، العار الذي لا يمحوه أبدا هذا التعاطف الذي أبداه كثير منّا، والحزن الذي جلل قلوب كثيرون مستهم هذه المدينة بعشقها ولعنتها حتى وهي تموت، إذ لكل منا قصة أو حكاية مع بيروت التي عشقها حتى من لم يزرها، لأن أسطورتها سبقتها إليه فحلم بشوارعها وباراتها وبهجة الحياة في عيون أهلها، هذه العيون التي تبكي اليوم، غياب الغد والأمل الذي طالما كان يشع في الأجساد الراقصة قبل العيون والقلوب.
تموت المدن، حين يغيب الأمل من وجوه أهلها، وهذا هو الواقع الذي نكابر الاعتراف به. ومع ذلك، هذه ليست مرثية يا بيروت، فبيروت لا تموت ولا ترثى!