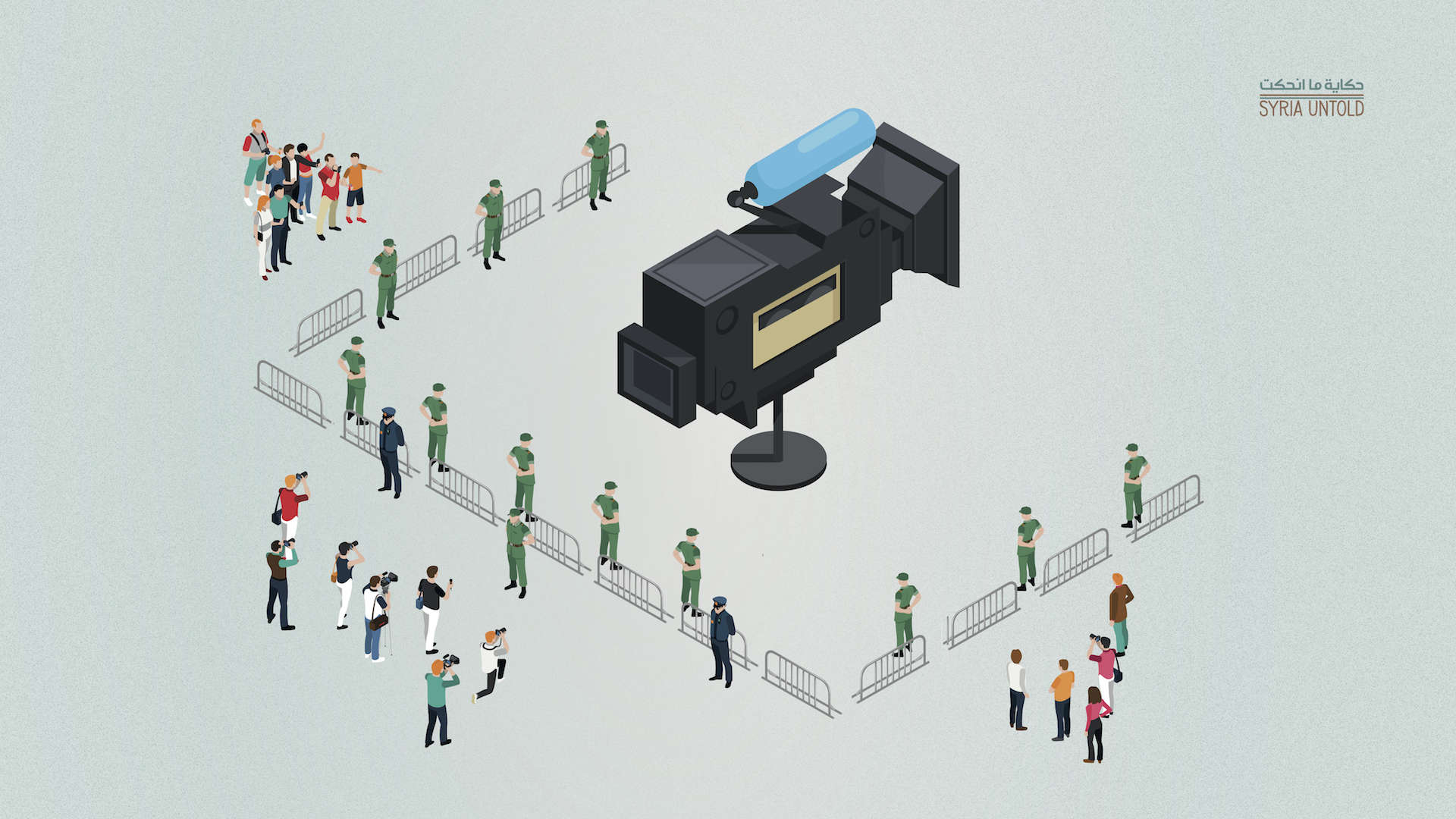(هذه المادة جزء من ملف حكاية ما انحكت "أصوات كويرية". بإداة وإشراف المحرّر الضيف، فادي صالح، وينشر هذا الملف بدعم من مؤسسة: Hannchen-Mehrzweck stiftung)
شعور بالضيق والعجز هو ما أحسست به فور تلقي خبر وفاة إحدى الناشطات المصريات في مجتمع الميم-عين، سارة حجازي، بعد كل ما تعرّضت له من اعتداءات و تعذيب في بلدها الأم مصر لمجرد رفعها لعلم قوس قزح في حفلة لفرقة مشروع ليلى عام 2017، لتنتحر لاحقاً في كندا تاركة رسالة واحدة قصيرة تبيّن مدى قبح هذا العالم.
بحكم عملي في المجال الإعلامي أقرأ وأحرّر يوميا أخبار مأساوية كثيرة، ولكن لم يكن خبر انتحار سارة حجازي مجرّد خبر عادي يمرّ عليّ بشكل عابر، ولم تكن رسالتها الأخيرة مجرد كلمات، فقد كان لها وقعا مختلفا وشكّل ثورة خوف حقيقية في داخلي ونقمة على هذا الواقع. فيما خلق انتشار الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي والرسالة التي تركتها قبل رحيلها موجة تعاطف وتضامن كبيرة بين السوريين وفي مجتمع الميم - عين السوري بشكل خاص.
التضامن مع سارة وخوف من مصير مماثل
مقدمة الملف: الكويرية والثورة: نحو أرشيف سوري بديل (الجزء الأول)
29 أيلول 2020
لم يمنع الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب بعد حربٍ أنهكت البلاد ولا زالت مستمرة في شمالها، إضافة إلى الظروف النفسية المضاعفة التي يتحملها المثليون/ات في سوريا، من جعل قضية سارة حجازي وخلفياتها تتصدّر أحاديثهم اليومية وتعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنهم رؤوا تشابهاً كبيراً، وحدّ التطابق، بين معاناتهم في مجتمع يرفضهم ومع ما عانته سارة من اضطهاد وتنمّر كبيرين.
كثيرون من مثليي سوريا أصابهم رعب تلقّي المصير ذاته، وبالأخص من اكتشفوا مثلية ميولهم الجنسية حديثاً ولا زالوا يخوضون صراعاتهم النفسية بين ذاتهم وهويتهم المستجدة من جهة، وبين الأهل والمجتمع والدّين من جهة أخرى، فانتحار سارة حجازي تجاوز حرفيته كخبر انتحار عادي في أوساط مجتمع الميم – عين، وتحوّل إلى مواجهة حقيقية مع سؤال: ما هو مصيرنا في مجتمعاتنا التي ما تزال تجرّم الاختلافات الجنسانية والجندرية؟ أي توجّب علينا أن نشعر بقدر أكبر من القلق عندما نقاطع تشابه ظروفنا الاجتماعية والسياسية مع ما عانت منه سارة حجازي في وطنها الأم، وأيضاً ما عانته من الوحدة والشعور بالاغتراب في بلد اللجوء، فليس من السهل أن يصل الإنسان إلى الانتحار دون أن يكون قد استنفد كل قدرة على المقاومة، فقدان العائلة والأصدقاء وفقدان الإحساس بالانتماء والأمان.
انتحار سارة حجازي تجاوز حرفيته كخبر انتحار عادي في أوساط مجتمع الميم – عين، وتحوّل إلى مواجهة حقيقية مع سؤال: ما هو مصيرنا في مجتمعاتنا التي ما تزال تجرّم الاختلافات الجنسانية والجندرية؟
وعلى الرغم من كل هذه المخاوف والتساؤلات التي أثارها الخبر، كانت ردة فعل الكثيرين تتميز بالوضوح والصراحة والعلنية، فالبعض أخذ دور المدافع الشرس عن هذه القضية، معتبراً أنها قضية سياسية بالدرجة الأولى ويجب على كل مثليي/ات العالم التضامن أكثر، سواء بالكلام أو بالمقاطع المصوّرة، أو حتى تغيير الصور الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي. بينما رأى البعض الآخر في نفسه ضحيّة لما جرى ويجري من اضطهاد للمثليين/ات، ضحيّة سكوت الكثيرين وعدم اكتراثهم لظلم لم يطلهم بعد، أو ربما لا يرون فيها تلك القضية التي يجب أن يُناضل من أجلها.
الثورة وملامح خطاب جديد
استراتيجيات التمرد: قراءة كويرية في الثورة السورية
لم يكن هذا النوع من العلنية في التعبير عن الهويات الجنسية والجندرية أو التعبير عن الألم الجمعي الكويري لفقدان فرد من الميم – عين متاحا دائما، فقد كان الحديث بالأمور الجنسيّة يشكّل نوعاً من أنواع المحرّمات قبل ال 2011 أو في السنوات الأولى من الثورة والحرب، سواء كان الحديث عبر شبكات التواصل الإجتماعي أو عبر المؤسسات الإعلامية التقليدية كالصحف والتلفزيون والإذاعة أو حتّى في المدارس والجامعات. كان التطرّق لمثل هذه الأمور يقتصر على التجمّعات الخاصّة غير العلنيّة، فما كنّا نراه في السابق في هذه التجمّعات هو عبارة عن تواجد لمجموعات من الأصدقاء المقرّبين إما في أماكن مغلقة أو في مساحات عامة معينة ومعروفة لأفراد الميم – عين (أي متفق على أنها آمنة) يتبادلون الأحاديث اليوميّة العادية ويعبّرون عن أنفسهم أمام أصدقائهم بأريحية أكبر كونهم يتشاركون الميول والهويات ذاتها، ويأخذون على عاتقهم تعليم أي شخص جديد كل ما يتعلّق بأن يكون الشخص لانمطيا وخارجا عن السائد فيما يخص تعبيره الجندري، جنسانيته، أو ممارساته الجنسية، من مصطلحات وأفكار وأساليب التعارف المتبّعة وأماكن اللقاء الآمنة، إضافة إلى تنبيهه/ا على الطرق التي قد تساعده/ا في حماية نفسه/ا من التعرض لخطر الخطف أو السرقة أو الاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية.
هذا ما شكّل لاحقاً نواة لأسلوب جديد في التعاطي بين المثليين، فالكثير من المثليين، وأنا منهم، ومع بداية العقد الأخير كانوا يتطلّعون لإيصال صوتهم والتعبير عن أنفسهم بحريّة أكبر، وخصوصاً مع بداية الثورة السورية، فطموح العديد من مثليي/ات سوريا كان متجهاً نحو قبول المجتمع السوري بهم وبوجودهم أولاً، واعتراف السلطات بحقوقهم وعدم تجريمهم ثانياً.
بدأت ملامح خطاب جديد تتشكل، انتقل من كونه مقتصرا على الدوائر الخاصة، و بدأ يأخذ حيزا من الفضاء الافتراضي السوري و العالمي أيضا.
ومع توفّر المعلومات بشكل سريع ومباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وظهور بعض مثليي/ات سوريا (خاصة بعد تصاعد وتيرة الحرب والنزاعات ولجوء أعداد كبيرة من السوريين للبلدان المجاورة لسوريا ولأوروبا) في أكثر من محفل دولي واشتراكهم/ن بالعمل مع منظمات حقوقية و إنسانية، أدّى ذلك لتغيّر كبير في الخطاب الجنسي الحقوقي والحديث عن الجندرية والجنسانية في العقد الأخير. وبانتشار خبر وفاة سارة حجازي والاحتدام العاطفي والفكري الذي تسبّب به في الفضاء الافتراضي السوري، تجلّى هذا التغيّر في الخطاب بشكل محسوس وأصبحت معالمه واضحة بشكل أقوى من قبل، حيث تعدّى النقاش كونه يتعلق بالمواضيع التي أخذت حيزا كبيرا من الاهتمام عبر سنوات النزاع الماضية، كالميم – عين السوري في المهجر أو داعش وممارساتها العنيفة ضد المثليين، وبدأت مواضيع أخرى تستقطب اهتمام أفراد الميم – عين في سوريا خاصة، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: سياسات الظهور العلني والإفصاح عن الهوية الجنسية والجندرية أمام العائلة والأصدقاء أو على وسائل التواصل الاجتماعي، الأمن والأمان في الفضاء العام والافتراضي، مكان المثلية الجنسية والعبور الجندري من الخطابات الحقوقية في سوريا في ظل الأوضاع الحالية، الصحة النفسية والجسدية والجنسية، القدرة على العمل السياسي وبناء التحالفات مع الداعمين/ات لقضايا الميم – عين في سوريا، وتحديث المعلومات المتوفرة عن كل ما يخص تعاريف ومصطحات جندرية وجنسانية شائعة ومستخدمة ومقبولة من قبل الميم – عين. بدأت ملامح خطاب جديد تتشكل، انتقل من كونه مقتصرا على الدوائر الخاصة، و بدأ يأخذ حيزا من الفضاء الافتراضي السوري و العالمي أيضا.
التضامن و توسيع دوائر التغيير
تحت ظلّ ذاك العلم
ولم يكن هذا الخطاب الجديد موجّهاً فقط لمن يمتلكون هويّات جنسيّة أو جندرية لانمطية، إنما كان يستهدف حقيقة كل الجيل الشاب الجديد، سواء كان من الميم – عين أو غيره، وبالأخص من هم على احتكاك بأشخاص مثليين في الأوساط الثقافية والفنيّة، وهو ما دعا الكثيرين لتغيير وجهات نظرهم حول المثلية وزيادة الوعي حولها باعتبارها ليست مرضاً أو خياراً، إنما هي جزء من هويّة أشخاص يحبونهم ويحترمونهم ويكنّون لهم كل الود.
وهذا ما رأيناه في عدد كبير من ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي من فنانين ومثقفين رؤوا في قضية سارة حجازي سبيلاً للتعبير عن دعمهم للحريّات الشخصية وحقّ الأشخاص بالتعبير عن هويتهم دون خوف، فما كان من بعض الفنانين مثلاً إلا أن غيّروا صورهم الشخصية أو نشروا علم قوس قزح على صفحاتهم الشخصية معلنين تأييدهم لقضايا الميم – عين حتّى لو أثر ذلك على شعبيتهم في المنطقة.
إلا أن العديد منهم تضامن مع قضية انتحار سارة حجازي كقضيّة إنسانية بالدرجة الأولى قبل أن تكون خاصّة بالمثليين، ورؤوا فيها دليلاً على أن سلب الحريّات الشخصية والتعدّي عليها من قبل الأنظمة والحكومات العربيّة هي السبب الأول والأخير في صنع الأزمات والاضطرابات النفسية والاجتماعية وهي ما يجعل أفراد الميم - عين تلجأ إلى الهجرة بعيداً عن الوطن والأهل والمجتمع.
يعطي الدعم المقدّم من قبل شخصية/ات عامة وثباتها على رأيها، رغم ردات الفعل السلبية، أملا بأن مطالب الحريات الشخصية لم تنس، بل وأصبحت مواضيع مهمة لعدد أكبر من شرائح المجتمع السوري.
فعلى سبيل المثال، عبّرت إحدى الفنانات السوريّات عن تعاطفها مع ما حصل لسارة، وكتبت الفنانة فرح يوسف (المعروفة بمشاركتها في برنامج المواهب العربي ARAB IDOL) تغريدة عبر حسابها على تويتر: "الله يرحمها ويسامحها... ويا ريتها كانت أقوى... أو ع الأقل محاطة بالناس المحبّة اللي تقويها.... نحنا مش مسؤولين عن تخلف هذا العالم القذر، وما في شي بالدني كلها بيستاهل انو نستسلم بهالطريقة... العالم في البشع بس فيه الحلو والخير وما لازم نستسلم أبداً. #سارة_حجازي"، مما أثار موجة من التعليقات السلبية من متابعيها العرب عموماً، والسوريين خصوصاً، وهو ما انتهى بتعبيرها عن غضبها من هذه التعليقات مناشدة أصحاب الرأي العام بعدم ترك الساحة للجهلاء كما وصفتهم، وطلبت من المتابعين احتواءها وعدم التنمّر والحكم المسبق عليها. ويعطي هذا النوع من الدعم من قبل شخصية عامة وثباتها على رأيها رغم ردات الفعل السلبية أملا بأن مطالب الحريات الشخصية لم تنس، بل وأصبحت مواضيع مهمة لعدد أكبر من شرائح المجتمع السوري.
مجتمع الميم – عين في سوريا إلى أين؟
سوريا وللأسف الشديد تعيش اليوم وضعاً عصيباً على كل المستويات سياسياً واقتصادياً ومعيشياً. ومع ما يعانيه السوريون اليوم، يرى البعض أن الحديث بقضايا مثل قضايا المرأة والنسوية والمثليين هي رفاهية ثقافية لا يستطيع السوري اليوم تحمّلها مهما كانت هويّته أو وضعه الاجتماعي. وبالرغم من انحسار الاهتمام بالمشروع الحقوقي والسياسي في سوريا، يجب ألا يتخلى السوريون عن أهمية تشكيل وتعزيز وعي سياسي لحقوقهم بالدرجة الأولى ووعي اجتماعي لظروفهم وتكاتفهم المجتمعي بالدرجة الثانية. وأفراد الميم – عين هم جزء من هذه المنظومة الاجتماعية أولاً وأخيراً، ولا شيء قد يساعد في هذه المرحلة الحسّاسة إلا محاولات زيادة الوعي بين الميم - عين أنفسهم، زيادة الوعي والتثقيف الجنسي لأنفسهم من جهة ولباقي أبناء وبنات المجتمع السوري من جهة أخرى، سواء كانت هذه المحاولات عبر المنصّات الإعلامية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه الأخيرة ربّما تعتبر أفضل خيار لنشر الوعي والثقافة الجنسيّة كونها غير مرتبطة بأية قيود حكومية وبإمكانها الوصول لشرائح أوسع من المجتمع، فيما يبقى الواقع الافتراضي أكثر أماناً بالنسبة للمثليين.
(إ)رهاب المثليين الجنسيين
17 أيار 2019
أما العمل على الأرض حقيقة هو الأصعب في هذه المرحلة وإن كان لا بدّ منه، لكنّه بحاجة إلى غطاء وحماية لكل الناشطين وهو ما تفتقده سوريا اليوم في ظل النظام الحالي والسلطة القائمة. لكن ما يمكن أن يحصل في الواقع سيقتصر على الدعم النفسي لمن تضرّر نفسيّاً، جرّاء الظروف المحيطة والدعم النفسي والطبي للعابرين/ات جندريا الذين يمنعهم الخوف من التحدّث علناً أو إبراز هوّياتهم الحقيقية ما قد يؤدي إلى أزمات نفسية في حال لم يجدوا من يدعمهم ويساعدهم ويستمع إليهم.
بالإضافة إلى ذلك يحتاج مجتمع الميم – عين في سوريا إلى إلقاء الضوء على كل الانتهاكات التي تحدث يوميّاً باسم القوانين والعادات والتقاليد والإرث الديني، والتي تحدث بصمت بعيداً عن مواقع التواصل أو تغريدات الناشطين/ات الذين/ اللواتي لا يرون/ين في سوريا إلا خراباً ودماراً ومادة مستهلكة لم تعد تستحق الحديث عنها أو الإضاءة على ما يحدث فيها كما في السنوات السابقة، فما بالكم بالمثليين/ات اليوم، سواء في مناطق سيطرة النظام أو مناطق سيطرة المعارضة وما يطبق بحقهم/ن من أحكام مجحفة وإجرامية لا تمت للإنسانيّة بصلة، حيث لم يعد لهم/ن متّسع للحلم بغد أفضل في ظلّ ما حدث ويحدث يومياً وبشكل علني وعلى مرأى المجتمع "الشرقي" المدّعي للفضيلة وهو في ذات الوقت يغض النظر عن كل الانتهاكات والاعتداءات التي تحدث، سواء بحق المثليين/ات و العابرين/ات جندريا أو غيرهم.
وهذا كلّه جعل آمال كل فرد من هذه الفئات متعلقة بالهجرة إلى بلاد تكون فيها المساحة آمنة وتسمح لهم بالتعبير عن أنفسهم من دون خوف أو قلق مما قد يحصل عليهم، آمال هي نفسها وليدة المكان والزمان، قد تنقذنا من قساوة وضعنا الحالي، ولكنها ستضعنا في مواجهات لم تكن في الحسبان مع مصاعب الهجرة والغربة، مع قساوة البعد عن الأهل والأصدقاء، ومع تجاربنا وتاريخنا وصدماتنا النفسية التي مررنا بها ككويريين/ات، والتي مازال استمرارنا في الحياة مرهونا بتجاهلنا لها وهروبنا منها.
وبين البقاء والرحيل، بين الوطن والمنفى، بين هويتي وعادات المجتمع، بين الحرية و قمع السلطة، نحن بأمس الحاجة لخلق مساحة في كل تخيلاتنا لدولة سورية مستقبلية غير مبنية على قساوة هذه الخيارات، تحمي الحريات الجندرية والجنسية وتضمن حقوق الميم – عين، وتجعل منها مكانا آمنا لكل من عاش وما زال يعيش القساوة التي عانتها سارة حجازي.