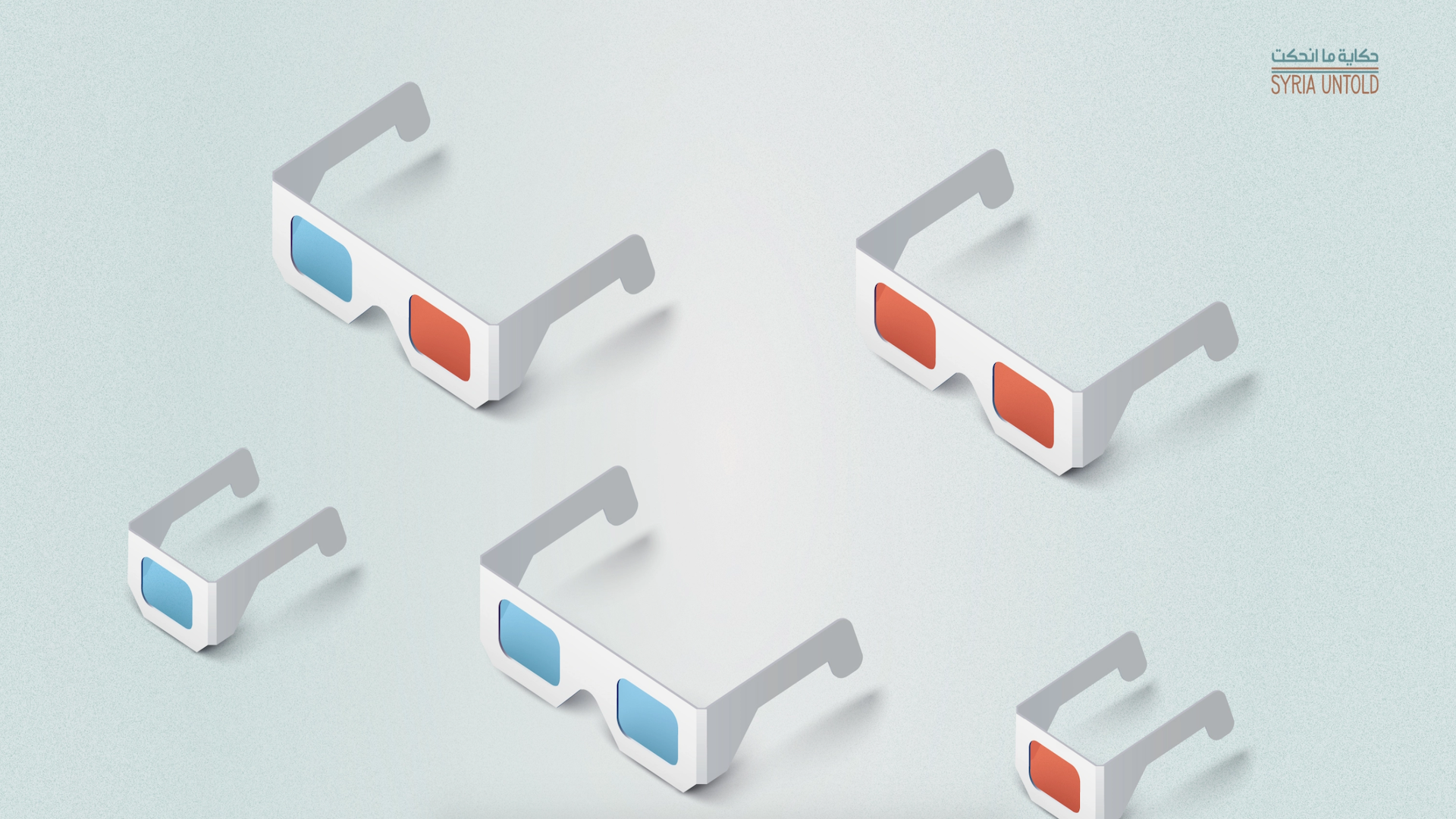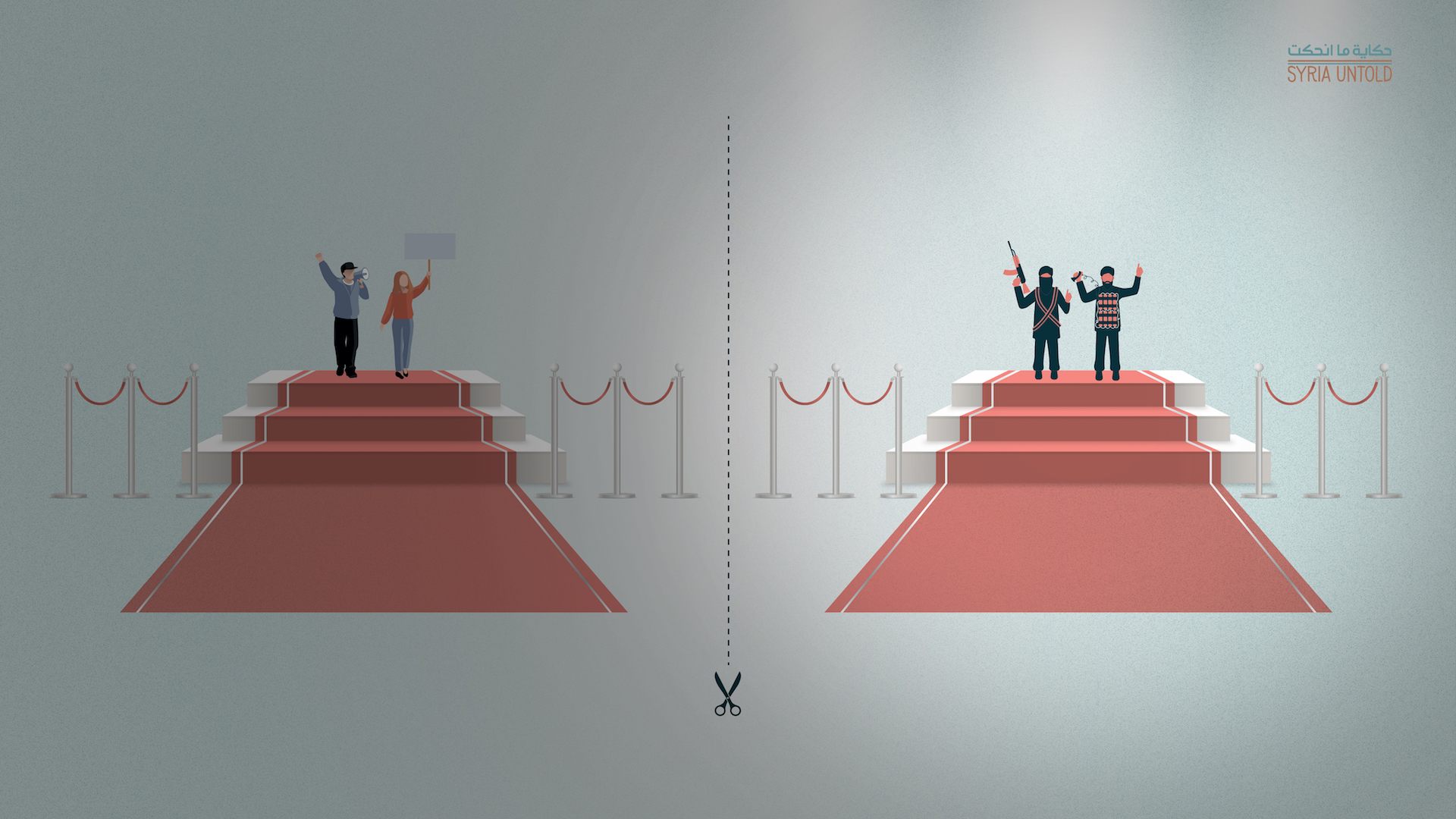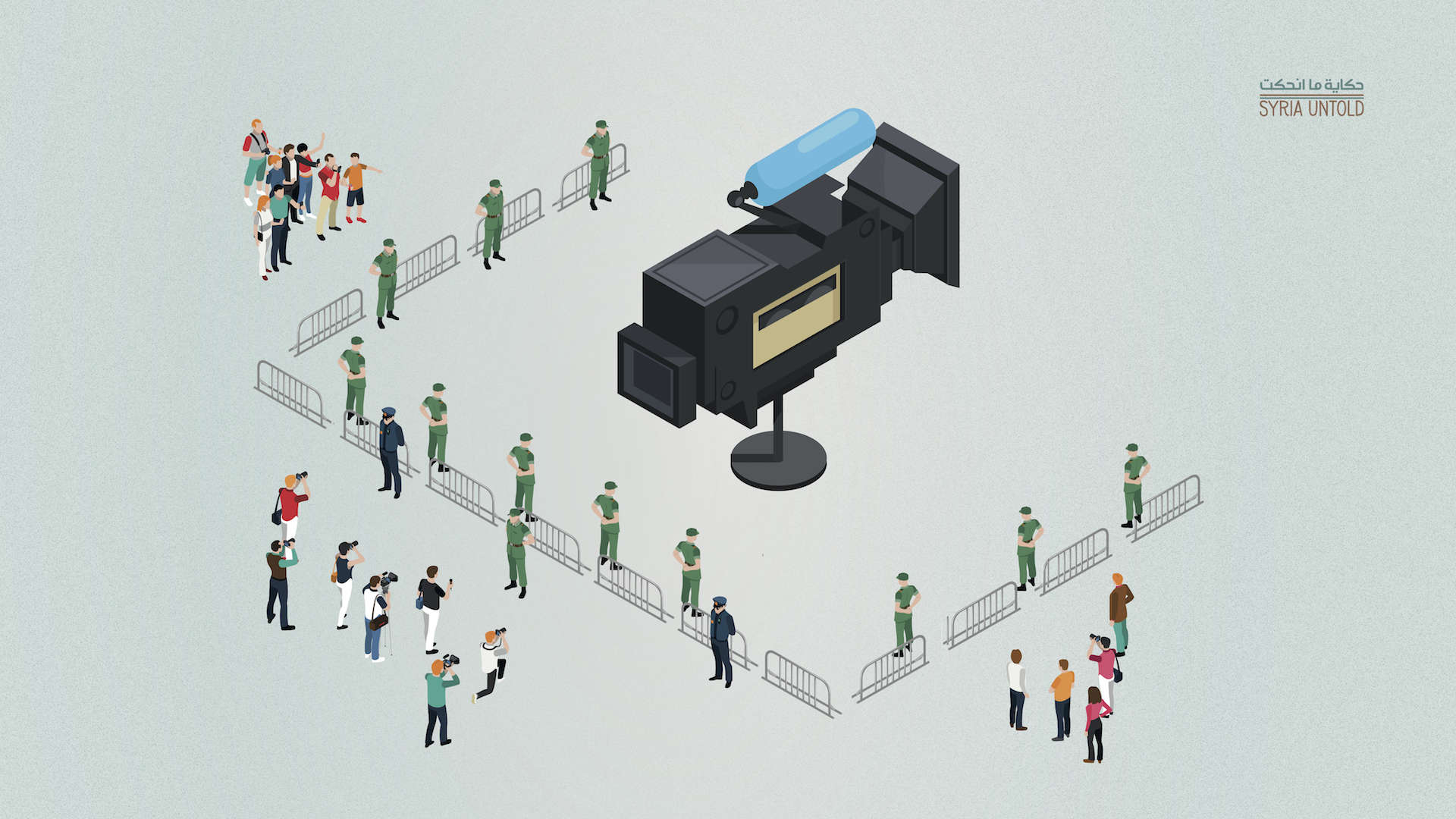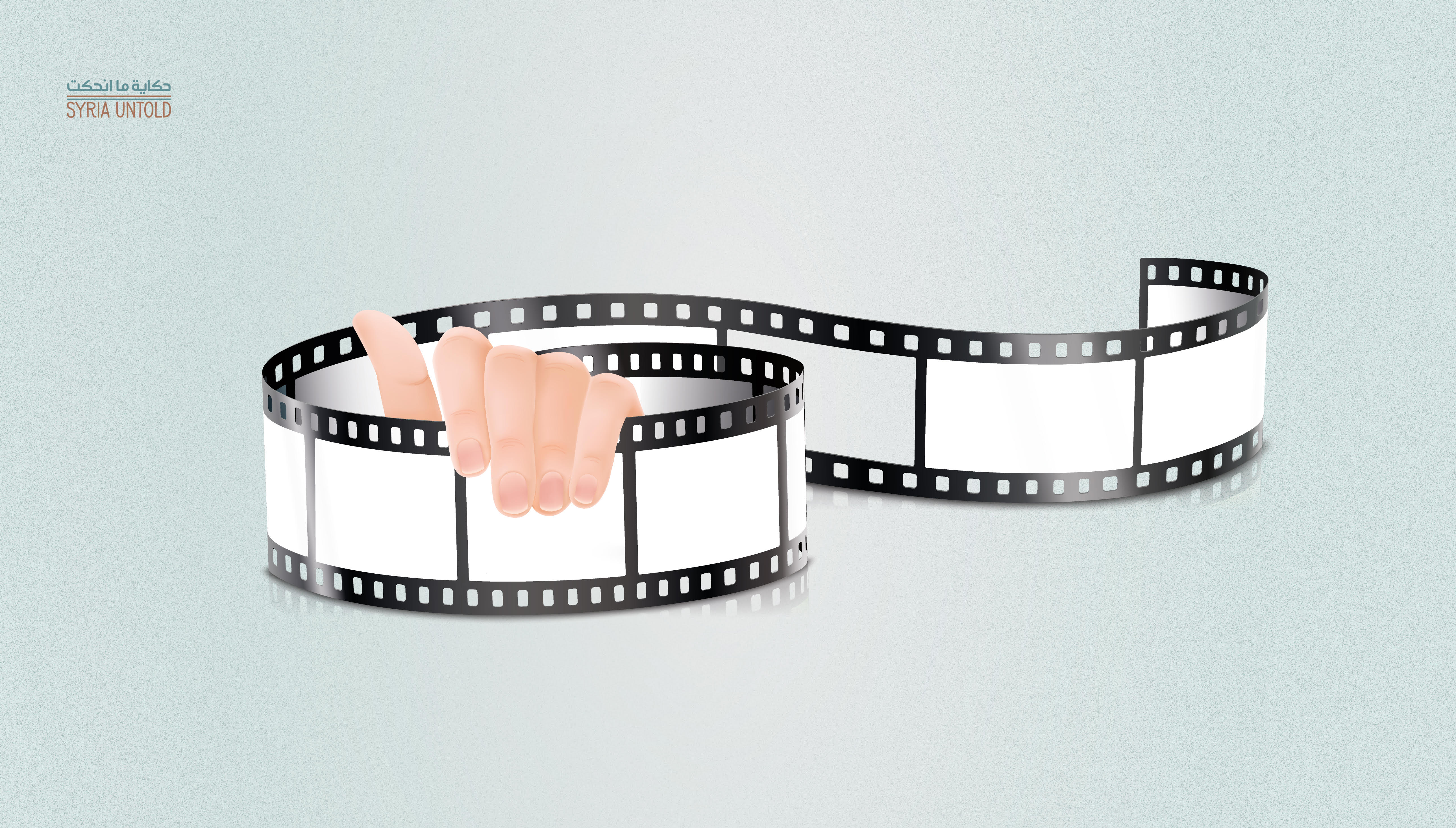نضال الدبس: مخرج سينمائي سوري من مواليد سوريا/ حمص 1960، درس الهندسة المعمارية في جامعة دمشق قبل توجهه إلى موسكو لدراسة السينما في معهدVGIK الذي تخرّج منه في العام 1994. عمل منذ ذلك الوقت في المؤسسة العامة للسينما في دمشق، كتب وأخرج فيلمه القصير الأول "يا ليل يا عين"/ ١٩٩٩. له فيلمين روائيين طويلين من تأليفه وإخراجه، الأول "تحت السقف" (2005) وهو من إنتاج المؤسسة العامة للسينما، و "روداج" (2010) من إنتاج شبكة أوربت التلفزيونية. لديه أيضا فيلم وثائقي بعنوان "الحجر الأسود" (٢٠٠٦). هنا حوار معه أجراه في 10/07/2020 السينمائي والمسرحي السوري إياس مقداد.
إياس: أنت من الجيل الثالث من السينمائيين السوريين ممن أتيحت لهم الفرصة لدراسة السينما في مدرسة عريقة ومهمة كـالأكاديمية الوطنية للسينما في الاتحاد السوفييتي VGIK. لكن وقبل أن نتحدث عن هذه المرحلة، أود أن أعرف معلومات بسيطة عن تاريخك الشخصي.
نضال: آه… طيب… تريد أن تعيدني إلى طفولتي؟!
إياس: دعني أشرح لماذا…
السينما السورية في المنفى: حوار مع صانع الأفلام: عروة النيربية (16)
06 كانون الثاني 2021
نضال: لقد فهمت تماماً ما عنيت… حتى لو لم تسألني، كنت سأذهب إلى نفس المكان. لأن السينما فعلياً قد بدأت قصتها من هناك. أنا من مواليد حمص، لكن عائلتي جاءت من مدينة السويداء. أبي كان شرطي مرور في تلك المدينة. كان فلاحاً ثم تطوّع في الدرك (الشرطة)، ولأنه كان يجيد القراءة والكتابة، وكان يعرف القليل من الفرنسية، وظفوه كشرطي مرور. هو شخص شديد الطيبة وشديد اللطف. كان محبوباً جداً في مدينة حمص. نشأت في حي شعبي، لأسرة كثيرة العدد. حمص في ذلك الزمان كانت قرية أكثر من كونها مدينة. كثيراً ما تختلط الذكريات عليَّ بين ما عشته في مدينة حمص والقرية التي كنت أقضي فيها العطلة الصيفية في السويداء. كان حجم المشترك كبير، بما فيها المشاهد البصَريّة. في السويداء حجر البازلت الأسود وفي حمص كذلك. تختلط في ذاكرتي الأمور أحياناً، لا أعرف فيما إذا كانت أحد ذكرياتي قد وقعت في حمص أم في السويداء. كانت حمص قرية بالمعنى البصري ولطبيعة العلاقات الاجتماعية في تلك المدينة. كان أبي معروفاً، ومحبوباً في حمص، لأنه لم يكن يحرّر الكثير من المخالفات بحق السائقين. عدد السيارات في حمص حينها لم يكن يتجاوز العشرة أو عشرين سيارة في أحسن تقدير، مع الباصات وغيرها من وسائط النقل العامة.
نحن الآن نتحدث عن بداية الستينات، كانت طفولتي هناك. أسرتي تعتبر فقيرة وليست متوسطة حتى، على الرغم من أنّ أبي كان موظفاً، لكن الأسرة كانت كبيرة، وإعالتها كانت صعبة. كنت أحكي لابنتي سلمى قبل يومين عن المهنة الأولى التي مارستها في حياتي، والتي كانت صناعة الأكياس الورقية. في ذلك الوقت لم يكونوا اخترعوا الأكياس البلاستيكية. كانت الأكياس الورقية هي الرائجة في محال الخضار والأسواق. كانت تصنع تلك الأكياس في البيوت. لم يكن هناك معامل لتصنيعها. كان أبي يحضر لنا أكياس الإسمنت الورقية من الورشات، فنقوم نحن بقصها، وصناعة الأكياس منها في البيت. الاستخدام الأول ليديَّ مهنياً، كانت في مهنة صناعة الأكياس الورقية. ثم انتقل عمل أبي إلى دمشق.
إياس: في أي عام؟
نضال: في الـ ١٩٦٧، بعد الحرب بشهر. كانت هذه هي الجملة الافتتاحية لفيلم (تحت السقف) الفيلم يبدأ هكذا "سكنا بهاي الغرفة بعد حرب الـ٦٧ بشهر". كان هذا حدثاً استثنائياً…
إياس: هل تعني أن أهل الحي اعتقدوا أنكم نازحين أيضاً كما في قصة فيلم تحت السقف؟
نضال: نعم بالتأكيد، كان ذلك حقيقياً. في تلك الفترة كان النازحون القادمون من الجولان ومن أماكن أخرى، يذهبون إلى حي ركن الدين الذي سكنته عائلتي القادمة من حمص، وتحديداً المنطقة الواقعة بين ركن الدين ومساكن برزة. مساكن برزة كانت كلها خيام. كنت أذهب مع أطفال الحي للفرجة على خيام النازحين. في تلك اللحظة أعتقد أنه قد حدث لي اللقاء الأول مع القصة الكبيرة. أنا قادم من قرية (بغض النظر إذا كانت حمص أو السويداء) إلى مدينة كبيرة مليئة بالنازحين، ثم التصق بعائلتنا لقب النازحين. لم يكن ممكناً أن تشرح للجميع ملابسات قدومنا إلى دمشق في تلك الظروف. أستطيع تسميتها بالصدمة الأولى، إذا أردت. لقد أخرجتني من طفولتي وعالمي الصغير. أخرجتني من بين شقائق النعمان، لأرى وبشكل مفاجئ تلك الخيام التي يسكنها بشر مثلي، ليبدأ التساؤل: من هؤلاء؟ لماذا؟ وكيف؟ وكما يحدث دائماً بعد الهزيمة، تبرز الحاجة لشخص أو جهة لتحمل المسؤولية عن تلك الهزيمة. أطلقت شائعة في دمشق تقول: أنّ الدروز قد باعوا الجولان. كان هناك شريحة كبيرة من الدمشقيين مصدّقين لتلك الشائعة، وبسبب ذلك لم يكن الدروز محبوبين في تلك الفترة. الدروز لم يكونوا محبوبين أصلاً، فما بالك بعد تلك الشائعات؟ فجأة أعطاني والدي تعليمات صارمة تقضي بعدم البوح بأني من السويداء ( درزي)، قال: أنت حمصي. وزاد الفقر.

دخل التلفاز بيتنا عندما كنت في الخامسة عشرة أو السادسة عشرة على ما أذكر، لم يكن لدي علاقة مع الصورة. لكني كنت أستمع وبشكل جيد لصوت الصورة. كان عندي راديو، أتابع عبر أثيره المباريات. "عدنان بوظو" بالنسبة لي هو صورة، وليس مجرّد صوت. كنت أستمع إليه فأرى المباراة. كنت أجلس وحيداً، أتفاعل مع اللعبة، أشجع وأصرخ، وأنفعل. لم أكن أرى المباراة، أحياناً كنت أتابع المباريات من خلال الصوت المتسرّب من خلال الجدران، وقادماً من تلفاز الجيران. كانوا يبثون على الراديو كل ليلة خميس فيلماً سينمائياً. كانوا يبثون الفيلم بنفس طريقة بث المباريات.
المذيع يبدأ بالقول: نحن في الصالة الفلانية، الجمهور بدأ بدخول الصالة… ثم تسمع صوت الجمهور… ثم يقول المذيع: سوف نشاهد اليوم الفيلم الفلاني… على الأغلب فيلم مصري، ليس على الأغلب، هو أكيد فيلم مصري. المذيع: تخفت الإضاءة في الصالة… و تبدأ آلة العرض… ثم يبدأ بقراءة العناوين الفرعية للفيلم. يسكت المذيع فقط عندما يكون هناك حوار بين الشخصيات.
إياس: المذيع يوصف الحركة في الفيلم ( الميزانسين/ mise en scène )؟
محمد علي الأتاسي: لم ننتج يوما فيلما يخص جمهورا غربيا (15)
17 تموز 2020
نضال: كأن المذيع يقرأ علينا السيناريو. المذيع يقول: "يدخل إلى غرفتها متلصصاً...". ثم يسكت المذيع ليترك لنا فرصة الاستماع إلى صوت ردّة فعل الشخصية الأخرى ( الفتاة)… الفتاة تصرخ وتهرب نحو النافذة إلخ…
بسبب عدد أفراد أسرتي الكبير، والتي كانت تنام في غرفة واحدة، كنت مضطراً أن أضع الراديو كبير الحجم تحت مخدتي لكتم الصوت عن النيام في الغرفة. كانت تلك أول علاقة لي مع السينما. علاقة سمعية تماماً.. علاقة وصفية تماماً. العلاقة مع الراديو كانت تأسيس ليس فقط للجانب السمعي في علاقتي مع صناعة الفيلم، بل كانت أيضا تأسيساً للجانب البصري لها. في علاقتي مع الراديو، كنت أبتكر كل شيء ما عدا الصوت، أتخيّل وجه الممثل المتلصّص، أتخيل وجه الممثلة الخائفة، أتخيّل الطريقة التي ذهبت بها إلى النافذة. كنت أقوم بإخراج الفيلم… هل تفهم عليّ؟ أنا عم أخرج الفيلم. الصوت من عندكم، والباقي اتركوه لي.
إياس: دعنا نتحدث قليلاً عن الفترة الممتدة بين العام ١٩٦٧ والعام ١٩٧٣، تلك الفترة الواقعة بين حربين. الحرب الأولى كانت هزيمة نكراء والحرب الثانية كانت نتيجتها انتصار واهم. كيف عايشت مع أبناء جيلك تلك الأحداث؟ ما يهمني هو تجربتك الشخصية فيما يخص هذا الأمر.
نضال: حسناً… حسناً. الآن سوف أحكي لك مشاهد سوف تكون في أفلامي القادمة. إن حقوق النشر لتلك المشاهد يجب أن تكون محفوظة… ( يضحك) الـ ١٩٦٧ بالنسبة لي هي مشهد… مشهد سينمائي. توصيفه لك هو جوابي على ما عنته لي تلك السنة، سوف أروي لك ٣ مشاهد.
هل يوجد لغة سينمائية سورية؟ نعم، هناك لغة سينمائية سورية. هل يوجد تمايز للفيلم السوري عن الفيلم المصري، أو التونسي، أو العراقي؟ نعم، هناك تمايز. هل نستطيع معرفة الفيلم السوري فقط من خلال الصورة دون الصوت؟ نعم وهذا ليس رأيي أنا، هذا رأي النقاد و الجمهور.
المشهد الأول، العام ١٩٦٧ كنّا ما نزال نعيش في حمص. كنت طفلاً وتسليتي الوحيدة في ذلك الوقت هو اللعب على سطح منزلنا العربي القديم، والذي يحتوي العديد من الأغراض المهملة ( الكراكيب). كان هناك كرسي خشبي مربع صغير، مقعده مصنوع من القش، لم يبقى منه سوى إطاره الخشبي، وأنبوب للصرف الصحي مصنوع من البلاستيكي، مكسور (مزراب). قمت بربط المزراب إلى الكرسي الخشب. كان للمزراب رأس على شكل قمع، كمدفع. قمت بربط قطعة من المطاط برجل الكرسي، وبدأت بقذف الحجارة من خلال الأنبوب البلاستيكي، بمساعدة الشريط المطاطي. كنت سعيداً بهذا الذي صنعت. ما حدث بعدها أنّ أحد الجيران انتبه لما كنت أفعله على سطح منزلنا، الجار تحدّث إلى والدي قائلاً له: مشان الله، حاول أن تخفي تلك الدمية التي صنعها ولدك، فالطائرات قد تعتقد أنه مدفع حقيقي فيقومون بقصفنا! كانت تلك أول علاقة لي مع الحرب، كان مطلوباً مني تفكيك تلك اللعبة وإخفاء أجزائها.
المشهد الثاني، كان مشهداً مرعباً، ما جعلني مقتنعاً أنّ للجيران كل الحق بالخوف من مدفعي الذي بنيته على السطح. كان ذلك عندما قصفت إسرائيل مصفاة النفط في حمص، والتي كانت قريبةً نسبياً من بيتنا. أذكر أننا سهرنا كل الليل نتفرج على النار التي التهمت المصفاة. كان حجم النار هائلاً. كنّا أطفالاً، وبقينا مستيقظين حتى الصباح نتفرج على تلك النار دون أي موقف، لم نكن حزانا أو خائفين، لكن صورة النار تلك كانت اكتشافاً بصرياً عظيماً… أيضاً لاحظت الوجوه المُكَدَّرة من حولي.

المشهد الثالث، وهو المشهد الكارثة، الكبير، والعنيف. بعض الناس قد لا يصدقون تلك الرواية. لو لم أعش تلك القصة، لو أني قرأتها في كتاب ما، لكنت قلت أنها مجرّد مبالغات.
كان هناك مجموعة من الجنود السوريين، هربوا من جبهة الجولان عند الهجوم الإسرائيلي، ضلّوا طريقهم. لم يتمكنوا من الوصول إلى دمشق، فضاعوا في الجبال. ساروا لأيام حتى وصلوا أخيراً إلى مدينة حمص، وما كانوا يعرفون بها أحداً. من بين أولئك الجنود، جنديين من السويداء، سألا الناس عن شخص ما ينتمي لمدينة السويداء في حمص، فدلّوهما على أبي، بحكم أنّ أبي كان شخصاً معروفاً في حمص. وصل الجنديان من جبهة الجولان إلى منزلنا بعد أسبوع تقريباً على الهجوم الإسرائيلي. أتذكرهما عندما دخلا. كانت أشكالهما مرعبة. بدأت أمي بسرعة بتحضير المياه الساخنة للشابين الذين بدآا بخلع بدلاتهم العسكرية. دخلت إلى الغرفة حيث كانت ملابسهما. رأيت الحالة التي كانت عليها تلك البدلات العسكرية. كان قماشها قابلا للكسر بسبب التعرّق المستمر للجنود على مدار أسبوع في شهر حزيران الملتهب. اللقطة القريبة والفظيعة في ذلك المشهد كانت عندما بدآا بخلع أحذيتهما العسكرية وجواربهما. طلب إليّ أبي مساعدته في معاونة الجنديين اللذين لم يكونا قادرين على خلع تلك الأحذية. عندما كنّا نحاول خلع البوط من قدم أحدهما، كان يصرخ من شدّة الألم. سمع أصواتهما كل أهل الحي. المرحلة الثانية كانت مساعدتهما في خلع الجوارب. هذا الجزء كان مرعباً، لأن الجوارب كانت ملتصقة بالجلد. كان الجلد ينسلخ مع تلك الجوارب. كان صراخاً فظيعاً. تلك كانت صورة الهزيمة في حزيران. رائحة ملابس وجوارب، جلد مسلوخ، ورجال يبكون وأمي تغلي الماء. هكذا تركت عام ١٩٦٧.
اغتراب السينما السورية (8)
10 شباط 2020
في العام ١٩٧٣ كانت الحالة مختلفة، أولاً: كنت قد صرت أكثر وعياً، ثانيا: كان لدينا الكثير من الأقارب يقطنون في دمشق. واحد منهم ابن عم لي تزوّج أختي. كان ذلك الشاب ضابط في الجيش، ضابط نموذجي. صورته كانت على غلاف مجلة الجندي العربي. كان هذا الشاب محباً للشعر، وهو الذي شجعني على الكتابة. كان يحبني كثيراً. كان من الأشخاص الذين بذلوا جهداً في توسعة مجال قراءاتي. كانت علاقتي به خاصة جداً. كان يسكن بمكان قريب على منزلنا، وكان يحضر مخططات عسكرية إلى المنزل قُبيل حرب العام ١٩٧٣ بأشهر. كان لديه غرفة فارغة خصّصها للعمل على تلك المخططات. كنت أذهب لمساعدته، وتعاملت لأول مرة مع أدوات الهندسة العسكرية. تعلمت كل الرموز الموجودة على تلك المخططات. المثلث كان يعني دبابة، والمستطيل يرمز للأبنية إلخ...
كان يطلب مني أن أرسم دبابة في هذا المكان أو جندي في ذلك المكان على الخريطة. في تلك الغرفة التي تحوي خريطة ضخمة، كنت أمارس لعبة الحرب، عم عيش الحرب. كانت تلك اللعبة كأنها فيلم سينمائي. كل البلد كانت تعيش حالة احتفالية عند نشوب الحرب. كنا قادرين هذه المرة على رؤية ما يحدث بأعيننا، دون الحاجة لوسائل الإعلام التي كذبت علينا في حرب العام ١٩٦٧. نشبت الحرب في رمضان. عند الإفطار مساءاً، كنا نرى الطيران الإسرائيلي في سماء دمشق، كيف كانت تخرج الصواريخ من قواعدها الأرضية لتصيب الطائرات المهاجمة. كنا نرى الطيارين الإسرائيليين وهم يقفزون بمظلاتهم هرباً خارج الطائرات المحترقة. كان جارنا في حي ركن الدين طياراً حربياً، كان كلما انتهى من تنفيذ عملية فوق الأراضي المحتلة، وهو في طريق عودته إلى القاعدة، يمرّ على ارتفاع منخفض من بيته محيياً زوجته المنتظرة في المنزل. كان الحي كله يقول: لقد عاد مجيد. عند سماع هدير المحركات يهللون باسم مجيد العائد. هكذا كانت الأجواء. كنّا في حالة من النشوة. الأيام العشر الأولى كنّا في حالة نشوة. انتهت الحرب بخبر استشهاد ابن عم لي. كان الخبر صاعقاً، ثم استشهد ابن عم آخر بعد عدة أيام من استشهاد الأول، ليأتينا بعدها خبر استشهاد ابن عمي، زوج أختي الذي أحب. كان أمراً صعباً، لم يمضي على زواجه من أختي أكثر من ثلاثة أشهر، كان ما يزال عريساً. هذا ما جعلني أدرك أن ما يحدث ليس بلعبة. كان لي خالة تسكن في الجولان في قرية حضر، وعندما بدأ الخراب، وبدأ الإسرائيليون بالدخول، نزحوا إلى منزلنا. لقد كانوا أيضاً أسرة كبيرة، فجأة تحوّل بيتنا إلى مخيم، هنا بدأ ميلي إلى السياسة.
إياس: النادي السينمائي؟
نضال: أسس في العام ١٩٥٨ النادي السينمائي في دمشق، والذي توقف عمله لفترة طويلة بعد تأسيسه. لكن وبعد عودة عمر أميرلاي من فرنسا وبالتعاون مع هيثم حقي ومحمد ملص أعادوا إحياء النادي السينمائي. أنا الآن أتحدث عن بداية السبعينات ١٩٧٤ على ما أذكر. في تلك الفترة كنت قد تعرفت على النادي السينمائي، أخي الأكبر هو من اصطحبني إليه أول مرة. كان أخي مهووساً بالسينما على الرغم من عدم دراسته لهذا الفن، كان يدرس في فرنسا، وعند عودته إلى دمشق تعرَّف على الشباب الذين قاموا بإعادة إحياء النادي السينمائي، ثم عرفني أخي على النادي لأصبح العضو الأصغر فيه، حيث تعرفت على الشباب (عمر أميرلاي، محمد ملص، هيثم حقي،... إلخ ) وكانوا يحبونني كثيراً كوني الأصغر، ولكوني أُمثل الدم الجديد الذي يحتاجه النادي للاستمرار. صار النادي السينمائي بيتي الثاني… نحن الآن في العام ١٩٧٦- ١٩٧٧ كنت في السابعة عشرة تقريباً.
إياس: حدثني عن الاستعداد لدراسة السينما، عن قبولك في أكاديمية السينما في الاتحاد السوفيتي، وسفرك إلى هناك.
نضال: حصلت على المنحة لدراسة السينما بعد تدخل شديد العنف وشخصي من فواز الساجر، سعيد مراد، محمد ملص، وهيثم حقي… شكلوا وفداً وذهبوا للقاء المسؤول الثقافي في السفارة السوفيتية في دمشق. قالوا للمسؤول السوفيتي، يجب أن يسافر نضال لدراسة السينما. لقد فعلوا ذلك تحت شرط وحيد وهو أن أدرس التصوير السينمائي وليس الإخراج، كانت سوريا قد بدأت تعاني من قلّة المصورين السينمائيين، الكثير من المخرجين والقليل من المصورين. أنا وافقت على الفور، قلت لهم أعدكم بأن أدرس التصوير السينمائي، فقط أعينوني على الحصول على منحة. كتب الشباب عريضة وقع عليها كل خريجي السينما من الاتحاد السوفييتي مع العديد من الشخصيات السينمائية مثل المخرج سمير ذكرى، ثم أخذ المخرج الراحل، فواز الساجر، تلك العريضة شخصياً إلى المسؤولين السوفييت في دمشق، وبهذه الطريقة حصلت على المنحة، وكانت لدراسة التصوير السينمائي، لكني غيّرت الاختصاص هناك في موسكو، وقد خيّب ذلك آمال الأشخاص الذين دعموني، واعتبروها خيانة للوعد الذي قطعته. وكان جوابي: هذا صحيح، لقد خنت الأمانة.
في موسكو كانت بداية حكاية جديدة، يبدو لي أنّه مقدّر عليّ العيش في أماكن تشهد تحولات كبيرة. لقد كنت في موسكو في فترة نظام البيروسترويكا (Perestroika). كان هناك شيء يحدث على الصعيد السياسي، وما يحدث كان كبيراً. كان هناك نقاش حول قدرة البيروسترويكا على إنقاذ النظام الشيوعي في الاتحاد السوفيتي، ونقاشات حادة حول تطوير النظريات الفكرية إلخ…
إن ما يجمع المخرجين السوريين، ومن كل الأجيال، هو ذلك الإحساس العميق بالالتزام، والذي يحوّل مشروع كل فيلم ينجزه السينمائي السوري إلى مشروع حياة.
بعد تعلم اللغة الروسية بدأت دراستي في أكاديمية السينما. كان المكان مختلفاً عن الصورة التي رسمتها في خيالي، من خلال قصص الطلاب السوريين القدماء، والذين كانوا هنا قبلي. كان في المعهد عندما كنت هناك الكثير من الأفكار المتناقضة والكثير من الصراعات في هيكل إدارته مع رقابة على طريقة تفكير الطلاب. كان واضحا أنّ المعهد تحوّل إلى مكان ضيق ومحدود. ما تبقى من الكادر التدريسي القديم كانوا عنيفين معنا. كان لديهم شعور أنّ الخيوط بدأت تفلت من بين أصابعهم. على سبيل المثال: كان هناك كِتاباً مهماً بالروسية عن السينما السوفيتية، ترجمه الراحل "سعيد مراد" إلى العربية، قرأناه جميعاً. مؤلف هذا الكتاب كان "روستيسلاف يورينيف Rostislav Yurenev"، والذي يعد من النقاد العظماء، وأحد أهم مؤرخي السينما السوفيتية، وكان أستاذي الذي درسني تاريخ السينما السوفيتية في الأكاديمية. كان الأمر بالنسبة لي عظيماً، كنت قد درست الكتاب في دمشق، والآن أنا طالب لدى مؤلف ذلك العمل الكبير. لكن كانت المحاضرة الأولى والثانية مع هذا الشخص كارثة، كان شخصاً مؤدلجاً إلى حد اللعنة، أفقه ضيق لحد اللعنة. كان يمضي وقتاً لا بأس به من محاضراته، يبرّر أمامنا مساهمته المعروفة بمنع الكثير من الأفلام في الاتحاد السوفيتي. كان يحاول التبرؤ من تلك الأفعال، كان مأساة حقيقية. كانت المادة التي درَّسها لنا شديدة الصعوبة، وهو كان شديد القسوة. لقد تعاملت مع مادته تماماً بنفس الطريقة التي نتعامل بها مع مادة التربية القومية والاشتراكية الموجودة في مناهج المدارس والجامعات في سوريا. في أي موضع تشعر أنك لا تعرف ماذا تقول، عليك فقط بكتابة قال القائد، ثم تضع أي جملة بعدها. بهذه الطريقة تحصل على التقييم الجيد بغض النظر إذا كان القائد قد قال ذلك الكلام، أم لم يقل. كان "يورينيف" يطلب مني تحليل مشهد في فيلم سوفيتي، فأبدأ أنا بالقول: أن هذا المشهد من الفيلم يجسد النظرية اللينينية القائلة بلا بلا….. إلخ، هذا كان يجعله منتشياً، فلا يسمح لي بالاستمرار وينتقل إلى طالب آخر أو سؤال آخر. بعد تلك الفترة بدأ الانهيار الفعلي في الاتحاد السوفييتي وهذا أمر قد عايشته. كان وضعي في تلك الأكاديمية مختلف عن الطلبة السوريين الذين تخرجوا قبلي من نفس المعهد. إذا سألت المخرج أسامة محمد، عن ذكرياته هناك، فسوف يحدثك لساعة على الأقل عن علاقته الحميمة مع المشرف عليه في سنوات دراسته، وعن التأثير الذي صنعه "تالانكين" (Igor Talankin) في وجدانه السينمائي. كان من المفروض أن يشرف "تالانكين" عليّ أيضاً. لكن في اللحظة الأخيرة قرّرت الإدارة تغييره دون التصريح بالسبب، لكني عرفت السبب. لقد كان "تالانكين" شخصا منفتحا فكرياً، وتوجهاته السياسية لا تتطابق مع رؤية إدارة المعهد. أحضروا لنا مشرف آخر كان اسمه "خوتسيف" (Marlen Khutsiev)، والذي يعد من المهمين جداً في تاريخ السينما السوفيتية في فترة الستينات، كنا سعداء بالأستاذ الجديد، لكن وبعد المحاضرة الأولى والثانية أصابنا الإحباط بشكل تام، فقد كان هو أيضاً متعفناً. هذا هو الفرق الأساسي بيني وبين الخريجين الذين سبقوني، أنا لم يكن لديّ مشرف آمنت به ليؤثر بي. خلال السنوات التي درستها أشرف عليّ ٣ معلمين. كانوا يغيّرون الأساتذة بشكل سريع ومستمر. ببساطة، المرحلة السياسية التي كانت تشهدها البلاد لا تستطع تحمّل أياً من أولئك المشرفين، أصحاب الفكر الحر. كان تعيين الأساتذة متوقف على مواقفهم السياسية من الإجراءات المتبعة في دوائر السلطة العليا، إلى جانب التغيّر في مراكز القوة داخل تلك السلطة. ثلاثة مشرفين لا أحد يشبه الآخر. كان من بينهم المخرج التشيلي "سباستيان ألاركون" (Sebastián Alarcón) الذي أخرج فيلم "ليل فوق تشيلي" ذلك الفيلم العظيم إذا كنت تعرفه؟! هرب من تشيلي إلى الاتحاد السوفيتي بعد الانقلاب العسكري، وفي الاتحاد السوفيتي صنع ذلك الفيلم العظيم آنف الذكر. لقد درسني لمدة عام، هو أيضاً، كان جيفارياً على الطريقة السوفيتية المتحجرة. أنا لم يكن لدي مشرف، لكني استعضت عن ذلك المشرف بشيء آخر.

إليك الحكاية: عندما انهار الاتحاد السوفيتي، فُتِحت مخازن الأفلام الممنوعة من العرض في موسكو، لقد كان عدد الأفلام هائلاً. كل الأفلام التي صُنعت في الاتحاد السوفيتي ومُنعت من العرض كانت محفوظة في مخازن استديوهات الشركات التي أنتجتها. واحد منها كان استديو "غوركي" الذي كان قريباً من المعهد. عندما فتحت تلك المستودعات أقبل الجمهور عليها بنهم منقطع النظير. كانوا يعرفون عناوين تلك الأفلام، لكنهم لم يشاهدوها قط. أتاح لي ذلك رؤية عدد هائل من الأفلام السوفيتية الممنوعة. كما تمكنا من مشاهدة النسخ الأصلية للأفلام التي تم قصها من قبل الرقيب الحكومي. تمكنا من مشاهدة المونتاج الخاص بمخرجي تلك الأفلام. رأيناها كما صنعها مؤلفوها، وليس كما أرادت لها السلطة أن تكون. على سبيل المثال، أفلام "تاركوفسكي" التي صنعها في الاتحاد السوفيتي، تلك الأفلام لم تُعرف بالمونتاج الأصلي لتاركوفسكي، بل بالمونتاج الذي أقرته السلطة السينمائية حينها. لقد شاهدنا فيلم "أندريا روبلوف" كما منتجه "تاركوفسكي" ورأينا الفرق بين النسخة التي نعرف والنسخة الجديدة أمامنا. دخلنا في تحليل أسباب قطع لقطعة معينة من فيلم لإحلال لقطة أخرى مكانها. كنت محظوظاً.
إياس: إذا نستطيع القول أن نضال الدبس تعلّم السينما من السينما الممنوعة؟
جمهور السينما السوريّة في ألمانيا والقيود الإنتاجيّة المفروضة (6)
21 كانون الثاني 2020
نضال: تقريباً، كانت منبع مهم للمعرفة. بعد أن تعلمنا في السنة الأولى والثانية كل الكلاسيكيات والأصول الخاصة بالمدرسة السوفيتية في السينما، والتي هي سينما عظيمة بحق، أتيحت لنا تلك الفرصة لرؤية شيء آخر تماماً. كان هذا أمراً عظيماً، وما أزال أعتبر نفسي محظوظاً. كنا نناقش أدق التفاصيل في تلك الأفلام. ثم أتيحت لنا الفرصة للقاء شخصيات مهمة في تاريخ تلك السينما. على سبيل المثال، جلسنا إلى مهندس الصوت "إينا زيلينتسوفا Inna Zelentsova" الذي عمل على الصوت في فيلم (أندريا روبلوف) لـ تاركوفسكي. حكى لنا عن صوت جرس الكنيسة في ذلك الفيلم، وكيف أنهم قاموا بتسجيل عدد كبير من أصوات أجراس الكنائس من أماكن مختلفة من أنحاء الاتحاد السوفيتي، ليقدموها أخيراً للمخرج ليختار منها. كيف أن تاركوفسكي اختار صوتين لجرسين محددين، ومزج الصوتين معاً للفيلم. هنا بدأنا التعلّم بطريقة مختلفة، أدركنا أنّ المنع لا يقتصر على حذف مشاهد من الفيلم أو منعه بشكل كامل. المسألة كانت مرتبطة بنضال أولئك المخرجين ورؤيتهم الفكرية والفنية. كنت أجلس إلى أحد النوافذ في الأكاديمية، مرّ بالقرب مني أحد الأساتذة، قال لي: هل تود الانتحار؟ فاجأني السؤال، فأجبت: عفواً ولماذا أنتحر؟ ضحك الأستاذ وقال لي: ألا تعلم أن "تاركوفسكي" حاول الانتحار من هذه النافذة بالتحديد؟ (يضحك ساخراً).
كانت المتغيرات حادة. عندما كنت في السنة الأولى أو الثانية، أخرجت مشهداً مسرحياً من نص لـ "تشيخوف" حوّلت المشهد الجدي إلى هزلي، كنت أريد ذلك. لم يسمحوا لنا بتقديم المشهد لأنه في تلك المرحلة كان ينظر إلى نتاج تشيخوف الأدبي على أنه مقدّس ولا يمكن المساس به. لكن وبعد تلك التحولات السريعة تمكنا من تقديم المشهد في المدرسة كما أردته (سيرك)…
إياس: حدثني عن عملك مع أسامة محمد، والذي سوف يتعاون معك لاحقاً في فيلمك "تحت السقف".
نضال: الفترة التي عملت فيها مع أسامة، كانت تعارفاً، ليس فقط على الصعيد الشخصي، الأهم كان على الصعيد الفني، وحتى على المستوى السياسي. في تلك الفترة حدثت أزمة مؤسسة السينما التي كانت في طريقها إلى الخصخصة، فوقف السينمائيون في وجه هذا المشروع عن طريق البيانات والاجتماعات. بالمختصر، لقد صنعنا هيصة والهيصة حينها كانت فعلاً سياسيا. طرحنا موقفنا من باب أن الدولة بحكم الدستور مسؤولة عن دعم الفن والثقافة، ومن أرد أن ينتج فيلم قطاع خاص فهذا متروك للراغبين بفعله. النظام يتحمل مسؤولية ضرب السينما الخاصة وإنهاءها في سوريا، وليس السينمائيين. نحن لم نكن ندافع عن المؤسسة العامة للسينما، إنما كنا نرفض تخلّي الدولة عن دورها في دعم الثقافة والفن، وكنا نتحدث عن الآليات التي يجب أن تُتبع في سبيل الحفاظ على ذلك الدور.
أنا تعرفت على أسامة من خلال العمل على فيلمه "صندوق الدنيا/ ٢٠٠٢". جئت إليه وقلت له بأني عاطل عن العمل، وبأني لا أطلب أي شيء، فقط أرغب بعيش التجربة. وفعلاً، بدأت بحضور الاجتماعات كمستمع ومتفرج فقط… بعد وقت قصير بدأت أشارك في الحوار، وفي بعض الأحيان كانوا يسألونني عن رأيي. بعد ذلك قال لي أسامة: أنت يجب أن تكون في فريق الفيلم، ويجب أن تحصل على أجر، وهذا ما كان، وكرّست نفسي لمشروع الفيلم.
الفكرة هي ليست في إعادة الإصلاح، المسألة تكمن في البحث عن الذات قبل التفكير بالإصلاح أو الهدم. مطلوب منك أن تجد ذاتك، ويجب أن تكون واضحا في خياراتك، وألا تكون متأرجحاً.
بعد فيلمي القصير الأول "يا ليل يا عين 1999"، زادت علاقتي قرباً بأسامة، وبدأ الحوار بيننا. بعد ذلك زادت ثقته أكثر بي، وهذا ما حفزه على التفكير بأنّي قد أكون مفيدا للفيلم، فبات يشركني أكثر بالنقاش والعمل على الفيلم. كان هذا يستمر حتى ساعة متأخرة من الليل.
إياس: وَصِّفَ لي أسامة محمد كسينمائي
نضال: أسامة يتعامل مع السينما كأنها دين، بمنطق ديني إيماني. هو من المتصوفة الذين يهبون جسدهم بعد الروح لمشروعهم. لذلك دائماً أتحدث عن عمله على أنه مشروع، شيء أكثر من مجرّد فيلم. أسامة يهب كل شيء، ويجرك معه، يصيبك بالعدوي، فتجد نفسك متورطاً أيضاً. قد لا تكون موافق على وهب نفسك للسينما، لكن تفانيه يجذبك.
إياس: فيلمك الطويل الأول "تحت السقف" حدثني عن الفيلم.
نضال: نعم هو تعذيب. التعذيب قادم من تلك الغرفة المكعب التي تملك سقفاً. أنت محاصر داخل تلك الغرفة التي تشكل ذاكرتك، وكل حكايتك الشخصية، هي كل ما تملك، هي عالمك. عالمك ليس بصغير، فيه تنوّع، وإلى حد كبير نستطيع اعتباره واسع، لكنه بعد ذلك يبدأ بالانكماش، فيصبح ذلك المكعب هو فضاءك المحدود. أنت فاقد للخيارات. ليس أمامك سوى التواطؤ مع السقف، مع الذاكرة. السقف يختار لك ما الذي يجب أن تراه الآن، ما الذكرى التي ستداهمك في هذه الحظة!. السقف والتلفاز يمثلان في الفيلم الشكل المعاصر للذاكرة. شخصيات الفيلم تواجه ذلك التحدي: هل ستظل داخل المكعب؟ أم أنك ستخرج منه؟! لا خيارات أخرى.

الأمر الآخر هو على شكل سؤال: هل المكعب قابل للإصلاح؟ بطل الفيلم كان من الممكن أن يصلح الغرفة التي يسكنها، لكن الأزمة بالمكعب الأكبر، أو كما سميته السقف الثاني. ففي كل مكعب خارج المكعب الأول هناك قصة، وإذا خرجت أكثر، إلى الشارع، فستجد مكعبات وقصص. الفكرة هي ليست في إعادة الإصلاح، المسألة تكمن في البحث عن الذات قبل التفكير بالإصلاح أو الهدم. مطلوب منك أن تجد ذاتك، ويجب أن تكون واضحا في خياراتك، وألا تكون متأرجحاً. تلك الميوعة بالموقف عند عدد كبير من السينمائيين السوريين والوسط الثقافي بشكل عام، والتي لاحظتها عندما عدت من موسكو إلى سوريا. الهامش الذي كانوا يقولون أنه كافٍ، لا إنه ليس بكاف (إشارة إلى موقف المخرج عبد اللطيف عبد الحميد والمرتبط بقبوله للهوامش التي تركها النظام للمخرجين السينمائيين، وقناعته بأنها كافية لقول ما يجب أن يقال). لن أمضي حياتي داخل الهامش، لأعود بعد فترة للمطالبة بهامش أوسع.
موت الشاعر في فيلمي "تحت السقف" هو موت لكل الأشياء التي يمكن أن نعتبرها خالدة، فالشاعر كان رمزاً ممسكاً بالذاكرة.
موت الشاعر في فيلم "تحت السقف" هو موت لكل الأشياء التي يمكن أن نعتبرها خالدة، فالشاعر كان رمزاً ممسكاً بالذاكرة.
حجم المتغيرات التي حصلت، وأنا هنا أتحدث عن الفيلم، كانت كبيرة. أولئك الشباب الذين كانوا يجتمعون يوماً لترديد أغاني الشيخ إمام، باتوا في مكان آخر، بطل الفيلم بات في مكان آخر أيضاً. كنت في الفيلم أتحدث عن تغيّر تلك الشخصيات ضمن الظروف التي عاشتها على هامش الحياة في دمشق. هذا كان انطباعي عندما عدت من موسكو. نحن نحاول الانتماء إلى عالم قد لا يشبهنا، قد لا يشبه الذات التي نملك. ذلك هو السؤال الذي كان أمام لينا (سلاف معمار) وأمام مروان (رامي حنا)، السؤال كان: هل من الممكن استرجاع تلك الذاكرة؟ لم يكونوا قادرين على استرجاع تلك الذاكرة على الرغم من المحاولات.
إياس: في فيلم "تحت السقف" لاحظت النقد الواضح لصورة المناضل الرمز (شخصية الشاعر/ فارس الحلو)، تلك الصورة الهشة، والساذجة في بعض الأحيان، تلك الشخصية التي لا تحمل عمقاً سياسياً، ولا تملك الرؤيا. مجرد حالة عاطفية ديماغوجية.
الوثائقي السوري وجمهوره (٤)
18 كانون الأول 2019
نضال: تماماً، إنها جمعية قطيعية إذا أردت. يجب أن نتحلّى بالجرأة، للاعتراف بذلك. كان الوضع كذلك فعلاً. الشعر خلق لـ "لينا" حلماً لم يتحقق. عندما كانت لينا تشكو لـ مروان، جوابه كان أن الأشياء الكبيرة جعلتهم لا ينتبهون للأشياء الصغيرة. تصاب لينا بموجة من الغضب بسبب تسمية مروان لتلك الأشياء بالصغيرة، وتلومه على التسمية. كل المشكلة تكمن في اعتبار ذواتنا أشياء صغيرة وهامشية، وبأنّ الأهم هو العمل على القضايا الكبيرة، فكان ضياعنا. صحيح أنه شاعر لكنه ضعيف.
إياس: كان كل ما أنتجته المؤسسة العامة للسينما والتي تأسست في العام ١٩٦٣ مشغولة بالقضايا الكبيرة.
نضال: أضف إلى ذلك أنها كانت مشغولة بتحليل بنية السلطة أيضاً. في الوقت الذي كان اقتراحي هو أن نحلل البنية الخاصة بالفرد… ما نحن؟ لماذا نحن دائماً وراء الكاميرا، بينما السلطة تقف أمامها؟ ماذا لو أدرنا الكاميرا إلى الجهة المقابلة للسلطة؟ كيف سيكون شكلنا في الصورة؟ عندما قدمت الفيلم حكيت لهم النكتة الحمصية القائلة: أن حمصياً أضاع قطعة من النقود في العتمة، فراح يبحث عنها تحت ضوء الشارع. وأضفت أن هذا الفيلم هو محاولة للإضاءة في المكان الذي أضعنا فيه قطعة النقود، لقد سلطت ضوئي، فتعالوا وانظروا ماذا رأيت.
في السينما السورية لم يكن هناك انفصال بين الأجيال السينمائية، كان كل جيل يسلم الجيل الذي يليه، ثم يبدأ الجيل الجديد بالعمل على نفس الأفكار مع إضافات بسيطة. نحن شديدو الاحترام لجهود المؤسسين، ولم يكن هناك رغبة بالخروج على تقاليدهم، لم يأتي أحد ليقول كفى، دعونا نتحرك بغير اتجاه. البلاد كانت تتغيّر والمتلقي تغيّر، بينما كانت السينما ما تزال داخل المكعب. وباتت الفوارق بيني وبين جدي وأبي والجيل الذي تلانا صغيرة جداً، وهذا غير حقيقي أو واقعي. عندما يطلب مروان من أمه أن تحكي له عن طفولته المبكرة، كانت تجيب: في يوم مولدك كان هناك انقلاب عسكري ومنع للتجول في الشارع، ثم يجيب مروان: أرجوكِ إحكِي لي عن لون عيناي، عن رائحة جلدي… هذه قصص واقعية، عندما ولد أبي، كانت ثورة لا أدري فيها من ضد من، فهل سنظل نفعل الأشياء بنفس الطريقة، أين الشخصي الذي يخصني أنا؟ أين ذاتي؟
في السينما السورية لم يكن هناك انفصال بين الأجيال السينمائية، كان كل جيل يسلم الجيل الذي يليه، ثم يبدأ الجيل الجديد بالعمل على نفس الأفكار مع إضافات بسيطة. نحن شديدو الاحترام لجهود المؤسسين، ولم يكن هناك رغبة بالخروج على تقاليدهم، لم يأتي أحد ليقول كفى، دعونا نتحرك بغير اتجاه.
إنّ إيجاد الذاتي عند بطل الفيلم، يجعله قادراً على الفعل، لم يكن قادراً على ممارسة الجنس، لكنه وفي بداية تلمسه لذاته يبدأ باستعادة قدرته على التمتع بالحياة وممارسة ما كان عاجزاً عن فعله. لقد كان هناك تشويه للذات، لم يكن نتيجة التشويه الذي مورس علينا فقط، بل نحن أيضاً نتحمل جزءا من المسؤولية عن تلك التشوهات.
إياس: كأن الفيلم يدعونا للنظر إلى الماضي من مكاننا المعاصر، لكي نفهمه ونقبله دائما؟
نضال: بالضبط. وهذا يبدأ في الفيلم عندما يقرّر مروان تفريغ الغرفة. الحل يكمن في تفريغ الغرفة. ويجب أن تبدأ بالكتب، أن تبدأ بالنظري، الأيديولوجي الثابت. الشخصيات تبحث في الفيلم عن صوت خطواتها المفقودة في قلب تلك المدينة العظيمة دمشق، التي ما تزال طرقها القديمة مرصوفة بالحجارة، لكن لا صوت لخطواتنا فيها.
إياس: هل منع الفيلم؟
الاستشراق في الصورة (١٤)
15 تموز 2020
نضال: لا، ليس فعليا. لم يصدر أمراً بمنعه، لكنه لم يوضع في السينمات كعرض تجاري، كان الرأي أنه دعونا لا نصدع رؤوسنا.
إياس: حدثني عن انطباعاتك عن الثورة السورية وأنت اللاجئ في القاهرة منذ سنوات بسبب موقفك السياسي والأخلاقي.
نضال: لقد قلت في أفلامي أنه لا مكان للتغيير داخل المكعب تحت السقف، ذلك مكان غير قابل للإصلاح. تلك اللحظة في ٢٠١١ تمثل لي ذلك المشهد من فيلم تحت السقف، عندما يبدأ مروان برمي أغراضه الشخصية في فسحة البيت تحت السماء الماطرة. عملنا كثيراً في هذا المشهد، على ابتكار أصوات الأشياء التي كان يرميها مروان في المشهد، أصوات كأنها أصوات انفجارات. أنا لا يمكنني القول أنّي تنبأت بما حدث، لكن يمكن أن أدّعي أني كنت أدعو إليه، لأني كنت أرى أن هذه الغرفة غير قابلة للإصلاح. لا أدري إذا ما كنت قد انتبهت إلى تفصيل في الفيلم وهو أن صاحب البيت الذي يسكنه مروان قد حوّل سطح تلك الغرفة إلى مزرعة صغيرة للخضراوات، هذا هو سبب تسرّب المياه من خلال السقف والجدران إلى الغرفة في الفيلم. المالك يجلس فوق رأسك، والسقف سوف يستمر بالدلف عليك. الحل البديهي هو تحطيم تلك الغرفة تماماً. هل تعلم أن كل تلك الملصقات التي كانت على جدار الغرفة، كانت من مقتنياتي الشخصية التي جمعتها على مدار سنوات؟ البوستر الأصلي لمعرض يوسف عبدلكي الأول، البوسترات التي كانت تأتيني من فرنسا لأهم الأفلام العالمية، أردت أن أعدم كل ذلك الإرث في الفيلم، متطلعاً إلى بداية جديدة (يشير المخرج إلى تلك الملصقات، والتي جمعها على مدى سنوات من عمله في النادي السينمائي في دمشق. ذلك النادي الذي استطاع بناء شبكة علاقات دولية مع أندية السينما العالمية، المخرج وضع تلك الملصقات على جدران الغرفة التي صوّر فيها فيلمه تحت السقف، وقد دمرت تلك الملصقات أثناء التصوير بسبب تعرّضها للماء بشكل مباشر). ما حدث في ٢٠١١، سببه الشعور العميق لدى السوريين أنه لم يعد ممكناً إصلاح تلك الغرفة. وهذا ما كان.
إياس: نضال الدبس، عندما تتحدث عن السينما السورية، هل تقول عنها أفلاماً سورية، أم أنها سينما سورية ذات سمات واضحة؟
نضال: نعم، هناك شيء نستطيع تسميته سينما سورية، والموضوع ليس مرتبط بالكم، بل بالنوع. لو كان هناك ثلاثة أفلام فقط لقلت أنها سينما سورية. هل يوجد لغة سينمائية سورية؟ نعم، هناك لغة سينمائية سورية. هل يوجد تمايز للفيلم السوري عن الفيلم المصري، أو التونسي، أو العراقي؟ نعم، هناك تمايز. هل نستطيع معرفة الفيلم السوري فقط من خلال الصورة دون الصوت؟ نعم وهذا ليس رأيي أنا، هذا رأي النقاد و الجمهور. هنا في القاهرة عندما ألتقي ببعض الطلاب أو المهتمين، و أعرض عليهم إنتاجات سورية، يقولون بعد العروض: آه رائع، هذه المرة الأولى التي نرى فيها سينما سورية، وليس أفلاماً سورية. يشعر الجمهور باللغة السينمائية، وتمايز الكوادر واللقطات، ومنطق الأحداث، والبناء القصصي. وهنا لا أتحدث من زاوية حكم القيمة على السينما الأفضل، أنا فقط أصر على فكرة وجود ما هو خاص في الأفلام التي أنتجت في سوريا، أن تجعلها سينما ذات لغة خاصة. تلك السينما التي أُسس لها منذ إنتاج فيلم "اليازرلي" لـ قيس الزبيدي. حتى الأفلام التي أنجزت في السنوات الأخيرة، فيها شيء مختلف وجديد، لكنها ما تزال بنكهة سورية. عندما تكون البداية كما عرفناها في نشأة السينما السورية المعاصرة، فإنه من البديهي أن تكون مآلات تلك السينما في المكان الذي نراه اليوم. الالتزام بالبحث عن الحقيقة، والوقوف في وجه الطغيان، مع احتفاظ الجيل السينمائي السوري الجديد، والسينما السورية الجديدة، بحقهم في أن يتمايزوا عن جيلنا والأجيال التي سبقتنا من المخرجين السوريين. لقد أسس لسينما سورية ذات ثوابت فكرية، ولغة سينمائية لا يجب أن تكون ثابتة، بل متغيرة و حيوية. إن ما يجمع المخرجين السوريين، ومن كل الأجيال، هو ذلك الإحساس العميق بالالتزام، والذي يحوّل مشروع كل فيلم ينجزه السينمائي السوري إلى مشروع حياة.