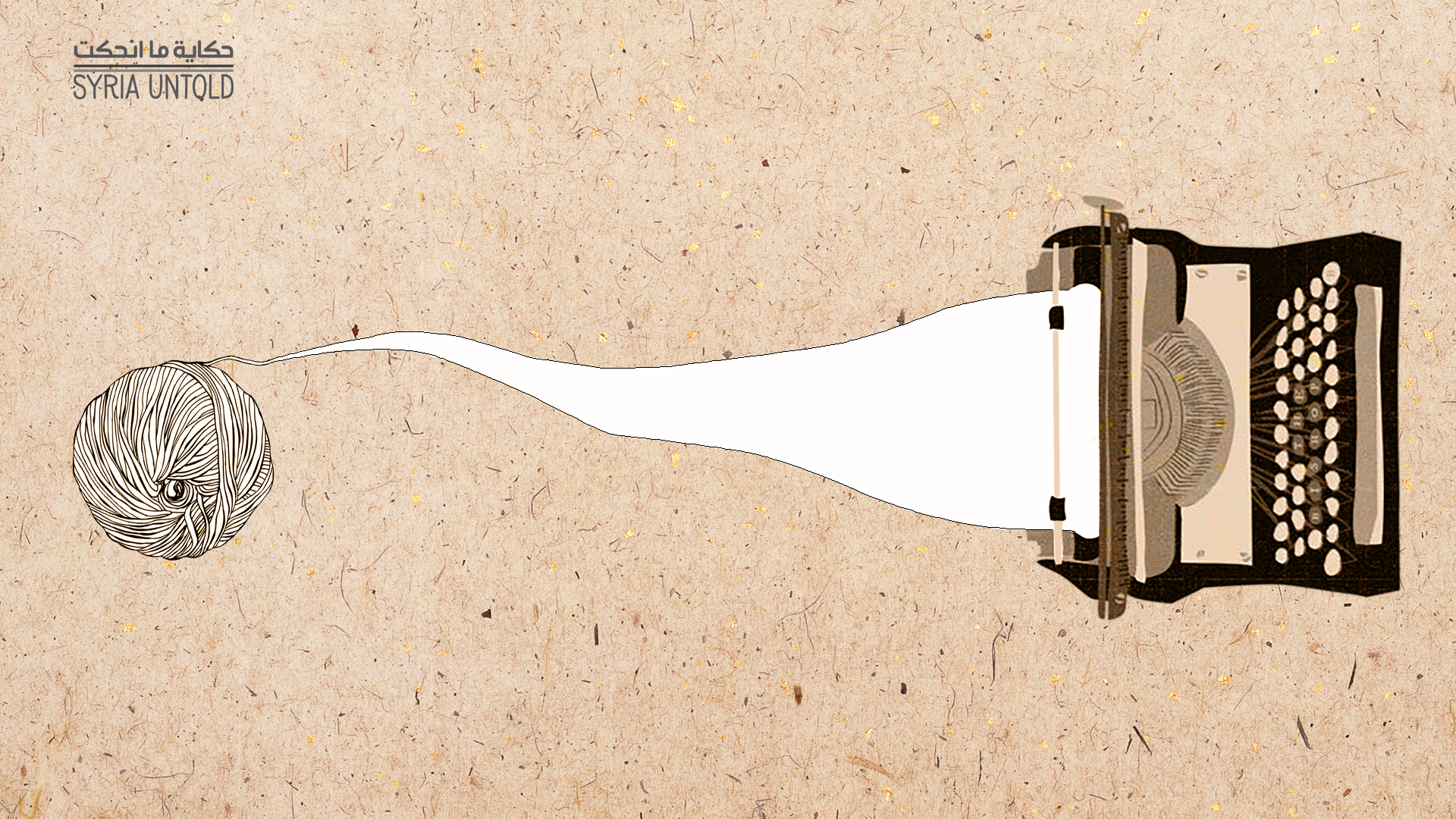كيف يمكن توصيف راهن الرواية السوريّة؟ هل يمكن القول إنّها ترصد محطّات من الحلم بالتغيير والخيبة التي صاحبت مسارحها، إلى الأمل الذي لا يمكن أن تستقيم حياة أو حكاية من دونه؟
إذا أخذنا سنة 2000 عامًا مفصليًا في تاريخ سوريا الحديث، حيث تزامن مجيء "بشار الأسد" مع انتقال العالم إلى الألفيّة الجديدة، وهو الذي حرص بداية على إعطاء نفسه صورة المتنوّر الساعي إلى الانفتاح والتغيير، والإيحاء أنّ عهدًا جديدًا يبدأ في سوريا مع بداية القرن الواحد والعشرين، وأنّ القادم قد يكفل بالتمهيد للقول في مرحلة لاحقة مأمولة: "عفا الله عمّا مضى"، ولاسيّما أنّه قُرن اسمه بشعار التحديث والتطوير، وحاول الادّعاء أنّه عرّاب إدخال التكنولوجيا إلى البلاد بمسمّيات وأقنعة مختلفة، فإنّنا بعد عقدين على ذاك التاريخ، نعي بأنّه كان تمهيدًا لنفق مظلم جديد في تاريخ سوريا الحديث لا غير.
لم يفِ بشار الأسد بأيّ وعد من وعوده، بل على العكس من ذلك، شدّد القبضة الأمنيّة بطريقة لا تناسب روح الألفيّة الجديدة، واظب على سياسة الإرهاب والترويع لإبقاء الرعب متغوّلًا في نفوس الناس، بحيث يشلّهم عن الإقدام بأيّة حركة من شأنها تعريّة التزييف والتعليب اللذين مارسهما نظامه الذي كانت معالم تضعضعه لا تخفى على السوريّين، لكنّه كان يتغذّى على الإرهاب ويطيل عمره بافتعال الأزمات وإبقائها مستعرة لإسكات أيّ صوت منتقد، أو معارض، بحجّة أنّ المرحلة لا تحتمل توجيه الانتقادات للعهد الجديد الذي لم يكن إلّا ترقيعًا للعهد المديد لوالده نفسه.
التحدّي أمام الأدباء المناهضين للفساد والظلم والدكتاتوريّة والقمع والقهر تجسّد في سرد الحكاية المعتّم عليها؛ حكاية أريد تناسيها وتجاهلها، والالتزام بتعرية الخراب الذي يراد له أن يتشكّل كهوية رئيسة من هويات المجتمع السوريّ
كان الفساد ينخر بنية مؤسّسات الدولة، ينهش أسسها، ينسفها لصالح هياكل مشوّهة بعيدة عن روح المسؤوليّة والالتزام بأيّة قيمة، وبشكل عمل على تحريف المفاهيم، وتغيير سلّم القيم الاجتماعيّة، بحيث غدا المتسلّق والانتهازي والفاسد واللصّ من وجوه المجتمع، على اعتبار أنّهم من واجهات الفساد أو رموزه، وانحسر التقدير، لدرجة كاد يتلاشى، أو ينقلب إلى النقيض، للأدب والثقافة والفكر، بحيث أصبحت الصورة الشائعة المتداولة عن المثقّف أو الأديب أنّه شخص منسلخ عن واقعه، بعيد عن همومه، غارق في عوالم بعيدة لا تهمّ الناس.
سؤال السياسة، تأثّرها وتأثيرها على الرواية السوريّة
16 شباط 2021
كان النظام من الخبث بمكان أنّه أفسد الذائقة، وشوّه المعايير والمفاهيم، فالأدب والثقافة والأخلاقيّات والقيم لم تكن تطعم خبزًا، ولا تغني أصحابها، كأنّها عالة عليهم، أو أعباء ينبغي عليهم التخلّص منها إذا ما أرادوا الارتقاء في سلّم الارتزاق والتنفيع والفساد، ما خلق شريحة من الانتهازيين بهيئات أدباء ومثقّفين، ليملؤوا الفجوة التي أحدثها النظام بقمعه وفساده، ويشغلوا الفراغ بضوضاء باهتة وضجيج بائس مفتعل لم يتمكّن من الارتقاء إلى جوهر الأدب والثقافة المنتصر للإنسان وقيمه العليا التي تحتفظ باعتبارها وتقديرها عبر العصور. هكذا كانت فصول من حكاية نظام عادى البلاد وأهلها وتفنّن في استراتيجيات التدمير عبر عقود..
التحدّي أمام الأدباء المناهضين للفساد والظلم والدكتاتوريّة والقمع والقهر تجسّد في سرد الحكاية المعتّم عليها؛ حكاية أريد تناسيها وتجاهلها، والالتزام بتعرية الخراب الذي يراد له أن يتشكّل كهوية رئيسة من هويات المجتمع السوريّ، وأنّ يتحوّل النموذج الفهلوي، المتشاطر، المبندق، التابع، الإمّعة، إلى مثال للنجاح في منظومة الفساد المكرّسة بالتقادم والتراكم.
لم يذعن عدد من الأدباء للتلويث الفكريّ الذي سمّم به البعث عقول الأجيال السوريّة منذ الستينيات من القرن العشرين لقرابة نصف قرن، بحثوا في التاريخ السوريّ عن محرّكات التغيير، عن بؤر التأميل، عن جماليات يحتفظ بها المجتمع، ولا يمكن لأيّة سلطة مستبدّة أن تنزعها منها أو تلوّثها بالمطلق، فكانت الكتابة عن الأمل في ظلّ التيئيس المطلق، وعن إحياء الأحلام بالتغيير وإبقائها متفعّلة على الرغم من القهر والإجرام الممارسين في كلّ بقعة من بقاع الوطن على أيدي أجهزة النظام القمعية.
وهنا لابدّ من الإشارة إلى أنّ مناهضة النظام وحدها لا تصنع أديبًا، وإلّا سيكون هناك استهتار بماهيّة الأدب وهويّة الثقافة والفكر، وسيتحوّل كلّ مجعجع إلى مفكّر.
قبل الثورة السوريّة كانت هناك أعمال روائيّة تنتقد الفساد والإجرام والسجون والتخريب، لكنّها كانت تلجأ إلى التوريّة حينًا وإلى الاستعارة والكناية أحيانًا أخرى، وكان الأمر يختلف من عمل لآخر في المواجهة والتعريّة، وسعى عدد من الروائيّين الذين واجهوا آلة القمع بالكتابة وفكّكوا خيوط اللعبة التي يدار بها البلد.
سؤال الزمن في اختبارات الفن والواقع
09 شباط 2021
بعد ذلك أصبح هناك حديث مباشر، وتحديد للمجرمين بالاسم، تمّت تسمية الطاغية وحاشيته من المجرمين والقتلة والفاسدين بالاسم، لم تعد المداورة والكناية والاستعارة والتوريّة كافية، لم يعد الواقع يتحمّل أسلوب الترقيع أو الابتعاد عن التسميّة، أو إبعاد الرئيس عن المسؤوليّة، وتحميلها للمحيطين به من بطانته الفاسدة، وهو الذي أغرق البلاد في دوّامة العنف والدمار، والتزم بشعار "الأسد أو نحرق البلد" دون غيره من الشعارات المستهلكة التي كان يتاجر بها لعقود.
ظهرت عدّة أعمال حاولت الانتصار للثورة، بدا بعضها انفعاليًا عجولًا لم يسعفه نُبل القضيّة التي يدافع عنها أو يعالجها في الارتقاء بالفنّ الروائيّ، بل كان أشبه بصرخات احتجاج، أو تمظهرات لشعارات المظاهرات، أو تصويرًا حكائيًا لمقاطع فيديو منتشرة للثورة ويومياتها، ومن دون أن يعني ذلك عدم خروج أعمال مهمّة تعالج الوضع السوريّ الضاغط، وتقتحم أتون المحرقة الماضية المستمرّة لرصد تداعياتها وتأثيراتها المعاصرة والمحتملة.
وهنا لابدّ من الإشارة إلى أنّ مناهضة النظام وحدها لا تصنع أديبًا، وإلّا سيكون هناك استهتار بماهيّة الأدب وهويّة الثقافة والفكر، وسيتحوّل كلّ مجعجع إلى مفكّر، ويكون الصوت المرتفع فيصلًا للتصنيف، وهذا لا يستقيم في عالم الأدب ولا يبلور هوية أدبيّة.
غدت بداية الثورة محطّة تأسيسيّة جديدة للرواية السوريّة، وللأدب السوريّ عمومًا.
ارتفع صوت الكثير من الأدباء في مواجهة الطغيان، وقُتل عدد من الكُتّاب على أيدي أجهزة النظام. أدان الكثير من الأدباء السوريّون ما أصبح البلد عليه من ملعب للعصابات الإجراميّة والميليشيات التي استغلّت الانفلات الحاصل وسرقت الثورة وتاجرت بشعاراتها، وأظهر الواقع لاحقًا أنّها كانت من ألدّ أعداء الثورة نفسها.
لم يركن الكثير من الأدباء لليأس بعد قرابة عقد من الثورة، ولم ينجرفوا وراء عتمته بوأد الأمل والحلم ببلد جدير باسمه وتاريخه ومستقبله، لا ببلد أصبح مرتعًا للإرهاب والمرتزقة، ومستنقعًا لاحتلالات تنهش أرضه وتنهب خيراته وتتحكّم بمصيره ومصير أبنائه.
في شهوات السرد السوري!
ظهرت أعمال روائيّة أكثر عمقًا حتّى من قبل روائيّين أصدروا أعمالًا في بداية الثورة، لأنّ الوقائع والأحداث راكمت الكثير من الخبرات، وفرضت المستجدّات نفسها على الرواية، شعر الروائيّون بمدى قسوة العالم ووحشيّته، التقطوا معالم الطريق الطويل؛ طريق الأسى المتفاقم والأمل المنكوب، وتفاءلوا بملامح غدٍ منشود، من دون إغفال أو سهو عن رصد المتغيّرات العالميّة والمحليّة.
خريطة البلاد تغيّرت، حكايات الناس المفجوعين تشعّبت واتّخدت مسارات مختلفة، واستجاب الأدب إلى حدّ بعيد لهذه التغيّرات، بالتقاطها والتعليق عليها، تصوير تداعياتها وكشف خباياها، وما يعترك فيها من مفارقات وتناقضات وفجائع. فلجأ روائيّون إلى المكاشفة، إلى إنارة الزوايا المعتمة، وإلى طرح المسائل المسكوت عنها، أو تلك التي كان يرحّل تناولها من مرحلة لأخرى بذريعة عدم إثارة الحساسيّات أو الضغائن، وذلك من أجل تشخيص العلل الاجتماعيّة والتاريخيّة ومحاولة استلهام العبر منها، كي لا نبقى دائرين في متاهتها، أو نعيد الاكتواء بنيرانها المتجدّدة.
غدت بداية الثورة محطّة تأسيسيّة جديدة للرواية السوريّة، وللأدب السوريّ عمومًا، وبعد سنين من تلك البداية، وبعد أن ظنّ أزلام النظام وكتبته والمختبئون في رمال الرمادية (مع العلم أنّه لم يبقَ الكثير مما هو مخبوء في واقعنا بعد أن حدث ما حدث)، ظهرت أعمال روائيّة من مُعسكر القتلة، تطرح رواية بديلة، أو موازية، تحاول قلب الحقائق، أو تناولها من زاوية ضيّقة تعكس زاوية النظام وروايته، وهنا يمكن التذكير برواية باهتة "لحيدر حيدر" اسمها: "مفقود"، صدرت العام 2016، هي أشبه ببيان سياسيّ أو منشور دعائيّ في قناة من قنوات النظام الفاقدة للمصداقيّة والثقة.
لا يخفى على المتابعين أنّ هناك فئة، ممّن يقدّم المنضوون تحت ستارها أنفسهم كصحافيين ومثقّفين وكتّابًا، كانت منتفعة من النظام، تخفي نفسها عن الواجهة، أو تتباهى بتصدّر الواجهات الثقافيّة والصحافيّة، وتحاول الابتعاد عن تحمّل آثام النظام التاريخيّة بحقّ البلاد بما ومَن فيها، بحيث يدّعي المتخفّون في ظلال هذه الفئة الانتهازيّة أنّهم لم يكونوا أصحاب قرار، في حين أنّنا نعلم أنّهم كانوا أصحاب امتيازات، وإن كانت أقلّ من المسؤولين الأمنيين والعسكريين الكبار في البلد، وكانوا مرقّعين للقباحات ومجمّلين للتشوّهات، أيّ ساهموا بقسطهم في التخريب التاريخيّ الماضي المستمرّ. بعد الثورة نأى البعض من هذه الفئة بنفسه عن النظام، لكنّهم حرصوا على أن تكون لهم انتفاعاتهم في الضفّة الأخرى، طالبوا بمناصب لا تقلّ تنفيعًا عن مناصبهم السابقة في ظلّ النظام، وكان الأمر بالنسبة إلى هؤلاء هو تغيير الضفّة مع وجوب الحفاظ على المكتسبات والامتيازات، بالتزامن مع الحفاظ على الأسلوب الانتهازيّ السابق نفسه، وإضافة بهارات الشعارات الثورجيّة للتعميّة عليها.
من الضروريّ التأكيد على أنّ حكايات الناس وأساطيرهم وملاحمهم تثري تاريخ بلادهم.
الاعتياش على "أيّام الزمن الجميل" (برأي هؤلاء وهو إشارة إلى زمن النظام القذر)، يبقيهم أسرى الفساد والوهم والتفاهة، وندرك جميعًا كسوريّين، أنّ الملعب مكشوف والواقع فضّاح ولا يمكن إخفاء الشمس بغربال.
السرديّات السوريّة في مرآة الآخر. ما الذي غيّرته المنافي في سردياتنا؟
26 كانون الثاني 2021
هذه أيضًا فصول من حكاية متسلّقين عادَوا القيم وتفنّنوا في تضخيم أنانيّتهم ونرجسيّتهم عبر استراتيجيات التملّق والانتهازيّة لعقود... وهؤلاء وأولئك تحت مرمى حكايات السوريّين، روائيّين وغير روائيّين، وسيأتي أوان التعريّة، ليس من باب الانتقام بل من واجب الأمانة التاريخيّة، ولو طال.
وبالعودة إلى ميدان الرواية، فيمكن أن نلحظ بدء جيل جديد بكتابة روايته، جيل تبلور وعيه الأدبيّ والفكريّ أكثر بعد الثورة في المهاجر، يحاول تقديم حكايته التي تعبّر عنه وعن محنته ومآسي أهله وبلده، يثري تفاصيل خريطة الأدب السوريّ في المهجر، ويلوّنه بحكاياته التي تستحقّ أن تُقرأ وتُسمع.
لا يعود الأمر إلى ما أحدثته الثورة من تغييرات في بنية المجتمع السوريّ فقط، رغم أهمّيتها واتّساع رقعتها، لكن هناك مستجدّات ومتغيّرات عالميّة مواكبة، سواء على صعيد التكنولوجيا وما أحدثته من ثورة خلخلت الذهنيّة التقليديّة، أو ما أثارته من تأثيرات وتداعيات، لعبت دورًا في تشكيل تجارب جديدة، أو إسباغ إضافات جليّة على تجارب سابقة.
ولعلّ من الأهمّية بمكان الإشارة إلى أنّ التعويل على الأدب من أجل إدانة الدكتاتوريّة وأدواتها الإعلاميّة والدعائيّة، يساهم في تفعيل الذاكرة لتكون سلاحًا يمضي بنا إلى المستقبل الذي نريد لشعوبنا، لا ذاك الذي يرسمه الطغاة والمجرمون والمحتلّون لنا ولبلدنا، وهنا يكون التحدّي المتجدّد الذي يحتاج من الأدباء عملًا دؤوبًا وعميقًا ودقيقًا لإنجاز ما أمكن من ملامح دربه الطويل.
كما أنّ من الضروريّ التأكيد على أنّ حكايات الناس وأساطيرهم وملاحمهم تثري تاريخ بلادهم، وهي براهين على أنّ هذا الجيل أدّى واجبه لنقل شعلة الأمل؛ الأدب، المتّقدة، إلى الأجيال التالية، وبصيغة تحفظ فيها الحكايات ما يسقطه التاريخ الذي يكتبه الطاغية وأعوانه وحلفاؤه هنا وهناك. ومن هنا تتأتّى أهمّية الرواية السوريّة المعاصرة، وتشتدّ الحاجة إليها كأداة من أدوات المجابهة المتجدّدة.