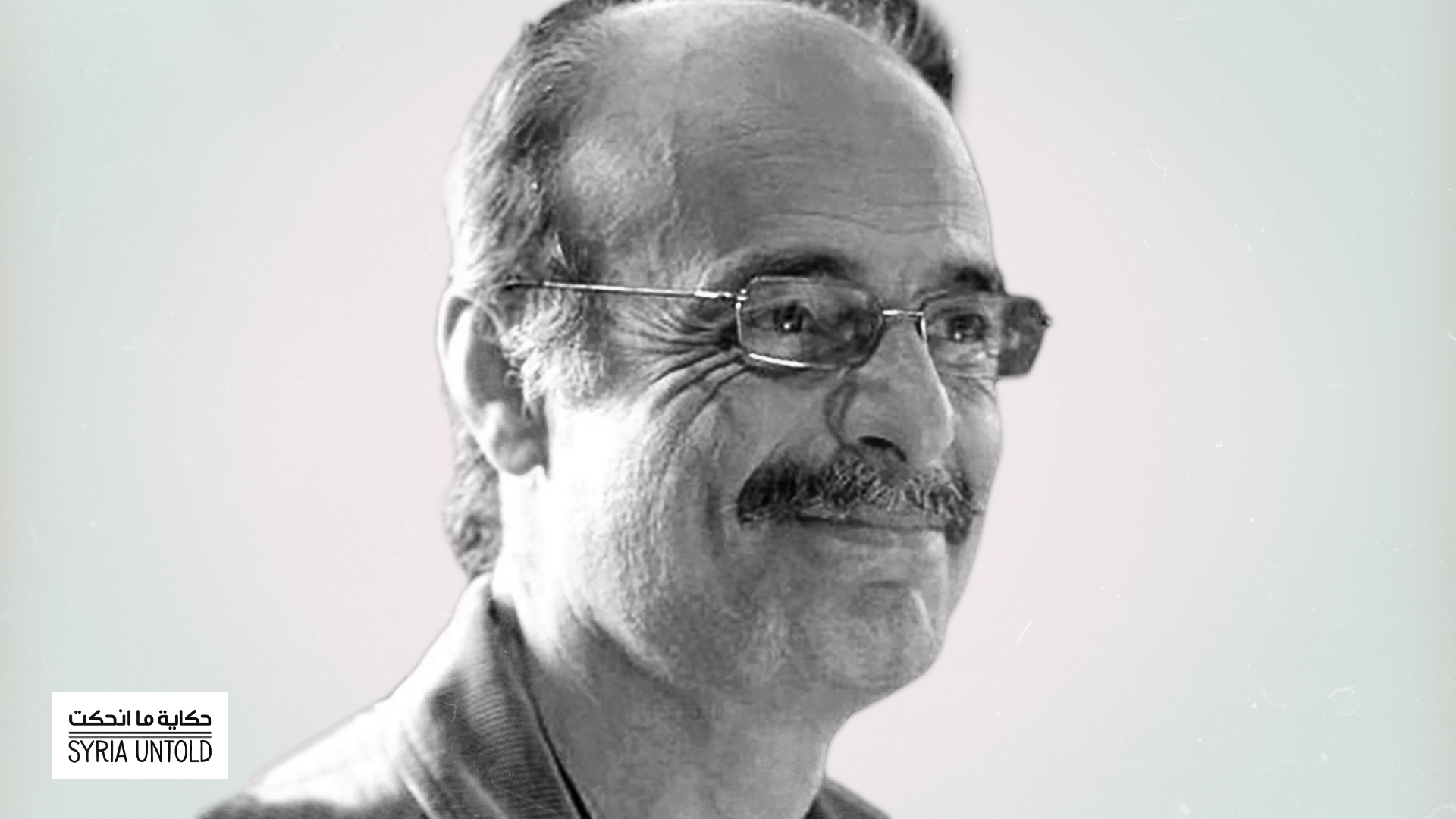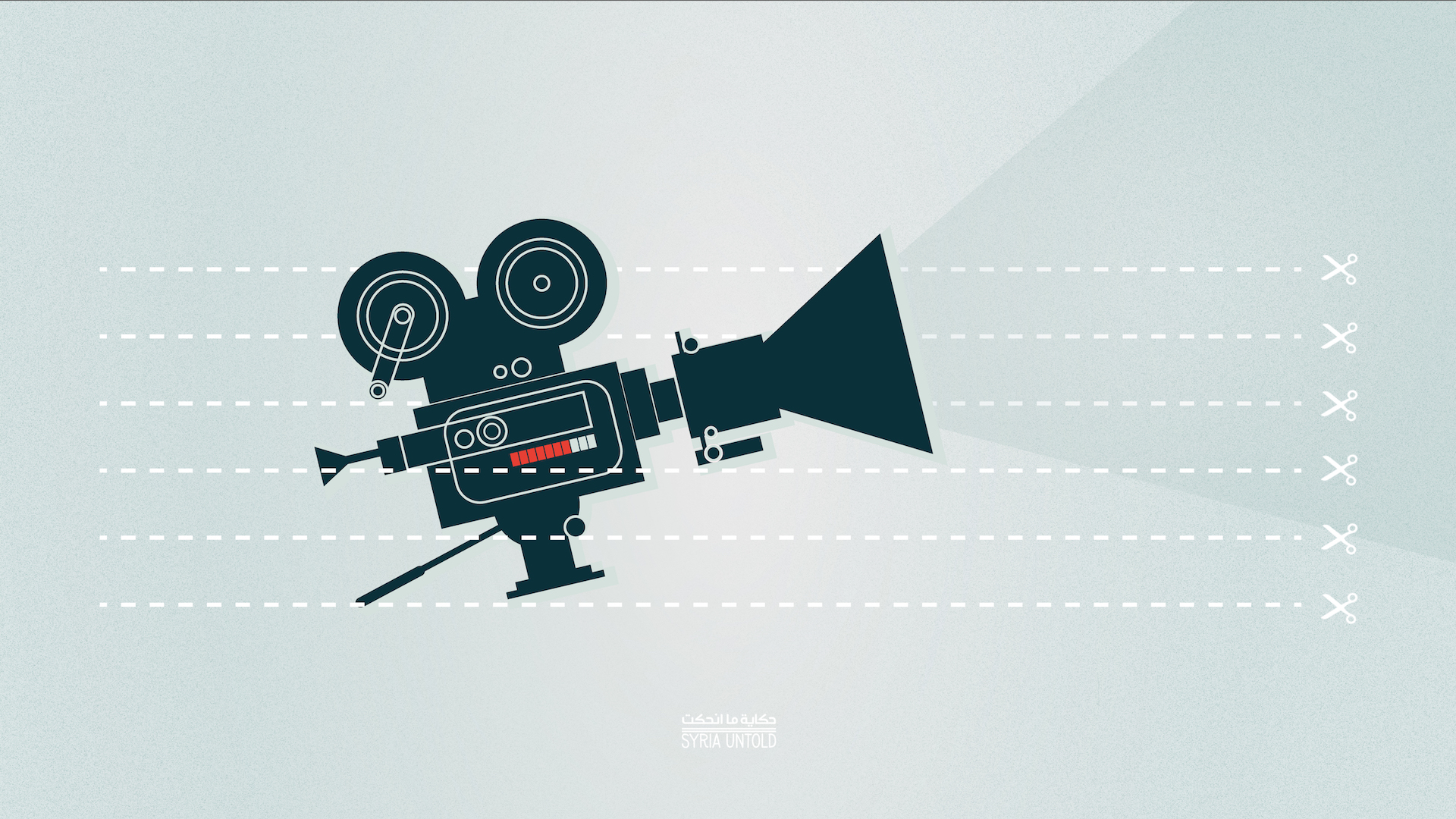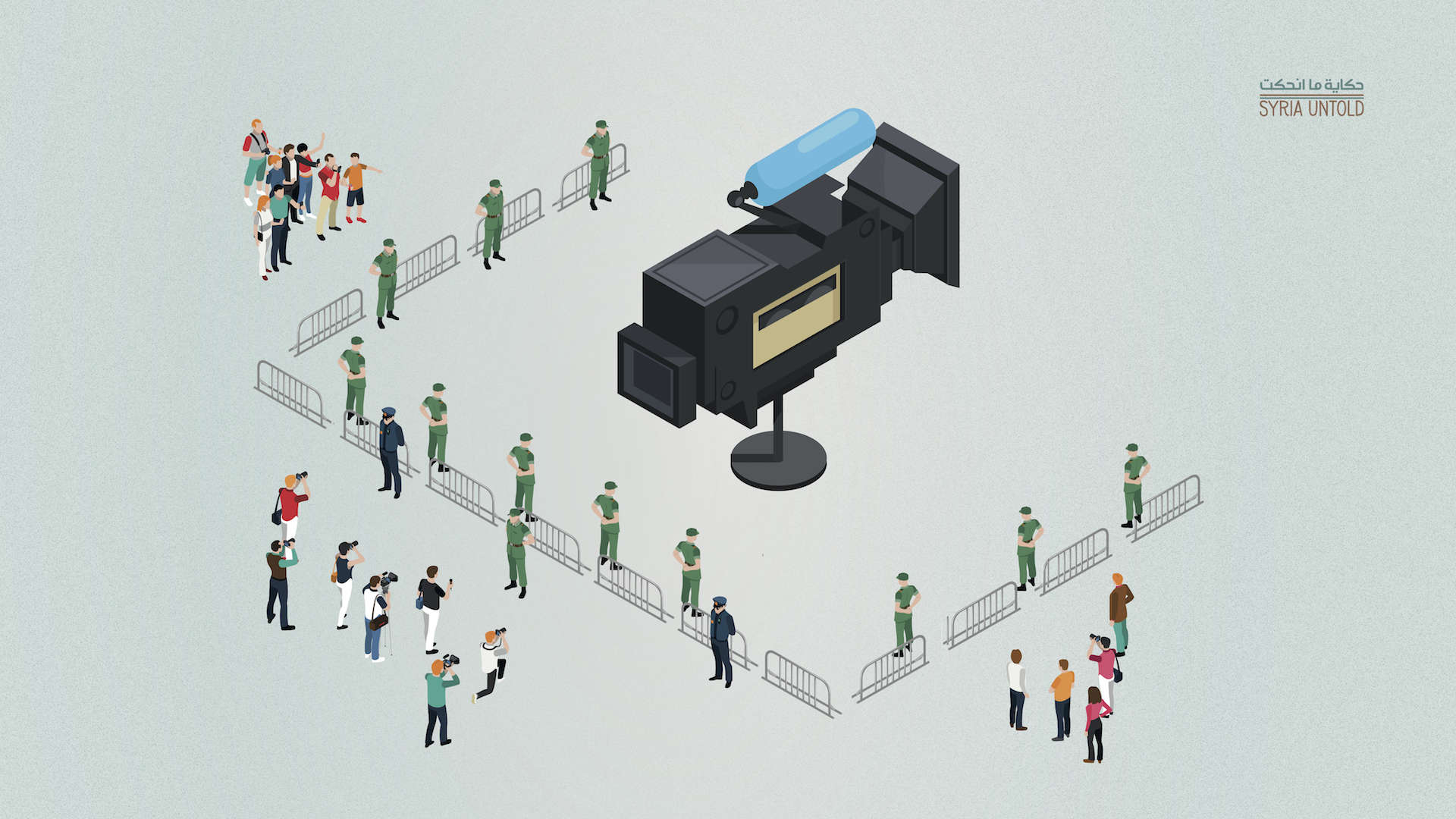هذا الحوار جزء من سلسلة عن السينما السورية، والتي تهدف إلى اكتشاف عالم صناعة الأفلام السوريّة من خلال عيون المخرجين والصحفيين والأكاديميين السوريين والأجانب.
هل هناك سمات مشتركة أو أسلوب تشترك فيه الأفلام السوريّة الحديثة بشكل عام، أم أنّها تُعتبر أعمالًا منعزلة؟ هل يمكن اعتبار هذه السينما السوريّة الجديدة ظاهرة لها هويتها الخاصة؟
بصفتي مديرًا مشاركًا لـ Doclisboa ومقيّمًا (film curator) لـ TFFdoc، أتيحت لي الفرصة لدعم وعرض العديد من الأفلام؛ أفلام لمخرجين مثل سارة فتاحي وعروة المقداد وزياد كلثوم وآفو كابرئليان وعمار البيك.
لقد طورت صداقات معهم جميعًا، فضلًا عن التبادل الفكري المكثّف الذي تعزّز على مرّ السنين، حتى مع أولئك الذين لم أتمكن من مقابلتهم شخصيًا ، مثل عروة المقداد.
حتى لو قدمت أفلامهم أنماطًا مختلفة على المستوى الرسمي، فقد كان واضحًا لي منذ البداية أن هناك شيئًا مشتركًا بينهم جميعًا. كان واضحًا بالنسبة لي أنّه في تلك الأفلام كان هناك شيء أكثر من ضرورة الحديث عن وحشيّة القمع والحرب.
كانوا جميعًا مدركين تمامًا بأنّهم يستخدمون لغة محدّدة: السينما. أجبرتهم تلك اللغة على تفكير مستمر بالصور التي توجّب عليهم استخدمها لقول ما يريدون.
وللمفارقة، فإنّ السمة المشتركة التي تحدّد التجربة الفريدة للسينما السوريّة الشابة هي بناء ما هو "خارج الشاشة" كمساحة خياليّة تسكنها الصور التي يفضّل المخرجون السوريون إبعادها عن الكادر.
نضال الدبس:لماذا نحن دائماً وراء الكاميرا، بينما السلطة تقف أمامها؟ (17)
23 كانون الثاني 2021
هناك عنصر آخر يُمكّنُنا من الحديث عن السينما السوريّة الشابة كتجربة لها هويتها الخاصة: الارتباط الوثيق بسينما "توت كورت" (tout-court) (1) ، وخاصة مع السينما السوريّة التي سبقتها. ولكي نكون واضحين، أقصد سينما عمر أميرالاي ومحمد ملص وأسامة محمد، إلخ.
لنأخذ فيلمين حديثين على سبيل المثال: "كوما" لسارة فتاحي و"الرقيب الخالد" لزياد كلثوم.
فيلم فتاحي هو نوع من أنواع مسرح الغرفة (kammerspiel)(2)، شيء ما يذكرنا بسينما كاسافيتس(3). في فيلم "كوما" تعيش ثلاثة نساء، ابنة وأم وجدّة، في بيتهن في دمشق أثناء احتدام الحرب خارجها. الأصداء الوحيدة التي تأتي من الخارج -خارج الشاشة- هي أصوات مسلسل سوري شهير، والذي، على الأغلب، تمّ تصويره في الغوطة.
أما في الناحيّة الأخرى، فإنّ زياد كلثوم، يحكي تجربته كمساعد مخرج وجندي خلال تصوير الفيلم الأخير لمحمد ملص. أيضًا في هذا الفيلم الحرب هي "ضيف من حجر" (convitato di pietra)(4). تتجسد الحرب في الفيلم فقط من خلال ضجيج الضربات الجويّة التي تصمّ الآذان.
أعتقد أن هذا التوتر بين داخل وخارج الكادر، والذي يتوسطه وعيّ سينمائي نادرًا ما يوجد في مجموعات أخرى من نفس الجيل، هو ما يجعل تجربة السينما السوريّة الجديدة فريدة تمامًا.
هل هناك تجارب سينمائيّة أخرى صُنعت في المنفى مشابهة لهذه السينما السوريّة الجديدة من حيث كميّة الإنتاج والنجاح العالمي والعلاقة مع الجمهور الأصلي؟
برأيي لا توجد تجربة سينمائيّة أخرى في المنفى يمكن مقارنتها بالسينما السوريّة الجديدة، على الأقل مؤخرًا.
السمة التي تجعلها فريدة من نوعها هي الشغف الشديد(5) لدى هذه المجموعة من المخرجين للسينما. وهذا ما فاجأنا. غالبًا ما يتبنى الجمهور الغربي وجهة نظر استشراقيّة حول هذه الحقائق. هؤلاء المخرجون، نساءً ورجالاً، يعرفون السينما (الأوروبيّة) جيدًا، ويعرفون كيف يستخدمونها.
واجه هؤلاء المخرجون والمخرجات فائضًا من الصور، اتسم معظمها بالعنف، وانتشر بالفعل في جميع أنحاء العالم، بوعيّ شديد؛ لقد قرروا ما المنطقي للعرض وما هو غير المنطقي.
في الوقت نفسه، هم ينتمون إلى تقاليد سينمائيّة محدّدة، وهي التقاليد السوريّة، والتي بالكاد نعرفها. لقد أغرقونا بهذه اللغة الجديدة.
ومع ذلك يمكننا فهم السينما الخاصة بهم، رغم أنّها تأتينا كشيء غير متوقع، وذلك فقط بسبب تجاهلنا لذلك الواقع وإحساسنا الخاطئ بالتفوق كمخترعين أصليين للسينما.
كيف ترى العلاقة بين الأفلام الوثائقيّة السوريّة وإنتاج الفيلم الوثائقي حول العالم؟ هل هناك شيء محدّد يخص هذه التجربة؟ هل هناك اتجاهات مشتركة؟
أعتقد أنّ الأفلام الوثائقيّة التي صنعها المخرجون والمخرجات السوريون الشباب تجبرنا على التفكير بجديّة في دور الصورة فيما يُسمى سينما الواقع (cinéma du réel)، وبالمناسبة هو تعبير لا معنى له بالنسبة لي.
السينما السورية في المنفى: حوار مع صانع الأفلام: عروة النيربية (16)
06 كانون الثاني 2021
واجه هؤلاء المخرجون والمخرجات فائضًا من الصور، اتسم معظمها بالعنف، وانتشر بالفعل في جميع أنحاء العالم، بوعيّ شديد؛ لقد قرروا ما المنطقي للعرض وما هو غير المنطقي.
كلّ منهم فعل ذلك بشكل مختلف عن الآخر، ولكن كلّ صورة في تكوين أفلامهم هي ثمرة هذا الانعكاس المتطرف.
عندما عرضنا فيلم "الرقيب الخالد" في تورينو، عرضنا أيضًا فيلم "ماء الفضة"(6). أنشأ المخرجان زياد كلثوم وأسامة محمد حوارًا في السينما.
فيلم محمد هو نسخة سوريا من فيلم "جرمانيا، السنة صفر"(7). فيلم كلثوم هو قصة جندي بسيط يبحث عن لغته دون أن ينسى أسلافه. بين هذين الفيلمين نشأ توتر رائع، من ذاك الذي يتوجب أن يخلقه كلّ فيلم وثائقي من أجل جعل العلاقة مع "الحقيقي"، أخيرًا، سينمائيّة.
لقد نسينا هذا التوتر في عالمنا الغربي القديم المُتعَب.
لماذا برأيك حققت هذه الأفلام نجاحًا كبيرًا في المهرجانات الأوروبيّة؟ ما الذي يميزهم عن التجارب السينمائيّة الأخرى؟
هذا سؤال أجد صعوبة في الإجابة عليه. ربما لأنّنا يجب أن نميز أولًا نوع النجاح الذي حققته الأفلام وفي أيّة مهرجانات.
على سبيل المثال ، اعتبر مهرجان كان فيلم "إلى سما"، للمخرجة وعد الخطيب والمخرج إدوارد واتس فيلمًا سوريًا رائعًا. إنه منتج كان يُعتقد أنّه مخصص لعالم مستعد وجاهز للإعجاب بالشرق الـ"بربري" ولكنه قادر أيضًا على إنتاج مشاعر جيدة.
مهرجانات أخرى، مثل لوكارنو وروتردام وتورينو، أعطت مساحة لسينما سوريّة مختلفة كليًّا، والتي كانت قادرة على إرباك السينما الوسطيّة.