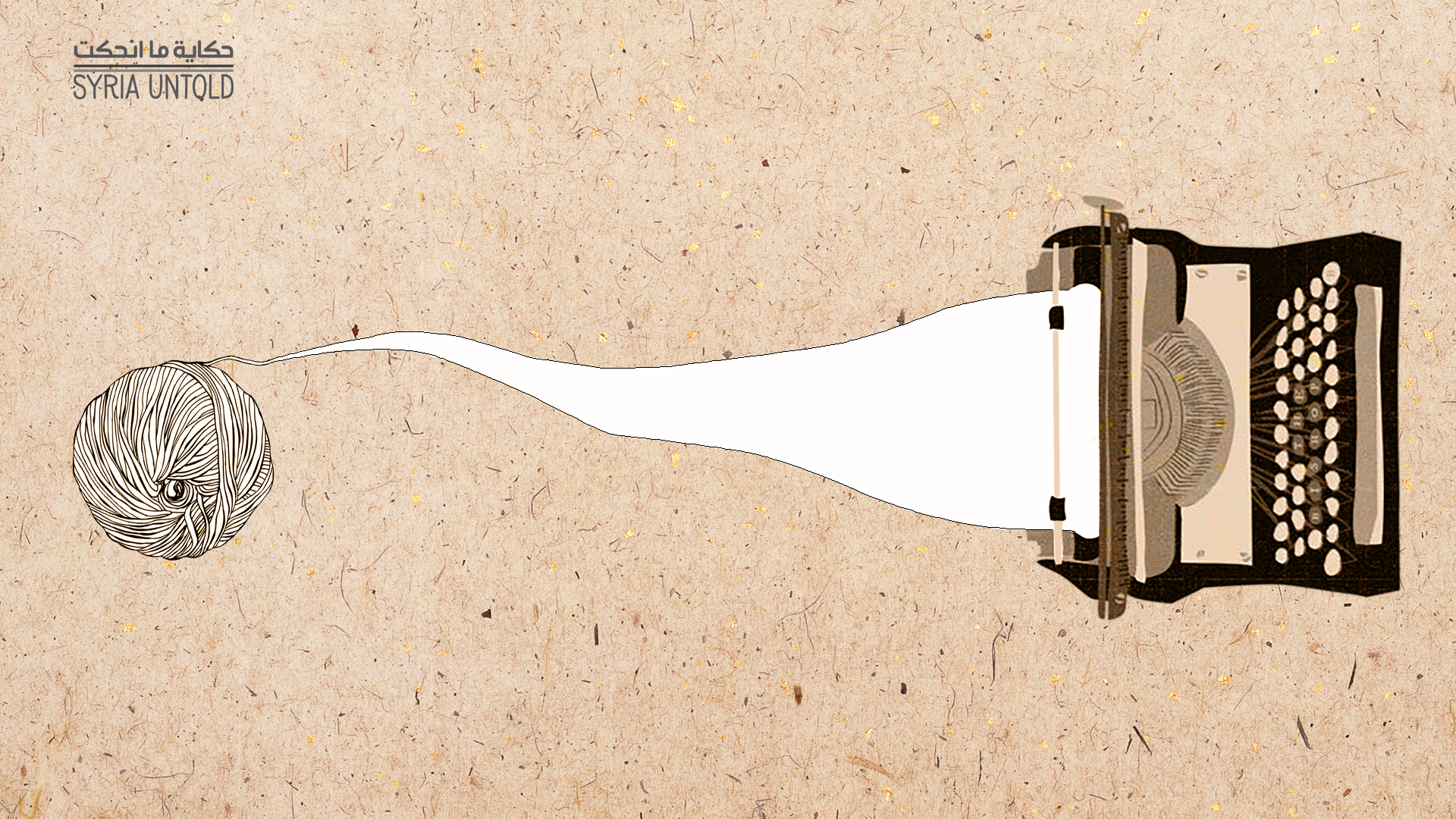يُذهل المتابع للإنتاج الفني والأدبي السوري الذي ظهر في السنوات العشر الأخيرة من الكم الكبير الموجود والمشتّت، ويُذهل أيضًا، من عدد الأعمال المعبّرة عن الظروف الصعبة التي مرّ ويمرّ بها السوريون. هذا الإنتاج متنوع جدًا من رواية ونصوص شعريّة ونثر ونصوص وعروض مسرحيّة، وعروض فنيّة بأشكالها من رسم وميديا ونحت وتجهيز وأفلام قصيرة وطويلة.. إلخ. ومن البديهي أنّ هذا الكم الكبير يوحي بأنّ السوريين يصرخون بـ"نحن موجودون"، وأنّهم بالضرورة يريدون أن يتركوا أثرًا لوجودهم أينما كانوا، ويريدون أن يعبّروا عمّا يعيشونه وأن يسترجعوا الظروف الصعبة غير المتوقعة التي مرّوا بها وما زالوا، خوفًا من النسيان مع مرور الزمن. الذاكرة والتوثيق موضوعان هامان يُدرسان بكلّ تأكيد، ولكن السؤال الذي يمكن أن يُطرح اليوم خاصة بالنسبة لمن هم في دول الشتات هو: ماذا بعد؟ عمّاذا تريدون أن تتكلموا؟ ولمن توّجهون كلامكم؟ أما بالنسبة للذين في الداخل السوري هناك أسئلة أخرى يجب أن تطرح، منها: ما هو دور المسرح اليوم؟
للكلام عن المسرح السوري ننطلق هنا من أفكار أوليّة، وهي على التوالي:
أولاً، وهذا من البديهيات، يؤكد هذا الإنتاج على وجود إرث ثقافي تراكمي يحمله هذا الشعب، والذي لم يكن معروفًا أبدًا للآخر في السابق إلّا فيما ندر وعبر المشاركة في المهرجانات.
ثمّ لا بدّ لنا من ملاحظة أنّ ما يحصل اليوم مع السوريين يشبه ما حصل سابقًا مع الفنانين والمثقفين العراقيين واللبنانيين حين رحلوا عن وطنهم وتشتّتوا في أرجاء العالم، بعضهم أنتج في الشتات وبعضهم لم يُنتج، لكنهم تركوا أثرًا مؤكدًا وطوّروا في نظرتهم إلى المسرح.
المسرح هو فن جماعي له متطلبات مُعقدة، فالأمر ليس سهلًا لمن يريد أن يعمل في هذا المجال، في فن ليس فرديًا أبدًا. ولهذا لا يمكن مقارنته بالفنون الفرديّة والرواية ولا حتى السينما، ولهذا تلحظ أنّ هناك أشكالًا فنيّة طوّرت نفسها بسرعة في الآونة الأخيرة، وهي الفنون البصريّة، وخاصة في فترة الإغلاق بسبب جائحة كورونا.
هناك مؤسسات لعبت دورًا كبيرًا في حياة المسرح السوري تحديدًا، لكن السؤال يبقى: ما هي آليّات الإنتاج التي تسمح للسوري بالتعبير في الخارج؟ هل يمكن حصرها؟ وتوصيفها؟
من ناحية أخرى، ومع مرور السنوات طالت الأزمة لدرجة أنّنا بتنا نتكلم عن جيل الحرب، جيل كامل يسعى للقول، للتعبير، لكن هل بالإمكان حصر ومتابعة كل ما صدر ويصدر؟ هناك نصوص مسرحيّة كثيرة موجودة، بعضها نُشر وبعضها لا، وهناك دورات تدريبيّة في الكتابة المسرحيّة تشجع الإنتاج المسرحي وهناك عروض هنا وهناك من الصعب حصرها، ومستوياتها الفنيّة والفكريّة متفاوتة جدًا.
منذ بداية الأزمة السوريّة وبشكل واضح تمّ الاستعانة بالدعم المادي "المستقل"، وهناك مؤسسات لعبت دورًا كبيرًا في حياة المسرح السوري تحديدًا، لكن السؤال يبقى: ما هي آليّات الإنتاج التي تسمح للسوري بالتعبير في الخارج؟ هل يمكن حصرها؟ وتوصيفها؟
كذلك بدأت ترتسم بالضرورة هوّة (وما زالت تكبر) بين سوريي الداخل وسوريي الشتات، (وهذا موضوع مؤلم سنحاول أن نتعرّض له ولو بشكل غير مباشر لكنه صعب ولا مكان له هنا). كذلك لا بدّ من التأكيد على أنّ الأزمة التي تعيشها الثقافة والفنون السوريّة ليست وليدة السنوات الأخيرة، إنّما نتيجة لتراكم طويل سنحاول تلمسّه ومقارنة بين ما يصطلح على تسميته الداخل والخارج.
لهذا لا بدّ من العودة إلى الوراء قليلًا لطرح بعض الأفكار عن هذه الأزمة، منها ما يتعلّق بالإنتاج المسرحي، ومنها ما يتعلّق بالرؤية المسرحيّة وحريّة التعبير، وطبعًا شكل ومضمون الكتابة نصًا أو على الخشبة.
أسئلة التغيير المتنامي في السرديات السوريّة
12 كانون الثاني 2021
المسرح في سوريا ما زال يعيش في أُطر الماضي من حيث فضاءاته المسرحيّة وصيغه وأشكال إنتاجه، الظروف التي مارس فيها جيل الآباء تجربتهم وهي ظروف مختلفة تمامًا عن اليوم. ومن أهم ملامح الأزمة هجرة أهل المسرح وصعوبة الإنتاج من حيث التمويل والتعقيدات (الإداريّة والأمنيّة) والانكفاء عن الكتابة للمسرح (وتعتبر نصوص سعد الله ونوس استثناءً منذ تسعينيات القرن الماضي لأنّ غيره توقف عن الكتابة قبل ذلك) والتوجه إلى مجالات أكثر سهولة بالنسبة لهم ومجديّة أكثر من الناحية الماديّة. لكن بالمقابل ظهرت كتابات للشباب المسرحي غالبًا من خريجي المعهد العالي للفنون المسرحيّة قد تشي بوجود شيء جديد. الأسماء القديمة المعروفة قبل الأزمة لم تعد موجودة، أغلبها غيّبها الموت، أو إنّها تنتج ولكن بدرجة أقل من الجيل الجديد، والملفت للنظر أنّ هناك أيضًا أسماء كثيرة لشباب جدد لا يمكن حصرها نظرًا للتشتّت الحاصل على الساحة الثقافيّة. (وهنا نتكلم عن تشتّت على كافة الأصعدة الجغرافيّة والنفسيّة، الخ). والمُلاحظ أنّ المسرح السوري في التسعينات تراجع أو في أحسن الاحتمالات راوّح في مكانه لفترة من الزمن.
المسرح والدولة
عودة إلى الوراء، نقول إنّنا تعوّدنا في سوريا، اعتبارًا من ستينيات القرن الماضي، أي منذ تشكّل الملمح السياسي الذي كان سائدًا في النصف الثاني من القرن الماضي، أن يكون العمل الفني تحت إدارة الدولة، وأن يكون جزءًا من خطتها السنويّة أو الخطة الأبعد أمدًا، وقد دام هذا الوضع لعقود طويلة، وكان وضعًا مريحًا لكثير من الفنانين، حيث أنّ الفنان والمثقف كان يتكل بشكل كامل على المؤسسة الرسميّة من الناحية الماديّة واللوجستيّة، وما كان عليه لكي يُنتج فنيًا إلا أن يفكر بفنه وإنتاجه.
يمكن القول إنّ خلال تلك المرحلة ظهر ما نسميه المؤسسة المسرحيّة: صالات مجهزة (عددها محدود لكنها موجودة وهي في أغلبها كانت سينما حُوّلت إلى مسارح)، ثم تم تأسيس المسرح القومي وظهرت بنى جديدة مثل المسرح العمالي والمسرح الجامعي والمسرح العسكري ومسارح المراكز الثقافيّة في العاصمة والمحافظات التي كان لها دورها في تعميم الثقافة ومن ثمّ المسرح. وقد لعبت مؤسسة المسرح الجامعي دورًا هامًا في السبعينات، خاصة في تشكيل كادر للمسرح، وخرّجت عددًا من الممثلين الذين أصبحوا لاحقًا نجوم سوريا في المسرح وبعده الدراما، ومنهم: عباس النوري، رشيد عساف، سلوم حداد، بسام كوسا وغيرهم.
بعد افتتاح المعهد العالي للفنون المسرحيّة، صار تعليم المسرح متوفرًا للجيل الجديد، وقد خرّج المعهد العالي للفنون المسرحيّة العديد من الممثلين (الذين نادرًا ما عملوا في المسرح وعندما ازدهرت سوق الدراما التلفزيونيّة انقطعوا عن المسرح نهائيًا). وبُنيت دار الأوبرا التي زادت من إمكانيّة وجود أماكن للعرض المسرحي. وأقيم مهرجان للمسرح كلّ سنتين كان له دور كبير في تنشيط التفاعل مع المسرح العربي والعالمي في البداية.
لم يكن في ذلك الوقت قد ظهر منافس المسرح القوي، التلفزيون، الذي شكّلت دراماه التي بدأت محليّة، لكنها بسرعة ركبت موجة العولمة وصارت لها شروط إنتاج خاصة.
هذا من ناحية الإنتاج، أما من ناحية التوجه السياسي الاجتماعي والإنساني فقد عبّر الإنتاج المسرحي وقتها عن رؤيته للعالم والأحداث السياسيّة الكبيرة التي مرّ بها البلد. (أهم كتّاب ومخرجي المرحلة قدّموا عروضًا في هذا الإطار، سعد الله ونوس ممدوح عدوان، فرحان بلبل وغيرهم، ومن المخرجين أسعد فضة -الذي كان مدير مسارح لفترة طويلة- نائلة الأطرش وحسن عويتي وفواز الساجر). أما بالنسبة لحريّة التعبير، فلم يخلو الأمر من المضايقات، لكن المثقف كان له كلمته وقد عبّر عن ذلك بشكل واضح. ولا بدّ من الإشارة، ولو بشكل سريع إلى أنّ المواضيع التي كان يتطرّق لها هذا المسرح كانت بأغلبها مواضيع سياسيّة، وبرأيي الشخصي تمّ إهمال العامل الفردي والإنساني لصالح الرؤية المتكاملة، وهذا موضوع يطول البحث فيه لكنه يفسر نوعًا ما توّجه الجيل الجديد للثورة عن جيل الأباء والكلام عن الذات. عاشت الكتابة المسرحيّة أزمة حقيقيّة.
طبعًا لم يكن في ذلك الوقت قد ظهر منافس المسرح القوي، التلفزيون، الذي شكّلت دراماه التي بدأت محليّة، لكنها بسرعة ركبت موجة العولمة وصارت لها شروط إنتاج خاصة.
عن ماذا يكتب المسرحيون؟
حاول جيل الآباء أن يقدّم رؤية وقراءة سياسيّة شاملة، وربما أهملوا دور الإنسان الفرد (الأنا)، لهذا نرى، على سبيل المثال لا الحصر، أنّ الشخصيات التي رسموها في نصوصهم هي شخصيات نمطيّة تُوحي برؤية عامة للمجتمع لكنها لا تبحث في وضع الفرد.
المهم أنّ المسرح السوري حقّق لنفسه تواجدًا هامًا في مرحلته الذهبيّة، التي تشمل الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين وبداية الثمانينيات، في تلك المرحلة كتبت النصوص المسرحية الهامة وعرف المسرح المكتوب ازدهارًا، مع كتّاب ومخرجين وممثلين اشتهروا على مستوى العالم العربي وحتى على المستوى العالمي.
مقدمة الملف: الكويرية والثورة: نحو أرشيف سوري بديل (الجزء الأول)
29 أيلول 2020
وأخيرًا، لا بدّ من الذكر أنّ مجلة الحياة المسرحيّة صدرت أول أعدادها في (1969) وكان أول رئيس تحرير لها هو سعد الله ونوس، تلاه الدكتور نبيل حفار. لكن هذا الحال لم يدم طويلًا، فسريعًا ما بدأ الترهل يظهر على المنظومة الإدرايّة والفنيّة لأنّها لم تتطوّر نهائيًا وبقيت الأطر الموجودة هي ذاتها في السبعينات والثمانينات إلى يومنا هذا، ولأنّ عوامل جديدة دخلت وأثرت على انتقاء الأشخاص الممسكين بالقرار الفني والإداري.
اعتبارًا من ثمانينات القرن الماضي، بات من الواضح أن الأطر والقوانين التي ترعى الفن المسرحي بحاجة إلى إنعاش أو إعادة إحياء، وكأنّ هذه الأطر تحولت إلى عبء على الثقافة والفن. وبدأ الكلام عن هذه الحاجة للتغيير يتزايد على المستوى الوطني والاقليمي؛ واعتبارًا من هذا التاريخ بدأنا نسمع عن المطالبة بفن مستقل.
إشكاليّة الاستمرار
لن ندخل هنا في تحليل هذه المشكلة، لكننا نذكرها عبر سردنا لنوضح الفكرة التي ننطلق منها. إذًا، منذ ذلك التاريخ بدأ التفكير بشيء جديد، ولكن ما هو هذا الجديد وما علاقته بالموجود؟، هل هو استكمال له؟ أم أنّه يشكّل ثورة عليه؟ هل يقوم بالتنسيق مع الموجود أم يستقل عنه نهائيًا ويدير له ظهره؟. هنا اختلفت الآراء، لكنها كانت واعية في مجملها للإشكال، حتى لو لم يقتصر الأمر على المسرح، ولا حتى على المؤسسات الفنيّة أو التعليميّة. وقد أثر هذا التصلّب على مضمون الفن بشكل كبير.
قبل الأزمة كانت كلّ المؤشرات تدلّ على المشكلة التي كان يعيشها المسرح رغم المحاولات الجادة للخروج من هذه الأزمة التي قادها مسرحيون ومثقفون، وذلك لتجاوز التصلّب والانفتاح على المسرح المعاصر، وتجلّت هذه المحاولات بتشكيل فرق شبابيّة، والبحث عن أمكنة بديلة، تأسيس معاهد خاصة والانفتاح على أشكال عروض جديدة مثل مسرح الشارع، مسرح الصورة، وخاصة الكتابة الجديدة. اعتبارًا من بداية القرن الواحد والعشرين ظهر مسرح تنموي (سمّي بالمسرح التفاعلي) ودربت له كوادر من خريجي المعهد العالي للفنون المسرحيّة أساسًا، عمل في المجتمع والأرياف وحاول أن يلعب دورًا في عملية التنمية والتطوير، وخاصة على مستوى التعليم وتنمية المناطق النائية وكانت هذه مبادرات خاصة مموّلة بشكل مستقل.
لا بدّ لنا من الإشارة إلى أنّ الإنتاج الأدبي والفني السوري كان في السابق محليًّا بحتًا، أي أنّ السوري كان مغلقًا على نفسه برضاه أو دونه.
الزلزال (تسونامي كما سمّاه الفاضل الجعايبي) الذي عصف بالمسرح كانت له أسبابه، الداخليّة والخارجيّة، وله أسس قديمة وجديدة. وقد طال بشدّة الذين بقوا في سوريا، حيث لا أفق أمامهم، لكنه طال أيضًا من خرجوا من سوريا مهما اختلفت أسباب خروجهم. الظروف تغيّرت بالنسبة للكثيرين منهم وصار عليهم بعد فترة البداية التي استثمروا فيها رغبة الآخر في معرفة من هو السوري واستثمروا ما حملوه من ذاكرة عن واقع حقيقي ومتخيّل معروف أو غير معروف، كان عليهم التأقلم مع عالم جديد وظروف معيشيّة وإنتاجيّة مختلفة، وبالتالي مع مرجعيّات مختلفة، كلّ بحسب ظروفه ومكان وجوده.
من ناحية أخرى كثيرون هم الذين امتهنوا الفن في بلاد اللجوء، وحاولوا أن يُعبروا عن أنفسهم وأن يجدوا لأنفسهم مكانة جديدة. وهذا ليس بالأمر السهل (وهذا الملف يحاول أن يقارب هذا الأمر بشكل أو بآخر من خلال شهادة بيسان الشريف). وأظن أنّه، وحتى الآن، قليلون هم من نجحوا في ذلك.
هنا لا بدّ لنا من الإشارة إلى أنّ الإنتاج الأدبي والفني السوري كان في السابق محليًّا بحتًا، أي أنّ السوري كان مغلقًا على نفسه برضاه أو دونه، لكنه كان معزولًا حتى أنّ من المجدي إجراء دراسة عن حركة الترجمة في الماضي وحركة الترجمة الآن. غزارة الترجمة تجعلنا نسأل: ماذا حدث؟ هل بدأ العالم يسأل من هو السوري وما هي هويته الفنيّة والأدبيّة؟ من المؤكد أنّ هناك رغبة عامة عند مختلف شعوب العالم في اكتشاف "السوري".
السينما السورية الجديدة.. شابة تلتقط أنفاسها (5)
14 كانون الثاني 2020
أظن أنّ الوحيد الذي عرف عمله نوعًا من الاستمرار والتطوّر في السنوات الأخيرة هو المسرحي عمر أبو سعدة من خلال شراكته مع محمد العطار (وبيسان الشريف)، فعمر بدأ وهو في دمشق يقدّم أعمالًا مسرحية مستقلّة (ولم يكن الوحيد في ذلك، أسامة غنم قام بنفس الشيء) ولكن عمر أبو سعدة مع شريكه محمد العطار وفريقه عملوا في مجالات عدّة، منها المسرح التنموي التفاعلي وقد راكم التجارب، عملوا في لبنان ومن ثم في أوروبا مستخدمين الخبرة التي اكتسبوها من خلال التقنيات التفاعليّة لكتابة النصوص (منها أنتيغونا الطرواديات) وخبرة المسرح التقليدي وخبرة التوجه إلى الجهات المانحة.
من ناحية أخرى، هناك تشتت جغرافي يجعل من شبه المستحيل متابعة إنتاج الجميع. أذكر مثلًا أنّ نائلة الأطرش وهي تدرّس المسرح في أمريكا، قدمت مسرحيّات عربيّة (منها مسرحيّة ونوس "الأيام المخمورة") هناك باللغة الانجليزيّة مع طلابها، وناندا محمد (الممثلة) تعمل في مصر حيث استقرت وتشارك في العديد من الأعمال في أوروبا وكذلك حال حلا عمران وأمل عمران ورمزي شقير ومحمد آل رشي والقائمة تطول... كيف سيستمر هؤلاء وهل يعتبر مسرحهم ضمن المسرح السوري؟
حال الأزمة قبل الأحداث
حاولنا أيضًا في هذا الملف، أن نلقي نظرة على ما يقدّم في سوريا (شهادة آنا عكّاش)، وهنا نلاحظ أن "المسرح القومي" وغيره من المؤسسات المسرحيّة قدّمت العديد من المسرحيات، وأغلبها بالعقليّة المتحجّرة ذاتها، لأنّ المسرح القومي يعمل كرقيب لا كمؤسّسة منتجة وميّسر، هذا بالإضافة إلى صعوبات الإنتاج.
"المعهد العالي للفنون المسرحيّة" (وهو مؤسّسة تعليميّة) لعب دورًا مهمًّا في البداية لكن هذا الدور تراجع كثيرًا فيما بعد لنفس الأسباب، كذلك الأمر بالنسبة لمجلة الحياة المسرحيّة. إن تغيير الاشخاص المسؤولين عن أداء هذه المؤسسات أثّر كثيرًا على السويّة العلميّة والفنيّة. ما نعرفه، مؤخرًا قامت في دمشق وغيرها من المحافظات بعض التجمعات المحليّة بمحاولة بناء وخلق أُطر جديدة تحت مسميّات مختلفة، وهي بحاجة إلى دعم مادي ومعنوي لتستطيع الاستمرار والتطور. ولا بدّ من الإشارة إلى بعض الحالات الاستثنائيّة التي ما زالت تعمل أو تحاول أن تعمل باستقلاليّة وأهمها تجربة مختبر دمشق المسرحي الذي يديره، أسامة غنم، الذي افتتح في دمشق، وهو مختبر مستقل من تمويل مستقل، وفيه يدرّب طلّابًا وخرّيجين ويحضّر لعروض مسرحيّة مستقلّة. وهناك المعهد الخاص للمسرح (المستقل) في جرمانا الذي يديره سمير عثمان، ويؤهل طلابًا ويقدّم عروضًا مسرحية، وفي اللاذقيّة افتتحت جامعة خاصة تدرّس المسرح.
المطالبة باستقلاليّة الفن، وخاصة حرية التعبير، كانت وما زالت واحدة من الإشكاليّات التي ما زالت موجودة في كلّ مكان، والتي تُطرح حول الفن المستقل، كما أنّ بعض الدول لاقت أجوبة مختلفة ومتنوعة لها بقدر ما.
منذ سنوات عديدة نُودي بمسرح مستقل في أغلب الدول العربيّة، ومنها سوريا. المسرح المستقلّ برز خلال الأزمة وكان خجولًا في البداية، لكنه بعد ذلك، وبدعم من مؤسسات مانحة عربية وأجنبيّة، حاول بوسائل عديدة مقاومة حالة التغييب المفروضة على المسرح، ذلك أنّ مؤسّسات الدولة انكفأت على ذاتها ولم تعد تدعم إلا العروض ذات المضمون الموافَق عليه أو بعض الأشخاص المُرضى عنهم.
المطالبة باستقلاليّة الفن، وخاصة حرية التعبير، كانت وما زالت واحدة من الإشكاليّات التي ما زالت موجودة في كلّ مكان، والتي تُطرح حول الفن المستقل، كما أنّ بعض الدول لاقت أجوبة مختلفة ومتنوعة لها بقدر ما. طبعًا لم يُطرح هذا السؤال بمعزل عمّا جرى في كلّ أنحاء العالم من عولمة للثقافة وتطوّرات تقنيّة زعزعت الموجود والقائم.
الخروج من سوريا
كانت هناك تجلّيات واضحة ومهمّة لإنتاج الشباب الجديد في بلدان الجوار. في البداية شكلت بيروت نقطة استقطاب للفنانين السوريين ممن لجأوا إليها أو اتخذوا العاصمة اللبنانيّة محطّة لهم. حتى أنّ الموجة بدأت تفرض نفسها على الفضاءات الفنيّة اللبنانيّة (انظروا ماذا حدث بالنسبة للدراما التلفزيونيّة) وهذا كان له دورًا كبيرًا بالتعريف بالمسرح السوري والمواهب السوريّة.
أول من بادر بالتعريف بالمسرح السوري الشاب هو مسرح دوار الشمس في بيروت في ملتقى "منمنمات شهر من أجل سوريا" الذي دام شهرًا كاملًا في العام 2013 وقدّم أنواع العروض السوريّة كافة، من الرقص المعاصر، مرورًا بالعروض الموسيقيّة والسينمائيّة والمسرحيّة، وصولًا إلى التشكيل الفني. عرض الافتتاح لهذه المناسبة كان "الغرف الصغيرة" للكاتب وائل قدور (الذي يُمكن متابعة أعماله وكتاباته اللاحقة في الأردن وفرنسا). الشقّ المسرحي في الملتقى حمل الكثير من الإسقاطات السياسيّة على الواقع الملتهب من خلال مسرحيات مثل "المراقب" (12 و13 نيسان 2013) الذي اقتبسه المخرج الشاب يامن محمد عن نصّ "محطة فيكتوريا" لهارولد بنتر. وفي محاكاتها للهجرة والظلم، قدّمت فرقتا "سما" للرقص و"كون" عرض "سيلوفان" (7 و8 نيسان 2013) الذي يُقارب فيه أسامة حلال القمع في بلده. ثم كانت هناك مناسبة ثانية في نفس المسرح وهي "أغورا" بيروت ملتقى "أغورا" للتعريف بالمختبرات المسرحيّة في العالم العربي. كذلك نُظّمت تظاهرة "منصّة للمسرح العربي اليوم" معوّلة على التغييرات التي تُحدثها الثورات العربيّة. فجمَع مسرحيّين وتشكيليّين ومفكّرين من مختلف البلدان العربيّة. تتالت بعدها العروض (ومقالة علاء رشيدي تسرد أغلب ما قدّم).
الأغنية بوصفها ثورة وتوثيقا لا يموت
02 نيسان 2021
قدّم بيروت ملتقى "أغورا" للتعريف بالمختبرات المسرحيّة في العالم العربي، أعمال أربعة مختبرات من سوريا: "مختبر دمشق للمسرح" (أسامة غنم) "فرقة زقاق" (لبنان)، "مختبر المسرح الحيّ معز المربط" (تونس)، "فرقة أدا" (المغرب).
وهناك بعض الأعمال في الأردن (مثل "خيمة شكسبير" لنوّار بلبل في مخيم الزعتري للّاجئين). كما نُظّم مشروع "عندما تبكي فرح" للكاتب المسرحي السوري مضر حجي (وهو أيضًا يجب متابعة عمله وتطوّره لاحقًا في ألمانيا) ورشةَ عملٍ في عمّان، الأردن، بعنوان "محاولات كتابة الكارثة" بمشاركة فنّانين سوريّين وأردنيّين ولبنانيين على مدى يومين (من 16 إلى 17 آب 2014 في "مسرح البلد" في عمّان).
من أهم الأعمال أيضًا عرض "الطرواديّات" الذي قدّمه عمر أبو سعدة ومحمد العطار بالاشتراك مع ناندا محمد (كمدرّبة وممثّلة) وبيسان الشريف (سينوغراف) في الأردن، عُرض بعدها في لبنان ثمّ في أوروبا. ومن بعده عرض "أنتيغونا" الذي كما "الطرواديات" اعتمد العمل مع اللاجئين أسلوبًا فريدًا في بناء العمل المسرحي. البداية كانت مع تمارين في التفاعل الاجتماعي لخلق علاقة مع النساء اللاتي لا علاقة لهنّ بالمسرح. وخلال هذه المدّة تمّ إعداد نصّ الكاتب الإغريقي يوريبيدس "الطرواديات" (وهو نصّ يطرح مصير النساء الطرواديّات بعد نهاية حرب طروادة)، وتمّ إدخال نصوص نساء سوريات اضطّررن للهجرة إلى الأردن. وقد جرى إعداد النصّ وتدريب النساء على الإلقاء ليقدّمن قصصهنّ الحقيقيّة.
وفي هذا الصدد لا بدّ من تسجيل دور المؤسسات المانحة العربيّة، خاصة التي دعمت المسرح الشاب وأطلقت مواهب جديدة على الساحة الفنية، ولا مجال لذكر الأسماء هنا، لكن تجدر الإشارة إلى الحريّة التي تمتّع بها المسرحيون في إنتاجهم.
بالنسبة إلى الكتابة المسرحيّة، كان وما زال، هناك غزارة في الكتابة المسرحيّة على الرّغم من الصعوبات الشديدة والظروف القاهرة التي يمرّ بها السوريون. وقد برز ذلك من خلال فرص عدّة أتاحت للشباب الإفادة من ورشات عمل في الكتابة المسرحيّة، فضلًا عن برامج دعم للعروض الشابّة، شأن برامج "مؤسّسة مواطنون فنّانون" (وممولها الرئيسي شبكة تماسي) وغيرها مثل "المورد الثقافي" و"آفاق" واتجاهات - ثقافة مستقلة. لا مجال هنا لذكر كلّ ورشات الكتابة، بل نذكر أهمّها وهي ورشة نظّمها "مسرح الرويات كورت" البريطاني برعاية المجلس الثقافي البريطاني في بيروت وهناك ورشة أخرى نظّمتها "مؤسّسة مواطنون فنّانون" في العام 2012. ومن ثمّ ورشتين متتاليتين لنفس المؤسسة أشرفت عليهما الدكتورة ماري الياس، والورشات تحاول أن تجمع كتّابًا من الداخل والخارج.
ماذا سيقدم هؤلاء الشباب عبر المسرح ولمن سيتوجهوا بكتاباتهم؟ أظن أنّ هذا السؤال يجب أن يطرحوه على أنفسهم وبشدّة.
حركة الطباعة والنشر ضعيفة لهذا لا يمكن الإلمام بكافة النصوص، إنّما لكوني شخصيًا تابعت العديد من الورشات وأشرفت عليها، سأحاول التوقف عند بعض ملامح الكتابة الجديدة، وهنا أذكر الورشتين الأخيرتين التي سميناها "الكتابة للخشبة"، لأنّنا طمحنا فعلًا إلى نوع من الكتابة الجديدة.
ما هي ملامح مسرح الجيل الجديد؟
ملامح تجربة مسرح الجيل الجديد في الكتابة المسرحيّة أو العرض المسرحي، تبيّن أنّ المسرح السوري، كما في دول عديدة في العالم العربي، يعيش مشاكل حقيقيّة، وأهمها فقدان المرجعيّة، ووجود هوة موضوعيّة تفصل بينه وبين الجيل السابق، أي جيل الستينات والسبعينات، فالجيل الجديد لا يشكل استمراريّة طبيعيّة لما سبقه. إن ما ينتج أو يُكتب للمسرح اليوم يدل على أنّه غير قادر أن يستند إلى الحاضر المُركّب المُعاش والتعبير عنه بشكل واضح، من عبثيّة الحياة وإلحاح القضايا الكبيرة والمصيريّة، وقد يشكل هذا الأمر أحد أهم صعوبات الكتابة للمسرح اليوم. ثمّ أنّ المواضيع التي يطرحها الشباب بدأت تتغير وتتطور بعد مرحلة الحنيني والتوثيق والتنفس بسبب إمكانيّة التعبير.
ماذا سيقدم هؤلاء الشباب عبر المسرح ولمن سيتوجهوا بكتاباتهم؟ أظن أنّ هذا السؤال يجب أن يطرحوه على أنفسهم وبشدّة.
ما نراه في نصوص الشباب في الوقت الحالي أنّه لا مجال لتقديم صورة متكاملة عن الوضع السياسي والاجتماعي الذي يعيشه السوريون أينما كانوا. مؤخرًا وفي ورشة كتابة (دُعيت إليها وتابعتها مؤسسة مواطنون فنانون) مع كتّاب شباب من الداخل والخارج، كان الموضوع الأهم المطروح هو الضياع وسؤال لا نعرف ماذا نكتب (نصيّن لمضر حجي "حبك نار" و"عودة دانتون") وهذا الضياع قارب الجنون في بعض النصوص (نصوص هيا حساني دمشق، دانيل الخطيب طرطوس، حسن الملا وعمر جباعي لبنان وغيرهم). كما أنّ إشكاليّة الهويّة ما زالت حاضرة وبكثافة، الهويّة-الانتماء/ الهوية-الجنسيّة.
ثورة على التحجّر
سأسرد نوعًا ما ملامح مسرحيتين لفتتا انتباهي، هما أولًا نص "عندما تبكي فرح" لمضر حجي (الذي نُشر عن دار الفارابي في لبنان) ومن ثمّ "حبك نار"، حيث حاول حجي طرح موضوع الثورة من خلال مسرحيّات تطرح تساؤلات أساسيّة وقد استخدم مستويين من اللغة، الفصحى للكاتب والعاميّة للحوار الموازي. النص الأول لصيق جدًا بفكرة الثورة ويطرح سؤالًا معها هو: ما معنى الثورة؟ ولعلّه أهم الاسئلة التي يُمكن أن تطرح. أمّا النص الثاني وما تلاه بعد ذلك فهو يطرح سؤالًا عمليًّا حول ماذا نكتب.
الثقافة الشفوية والهوية في سورية (ملف)
15 أيار 2018
نصّ "عندما تبكي فرح" مأخوذ عن حكاية حقيقيّة، وسؤاله الأساسي يدور حول مستويات التغيير في المجتمع السوري، حيث الحكاية الشخصيّة تسير بالتوازي مع حكاية البلد والثورة. تدور أحداث الحكاية في أواسط العام 2012، حين تغادر الشابة فرح (خريجة كليّة الفنون الجميلة) دمشق إلى عمّان لتلتحق بحبيبها أحمد، أحد الناشطين السلميّين، الذي اضطرّ إلى السفر هربًا من خطر الاعتقال. وبرحيلها هذا، تحاول فرح التخلّص من شعورها بالذنب الذي كانت قد ورثته عن أبيها ومجتمعها. تتّخذ فرح، التي توقّفت عن ممارسة النحت منذ سنوات، خطوةً "ثوريّة" برحيلها عن أبيها إلى حبيبها، ولكنّها سرعان ما تكتشف أنّها تقف على أعتاب ثورة جديدة ورحيل جديد لا تعرف ملامحه بعد، ولكنّها متأكدة أنّه سيوصلها إلى استئناف مشروعها في النحت من جديد.
سنذكر مثالًا هنا، والذي نعتبره من أهم النصوص/ العروض التي كتبت في هذه المرحلة، وأقصد نص/عرض "ما عم أتذكر" لوائل علي المُقيم في مدينة ليون بفرنسا. النص باللغة العاميّة لأنّه عبارة عن لقاء/ حوار بين ممثل وسجين سياسي سابق. النص مفعم بالشعريّة، وذلك لأنّه ابتعد تمامًا عن الواقعيّة، على العكس، النص يعطي أمثلة عن واقع عاشه السجين لكنه في الآن ذاته يطرح قضيّة أخرى وهي قضيّة الذاكرة ومتابعة الحياة ومقاومة ضغط السجن. العرض هو محاولة إعادة بناء السيرة الذاتيّة لموسيقي ومعتقل سياسي في ثمانينيات القرن الماضي في سوريا يُدعى "حسّان". حياة الشاهد محكومة بكثيرٍ من الانقطاعات والمحاكمات: العمل السرّي، التخفّي، الاعتقال، السجن، الهجرة، اللجوء، العيش في مكان جديد، استعادة البلد بعد الثورة التي تغرق بدورها في دوّامة عنف يتصاعد باستمرار. هل يمكن إعادة تركيب هذه السيرة حقًّا؟ هكذا يقارب العرض سؤال العنف من خلال أثره على الذاكرة والذات والعلاقة مع المكان/ البلد.
يقول الباحث وسيم الشرقي في بحثه للتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، (أطروحة تخرج) "المسرحية التي تخلّلها عرض لقطات من حوار قديم مع حسّان، وبضع لقطات من ذاكرة السوريّين مع مذيعات التلفزيون الرسمي والبرامج القتالية الحماسيّة، اكتفى بتقديم تجربة واحدة من تجارب عديدة عاشها السوريون. وتلك التجربة لم تستدرج ولا للحظة واحدة عطف المتفرّج. تجربة صافية، اجتزأ منها المخرج بمساعدة حسّان، مجموعة من التفاصيل التي نجهلها. لم يتطرّقا إلى التعذيب حيث أضحى "كليشيه" في القصة السوريّة، ولم يقتربا ممّا يعيشه الآلاف كلّ يوم. اكتفيا بقصص عن يوميات السجن التي تتوق إلى حياة طبيعيّة. قصّة السجناء مع القطّة التي زارت مهاجعهم فاحتضونها وعلّموها كيف تتخفّى عندما يزورهم السجّان. القطة لوسي التي أكلت عصفور جيرانهم في المهجع القريب، والاجتماعات التي عقدوها لتفادي الأزمة ولاحتواء غضب "أهل العصفور الفقيد". بعد الإفراج عن حسّان وسفره إلى فرنسا، ظلّ يَطْمَئِنّ على لوسي عبر أصدقاء مشتركين، ثمّ علم بمقتلها بعدما أغلق السجّان باب المهجع عليها" ( أطروحة تخرج، والمسرحي الذي شارك في ورشات الكتابة وسيم الشرقي موجود اليوم في ألمانيا).
اللغة جزء من هذه الثورة
أظن أن أغلب هؤلاء الكتاب الشباب شعروا أنّ العاميّة أقرب إلى أنفسهم من الفصحى وأقرب إلى موضوعهم، وقد يكون هذا جزء من ثورتهم على الماضي. العمل على اللغة المسرحيّة أو أدبيّة النص، ولعلي استخدم عبارة أخرى وهي "شعرية النص" أو "براعة الكتابة"، لا تتحددان بالمستوى اللغوي بل باختيار الكلمات والتعابير واقتصاديّة اللغة المسرحيّة. لا ترتبط شعريّة النص أبدًا بالفصحى، بل بمدى تملّك لغة المسرح، فاللغة المسرحيّة لها خصوصيتها وهي لا تأتي من اختيار الفصحى بل من طريقة التعامل مع الكلام أو التعبير في المسرح. أما عن أدبيّة النص، فالمسرح يبتعد يومًا فيومًا، عن الأدب ليكون أقرب إلى سيناريو لعرض. المستوى اللغوي يرتبط كليّة بمضمون ما يُقال والموقف المسرحي، وفي الحالات التي نتكلم عنها، أتفهم تمامًا المستوى اللغوي الذي تمّ اختياره لأنّه مرتبط تمامًا بالسياق الذي يُقدّم به وهو سياق الحياة اليوميّة للناس، وقد يبدو في هذه الحالة اختيار الفصحى فيه نوع من الإبعاد أو الحذلقة أو حتى التغريب. من ناحية أخرى، أثّر انتشار كتابة السيناريو التلفزيوني والسينمائي على تحرير المسرح من شرط الأدبيّة وفتح الباب واسعًا أمام اختيار المستوى اللغوي في المسرح.
هنا لا بدّ أن نلاحظ أنّ استخدام اللغة المحكية يحدّ من إمكانيّة فهم النص للذين لا يفهمون اللهجات السوريّة.
آليّات التمويل
نختم مع مسألة جديدة واجهت هؤلاء المسرحيين، وخاصة في بلدان اللجوء، وهي سؤال علاقة هذا الجديد بمسألة التمويل وآليات التمويل.
ماذا يمثل هذا الجديد؟ هل يكون هامشيًا بالنسبة للمجتمع الذي يعيش فيه اللاجئ، أم أن عليه أن ينخرط في الإطار الجديد ويطرح مواضيع مغايرة؟ وأظن أنّ هذا السؤال يلتقي بالإشكاليّة الأولى التي نختصرها: بماذا نكتب ولمن، وهو يجمع بين الإشكاليتين.
كذلك سؤال: من يموّل مشاريع الفن المستقل؟ وما هي أرضيّة هذا الفن؟ وأقصد بأرضيّة هذا الفن، البنى التحتيّة التي ينطلق منها ويعود إليها من مؤسسات وفضاءات وأشخاص، الخ. وهذا سؤال ملح وطالما طُرح سابقًا، لكن جوابه ما زال في صدد الأخذ والردّ. ثمّ هل هذا النوع من العمل الذي يُسمّى بالمستقل، هو عمل انتقائي لا ديمقراطي حيث أنّه لا يعطي الفرص للجميع على وجه واحد، وأنّ الآخر هو العمل الديمقراطي؟
نظرًا للظرف الذي يمر به السوريون قد يكون موضوع شرط الإنتاج وانفتاح السوق، وموضوع الترجمة في حال تمت الترجمة إلى لغات غير العربيّة، كلها أمور يجب التفكير بها لا سيما موضوع التوزيع، فالسوق يطلب أن يعرف والسوريون في الخارج يلبون مطلب السوق، وربما أحيانا أكثر مما يجب، دون أن يفقدوا القيمة الفنيّة. أظن أنّ علينا التفكير وبعمق بآليات الإنتاج وقنوات التوصيل لفهم الفرز الذي يحصل على الأرض.