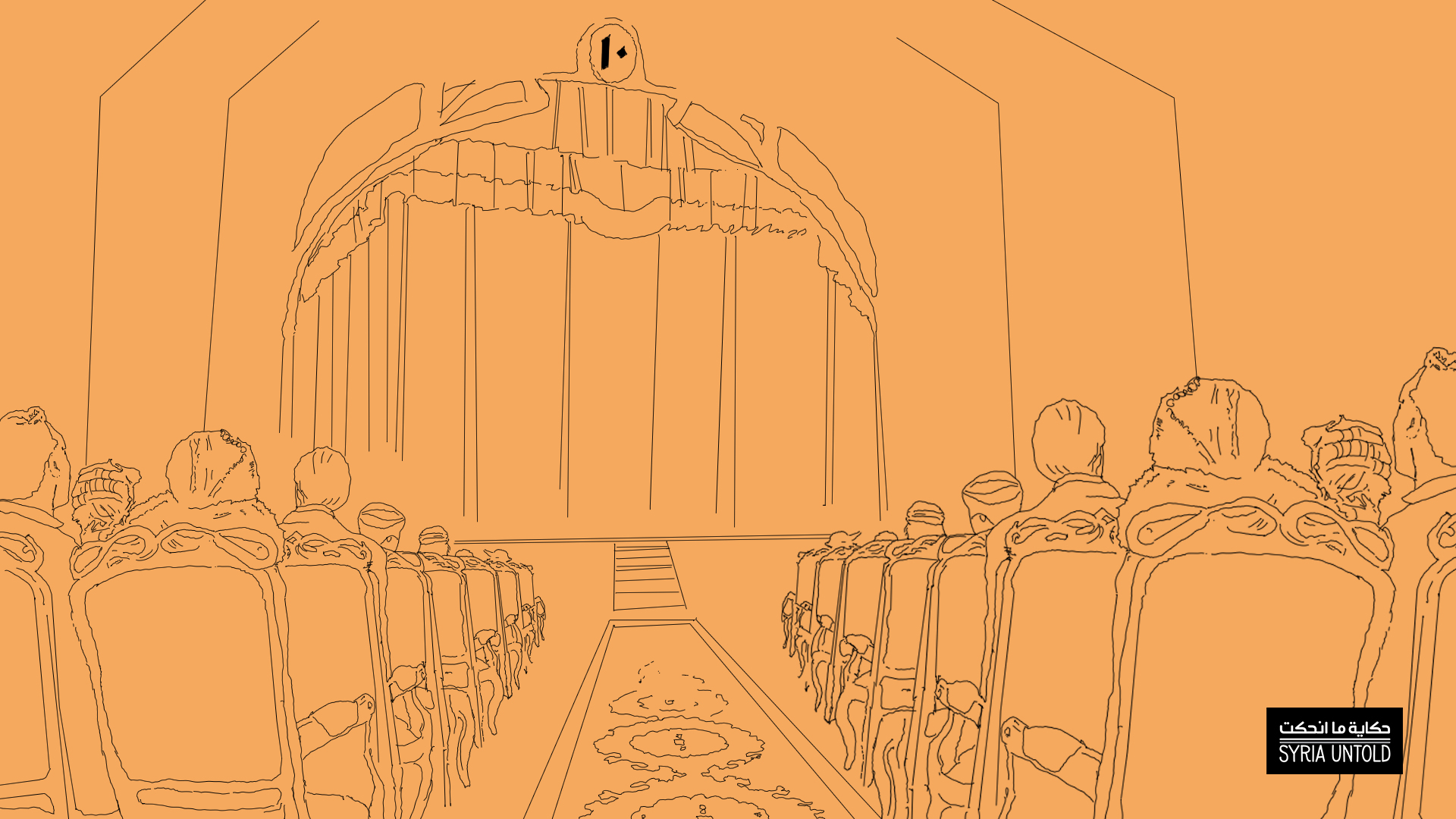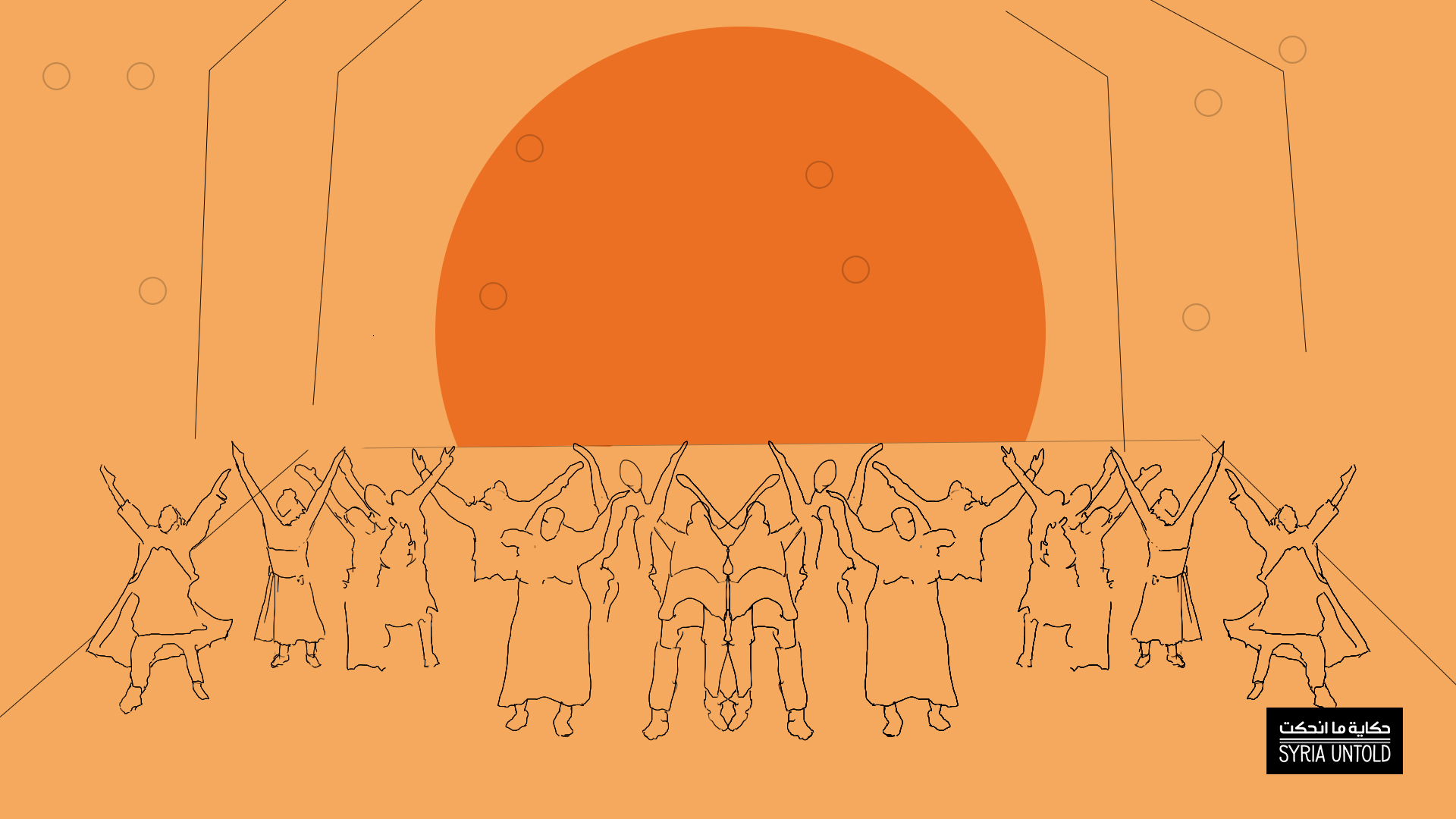منذ اندلاع الثورة/ الحرب السوريّة عام 2011 وانتقال أغلب المشتغلين في الحقل الثقافي ومن بينهم المسرحيين إلى خارج البلاد، وخاصة إلى أوروبا، يتبادر إلى ذهني سؤالين أساسيين: الأول يتعلق بالتغيّرات الطارئة على التجربة المسرحيّة المهاجرة، وإن كانت هذه التغييرات تمس الشكل فقط أو المضمون أو الاثنين معًا. والسؤال الثاني يتعلق بما هو "جديد" في التجربة المسرحيّة السوريّة الناشئة في بلاد الاغتراب. أسئلة أطرحها على نفسي، أنا العاملة في المسرح والمتخصّصة في مجال السينوغرافيا في فرنسا، والتي راكمت تجربتها في العمل المسرحي في سوريا خلال السنوات الست التي سبقت بداية المقتلة السوريّة، ومن ثم تابعت مسارها المهني في أوروبا بعد العودة إلى فرنسا مجددًا عام 2012.
بداية، لابد من التوضيح أنّ الإلمام بكلّ التجارب المسرحيّة السوريّة منذ عام 2011 أمر بغاية الصعوبة لتنوّع النصوص وكثرة العروض وانتشارها في الكثير من بلدان العالم، لذلك سأكتفي بمشاركة انطباعاتي/ تأملاتي الشخصيّة، مستعرضة بإيجاز أبرز التجارب التي عملت فيها مع مسرحيين سوريين مثل المخرج عمر أبو سعدا، الكاتب محمد العطار الحسيني، والمخرج وائل علي.
مهمة صعبة
إحدى المهمات الصعبة التي واجهتنا أثناء جولاتنا المسرحيّة هي تعريف الجمهور الأجنبي بالمشهد الثقافي السوري السابق للحرب. فالإنتاج الثقافي السوري مرتبط، بشكل عام، في ذهنيّة الأوروبي بالحرب والهجرة، وكأن هذه الثقافة الوافدة لا تملك أيّة جذور فنيّة اجتماعيّة سياسيّة محليّة.
أحوال المسرح السوري اليوم
17 أيار 2021
لسنا هنا بصدّد الحديث عن نشأة المسرح الحديث وتاريخ تطوّره في سوريا، ولكنني أجدّ من الضروري التذكير بالمساعي الجادّة التي عملت على رسم ملامح هويّة مسرحيّة سوريّة، خصوصًا في العشريّة التي سبقت عام 2011. صحيح أنّ التجارب المسرحيّة لم تكن كثيرة في سوريا، لكنني أعتقد أنّ بعضها كان على مستوى فني جيّد، يحاول مواكبة ما يحدث على الساحة المسرحيّة العالميّة، على الرغم من سلطة الرقيب.
نستطيع القول إنّه وبعد العام 2011، أصبح لدينا مسرحيون في الداخل يواصلون إنتاجهم الثقافي داخل البلاد رغم الظروف الصعبة للبلد، ومسرحيون في الخارج ينتجون أعمالهم في البلاد التي لجؤوا إليها وهم أغلبيّة(!!) حسب علمي. احتاجت هذه الفئة الأخيرة إلى وقت ليس بالقليل حتى تتكيّف مع بيئتها الجديدة، حيث بدأ المسرحيون في الخارج بالتعرّف على طرق وأساليب إنتاج غير معتادين عليها في الإنتاج المسرحي ممّا أدى إلى ظهور عروض مسرحيّة جديدة أو مختلفة.
كان هدف أغلب المسرحيين في الخارج، بداية الأمر، استخدام الفن كشهادة وتعريف الجمهور الغربي "الآخر" بالواقع السوري، بعيدًا عمّا تنشره وسائل الإعلام العالميّة. كان التعريف بالمأساة السوريّة من خلال النصوص المسرحيّة هو طريقتهم في الاستمرار والمقاومة، وكان المسرح بالفعل أحد الأدوات الرئيسيّة التي وثّقت للحدث السوري.
تطوّر المسرح الوثائقي
مع تسارع الأحداث، وفي مواجهة العنف، تطوّر شكل من أشكال المسرح الوثائقي يملك رغبة جديّة في عرض وقول الأشياء كما هي وبأسرع طريقة ممكنة. كما في عرض "فيك تتطلع على الكاميرا؟" (2011-2012)، لمحمد العطار (كاتب) وعمر أبو سعدا (مخرج). يعتبر هذا العرض من أوائل الأمثلة الواضحة على المسرح التوثيقي. ترتكز حكاية النص البسيطة على قصص واقعيّة لعدد من الأصدقاء عانوا من الاعتقال في بداية الثورة. تدربنا على البروفات في سوريا، لكن العرض لم يقدّم بالطبع هناك، عُرض للمرة الأولى في كوريا الجنوبيّة ثمّ في لبنان، وبعد العرض في بيروت، بدأ معظمنا بالانتقال إلى أوروبا، واحدًا تلو الآخر.
"ما عم اتذكر" (2014) للمخرج والكاتب وائل علي، هو مثال آخر على المسرح الوثائقي. بُني النص على شكل حوار بين الموسيقي والسجين السياسي السابق، حسان عبد الرحمن، الموجود على المسرح والممثل أيهم عبد المجيد آغا، حيث يحاول هذا الأخير استجواب ذاكرة حسان البعيدة. يجمع هذا العرض بين الشهادة والنقد الذاتي لهذه الشهادة.
كان هدف أغلب المسرحيين في الخارج، بداية الأمر، استخدام الفن كشهادة وتعريف الجمهور الغربي "الآخر" بالواقع السوري، بعيدًا عمّا تنشره وسائل الإعلام العالميّة.
تحديات جديدة
اليوم وبعد مرور عشر سنوات على الثورة السوريّة، يواجه الفنانون السوريون تحديًا جديدًا يتعلق بمتطلبات سوق الإنتاج، التمويل والبرمجة المسرحيّة التي، في معظمها، تضع الفنان السوري في قالب جاهز: أن تكون فنانًا سوريًا يجب عليك إذًا طرح موضوع الحرب، وهذه مشكلة.
في عرضه المسرحي الثاني "عنوان مؤقت" (2017) حاول وائل علي، بالتعاون مع كريستيل خضر، وهي فنانة مسرحيّة لبنانيّة، أن يتحدث عن قصة كريستيل الشخصيّة من خلال تاريخ عائلة عمها وأبيها (من أصول سريانيّة) المقيمان في السويد ورحلة هجرتهم القديمة إلى السويد، يمزج العرض بين حياة كريستيل كعاملة في المسرح وبين ما تحمله من إرث متعلق بالهجرات. يسأل النص عن موضوع الذاكرة بينما يطرح الإخراج الأسئلة مباشرة على خشبة المسرح أمام المتفرجين: ماذا يعني القيام بالمسرح أثناء الحرب؟ كيف نستطيع تمثيل قصتنا الخاصة؟ ماذا يعني القيام بالمسرح اليوم خارج بلدنا مع استمرار الحرب في سوريا؟ وماذا يغيّر كلّ هذا في مهنة الممثل والمسرحي؟.
أي جمهور؟
التحديّ الأساسي الآخر الذي يواجه الفنانين السوريين في المنفى، خصوصًا في المسرح هو العلاقة مع الجمهور، يثير هذا التحدي الكثير من الأسئلة: ما هو النوع المسرحيّ الذي نود تقديمه؟ ما هي الرسالة التي نود إيصالها للجمهور الجديد والمجهول بالنسبة لنا؟ أيّ شكل فني سنختار؟ وبأيّ لغة يجب أن يتم تقديم العرض؟ ما هي الغاية من تقديم عروض باللغة العربيّة للجمهور الأوروبي؟ وإذا كان العرض باللغة العربيّة كيف نؤمن وصول معنى النص لهذا الجمهور؟ من الناحية التقنيّة: كيف نتعامل مع "شاشة الترجمة" التي أصبحت العنصر الأساسي من فضاء المسرح؟
المسرح السوري خلال السنوات العشر الأخيرة
24 أيار 2021
في عرضه الثالث "تحت سماء واطئة" (2019) اختار وائل علي التعاون مع الممثل شريف أندورة، وهو من أم بلجيكيّة وأب سوري. ولد أندورة وعاش كلّ حياته في أوروبا. لعب أندورة الدور الرئيسي في المسرحيّة إلى جانب الممثلة ناندا محمد، وهي ممثلة سوريّة مقيمة في مصر.
مزج علي، منذ البداية، بين اللغتين العربيّة والفرنسيّة لكتابة نصه. النص عبارة عن رحلة ذهاب وإياب بين الماضي والحاضر، هو عرض مسرحي وثائقي يعتمد على سرد متدفق وعلى نص مجزّأ. يجمع النص بين سجليّ الشخصي المتمثل بضياع الماضي والسياسي، وبين بلدين: فرنسا وسوريا.
أمّا عمر أبو سعدة ومحمد العطار فقذ اختارا طريقة أخرى للتأثير بالجمهور الأوروبي، وذلك باعتمادهم على حكاية تروي حادثة فرع مصنع "لافارج" الموجود في شمال سوريا. "لافارج" هو أحد أكبر الاستثمارات الفرنسيّة السويسريّة، والذي حظي، في الفترة الأخيرة، بتغطية إعلاميّة واسعة في أوروبا بعد العديد من الفضائح التي أثبتت تورّط هذا الفرع بعلاقة تنسيق مع تنظيم الدولة الإسلاميّة. عُرضت مسرحية "المصنع" في العام 2017، على عدّة مسارح منها مسرح "فولكسبونه" في برلين.
يناقش أبو سعدة والعطار من خلال العرض قصة افتتاح هذا المصنع عام 2010 وكيف أصرّ أصحابه وشركاؤهم في العمل من النظام السوري وغيرهم على أنّ المصنع يجب أن يستمر في العمل أثناء الأحداث في سوريا بغضّ النظر عن نتائج ذلك على العمال السوريين: في البداية كانت المنطقة تحت سيطرة جيش النظام السوري، خلال عام 2012، استولى حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي على جزء من هذه الأراضي بينما سيطر الجيش السوري الحرّ على الباقي. في نهاية عام 2013، فرضت داعش سيطرتها الكاملة على المنطقة، مع ذلك استمر المصنع في الانتاج، إلى أن أدّت حادثة تخص عمال المصنع إلى الكشف عن تفاصيل مثيرة للجدل بخصوص شبكة معقدة من المستفيدين من الحرب ورجال الأعمال القذرين.
في عام 2019، عملت مع المخرج عمر أبو سعدا والكاتب محمد العطار، على شكل آخر من أشكال إنتاج مسرحي: كجزء من برنامج "أطلس التحولات"، أنتجنا عرضًا جديدًا بعنوان "دمشق 2045"، طرح العرض أسئلة حول الذاكرة والنسيان، ولكن في إطار مستقبلي. يهتم العرض بكتابة تاريخ الحرب بناءًا على فرضيّة مستقبليّة تتبنى فكرة انتهاء الحرب لصالح النظام السوري، وتسرد حكاية العرض قصة المنتصر وقصة المهزوم، حيث يتعرض أحد التجهيزات الفنيّة في متحف في دمشق عام 2045 التي تمّ افتتاحه حديثًا لعملية تخريب غامضة. وسرعان ما يعاني سكان المدينة من كوابيس متكرّرة، تحمل صورًا من الماضي الذي تعرّض لعملية مسح كامل. يبدأ ضابط شاب بالتحقيق، ويبدأ باكتشاف حقائق شخصيّة مسحت بشكل مقصود من ذاكرته. مع انتشار التخريب خارج المتحف واستمرار الكوابيس يجد سكان دمشق أنفسهم يشككون في أسس مدينتهم حيث يبدو كلّ شيء من حولهم كذبة آيلة للانهيار.
إنّ وجودنا اليوم ضمن منظومة مختلفة ورغبتنا في تقديم عروض مسرحيّة سوريّة وتنظيم جولات لهذه العروض يتطلب منا التفكير بشكل مختلف بعمليّة الإنتاج المسرحي.
هذا العرض تمّ تنفيذه بالشراكة مع مسرح Powszechny في بولندا وقدّم بلغة البلد، بتمثيل فرقة المسرح المنتج/ المضيف، الفريق الفني والتقني أيضًا موظفين في المسرح. ما أود قوله هنا هو أنّ عدم فهم اللغة التي تمّ فيها العرض خلق بالضرورة مسافة بيننا وبين ما يقال رغم أنّ الحكاية تخصّنا وتحكي عنّا.
إنّ وجودنا اليوم ضمن منظومة مختلفة ورغبتنا في تقديم عروض مسرحيّة سوريّة وتنظيم جولات لهذه العروض يتطلب منا التفكير بشكل مختلف بعمليّة الإنتاج المسرحي. فحتى يتاح لنا تقديم عرض مسرحي اليوم، يجب أولًا جمع الفريق في مكان واحد، يتطلب هذا الأمر جهدًا إداريًا استثنائيًا للحصول على تأشيرات سفر لـ"الفنانين اللاجئين"، يتطلب أيضًا العثور على مكان للتدريبات، وتأمين فريق تقني مختلف في كلّ بلد أو على الأقل منفذين للديكور والتقنيات، قادنا كلّ هذا إلى فهم وظائف في المسرح كانت مهمّشة في سوريا بينما هي وظائف أساسيّة لا غنى عنها في الفرق المسرحيّة والمسارح الكبيرة والصغيرة في أوروبا مثل وظيفة مدير الإنتاج.
إعلان وتنظيم الجولة المسرحيّة، كان أيضًا موضوعًا هامشيًا في سوريا، بينما أصبحت ضرورة لنا اليوم لاستمرار ونجاح أي عرض.
قد تكون الخبرة التي اكتسبناها في عرض "بينما كنت أنتظر" (2015) لمحمد العطار وعمر أبو سعدا، مثالًا واضحًا على ما ذكرته سابقًا، حيث أنتج هذا العرض بتمويل وتعاون عدد من الشركاء العرب والأوروبيين أذكر منهم: مهرجان أفينيون، ومهرجان نابولي تياترو، Friche La Belle de Mai في مرسيليا، Onassis Cultural Centre في اليونان، Theatre Spektakel في زيورخ، مهرجان الخريف في باريس، ومؤسسة آفاق للثقافة والفنون، وقد عرضت المسرحيّة في هذه المدن وعدة أماكن أخرى.
ما الجديد؟
في الخاتمة أود أن أشير إلى أنّ مفهوم "الجديد" بالنسبة لي ولمعظم الشباب المسرحيين السوريين الذين انتقلوا إلى أوروبا، هو أنّنا أصبحنا تدريجيًا نتعامل مع المسرح كـ"مهنة" وأدركنا أنّنا، ورغم كلّ الصعوبات الدائمة، سنكون، يومًا ما، قادرين على كسب عيشنا من "مهنة الفن".
بالطبع، أنا لا أدّعي أنّ أوروبا هي جنة الفنانين، لكن على الأقل تملك هذه البلاد حدًا أدنى من التشريعات التي تعمل على حماية الفنان. مشكلتنا الأساسيّة كفنانين في سوريا هي انعدام الاستقرار والأمان. اليوم، أعتقد أنّ معظم الفنانين أدركوا أنّهم يملكون حقوقًا وأنّ الطريق أمامهم من أجل مواصلة الإنتاج، على أمل أن نتمكن يومًا ما من إنشاء قواعد صلبة للفن في بلدنا، سوريا.