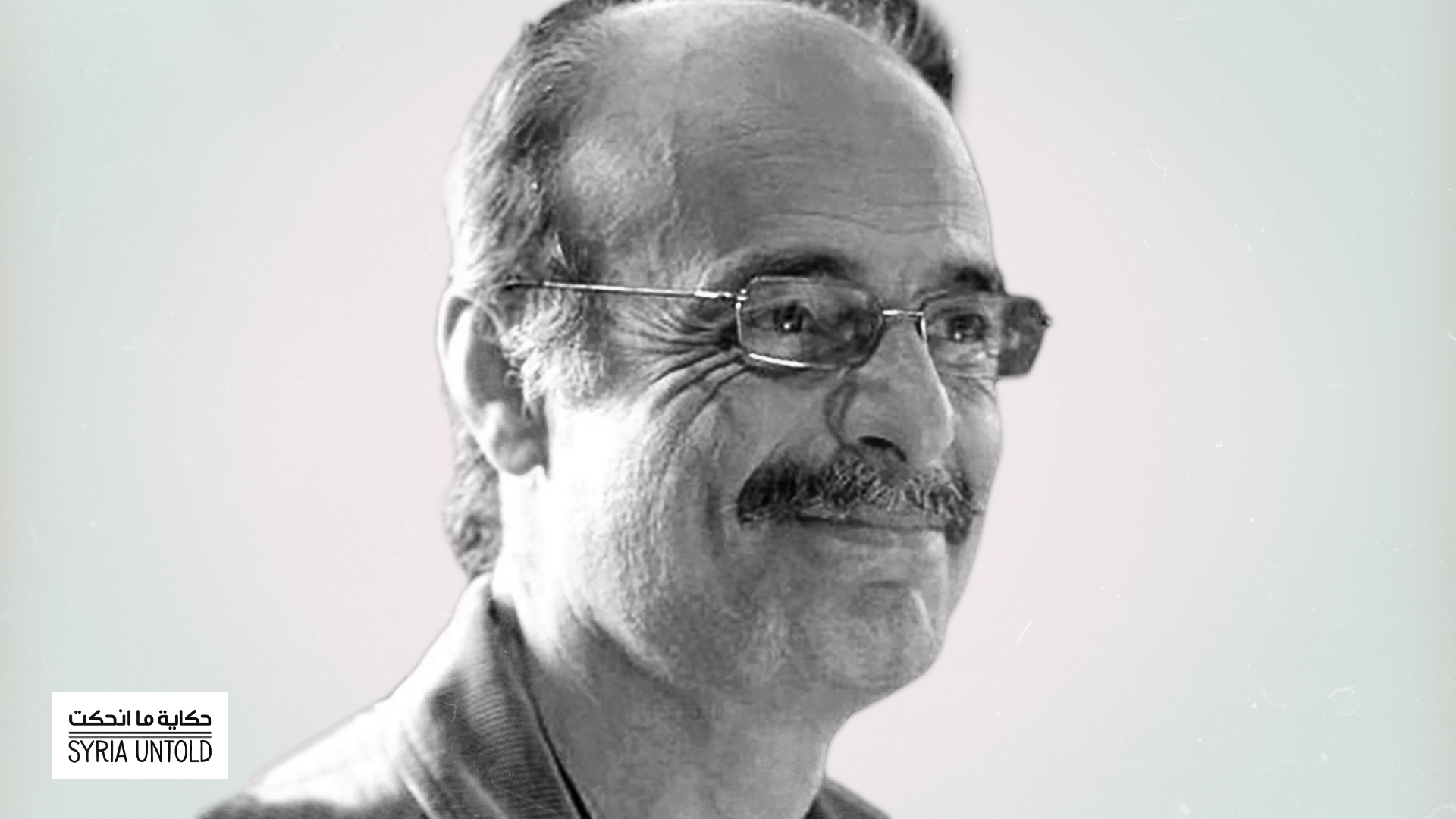تعد سؤدد كعدان من الأسماء البارزة في السينما السوريّة في السنوات الأخيرة، حصلت على جوائز عالميّة ذات قيمة عالية، كما عُرضت أفلامها في أبرز المهرجانات العربيّة والدوليّة. بدأت مسيرتها مع الفيلم الوثائقي "مدينتان وسجن" (إنتاج عام 2008) لتلحقه بفيلم "سقف دمشق وحكايات الجنة" ذو النزعة "الواقعيّة السحريّة"، حسب تعبيرها، وصولًا إلى أفلامها الدراميّة الأخيرة "يوم أضعت ظلي" و"عزيزة" وغيرها، وابتعادها عن الفيلم الوثائقي.
في هذا الحوار، تحكي سؤدد كعدان عن خياراتها السينمائيّة، الوثائقيّة والدراميّة، وعن طريقة تعاملها مع شخصيات أفلامها ومع المؤسسات الرسميّة مثل المؤسسة العامة للسينما في سوريا، وكذلك تحكي عن صعوبة حصول امرأة مخرجة على إنتاج لأفلامها، كما تحكي عن جمهور السينما السوريّة.
تقول كعدان إنّ أفلامها يُمكن أن تعتبر خطًا ثالثًا لأنّها تتجه إلى كلّ الجمهور "دون أي مساومة سياسيّة ودون أيّ أدلجة" مضيفة أنّها تخلت عن كل القوالب والهيكليات والبيروقراطيات، ولا تنتظر موافقة شخص من أجل إنتاج أفلامها.
بدأ هذا الحوار عن طريق رسائل نصيّة وصوتيّة في تطبيق مسنجر ومن ثم عبر البريد الإكترونيّ، والتحرير المشترك، حتى وصل إلى صيغته النهائيّة هذه.
يصنف معظم المتابعين السينما في سوريا بعد العام 2011 إلى نوعين: أولهما السينما المعارضة للنظام، ويغلب عليها الطابع الوثائقي وتذكر بوضوح معارضتها لنظام الحكم، النوع الثاني هو ما يُمكن تسميته "سينما النظام" وهي السينما التي تمثل بروباغندا النظام وأقواله، ويغلب عليها الطابع الروائي. في أفلامك يُمكن متابعة ما يشبه "الخط الثالث". كيف تصفين ذلك؟
لا أعرف إن كانت أفلامي تتبنى خطًا ثالثًا، ولا أعرف إن كانت هذه التصنيفات تبقى مع الزمن. لكن ما يُمكن أن أقوله عن أفلامي هو أنّني حاولت دائمًا أن تكون أفلامًا إنسانيّة، وكان دائمًا موقفي السياسي واضحًا. بدءًا من خياري مكان الحكاية: أين تحدث وما الذي يحدث. موقفي واضح وهذا يظهر جليًا في اختياري الحكايات والشخصيات التي تجتمع في هذه الحكاية. إن خيار المكان والشخصيات هو خيار سياسي، و لكن أنا لا أحاول أن أحكي خطابًا سياسيًا مباشرًا.
قد يدرك الجمهور هذا التوجه أو لا، هذا مستوى خفي في الفيلم. و لكن المستوى الأول في الفيلم، بالنسبة إليّ، هو الجانب الإنساني. إنّه همّي الأول: ما الذي يشعر به الإنسان العادي الذي عاش الحرب، بغض النظر عن موقفه السياسي.
من أجل كلّ ما سبق، نعم يُمكن أن يُعتبر هذا خطًا ثالثًا إذا أردت، لأنّني أحاول أن أصنع أفلامًا تتوجه إلى كلّ الجمهور السوري المحلي، والعالمي، دون أي مساومة سياسيّة، ودون أي أدلجة. أؤمن بأنّنا عندما تتحدث عن الإنسان بشكل بسيط، وعن ظروفه الإنسانيّة والاجتماعيّة فإنّ الجمهور يتعاطف مع الشخصيّة ومع معاناتها بغض النظر عن موقفه السياسي.
شخصياتي عادة هي شخصيات بسيطة: أم تحاول البحث عن جرّة غاز، والد يحاول أن يحافظ على بيته، وزوجين يحاولان التمسك بذكرياتهم أثناء الحرب، و مراهقة تبحث عن الحريّة والحب تحت القصف. هذه الشخصيات وهذه الحكايات تمكّن المُشاهد من أن يتعاطف معها، أينما كان.
جئتِ من السينما الوثائقيّة، أفلامك الأولى أفلام وثائقيّة، لاحقًا انتقلت إلى صيغة أخرى، وصارت أفلامك روائيّة، طويلة وقصيرة تخلّلها فيلم وثائقي (عتمة)، لماذا هذا التنقل بين الصيغ المختلفة؟ وكيف تصفين العمل على كلّ صيغة وأنت التي وصفتِ فيلم "يوم أضعتُ ظلي"، فيلمك الروائي الطويل الأول، بـ"الواقعيّة السحريّة"؟
بدأت العمل سينمائيًا في سوريا في العام 2007 وأنهيتُ فيلمي الوثائقي الأول عام 2008. في ذلك الوقت لم يكن هناك إلا طريقتان لصناعة الفيلم: إما أن تكون جزءًا من المؤسسة العامة للسينما، ومن المؤكد أنّني لن أكون كذلك، وإمّا أن تصنع فيلمًا وثائقيًا مستقلًا بميزانيّة منخفضة جدًا. لم يكن هناك فرص أخرى للتمويل، و من الصعب جدًا أن تجد تمويلًا وخاصة لفيلمك الأول.
هالة العبدالله: معياري الوحيد هو الحريّة
05 أيار 2021
بدأتُ بالسينما الوثائقيّة لأنّها كانت الطريقة الوحيدة التي استطعت من خلالها أن أصنع أفلامًا، حيث قمت بالانتاج، المونتاج، المكساج، تصحيح الألوان و تصوير الفيلم وإعداد النص لكي أستطيع تنفيذه بميزانيّة منخفضة، إذ لم تكن تكفي الميزانيّة لأحصل على فريق عمل متكامل. ومعظم الأفلام المستقلة الأولى يضطر المخرج\ة بالقيام بجميع العمليات الفنيّة لإنجاز العمل.
سببٌ آخر لاختيار الوثائقي، وبما أنّ ميزانيته منخفضة، فهنالك حريّة أكبر في صناعة الفيلم، دون ضغوطات التمويل.
شارك فيلمي الأول في مهرجانات كثيرة، توليت أيضًا في هذا الفيلم، كما في كلّ أفلامي مهمة التواصل مع المهرجانات وإرسال الفيلم. لذلك يُمكن القول أنّ الضرورة تحكمت بصناعة فيلمي الأول، لكن حلمي كان أن أصنع أفلامًا دراميّة.
هذه رغبة قديمة عندي، فأنا أحب التعامل مع الممثلين ومع كادر التصوير، و كتابة حكاية جديدة وخلق عالم جديد.
الواقعيّة السحريّة لم تبدأ معي في فيلمي الروائي الأول الطويل "يوم أضعت ظلي" بل في فيلمي الوثائقي "سقف دمشق وحكايات الجنة" حيث قمت بالمزج بين الرسوم المتحركة وبين الوثائقي. حيث تمثل الرسوم المتحركة العالم السحري للخرافات الشعبيّة للمدينة.
منذ تلك اللحظة لاحظت أنّ الواقعيّة السحريّة تتسلل إلى كلّ أفلامي، حتى لو لم أكن أنوي كتابتها وضمّها في فيلمي. كذلك في فيلمي القصير "خبز الحصار" حيث يقوم الجنود بقصف الأشجار، فيتسلل الضوء منها، لكي تتحول إلى صورة رمزيّة أخرى للحرب.
أؤمن بأنّ المخرج ليس موظفًا، ولا يستطيع أن يبدع إلّا إن تخلّى عن كلّ القوالب والهيكليات والبيروقراطيات.
في "يوم أضعت ظلي" بدأت بكتابة الفيلم بواقعيّة مطلقة: قصة واقعيّة سوريّة عن والدة تبحث عن الغاز النادر في وسط الحرب، فتسللت صورة فقدان الظلال إلى كتابتي للتعبير عن مشاعر وصور، وتراوما الفقدان التي لم تستطع، بالنسبة إليّ على الأقل، الكلمات والأحداث الواقعيّة التعبير عنها. كيف تعبّر عن فقدان بلدك، وناسك، ومشاهدة كلّ هذه الدماء؟ تشعر وكأنّك لم تعد نفسك، وكأنّك فقدت جزء منك، فقدت ظلّك. الوصول إلى الواقعيّة السحريّة يقوم على سؤال واقعي ومنطقي جدًا: كيف نعبّر عن كلّ هذا الألم؟
لماذا قلت بأنّك لن تكوني جزءًا من المؤسسة العامة للسينما، ما هي مآخذك على المؤسسة أو على العاملين فيها؟
أؤمن بأنّ المخرج ليس موظفًا، ولا يستطيع أن يبدع إلّا إن تخلّى عن كلّ القوالب والهيكليات والبيروقراطيات. عندما تملك مشروع فيلم، لا يمكنك أن تنتظر دورك، أو تنتظر الموافقة من شخص واحد. عندما تملك مشروعًا لا يمكنك أن تنام، أو أن تقوم بأي شيء آخر حتى تنجزه. تصارع بكلّ طاقتك لإنجازه، تطرق كلّ باب لتنفيذه، وتغامر بكلّ شيء. هذا الشعور وهذا الدافع، أكبر من إطار المنطق المؤسساتي.
تعاملتِ في أفلامك الروائيّة الأخيرة مع ممثلي الصف الأول في سوريا، مثل سوسن أرشيد وعبد المنعم عمايري وكاريس بشار وسامر اسماعيل وغيرهم، بينما تعاملتِ في فيلمك الوثائقي الأول "مدينتان وسجن" مع أطفال سجناء في سجن الأحداث في الحسكة ودمشق. كيف تتعاملين مع الأشخاص المختلفين في أفلامك؟ ما هي طريقتك في التواصل مع شخصياتك؟ وكيف يختلف التعامل بين الممثلين المحترفين وشخصيات الفيلم الوثائقي؟
بالتأكيد يختلف التعامل بين الممثلين وبين شخصيات الفيلم الوثائقي. فشخصيات الفيلم الوثائقي تبوح لك بالأشياء أمام الكاميرا، نحن لا نعرف الكثير عنها، نحاول أن نكتشف بعضنا أمام الكاميرا، هي علاقة تبادليّة بين الشخصيّة وبين المخرج/ة، أخذ وعطاء،و كأنْه حديث حميمي بين الشخصيّة والكاميرا. دائمًا في أفلامي الوثائقيّة أحب أن تكون الكاميرا على مستوى نظر الشخصيّة، وكأنّه حوار بين شخصين، أحب أن تكون الكاميرا قريبة حتى نستطيع الحديث مع بعضنا. أحبّ أن أسمي الفيلم الوثائقي بـ"البوح".
السينما السوريّة الجديدة: الشغف الذي فاجأ العالم
30 آذار 2021
فيلم "مدينتان وسجن"، هي تجربة جد مميزة، لأنّ الحكاية موجودة في سجن الأحداث. حاولت أن تعتمد طريقة التصوير على لقطات مقرّبة جدًا، والقليل جدًا من اللقطات العامة التي تسمح للمتفرج بالتنفس. أردتُ أن أعبر عن وضع المراهقين السجناء الموجودين في أماكن مغلقة في ظروف غير إنسانيّة. حاولت أن أعبر في هذا الفيلم، عن كيفيّة تغيّر الأشياء عند إعطائهم فرصة ما، مثل المسرح، أو أن يحكي معهم شخص ما أمام كاميرا، و من أجمل هذه اللحظات عندما نرى كيف يحدث التغيير أمام عينينا مباشرة، أمام الكاميرا. حتى شخصيتي تغيّرت بعد هذا الفيلم عمّا كنته قبله. في الفيلم الوثائقي نكتشف جانبًا إنسانيًا كان مخفيًا عنّا.
في الفيلم الدرامي، التعامل مع الممثلين مختلف، في البداية يكون السيناريو والشخصيات المكتوبة. لكن بما أنّ عملي الإخراجي يعتمد على الارتجال، فإنّ الشخصية تكبر أيضًا مع الممثل. وهذا يعتمد في النهاية على قدرات الممثل: هناك ممثلون قادرون على الارتجال وإضافة لحظات مدهشة جديدة على الشخصيّة، وقادرون على أخذ النص إلى أماكن بعيدة، حيث يتقمصون الشخصيّة، ويصبحون أكثر معرفة منّا، نحن كتّاب السيناريو، بالشخصيّة. وهنالك ممثلون، تحاول فقط أن تحصل منهم على الشخصية كما كُتبت. العمل الإخراجي مع الممثل/ة، هو نوع من الرهان و المقامرة، إذ لا تكتشف قدرات الارتجال للممثل/ة إلّا في لحظة البروفات والتصوير. عندها تحاول أن تدير الممثل اعتمادًا على قدراته. وبما أنّني عملت في كلّ فيلم مع ممثلين وممثلات لم أعمل معهم سابقًا، ولم أكرر العمل مع الممثل/ة نفسه/ا حتى الآن، كان الفيلم الدرامي في كلّ مرة، سواء كان فيلمًا قصيرًا أو طويلًا، مغامرة.
أحبُّ العمل مع الممثل/ة الأكبر من النص، الذي يصبح هو/هي الشخصيّة، ويحوّلها إلى شخصيّة وثائقيّة، بمعنى خلق إنسان جديد بلحظات بوح حميميّة أمامي وأمام الكاميرا، أحبّ أن أكتشف فجأة شيئًا جديدًا معه\ا أمام الكاميرا. فأنا لا أحب تنميط الممثل/ة بدور محدد، و لا أطلب منه/ا فقط التنفيذ. عملي الاخراجي يعتمد على الشراكة مع الممثل، نحن معًا في هذا الفيلم، ونحاول أن نتجاوز قدراتنا ومعارفنا المسبقة.
لا يخفى على أي متابع، بأنّ عدد النساء قليل جدًا مقارنة بعدد الرجال في الحقل السينمائي، ولا سيما في موقع الإخراج، كيف تتغلبين على هذه المصاعب؟
من الصعب أن تكون مخرجة، وخاصة في البلاد العربيّة، وربما كان هذا السبب في أن أكون منتجة كلّ أفلامي. لم يكن هناك من قبل منتجين في سوريا يطلبون من امرأة مخرجة أن تُخرج أفلامًا ينتجونها، إن كانت وثائقيّة أو دراميّة، وحتى في المسلسلات التلفزيونيّة، دائمًا ما يكون الخيار الأول رجلًا. فكان خياري هو أن أكون منتجة أفلامي، بالشراكة مع أختي أميرة كعدان. شريكتي التي دعمتني و آمنت بي، حتى استطعت انجاز أفلامي بأكثر الظروف صعوبة.
أردتُ أن أعبر عن وضع المراهقين السجناء الموجودين في أماكن مغلقة في ظروف غير إنسانيّة. حاولت أن أعبر في هذا الفيلم، عن كيفيّة تغيّر الأشياء عند إعطائهم فرصة ما، مثل المسرح.
معظم المخرجات الموجودات حاليًا في العالم العربي يحصلن على تمويل وإنتاج لأفلامهن من أوروبا. قليلٌ جدًا التمويل العربي لمخرجات، ربما باستثناء لبنان الأكثر انفتاحًا، حيث توجد حقوق متساويّة بين المرأة والرجل، على صعيد الإخراج، وبالتأكيد ليس على الصعيد المجتمعي والحقوق المدنيّة. و لكن في النهاية المنح والتمويل في المنطقة العربيّة قليلة جدًا، وشحيحة، لعدم وجود مؤسسات تدعم السينما المحليّة، فنضطر أن نأخذ أفلامنا و ندور فيها على الأسواق العالميّة، وعلى الممولين العالميين لإنجازها. و بما أن حكاياتنا نابعة من واقعنا فضرورة وحاجة سرد الحكاية، وجمهورها مختلف، ممّا يجعل المهمة أصعب بكثير، سواءًا أكنت مخرجًا أو مخرجة.
ربما كنت المخرجة السوريّة الوحيدة التي تُعرض أفلامها على منصة عالميّة مثل نتفلكس؟ كيف وصلت إلى هذا الموضع؟ وكيف استقبلتِ الأمر؟
لا أعتقد بأنّني المخرجة السوريّة الوحيدة التي عُرضت أفلامها على نتفلكس، أظن أن أفلامًا لمخرجات أُخريات عُرضت هناك، لكنها غير موجودة الآن لأنّ المنصة تغيّر وتحذف وتضيف الأفلام بين فينة وأخرى. ربما في الوقت الحالي لا توجد سوى أفلامي.
في الحقيقة أنا سعيدة جدًا بهذا الأمر، لأنّ هذه الأفلام عُرضت في مهرجانات عديدة وكثيرة وشُوهدت في سياقات مختلفة، فالأفضل أن تتاح الآن لجمهور أكبر.
السينما السورية الجديدة.. شابة تلتقط أنفاسها (5)
14 كانون الثاني 2020
ما لم أنتبه له قبلًا هو أنّ الأفلام التي صنعتها حتى الآن تندرج تحت بند "سينما المؤلف"، وجمهور هذا النمط من الأفلام محدود أكثر. عندما عُرضت أفلامي في نتفلكس صار هناك جمهور أوسع، فهناك أشياء مثلًا لم أكن أعرف أنّها ستزعج جمهورًا أكبر. منها مثلًا وصلتني الكثير من الرسائل عن أناس تأثروا برؤية حكاية سوريّة على منصة عالميّة، لكن في المقابل فإنّ لغة الأفلام لم تحكِ الحكاية بشكل مباشر، مما أشعرني بأنّ هذه الأشياء يُمكن أن تزعج الجمهور الأكبر الذي يبحث عن حكاية بسيطة تقليديّة، يغلب عليها طابع التشويق.
كذلك الأمر مع الشتائم في الأفلام، في "يوم أضعت ظلي" كان السيناريو يحاول أن يجعل لغة الشخصيات تشبه لغة الواقع السوري فكان هناك بعض الشتائم، لم أنتبه هنا إلى أنّ الجمهور الأوسع قد ينزعج من هذه الشتائم، وهكذا يُمكن أن يخسر الفيلم جمهوره بسبب كلمة.
أنا حقًا لا أعرف إنّ كنت سألغي الشتائم من أفلامي كرقابة ذاتيّة، حيث أشعر بأنّ هذا الجمهور كان يُمكن أن يشاهد الفيلم بشكل آخر لو لم تكن هذه الشتائم موجودة، و لكن في المقابل يخسر الفيلم الكثير من واقعيته بدونها. لكن هنا السؤال الأكبر: هل نفرض على أنفسنا رقابة ذاتيّة إضافيّة للرقابات الحكوميّة من أجل جمهور أوسع؟
فهل نملك الحريّة لقول الحكاية التي نريدها بالطريقة التي نريدها؟ في أيّ فيلم نحاول أن نصل إلى جمهور أكبر وفي أيّ فيلم نحاول أن ننقل الواقع كما هو، أو نجدّد و نكسر الشكل التقليدي للحوار؟
بالنسبة إليّ، قد لا تكون بعض أفلامي سينما جماهيريّة أو سينما "شباك تذاكر"، و لكنني صرت أكثر خبرة الآن بمعرفة من الجمهور الذي سيتلقى فيلمي، ومتى أجعل فيلمي متاحًا أكثر للجمهور الأوسع، ومتى يكون فيلم تذاكر، ومتى اختار أن أتوجه إلى جمهور أضيق.
يصنع السينمائيون والسينمائيات السوريون أفلامهم بشكل عام خارج سوريا، وتعرض الأفلام خارج سوريا بشكل رئيسي، وجمهور هذه الأفلام هو جمهور غير سوري في معظم الحالات. ربما تتيح منصات مثل نتفلكس حلًا في الوقت الحالي، لكن كمخرجة سينمائيّة فقدتِ، مثلما فقد معظم العاملين في الحقل الثقافي، جمهورك الأساسي ومكانك الأساسي. كيف تتعاملين مع هذا الأمر؟
من الصعب أن تكون سوريًا/ة وأن تصنع أفلامًا وأن تحكي الحكاية لجمهورك المحلي بدون أن تكون لك فرصة عرض الفيلم أمام جمهور واحد في بلدك. فالسوريون في كلّ أنحاء العالم الآن، والجمهور لم يعد جمهورًا واحدًا. ولكن في الوقت ذاته، هذه الصعوبة ليست نتيجة الحرب فقط، فنحن لا نملك الفرصة لعرض أفلامنا في معظم الحالات في البلاد العربيّة، ولا نملك حتى إنتاجًا عربيًا، أو عدد كبير من السينمات في العالم العربي التي تهتم بعرض أفلامنا، إن لم تكن أفلام تجاريّة جدًا. الأمر يزداد صعوبة يومًا بعد يوم، في العالم.
هذه إشكاليتنا الدائمة: كيف نحكي الحكاية ونصنع الفيلم ونحن لا نملك المال للإنتاج ولا نملك أماكن لعرض هذه الأفلام في وطننا أو في البلاد العربيّة؟ هناك دائمًا محاولات بأنّ نأخذ تمويلًا أجنبيًا وأن نصنع حكاياتنا، و نحاول أن نوصل الحكاية إلى جمهور محلي، وجمهور عالمي أيضًا. أحيانًا ننجح وأحيانًا أخرى لا ننجح. الإيجابي في هذا الأمر بأن محاولتنا للوصول إلى الجمهورين، تدفعنا إلى لغة سينمائيّة أكثر عالميّة، لكن السلبي هي أنّنا نحكي حكايات قد لا يفهمها غير جمهورنا المحلي، مثل النكتة، والمفارقات اللغويّة. مؤخرًا بدأت اؤمن بأنّه كلما كانت القصة مغرقة بالمحليّة، تصبح فجأة عالميّة أكثر. مفارقة غريبة، لكنها مفارقة، وهذا هو سحر السينما.