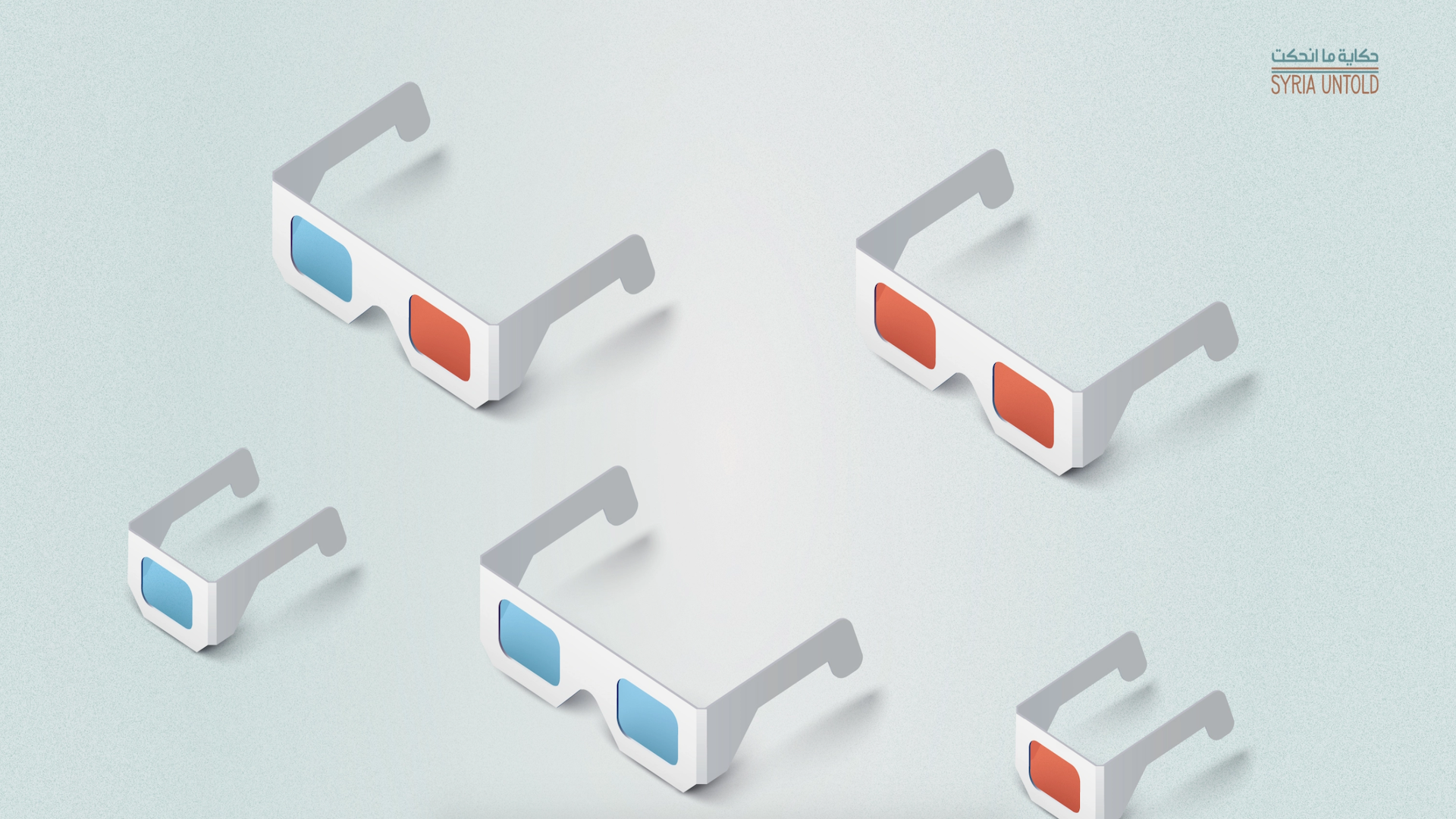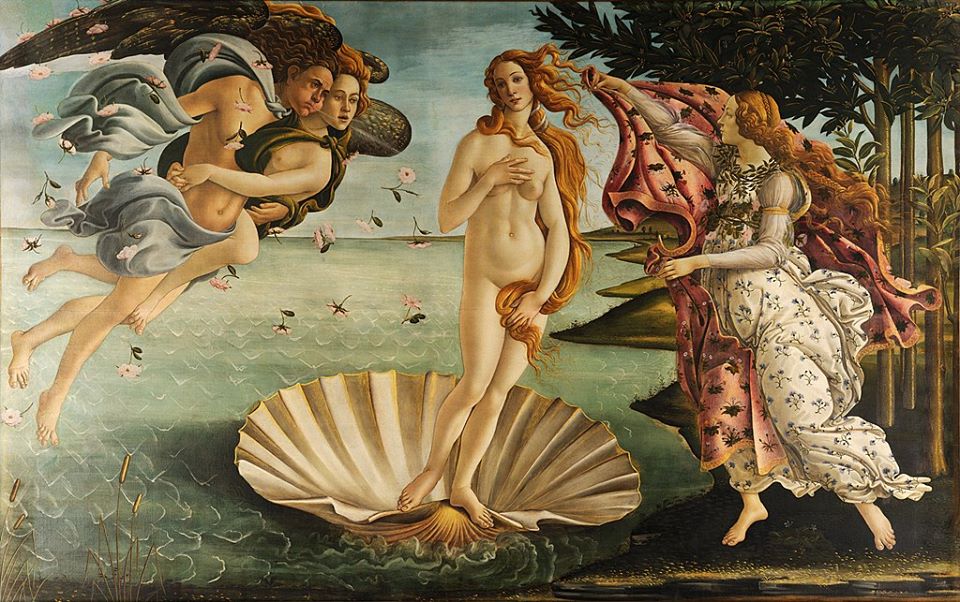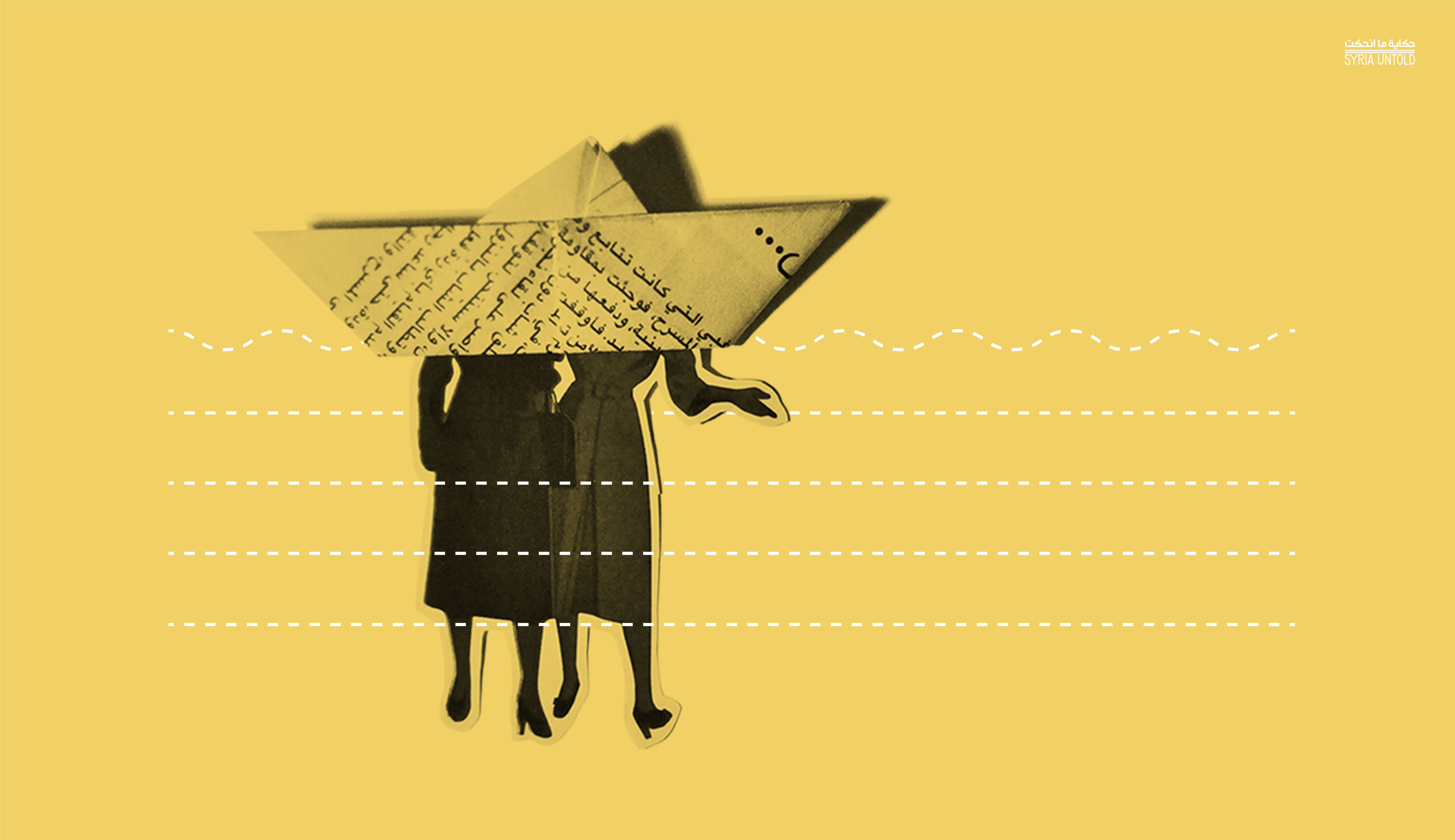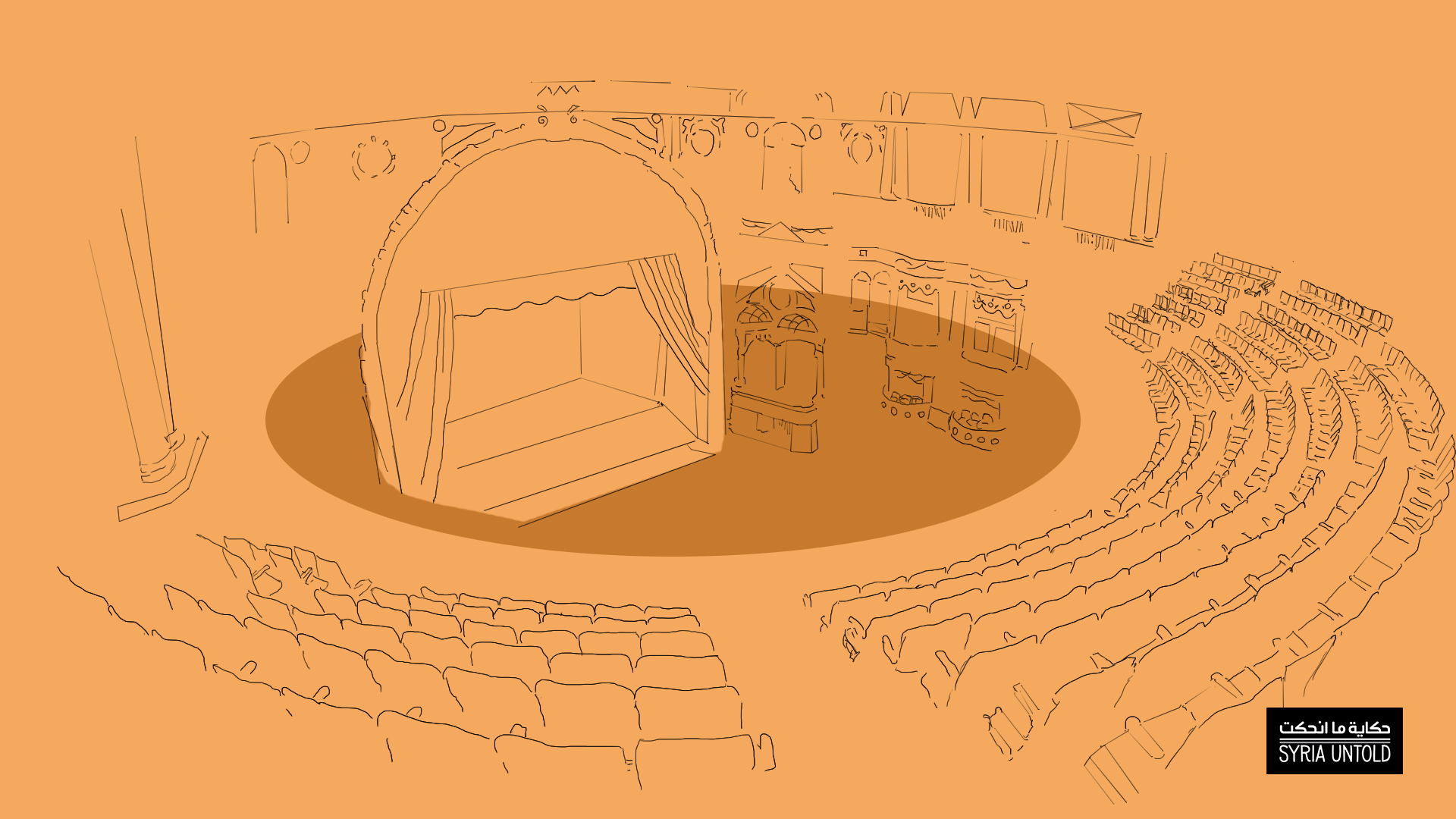حين وصلت برلين للمرة الأولى، قال لي أحد السوريين ممن سبقوني في رحلة المنفى: "أنا أسكن في وسط البلد، بنص برلين". بعد مدة، سأنتبه إلى تكرار العبارة على ألسنة سوريين كثر، وسأنتبه أيضًا أنّ أغلبهم لا يسكن وسط البلد بالمعنى الذي يعنيه، الأمر الذي أثار وعيي مبكرًا لالتقاط وتأمّل تلك العبارات التي يطلقها وعيهم/ن فيما هي تعبّر في اللاوعي عن أشياء أخرى، مكبوتة، مخفيّة.
"أنا أسكن وسط البلد، بنص الشام"، تلك عبارة كان يقولها السوريون/ات لبعضهم/ن البعض حين كانوا/ن يعيشون/ن في سوريا، للدلالة على طبقة اجتماعيّة معينة، فأن تسكن في "وسط البلد"، فهذا يعني أنّك تسكن/ين في باب توما أو القصّاع أو الصالحيّة أو المزة فيلات أو... بما يعني أيضًا أنّك تنتمي/ن إلى طبقة اجتماعيّة ميسورة حتى لو لم يكن الأمر كذلك حقًا، المهم أنّها في المخيال الشعبي كذلك. وإن كنت تسكن/ين في أبو رمانة فأنت "حتمًا" من طبقة الأغنياء، أمّا إذا كنت تسكن/ين في حيّ تشرين أو القابون أو عش الورور أو عين ترما أو أيّ منطقة من مناطق العشوائيّات أو الضواحي البعيدة (كحال صاحب هذه السطور)، فأنت تنتمي/ن إلى طبقة فقيرة ومهمّشة. وهكذا كلّما انتقلت من مسكن إلى آخر تتحدّد طبقتك ومكانتك في نظر نفسك ونظر الآخرين/ات، وفقًا للمكان الذي يكون فيه هذا المسكن الذي لم يُشر يومًا في سوريا إلى مكان سكن وبيت وعائلة تنتمي/ن لها وتعيش/ين معها فحسب، بل هو أيضًا يحيل إلى طبقة ومكانة ما، تتحدّد من خلالها مكانتك في المجتمع وكيفيّة نظر الناس إليك وتعاملهم معك.
في أحوال "منفانا"
25 حزيران 2021
أعتقد أن شيئًا من هذا يحدث في كلّ مكان في العالم، وفي برلين أيضًا، إذ تفاجأت أنا وشريكتي في الحياة بعد سكننا في منطقة "شارلتون بورغ/ Charlottenburg" أنّ البعض يفتح فمه فاغرًا: "أوه... تسكنون في شارلتونبورغ"، ففي أذهان بعض الألمان/ات، أنّ هذه منطقة سكن الأغنياء والميسورين/ات ماديًا، علمًا بأنّ أغلب سكان/ات الحيّ الجميل الذي أعيش به صامدون/ات فيه بسبب إيجارات بيوتهم/نّ الرخيصة كونهم مستأجرين/ات قدامى. بعد فترة سنعرف أنّ ثمّة قسم من الحيّ يسكنه الأغنياء فعلًا، إلى جانب قسم آخر من أصحاب/ات الطبقة المتوسطة والدخل المحدود أيضًا. ولكن هذا الواقع، لم يغيّر من سمعة الحيّ في مخيال ووعي الناس، فـ"صيت غنى ولا صيت فقر".
أعتقد أنّ المنفيين والمنفيات منّا حين يصرّون على عبارة "أنا أسكن بنص برلين" يبحثون/ن عن مكانة ما، تعويضًا لما فقدوه/نّ، ومحاولة لإثبات الذات للأخر، تعويضًا عن نقص يشعرون/نّ به في دواخلهم/نّ، نقص لا تعبّر عنه هذه العبارة وحدها، بل تحيل إليها عبارات كثيرة تمر في سياق كلامهم/ن، يقولونها/ن بثقة وتكرار، دون أن يفطنوا/نّ إلى معانيها العميقة التي تحيل إلى أزماتهم/ن واغترابهم/ن ولا ثباتهم/ن في المكان.
لم يُشر موقع البيت ومكانه يومًا في سوريا إلى مكان سكن وبيت وعائلة تنتمي/ن لها وتعيش/ين معها فحسب، بل هو أيضًا يحيل إلى طبقة ومكانة ما، تتحدّد من خلالها مكانتك في المجتمع وكيفيّة نظر الناس إليك وتعاملهم معك.
"أنا هي الفترة ما عم شوف غير ألمان/يات أو أجانب/يات"، واحدة من العبارات التي تتكرّر، وأسمعها من سوريين/ات كثر/ات حين أسألهم/ن "مين عم تشوف/ي هي الأيام؟". وحين نفكر في معنى ومبنى العبارة وما تحيل إليه، نشعر بحجم الاغتراب وحاجة هؤلاء/ أولات للشعور بالثقة والأمان وتعزيز الذات. من الطبيعي أن نجيب حين يسألنا أحد/هن ما: "مين عم تشوف/ي هذه الأيام؟" أن نقول له/ها: "رأيت فلان/ة وحكيت مع فلان/ة"، أمّا أن نجيبه بإطلاق: "والله أنا ما عم شوف غير ألمان أو أجانب"، فهي عبارة تشي بمحاولة صاحبها أو صاحبتها في وضع أنفسهم في مكان مختلف عن أقرانهم/ن ورفاقهم/ن وأهل بلده/ا، خاصة حين تتكرّر في الجلسة الواحدة أكثر من مرة، وخارج سياق الحديث المعني.
أمّا لماذا هم/ن بحاجة إلى هذا الشعور: فجوابه، ربما، عند فرويد وأتباعه. ثمّة حاجة هنا لتعزيز إثبات الذات في الاندماج في المجتمع الجديد وربما التعالي على المجتمع الذي جاؤوا منه. وهذا ما يتكرّر في محاولة المعنيّ/ة هنا، إثبات "تفوقه/ا"، من خلال تعمّده/ا رمي كلمات معينة أو تصرّف تصرفات معينة تشير إلى "مكانته/ا" و"موقعه/ا" الجديد"، في محاولة لإثبات التفوق والتغلب، على طريقته/ا، بشعوره/ا بالاغتراب والضياع وعدم الشعور بالأمان في مكانه/ا الجديد، وهي أمور لا تلبث أن تدل عليها كلمات أخرى وعبارات تشير إلى حجم التناقضات والصراعات التي تفعل فعلها في لاوعي المنفيين.
بين "صرنا ألمان" و"السوريون الألمان"
حين يلتقي اثنان/تان بعد انقطاع طويل، يبادر/ تبادر أحدهما/هن الأخر/ى بالقول: "منذ كم لم نلتقي؟ والله صرنا ألمان/نيات بدون ما نعرف" (وهذا ما يقوله صاحب هذه السطور أيضًا)، في إشارة إلى فكرة مستقرة في لاوعي السوريين/ات والمنفيين/ات عن كون الألمان/ات يعطون/ين مواعيد بعد ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر، وفيها إشارة أيضًا، ربما، إلى البيروقراطيّة الألمانيّة ثقيلة الظل. العبارة (والله صرنا ألمان) لا تعني هنا الاندماج بقدر ما تعني السخرية من هذا الوضع الذي لا يتيح للأصدقاء الالتقاء بشكل طبيعي وبلا مواعيد مسبقة، مثلما كانوا يفعلون/ن في سوريا، حين كان يكفي أن يرن/ترن صديق/ة ما جرس بيتك دون موعد مسبق ثمّ يدخل/تدخل (لم يكن بإمكاننا رفض دعوته/ا للدخول إلّا إذا كنّا قليلي أدب وفق العادات المتبعة هناك)، وإذا أراد/ت أن يكون/تكون مؤدبًا/ة فقد يتصل/تتصل قبل مجيئه/ا ليقول/تقول "يلا جاي لعندك مسافة الطريق" أو "لاقيلي على القهوة بعد نصف ساعة" ليتم الموعد.
جمهور السينما السوريّة في ألمانيا والقيود الإنتاجيّة المفروضة (6)
21 كانون الثاني 2020
هذا النوع من الحميميّة والأريحيّة في اللقاءات، يفتقده السوريون/ات بنوع من النوستالجيا المرضيّة التي لا تعرف معها على وجه الدقة ماذا يريدون/ن حقًا/ ماذا نريد حقًا؟
مثلًا، ما إن يجلس الأصدقاء والصديقات ويبدؤون التحدث، حتى تصبح الفوارق بين الحياة في ألمانيا وسوريا محور أحاديثهم/ن، وسرعان ما تتم السخريّة من قبل البعض (ومنهم الشخص الذي قال بسخريّة منذ قليل "والله صرنا ألمان") عن "عاداتنا" في سوريا، ومنها بالذات عدم احترام المواعيد وقيام أقاربك أو أصدقائك بزيارتك دون موعد، ثم بعد دقائق يتم الانتقال إلى السخريّة من نموذج/ نظام الحياة الألمانيّة الذي أخدنا في دهاليزه وجعلنا ألمان دون إرادتنا، ثم يعود/تعود بعد دقائق ويؤكد لك أنّه/ا لا يرى/ترى "غير الألمان" هذه الأيام.
حين العودة إلى المنزل، أحاول حلّ شبكة الألغاز هذه وتفسيرها، لا بهدف محاكمة صاحبها، بقدر ما هي محاولة لفهمها وفهم نفسي وتحولاتي أيضًا في هذا السياق، فأتأمل نفسي وأحاول فهم ما أصبحت عليه حقًا، متسائلًا: هل هي أعراض المنفى الذي لا أعترف به أساسًا؟ هل أحمل شيئًا من هذه التناقضات؟ هل هي أمور صحيّة وطبيعيّة أم أنها تشير إلى أزمة تعبّر عن اغترابنا في مكاننا الجديد؟ بحيث نبقى عالقين/ات في اللامكان، فلا نحن هنا حقًا، ولا نحن هناك، حيث جذورنا التي نسعى جاهدين لإيجاد صيغة مرضية للتعامل معها، دون أن نفهم حقًا: ماذا نريد من تلك الجذور وكيف نتعامل معها؟
فجأة، وخلال حديث ما، تجدنا نتحدث عن ضرورة التمسك بالهويّة والجذور وتعليم الأطفال لغة آبائهم وأمهاتهم...، ثم ننتقل للحديث بشغف وحماس لا يخلو من تعالٍ على من حولنا: والله بعد سنة بيحقلي قدّم على الجنسيّة.. إي خلص معي إقامة دائمة....
نحاول أن نفهم كيف يمكن إيجاد خط يربط بين الأمرين؟ وما إن نكاد نلمس ملامح خيط واه يبرّر لنا هذه التناقضات، حتى ننسف كلّ شيء، حين نقول: "والله بس أخذ الجنسيّة لأحمل حالي وفل من هي البلد، هي بلد بينعاش فيها؟"، وحين يُسأل هذا السؤال: هل ستعود/ين إلى سوريا؟ يكون الجواب: "حتمًا لا، سأختار بلدًا أخرى، فيها حياة.. فيها شمس...". نحاول حلّ كرة الصوف المتشابكة هذه: كيف يمكن لنا التشبث بجذورنا والتباهي بأخذنا الجنسيّة تحيّنًا للهرب إلى مكان ثالث؟
يأتيني اتصال صديقي عمر من باريس مرساة نجاة من عصف الأسئلة، ولكن قبل أن أحكي أية كلمة، يقول لي: "كيفك يا ألماني؟"، وحين أفكر بالعبارة وأتأخر بالرد عليه، يصيح:
-وين رحت؟
- كنت أفكر بقولك "يا ألماني" أيها "الفرنساوي".
- أي ما أنتو العلويّة بالأصل كلكم ألمان. هههه.
أنتبه للمعنى الثاني لعبارة "الألماني" هنا، حيث اعتدنا أنا وصديقي عمر (كلانا ملحدان)، السخريّة من جذورنا الطائفيّة على طريقتنا مذ كنّا في دمشق. حينها كان يقول لي دائما وبسخريّة "أنتم الألمان". في البدء لم أكن أفهم ما الذي يعنيه بالضبط ومن يعني بالألمان، إلى أن سألته بعد عدّة مرات وقال لي: ألا تعرف؟ بعض السوريين يشيرون إلى العلويين بالقول إنّهم ألمان، فإذا أراد اثنان الحديث عن شخص ثالث أو تنبيهه إلى وجود شخص غريب (علوي) في الجلسة، يبادره للقول إنّه "ألماني"، فيأخذ حذره في الكلام، وهي حيلة تعتمدها كلّ الطوائف مع بعضها البعض في سوريا (وقد تمّ الحديث عن هذه المسألة في ملف خاص عن الثقافة الشفويّة في سوريا).
هذا الأمر، يحيلنا مباشرة إلى حديث السوريين في ألمانيا والغرب عمومًا، عن العنصريّة التي يتعرّضون لها بسبب لون بشرتهم أو أديانهم، إذ نادرًا ما خلا حديث من هذا الموضوع، في حين لا يتطرق معظمهم/ن أبدًا إلى العنصريّة الممارسة فيما بينهم، والنظرات المسبقة التي لا تزال تحكم وعينا تجاه بعضنا البعض، فمعظم هؤلاء المشتكون والمشتكيات من العنصريّة الممارسة نحوهم، يعبّرون "بحرية" عن اشمئزازهم من المثليّة الجنسيّة ويرفضون زواج الطوائف والقوميات من بعضها البعض، ويصنّفون البشر وفقًا لوضعهم المادي وطوائفهم ومواقفهم السياسيّة، ويمارسون عنصريتهم على من يرونهم أدنى منهم في السلم البشري، خاصة أصحاب البشرة السوداء، بما يشير إلى تناقضات غريبة، وهذا من بعض مشاهداتي ولا تعميم في ذلك.
"في أقل من نصف ثانية"
بعض حججنا وتكتيكاتنا ضد المثليين والمعادين لهم
21 شباط 2019
يُمكن اكتشاف هذه التناقضات والمواقف الكاشفة في تفاصيل صغيرة تحدث في أقل من نصف ثانية في الحياة اليوميّة (ليس لدينا نحن السوريون فقط، بل أيضًا لدى الألمان وكلّ الشعوب الأخرى). مثلًا، كثيرًا ما أكون في الشارع، وأرى أمامي اثنان/اثنتين مثليي/مثليّتي الجنس يمسكان/تمسكان بأيدي بعضهما البعض بحب، حينها أتركهما لشؤون حبهما وأنتبه قدر الإمكان لمن حولهما، ما ألاحظه هو أنّ غالبية الناس يُظهرون الودّ في وجوههم ولكن ما إن يعبروهم حتى تظهر على معالم وجوههم وبأقل من نصف ثانية، الموقف الحقيقي الذي يحكم جوانياتهم تجاه مسألة المثليّة الجنسيّة أو أيّة مسألة أخرى، فمن يرفضهم/ترفضهم، يُظهر/تُظهر الاشمئزاز على ملامحه/ا بوضوح مع هزة رأس متأسفة، ومن يتصالح/تتصالح مع الأمر، يبقى وجهه/ا كما هو مع ابتسامة خفيفة تعبّر عن الرضى أو القبول.
في قطار الأنفاق، أقوم أيضًا بمراقبة وجوه الناس وردود أفعالهم (ومن راقب الناس مات همًا! كما يقول مثلنا العربي)، لأنّني توصلت إلى قناعة تقول إنّ ردود الفعل الفطريّة والأولويّة تعكس المواقف الحقيقيّة للبشر تجاه أيّة قضية.
مثلًا، ومما ألاحظه في الحياة اليوميّة، وهو أمر يحصل في أقل من نصف ثانية أيضًا، أنّه حين يصطدم شخصان ببعضهما دون قصد، يبادر/تبادر أحدهما بالقول "المعذرة/ entschuldigung" ثم ينظر/تنظر إلى وجه من صدمه. هذه النظرة التي لا تكاد تستغرق نصف ثانية، تكشف الموقف الحقيقي ونظرة المعتذر/ة. مثلًا إذا كان المعتذر/ة أجنبيًا/ة، ثم انتبه/ت أن من اعتذر/ت له هو أجنبي/ة مثله/ا، يشيح/تشيح بوجهه/ا سريعًا، وكأنه/ا يتحسّر/تتحسر على الاعتذار، في حين تكون النظرة مختلفة كليًا، في حال كان المُعتذر منه/ا ألمانيًا/ة أو أبيض/بيضاء البشرة، فأولئك يستحقون الاعتذار، أمّا من يشبههم/ن بلون البشرة فلا. الأمر نفسه يحصل، حين يكون/تكون المعتذر/ة أبيض/بيضاء البشرة، فحين ينتبه/تنتبه إلى أنّ المُعتذر منه/ا أجنبي/ة يشيح/تشيح بوجهها سريعًا، في حين تكون النظرة مختلفة كليًا، حال كان المُعتذر منه/ا ألمانيًا/ة أو أبيض/بيضاء اللون.
يجب محاربة العنصرية في الاتجاهين، مواجهة النظرات النمطيّة والمُسبقة التي نتعرّض لها وأيضًا تكسير وتغيير نظراتنا النمطيّة والمُسبقة تجاه أنفسنا والآخرين
هل الجميع هكذا؟ حتمًا لا، فأكيد هناك استثناءات، ولكن يبدو لي أيضا، ومن خلال مشاهداتي، أنّ هذه الاستثناءات قليلة قياسًا للحالات الأخرى، وهي الأقليّة التي علينا أن نعمل على توسيعها، علّنا نصل عالمًا أقل قبحًا وعنصريّة وهيمنة للنظرات النمطيّة والمُسبقة عن الآخرين.
أمّا عن تناقضات المنفيين والمنفيات اللاجئين واللاجئات التي تحدثت عنها/هن في هذه المادة، مكتفيًا بالإشارة إلى الملاحظات والمشاهدات والتناقضات التي بدت لصاحب هذه السطور، فإنّها تأمل أن تكون مقدّمة للتأمل في أزمات المنفى واللجوء والهويّة والاغتراب وعدم الثبات في المكان. وإذا كانت هذه المادة تشير إلى العنصريّة والتمزقات والاغتراب الذين يتعرّض/ تتعرض له المنفيون والمنفيات واللاجئون واللاجئات، فإنّها تشير أيضًا إلى العنصريّة والنظرات المُسبقة التي يحملونها هم أيضًا تجاه الآخرين، الأمر الذي يحتّم ضرورة العمل في الاتجاهين، مواجهة النظرات النمطيّة والمُسبقة التي نتعرّض لها وأيضًا تكسير وتغيير نظراتنا النمطيّة والمُسبقة تجاه أنفسنا والآخرين. وهذا، بالمناسبة، أصعب من مواجهة العنصريّة في دولة لها قوانين واضحة في مواجهة العنصريّة، فهل نفعل؟