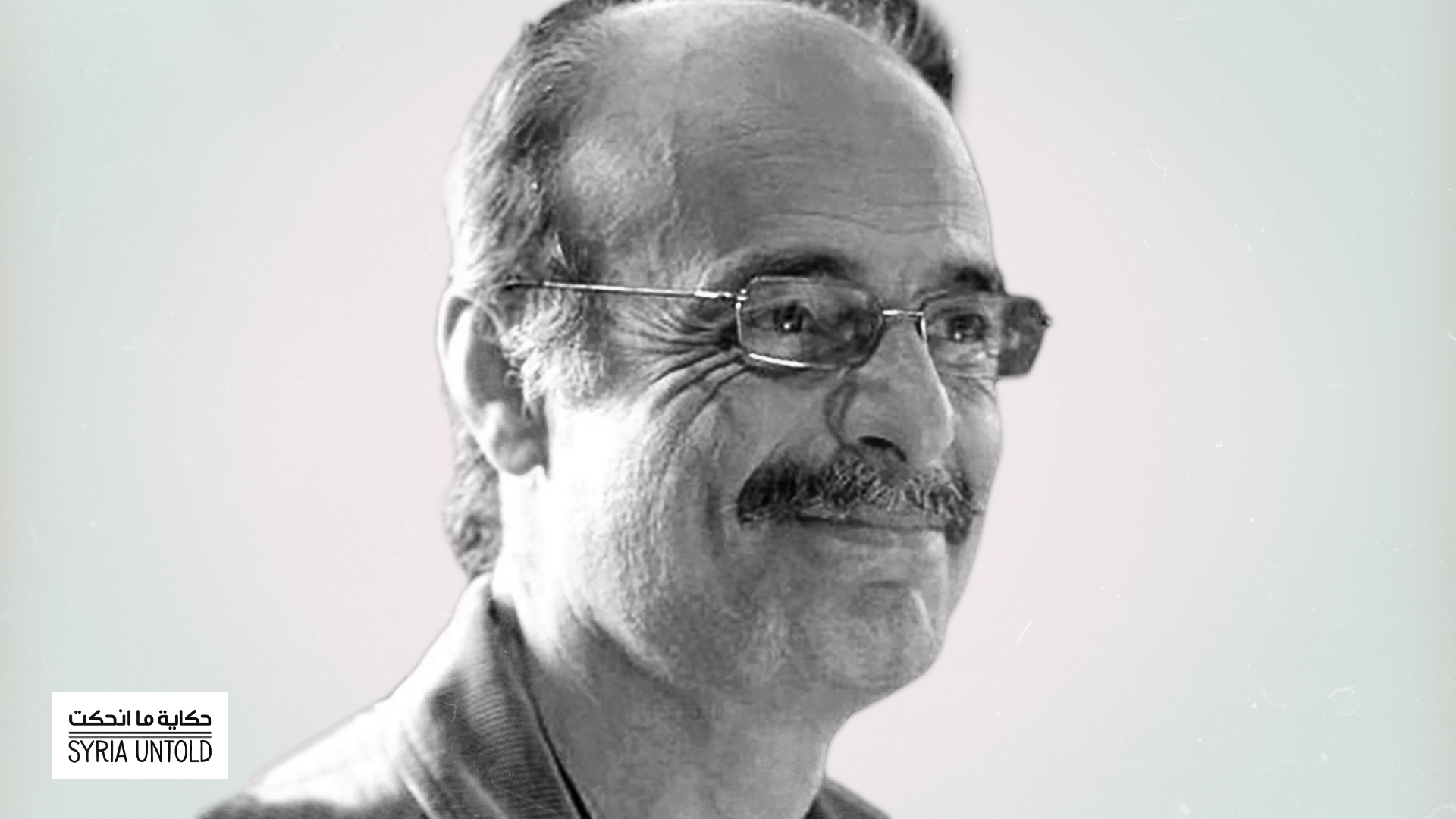جميع أفلامي من إنتاجي وتمويلي الشخصي...
أقترح أن تبدأ تسجيل هالـzoom مُباشرةً، زووم غار حلبي... إياس المُخرج السينمائي والمخرج المُحفّز لكلامي، صديقي راقص سوريا المُعاصر والحُر، الذي سَلمتهُ صَوتي وصُورتي في نيسان الماضي (2022). وبالطبع لإيمان كبير بفحوى صداقتنا، وبهذه اللحظة، أُضيف هذه الكلمات المحشورة حُبّاً، بعد أن أرسلت لي النص لأُعاين أجوبتي التي سبقها رغبة لقائنا والحديث آنذاك لصالح حكاية ما انحكت، للإفصاح عن حكاية لم يَسبق أن حُكيت مُتداخلة ومُتشعبة، أنت من ساعدني وشجعني لحِكايتها لك، فكانت الحَماسة لحظة اللقاء أسبق أحياناً من دراية الاهتمام بتكوين أجوبة موزونة 99% ومُنمّقة، قلباً وقالباً… شُكراً لكرم الثقة، منحتني فرصة إعادة القراءة والتدقيق، بالطبع تدقيق أجوبتي المحكية التي طالت في أحيان، فالبوح لكَ كان منبعهُ تفاعل الأرواح، لا مانع من وضع بِضع نُقاط على الحُروف، هذه هي رغبة تجميل وهندسة المكتوب وإظهاره في أجمل حُلّة، فِسحر الحروف والكلمات، مثيلْ لامثيلَ لهُ، وحتى تحريك ومُباعدة الفواصل غير المنقوطة أثناء كتابة النُسخة الصالحة للنشر، وبالطبع لا غنى عن حديث العيون والصوت المُباشرين عبر zoom، وأريد أن أُضيف أنّ حرصي بالحفاظ على تفريغك وبنائك لحكاية وسردية الحديث، كان من أولى أولوياتي، متجاوزين في أحيان كثيرة قواعد اللغُة العربية، فالمحكي لهُ عميقُ نبض أيضاً، ولا تنسى دائماً أنّ فيلمك عن الأم والابنة والصور والذكريات، علّمني وأضاف لي الكثير، فيلم تأسيسي ومرحلي لسينما (سوريّة) ذات شخصية ناضجة، شخصية سينما حداثية، وهي وليدة لثورة فكرية شغل البلد، حقيقية مجبُولة بالحُب ودماء الشُهداء والصبر والإيمان بالقادم الأجمل، آمال ستتحقق تِباعاً، ومن قلب خزانك الحسيّ، ستَرشح أفلام تُعبّر عنا وتعبُر بنا بعيداً، بعيداً، وبتؤدة!
شُكراً أُيها الدمشقي الحوراني البروكسلي، وعَود على بدء، عودة لبداية الفضفضة...
لقد بدأت التسجيل فعلاً…
هل تعلم لماذا يا صديقي طلبت تسجيل حوارنا السمع-بصري؟ إنّ واحداً من أهم الأشياء في الحياة أن يكون لديك أرشيف تعود إليه، لترى أين كُنت، وأين أصبحت، لاستقراء الغد، فالأرشيف أمر شديد الأهمية، إن لم يكن الشيء الأهم على الإطلاق، أرشيف الصوت والصورة هو الذاكرة التي نبني عليها قادم الأزمنة داخل عالم الوقت.
إنّ أفضل ما حملتُه معي من الشام إلى هُنا في المهجر، هو "البيت"، بيت الأهل، "البيت" بيتي المُغتَصب، "البيت" دِمشق، "البيت" سوريا، …بيوتات مؤرشفة على (الهارد الصعب، الهارديسك… it was very hard)، خزّان يغُص بالأصوات والصور والرُموز، نعم إياس، الرموز، حياتنا مجموعة لامُتناهية من الرموز، نحنُ أحفاد المسماريين والمسمارية Cuneiform.
عندما عدت إلى الأفلام التي صنَعتَها، شعرت بأن لقطات أفلامك هي أرشيف عمَّار البيك.
تماماً!
هُناك العديد من الطُرق التي يمكن بها صناعة الفيلم، وقيمة تلك الأفلام قد تكون لحظية في زمن تصنيعها، لكن هُناك أفلام تحمل قيمة مُضافة. ليس كلّ الأفلام قادرة على التحوّل إلى وثيقة ومَرجع. هُناك أفلام، وهناك وثيقة سينمائية. عمار البيك، أنا مشتاق لك كثيراً...
شوق مُتبادل، وعابق كثيراً يا صديقي.
أنت صديق غالي، وتجربتك السينمائية بالنسبة لي ولأبناء جيلي من السينمائيين المُستقلين السوريين شديدة الأهمية. عندما بدأنا التفكير بصناعة أفلامنا الأولى خارج منظومات الإنتاج المتوفرة في سوريا كنّا نعرف، أن هُناك صانع أفلام أسمه عمَّار البيك. وجودك كصانع أفلام مُستقل في دمشق جعل من فكرة صناعة أفلامنا الأولى أمراً ممكن التحقيق. بدأنا بالكاميرات المنزلية لصناعة تلك الأفلام لتستمر التجربة حتى اليوم.
يخطر لي في هذه اللحظة الكثير من الأشياء. عندما ذكرت تأثير تجربتي عليكم، وكيف شجعتم بعضكم البعض لاتخاذ الخطوة، واستخدمتم كاميرات منزلية لصناعة أفلامكم الأولى، تذكرت أنه لم يكن لدينا كاميرا فيديو في البيت صالحة للاستعمال الخارجي. كاميرا خالي "أبو محمد"، التي وبكل تأكيد، وبمُجرّد استعمالها خارج البيت سوف تتعرّض للمُساءلة من قبل المخابرات ورجال الأمن. بالطبع هذا أمر لا تحمد عُقباه، فالمخبرين بائعي اليانصيب والمارلبورو ولعيّبة الكشاتبين من يرتدون بنطلونات سرايا الدفاع (الخُلبي)، يملؤون شوارع دمشق مثل الهم على القلب. كانت كاميرا خالي من نوع Sony Trinicon HVC 2200 and Portable Betamax 2000.
كان من شبه المستحيل أيضاً استعمال الكاميرا السينمائية الخاصة بجدي، والتي ظهرت في فيلمي سوريا الحلوة (2015)، لأنّ استعمالها كتير لبكة ومكلف، وهي من نوع Paillard Bolex H-16 Reflex 8/16 mm. بالطبع إياس أنا تعمّدت كتابة أسماء الكاميرات وأرقامها لأجل بحث الشباب المهتمين بهذا الأمر، وأعتقد أنه أمر مهم.
كانت الكاميرا الأولى التي اقتنيت في حياتي من نوع Panasonic VHS Movie nv-m3000، اشتريتها من مصوّر أعراس يدعى "أبو إبراهيم"، أراد تطوير مَعداته. أبو إبراهيم هو أحد شخصيات فيلمي نهر الذهب، وهو فيلم تسجيلي عن نهر بردى، اشتريت الكاميرا منهُ بالتقسيط بثلاثين ألف ل.س، أي ما عادل 600 دولار أمريكي آنذاك. قمت بدفع خمسة آلاف شهرياً، كان هذا في التسعينات. صوّرت بتلك الكاميرا فيلمي الأول، حصاد الضوء (1995) في مطحنة ميسلون القديمة الواقعة في باب السلام داخل السور القديم. مطحنة ذات عنفات خشبية كبيرة تدور بقوة تيار مياه نهر بردى، ثم تحوّلت بعدها إلى مطحنة تعمل على الديزل، والمؤسف في الأمر، أنه، وبسبب وزارة سياحة الـ''لا نظام" القمعي، تحوّل هذا المكان المُهم إلى مطعم بعد أن تعرّض للغزو كمعظم أحياء مدينة دمشق القديمة، والتي تعرّضت لغزوات ممنهجة على أيدي عصابات تابعة للقصر الجمهوري، ومن لفّ لفيفهم من تُجار الحرب، ومُحدثي النعمة!
في تلك المرحلة تعرفت على رجل دين، وأصبحنا أصدقاء، كان يدعى الخوري نجيب شنكجي، أحد رجال الدين السالزيان في كنيسة دون بوسكو" في حي الطلياني. كان يحدثني عن السنوات التي قضاها في إيطاليا وهو يدرس هندسة الصوت. على ما أذكر، كان يدرس في روما، كُنّا أيضاً نتبادل حوارات في علوم الدين والروحانيات والسينما، كان إنساناً طيب القلب ومُنفتح تجاه الآخر، وكنت أفرح عندما يؤّمن لي أفلام خام ٣٥مم، بالإضافة لكاميرا الكنيسة الفوتوغرافية Nikon 401، والتي صوّرت بها احتفالات، وطقوس المُناولة الأولى للأطفال (أول قربان). كُنت أعمل بالمجان لاعتقادي الراسخ بأنّ العمل مع الكنيسة يجب أن يكون مجانياً وتطوّعياً. كان المصوّرون المحترفون ينتظرون تلك المُناسبات والأعياد المسيحية لجني المال مُقابل صورهم من أبناء العائلات المتوسطة الدخل. كانت الصورة تكلّف 75 ل.س تقريباً. كانت العائلة تكتفي بصورتين كحد أقصى لأنّ الـ300 ل.س في تلك المرحلة تكفي العائلة لصنع 3 طبخات. كُنت ألحظ أنّ ما أفعله يخلق توتراً في وسط محترفي التصوير الفوتوغرافي التابعين للكنيسة، وبحسب تعبير أحدهم، لقد كنت "أنزعلهم القبض والشغل"!
وبالمُناسبة ثاني معارضي الفوتوغرافية، والذي افتُتح سنة 1999 بمعهد غوته الألماني في الشعلان كانت التيمة والقيمة لذلك المعرض للصور بالأبيض والأسود، طبعتها في غرفتي ببيت أهلي آنذاك، كانت عبارة عن 25 عمل فوتوغرافي، عبر سردية تبدأ من جدران كنيسة دون بوسكو ذات الطابع الكاثوليكي الإيطالي، وصولاً لرمزية جدران دمشق القديمة وسمائها ودوالي عِنبها وأشجارها الوارفة.
أذكر جيداً وجوه زوّار المعرض، وعلى رأسهم الدكتور صباح قباني، الذي شجعني في ذلك الوقت وأعطاني دفعة ثقة، فالدكتور صباح من مؤسّسي فن التصوير الفوتوغرافي في سوريا، أيام الأمير يحيى الشهابي والموسيقي حسني الحريري والدكتور مروان المسلماني.
نضال حسن: ثمة أنفاسٌ تتعلق بسطح الماء الرقراق عند الفجر
23 آب 2022
من سوريا: أرضٌ وثورات ودروس
28 حزيران 2021
أما القصة التالية والمُهمة كانت، إنّ الأب نجيب كان بحاجة لشِراء كاميرا فيديو مُستعملة لتصوير تلك المُناسبات في الكنيسة، فعرضت عليه كاميرتي الباناسونيك بعد أن صوّرت بها المطحنة، وبالفعل وافق على عرضي. مكنني بيع الكاميرا إلى الخوري من استعادة الثلاثين ألف ليرة دفعة واحدة، وبذلك المبلغ تمكنت سنة 1997 من مونتاج فيلمي الأول (حصاد الضوء) مع أحد مصوّري الأعراس الصديق، عامر العايق، الذي حوّل غرفة تحت درج بيت أهله في شارع حلب إلى غرفة مونتاج. هُناك كانت غرفة المونتاج الأولى والرائعة. أتذكر كيف عملنا على المونتاج في أحد المرات لمدة 24 ساعة متواصلة على جهازي VHS متصلين بجهاز ميكسر بسيط. بتلك المعدات أنهينا النسخة الأولى من الفيلم. أذكر أنّ رؤوس الفيديوهات ارتفعت درجة حرارتها بشكل كبير بعد تلك الساعات الطويلة من العمل المتواصل. ذلك أنتج ألوان قوس قزح ظهرت على المادة النهائية للفيلم مما اضطرنا للتوقف عن العمل تلك الليلة.
في زيارتي الوحيدة لبيت المُعلّم نزيه الشهبندر، والتي حصلت على وجه السرعة، لم أكن أملك في حينها، لا كاميرا فيديو ولا حتى مسجل صوت لتسجيل أيّ صوت أو صورة معه. زيارتي كانت زيارة عمل مُستعجلة لصالح الصديق ميشيل من استوديو هايك الذي اشترى من نزيه عدسة قديمة نوع 1858 Holmes, Booth & Haydens Petzval، عدسة نحاسية كبيرة الحجم، وُضعت في خزانة للعرض في استديو هايك وكتبت تحت العدسة عبارة (للعرض فقط).
كانت زيارتي له في فترة بعد الظهر، في ساعة الغداء، وكان بيته يقع على الطريق المؤدية لبيت أهلي في شارع بغداد قبل ساحة التحرير بقليل. دخلت قصر الشهبندر، بيت شيخ الكار. رأيت فوضى جميلة. أتذكر حامل كاميرا من طراز قديم، وكاميرا تصوير سينمائية 35 مم كبيرة وجميلة. مكان عتيق وجميل. كُتب ودفاتر متناثرة في كلّ مكان، وصوت أغاني آتٍ من راديو كبير موجود في المطبخ بالقرب من وعاء طبخ لطباخ. النزيه نزيه يُسخن طعام غدائه، كوسا وبندورة وزيت زيتون. سوف لن أنسى في حياتي ذاك الطعم الشهي، ولن أنسى كيف أكلت صحني بشهية عامل في ورشة، ليست كأي ورشة، مكتب وبيت أول سينمائي سوري وضع (الصوت على الصورة) في شريط سينمائي بأجهزة من صنع يديه، فكان "نور وظلام" الفيلم الذي تعرضت نسخته الأم للاحتراق في مخبر التظهير في إحدى ستوديوهات لبنان. هذا الفيلم الذى لم يبق منه سوى بضع أمتار موجبة تُظهر بعض لقطات الفيلم. هذا المُعلّم الثمانيني في حينها، قال لي بعد أن وجهتُ الكثير من الأسئلة العابقة بالدهشة والحُب والاحترام عن السينما والتقنيات، قال بصوت دافئ وحنون ذو بحة، بحة العارف المُتيّقن، قال: "حين تصنع شيئًا ما، فذلك لأنك ترغب بصناعته، وأنت رح تصير مُخرج سينما شاطر يا عمَّار، أسئلتك مهمة وحساسة والله يوفقك، بس لا تيأس أبداً ولا تستسلم، هالشغلة مو شغلة سهلة".
ما أجمل تلك اللحظات في بيت هذا الوقور الحكيم! في حينها كان الشهبندر يحاول أن يصنع منشار خاص يمكّنُهُ من قص مكعب زجاجي كي يصنع منه عدسة محدّبة الوجهين لابتكار عارض سينمائي ثلاثي الأبعاد. كان يعمل باجتهاد في ذاك العُمر. تردّد الشهبندر عدّة مرات على استوديو هايك للتصوير كي يستعين بالخبرة الكبيرة للمعلّم ميشيل هايك في هذا المجال.
في يوم ما كنت أمشي من حي القشلة، طريق باب توما نحو باب السلام حيث بيت أهلي. في منتصف الطريق، وللمرة الأولى لمحت الباب الكبير، والذي اعتدت رؤيته مغلقاً مشرعاً ومفتوحاً. بناء حجري عتيق، مرتفع وفخم الطراز. يقع ذلك البناء تقريباً مقابل حارة العزرية. كان قد سبق للمُعلّم نزيه أن أخبرني عن الاستوديو، لكنه توفي قبل أن يريني إياه. في ذلك اليوم اكتشفت مكاناً مُفعماً بطاقة إيجابية غريبة محسوسة، في هذا الفضاء، سيارة نقل كبيرة عند المدخل (إيسوزو) يملؤونها بالردم والأنقاض لتُرمى محتويات ذلك المكان في مكبّات الزبالة خارج دمشق. نظرت متفحّصاً لأجد أنّ هنالك إمكانية لصناعة صور فوتوغرافية داخل المبنى. دخلت لأكتشف أنّ المكان هو سينما واستوديو الشهبندر. يا للروعة! أنا في منتصف "سينما باراديسو دمشقية" تعج بالغُبار والذكريات والجمال الأخاذ، هذه الجنة تحوّلت جرّاء الغزو السياحي المُمنهج على دمشق إلى مطعم أيضًا. يا للخسارة الرهيبة! بدل أن يتحوّل المكان إلى سينما متحفية مُعادلة لـ"سينما لاسيوتا" في الجنوب الفرنسي، السينما الأولى في تاريخ سينما، الأخوين لوميير 1899، تحوّل إلى مطعم.
كان استوديو وسينما الشهبندر فضاءً واسعاً، ارتفاع السقف داخل ذلك البناء لا يقلّ عن العشرة أمتار. في ذلك المكان ترى كلّ ما يرمز للسينما من أدوات وتفاصيل. أنا بدوري قمت أيضاً بإحضار سيارة البيك آب الصغيرة السوزوكي اليابانية الصُنع، وسائقها كان رجل بمنتهى اللُطف ساعدني في حمل ما بقي من أشياء ذلك المكان، والتي عُوملت على أنها أنقاض. تستطيع سيارة السوزوكي ذات الحجم الصغير التنقّل داخل أضيق حارات دمشق بمُنتهى السهولة، البيك آب تتجه حاملة عمار البيك وحمولة جمال متناثر من سينما باراديسو، الى بيت الأهل في باب السلام، سائق الإيسوزو بادل تصرفاتي بالاستهزاء، على مدخل الاستوديو بينما كنت على حدّ علمه المتواضع أُخلصهم من بقايا الترحيل، بينما أنا كُنتُ ألملم عظام كبرياء المكان والمدينة، وكان عزائي الوحيد في تلك اللحظات هاتفي النوكيا 5200، قمت بالتقاط بعض الصور التي ما أزال أحتفظ بها حتى هذا اليوم. أتذكر وبأسى ما قاله لي نزيه الشهبندر يوماً قبل رحيله: "أعلم أنه بعد موتي سوف يتم رمي كلّ مُقتنياتي، من قبل الورثة". كان المُعلم شبه مُتأكد من ذلك، وهذا ما حصل والأقدار جعلتني أشهد على ذلك والصور دليل على النهايات المُحزنة. تخلّصوا من كلّ شيء، والدليل على ذلك أنّي تمكنت من الحصول من هذا المكان على بعض البروشورات الأصلية لفيلم "نور و ظلام". تلك المطبوعات كانت باللونين البني والبيج، حصلت على الكثير من الأغراض شبه التالفة، لكنها تُذكّر برمزية المكان: كرسي خشبي بهيكل معدني، مكتب خشبي صغير مُتهالك، لمبات وكتب قديمة وبعض الديكورات المُزخرفة المصنوعة من الجبس التي تهاوت من أسقف المكان، قطع ورق جدران قديمة...
حزن وفرح في آن، أفرح يوماً بتلك المُقتنيات التي بقيت في دمشق وأفرح أكثر لتلك الصور التي وثّقت بها هذه اللحظات النادرة والمؤلمة. الفرحة الأكبر يا صديقي أنني أملك صورة فوتوغرافية واحدة تجمعني بالمُعلّم القدير النزيه، طلبت من أحد المصوّرين الطيبين، والذي كان يعمل مصوّراً في النوادي الليلية الدمشقية، أن يصوّرني مع نزيه الشهبندر أثناء صدفة عابرة في ستوديو هايك. في تلك اللحظة أردت أخذ صورة للتاريخ.
"حبيب" أحد أهم زبونات الاستوديو، كان دائم التردّد لأجل معايرة كاميرته وفلاشات الإضاءة لديه، كان يحب مهنته بشكل كبير، كان مصوّرًا محترفًا، طلبت من حبيب هذه الصورة إيماناً مني بشطارة "حبيب"، صورة سريعة بفلاش كاميرة (Nikon 601). جاءني النور الخاطف القادم من فلاش الكاميرا الصغير في نفس الغرفة التي صنعت لي عائلتي الصورة الأولى في تاريخي، في استديو هايك عندما كان عمري أربعة شهور.
في الصورة التي التقطها حبيب لي مع المعلم نزيه، كنت أضع يدي حول كتفه. ما أزال أذكر ملمس قميصه، كان منسوجاً من خيوط تشعرك عند لمسها بالقليل من الخشونة كالقش، سبق لي أن نشرت تلك الصورة مع نزيه الشهبندر مرات عدة على الانستغرام، دفتر المذكرات الافتراضي الخاص بي.
عدت إلى زيارة المُعلّم نزيه من دون موعد مُسبق، والهدف كان الاطمئنان على صحته، ذهبت برفقة حبيبتي وصديقتي آنذاك حاملاً معي باقة من الزهور، ليقول لي جار نزيه الشهبندر عند باب بيته "البقية بحياتك، نزيه توفي" زعلت كتير. عدت مع باقة الزهور محمّلاً بإحساس عميق بالألم و الانكسار. فقدتُ رجلًا مهمًا في الحياة، منبع طاقة إيجابية، صاحب تاريخ مُشرف.
دعني أحدثك عن استوديو هايك، المكان الذي التقيت فيه بشيخ الكار "نزيه الشهبندر"، وبالكثير من المصوّرين، والسينمائيين السوريين، أشعر أنه في ذلك المكان حصلت على الصعقة الضوئية الأولى التي غيّرت ما غيّرت في حياتي. هنالك لقطة في نهاية فيلم "حاضنة الشمس" إذا كنت تذكر، اللقطة تُظهر طفلة في الحاضنة، هي "صوفيا شمس" ابنتي، بعد ولادتها بدقائق، كانت في تلك اللقطة تنظر نحو العدسة. يُقال إنّ الطفل في ذلك العمر لا يستطيع الرؤية بدقة، لكنه يتحسّس الضوء، بالنسبة لي، صوفيا شمس كانت تنظر إلى العدسة بشكل مُباشر، إذا عدت إلى الفيلم سوف ترى أنها تنظر، كان عمرها عندما قامت بتلك المحاكاة عشرة دقائق أو أكثر بقليل (عدسة تنظُر إلى عدسة) يا لجمال الحياة!
في استوديو هايك، والذي يعدّ واحداً من أقدم خمسة استوديوهات تصوير فوتوغرافي (صور الهوية والكرت البريدية) في دمشق. عملت فيه لمدة 11 سنة شبه متواصلة، مع انقطاع وحيد وهو سفري لأميركا الجنوبية سنة 1996 بغرض دراسة السينما في تشيلي. السنوات الخمس الأولى لي في استوديو هايك، قمت بمسح الغبار والتكنيس، وإعداد القهوة والشاي للزبائن، في تلك السنوات الأولى لم أطالب بأجر مقابل عملي، خجلاً، ولاعتقاد مني أني لا أستحق. الأجر بالنسبة لي كان خبرة حياة وعلم.
في كثير من الأحيان كنت أمشي من بيتي إلى الاستوديو لعدم امتلاكي لثلاث ليرات من أجل ركوب الميكروباص من باب توما إلى موقف وزارة الصحة. المهم، اكتشفت في الاستوديو مكان السقيفة، وجود مجموعة من المُراسلات بين المصوّرين الفوتوغرافيين الأرمن، مكتوبة باللُغة الأرمنية، والكثير من الأختام، كان عالم المُصوّرين عالم شديد التنظيم في الزمن الماضي، شعرت أنّ هُناك قامات كبيرة كانت تقوم بصناعة ذاكرة مدينتنا دمشق من خلال بورتريهات الناس (ستوديو آزاد، ستوديو هايك، ستوديو گربيس، ستوديو بردى، ستوديو الهرايسي). ولكلّ مكان من تلك الأماكن قصة جميلة.
اكتشفت بالمُصادفة أنّ الختم المطبوع وراء صورتي التي أخذت لي عندما كنت في عمر الأربعة شهور، كان من أختام ستوديو هايك، البورتريه الأول. كُنت عارياً في الصورة، ويد أمي مُمتدة لتسند جسدي الغض. لا أعرف من كان المصوّر لأنّ الاستوديو في تلك الأيام كان يضم عدّة مصوّرين يعملون على مدار الساعة، وعلى رأسهم "البارون هايك"، مؤسّس المكان. الجميع يعمل لتجهيز صور الناس الذين كانوا يصطفون على طول الرصيف المُقابل لمطعم الريس، صعوداً إلى الطابق الأول، في بناء الطيران السورية. كان يتم توزيع الصور الشخصية والصور الفنية المُلتقطة في الاستوديو ليلاً على ذلك الحشد اليومي من الناس. كانت صورتي قد التقطت في أحد غرف الاستوديو، الغرفة التي قضيت فيها أحد عشر عاماً لاحقاً، فيها قرأت عن السينما والأدب والفلسفة، الكثير من قصص الحُب الجميلة والعابرة، وتعلمت مسح الغبار بدقة، وكتبت إيصالات الكاميرات الموضوعة في الاستوديو بغاية التصليح. تعلمت معنى التفصيل والدقة والمُضيّ والإصرار، أنا مُتأكد بأنني كنت في عمر الأربعة أشهر قادر على تمييز إضاءة المُصوّر، وأكيد أني رأيت المُصوّر، وعدستهُ، الصورة تقول ذلك يا إياس.
في الصورة طفل مشدوه بتلك اللحظة، وهناك بدأ المُركّب الكيميائي المرئي المُعقد لحياتنا، وهو الموضوع الذي نرجع كلينا إليه في هذا الحوار، المرئي شديد الأهمية، كلمة (المرئي) أو "السمع-بصري" مُركّب لغوي من كلمتين، هو كمفهوم، أكثر حساسية من السينما، السينما هي اتساق مجموعة من الفنون، أما "السمع-بصري" فهو شيء يبدأ من رحم الأم برأيي. إن اقتراب ضوء ساطع من بطن الأم اثناء الحمل، يحوّل فضاء الجنين إلى فضاء مائل إلى الاحمرار، ومشهدية النبض والتعايش، تمتزج بأصوات العالم الخارجي، ذلك هو "السمع-بصري" الحرارة النابضة. أعتقد بأني أصبت بمسّ ضوئي عند التقاط تلك الصورة، صورتي الشخصية الأولى، وأحبّ أن أُصدّق ذلك. في ستوديو هايك حصلت على النبضة الأولى.
في أي عام ولدت؟
17/12/1972 أضف عليها أربعة شهور بحسب ختم ستوديو هايك المطبوع خلف الصورة.
كان هذا في العام 1973؟
تماماً، آذار 1973، لقد كانت أمي تضع عقداً خاصاً حول رقبتي في تلك الصورة، عادة مُتبعة عند أغلب العائلات في سوريا، (الذكورة) ابني ذكر. لاحقاً التقطت صورة لصوفيا مُطابقة لصورتي وبالقرب من صورتي في آذار 2011 وضعنا لها ذات العقد حول رقبتها، والآن في سجلّها الحياتي فيلم لها عن الثورة السورية هو فيلم حاضنة الشمس، وتلك الصورة. ولها الخيار أن تُحب ما صنعته، أو عليها صناعة فيلمها الخاص رُبما، لانتقاد والدها، ولسرد القصة التي تريد، صوفيا شمس ابنتي موجودة في وثيقة بصرية توّثق بداية الثورة في تونس، مصر، وسوريا، والفيلم كان أول فيلم يُعرض في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في سبتمبر 2011. الفيلم يمثلني ويمثل رغبتي بمُناصرة الشعوب الساعية للتحرّر من قيود الديكتاتوريات العربية. أهديت الفيلم في تيترات النهاية لشُهداء الحرية، محمد البوعزيزي، خالد سعيد، وحمزة الخطيب. في تلك الوثيقة (أي الفيلم) نرى لقطة لشاب تسلّق على أحد الأعمدة الكهربائية في أحدى شوارع قرى الغوطة الشرقية بدمشق، وقام بتمزيق صورة بشار الأسد (بموس كبّاس)، كانت تلك اللقطة ظاهرة على شاشة التلفزيون في الفيلم، وتحت كومودينة التلفزيون كان هناك كتاب للفنان "جون بالديساري" (Pure Beauty) الذي نقل مفهوم الصورة الفوتوغرافية إلى مفهوم جمالي فلسفي صِرف، كل تلك الأضداد موجودة مع حمزة وصوفيا.
في مقدمة فيلمك "حاضنة الشمس" كتبت مقتبساً عن كتاب ملاحظات في السينماتوغرافيا "ينتمي مستقبل السينما إلى سلالة من المعتزلين الشباب الذين سيصوّرون أفلامهم بإنفاق قرشهم الأخير عليها، من دون أن يسمحوا للروتينيات المادية للمهنة بأن تصادرهم". إن ذكر الاعتزال في تلك الجملة، يدلّل على المفهوم الفلسفي للاعتزال، والذي يعني المعارضة الفكرية لتيار فكري منتشر ومتسيّد، فأنت تعتزل ذلك التيار لامتلاكك أفكاراً مغايرة. أتلمس في تلك الجملة التي افتتحت بها فيلمك، الجانب الفلسفي، الجانب الفرداني، والجانب النضالي لسينما عمار البيك. قبل العام 2011 كنت قد أنجزتَ عدة أعمال (إنهم كانوا هنا، حصاد الضوء ، سامية، أنا التي تحمل الزهور إلى قبرها). لكن مع فيلم "حاضنة الشمس" أشعر أنّ هناك تبلورت الكيفية التي يرى بها عمار الفيلم المستقل وصناعته. قبل أن نفنّد كلّ تلك المواضيع، أرغب بأن تحدثني عن عمار البيك ابن مدينة دمشق. حدثني عن تلك المدينة كمرتع للطفولة وللذاكرة السمع-بصرية.
أحد مراتع طفولتي في مدينة دمشق هي المساحة الممتدة حول بحرة الجامع الأموي الكبير، كان المكان بالنسبة لي مكانًا يجمع الناس، ساحة كبيرة للركض، وساحة لممارسة تطيّير أكبر كشة حمام في دمشق. لأكتشف فيما بعد أني كنت أعيش في قلب فضاء مثلثاتي، هرمي. معبد روماني شبه مُتكامل، مُرتبط بالسوق الطويل (سوق الحميدية) الذي ترسم مساره أعمدة رومانية مُصطفة بشكل متوازي لمئات الأمتار، كل ذلك يخبرك أنّ الرومان مرّوا من هناك كحضارات سابقة كثيرة. الرومان تركوا لنا أثراً هندسياً يسمح لأجيالٍ لاحقة أن تدخل إلى ذلك المعبد للتأمل، بغض النظر إذا كان المعبد كنيسًا، أو كنيسةً، أو مسجدًا. الطاقة الكامنة في تلك البحرة كانت بقوة لسعات قضيب الخيزران الذي كان يحمله حارس الجامع، والذي كان يغدر به أجسادنا، أنا وأصدقائي عندما كنّا نغافله للسباحة بالبحرة الكبيرة. كنت أركض هارباً من أزيز الخيزران مع الحرص بألا ينزلق جسدي المُبتل على الرخام. تخرج من باب الجامع الكبير لتجد نفسك فجأة بين المئات من طيور الحمام التي تستجيب لحركتك وتناور، فيصير المشهد خليطاً من رفرفة الأجنحة، وركض الصبية المُطَاردين من خادم الجامع الكبير.
في السوق خارج المسجد، كان المكان الذي اشتريت منه الكتب المدرسية المستعملة الخاصة بالمرحلة الابتدائية والإعدادية. كنّا نشتري الكتب من هناك لأننا لا نملك 14 ل.س ثمن الكتب المدرسية الجديدة. داخل تلك الكُتب المستعملة كنت أجد هدايا غرافيكية قيّمة، كأن تجد مُذكرات المالك القديم مخطوطة على هوامش الكتاب، رموز، رسوم، وجوه، وجنس أحياناً، إلى جانب إضافات كاريكاتورية على صورة القائد الخارج عن القانون حافظ الأسد. تلك أماكن الطفولة ومرتعها، على اليسار من البوابة الرئيسية للمسجد وبتاريخ 15 آذار 2011 صرخت دِمشق بأسرها، عن طريق فم مروة الغميان بكلمة "حرية" وبالقرب منها حسب الرابط كان يقف رجل الأمن مرتدياً سترة بلون ترابي لأنه يريد التخفّي، ويريد أن يمنعها من قول تلك الكلمة المُكرّرة "حرية حرية حرية". كانت مروة فتاة جميلة الوجه، مُفعمة بالطاقة الكامنة لدمشق. صرخت بأعلى الصوت، يا للروعة! الثورة السلمية تبدأ وإجاك الدور يا دكتور.
كانت تمثلني بصرختها بالمُطلق، وتنبئ ببداية الثورة السلمية. كان حافظ الأسد يؤدي الصلاة في الجامع الأموي في المناسبات الرسمية. اختيار المكان في قلب العاصمة دمشق لفعل ذلك، ما هو إلا دلالة على سيطرته على سوريا بالكامل.
أودّ ربط حوارنا هذا مع الحوارات التي حققتها مع فنانين سوريين آخرين حول موضوع السينما السورية. بمعزل عن وجهة النظر السياسية بالنظام السوري أو ما قد وقع خلال السنوات الأحد عشر المنصرمة على الصعيد السياسي والاجتماعي والثقافي. السينما دائماً مشاكسة، حتى في أعنف أنظمة السيطرة، وهذا أمر نستطيع تتبعه في العديد من التجارب السينمائية العالمية. السينمائي لا يستطيع أن يكون سينمائياً حقيقياً من وجهة نظري، إذا لم يكن مشاكساً مع الحياة، يقوم بطرح أسئلة أساسية حولها. أردت النظر إلى تلك السينما متحرّراً من الموقف السياسي الذي أملكه ضد النظام الذي أنشئ المؤسسة العامة للسينما كجزء من هيكليته السلطوية. بعد الثورة السورية نشأت رغبة عند الكثير من الناس لقطع العلاقة مع الماضي، والهجوم عليه ورفضه بشكل كلي.
كل فيلم أنتج في سوريا قبل العام 2011، منذ فيلم "نور و ظلام" أو "تحت سماء دمشق" هو فيلم مُهم ومرحلي، سواء كان إنتاجاً خاصاً أو من إنتاج المؤسسة العامة للسينما، مدعوم وبواسطة أو بدون، أفلام نهاد قلعي وغوار الطوشة وأبو عنتر مُهمة، أفلام إغراء كانت أفلام مُهمة، وأفلام عبد اللطيف عبد الحميد وأفلام جود سعيد مهمة، سينما العسكر والعيد مهمة، إنتاجات الأتاسي لفيروز مهمة. بالطبع نحن لسنا بصدد تصنيفات إبداعية، لكن هناك أهمية كبيرة للتراكم والتأريخ بالصورة والصوت لوجهات نظر البشر. فيلم "جزيرة النساء" لفيصل الياسري مهم ودرس بالجغرافية، "اليازرلي" لقيس الزبيدي مهم. فيلم "المخدوعون" لتوفيق صالح مهم، وجميع الأفلام التي أنتجت داخل سوريا خلال السنوات العشر الماضية مهمة لأنها وثائق للتاريخ، إنتاجات للبشر، ما أعنيه هو أنّ أولئك المُخرجون صاغوا أفلامهم بحسّ الفنان الفردي ووجهة النظر التي قد تتقاطع مع المنظومة الأمنية (الأفلام تشبه أصحابها بالضرورة القصوى والحتمية مثل الأدب والقصيدة). هناك أفلام أثرت بوعينا، وصنعت فارق على المستوى الفكري. مُخرجون قدموا تجارب مُهمة، مواجهات من داخل المنظومة وبيروقراطية مؤسستها الوحيدة. مُنع أغلبهم من فعل كلّ ما يريدون، لكن وبالمُقابل تمكن بعضهم من إنجاز سينما إبداعية كأفلام عمر أميرالاي، نبيل المالح، ورياض شيا، ريمون بطرس، محمد ملص وأسامة محمد وسمير ذكرى. كثيرة هي الأسماء، كانت الأفلام تكتسب أهميتها من مستواها الفني الإبداعي واستقلالية فكر صنّاعها. كلهم كانوا يعملون على فيلم يُشبههم، يعبّر عنهم وعن رؤاهم، هُنا تكمن استقلالية العمل الإبداعي المنتج في مؤسسة تخضع لسيطرة أمنية.
محمد الرومي: السينما دائمًا ضروريّة
07 كانون الثاني 2022
عروة المقداد: وقعت في غرام السينما
12 آب 2021
على الرغم من تسلّط الرقيب و فرض سلطته وإيديولوجياته، لكنهم صنعوا أفلاماً تتحدّث عن الآباء والأمهات والمُدن والهموم والآمال والذكريات والحُب، أفلام تُراكم تاريخ البلد. وهنا يخطر لي أن أذكر عرّاب السينما المستقلة محمد الرومي صاحب فيلم "أزرق رمادي" المُستقل والمُشاكس والخارج عن المنظومة. هو درس كبير في تاريخ السينما السورية. يجب التأكيد أنّ كل تلك الأفلام والجهود المبذولة في تاريخ السينما السورية مهدت الطريق لظهور تحفة سينما سورية تسجيلية كـ"إلى سما" (فيلم لوعد الخطيب)، على مستوى السينما العالمية، فيلم ثوري صادق، ويستحق نيل جائزة الأوسكار، وكلّ التكريم الذي حصل عليه الفيلم.
مروان حداد ومحمد الأحمد ونجاح العطار مهمين أيضاً بالنسبة لمنظومة النظام الفكرية المؤدلجة بالخرافات التحرّرية. أهميتهم بالنسبة للنظام تكمن في أنهم كانوا رقباء، منعوا وحذفوا وحرموا الكثيرين من نيل فرصهم، وذلك ما شكل سمات المرحلة المُنصرمة. حُرمت البلد من حرية الفكر، ودورنا اليوم هو إعادة تفكيك وتحليل كلّ ذلك لفهم ما حصل من تعقيدات في مسار تطوّر مجتمعنا. نتحدث اليوم أنا وأنت بطريقة تحليلية فلسفية عن حياتنا، لأنّ عسكرياً عُصابياً كحافظ الأسد كان جزءاً منها، حافظ الأسد قهرنا، وخلق في داخلنا خوف عميق ومتجذّر، حافظ هو تاجر التراب، (بيّاع وشرّا عالتئيل). التحرّر من الخوف يقتضي الاعتراف بأنه لولا ذلك لما كنّا اليوم أجرينا هذا الحوار عن السينما والإنسان بين بروكسل ومارسيليا. لذلك فإنّ كل الأفلام السورية فردية ومستقلة بالمعنى الفكري، وجميعها مُهمة، والأهمية تكمن في تراكم وجهات النظر عن الحياة. لكلّ إنسان وجهة نظر تساعدك على التعرّف عليه بالعُمق، والتعرّف على بيئته التي شكلته، كلّ التجارب مهمة لصوغ المنطق لاحقاً، وكل شخص أنجز فيلماً يجب شكره بمعزل عما إذا كان الفيلم أعجبك أم لم يعجبك، مؤيداً كان أو معارضاً، و بغضّ النظر عن اعتبارات تقييمات الفيلم الفنية، تلك الأفلام تعبر عن صُنّاعها. أفلام إغراء تشبه إغراء، وأفلام العسكر تشبه العسكر، وأفلام القصر الجمهوري تشبههُ!
بالمناسبة إياس بحب ذكّر بحادثة حصلت في عام 2012 كنت واحداً من الموّقعين على عريضة لحرمان فيلم جود سعيد من المشاركة بمهرجان دبي، والموّقعون كانوا كثر. قابلت إدارة المهرجان العريضة بالقبول، وتمّ منع عرض الفيلم، هي لحظة وفرصة مناسبة للاعتذار من "حرية التعبير" (لقد أخطأتُ إنسانياً) بغضّ النظر عن تأييد المخرج الكبير لبشار الأسد وعساكره، لكن إنسانياً كان لابدّ للفيلم أن يشارك، كي نرى، وكي يرى العالم وجهة النظر التي مكنت عائلة واحدة من حكم سوريا لخمسين عام، جزأوها وباعوها للإيرانيين والروس بحجة المقاومة والدفاع عن السوريين. السوريون المحروم نصفهم اليوم من أقل حقوقهم بالطبابة والتغذية والتعليم والحياة الآمنة، والنصف الآخر من هذا الشعب طرد خارج البلد تعسفاً. أعتذر لحرية التعبير، والفناء للقتلة!
عمار، هل تخرجت من كلية الفنون الجميلة في دمشق؟
تقدمت بعد حصولي على شهادة البكالوريا إلى كلية الفنون الجميلة في دمشق. رسمت في اختبار القبول لمدة خمسة ساعات متواصلة، خلال الاختبار وأنا منغمس بالرسم، مرّ بقربي عميد الكلية الفنان، خالد المز، الذي عرفت من يكون لاحقاً، ربت على كتفي مُشجعاً، قال لي: "ممتاز، أكمل الرسم"، ما قاله أشعرني بأنّ ما أقوم به جيد. كنّا نرسم تكوين مصنوع من الخُضار، ورأس العظيم الفيلسوف سقراط. أذكر تماماً بأني لم أغادر مقعدي طوال الساعات الخمس، كنت أظلّل بشغف، كان الاختبار على مقاعد كلية الهندسة المدنية في منطقة البرامكة. عند صدور النتائج ذهبت إلى كلية الفنون التي كانت في ساحة التحرير لأكتشف أنّ إسمي ليس بين المقبولين في الكلية، ناطور الكلية أدرك الحاصل، جاءني مُبتسماً ودارياً بالحال ثم قال: عمو، يجب أن يكون لديك واسطة للقبول في هذا المكان، أجبته بأني قد رسمت جيداً بشهادة عميد الكلية، فرد عليّ: "فهمت عليك، ممكن تكون نجحت بالعملي، لكنك بحاجة إلى واسطة تقيلة"، ثم سألني: "أنت من وين؟" أجبته "من الشام...". ابتسم الرجل، وهزّ رأسه ثم قال لي يجب أن أجد أحداً ما يستطيع الحصول على استثناء لي، من وزير التعليم العالي. عندما قال ذلك أدركت استحالة قبولي في كلية الفنون الجميلة. هل من المعقول أنّ كل الفنانين المهمين كان لديهم واسطة للدخول إلى الكلية؟! لم ألتقي بصديق واحد من الخريجين من الكلية اعترف بأنه اعتمد على الواسطة للدخول إلى الكلية. كلهم قالوا إنهم دخلوا الكلية بموهبتهم فقط. هل يجب تصديق الجميع؟ بكلّ الأحوال، عدم قبولي شدّ عودي!
سجلت في معهد التجارة وإدارة الأعمال مُرغماً، فعلت ذلك نزولاً عند رغبة أمي، وضعف معدل علاماتي. من أجل أمي أردت الدخول إلى الجامعة. بدأت دوامي في المعهد التجاري في منطقة المزة فيلات غربية. كانت المنطقة تعجّ بضباط المخابرات، ومسكونة من أغلب النافذين بالدولة، بهجت سليمان وأولاده، آصف شوكت، وآخرين كثر، يعني حثالة المجتمع. المنطقة تعج برجال الأمن، الذين يجلس بعضهم في قُمَر صغيرة موضوعة على مداخل الأبنية التي يسكنها الضباط والمسؤولين المهمين، والكثير من سيارات المرسيدس من نوع "الشبح" مظللة النوافذ. طاقة سلبية فظيعة.
بدأت حضور محاضراتي في المحاسبة وإدارة الأعمال. أشياء لا تشبهني أبداً. في إحدى تلك المحاضرات، طلبت مني المُحاضرة بأن أتقدم إلى اللوح الخشبي الكبير في القاعة لحل المسألة المكتوبة عليه، قلت لها إنّني لا أعرف حلاً للمسألة. سألت فيما إذا كنت قد كتبت الوظيفة، فكان جوابي بالنفي طبعاً، قالت بالحرف: "انقلع وسكر باب القاعة من الخارج، ولا تريني وجهك حتى نهاية العام الدراسي".
أعرف أنّني لم أكن ملتزماً كطالب في المعهد، لكن كل طلاب المعهد يعلمون أنّ تلك المُحاضِرة كانت مدعومة فهي زوجة رجل أمن. شكرتها، وذهبت فوراً إلى شؤون الطلاب، وقدمت طلباً بطي القيد الخاص بي في جامعة دمشق. حقّقت معي المخابرات السورية بسبب ذلك. تم استدعائي لقسم شؤون الطلبة، وهناك سألني رجل الأمن، لماذا طويت قيدك الجامعي؟ قد يكون سبب السؤال هو اعتقادهم أنني كنت أخطّط لمغادرة البلد في التسعينات، ربما.
كرّرت أمي كثيراً عبارة "يا حوينة الـ1200 ليرة التي أنفقتها على بدلتك الجامعية المجبرين على شرائها". كان طلاب الجامعة آنذاك، يرتدون لباساً موّحداً بلون أزرق، بالطبع لم نكن لنلتزم به!
كانت هديتي عند نيلي شهادة البكالوريا هي كاميرا تصوير فوتوغرافي نوع Zenit TTL أهدتني إياها أمي. أشهر وتعطلت الكاميرا، فأخذتها إلى استوديو هايك الذي بتّ أزوره بشكل شبه دائم، وذلك قبل تركي لمقاعد الدراسة في الجامعة. لم أكن أرغب بأن يتم إصلاح الكاميرا بشكل سريع في قرارة نفسي. كنت أستمتع كثيراً بزياراتي تلك، كان يُطلب مني الانتظار، فأقضي الوقت أراقب من يعملون، وأتصفح بشغفٍ مجلات التصوير الضوئي الكثيرة في الاستوديو (مجلة الفوتو آنسر، والبراكتيكال فوتوغرافي..إلخ)، استمر الحال هكذا عدّة أشهر في انتظار إصلاح كاميرتي. لم أكن سعيداً حينها في دراستي إدارة الأعمال، وكنت حزيناً لعدم تمكني من الدراسة في كلية الفنون الجميلة.
كان يطلب مني ميشيل صاحب الاستوديو الانتظار لمدة ثلاث أو أربع ساعات على أمل إصلاح كاميرتي، حتى جاء يوم قال لي فيه: "هل ترى هذا المسنن الصغيرة المكسور في كاميرتك؟ أنا متأكد بأني أملك واحداً مثله، لكني لم أستطع العثور عليه، حاولت ترميمه، لكن المحاولات كلها فشلت" أدخلني إلى غرفة جانبية مليئة بالكاميرات الخردة ثم قال: "المسنن الذي نحتاجه لإصلاح كاميرتك موجود في هذه الغرفة، بين فوضى آلات التصوير القديمة تلك، عمار حاول إيجاد تلك القطعة"، أجبته بحماس بأني سأفعل. بعد قرابة الساعتين تمكنت من إيجاد القطعة المطلوبة. عدت مسرعاً إليه أحمل القطعة الصغيرة بفرح. بعد تلك الحادثة سألني ميشيل عما أفعله في الحياة، فأجبته بأني طالب في الجامعة، ثم قال: هل ترغب في العمل معي؟ فقلت نعم، وبقيت أعمل في الاستوديو لمدة أحد عشر عاماً. في 1996 سافرت إلى تشيلي في رحلتي الأولى خارج سوريا. ولاحقاً لندن لأجل دراسة السينما. رافقني بتلك الرحلة نسخة الفيلم غير الممنتج بشكل نهائي بعد، والذي كان طوله 22 دقيقة.
استمرت رحلتي لمدة شهر ونصف تقريباً لم تكن موفقة في مساعيها، سانتياغو كانت بلد صعب بالنسبة لي، اللغة الإسبانية وشكل الحياة، قبل سفري اعتقدت أنني سأسافر إلى دولة تشبه كوبا، لكن ما وجدته كان مدينةً تشبه إلى حد كبير طراز بعض الأحياء في مدينة نيويورك. حياة عصرية ومكلفة على الصعيد المادي. في طريق عودتي زرت لندن بحثاً عن فرصة للبقاء، لكن المدينة كانت مكلفة أيضاً والقبول الجامعي يحتاج لدعم مادي كبير لم أكن أستطيع تحمله. عدت أدراجي إلى سوريا للعمل لتعويض تكاليف أول رحلة خارجية لي في حياتي.
أخبرتك كلّ تلك القصص يا إياس عن الصورة التي أخذت لي عندما كنت طفلاً في استوديو هايك، قصة الجامعة والعمل مع الاستوديو لاحقاً... كل تلك القصص في اعتقادي هي جزء من تكوين القدر السينمائي!