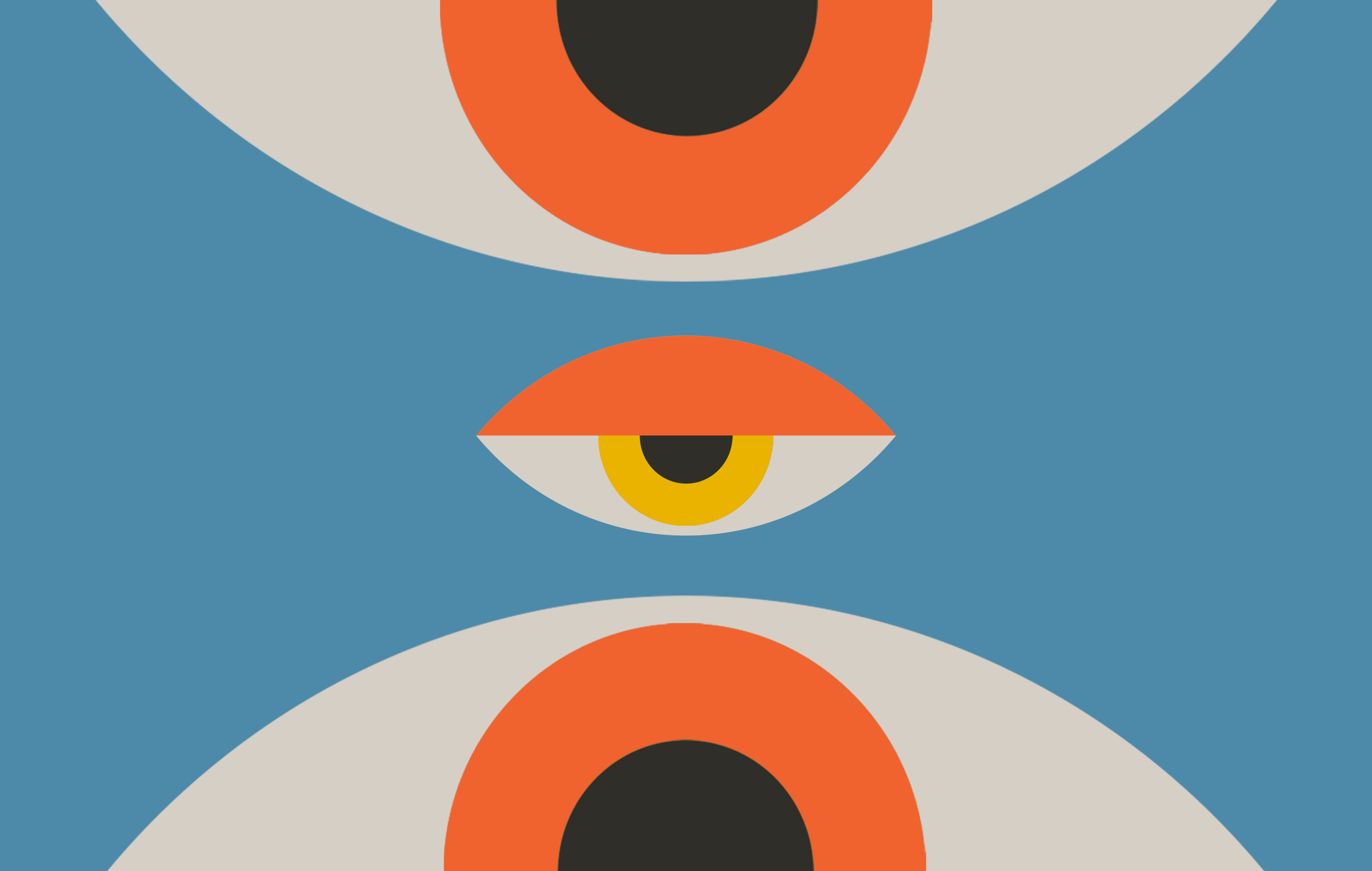(طرطوس)، "كنت رايحة احضر حفل خطوبة بنت أختي، حاملة معي ابني الرضيع وقلبي مليان بالفرحه، ما كنت عارفة إنه هاليوم راح ينسرق مني فيه كل شي؛ الأمان وحتى ابني! ما نسيت صوت الرصاص ولا وجه أم عبدو وهي عم تقول: "فوتوا لعندي ما حدا هون رح يشك أنكن علوية أو حتى يلمسكن"، لو ما ساعدتنا كنا أكيد هلأ تحت التراب".
تمنّت نوال (اسم مستعار/ ٣٢عاماً)، التي التقتها سوريا ما انحكت مع أختها فاطمة وابنة الأخيرة رنا، إضافةً إلى زوج نوال في بيتهم في مدينة طرطوس، لو أنها ماتت ولم تروِ ما روته لنا بعد أن نجت، ومن معها، من مجزرة حي القصور في مدينة بانياس على الساحل السوري، والتي كانت واحدةً من سلسلة مجازر تعرّض لها المدنيون في الساحل السوري بين يومي 6 وحتى 10 من شهر آذار/ مارس 2025.
كانت نوال تتحدّث بصوتٍ خافتٍ يختلط بالدموع بينما فاطمة تمسك بيديها وتضيفُ التفاصيل التي تحاول الذاكرة نسيانها. أمّا رنا فكانت تصغي أكثر مما تتكلّم، كأنّها ما زالت تعيش في تلك الليلة وما تلاها من ليالي، نسرد هنا تفاصيلها من عيونٍ شهدت ورأت المجزرة عن بعد أمتارٍ فقط.
عاملة منزلية... تخلّت عنها الطوائف
ووفق تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد "تضمنت الأحداث في بانياس عمليات قتلٍ خارج نطاق القانون، شملت إعداماتٍ ميدانية وعمليات قتلٍ جماعيّ ممنهجة بدوافع انتقامية وطائفية، إضافةً إلى استهداف المدنيين، بمن فيهم أفراد الطواقم الطبية والإعلامية والعاملون في المجال الإنساني. كما طالت الانتهاكات المرافق العامة وعشرات الممتلكات العامة والخاصة، متسببةً في موجات نزوحٍ قسريّ طالت مئات السكان، فضلاً عن اختفاء عشرات المدنيين وعناصر من قوى الأمن الداخلي، الأمر الذي أدى إلى تفاقمٍ حادٍّ في الأوضاع الإنسانية والأمنية في المناطق المتضررة".
وتأتي مجزرة مدينة بانياس ضمن عدّة مجازر استهدفت الساحل السوري بين يومي السادس والعاشر من آذار/ مارس، والتي راح ضحيتها "ما لا يقل عن 803 أشخاص، بينهم 39 طفلاً و49 سيدة (أنثى بالغة)، وذلك في الفترة الممتدة من 6 إلى 10 آذار/مارس 2025" وفق تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR).
وكانت المجازر في الساحل السوري قد بدأت بعد قيام مجموعةٍ من المسلحين، المحسوبين على نظام الأسد في يوم السادس من آذار/مارس ٢٠٢٥، بالاعتداء على قوات الأمن العام وفق ما ورد أيضاً في تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "وقد سجَّلت الشَّبكة مقتل 172 عنصراً على الأقل من القوات الأمنية والشرطية والعسكرية (قوات الأمن الداخلي ووزارة الدفاع) على يد المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد، إضافةً إلى مقتل ما لا يقل عن 211 مدنياً، بينهم أحد العاملين في المجال الإنساني، جراء عمليات إطلاق نارٍ مباشرة نفَّذتها هذه المجموعات".
ذنب أن تنجو
"نحن مسؤولون عمّا لم نفعل، بقدر ما نحن مسؤولون عمّا فعلنا". هذا ما قاله الفيلسوف الفرنسي، جان بول سارتر، في عبارة تبدو وكأنها كُتبت لأجل نوال، وتنطبق في الوقت نفسه على السوريين جميعاً. نوال التي ستعيش طيلة عمرها، كما قالت لنا، وهي تحمل ذنباً لم ترتكبه، ذنبَ النجاة من المجزرة في مدينة بانياس التي كان كلّ ما فيها هادئًا على نحوٍ خادع لحظة وصلتها مع رضيعها (٧ أشهر) يوم السادس من آذار/ مارس، بهدف حضور حفلة خطوبة ابنة أختها رنا. كان كل شيء يشير إلى أننا في يومٍ طبيعي كما تصف لنا؛ بائع الفطائر المتواجد في زاوية الشارع يفرشُ عجينته على صينيةٍ من نحاس، صوت الآذان، رائحة البحر المختلطة بدخان مصفاة بانياس الشهيرة..
أخبرتنا رنا (اسم مستعار/ ٢٤ عاماً)، أنها كانت قد اختارت في ذلك اليوم فستاناً سماويّ اللون ليوم خطبتها، وزيّنت شعرها بوردٍ أبيض صغير. أرادت أن يكون حفلها صغيراً، لا يتجاوز الأقارب والجيران. وصفت لنا ما تواجد على الطاولة من حلويات صُنِعت في البيت، والعصير والقهوة التي حضرها وجهّزها والدها مع طبق التمر والمكسّرات.
وقبلَ أن تبدأ الحفلة ببضع ساعات بدأ الهاتف المحمول في يد أحد أفراد عائلتهم يومض بإشعاراتٍ متلاحقة ورسائل قصيرة تتواتر عبر منصّة واتسآب: "انتبهوا، لا تطلعوا برا البيوت في حواجز جديدة على طريق بانياس"، "في أخبار بشعة عن مشاكل وتوترات بالقرى القريبة من بانياس".
ساد الصمت للحظة، كأنّ الجدران نفسها تكاد تتنفس مع الخوف وتسمع الهمس. نوال جلست على الأرض الباردة، تضغط رضيعها الصغير بين ذراعيها بقوّة، محاولة أن تمنحه شعوراً بالأمان. أحسّت بشيءٍ غامض في صدرها، مزيجٍ من الرعب والدفاع الغريزي عن حياة طفلها. شدّته إليها أكثر كأنّها تحاول أن تمنع العالم كلّه من الاقتراب منه. همست في سرّها، بصوت خافت لا يسمعه سوى قلبها: "إذا صار شي فَ الله دخيله هو الحامي".
عندما خنق الخوف الأزقة
بعد حوالي الساعتين (الرابعة مساءً تقريباً) وقبل أن تبدأ الحفلة بساعتين كما كان مخطّطاً (السادسة مساءً)، بدا "كأنّ السماء فجأة قرّرت أن تسقط فوقنا". هكذا وصفت لنا نوال ما حدث بعد أن بدأ إطلاقُ نارٍ كثيف، بدأت معه تفوح رائحة البارود لتدخل من الشبابيك المفتوحة، على وقع أصوات سياراتٍ قادمة من بعيد، رسمت ظلّ الرعب على الجدران.
نزلت نوال ومن معها بسرعةٍ إلى القبو الرطب أسفل العمارة. كلّ خطوة تُحدث صدى ضعيفاً على الجدران الخرسانية، كأنّ المكان نفسه يختنق من الخوف. احتضنت رضيعها بين ذراعيها، جسده الصغير يرتجف من البرد والرهبة، وعيناه تتسعان كما لو كان يعرف أنّ شيئاً ما يهدّد الحياة.
جاء الصوت الحاد للطارق على أحد أبواب العمارة، متبوعاً بسؤالٍ مباشر، قصير، بلا تردّد: هل أنتم علويون؟
الصمت الذي تلا السؤال كان ثقيلاً كأنّه يحبس أنفاس الجميع. كلّ ثانية امتدّت كدقيقة، وكلّ خفقة قلب كأنّها رصاصةٌ مُعلّقة في الهواء. كان هذا السؤال وحده يكفي ليفصل بين الحياة والموت، بين نجاةٍ مُحتملة ومصيرٍ قاتلٍ ينتظر من يُجيب.
الخوف كان يلتصق بجلدهم، ملموساً في ارتجاف اليدين وخفقان القلوب الذي يكاد يُسمع في صمت القبو. كان الصوت الأقرب إليهم هو وقع خطواتٍ ثقيلة، تقترب ببطء من مدخل العمارة التي يختبئون في قبوها الرطب، يرافقها صرير بابٍ مُتهالك يهتزّ مع كلّ خطوة.
ثم جاء الصوت الحاد للطارق على أحد أبواب العمارة، متبوعاً بسؤالٍ مباشر، قصير، بلا تردّد: هل أنتم علويون؟
الصمت الذي تلا السؤال كان ثقيلاً كأنّه يحبس أنفاس الجميع. كلّ ثانية امتدّت كدقيقة، وكلّ خفقة قلب كأنّها رصاصةٌ مُعلّقة في الهواء. كان هذا السؤال وحده يكفي ليفصل بين الحياة والموت، بين نجاةٍ مُحتملة ومصيرٍ قاتلٍ ينتظر من يُجيب.
نوال شعرت بأنّ الهواء قد اختفى، وأنّ كلّ جزءٍ من جسدها مترقّب. نظرت إلى فاطمة أختها ورأت في عينيها المرعوبتين خوفاً كالذي يملأ قلبها فابتلعت دموعها بصعوبة. كلُّ شيء حولهم أصبح مشحوناً بالرهبة: صدى الصوت، برودة الجدران، وطيف الموت الذي يلوح في الظلام.
فاطمة أم رنا تشدّ الحجاب على وجهها، وبصوت بالكاد يسمع تقول لهم: "لا تطالعوا صوت لا تحكوا شي، خليكم ساكتين". كانت هذه أوّل مرّة ترتدي فيها الحجاب. اعتقدت أنها قد تنجو، هي وعائلتها، إذا موّهت انتماءها العلويي بكذبةٍ بيضاء أو "أمل كاذب" كما وصفت لسوريا ما انحكت.
رحلتي القصيرة في فروع أمن سوريا (الجديدة).. إعادة معايشة التراوما أم تراوما جديدة؟
27 آب 2025
فجأة، اخترقت أصوات الرصاص مسامعهم. فصرخت نوال بصوت مبحوح: "هم دخلوا البيت اللي جنبنا!". غريزيّاً، وعلى وقع الخوف، تحرّكوا في القبو (كانوا ثمانية أشخاص) من دون اتجاهٍ محدّد. كلّ شخص يحاول أن يجد موضعاً للاختباء أو نافذةً ليرى ما يجري. ركض بعضهم نحو إحدى النوافذ الصغيرة، عيونهم تتابع الظلام في الخارج، لكن كلّ شيءٍ كان ضبابياً، غارقاً في أصوات الصراخ المُتقطّعة، وبقايا دخانٍ متسرّب من الحيّ.
شعرت نوال بأنّ جسدها يضيق من الرعب، عينها لا تفارق الرضيع، تحاول أن تحميه من كلّ شيء: من الرصاص، من الظلام، من الخوف الذي بدأ يتسلّل إلى داخلها. فاطمة وقفت بجانبها، تهمس بصوتٍ منخفض كأنها تتحدث إلى نفسها: "يا رب... خلّينا ننجو من هالليلة".
يبعد القبو عن مدخل البناية خمس درجاتٍ فقط، وهي الخطوات التي تفصلهم عن العالم الخارجي. طوله لا يتجاوز أربعة أمتار وعرضه حوالي مترين ونصف. السقف منخفض وجدرانه عارية. من جهة الشارع، توجد نافذة تهويةٍ صغيرة مستطيلة تسمح بمرور بعض الضوء. ومن خلالها كان بإمكان من يجرؤ على الاقتراب أن يلمح بعضاً من الظلام والحركة في الخارج.
صوت الرصاص يتكاثف متعالياً ومُترافقاً مع صوت انفجاراتٍ صغيرة، فيما الخوف يأكل قلوبهم، قبل أن تأتي يد الرحمة. تروي فاطمة أنّ جارهم في البناية نفسها، أبو عبدو، رجلٌ ستيني له وجهٌ مجعّد وخبرةٌ طويلة في الحياة كما وصفته. كان قد خرج لاستطلاع الطريق في الحارة. عاد إلى البيت مرتجفاً مع صوتٍ يحمل مزيجاً من القلق والخوف.
وعندما سألته زوجته أم عبدو بنبرةٍ مرتجفة وحذرة: "شو الوضع برا؟". أخذ نفساً عميقاً قبل أن يجيب بصوتٍ خافت لكنه مليءٌ بالإلحاح: "كارثي!! الوضع مأساوي، جارتنا فاطمة مع أهلها في القبو، يجب أن ندخلهم عندنا وندافع عنهم".
كانت كلمات أبو عبدو كجرس إنذار، وأدركت أم عبدو هنا حجم الخطر الذي يحيط بالحيّ. لكنها لم تتردّد، جلست بجانب النافذة تراقب المسلحين إلى أن رحلوا مؤقتاً. فتحت الباب بحذر، متجنّبة أيّ ضوضاء. نزلت إلى القبو بخطواتٍ سريعة لكنها حذرة، وناشدت نوال وفاطمة وأفراد العائلة بصوتٍ منخفض، لكنه حاد بما يكفي ليُسمع: "تعّوا لعندي بسرعة يا جماعة، لا تظلّوا هون!".
كانت لحظةً يختلطُ فيها الخوف بالإصرار. هي ترغب بكامل وعيها بحماية جيرانها وتدرك في ذات الوقت خطورة ما تفعل، إذ قد تدفع حياتها ثمنًا لهذه اللحظة الإنسانية، التي ستبقى راسخةً في ذهن عائلة نوال طيلة عمرها، حدّ أنهم أكدوا علينا مراراً التركيز عليهم في هذه الحكاية، إلى جانب حكايتهم، بل وطلبوا منا التركيز أكثر على الدور الذي لعبوه في إنقاذ حياتهم!
بأنفاسٍ متقطّعة، وخوفٍ يحتلّ العيون، دخلوا منزل أم عبدو غير مصدقين ما يحصل معهم حتى اللحظة. هم الآن داخل جدار منزلٍ آمن، يحميهم ولو مؤقتاً.
بيت أم عبدو .. فسحة أمانٍ في محيط القتل
دخل الجميع. فاطمة تمسك بأصابع يديها، تشدّ عليها بقوةٍ من شدّة توتّرها وتحاول أن تُبقي صوتها منخفضاً كي لا يسمعه أحدٌ من الخارج وكي لا يُسأل عن انتمائها ويُعرف دينُها.
من خلال فتحةٍ صغيرة، يرى أبو عبدو ظلّ شخصٍ يمرُّ بجانب النافذة، خطوات قوية ومختلطة بصوتِ صراخ: "هذا علوي، تفضّلوا!".
قلب نوال يخفق كأنّه يريد أن يفجّر صدرها. الرضيع يبكي بسبب البرد والذعر. تبكي أم عبدو أيضاً بصمت، تشعل شمعةً، تضعها في زاوية البيت، كما تصف لنا نوال ما حدث في تلك الليلة التي لم يكسر صوت صمتها سوى صوت أقدام عائدين من الفناء الخلفيّ. وجه أحد الجيران يظهر عبر الباب المشقوق، يقول بصوتٍ مغمورٍ بالخوف: "رأيتهم يقتادون رجلاً مسناً إلى السطح، سألوه إن كان من الطائفة العلوية، فأجابهم نعم، ثم سمعت طلقة".
حتى الطفل، الذي عادةً ما يملأ المكان بالبكاء، أدهش الجميع بصمته الكامل طوال الرحلة، كأنّ الصمت أصبح شكلًا من أشكال النجاة، لغة مشتركة بين الناجين والحارس الوحيد لهم في مواجهة الطريق المليء بالخطر.
الجيران كانوا قد علموا عبر تواصلهم عن طريق منصة واتسآب أنّ بعض الأسر السنّية تُخفي الجيران العلويين لحمايتهم من الاعتقال أو القبو.
عندما غطّ بعضهم في النوم من شدّة الإرهاق والخوف، بقيت نوال مستيقظة، تلمس يد رنا الصغيرة بين أصابعها في محاولةٍ صامتة لتخفيف القلق الذي يخنق قلبها.
في قاعدة حميميم
صباح السابع من آذار/ مارس قرّروا الرحيل إلى قاعدة حميميم العسكرية التابعة للجيش الروسي في اللاذقية. كان الخطر مُحيقاً بهم بعد ورود معلوماتٍ عن تفتيش البيوت والتأكّد من هويات الجميع، ما يعني أنّ الخطر لم يزل بعد، ناهيك عن كونه يهدّد العائلة التي حمتهم.
بعد تواصلٍ مع الأقارب والبحث عن أفضل صيغة للنجاة، وبناءً على نصيحة أبو عبدو وزوج نوال ذهبوا إلى القاعدة، على أن يلحق بها زوجها إلى هناك، لأنه كان من المستحيل عليه دخول مدينة بانياس وقتذاك.
تواصل أبو عبدو مع سائقٍ من الطائفة السنية يثق به. وافق على القيام بالمهمّة، لتبدأ رحلة هروبٍ شاقة عبر طرق متعرّجة وموحلة، مُحاطة بغاباتٍ كثيفة وأراضٍ مُحترقة. كانت القرى التي مروا بها تبدو كمدن أشباح؛ المنازل مدمّرة جزئياً، النوافذ محطّمة، والأبواب مهشّمة، بينما أعمدة الدخان الأسود ترتفع في السماء الرمادية، وكأنّ الأرض تحاول أن تبتلع كلّ أثرٍ للحياة هناك.
الخوف يملأ السيارة كما الغبار والدخان. نوال تشدّ رضيعها بين ذراعيها بقوّة، محاولةً تهدئته، بينما عيون الرضيع تتسع ويداه الصغيرتان تصطدمان بصدرها مع كلّ ارتجاجٍ للسيارة. رنا كانت بجانب أمها مُمسكةً بيدها، ترتجف أصابعها من الخوف، وزوج فاطمة يجلس خلف المقعد يحاول ضبط نفسه ليبدو مُتماسكاً أمامهم، لكن نوال تسمع صوت إطلاق نارٍ بعيد، يجعل قلبها يخفق بشدّة.
حكاية الساعات الأخيرة في حياة الحزب القائد
29 آب 2025
مع اقترابهم من بوابة القاعدة (حميميم)، ارتفع صوت الجنود الروس صارخين بأوامر مُتقطّعة، يفتشون السيارات بعناية وينظرون إلى وجوه الركاب بعينٍ مرتابة، وكأنهم يحاولون كشف أيّ تهديد مُحتمل.
داخل القاعدة، كان الجوع والرعب متكافئين في قسوتهما. الناس يفترشون الأرض ويتقاسمون البطانيات المُهترئة التي لا تقي من برد الليل ولا من الأحلام المُمزّقة التي تلاحقهم. الأطفال يبكون والنساء يبحثن عن لقمة طعام أو جرعة ماء.
وسط هذا المشهد، جلست نوال على الأرض الباردة تحت ظلّ جدارٍ رطب. طفلها الرضيع ملفوفٌ بوشاحٍ رقيق بالكاد يغطيه من البرد القارس. جسده الصغير يرتجف بشدّة، ووجهه شاحبٌ إلى درجة أنّ ملامحه بدت شبه شفافة، كأنّها على وشك أن تذوب في الهواء. كلّ نفَسٍ يأخذه يبدو كمعركةٍ صغيرة بين الحياة والموت، وعيناه تُبرزان خوفًا لا يعرف أحد كيف يخفّفه.
حاولت نوال أن ترضعه، لكن الحليب جفّ في صدرها، "من كتر الرعبة انقطع الحليب، ابني عم يضعف وما قادرة طعميه". قالت لنا باكية، وهي تشعر بالعجز ينهش قلبها، والذنب يثقل صدرها.
كلّ كلمةٍ خرجت من فمها كانت مشحونةً بالخوف والقلق، ويدها الصغيرة تحاول أن تُدفئ الطفل، بينما قلبها يصرخ بصمت، محاولًا أن يلاطفه ويعطيه شعوراً بالأمان، الذي لم تعرفه هي نفسها منذ لحظة مغادرتها بانياس.
العودة إلى طرطوس
في اليوم الثاني لتواجدهم في قاعدة حميميم، الموافق 8 آذار/مارس، استطاع زوج نوال أن يؤمّن لهم سيارةً كبيرة، بعد أن دفع مبلغ كبيراً (لم يُكشف عن قيمته)، لسائقٍ يعرفه ويثق به منذ زمنٍ بعيد ويعمل في المنطقة. وافق السائق (وهو من الطائفة السنية أيضاً) على أن يقطع بهم الطريق الخطر من حميميم إلى طرطوس، رغم المخاطر الواضحة على جانبي الطريق.
كان الطريق أشبه بخطّ الموت، يمتدّ عبر مساحاتٍ مفتوحة، طرق متعرجة، وقُرى أصابها الدمار والرماد. كل شجرة وكل زاوية من الطريق بدت وكأنها تخفي خطراً مُحتملاً، والهواء نفسه كان ثقيلاً برائحة الدخان والغبار. لم يتبادل أيٌّ منهم كلمة طوال الرحلة، وكلّ حركة أو صوت بدا كتهديدٍ صامت.
حتى الطفل، الذي عادةً ما يملأ المكان بالبكاء، أدهش الجميع بصمته الكامل طوال الرحلة، كأنّ الصمت أصبح شكلاً من أشكال النجاة، لغة مشتركة بين الناجين والحارس الوحيد لهم في مواجهة الطريق المليء بالخطر. نوال تشدّ الطفل بقوّة بين ذراعيها، محاولة أن تمنحه بعض الأمان، بينما تراقب كلّ حركةٍ أمام السيارة بعينين مفتوحتين، وقلبها يخفق بسرعة مع كلّ سيارةٍ عابرة أو ظلٍّ على جانب الطريق.
موتٌ من حيث لم يتوقع أحد
عند وصولهم إلى طرطوس، كان التوتّر والخوف لا يزال يثقل كواهلهم، فجاءت اللحظة الأولى من الأمان مؤقّتة، إذ سكنوا في بيتٍ صغير تملكه قريبة فاطمة. البيت رغم بساطته، كان كافياً ليمنحهم شعوراً مؤقّتاً بالاستقرار، مع جدران مطلية بألوانٍ باهتة وأرضية من البلاط البارد. نافذةٌ صغيرة تطلّ على الشارع الضيق، وبابٌ خشبيّ يذكّرهم صريره دوماً بالحيطة والحذر والرعب والموت القريب، الذي جاءهم من حيث لم يتوقعون.
بعد عودتهم بيوم واحد فقط من قاعدة حميميم، بدأ الطفل يضعف أكثر فأكثر. حرارته ارتفعت كثيراّ ونبضه صار واهناً. حاولت نوال أن تطعمه حليباً مُجفّفاً لكنه رفضه واستفرغ، ثم نام نوماً عميقاً لم يُفق منه.
كانت ليلةً طويلة، قاسية، لا ضوء فيها، الليل فيها ساكنٌ أكثر من العادة، كأنّه تواطأ مع الحزن ليُخفي أنفاس البيت. نوال انهارت وجلست على الأرض، تحتضن جسده الصغير وقد بدأ يبرد بين يديها. لم تصرخ نوال كما أخبرت سوريا ما انحكت عندما التقتهم في منزلها، لم تبكِ لكنها غابت عن الوعي فهي لم تتحمّل إطلاقاً موت ابنها الرضيع.
بعد عودتهم بيوم واحد فقط من قاعدة حميميم، بدأ الطفل يضعف أكثر فأكثر. حرارته ارتفعت كثيراّ ونبضه صار واهناً. حاولت نوال أن تطعمه حليباً مُجفّفاً لكنه رفضه واستفرغ، ثم نام نوماً عميقاً لم يُفق منه.
في الصباح التالي بتاريخ ١٠ آذار/ مارس غُسّل الطفل ولفّ بقطعة قماشٍ أبيض. رنا ابنة خالتها، جلست قربه تحت الضوء الخافت، تغطي وجهه بيدٍ مرتعشة، ودموعها تنزل بصمت وقهر.
زوج نوال من هول صدمته وحزنه يصلّي طوال الوقت، وقد رفض النظر إلى وجه رضيعه عندما تأكّد من وفاته. كما أنه رفض تسليمه للممرّض الذي قدمَ من منظمة الهلال الأحمر بطلبٍ هاتفيّ من فاطمة أختها كمحاولةٍ أخيرة علّهم ينقذونه!! ولكن قدر الله كان أسرع من وصول الإسعاف، زوج نوال رفض تصديق أنّ ابنه حقاً فارق الحياة ، وقال لسوريا ما انحكت أنه قد استفاق من صدمته حين صرخت نوال في وجهه وقالت له: "ليش ما رحت معي لبانياس، ليش ما كنت معي هونيك وحميتنا ليش؟".
نوال كانت تتحدّث بصوتٍ متقطّع لسوريا ما انحكت عن تلك اللحظة، عن الذنب الذي التصق بها كظلٍّ لا يفارقها. قالت إنها تُلقي باللوم على زوجها أحياناً، فقط لتخفّف عن نفسها وطأة السؤال، لتقنع نفسها أنّ أحداً آخر غيرها مسؤول عن موت طفلها. طلبتْ منه البقاء يوم 6 آذار/ مارس على أن يلتحق بها في يوم 7 آذار، ولم يستطع بسبب ظروف عمله، لكنها تعلم جيداً في أعماقها أنها كانت وما زالت تقاتل المستحيل: "أنا اللي حملت ذنب، بحسّ حالي أم مو صالحة وكتير بخاف جيب ولد تاني بهالبلد".
بعد أسبوعين من الإقامة المؤقتة في منزل نوال استطاعوا استئجار منزلٍ آخر بفضل الأموال التي وصلت إليهم كمساعداتٍ من جيران نوال، وأشخاص غرباء قد سمعوا بقصّتهم، وتفاعلوا معهم بتعاطفٍ إنساني. كان لهذه الأموال دورٌ مزدوّج: إعادة بناء مساحاتٍ للعيش، وأيضاً تخفيف جزءٍ من العبء النفسي الذي حملوه طوال رحلة الهروب.
كما قدّمت بعض الجمعيات الإنسانية العاملة في المدينة مجموعةً من المساعدات التي كانت حيويةً لاستقرارهم (أدوات مطبخ، ألبسة، فرش أسرّة، زيت الزيتون، زعتر، مكدوس، وحبوب متنوعة). كلّ هذه الأشياء، على رغم بساطتها، كانت تمثّل لهم الأمل بقدرة الحياة على الاستمرار، وشعوراً بأنّ هناك من يهتم بهم، وأنّ الإنسانية لم تمت تماماً رغم كلّ ما شهدوه من دمٍ ورعب.
منذ وفاة الرضيع، لم يغادر البكاء مُقلتي نوال، إذ تقول جارتها هيام (اسم مستعار/ خمسون عاما) أنها يومياً تسمع صوت بكاء نوال حين تحاول الخلود للنوم ..
تحاول نوال أن تصلّي لكنها تشعر أنّها لا تستحق حتى الغفران، لأنها نجَت بينما مات ابنها، فيما تقول لنا أم عبدو التي كان لها دورٌ كبير في إنقاذ عدّة عائلات بعد أن تواصلنا معها عبر واتسآب: "مافي شيء إسمه طائفة لما تشوف دم البريء قدامك، يومها حسّيت إنو الله عم يختبر قلوبنا، مو طوائفنا".