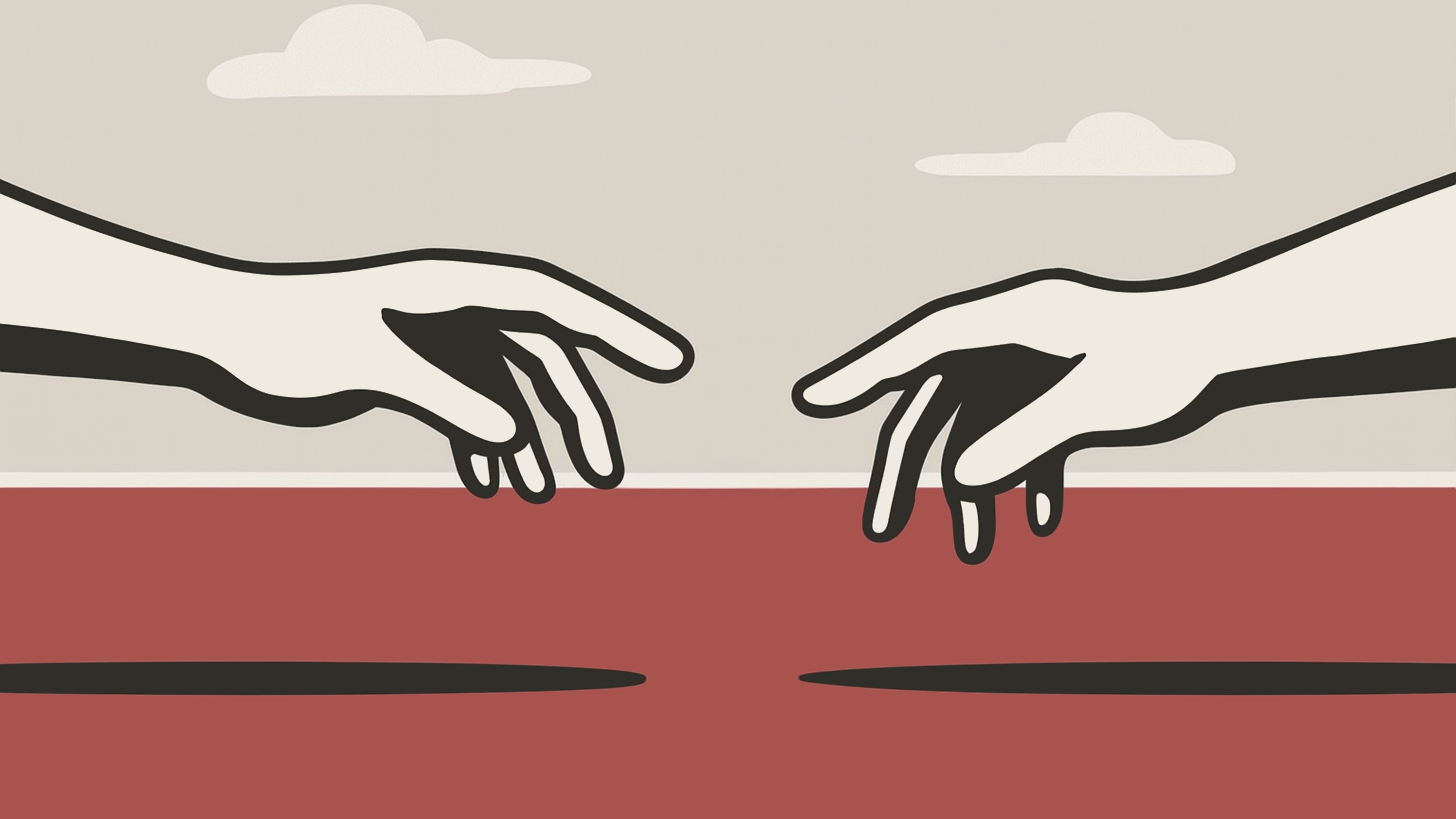ماذا تعيش سوريا اليوم؟ نشهد منذ سقوط نظام الأسد أنماطاً من الإبادة الطائفية والقتل والسرقة، تُفسَّر حسب بعض النظريات في علم الاجتماع السياسيّ، ودراسات النزاع ما بين انهيارٍ في الدولة وقوانينها، الخوف والطائفية، الانتقام الفردي والجماعي، الاقتصاد المستند إلى العنف، غياب العدالة الانتقالية، الانهيار الأخلاقي، والتصوير النفسي للخصم كغير إنساني. غالباً ما يتم التركيز على أحد هذه العوامل في تحليل الحال السورية اليوم، من دون توضيح حجم التداخل بينه وبين العوامل الأخرى المغفلة. هذه محاولةٌ لعرض عددٍ من التفسيرات النظرية التي يمكن أن تساعد في فهم المواقف، المختلف، لأطراف نزاع الأمس وفرقاء اليوم.
الطائفية، معضلة الأمن
لا يمكن اختزال مسببات الصراع السوري في سببٍ واحد، إذ جاءت نتيجة طبقاتٍ من المظلومية الاجتماعية، والاستبداد السياسي، والهويات الطائفية، وهشاشة الدولة، والتدخلات الخارجية. مع السقوط توطدت حالةٌ من السيطرة العسكرية، كانت قد سادت سابقاً في كثير من المناطق السورية جزئياً أو كلياً نتيجة تفكك المؤسسات الأمنية. عدم قدرة السكان على الاعتماد على جيشٍ وشرطةٍ وقضاء أدى إلى ظهور فراغٍ سلطويّ، يسمح للفواعل المسلحة المحلية بالسيطرة على حياتهم. عندما تصبح القوة والسلاح هما القانون الفعلي، تخلق البيئة المناسبة لممارسة القتل الفردي والجماعي، وتوفّر الظروف الملائمة للنهب والسطو والتخريب.
والآن وقد تغيرت موازين القوة، تسعى الأطراف المتضررة خلال الحرب للانتقام من خصومها عبر تصفية حساباتٍ فرديةٍ وجماعية، وقتلٍ متعمد للخصوم أو المشتبه بانتمائهم إلى الطرف الآخر. ويعد تزايد الخوف بين الجماعات، من أبرز سمات ما بعد الحرب الأهلية، وذلك كنتيجةٍ نفسية لبيئةٍ أمنية يسمها عدم الثقة. يشعر كل طرفٍ في المجتمعات متعددة الطوائف بأن الآخر قد ينتقم منه إن لم يُبادِر بالهجوم، فيصبح العنف وقائياً. تتفاقم بالنتيجة عمليات القتل الطائفي والتطهير العرقي، مع تفكك المعايير الاجتماعية، وتعطُّل القيم الأخلاقية، كتلك المتعلقة بالحماية كالمروءة ومساعدة الجيران، بينما يكرَّس نزع الإنسانية، ما يؤسس لإنتاج العدو الوجودي الذي يسهل قتله ونهبه، ويبرر لذلك أخلاقياً بسهولة داخل الجماعة الواحدة.
في هذه الأثناء يساهم اقتصاد الحرب بدرجةٍ كبيرة بدفع شبان مهمشين نحو العنف بغاية السلب، فتتحكم بهم فصائل يشكل اقتصاد الحرب مصدر رزقها الأساسي، الذي يراد له أن يبقى مستداماً. غياب جدولٍ زمني واستراتيجيةٍ واضحة لمسار العدالة الانتقالية يُضعف الإيمان بإمكانية تحقيق العدالة، ويفتح الباب لمسار محاسبةٍ فرديٍّ وجماعيّ خارج الأطر الرسمية، بينما قد يشعر الناجون من المحاسبة بالحصانة، مما يولد عنفاً إضافياً. خروج السجناء الجنائيين عند سقوط النظام، يعني وجود أعدادٍ كبيرة من محترفي استخدام الوسائل غير القانونية، أحراراً، يسعون لتحقيق مآربهم وتحصيل "رزقهم" من السوريين اليوم.
تأتي الاحتجاجات متنوعة، وكنتيجةٍ طبيعية لغياب الأمن. لكن الخوف المتبادل، والخطاب الموجَّه إلى جماعاتٍ متمايزة، يحولها بسرعةٍ إلى العسكرة، ما يعقّد الموقف أكثر. تزيد العوامل الخارجية من هذا التعقيد، حيث يرتبط استمرار الصراع بحساباتٍ سياسية واستراتيجية لقوى محليةٍ وإقليمية ودولية، ترى في الساحة السورية مجالًا لتحقيق مصالحها. كان مستوى التدخل الخارجي هو ما حوّل النزاع السوري من ثورةٍ محلية إلى حرب متعددة المستويات الإقليمية والدولية، وأسهم في إطالة أمده وتعقيد مسارات حله.
بالإضافة إلى ذلك، يصبح العنف سبيلاً للمتعة أو وسيلة للتنفيس النفسي في البيئات التي تشهد صدماتٍ جماعيةً طويلة الأمد. يؤدي التعرض المستمر للعنف والصدمات النفسية الجماعية إلى تشوهاتٍ سلوكية تجعل بعض الأفراد يجدون متعةً في ممارسة العنف، خاصة في غياب أيّ عقابٍ أو رادعٍ اجتماعي. أيضاً، غالباً ما ترتبط حالات القتل العمد دون تبريراتٍ عسكرية كافية بالاستعراض الشخصي للقوة، وبالترهيب وإظهار التفوق المسلح.
إلى أيّ غد؟
من الناحية المؤسساتية، إعادة بناء الدولة ومؤسساتها القضائية والأمنية ضرورةٌ أساسية لإيقاف الانفلات القانوني والحدّ من الجرائم في مرحلة ما بعد الحرب، لكن هذا البناء يحتاج وقتاً، فيما تتراكم أسبابٌ جديدة للصراع منها التصعيد العنيف الذي جرى في الساحل والسويداء. من غير المقبول أن تبقى الفصائل المحلية خارج إطار جهاز الدولة، لكن هذا الجهاز غير قادرٍ بعد على ضمان تطبيقها القانون بفعالية.
هناك حاجةٌ إلى المزيد من الوقت أيضاً للتحضير لإجراء محاكماتٍ عادلة للجرائم المرتكبة أثناء الحرب، وبرامج كشف الحقيقة والمصالحة لتعويض الضحايا وإعادة الاعتبار لهم. ولا بد لحدوث هذا من انفتاحٍ شامل بين الفاعلين في ملف العدالة الانتقالية، الأمر الذي يعوقه تاريخٌ من المشكلات الشخصية وتبدل الانحيازات وانعدام الثقة. في هذه الأثناء يزداد شعور الضحايا بالغبن ولا يُمنَح المجتمع إطاراً قانونياً وأخلاقياً لمعالجة الصدمات الجماعية، وكسر دائرة العنف المستمر.
كأنها القيامة: الصفحة الأخيرة في دفتر هزيمة نظام الأسد
08 كانون الأول 2025
برامج تسليم الأسلحة وتوفير حوافز لإعادة الدمج المهني والاجتماعي للمقاتلين السابقين تقلّل من تأثير شبكات اقتصاد الحرب، لكنها تحتاج إلى دعم الحكومة الاقتصادي، غير المتوفر، ونيّتها غير الموجودة بعد. تحفيز التجارة والاستثمارات المحلية يخلق بيئةً مستقرة ويقلل من الانخراط في العنف، لكن عدم القدرة على البدء بإعادة إعمار المدن والقرى المدمرة يساهم في تقويض إحساس العدالة ويعيدنا إلى خانة الصراع، فيما يعتبر الانفتاح المتسرع مخرباً للصناعة القائمة ومولداً للاحتقان في بيئةٍ مشحونة أساساً.
وليس آخراً، أن تسلّم مبادرات معالجة الانقسامات الطائفية الساحة إلى منصات التواصل الاجتماعي وتواجه عبرها حملات الكراهية ونزع الإنسانية، بدل أن يكون لها اليد العليا في التأثير وتقليل الاستقطاب. تقف معوقاتٌ كثيرة أمام الحدّ من ارتكاب الجرائم بعد الحرب، والتحول من حالة الفوضى المسلحة إلى السلام، وصناعة مسارٍ واضحٍ وممكنٍ لذلك أساساً. وتقوّض هذه المعوقات عملية بناء الدولة رغم ازدياد الحاجة إليها كهيكلٍ يُستند إليه في التعامل مع العنف.
في الوقت الحالي، لا يمكن نبذ العنف من دون أن يلعب الجميع دوره في تعزيز ثقافة الحلّ وتبني موقفٍ عمليّ وهادئ، مبادر وذي نفس طويل، ينأى بنفسه عن التسرع في تصيد الزلّات ويعلي من أهمية الدقة والشمول في الطروحات بين المجتمعات والتوجهات.
تحتاج سوريا الكثير من الثقة لتعاود امتلاك أمرها والبتّ فيه، ثقةٌ بأننا نستطيع إيجاد طرق تعويضٍ وتشميلٍ وتفاهم، اليوم وغداً، ثقةٌ يمكننا افتراض أننا نتحكم فيها ونرغب بردِّ من يقوضها، لا قذفه إلى مسار تخريب علاقة السوريين ببعضهم نهائياً.