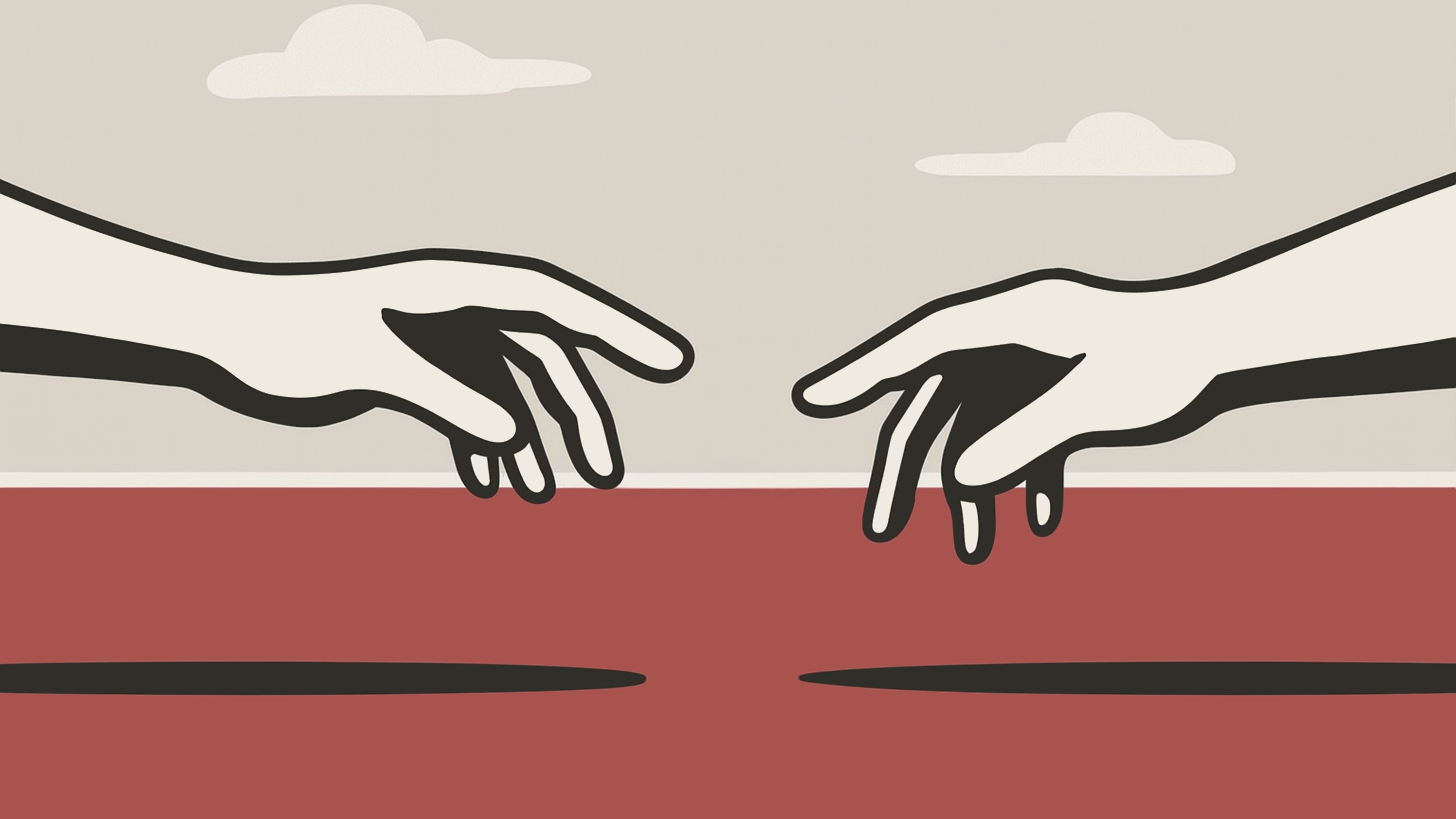منتصف ليل 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024. كأس الشاي الحمراء تشعّ على ضوء الليدة الوحيدة في دشمة خارجة من الأرض وممتدّة طولاً بضعة أمتار قرب تلةٍ مُعتمة تقريباً. يعدّ الرجل الخمسيني عدد إشارات تغطية شبكة الهاتف الخلوي: اثنتان من خمسة. الأمور جيّدة إذاً ولا تشويش على الشبكة.
يفرك الرجل عينيه بهدوء. الواحدة إلا ربع من صباح اليوم التالي، يوم ميلاد ابنته سماح. من فتحة الدشمة تبدو نقاط الحراسة ساكنة وحولها أشباح جنودٍ يتحرّكون بحذر. يدخّن العقيد في الجيش السوري، داوود، آخر سيجارة قبل أن ينام بثيابه العسكرية ويسلّم المراقبة لزميله النائم. الجيش كلّه في حالة استنفار ولا مجال لتضييع الوقت بارتداء الألبسة. في تلك اللحظة يتذكّر إرسال رسالةٍ لابنته. يفعل ثم يغطي عينيه بقطعة قماشٍ سوداء.
على يسار الدشمة يقف الرقيب "أبو خليل" بجثته الضخمة مُتردّداً يميناً ويساراً. هذا المارد عاد الأسبوع الماضي من رحلته إلى حلب حيث ودّع أخاه الذاهب إلى ألمانيا. تنتمي هذه النقطة العسكرية إلى الفوج 47 التابع للفرقة ثلاثين، التي تنتشر بين محافظتي حلب وإدلب على خطوط تماس قوات المعارضة السورية المسلّحة مع الجيش السوري، كما أخبرنا داوود. الدشمة نفسها تتوضّع في (تلة الدريجات) بين قريتي قبتان الجبل والشيخ عقيل شمال غرب حلب، على الخطّ الأوّل في تلك الجبهة المستقرة منذ العام 2020 مع توقّف المعارك وقتها. لدى داوود معلوماتٌ من القيادة العسكرية أنّ المعارضة ستنفذ هجوماً على محور إدلب - حلب، وأنّ الجميع مستعدٌ لمواجهة هذا الهجوم. كما أنّ "الجيش استنفذ بالاستنفارات التي حدثت قبل الهجوم، عشرة أيام في حالة ترقبٍ وانتظار ليلاً نهاراً".
السابعة و23 دقيقة صباحاً 27 تشرين الثاني، سمع داوود أزيز أشياء فوق رأسه. نظر إلى السماء الرمادية. كانت طائراتٌ مُسيّرة انتحارية من صناعة "المسلّحين"، كما يسميهم، سوف تُعرف لاحقاً باسم "الشاهين"، رؤيتها على أرض الواقع كانت شيئاً مختلفاً تماماً. "إلى مواقعكم!" صرخ داوود، لكن صوته اختفى في دوي انفجاراتٍ مدوية. تحوّلت نقطة حراسةٍ قريبة إلى كرة نار، موديةً بحياة جنديين.
فجأة، سمع أصوات محرّكات. لم تكن محركات دباباتٍ ثقيلة بل كانت دراجاتٍ نارية، مزوّدة برشاشاتٍ قواعدها موضوعةٌ على السنّادات (السيبة) تخرج من ممراتٍ جانبية قرب التل. النار في كلّ اتجاه، بينما استمرّت المسيّرات بقصف المواقع.
رفع داوود بندقيته وأطلق النار باتجاه إحدى الدراجات المقتربة، ثم بدأت البيكابات بالتدفّق بسرعة، وعلى متنها رماةٌ يطلقون رشقاتٍ قصيرة. سمع صراخاً إلى جانبه. كان أبو خليل قد سقط على الأرض مُمسكاً بصدره بعد اختراق رصاصةٍ درعه الواقي. "انسحبوا، انسحبوا!" صاح داوود.
صباح 27 / 11 أعلنت المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام إطلاق عملية "ردع العدوان". دارت معارك عنيفة بين الجيش السوري وهيئة تحرير الشام التي نفّذت هجوماً خاطفاً على بلدات وقرى في ريف محافظة حلب الغربي من بينها تلة الدريجات، وخلال ساعات سيطرت على 32 قرية ونقطة وتابعت تقدّمها باتجاه مدينة حلب ووصلتها بعد يومين ورفعت العلم على باب قلعتها.
بينما كان يحاول تنظيم انسحاب رجاله، انفجرت قذيفةٌ قريبة أطاحت به أرضاً. شعر بألمٍ حاد ثم غاب عن الوعي. عندما استيقظ بعد ساعات، كان الظلام قد حلّ والصمت يخّيم على التلة. يكمل داوود روايته لتلك الساعات الفاصلة في حياته: "نظرت حولي فوجدت جثث رجالي متناثرة، بينما كانت معداتهم العسكرية مبعثرة في كلّ مكان. سمعت أصواتاً بعيدة، توقعت أنّ "الإرهابيين" يواصلون تقدّمهم بعد أن حسمت معركة التلة لصالحهم. تركوني ربما لاعتقادهم أنني قتلت".
نهض داوود نحو الدشمة نصف المُدمّرة. خلع بدلته المُلطّخة بالدماء وارتدى بيجاما رياضية كانت هناك. يروي والدموع تغالب وجهه: "ألقيت بدلتي وهويتي العسكرية في حفرةٍ سطحية وغطيتها بالتراب. في تلك اللحظة كنت أدفن نفسي حيّاً في ذلك التراب الذي قضيت فوقه سنوات، أعمل كي لا تحدث هذه اللحظة".
يكمل داوود من منزله في الساحل السوري حكاية اليومين الأخيرين في الجيش الذي قضى فيه زهوة عمره: "مشيت مُسترشداً بحدسي بموازاة الطريق الدولي M5، اختبأتُ من سيارات التويوتا علامة المعارضة مع الدوشكا التي تعبر الطريق مسرعة. لجأت إلى البيوت المدمّرة. أما الأكل والشرب فكانا آخر همي، كل خطوة على قدمي المصابة كانت تذكّرني بسقوط التلّة".
في اليومين التاليين، قطع حوالي خمسين كيلومتراً. اختبأ في قبو بيت مدمّر في قرية (الزربة). نام من الإرهاق. في ضوء النهار، سمع مزارعاً محلياً يخبر جاره: "سمعت عم يقولوا خلصت حلب، صارت بإيد الهيئة". كانت تلك هي المرّة الأولى التي يسمع فيها بتفاصيل ما بعد معركته. لم تكن حلب قد سقطت بالكامل بعد، لكن الإشاعات تدفقت. مع الليل خرج واستأنف سيره جنوباً.
سار داوود وهدفه الوحيد الوصول إلى مشفى السقيلبية الوطني. توقفت قدماه مع عبور سيارةٍ عسكرية حملته من طريق الـ M5. حتى وصل إلى المشفى، يقول: "بقيت ساعات ومن ثمّ نقلوني إلى مشفى حماة الوطني بسيارةٍ خاصة لإكمال العلاج. لا أتذكر من تلك الرحلة سوى حديث صاحب السيارة اللئيمة وهو يروي تقدّم قوات المعارضة ويقول "انتصرنا بعد خمسة عشر عاماً من الصبر".
عند مشارف معر زيتا توقفت قدماه. كان المشهد كأنّه يوم القيامة: سياراتٌ محمّلة وأسرٌ تفرّ من المنطقة، وجنودٌ بملابس مدنية يحملون سلاحهم الفردي الخفيف. دباباتٌ واقفة في طرف الطرقات من دون حركة. على جنبات الطرق آلياتٌ عسكرية مشتعلة أو مدمرة.
سار داوود وهدفه الوحيد الوصول إلى مشفى السقيلبية الوطني. توقفت قدماه مع عبور سيارةٍ عسكرية حملته من طريق الـ M5. حتى وصل إلى المشفى، يقول: "بقيت ساعات ومن ثمّ نقلوني إلى مشفى حماة الوطني بسيارةٍ خاصة لإكمال العلاج. لا أتذكر من تلك الرحلة سوى حديث صاحب السيارة اللئيمة وهو يروي تقدّم قوات المعارضة ويقول "انتصرنا بعد خمسة عشر عاماً من الصبر".
منذ وصوله إلى منزله في اللاذقية في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر 2024 وداوود يراقب شاشة موبايله بحثاً عن تغيّرٍ قد يحصل أو نداءٍ قد يتلقاه للعودة إلى القتال، حصل التغيير ولكن ليس إلى جانبه. يقول قبل أن يروي لنا وقائع ليلة السابع حتى العاشر من كانون الأول/ ديسمبر: كنت مؤمناً بالمؤسسة التي أفنيت عمري فيها، وبقيمٍ كثيرة انهارت بسبب شخصٍ أحمق أورث البلد خراباً بلقعاً. وصلت ذروة توتري حين شاهدت الطيران الإسرائيلي يقصف مواقع الجيش السوري من الساحل حتى حلب. تلك اللحظة كادت تقتلني بذبحةٍ قلبية لولا رعاية زوجتي الطبيبة لي. أعطتني مُميّعات الدم والمسكنات حتى هدأتُ ونمت مجبراً: "أكان كل هذا وهماً؟ ليس لدي يقينٌ سوى يقيني أنني نجوت من الموت لكن روحي مدفونةٌ في حفرةٍ ضحلة على تلة الزيتون".
حين اختفى سلاح الطيران من الجو
في مشفى حماة التقى داوود بالمقدّم عليّ (35 عاماً) من مدينة حمص، قائد حوامة، وصل إلى المشفى بعد إصابته بطلقاتٍ نارية في فخذه أثناء محاولته النجاة من مطار حماة العسكري. ساعدنا داوود في التواصل مع علي المقيم حالياً في حمص بعيداً عن الأنظار.
يروي علي: "في الساعات الأولى من صباح 30 تشرين الثاني/ نوفمبر جاءني اتصالٌ على هاتفي الخليوي للتوجّه بسرعة إلى مطار كويرس. قطعت المسافة من بيتي في حي الحاضر إلى مطار حماة في عشر دقائق. ومن هناك إلى كويرس بالحوامة. من الجو رأيت مشهداً لا يتكرّر ولا أظنه سيتكرّر: مئات السيارات والعربات والأشخاص يتدفقون إلى المدرجات الممتلئة بالحوامات. ثماني حوّامات كانت هناك، والجميع يبدو مستعجلاً".
عن حال الإعلام السوري المستقلّ خلال عام ما بعد السقوط.. تغطية اختطاف النساء مثالاً
03 كانون الأول 2025
حين هبطت، جاء إلى الحوامة ضابطٌ برتبة عميد سألني فوراً: أنت المقدّم فلان؟ أجبت نعم متغاضياً عن الطريقة التقليدية في تقديم الأسماء العسكرية. ردّ العميد: "لا تحمّل حدا. دقائق ويجوا اللي لازم تنقلهم على حماة فوراَ".
ذلك اليوم 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 على الجهة المعاكسة من حلب، دخلت هيئة تحرير الشام ومن معها إلى المدينة. يروي علي: "في ذلك اليوم أقلعت طائرةٌ حربية سورية من كويرس ثم عادت إلى المطار بعد وقت، انتبهتُ إلى أنّ الطيّار أوقف طائرته ثم بدل ثيابه وغادر بسيارة خاصة. في التوقيت نفسه تقريباً عرفت من الموجودين في المطار أنّ هذه الطائرة قصفت بعدّة صواريخ دوار الباسل على الأطراف الغربية لمدينة حلب". يؤكّد علي: "كانت هذه من آخر طلعات الطيران الحربي السوري. توقّفت حركتها في كويرس وبقينا نحن والحوامات".
تسبّبت تلك الطلعة بوقوع مجزرة راح ضحيتها 16 مدنياً بينهم أطفالٌ وسيّدات وكوادر طبية إضافة إلى إصابة 70 آخرين بجروح، وفق ما نقل وقتها المرصد السوري لحقوق الإنسان مضيفاً إنّ حصيلة القتلى منذ بدء هجوم الفصائل في المنطقة وصلت إلى 327 شخصاً على الأقل. يعلّق علي: "لم يرغب هذا الطيار بأن يترك ذكرى طيبة ويمتنع عن جريمته مع معرفته - ربما - أنّ الذين على الدوار كانوا مدنيّين".
"بينما كانت أنباء المجزرة تنتشر، كنت أشاهد القيادات تتدافع للحصول على مقاعد في الحوامات. وصل إلى المطار محافظ حلب وقيادات الشرطة والأفرع الأمنية. يقول علي "فيما بعد صعد عشرة أشخاص، بعضهم أعرفه بالشكل. من بينهم رئيس اللجنة الأمنية في حلب وضابطان من الفرق القتالية مع امرأة لم أعرفها. كانت الأولوية نقلهم إلى حماة، حتى تلك الساعة لم أكن أفهم مما يجري سوى أنّ غرب حلب حتى القلعة سقط بيد المسلحين".
أغلق أحدهم باب الحوامة وأعطى علياً أمر الإقلاع. من الجو شاهد الطيّار الازدحام الخانق على طريق أثريا خناصر نحو تدمر ومنها إلى حمص: آلاف السيارات والشاحنات والعربات المدرّعة والأفراد الذين يمشون، غالبيتهم من العسكريين.
بعد حوالي ثلثي الساعة من الطيران هبطنا في مطار حماة العسكري. "نزل الجميع واتجهوا إلى سياراتهم مُسرعين وبقيت وحدي في المروحية لدقائق. اتجهت إلى منزلي فوجدت عائلتي في انتظاري للخروج من الضاحية. غالبية الناس في جواري من العسكريين المُرتبطين بالنظام السابق، لم يطل الانتظار وضعتهم جميعاً في سرفيس وأرسلتهم إلى بيت العائلة في حمص وعدت للمطار بسبب تلقي طلب نقلٍ آخر من كويرس من قبل قائد إحدى الفرق القتالية. حين وصلت المطار سمعتُ أصوات إطلاق نار وسيارات وتكبيرات."
بين 30 تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٢٤ و5 كانون الأول/ ديسمبر 2024، كان المطار، الذي يضم مدرجه الرئيسي ومرابض طائرات الميغ-21 والميغ-29، يشهد عملية إخلاءٍ محمومة للطائرات العاملة نحو قواعد في الساحل السوري، بينما تُركت الطائرات المُعطّلة ومستودعات الذخيرة لمصيرها. في ذلك اليوم فقد علي حوامته بعد إطلاق النار عليها من قبل مسلحي المعارضة الذين حاولوا اقتحام المطار. اخترقت رصاصةٌ فخذه فيما كان يحاول النجاة من الدفق المجهول. ركب سيارته واتجه إلى أقرب مشفى "ربما كانت هذه الرصاصة هي التي أنقذتني من مصيرٍ مجهول، وجعلتني ألتقي لاحقاً بداوود في المشفى".
في المشفى استعرض عليً حياته السابقة منذ دخل الكلية العسكرية الجوية في حلب وصولاً لما يجري الآن. لم يكن علي ممن رمى البراميل على السوريين، ولكنه نقل مئات الضباط عبر الجبهات لسنوات. "كم كان هذا النظام أحمقاً وغبياً، سوف تكون أمامي رحلة جديدة صعبة". لا يمكن له الفرار خارج البلاد في هذه اللحظات لأن أهله ينتظرون منه خبراً عن سلامته. بعد مئات الاتصالات التي وردته ولم يرد عليها. حمل هاتفه الخليوي واتصل بأبيه القلق. اطمأن الوالد على ابنه قبل أن يغلق عليّ جهاز الخليوي وهو يفكّر: وماذا بعد؟ غادر علي المشفى بعد أن وصلت طلائع هيئة تحرير الشام إلى حماة وانتشرت في المدينة. أخفى هويته في جيبٍ داخل ثيابه المدنية وقاد إلى حمص.
من حمص إلى طرطوس
حين عبر المقدّم علي أمام الكلية الحربية في منطقة الوعر في حمص، متجنباً الأوتوستراد الرئيسي بين حماة وحمص بسبب الازدحام الخانق للمتدفقين من جهات سوريا الأربعة إلى حمص وحماة والساحل، كانت الساعة قد قاربت الواحدة صباحاً 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.
على سور الكلية وفوق المحرس المواجه لحي الوعر على ارتفاع ستة أمتار وقف "أحمد" حاملاً بندقيته الآلية متلفعاً بشالٍ صوفي أهدته له والدته ليقيه من البرد في انتظار ما لا يعرف. أحمد طالب ضابط في السنة الثالثة في الكلية من مدينة بانياس.
يروي أحمد وقائع الساعات الخمس الفاصلة بين حياته واحتمال موته الكبير ذلك الوقت قائلاً: "كان قد مضى يومان ونحن مشتبكون، وكلّ ساعتين تصل أنباء عن إخلاء الجيش لمنطقةٍ من المناطق القريبة من حماة وحمص. كنا في منتهى الجاهزية. وزعونا نحن الطلاب على مجموعاتٍ مساندة لحراسة الكلية. وقت طلع الطيران وضرب الرستن توقف القتال لوقت قصير وقالوا في هدنة. وصلت موتورات على باب الكلية صاروا يضربوا رصاص علينا".
لم يكن مسموحاً للطلاب الانسحاب من مواقعهم حسب قول أحمد "مر الوقت من منتصف الليل حتى الثالثة صباحاً حين اكتشفنا نحن الطلاب أنّ القيادات الكبيرة في الكلية هربت كلها. كانت تلك اللحظة بداية انهيارنا". كنت في محرسي أحمل بندقيتي متسائلاً: "من نحن دون قادة؟ تذكرت يوم دخولي الكلية الحربية، وكيف وقفنا نؤدي القسم. اعتقدنا أننا انضممنا إلى عائلة، إلى مؤسسة، إلى وطن. لكن تلك الليلة، اكتشفت أننا كنا مجرّد أرقام في سجلات، تخلوا عنّا عند أوّل أزمة".
يكمل الشاب الذي يعيش اليوم في قريته في ريف بانياس على جمع الحطب وبيعه: "ما عاد اعتمادنا على حدا، والجو صار أنه انسحبوا. العناصر الصغيرة من الضباط بدأت تقول انسحب الضابط فلان وفلان ولم يبق أحد".
في تلك اللحظة يقول أحمد: "كنا أكثر من مجرد جنود منهزمين؛ كنا رمزاً لنظامٍ انهار، وذكرى لحقبةٍ انتهت، وهدفاً لغضبٍ متراكم. لم نكن فقط نهرب من المعركة، بل كنا نهرب من نظرات شعبٍ انقسم بين من رثانا ومن انتظر سقوطنا".
كان أحمد في جملة من خرج من الكلية حوالي الرابعة صباحاً بعد تواتر الشائعات والأنباء عن سقوط حماة وحمص. يقول: "طلعنا من الكلية من عند المشفى العسكري تجمعنا في الوعر مسلّحين، مشينا مسافة طويلة مع باصات خارجة من حمص، ومع الزحمة المهولة نزلنا وقفنا على أوتوستراد حمص طرطوس عند مصفاة حمص".
يتابع: "وقفنا على جانب الطريق، مجموعات من الطلاب العسكريين المنسحبين من مختلف الكليات مع عساكر وضباط ومدنيين متدفقين على الطريق. نراقب نظرات الناس تتنقل بيننا. نساء ينظرن إلى أبنائهن الضائعين، يرمقننا بشفقة ممزوجة باللوم، تقول عيونهن: "أين كنتم وماذا فعلتم؟" بالمقابل، كان هناك من يشمت فينا. سمعت أحدهم يصرخ: "شوفوا جيش الأسد كيف صار!" وكانت عيناه تلمعان بانتصار مرير، انتصار من دفع ثمناً باهظاً طوال سنوات الحرب.
في تلك اللحظة يقول أحمد: "كنا أكثر من مجرد جنود منهزمين؛ كنا رمزاً لنظامٍ انهار، وذكرى لحقبةٍ انتهت، وهدفاً لغضبٍ متراكم. لم نكن فقط نهرب من المعركة، بل كنا نهرب من نظرات شعبٍ انقسم بين من رثانا ومن انتظر سقوطنا".
الطريق وفق ما رواه أحمد "كانت سيئة جداً، الحوادث كثيرة ومن يموت على الطريق يمسكونه ويرمونه على جنب، كرمال العالم تكفي وتهرب منه ومن الزحمة. عالم تركت سياراتها ومشيت، عالم تركت كل ما تملك ومشت لأن الزحمة قاتلة والحوادث التي صارت على الطريق كثيرة. لم يكن هناك إسعاف. كان الطريق المعاكس فارغاً، والوضع كان متوتراً جداً".
ليلاً، على الأتوستراد كانت السيارات والدبابات تمشي معاً ومعها آلاف مؤلفة من البشر المدنيين والعسكر "ما فيك تمشي، مشينا مسافة، نمشي نمشي فيك تقول أمم أمم ماشية على الطريق. لما وصلنا تقريباً عند طرطوس طلع علينا الضو. أمامنا حواجز للفصائل والأمن العام التابعة للحكومة المؤقتة (كما أوضحت لوحات سياراتهم)، بعد مفرق قرية كرتو بطرطوس، كل واحد شلح سلاحه لما وصلنا لعندهم، حتى البدلات العسكرية شلحناها. في عالم وصلت عندهم لابسة فقط ثياب داخلية رغم البرد القاتل".
على الحواجز، وقف جنود الأمن العام بوجوه مرتاحة وعيون مرتبكة كأنهم هم أيضاً لم يعتادوا على هذا المشهد الغريب. كانوا يمسكون أسلحتهم بخشونة، لكن عيونهم تجنّبت لقاء النظرات التي لم تكن نظرات عداء، بل نظرات حيرة رجال وجدوا أنفسهم فجأة في دور الحكام على مصير من كانوا حتى الأمس أعداءهم. مع ذلك، يقول أحمد "نادراً ما حكّوا حدا أو زعجوا حدا. ولكن كانوا يقولوا للعالم اركضو من هون فوراً لسنا مسؤولين عما قد يحدث لكم". ولذلك ركضنا من بعد الحاجز "طيران".
وكنا نطير..
قرب دمشق… حيث تجتمع النقائض
كيف نفهم العدالة في سوريا بعد عامٍ من سقوط نظام الأسد؟
06 كانون الأول 2025
حتى السابع من كانون الأول، بينما كانت أنباء سقوط حماة تتسرّب إلى دمشق، ويعلن وزير الدفاع "انسحاباً تكتيكياً ثم محاولة تجميع القوات المنسحبة في حمص"، كان العميد حسين (55 عاماً) يشاهد شاشة الرادار وهي تتحوّل من اللون الأخضر إلى الأحمر. يقول الضابط الذي فضّل استخدام اسمٍ مستعار: "شاهدت النقاط تختفي واحدة تلو الأخرى".
يفسّر حسين السبب قائلاً: "مع تقدّم قوات المعارضة، كانت وحدات الجيش تنسحب من مواقعها متجاهلة أو متعمّدة تعطيل معدات الرادار خلفها. بعضها عطّل معداته عمداً كي لا تقع بيد العدو، والبعض الآخر تركها مشغولة وهرَب. ما كان يحدث هو انهيار منظومة كاملة"، على حد توصيفه.
خدم حسين سنواتٍ طويلة في ريف دمشق (القطيفة) قائداً لكتيبة دفاعٍ جوي ومدّدت له القيادة العسكرية مرتين بعد "بدء الأحداث 2011"، على حد تعبيره. يقول لسوريا ما انحكت في اتصالٍ هاتفي أنه أرسل في الأسابيع الأخيرة من تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، تساؤلاته أمام الضباط القادة، وهو منهم، بحثاً عن تفسيرٍ لما جرى في حلب وحماة وحمص، من دون أن يتلقّى أيّ رد: "كنا نرى الأمور تنهار حولنا دون أن نفهم السبب، تلقيت اتصالاتٍ من زملاء في محافظات أخرى. جميعنا كنا في ذات الحيرة: لماذا لا تصلنا أوامر واضحة؟ لماذا تسقط المدن بهذه السرعة؟ أين هو الرئيس، القائد للجيش والقوات المسلّحة؟ أين هو وزير الدفاع وقائد الأركان؟ أين هؤلاء جميعاً؟ لم نكن نعرف ما إذا كنا في حالة استنفار أم ماذا".
ليلة السادس والسابع من كانون الأول/ ديسمبر٢٠٢٤ كانت الأمور قد "فلتت بالمعنى الحرفي للكلمة، حوالينا كانت الدنيا تغلي وتفور، الجنود يتركون مواقعهم ويهربون بسلاحهم. الضباط حائرون ومنهم من يفر بسيارته. كنت في تلك الساعات قائد كتيبة. كل أرقام الهاتف التي ضربتها بحثاً عن إجابة أو توضيح باءت بالفشل. نظرت إلى ما تبقى من جنودٍ حولي وهم يرتجفون من البرد والخوف. عمري نصف قرن قضيت ثلثيها في الجيش وليس لدي سوى سيارة عسكرية "مهترئة" جيب واز روسية.. أيّة حياة كانت هذه".
يكمل الضابط المختص بسلاح (البانتسير): "اتخذت قراري الشخصي. أمرت بتسليم المجندين هوياتهم والعودة إلى بيوتهم. قلت لهم: "اتكلوا على الله، لو معي مال وزعته عليكم كلكم". بعد أن غادروا، بقينا نحن الضباط الكبار، جاء ضباط آخرون من وحدات مجاورة. كان المشهد مؤلماً: جميعنا برتب عالية وننتظر بياناً لن يأتي ولم يأت".
اتصل البعض بأقرباء لهم، وآخرون عرضوا علينا توصيلنا بسيارات خاصة لهم، لكني رفضت التحرّك من مكاني. كانت السادسة وثلث صباح الثامن من كانون الأول/ ديسمبر حين ردّدت الإذاعات والتلفزات وكلّ المنصات خبر مغادرة الأسد سوريا وسقوط نظامه. "لقد فعلها بطريقةٍ خسيسة هذا المعتوه". عندما سمعنا ذلك الخبر وقفنا جميعاً مشدوهين. بعضنا أنكر الخبر. بعضنا بكى. أحدهم خرج وبدأ يطلق النار في الهواء من روسيةٍ كانت معه.
وسط تلك المعمعة مع الاضطراب "تذكرت أمراً حساساً". يقول حسين ويتابع "تذكرت المستودع الذي كان تحت مسؤوليتي: مستودع عربات صواريخ البانتسير. مشيت نحو المبنى الخرساني المنخفض وفتحت البوابة. كان هناك دبابتان T-72، وثلاث عربات صواريخ، وأكوام من صناديق الذخيرة. لكن نظري توقف على الحواسيب المحمولة الخاصة بأنظمة "البانتسير" الدفاعية ملقاة على الأرفف، بينما كانت عرباتها الأصلية متروكة في العراء على التلال المجاورة. أقفلت البوابة بحزم، متأكّداً من إحكام القفل. وضعت بضعة براميل فارغة قرب الباب. هذه الأسلحة لم تكن ملكي كي أتخلى عنها. كانت ملك السوريين في يوم من الأيام. لقد تعلمت عبر حياتي في الجيش أن التسليم الرسمي هو الفاصل بين النظام والفوضى"، على حد قوله.
"وصلت منزلي في ضاحية قدسيا. جلستُ على الشرفة مرتدياً بزتي العسكرية رغم البرد القارس. رفضت كلّ نداءات عائلتي للدخول. كنتُ أحتاج أن أبقى هناك، أراقب البلاد التي خذلتني. بعد يومين، بينما كنتُ جالساً في صمتي سمعتُ دوي انفجارات مرعبة. انتفضتُ واقفاً. كانت الضربات الإسرائيلية تدمر كلّ أثر للجيش الذي قضيت فيه عمري. لم تكن الخيبة وحدها تعبر عما يجري حولي بل كان القهر بكل معانيه".
يكمل العميد حديثه: "حملني صديق بسيارته. حين وصلت تحت جسر القطيفة كانت القيامة هناك تمشي على قدمين. مئات السيارات، ازدحام لم أر مثله في حياتي. آلاف العساكر يمشون فيما تعبر سيارات تابعة لهيئة تحرير الشام نحو العاصمة. نقيضان يمشيان جوار بعضهما. النظرات في جهة مكسورة وفي أخرى تضحك فرحة وهي ترفع علم الهيئة".
"وصلت منزلي في ضاحية قدسيا. جلستُ على الشرفة مرتدياً بزتي العسكرية رغم البرد القارس. رفضت كلّ نداءات عائلتي للدخول. كنتُ أحتاج أن أبقى هناك، أراقب البلاد التي خذلتني. بعد يومين، بينما كنتُ جالساً في صمتي سمعتُ دوي انفجارات مرعبة. انتفضتُ واقفاً. كانت الضربات الإسرائيلية تدمر كلّ أثر للجيش الذي قضيت فيه عمري. لم تكن الخيبة وحدها تعبر عما يجري حولي بل كان القهر بكل معانيه".
ما حدث مع العميد لاحقاً ترويه ابنته في اتصال: "مع سماع أصوات تلك الضربات تأكد لأبي أن مستودع الذخيرة الخاص بكتيبته تعرّض للتدمير الشامل. كذلك كتيبته وما فيها من سلاح. تعرّض لجلطة قلبية نقلناه على إثرها إلى المشفى، والحمد لله نجا منها، ولكنه حتى اليوم يجلس وحيداً".
ليس العميد وحده ممن ما يزالون يعيشون في الصدمة، فمعظم من تبقى من جنود النظام السابق، يقضون حياتهم اليوم بين مقاتلين حاربوهم سابقاً. يرحل المسؤولون والضباط الكبار ويبقى من يدفع ثمن قرارات اتخذوها أو هربوا دون ذلك. وربما تمر عليهم الذكرى الأولى من سقوط النظام أكثر مرارة، مع انتشار فيديوهات قديمة، مُسربة ل "القائد العام للجيش والقوات المسلحة" الهارب بشار الأسد، وهو يسخر مع مستشارته لونا الشبل، حتى من جنوده، ومن تقبيلهم ليده.