يحلم الفنان السوري الفنان جلال الماغوط بالوصول إلى اليوم الذي يستطيع فيه أن يعتبر نفسه فناناً. وهو بذلك يذكّرنا بصرخة محمود درويش "سأصير يوماً شاعراً". ذلك الوصول الذي لن يتحقّق هو بالضبط طموح الفن، فالإبداع طريق فقط، والفنان سائر في وعورته دون أن يبتغي أي وصول.
تخرج جلال الماغوط من "كلية الفنون الجميلة" بدمشق عام 2010، ليعمل معيداً فيها لبعض الوقت، قبل أن يقدم استقالته منها، الأمر الذي يعتبره من أهم انجازات حياته.
أنتج في سوريا العديد من الأفلام المستقلة من بينها: "كائنات من عدم" 2010، و"قماش على مواد مختلفة" 2012، إضافة إلى إنتاجه أعمالاً لها علاقة بالتصوير الزيتي والغرافيك والفيديو آرت. ويعمل حالياً على المراحل الأخيرة من إنجاز فيلمه الوثائقي الذي يعتمد على تقنية التحريك القصير، وهي التجربة الأولى له في هذا المجال، إضافة إلى انشغاله بالتحضيرات من أجل الدراسات العليا.
تؤثر على عمله العديد من المواضيع والهواجس الكثيرة والتي تتغير وتأخذ أشكالاً جديدة مع كل تجربة، لذا فإن الحالة الصحية هي أن ينعكس كل ذلك في العمل الفني، لأن ذلك كفيل بتوليد آليات جديدة. فالمشاعر التي يمكن أن يختبرها الإنسان ثابتة منذ آلاف السنين مثل: الحب، الخوف، الألم، وغيرها من المشاعر، بل إنّ حضارتنا بمجملها هي عبارة عن تصعيد معرفي للخبرات الشعورية واللاشعورية المختلفة.
وهناك العديد من الحالات التي يمكن أن تكون موحية بالنسبة للماغوط، والإشارات التي يستطيع التقاطها من ملامح الوجوه، آثار الزمن على العيون، والانطباعات التي تمنحها الأماكن، كلها كانت إشارات تستطيع أن تخبره بصمت عمّا ينتظره في اللحظة التالية. في السابق كان الأصدقاء والأساتذة في الكلية يصفون أعماله بالسوداويّة، وخصوصاً فيلم تخرجه الذي يصوّر بالدرجة الأولى الجانب الكابوسي الذي كان يراه في دمشق، وعلاقات الناس فيه. لكنه الآن، ومع مرور السنين، يضحك كثيراً لأنهم تأخروا إلى هذا الحد في اكتشاف الحقيقة، وأنه وجدهم "الآن!" منشغلين على وسائل التواصل في قراءة و نشر مقتطفات من الفلسفات الما بعد حداثيّة (في محاولةٍ لتمثُّل فترة الغليان الفكري في أوروبا أثناء الحربين وما بينهما) وفي الواقع هذا هو فقط الجزء الظّاهر مما فرضهُ واقع الثورة من جدل عنيف يخص الهوية و التاريخ.

أما بخصوص ثنائيّة (الذات/ الموضوع)، يرى الماغوط أنّ أي خلل في طرحٍ فنّيٍّ ما يعود إلى تغليب أحد حدّي هذه الثنائيّة. لأنه لا يمكن للفن أن ينغلق كلياً نحو الذّات بحيثُ لا يصل إلى ذوات أخرى، ومن الناحية الثانية لا يمكن للفنان أن يتبنّى قضيةً عامّة وأن يكرّس عمله لخدمتها و التعبير عنها، هذه الحالة لا تستحق سوى أن توصَف بأنها دعاية، ويرى في اتجاهات الفنّ الاشتراكي أوضح مثال على ذلك. فهو في خلاصتهُ يمثل أيديولوجيا معينة تقوم باستخدام وسائل التعبير الفني لإيصال أفكارها، فاللوحةُ في هذه الحالة ليست سوى بيان أو خطاب بصري.
المحكّ بالنسبةِ له هو أن يكون لدى الفنان ما يستطيعُ أن يقوله، لأنه ينطلق من الذّات. وعلى الفنان أن يملك شيئاً يستطيع إيصاله من خلال وسيط بصريّ، يعني أنّ لديه آليات المعالجة "الذّاتيّة" القادرة على تحويل معطيات العالم الشعوري "موضوع" إلى شكل فني. ويضيف قائلاً: بدون آليات المعالجة تلك لن يستطيع أن يضيفَ شيئاً، وسيقدم فناً مؤدلجاً من الدرجة الثانية (بالنسبة للشكل). و من دون أن يدخل ما يستقبله من الخارج في هذه العملية (وهنا يكمن نوع آخر من خطايا الوعي حين "يقرر" أن لا يستخدم ما يعيشه في الواقع أو حين "يقرر" أن يتبنى جانباً واحداً منه) لا يمكنه تقديم شيء أيضاً. وينوه هنا إلى أنه لا يكون التركيز على موضوع معين، أو على جانب دون غيره من الواقع، وليس بالضرورة أن يكون دائماً ناتجاً عن نوع من الاستلاب، بل يكون في بعض الحالات ناتجاً عن عملية لاواعية، تنتمي بالضبط إلى آلية المعالجة التي تحدث عنها، والتي تختلف من شخص إلى آخر. لذا يؤكد على وحدةِ حدّي تلك الثنائيّة والتي يرى أنه: كلما استطاع الفنان أن يصل إلى أبعد الأماكن المظلمة في نفسه، كلما استطاع اكتشاف ما يمكن أن ينفذ إلى الآخرين بسهولة. و كلّما استطاع أن يشكّل فهماً أعمق لمعطيات العالم الخارجي، كلما كانت ألية المعالجة "الذاتيّة" الخاصة به أكثر إبداعيّة.
عاش الماغوط الواقع السوري، ووجد أن الفن هو وسيلته من أجل التفاعل معه، فغايته المبدئية تكمن في توجيه الرسائل من أي نوع، وما يدفعه للعمل بشكل عام هو الحاجة إلى التغيير. في البداية كانت فكرة الحرب وماهيتها تسيطر عليه، فالجميع كان يقول أنه ضد الحرب و ضد الخراب الذي تسببه، لكنه يجد أن الإنسان مارس الحرب على الدوام ورغم ذلك يصفها بأنها فعل غير "إنساني" معتمداً على أكذوبة من المُثل التي يسميها "إنسانية"، وعلى مدى التاريخ ازدادت الحرب سرياليّة بحيث أصبح لها قوانين، من ضمنها الحفاظ على حياة الأسرى ومداواة الجرحى وغير ذلك، واستناداً لذلك يمكن للماغوط الحديث عن حرب "احترافية" يكون فيها قوانين للتدمير، وأخرى "غير احترافية" لا تُراعى فيها القوانين، لأن قمة سوداوية الواقع الذي اكتشفه مؤخراً أنه لا يستطيع أن يدعو للسلام لأن ذلك لا يعني شيئاً على الإطلاق، لأن كافة الدعوات من هذا النوع لا تمثل سوى نوعاً من الاجترار الإعلامي والسخرية من السذج لأنها لا تترافق مع إرادات فعلية على الأرض، نعم، لذا يمكنه اعتبار الفيلم دعوة لممارسة الحرب باحتراف! ومن ناحيةٍ أخرى محاولة لعزل العلاقات الإنسانية عن الرموز و المُثل العليا لاكتشاف بساطتها الأولى.
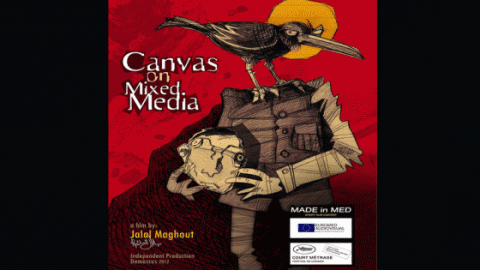
في فيلمه "قماش على مواد مختلفة" نسف الحمامة كرمز للسلام، ولم يكن هناكَ أفضل من الغراب ليستبدلها به، محاولاً من خلاله تحقيق السيناريو الموازي، الذي يعمل فيه الغراب على تخليص المكان من الرصاص و القذائف ليلقيها في مكان بعيد، هذه العملية التي تصبح أوتوماتيكية عندما يحدث التحول في السيناريو الأساسي، بحيث لم تعد القذائف و الصواريخ تصل إلى أهدافها بل تذهب بنفسها إلى ذلك المكان البعيد الذي اختاره الغراب. ويضيف قائلاً لموقعنا "سيريا أنتولد syriauntold": "من المفارقات المفيدة في هذا الخصوص، أن الغراب هو من أذكى الكائنات على الإطلاق، ولديه قوة نفسية تعادل ثقل لونه الأسود".
أما فيما يخص الفنون البصرية وعلاقتها بالثورة السورية، لا يجزم الماغوط إن كانت غزارة النتاج البصري تدل على تفوّق، لكنه يوافق على أنها متفوقة من حيث سرعة وسهولة الوصول من خلال زر الـ "المشاركة" في صفحات وسائل التواصل الاجتماعي. إلا أنه هناك مشكلة في التّلقّي، لأن تذوّق الفن عادةً لدى مجتمعاتنا - يأخذ صفةً سلبيّة، لا يكون فيها للمتلقي دور تفاعليّ في تفكيك و إعادة تركيب ما يتلقّاه من فنون وفق خبرته المعرفيّة والشعوريّة، فالمتلقّي لدينا بالأساس كسول، لأنه ينتظر دائماً خطاباتٍ جاهزة تدعم توجّهاته الاجتماعية والسياسيّة.
لذا فنحن – بحسب الماغوط - لم نصل بعد إلى المرحلة التي يوجد فيها نوعٌ من التّوازن بين مستوى شعبيّة عمل ما، والقيمة الفنية لهذا العمل. لأن هذا التوازن هو معيار الرقيّ الجمالي لدى أي مجتمع. فنجاح عمل ما على المستوى الشعبي لدينا، لا يعني نجاحه من حيث قيمته الفنية والإبداعية، لأننا لم نصل بعد إلى هذا الترف، بحكم الظروف هناك الكثير من العوامل الحيادية جمالياً لا زالت تؤثر في طريقة تعاطينا مع الفن البصري.
وفيما يخص المتلقي السوري يرى الماغوط بأن اعجابه بعملٍ ما يكون غالباً للموقف السّياسي الذي يقدمه هذا العمل، أو لحالةٍ إنسانيّةٍ ما. لذا يجد أنه حين نصل إلى اليوم الذي نستطيع فيه التمييز، بين القيمة الفنية، وبين ما يقدّمه العمل من اهتمامات سياسيّة كانت أو إنسانيّة، حينها نستطيع الحديث عن تفوّق الفنون البصريّة.
لذا يؤكد في نهاية حديثه على أننا بحاجة فعليّة لـ "الفن" الذي يستطيع أن يتعامل مع الوضع السّوري بالسّوية المطلوبة. والذي لازال حتى اللحظة في مرحلة رد الفعل على المستوى الفني و الثقافي. وهو ما يتطلّب من هذا الحراك الفني الفوضوي الكثيف، الصبر لسنوات كي نرى نتائجه، حينها، سيفرض نفسهُ ما كان حقيقياً من الفن.



