كانت ليلى قبل عام 2011 محط سخرية صديقاتها حين تضطر إلى ترك السهرة "في عزّها" أو مغادرة المطعم باكراً والعودة إلى المنزل بناءاً على قوانين منزلها، إذ بمجرّد أن تتأخر دقائق عن موعد عودتها إلى البيت لا يتوقف هاتفها عن الرنين، فتضطر لوضعه على "الصامت" هرباً من ألسنة أصدقائها الذين يقولون لها بمجرد سماعهم صوت الرنين: "الماما"؟ بلهجة استفهام ممزوجة بضحك ساخر.
اليوم تستأجر ليلى غرفة في بيروت مع أصدقاء شباب لها، وتقضي العطلة الإسبوعية، وهي تشرب النبيذ حتى ساعات الفجر الأولى في بارات بيروت، وأمها تعرف، مكتفية بعبارة "كوني بخير يا بنتي"، وإذا علّقت الأم أو الأب على نمط حياة ابنتهم الجديد، يكون أقسى ما تسمعه "صرتي بعيدة عنا يا بنتي وما بتشبهينا".
كسر التقاليد
لم تُصب هذه التحولات عائلة ليلى فحسب، بل تكاد تكون سمة لعدد كبير من العوائل السورية، إذ خلال خمس سنوات ونيّف، تمكنت الثورة والحرب من كسر العديد من التقاليد التي كانت تحكم العائلات، إذ طغى عامل النجاة والبقاء على قيد الحياة، والخوف من فقدان الأبناء والندم لاحقا على كل شيء.. طغى على كلّ ما عداه.
تتذكر "رولا" التي تقيم اليوم في برلين، علاقتها مع أهلها حين كانت تقيم في دمشق بينما هم يقيمون في القامشلي، إذ "رغم وجودي بعيدة عنهم، فإن زيارتهم لي أحيانا في دمشق كانت تعني توبيخاً دائماً، وتوجيه ملاحظات عن سبب التأخر عن المنزل"، الأمر الذي كان يدفعها لأن تخبّئ عن أهلها كل ما تفعله، وتعرف أنه لا يرضيهم (التدخين، شرب النبيذ، الذهاب إلى البار..)، لإدراكها صعوبة فرض ما تريد عليهم، وصعوبة تقبّلهم للأمر حال وضعتهم أمام الأمر الواقع.
الأمور كانت تأخذ مساراً سيئاً في الأمور التي لا مفرّ من إخبار العائلة بشأنها، مثل الزواج "مرّة أحببت شاباً مسيحياً، أمي كاد يغمى عليها حين أخبرتها، وظلت ورائي إلى أن اضطررت إلى إخبارها أنّ العلاقة انتهت، ولم تكن انتهت وقتها.
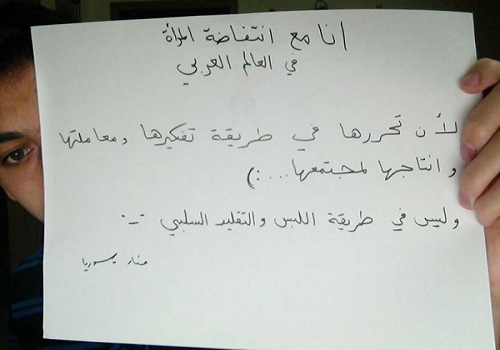
الأمر تغيّر بعد الثورة، فرولا تحبّ اليوم شابا من طائفة أخرى، وأمها تعرف بالأمر دون أن تعترض.
بعد الثورة تطوّر عمل رولا وباتت تسافر إلى بيروت وتعود إلى دمشق، لتنتبه أن ملاحظات الأم خفّت أو بشكل أدق، لم تعد حازمة ، وهو الأمر الذي تراجع أكثر بعد سفرها إلى ألمانيا، إذ أنّ "أمي لا تكف عن توجيه الانتقاد لي، إلا أنه اليوم انتقاد به استسلام أكثر مما هو محاولة لفرض الرأي كما كان في السابق" كما تقول لحكاية ما انحكت.
هذه التحولات ترجعها رولا إلى "الاستقلال المادي وأوضاع البلد الغير مستقرة، وتركيز الأباء على أن يكون أبناؤهم بسلام بعيداً عن المحرقة السورية، إضافة إلى كوننا نحن كبرنا وخرجنا عن سيطرتهم أيضا".
ثورة على ثقافة المجتمع
من جهته، يقول حسان لحكاية ما انحكت أنّ علاقته بعائلته انكسرت قيودها من جهته ومن جهة الأهل في آن، فهو قبل الثورة كان يعيش بعيداً عن أهله في دمشق، ولم يكن يخبرهم بنمط حياته المختلف عن نمط حياتهم، مكتفياً بزيارات الواجب السريعة، والتي يخوض خلالها جدلاً أقل معهم فيما يخص الأمور التي ينظرون لها كمحرّمات (العلاقة الجنسية قبل الزواج، المساكنة، الحشيش..).
بعد الثورة اعتقل حسان للمشاركة في المظاهرات، وخرج بعد خروجه من المعتقل إلى بيروت، ومذّاك تغيّرت علاقته مع أهله، فهو لم يعد يتحفّظ على شيء، يقول كل ما برأسه مباشرة و"دج"، فإذا كلّمه أهله من سورية، وسألوه: "من عندك؟" يجيب: "صديقتي وهي تقيم معي"، رغم إدراكه أن هذا الجواب سيزعجهم، مبرّرا تصرفه بأنّه "إذا لم تكن الثورة على كل شيء فلن تكون. هذا ما تعلّمته من الثورة، فإذا لم أكن قادراً على مواجهة معتقدات أهلي الخاطئة، فكيف سأحرّر بلدي من الدكتاتورية، وإذا لم أهدم ثقافة الدكتاتورية والحلال والحرام في عائلتي لن أتمكن من هزيمة الدكتاتور الكبير، لأن ثقافة أهلي وأقاربي تسند الدكتاتورية حتى وهم يظنون أنهم يحاربونها، بدءاً من الثقافة الدينية السائدة، وليس انتهاءا بالثقافة الاجتماعية" كما يقول لحكاية ما انحكت.
ثقافة الحرية
بعد الثورة، زارت "سوسن" أخاها حسان في بيروت، وكانت المرّة الأولى التي تزورها، لتفاجأ بنمط الحياة المختلف، لتبدأ أسئلتها عن الحياة والمساكنة والزواج، إذ يقول حسان "خضت معها حواراً لم أكن أتخيّل نفسي قبل الثورة أنني قد أجريه مع أحد من عائلتي، إذ حدّثتها عن ضرورة أن يمرّ العاشقان قبل زواجهم بمرحلة المساكنة وأن يكونوا أسياد أجسادهم ليكونوا أحراراً مع جسدهم وطموحاتهم، ما يساعدهم على تحقيق النجاح والسعادة.. والمدهش بالنسبة لي، أنها اقتنعت في نهاية المطاف"، وإذ قاطعناه بالقول: "وهل تعتقد أنها قد تسمح لابنتها بهذا الأمر؟"، أجاب "لا أعتقد أن الأمر بهذه السهولة، فلو كانت في بيروت ربما، ولكن طالما هي عادت إلى سورية، فإنها لن تتمكن من مواجهة محيطها حتى لو كانت مقتنعة، فالأمر يشبه تمسك الأهل بالكثير من التقاليد البالية رغم اقتناعهم بأنها لم تعد صحيحة، ولكن خوفاً من المجتمع ورد فعله تستمر.. ولكن رغم ذلك، فما أنا متأكد منه أن أختي ستمنح ابنتها دون شك حرية أكثر مما كان بعد هذا الحوار".
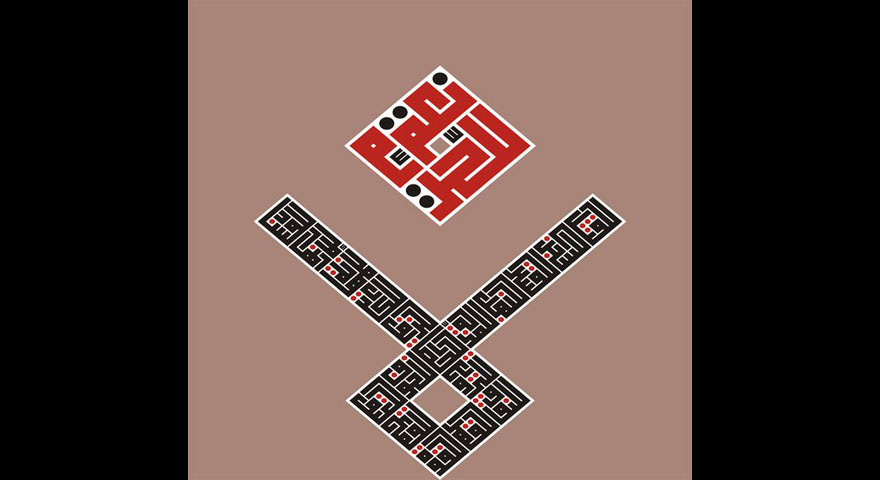
وعن تفسيره لهذا التحوّل، يقول حسان لحكاية ما انحكت، أن "الثورة فتحت من ضمن ما فتحت باب النقاش على مصراعيه، إذ مع انكسار محرمات السياسة في علاقة السوريين بالاستبداد انكسر معها أشياء كثيرة، خاصة حين نعلم أن العائلة الحاكمة في سورية كانت أكثر قداسة من المقدّس الديني نفسه، إذ كان يمكن لك أن تشتم الله في سوريا دون أن يحاسبك أحد، ولكن كان مستحيلاً أن تشتم الدكتاتور، وطالما أن المقدّس الأكبر انكسر بمثل هذه السهولة أمام أعين الناس، باتت كل المقدسات الصغرى قابلة للنقد، ما أطلق حواراً بين السوريين حوّل كل شيء، فهذا الحوار بيني وبين أختي لم يكن ليحصل في ظل الدكتاتورية، إذ كنا مستسلمين لثقافتها، في حين أننا اليوم في ظل ثقافة الحرية، رغم كل ما يشوبها من نواقص وفوضى".
تراجع سلطة المجتمع
"ممنوع تنامي برّا البيت أبداً... أبدا".
هذا ما كانت تسمعه ريم من أبيها حين تطلب أن تنام عند صديقتها قبل الثورة، وحين كانت تستفسر عن السبب يأتي الجواب قطعيا: "ما في سبب، ما بحب تنامي برا البيت، وانتهى الأمر".
بعد الثورة نزحت العائلة من مخيم اليرموك إلى ضاحية قدسيا، وكان بيت صديقة ريم يبعد ساعة عن بيتهم المستأجر، وحين تتأخر بالسهرة تتصل بالأب، وتطلب أن تنام عندها، وكان الأب يقبل بسهولة، ويبدو أحيانا مشجّعاً على ألّا تعود إلى البيت في وقت متأخر، وهكذا أصبحت ريم تدريجياً تنام مرة في ضاحية قدسيا ومرة في جرمانا، والحجة في كلّ مرة مختلفة "مافي سرافيس.. الوقت متأخر".
ولم يكن هذا، هو التنازل الوحيد الذي أصاب والدّي ريم، فقبل الثورة كان التدخين أحد المحرمات الممنوع كسرها، ولكن بعد الثورة أصبح الأب يعرف أن ابنته تدخن من خلال رؤيته لسيكارة مطفأة في صحن السجائر حين يعود، ليقول بلهجة غير جدية " بكسر إيدك إذا عم تدخني"!
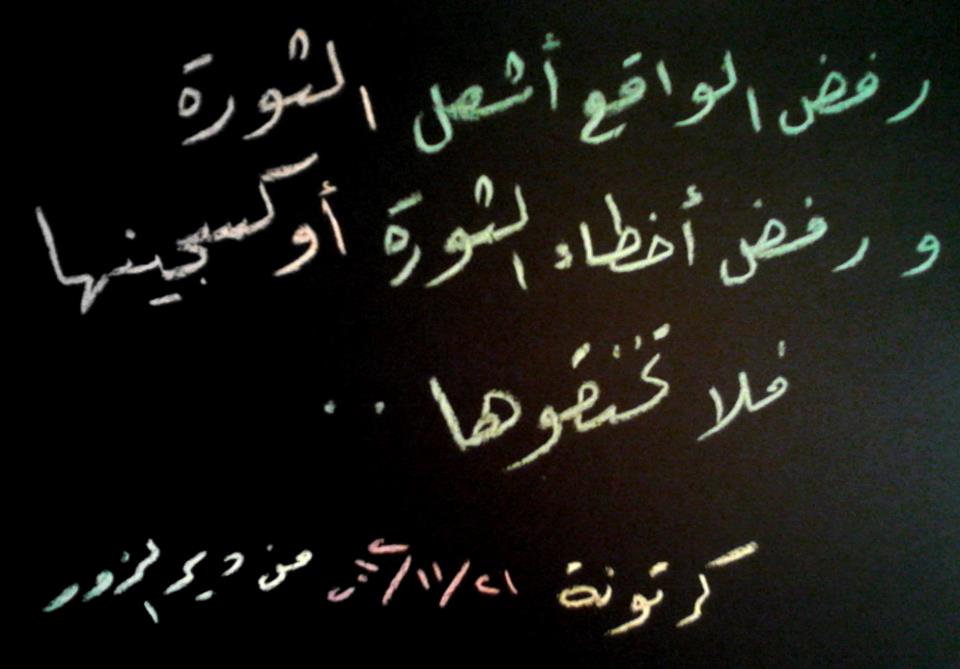
وأيضا لم يكن أحد من أصدقائها الشباب يزورها في المنزل قبل الثورة، ولم تكن تقضي وقت فراغها مع أصدقائها الشباب، وإن فعلته كانت تفعله سرّاً، في حين أصبحت بعد الثورة تستقبل أصدقاءها الشباب في المنزل، وتعرّف عائلتها عليهم وتخرج برفقتهم، حتى الأعمام الذين كانوا يتدخلون بكل شاردة وواردة "بت أصادفهم في الشارع ومعي صديقي، أسلّم عليهم وأتابع مشواري، وكأنّ شيئا لم يكن"، ما يعني أن سطوة العائلة كلها انكسرت هنا، أو تلاشى تدخلها، وهو ما ترجعه ريم إلى "خوف الأهل على الأبناء، فأمام الخطف والاعتقال وحضور الموت في كل لحظة (عبر القذائف) جعل اهتمامات الآباء تنصب بالدرجة الأولى على أن يكون أبناءهم بأمان، وبعيدين عن الموت ما أمكن، وهناك أيضاً الضغط المادي الذي ترتّب على العائلة، فأصبح الأب والأم يصرفون الكثير من الوقت بالعمل والتفكير بكيفية تأمين متطلبات العائلة، فخفّت سيطرتهم ولم يعد لهم وقت لفرض السيطرة، خاصة أنهم عاجزون عن تلبية متطلّبات الأبناء الكثيرة، فيكون السماح لهم بهذه "الحرية" نوع من مقايضة، إذ يشعر الأباء بضيق روح أبنائهم في ظل هذا الجو الجهنمي ويشعرون أكثر بعجزهم عن تقديم شيء لهم، فيكون كسر الرقابة والتحرّر من سطوة التقاليد أفضل الحلول"، خاصة أنّ سطوة المجتمع بدورها قلّت على الأباء أيضا، فالأب والأم في كثير من الأحيان يمنعون أبناءهم من القيام بفعل ما خوفاً من ردة فعل المجتمع عليهم، ولكن هذا المجتمع نفسه "مشغول" اليوم بتفاصيله الكثيرة ولم يعد قادراً على المراقبة، وهو ما تؤكده "ختام" لحكاية ما انحكت، إذ حين كانت تقول لأبيها أنها تريد خلع الحجاب قبل الثورة، كان الأب يهدّد ويتوّعد ويصرخ "وين بدي حط عيوني بعيون أهالي الحارة إذا رجعتي على البيت بلا حجاب"، وبعد الثورة خلعت الحجاب وباتت تعود إلى الحارة التي تغّير تفكير أو اهتمامات أهلها وخفّت رقابتها أو باتت رقابة من نوع مختلف تركز على الأمني/ السياسي، الأمر الذي دفع "ريم" لوصف هذه التحولات التي وصلت حدّ أن يوافق أباها على المبيت في بيت أحد رفاقها الشباب حين الضرورة، بالقول: "الحياة صارت أبسط وأفضل، وكل واحد بيعمل كل شي بدو ياه ومقتنع فيه، بمعنى أن الثورة كانت عامل إيجابي هون".
تحولات في المسار المعاكس أيضا
مقابل هذه التحولات، كان هناك تحولات في المسار المعاكس، خاصة في المناطق المحاصرة من قبل النظام، إذ أصبح التشدّد في معاملة الفتيات أكبر، بحيث أنّ بعضهن كنّ أكثر حرية قبل الثورة، وبات هناك نوع من الحجر عليهن بعد الثورة كما تقول ريم، واصفة حال من تعرفه من صديقاتها، وذلك خشية الخطف أو التعرّض لأمر يجعل الأب يندم لاحقاً، وهو ما دفع عدداً كبيراً من العائلات لتزويج بناتهم في سن أبكر مما كانوا يوافقون عليه عادة قبل الثورة، والسبب يعود للتخفّف من العبء المادي والتخلص من مسؤولية حمايتهم ومراقبتهم في ظل ظروف قاهرة معيشياً وأمنياً.
فرضت الثورة والحرب إيقاعها على السوريين، كسرت الكثير من القيم والتقاليد التي طالما كانت حاكماً غير مرئي للسوريين، وبالمقابل هي تخلق قيماً وتقاليد أخرى تترسخ رويداً رويداً، إلا أنها قابلة للتحوّل والتغيّر أيضاً. وطالما أنّ الحرب مستمرة فإن عملية الهدم والتحوّل ستبقى قائمة، إذ عرف عن الحروب دائماً أنّها تخط تحوّلات عميقة في بنية المجتمعات وتقاليدها، فبعضها يولد ولادة جديدة بفعل ثقافة جديدة تتطلّع نحو المستقبل رغم كل الجراح، وبعضها يخرج من التاريخ نهائيا إذ يواصل ارتكاسه نحو الماضي، فأيّ طريق ينتظر السوريون؟ وأي ثقافة ستنتصر وأيّة تقاليد وقيم؟
(الصورة الرئيسية: لوحة للفنان جوان زيرو. المصدر: الصفحة الرسمية للفنان على الفيسبوك)




