تعتبر عملية التحوّل الديمقراطي عموماً عملية معقدة جداً في الحالة السورية، وخصوصاً في شقها المتعلّق بعملية إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وبناء أجهزة جديدة تخضع للضوابط الديمقراطية والرقابة المدنية، كون تلك الأجهزة كانت منحازة في الصراع إلى جانب النظام وارتكبت ما ارتكبته من مجازر بحق المتظاهرين السلميين في بداية الثورة، الأمر الذي دفع بالتحوّل إلى الثورة المسلحة، بحيث تركّز الصراع بين المجتمع والأجهزة الأمنية. لذلك تظهر هنا إشكالية التقريب بين الطرفين من جديد وصياغة اتفاق مصالحة مقبول بالنسبة لهما، وهو ما يعدّ شرطاً مسبقاً لانطلاق عملية التحوّل الديمقراطي.
وعليه فستكون عملية نزع السلاح من أيدي الأطراف غير الحكومية المنخرطة في الصراع، وإعادة دمج مقاتليها في القوات الحكومية رهناً بنجاح اتفاق المصالحة وبتطبيق العدالة الانتقالية التي تضمن محاسبة مرتكبي المجازر بحق المدنيين وبخاصة من جانب النظام، وهذا ما يبدو صعب المنال في ظلّ التدخل الروسي إلى جانب قوات النظام والموقف الدولي الذي يسعى لحلّ الصراع بصيغ توافقية تهمل الأسباب الحقيقية التي أدّت لاندلاعه، ومما سيزيد من صعوبة تلك العملية هو خروج الصراع من الدائرة السورية المحلية إلى الفضاء الإقليمي، وما حمله ذلك من إضفاء صفة طائفية على الصراع ودخول ميليشيات طائفية أجنبية تقاتل إلى جانب النظام، وتزايد قوة ودعم فصائل المعارضة الراديكالية ذات المشروع الجهادي المنفصل تماماً عن مشروع الثورة السورية، الأمر الذي هيّأ مناخاً مناسباً لانتقال الجماعات المتشدّدة العابرة للحدود إلى سوريا، كما في حالتي تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة فتح الشام، واللتان تحوّلتا إلى رقم صعب في معادلة الصراع السوري.
وبناءً على ما تقدّم، ستحاول هاتين الورقتين تقديم سرد نظري مختصر حول ماهية عملية إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية كجزء من عملية التحوّل الديمقراطي في دول ما بعد الصراع والتركيز على شقّها المتعلّق بعملية نزع السلاح وإعادة التأهيل والدمج للمقاتلين في الفصائل والميليشيات غير الحكومية، كما ستحاول استشراف الفرص والتحديات التي قد تعتري تطبيق تلك العملية في سوريا بالنسبة للمليشيات المقاتلة مع النظام وفصائل المعارضة المسلحة، بجانبيها السياسي والتقني.
برامج إعادة هيكلة القطاع الأمني (SSR):
يعتبر مفهوم الـ (SSR/security sector reform) أو إعادة هيكلة القطاع الأمني مفهوم حديث نسبياً، حيث يعود استخدامه إلى الحرب اليوغسلافية 1990، ورغم حداثته إلا أنّه بات يحتل مكانة كبيرة بل أصبح يشكل جوهر اهتمام المؤسسات المعنية بالتنمية في مرحلة ما بعد الصراع وبناء السلام، وفي مقدّمة تلك المؤسسات تأتي الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وأكثر من ذلك فقد أصبحت برامج الـ (SSR) على رأس أولويات كبرى الدول في حلّ الصراعات، كالاتحاد الأوروبي وأمريكا وبريطانيا وكندا. وفي إطار هذا الاهتمام فقد طوّرت كلّ من تلك المنظمات والدول مفهومها الخاص لبرامج إعادة هيكلة القطاع الأمني في دول ما بعد الصراع، ووضعت أجندتها الخاصة التي تحمل آليات تنفيذ تلك البرامج، والتي تتفق في الخطوط العامة للعملية وتختلف في بعض تفاصيلها بحسب أهداف كلّ طرف ومصالحه الوطنية.
وتعرف الأمم المتحدة عملية إعادة هيكلة القطاع الأمني1: "بأنّها العملية التي تضمن حماية حقوق الإنسان والمساواة الجنسية وتعزيز سيادة القانون والديمقراطية في دول ما بعد الصراع ".
في حين تعرّفها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)2: "بأنها عملية تسعى إلى زيادة قدرة البلدان في مرحلة ما بعد الصراع على تلبية الاحتياجات الأمنية بطرق تتفق مع القواعد الديمقراطية، ومبادئ الحكم الرشيد والشفافية وسيادة القانون عبر بناء أجهزة أمنية ديمقراطية وشرعية وخاضعة للمحاسبة، تساهم في التقليل من خطر العنف وإمكانيات اندلاعه مرة أخرى".
ووفقاً للدليل الميداني للجيش الأمريكي، فتعرّف بأنها3: "هو النشاط الذي يمكن أن تعزّزه التدخلات الديبلوماسية والدفاعية، والهادف إلى تقليل الأخطار الأمنية على المدى الطويل من خلال المساهمة في بناء القدرات لمجتمعات مزدهرة وآمنة، ويتضمن إعادة تشكيل أو إصلاح المؤسسات الأمنية والوزارات الرئيسية، وتقديم الإشراف والاستشارات للدول المحتاجة للحفاظ على أمنها وأمن أفرادها".

وتعرّفه وحدة منع الصراعات الدولية التابعة للحكومة البريطانية4: "بأنّه مفهوم واسع يغطي العديد من الجهات الفاعلة، والتخصّصات، والأنشطة، ويتضمن السياسات المتعلّقة بالأمن والتشريع وهياكلها وقضايا الإشراف عليها، والتي تتم ضمن المعايير والمبادئ الديمقراطية المتعارف عليها".
و تتفق كلّ الجهات سالفة الذكر على أنّ عملية إعادة هيكلة القطاع الأمني في دول ما بعد الصراع، تتكوّن من البرامج التالية:
- (1): العدالة الانتقالية كبداية لعملية إعادة الهيكلة والمتعارف عليها بعملية (JSSR).
- (2): عمليات الـ (DDR) نزع السلاح، وإعادة التأهيل، والدمج للميليشيات المسلحة الغير حكومية.
- (3): إعادة بناء المؤسسات الأمنية للدولة (الجيش، الشرطة، المخابرات، حرس الحدود).
- (4): إعادة بناء النظام القضائي ونظام العقوبات.
برامج نزع السلاح، التسريح، إعادة الدمج (DDR)
إنّ هدف عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج هو المساهمة في الأمن والاستقرار في أوضاع ما بعد النزاع، وذلك لكي تبدأ عملية التعافي والتنمية. وتعتبر عملية نزع سلاح وتسريح وإعادة دمج المقاتلين السابقين عملية معقدة، وذات أبعاد سياسية وعسكرية وأمنية وإنسانية واجتماعية اقتصادية. وتهدف العملية إلى التعامل مع المشاكل الأمنية بعد النزاعات، والتي تنتج عن ترك المقاتلين السابقين دون مصادر للحياة أو شبكات دعم، سوى العودة لحمل السلاح، وذلك خلال الفترة الانتقالية من النزاع إلى السلام ومن ثم التنمية. هذه الرؤية لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج لها عدّة معان ضمنية سياسية وعملية، وهي5:
- - برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، ما هو إلا واحد من العديد من عمليات التدخل لتثبيت الاستقرار بعد النزاعات. وعليه فإنّه لا بد من التخطيط والتنسيق له بدقة كجزء من جهود سياسية وإنشائية أكبر تحدث بذات الوقت.
- - يجب أن تتعامل عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج بشكل كامل مع جميع أوجه نزع السلاح وضبط وإدارة الأسلحة. فبينما يركز برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج على الاستقرار الفوري للأمن في دولة ما من خلال عملية نزع السلاح، فإنّ الاستقرار على المدى البعيد لا يمكن أن يتحقّق إلا من خلال برامج مسؤولة ومدروسة بعناية لإدارة الأسلحة.
- - يجب أن تدعم برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج عملية تحويل المقاتلين إلى مواطنين منتجين. هذه العملية تبدأ في مرحلة التسريح حيث يتم خلالها تفكيك بنية القوات أو المجموعات المسلحة ومن ثم ينال المقاتلون الوضع المدني بشكل رسمي.
- - برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج مصمّمة لتحقيق إدماج مستمر. ولكنها لا تتمكن من ذلك بمفردها، وعليه فإنّ برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج يجب أن تكون ترتبط بعملية أكبر من التنمية وإعادة البناء الوطني.
- - الهدف النهائي لبرامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج هو منع عودة النزاع العنيف، أي جعل السلام غير قابل للنقض. ومن أجل تحقيق ذلك فإنّ على برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج أن تشجع الاطمئنان والثقة والتعامل مع جذور مشكلة النزاع.
- - برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج عملية مرنة يجب أن يتم تكييفها بما يختصّ بحاجات كلّ بلد بذاته. وبحسب الظروف، فإنّه ليس من الضروري تطبيق جميع جوانب البرنامج في بعض الحالات، وقد لا يتم تنفيذها بنفس الترتيب في كلّ عملية.
- - وختاماً، فإنّ على الجهات المعنية بالعملية أن تعي أنّ الـ "DDR "مفهوم واسع يشمل مجموعة من الأنشطة المرتبطة به، مثل إعادة التوطين، إعادة التأهــيل، المصالحة وغير ذلك، بهـدف تحقيق إعادة الدمج. وعليه فإنّ هذه الأنشطة يجب أن تصبح جزءاً من المبدأ العام والتخطيط لعملية إعادة الدمـج حيث يكون ذلك ضرورياً.
وتعرّف الأمم المتحدة العمليات المكوّنة لبرامج الـDDR بالشكل التالي6:
نزع السلاح: هو جمع وتوثيق وضبط والتخلّص من الأسلحة الصغيرة والذخائر والمتفجرات والأسلحة الخفيفة والثقيلة من المقاتلين، وكثيراً ما تجمع أيضاً من المدنيين. وتشمل عملية نزع السلاح أيضاً تطوير برامج إدارة السلاح بشكل مسؤول.
التسـريح: التسريح هو الإعفاء الرسمي للمقاتلين الفعليين من القوات المسلحة أو المجموعات الأخرى المسلحة غير الرسمية، وأوّل مرحلة من التسريح قد تمتد من عملية تسريح المقاتلين الأفراد في مراكز مؤقتة إلى الأعداد الكبيرة في مجموعات ضمن مخيّمات تقام لهذا الغرض (معسكرات، مخيمات، مناطق تجمع أو ثكنات) أما المرحلة الثانية فتشمل حزمة الدعم المقدّمة للمسرحين، والتي يطلق عليها "إعادة الإسكان".
إعادة الإسكـان: هي المساعدة المقدّمة للمقاتلين السابقين خلال فترة التسريح، ولكنّ قبل عملية إعادة الدمج ذات المدى الأطول. وإعادة الإسكان هي المساعدة الانتقالية لتغطية الاحتياجات الأساسية للمقاتلين السابقين وعائلاتهم ويمكن أن تشمل علاوات الانتقال الآمن، الطعام، الملابس، المأوى، الخدمات الطبية، التعليم قصير المدى، التدريب، التوظيف وبعض الأدوات. وفي الوقت الذي تكون فيه إعادة الدمج عملية تنمية طويلة الأمد ومستمرة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، فإنّ إعادة الإسكان تعتبر مساعدة عينية أو مالية قصيرة الأمد لتلبية الاحتياجات الفورية ويمكن أن تستمر لمدة عــام واحـد.
إعادة الدمــــج: هي العملية التي يحصل فيها المقاتلون السابقون على وضع المواطن ويحصل على وظيفة ودخل دائمين. إعادة الدمج هي بالضرورة عملية اجتماعية واقتصادية بإطار وقت مفتوح، ويحدث بشكل أساسي في مجتمعات على المستوى المحلي، وهي جزء من التنمية العامة للبلاد وهو مسؤولية وطنية، وعادة ما تتطلّب بالضرورة مساعدة خارجية على المدى البعيـد.
الحالة السورية:
يمكن من خلال ما استعرضناه من إطار عام لعملية إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، أن نستنتج بأنّ هذه العملية بحدّ ذاتها هي عملية تقنية تتكوّن من مجموعة متسلسلة من الخطوات تبدأ بالبناء التشريعي للقوانين الناظمة لعمل الأجهزة الأمنية، ومن ثم إحداث مؤسسات رقابية تتيح للسلطات المدنية مراقبة عمل وميزانيات هذه الأجهزة، فيما يلي تلك المرحلة يأتي الدور على هيكلتها الإدارية وتقسيم اختصاصاتها تبعاً للاحتياجات الأمنية للبلاد وتدريب ضباطها وأفرادها وفق البرامج المتفق عليها عالمياً، وقد يتم الاستعانة في هذه المرحلة بخبرات دولية أو إقليمية.
وعلى صعيد برامج الـ (DDR)، هناك فرق بين نزع سلاح وتسريح وإعادة دمج كل من أفراد القوات المسلحة والمجموعات المسلحة. فكلاهما يتطلب تسجيلاً كاملاً للأسلحة والمقاتلين، يتبع ذلك جمع المعلومات والإحالة للمساعدة وتقديم النصح وهي أمور مطلوبة قبل تنفيذ أيّ برنامج فعال لإعادة الدمـج. إلا أنّ خطر فشل هذه الجهود في الحالات التي يكون المقاتلون فيها أعضاء في المجموعات المسلحة الغير نظامية يصبح أعلى بسبب إمكانية رفض ومقاومة المجتمعات لهذا الدمج. كذلك، قد لا يثق قادة هذه المجموعات في عملية السلام، وقد يمنعون بعض جنودهم من المشاركة في عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج وذلك من أجل إبقاء احتياطي لهم في حال لم تصمد عملية السلام وتمّ اللجوء للقتال من جديد (مثال ذلك ما حدث في جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي و السودان)7
سياسياً (العقبة الكبرى):
من خلال استعراض تجارب الدول التي مرّت بمرحلة تحول ديمقراطي تتضمن عملية إعادة هيكلة للأجهزة الأمنية ونزع سلاح، نجد أنّ الإطار العام لعملية إعادة الهيكلة يكاد يكون متطابقاً ما خلا بعض الفروقات البسيطة العائدة لخصوصية كلّ بلد وأجهزته واحتياجاته الأمنية، ولكن المشكلة والاختلاف الحقيقي يكمن في طريقة وصول كلّ بلد إلى مرحلة التحوّل الديمقراطي، الأمر الذي سيترتب عليه تحديد شكل عملية إعادة الهيكلة ومدى صعوبتها والأطراف القائمة عليها، وخصوصاً إذا كان هذا التحوّل الديمقراطي جاء بنتيجة صراع دموي طويل الأمد كما هو الحال في سوريا.
فالصراع الدموي الذي أخذ طابع الحرب الأهلية، وأحدث انقساماً وشرخاً هوياتياً بين مكونات الشعب السوري، سيفرض أن تكون العقبة الكبرى في وجه التحول الديمقراطي في البلاد بما يتضمنه من عملية إعادة هيكلة للأجهزة الأمنية هي "العدالة الانتقالية وعملية المصالحة الوطنية"، تلك الخطوة التي سيحدّد شكلها السيناريو الذي سينتهي به الصراع في سوريا، وهنا نحن أمام خيارين: إمّا أن يخرج أحد طرفي الصراع منتصراً فيطبق ما يسمى سياسياً بـ (عدالة المنتصر)، وهي وإن كانت أقرب إلى الشكل الانتقامي منه إلى العدالة، إلا أنّها ستكون أسهل بالنسبة لعملية إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية كون العملية ستقاد من قبل الطرف المنتصر ووفق أجندته وتصوره لدور تلك الأجهزة، أما في حال تمت نهاية الصراع وفق المطروح من تصوّرات دولية تكون فيها قيادة المرحلة الانتقالية والتحول الديمقراطي مشتركة بين طرفي الصراع، فإنّ عملية العدالة الانتقالية لن تنجح على الغالب في محاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا، وعلى رأسهم نظام الأسد وضباط جيشه وأجهزته الأمنية، وهناك العديد من التجارب التي استدعت فيها المصالحة الوطنية والمشاركة في إدارة عملية التحول الديمقراطي العفو أو تأجيل محاكمة مرتكبي جرائم الحرب لسنوات ليست بقليلة، كما حدث في تجارب معظم دول أمريكا اللاتينية وأفريقيا وكوسوفو، ولكن الأمر مختلف في الحالة السورية حيث أنّ إفلات رموز الإجرام في نظام الأسد من المحاكمة أو تأجيلها سيفسد بالضرورة عملية المصالحة الوطنية، كونه سيترك إرثاً كبيراً جداً من الظلم والقضايا المعلّقة لمئات الآلاف من ضحايا النظام، وسيجعل البلاد عرضة لاندلاع الصراع مرّة أخرى في أيّ لحظة، خصوصاً مع وجود فصائل المعارضة المسلحة، والتي من الصعب أن تلقي السلاح في حال عدم تحقّق العدالة الانتقالية، وهنا تظهر عقبة أخرى في وجه عملية التحول الديمقراطي وهيكلة الأجهزة الأمنية كجزء منها، وهي صعوبة عملية نزع السلاح من يد فصائل المعارضة والمليشيات غير الحكومية الداعمة لنظام الأسد، وإعادة دمجها في القوات الحكومية، والذي يعتبر شرطاً مبدئياً لنجاح عمليتي التحوّل الديمقراطي وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، وتعتبر الحالة الليبية مثالاً واضحاً جداً على فشل عملية التحول الديمقراطي وإعادة بناء أجهزة أمنية جديدة، نتيجة لرفض الفصائل الثورية المسلحة إلقاء السلاح والاندماج في الأجهزة الأمنية الحكومية8، على الرغم من أنّ سيناريو الحل في ليبيا كان انتصار طرف على الآخر.
كما أنّ مشاركة ضباط أو مسؤولي نظام الأسد في عملية التحول الديمقراطي سيشكل عقبة جديدة في وجه تلك العملية وبخاصة شقّها المتعلّق بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، وسيطيل من أمدها ويزيد صعوبتها كما حدث في الحالة البرازيلية، خصوصاً مع انقسام الشارع السوري الناتج عن الصراع، وانشغال الأحزاب والمجتمع المدني في مرحلة ما بعد الصراع بعملية معالجة آثاره وعلى رأسها إعادة الإعمار، والتي ستكون على رأس أولوياتهم، مما قد يؤدي إلى فقد الدعم الشعبي والتوافق حول عملية إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، بل إنّ مشاركة أعضاء النظام السابق في عملية التحوّل الديمقراطي قد يودي بالعملية كاملة، ويؤدي إلى إعادة إنتاج الديكتاتورية بشكل مختلف، وهو ما حدث في مصر نتيجة سيطرة الجيش على عملية التحوّل الديمقراطي ومشاركة "الفلول" في العملية.
مما يزيد من خطورة سيناريو الإدارة المشتركة بين المعارضة والنظام لعملية التحوّل الديمقراطي ويجعلها في صالح النظام، وخاصة فيما يتعلّق بعملية إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، أنّ المعارضة السورية في تصوّرها إن لم يكن الوحيد فهو الأكثر تكاملاً وأقصد هنا "خطة التحوّل الديمقراطي"، لم تحسب حساب لهذا السيناريو، وإنما بنت خطتها وبرنامجها لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية على أساس أنها الطرف المنتصر، والذي سيقود منفرداً العملية برمتها9، وهذا قد يكون عائداً إلى توقيت إصدار الخطة والذي كان في آب/أغسطس 2013 حيث كانت الموازين العسكرية والسياسة تميل لصالح المعارضة، ولم يكن التدخل الروسي على الأرض في سوريا قد حدث بعد، الأمر الذي جعل من الخطة متفائلة جداً بل وأقرب إلى الحالة المثالية منها إلى الواقعية.
وفي ظلّ سيناريو الإدارة المشتركة بين النظام والمعارضة لعملية التحول الديمقراطي وهيكلة الأجهزة الأمنية، وما سينتج عنه من خلافات بين الطرفين كون تصوّر كل منهما مختلف تماماً عن الآخر حول الأجهزة الأمنية ودورها الوظيفي، تظهر الحاجة إلى وجود داعمين إقليميين ودوليين لعملية إعادة الهيكلة عموماً وخطواتها التقنية خصوصاً من حيث إعداد برامج التدريب وإرسال مدربين، وقد تكون العملية بحاجة لقيادة دولية في بدايتها نتيجة عجز النخب المحلية السورية عن قيادتها، وهنا ستظهر العقبة الأكبر أمام عملية إعادة الهيكلة فمن هو الطرف الدولي أو الإقليمي الذي سيدعم أو سيقود عملية إعادة الهيكلة10 في ظلّ انقسام المواقف الإقليمية والدولية بين داعم للمعارضة وداعم للنظام، وعلى هذا الأساس فإنّ لكل طرف وجهة نظر خاصة في عملية إعادة الهيكلة، وفي ظلّ الوجود العسكري الروسي على الأرض يبدو أنّ روسيا ستكون صاحبة الدور الأكبر في عملية إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية السورية، حتى لو شاركت أطراف أخرى إقليمية أو دولية، الأمر الذي إن حدث سيشكل خطراً على إمكانيات نجاح إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية بشكل ديمقراطي وسيجعل العملية منحازة باتجاه النظام، وهذا ما تثبته دراسة تجارب إعادة الهيكلة في دول ما بعد الصراع، والتي سيطر عليها طرف دولي وحيد مما أدّى إلى فشل العملية كما حدث في تجربة سيراليون، والتي سيطرة فيها الولايات المتحدة الأمريكية على عملية إعادة الهيكلة .
تقنياً (أزمة الإيديولوجيا):
ليست وحدها عقبة اتفاق المصالحة وشكل نهاية النزاع الدائر هي ما قد يعطّل عملية التحوّل الديمقراطي بما تحتويه من نزع للسلاح وإعادة دمج للمقاتلين في قوات حكومية تعمل وفق الضوابط الديمقراطية، وإنّما تعتري خطوات تلك العملية بشقها التقني أيضاً مجموعة من العقبات تفرضها التوجهات الإيديولوجية المختلفة للأطراف المنخرطة بالصراع السوري والجهات الداعمة لها، الأمر الذي سيزيد من صعوبة عملية نزع السلاح من أيدي الفصائل والمليشيات غير الحكومية، عملية صعبة جداً وطويلة الأمد وبحاجة إلى دعم وتوافق السوريين أنفسهم ومن خلفهم الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالأزمة السورية، لذا سنعتمد معيار الإيديولوجيا لتقسيم الأطراف المسلّحة المنخرطة في الصراع على الأرض السورية لمناقشة إمكانيات إلقاء كلّ من تلك الأطراف سلاحه في ظلّ أيّ سيناريو للحل يتمّ التوافق عليه.
النظام السوري:
كان الارتباك هو السمة الأبرز لتعاطي النظام السوري مع الثورة منذ بدايتها، وخصوصاً في قرار إقحام الجيش في حرب مفتوحة مع المجتمع استنزفت قوته العددية والتسليحية عبر القتل والانشقاقات، وإن كان لا يوجد أرقام دقيقة حول الخسائر البشرية التي لحقت بجيش النظام إلّا أنّ غالبية التقارير تشير إلى أنّه خسر ما يزيد عن نصف قوته البشرية خلال سنوات الصراع الخمسة، ومع انتشار رقعة الصراع جغرافياً لم يجد النظام السوري بدّاً من تشكيل مليشيات داعمة لتغطية العجز العددي في قواته، ونتيجة قلّة خبرة تلك القوات القتالية كون عمادها الأساسي هم المدنيون، انحسر دورها إلى حماية المدن الخاضعة لسيطرة النظام وليس القتال على الجبهات، الأمر الذي دفع النظام إلى استدعاء ميليشيات خارجية تحمل إيديولوجيا طائفية (شيعية) تمثل المشروع التوّسعي الإيراني مما زاد في توّرط نظام الأسد في هذا المشروع وأحكم السيطرة الإيرانية على قراره السياسي من جهة، وهيمنة قادة المليشيات الأجنبية على القرار العسكري الميداني من جهة أخرى، ومع عجز التدّخل الإيراني عن صدّ هجمات المعارضة المسلحة و استعادة أيّ من المناطق الخاضعة لسيطرتها، وكمخرج من الهيمنة السياسية والعسكرية الإيرانية على قرار النظام اتجه الأخير نحو استجرار الروس للتدخل العسكري المباشر على خط الأزمة، الأمر الذي زاد من تعقيدها وأضاف لها بعداً دولياً، وبطبيعة الحال أعاد خلط الأوراق وترتيب النفوذ السياسي والعسكري على صعيد جيش النظام والمليشيات الداعمة له.
تعدّد الإيديولوجيات والمصالح المتضاربة للمليشيات الداعمة لنظام الأسد، هو ما سيشكل العقبة التقنية التي ستواجه النظام حتى في ظلّ سيناريو مشاركته في المرحلة الانتقالية، وستكون صعوبة نزع السلاح من أيدي تلك المليشيات متفاوتة بحسب توّجهها الإيديولوجي، وسنستعرض فرص وعقبات كل منها (لمزيد من المعلومات حول الفصائل المقاتلة إلى جانب النظام يمكن الاطلاع على الجدول التالي) بالشكل التالي11:
المليشيات شبه الحكومية:
تنقسم هذه المليشيات إلى ثلاثة أنواع:
- مليشيات مهمتها حماية مراكز المدن والإيحاء بقدرة الدولة على فرض سيطرتها، وهي تقوم بدور الشرطة أكثر من الدور العسكري القتالي، غالبية منتسبيها من المدنيين عديمي الخبرة العسكرية والذين كان انضمامهم لها في الغالب نتيجة البطالة والظروف الاقتصادية السيئة، وتسليحها لا يتجاوز السلاح الفردي الخفيف، ومثالها قوات الدفاع الوطني وكتائب البعث وقوات الحماية الذاتية.
بالنسبة لهذه المليشيات ستكون عملية نزع السلاح وإعادة الدمج سهلة كونها تخضع بالكامل لسيطرة وزارة الدفاع أو أجهزة المخابرات وحزب البعث، وعودة أفرادها إلى الحياة المدنية أيضاً لن يتطلّب جهداً كبيراً أو برامج متخصّصة، وإنما سيتطلّب دعماً اقتصادياً وخلق فرص عمل بديلة عن العمل العسكري.
- مليشيات مكوّنة من جنود محترفين، تمّ تكوين بعضها بشكل مختلط بين أجهزة المخابرات والجيش للقتال بأسلوب حرب العصابات الذي تتبعه فصائل المعارضة بسبب عجز الجيش عن هذا النوع من المعارك مثل "قوات النمر" التي تشكّلت من المخابرات الجوية والفرقة الرابعة، و بعضها الآخر هو من الفصائل الفلسطينية الموجودة في سوريا والموالية للنظام وجيش التحرير الفلسطيني.
هذا النوع من المليشيات سيعود إلى مراكز خدمته النظامية في حال توّقف النزاع ولا خشية من تمسّكه بسلاحه خارج إطار القوات الحكومية، كونهم ينتمون بالأصل إلى المؤسسة العسكرية، وما الطبيعة المليشياتية لعملهم إلا نتيجة لطبيعة الصراع.
- ميليشيات عقائدية حزبية شكلتها بعض الأحزاب الموالية للنظام من أعضائها السوريين وغير السوريين، مثل ميليشيا نسور الزوبعة التابعة للحزب القومي السوري الاجتماعي، ومليشيا الحرس القومي المشكلة من قوميين عرب من عدّة دول ومليشيا المقاومة السورية التي تتبنى الفكر الماركسي اللينيني، وتعدّ تلك المليشيات منعدمة الوزن في الصراع السوري من حيث العدد والعتاد، وإنما هي تعمل كداعم لقوات النظام في بعض الجبهات وتحت إشرافها وسيطرتها، لذا سيكون إلقاءها للسلاح أمراً منوطاً بإرادة النظام.
المليشيات الطائفية:
يعدّ هذا النوع من المليشيات الداعمة للنظام هو الخطر الحقيقي والعقبة التي ستقف في وجه عمليات نزع السلاح من الأطراف غير الحكومية، كون هذا النوع من الميليشيات لا يخضع لقيادة النظام، وإنما يقوم بالتنسيق مع قواته فقط، ويمكن تقسيم تلك المليشيات إلى نوعين:
- مليشيات طائفية غير شيعية :
تتميز هذه المليشيات بكونها سورية نشأت من المكونات الطائفية السورية (العلوية- الدرزية- المسيحية) والحجّة حماية كلّ طائفة من الجماعات الإسلامية المتشددة (داعش والنصرة)، وهي وإن كانت لا تشارك في عمليات عسكرية مباشرة إلى جانب قوات النظام ضد المعارضة بل تلتزم في حدود مناطقها، ولكن خطرها يكمن في طبيعتها الطائفية والمعادية للأكثرية الأمر الذي يعزّز من البعد الطائفي للصراع ويزيد من احتمال الانجرار إلى قتال طائفي بين مكوّنات الشعب السوري، هذا النوع من المليشيات سيحدّد شكل نهاية الصراع فرص إلقائه للسلاح وعودة مقاتليه إلى الحياة المدنية، ففي ظّل سيناريو تسلّم المعارضة للسلطة ستكون العملية صعبة جداً كون تلك المليشيات لن تلقي سلاحها خوفاً من أعمال انتقامية لفصائل المعارضة، ولحماية مصالح طوائفها في النظام الجديد، أما في ظلّ سيناريو انتصار النظام أو الإدارة المشتركة، فسيكون الأمر أقلّ صعوبة كون حجة تشكيل تلك المليشيات ستكون باطلة، وهذا ما يشكّل جزءاً كبيراً من وجهة النظر الدولية حول بقاء بشار الأسد في المرحلة الانتقالية على الأقل وتشكيل حكومة مشتركة بين النظام والمعارضة، الأمر الذي سيعطي ضمانات للأقليات التي ربطت مصيرها بمصيره وسيسهل عملية سحب سلاحها.
- المليشيات الشيعية:
ترتبط هذه المليشيات بمجملها بإيران، وتخضع لسيطرتها من حيث الدعم والتمويل والقيادة، وتتمتع بنفوذ أكبر من قوات النظام على الأرض السورية، وهي على اختلاف جنسيات مقاتليها إلا أنّها منظمة ومسلحة بشكل يفوق تسليح قوات النظام مما جعلها القوة البرية الضاربة في مواجهة فصائل المعارضة حيث تنحسر مهمة قوّات النظام بتقديم الغطاء الجوي والدعم اللوجستي فقط لتلك المليشيات في الجبهات المشتركة، وقد تغوّلت تلك المليشيات على قوات النظام السوري لدرجة باتت تثير حنق ضباط النظام12.
تتركز مهمة تلك المليشيات حول تثبيت النفوذ الإيراني في سوريا عبر حماية نظام الأسد، لذلك ففي حال بقاء هذا النظام فسيتم سحب الميليشيات الأجنبية عدا حزب الله، والذي ستحاول إيران الاعتماد عليه لاستنساخ نفسه في سورية عبر تشكيل وتدريب مليشيات من الشيعة السوريين، وتكوين كانتون شيعي في العاصمة السورية أشبه بالضاحية الجنوبية لبيروت، وهذا ما تؤكده الرسالة التي وجهها الحزب عبر الاستعراض العسكري الذي أقامه في القصير13 وتوجه إيران لتشكيل مليشيات من الشيعة السوريين في مناطق تواجدهم وبخاصة نبل والزهراء في حلب والسيدة زينب في دمشق، وهذا ما يعكس ضعف الثقة الإيرانية بالنظام والطائفة العلوية كحليف دائم من جهة، ومن جهة أخرى خشية النظام من تزايد النفوذ الإيراني في سوريا وسيطرتها على القرار السياسي والعسكري، لذا لجأ النظام إلى الروس كمخرج لمأزقه العسكري أمام فصائل المعارضة ولتحقيق توازن نفوذ مع إيران على الأرض السورية، وهذا التواجد الروسي سيسهل عملية نزع سلاح المليشيات الشيعية السورية وحلّها أو إعادة دمج بعض مقاتليها في القوات الحكومية، بالإضافة للحؤول دون بقاء أيّ من الميليشيات الشيعية الأجنبية في الأراضي السورية وعلى رأسها حزب الله، وهذا ليس فقط لإضعاف نفوذ إيران في سوريا لصالح النفوذ الروسي وإنّما لصالح حماية أمن إسرائيل التي لن تقبل بوجود إيراني على حدودها مع سوريا.
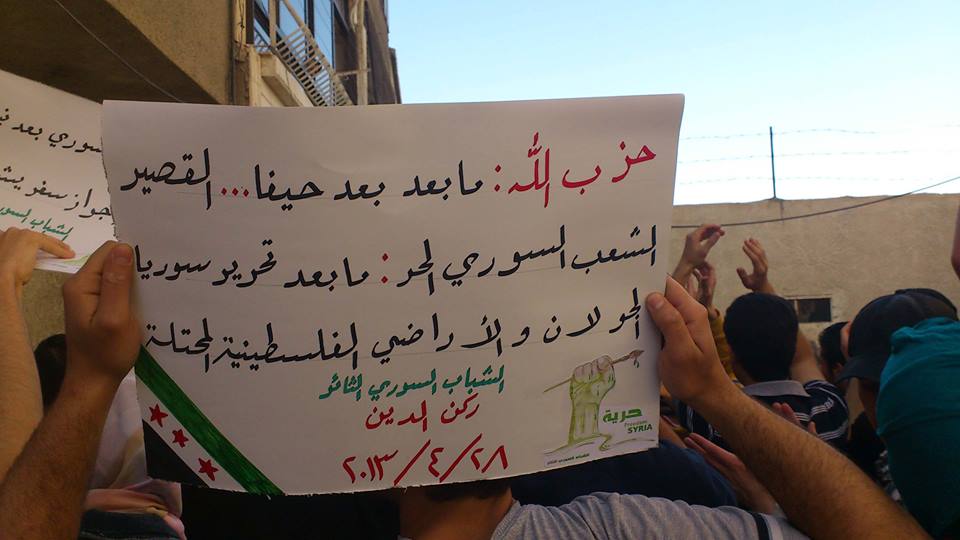
فصائل المعارضة:
سعى النظام في إطار مواجهته للثورة السورية السلمية في بدايتها إلى دفعها نحو العسكرة عبر استخدام العنف المفرط في مواجهة المتظاهرين، وذلك كي يخلق ذريعة لقمعها بشكل وحشي، وبذات الإطار أسهم بشكل مباشر في إسباغ الطابع الإسلامي على عملها العسكري عبر إطلاق سراح بعض المعتقلين الجهاديين بالتزامن مع انطلاقة الثورة، وعبر سياساته الطائفية في مواجهتها بهدف إلصاق تهمة الإرهاب بالثائرين وذلك لشرعنة قتلهم أمام جمهوره في الداخل وأمام المجتمع الدولي.
لذلك كان الطابع العفوي هو السمة الغالبة للنشاط العسكري في بداية الثورة السورية من جانب المعارضة إن كان على صعيد تشكيل الكتائب أو عملياتها العسكرية، حيث بدأ هذا النشاط بشباب مدنيين وبعض الضباط والعسكريين الوطنيين ممن انشقوا عن جيش النظام، وهم من شكلوا نواة العمل العسكري في الثورة، وهو الجيش السوري الحر بتوجهه الوطني وتبنيه أهداف الثورة السورية وعلمها، ولكن في ذات الوقت كانت تتشكّل كتائب إسلامية تنتمي للفكر السلفي الجهادي على يد بعض المفرج عنهم من سجون النظام من الجهاديين، وتلك الكتائب وإن كانت تقاتل في صفوف المعارضة ضد النظام إلا أنّها لا تعتبر نفسها في الغالب تنتمي للثورة السورية بأهدافها الوطنية ولا تتبنى علمها.
وهنا كان الشرخ الأساسي في العمل العسكري للمعارضة على أساس إيديولوجي، حيث باتت الفصائل السلفية الجهادية تنسّق مع بعضها على أساس التوّجه الإسلامي وتمارس نوع من الدعاية المضادة للجيش السوري الحر، علماني التوجه لاستقطاب مقاتليه، وتمّ تركه وحيداً في مواجهة التنظيمات الجهادية المتطرفة، وخصوصاً تنظيم الدولة، مما ساهم في إضعاف تشكيلاته بشكل كبير جداً وانحسار مساحة الأراضي التي يسيطر عليها لصالح السلفية الجهادية، ما زاد من تراجع الجيش السوري الحر هو البعد الإقليمي الطائفي للصراع، والذي أدى إلى تركز الدعم الإقليمي باتجاه الفصائل السلفية الجهادية، لذا فإنّ مناقشة عمليات نزع السلاح وإعادة الدمج ستكون في إطار هذين الفصيلين، واللذين تندرج تحتهما جميع الفصائل المسلحة في جانب المعارضة (لمعلومات أكثر تفصيلا عن هذه الكتائب يمكن الاطلاع على الجدول التالي) والتي وصل عددها إلى أكثر من سبعين فصيلاً14.
الجيش السوري الحر (مشروع الثورة):
يُشكّل الضباط والعسكريون المنشقون العمود الفقري لكتائب الجيش السوري الحر، والذي يسعى إلى إقامة دولة ديمقراطية تعدّدية تحترم حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي بحسب بيان تأسيسه، وهو الكيان العسكري الوحيد الذي لا يزال يرفع علم الثورة السورية بين فصائل المعارضة ويحظى بتأييد الحاضنة الشعبية للثورة في المناطق المحرّرة حتى الخاضعة منها لسيطرة فصائل السلفية الجهادية.

وعلى الرغم من تراجع قوته وانحسار الأراضي الواقعة تحت سيطرته وذوبان معظم كتائبه في كيانات أو غرف عمليات مشتركة مع الفصائل السلفية، إلا أنّه داخلياً وخارجياً يعتبر الجهة الوحيدة الممثلة للثورة السورية، والتي يعوّل عليها في بناء جيش جديد في سوريا في ظلّ أيّ سيناريو سياسي للحل. لذلك فهو الطرف الأسهل في جانب المعارضة من ناحية قبول عملية التحوّل الديمقراطي وعملية نزع السلاح وإعادة الدمج، كون هؤلاء الضباط والعسكريين المنشقين سيعودون بموجب أيّ حلّ سياسي إلى قطعاتهم العسكرية ومراكز خدمتهم، ولكن تبقى تلك العودة مرهونة بشكل اتفاق المصالحة والحل السياسي الذي يضمن تحقّق مطالب الثورة، والأمر سيان بالنسبة للمدنيين المنضوين في كتائب الجيش الحر، حيث سيكون من نزع سلاحهم رهناً بتحقّق الأهداف التي حملوه من أجلها.
الفصائل السلفية الجهادية (مشروع أمة):
تُصنّف الفصائل الجهادية في علم السياسة على أنّها جماعات فوضوية (أناركية) لها مشروعها الإيديولوجي الخاص بإقامة الدولة الإسلامية، وهي في هذا الإطار تبحث عن أيّ فرصة مواتية في بلد إسلامي تضعف فيه السلطة المركزية ويدخل في حالة فوضى أمنية بصرف النظر عن طبيعة الحدث الذي أدى إلى هذه الفوضى، فهي لا تعبأ بالثورة السورية أو أهدافها، وإنّما ما يعنيها هو سوريا كقطعة من الأرض لتنفيذ مشروعها الخاص.
ولكن مع تطوّر الثورة السورية وظهور النسخة الداعشية للسلفية الجهادية وبداية الحرب على الإرهاب، بدأ بعض المنظرين السوريين داخل تلك الجماعات بمراجعة التجربة الجهادية، وأعلنوا قبولهم ببعض المفاهيم الحداثية للدولة في إطار المراوغة السياسية فقط، فنشأ ما يسمى "بالسلفية الوطنية" والذي ترجمته حركة أحرار الشام الإسلامية إلى تغيير في شعارها من "مشروع أمة" إلى "مشروع ثورة"، ولكن هذا التحوّل الشعاراتي لم يترجم عملياً على الأرض فهم لا يزالون يمانعون رفع علم الثورة السورية ولا يقبلون سوى بمفهوم الدولة المدنية بمعناها اللا عسكري فقط، كما أن التقارب بينهم وبين "أخوة المنهج" في جبهة النصرة، فرع تنظيم القاعدة في سوريا لم يتأثر بهذه المراجعات، بل إنّ تلك المراجعات أحدثت انقسامات حادة داخل تلك الفصائل بين الأجنحة التي تصنّف معتدلة والأجنحة الراديكالية.
لذا تعد عملية نزع سلاح هذه الفصائل عملية معقدة بشكل كبير كون جزء كبير من مقاتليها هم ممن يتبنون الفكر الجهادي، وخصوصاً على مستوى القيادة، وأيّاً كان شكل نهاية الصراع في سوريا أو اتفاق المصالحة فهو لا يعنيهم، ولكن مع ظهور تيارات منفتحة نسبياً على العملية السياسية قد يتم التعويل على هذه التيارات وأنصارها للقبول بتسليم سلاحهم والعودة إلى الحياة المدنية، ولكن المؤكد أنّ التيارات الراديكالية في تلك الحركات لن تقبل وفي ظلّ ضربات التحالف الدولي والروسي لهذه الجماعات من المرجح أن تنزاح تلك التيارات باتجاه بعضها البعض لتشكيل كيان جديد متشدّد أو الانضواء تحت لواء جبهة فتح الشام المصنّفة إرهابية، وخارج أيّ اتفاق سياسي لإنهاء الصراع.
مليشيات انفصالية (الحرب المؤجلة):
هناك نوع ثالث من الميليشيات المنخرطة في الصراع السوري، والتي تحمل مشاريع ذاتية تستهدف الانفصال عن سوريا أو إقامة كيانات حكم ذاتي، وهذا النوع من المليشيات يعد أخطر ما يهدّد سوريا ما بعد نهاية الصراع بين النظام والمعارضة، وينذر باحتمالية كبيرة لاندلاع صراع جديد قد يشترك فيه جميع السوريين في ظل أيّ اتفاق للمصالحة ضد تلك المليشيات حفاظاً على وحدة التراب السوري، ونقول صراع كون تلك المليشيات إمّا مصنّفة إرهابية كتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وجزء كبير من جبهة فتح الشام وما سينضم إليها من تيارات راديكالية في الفصائل الجهادية من الرافضين للعملية السياسية برمتها، ويسيطرون على مساحات واسعة من الأرض السورية، أو تجد في الثورة السورية فرصة تاريخية للانفصال كالحالة الكردية التي تمثّلها مليشيات الـ PYD .
الخاتمة:
يُعدّ تشعب المشارب الإيديولوجية للأطراف المنخرطة في الصراع السوري والذي ضيّع البوصلة الوطنية للبنادق المشتركة فيه، هو العقبة الأكبر في وجه عملية التحوّل الديمقراطي بشقيها السياسي والمتعلّق بإمكانيات الوصول إلى اتفاق مصالحة وطنية مرضي لجميع الأطراف، أو شقها التقني المتعلّق بنزع السلاح من المليشيات والفصائل غير الحكومية، والذي سيكون عملية معقدة قد تعجز عنها النخب السورية لوحدها مما يدفع إلى تدخل دولي أو إقليمي بشكل قوات حفظ سلام لفرض أيّ اتفاق مصالحة يتم التوّصل إليه، وهو الاحتمال الذي تؤكده تجارب الدول التي مرّت بصراعات مشابهة.
(الصورة الرئيسية: تصميم للفنان مصطفى عذاب عن الجيش السوري، إذ يوضح العلاقة بين الجيش وما بات يعرف في سورية بالتعفيش. المصدر: الصفحة الرسمية للفنان على الفيسبوك. الحقوق محفوظة للمؤلف. تستخدم الصورة ضمن سياسة الاستخدام العادل)




