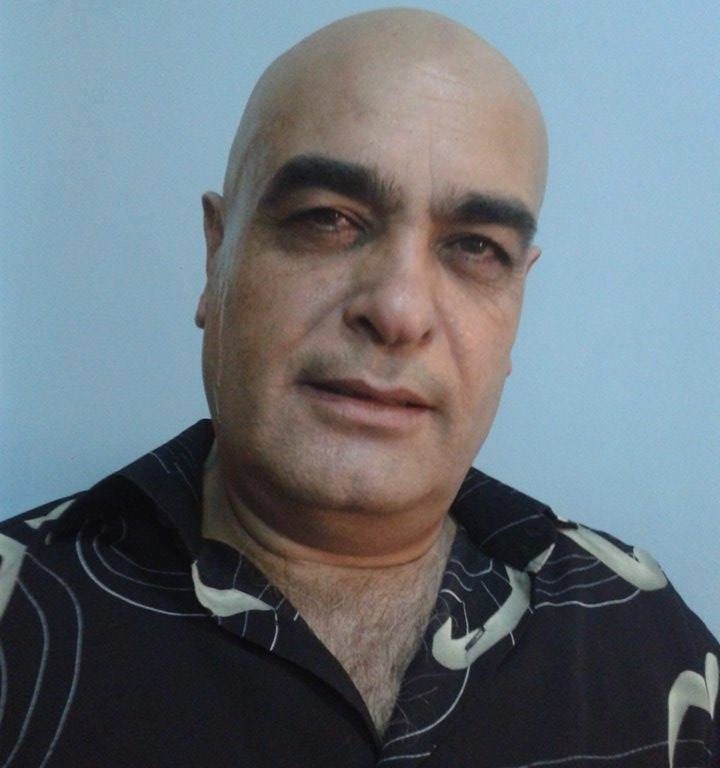يتيح "اليوم العالمي لحريّة الصحافة"، الواقع في 3/أيار/مايو، فرصة لتسليّط الضوء على حالة حريّة التعبير في سوريّة، ومعرفة فيما إذا كانت صاعدة أم هابطة. ولذلك يمكن لنا هنا طرح سؤالين يكون مصبّ الإجابة عنهما في منحنى حريّة التعبير ومعرفة كيف كان المنحنى صاعداً ومحرّضاً، وكيف كان هابطاً ومثبطاً، ويكشف لنا بروز "عقبة الفقه" أمام حريّة التعبير ويحدِّد لنا كيفية تجاوزها.
السؤال الأول: ما حالة حريّة التعبير في سوريّة الآن؟ أما السؤال الثاني: ما حالة حريّة التعبير في سيرورة الثورة السوريّة؟
إنَّ الإجابة تُدلِّل على حالتين متعاكستين ومتمايزتين لحريّة التعبير من جهة، ومن جهة أخرى، تُبرز عقبة قديمة/ جديدة أو متجددة أمام حريّة التعبير هي عقبة المنظومة الفقهيّة الثقافيّة العربيّة الإسلاميّة وما يُكمِّلها من عدم القطع المعرفيّ مع مثل هذه المنظومة من جهة غالبيّة الجمهور السوريّ. ومثل هذه العقبة يمكن أنْ تُضاف إلى عقبات أخرى تقمع حريّة التعبير وتلغيها كالحرب والإرهاب والاستبداد والفوضى التي تعيشها سوريّة في هذه المرحلة، ولكن تجاوز مثل هذه العقبة يختلف عن تجاوز العقبات الأخرى؛ لأنَّ المنظومة الفقهيّة الثقافيّة هي معرفة ولا يتم تجاوزها والقطع معها إلا معرفياً، والعقبة المعرفيّة تستدعي القطيعة المعرفيّة مع المنظومة المعرفيّة التي أنتجت هذه العقبة.
في الواقع، أحرز البشر في تاريخهم المأساويّ حريّة التعبير كمثلٍ أعلى تصبو إليه الثقافات المختلفة، وتحثّ عليه المواثيق الدوليّة العديدة لحقوق الإنسان، لما لحريّة التعبير من فاعليّة في تقدّم البشر إنسانياً. ومن هذه الثقافات ثمّة ثقافات قد حققّت هذا المثل الأعلى نسبياً وجعلته في مواثيق مقوننة، وثمّة ثقافات لم تحققّه بعد، بل بالعكس تسعى لتأصيله في ماضيها بوصفه استمراراً لشبيه ما في موروثها وكأنه فرع يُرد إلى أصل، فلا تسعى لاستيعاب الجديد الذي أتى به هذا المثل الأعلى ولا تراهن على فاعليته، فتتخلّى هذه الثقافة بهذا الأسلوب عن واجبها في تبيئة مثال حريّة التعبير في حاضرها وتطبيعه في وعي جمهورها.
وواقع الحال في المنظومة الفقهيّة الثقافيّة العربيّة الإسلاميّة، هو عدم تحقيق هذا المثال الأعلى (حريّة التعبير)، ومحاولة بلعمته وامتصاصه في أحشاء الماضي على الرغم من المحاولة العميقة لتحقيقه وممارسته في سياق الربيع العربيّ والثورة السوريّة بوصفه خيراً عاماً وشيئاً جديداً وافداً على الثقافة العربيّة.
عموماً، فجرّت حريّة التعبير الربيع العربيّ. فمن تونس إلى مصر إلى ليبيا واليمن وسوريّة، كانت حريّة التعبير، المقموعة أساساً من قبل أنظمة الاستبداد، هي من تُعبِّر عن طموحات العرب وآمالهم وإرادتهم في الحريّة والكرامة والتغيير الوطني الديمقراطي. وكان من المحتمل أنْ تمتد تداعيات حريّة التعبير هذه لتطال دول أخرى. أما خصوصاً وضمن السياق نفسه، فقد فجرّت حريّة التعبير الثورة السوريّة، ثورة الحريّة والكرامة، وتصاعدت حريّة التعبير وتنامت في سيرورة الثورة بالتغذية المتبادلة بين حريّة التعبير وبين ما تحمله الثورة من معانِ للحريّة والكرامة. فبواسطة حريّة تعبير "أطفال درعا"، الذين كتبوا إرادتهم على الحيطان وعبّروا بحريّة عنها، وبفضل حريّة تعبير غالبيّة السوريين عن آمالهم وطموحاتهم وإرادتهم، في المظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات، كسرت حريّة التعبير حالة الصمت الطويل في سوريّة.
وبعد أنْ كانت سوريّة "مملكة الصمت" أصبحت أرض حريّة التعبير بمختلف أشكاله وعبر جميع وسائله. كان للحيطان آذان؛ آذان مخيفة تتنصّت على الكلام المعارض قبل الثورة، في إشارة لمعرفة السلطة المستبدة بكلّ ما يدور في المجتمع وتعميمها الصمت والخوف عند السورييّن. ولكن "أطفال درعا" والناشطين السوريين حوّلوا هذه الحيطان إلى أداة لحريّة التعبير العلنيّ والعامّ مع الثورة وبعدها وفي سياقها. فالتحوّل من الصمت إلى التعبير هو من دفع لقيام الثورة وهو من نمى وتصاعد فيها.
ولكن ما يلخص هذه اللحظة في حالة حريَة التعبير هو هبوط وتراجع وانكماش حريّة التعبير بعد استفحال الحرب والإرهاب والفوضى في سوريّة. وترافق مع هذا التقلّص بروز المنظور الفقهيّ الذي يقنّن حريّة التعبير ويبلعمها ويقيم عليها الحدّ. وأصبح السوريّون أمام صعود حريّة التعبير وإمكانيّة تحقيقها من جهة، ومن جهة أخرى إزاء هبوطها وهضمها في الموروث الفقهيّ.
ففي سيرورة تحوّل مثال حريّة التعبير إلى واقع معاش في الثقافة العربيّة، تبرز عقبة الفقه الإسلاميّ لتأجيل ومنع تحققه متظافرة بذلك مع الحرب والإرهاب والاستبداد والفوضى.
وهكذا نجد، كيف يحتفي الخطاب الفقهيّ بحريّة التعبير التي تُبرِّر الواقع وتضفي عليه نوعاً من المشروعيّة العقليّة أو الدينيّة، ولكنه في الوقت نفسه يمنع ويقمع حريّة التعبير التي تنقده وتعارضه أو تتجاوزه وتقطع معه معرفياً.
إنَّ تحدي الفقه لحريّة التعبير يطرح على الثوار السورييّن بالدرجة الأولى تحدّياً مضاداً هو القطع المعرفيّ معه، وتجاوز تحديداته لحريّة التعبير، والوقوف في وجه سعيه لإعادة حريّة التعبير إلى زمن مضى يفقدها فاعليتها؛ لأنَّ الفقه يسعى إلى تأصيل حريّة التعبير بوصفها استمراراً للموروث العربيّ/ الإسلاميّ، في حين أنّها حالة جديدة ونوعيّة تختلف كلّ الاختلاف عن ماضي العرب.
وبالرغم من أنَّ الفقه الإسلاميّ لا يجيب ولا يستجيب للمشكلات الوجوديّة العيانيّة، وللمشكلات المعرفيّة المجرّدة التي طرحتها ثورة الحريّة والكرامة في سوريّة، إلا أنَّه يسود كتيّار عامّ لا يحمل في جعبته غير إجابات الفقه الإسلاميّ العتيقة عن مشاكل لا تهمّ اللحظة الراهنة.
وهنا تجدر الإشارة إلى أنَّ مجتمعنا السوريّ لم يعد مجتمعاً طبيعياً كاملاً كمجتمع النحل والنمل، بل هو مجتمع معرفيّ ناقص يسعى إلى الكمال ولا يصل إليه؛ وهذا معناه أن المجتمع السوريّ مجتمع تاريخيّ إراديّ عقليّ واقعيّ وراهن، وليس محض موجود كوجود الحجارة أو كوجودٍ في الماضي الفقهيّ. أجل، الحجارة موجودة والبشر موجودون ولكن وجود البشر بات أكثر من وجود الحجارة ويحتاج إلى تحديدات كثيرة ومناظير رؤية جديدة لا منظور فقهيّ. لقد بات المجتمع السوريّ عالماً وواقعاً وتاريخاً وإرادة... بات معرفة وليس فقهاً.
ولنلاحظ أنَّ الفقه في آليته يشابه أكثر ما يشابه "سرير بروكوست"، قاطع الطريق الأسطوريّ، الذي يقوم بقص من يقطع طريقهم إنْ كانوا أطول من سريره، ويشدّهم ويمطهم إنْ كانوا أقصر ليتناسبوا مع طول سريره. والفقه يفعل مثله؛ فيأتي بحالة ما مثل حريّة التعبير، ويلقيها على "سرير الفقه" (مقياسه)، فإذا كانت أطول شحّل منها وقصرّها وإن كانت أقصر مطها وشدها لتناسب مقاسه، فتستلقي بهذا الفعل على سرير الفقه جثة هامدة أو مادة لا شكل لها.
المطلوب سورياً، هو أنْ تُشرّع حريّة التعبير لمحاكماتنا العقليّة وأحكامنا بوصفها بوصلةً نسترشد بها الطريق، والمطلوب أيضاً أنْ يَلزمْ الفقه مجاله، لكن الحاصل الآن هو أنَّ الفقه من يُشرّع لحريّة التعبير وللمحاكمات والأحكام العقليّة ويتعدّى مجاله. وبهذا يمارس الفقه نفسه بالبحث عن أصل لما يفترضه فرع، وعن قديم لأيّ جديد، وذلك بالقياس إلى القديم والأصل معتمداً على النصوص العتيقة التي يعتقد أنّها تحتوي أيّ شيء. إنَّ حريّة التعبير ليست من دائرة المجال التداولي للفقه بأيّ شكل من الأشكال وليس الفقه إطاراً مرجعياً لها.
وبالتالي، إنَّ عدم إنجاز القطيعة المعرفيّة مع الفقه يُعمِّق عقبة الفقه أمام حريّة التعبير، ويؤكد الدوران في حلقة مفرغة تنتهي للهبوط أكثر فأكثر في حريّة التعبير. وما ذلك إلا لتأكيده على الاستمرار وإلغاء الانقطاع، تأكيده على القديم ورفض الجديد وانتزاع ألقه. فالديمقراطية ليست شورى، وليس تضارب الآراء في صدر الإسلام حريّة تعبير.
إنَّ تقييد حريّة التعبير في المواثيق الدوليّة العامة والمواثيق الخاصّة بكل دولة على حدة، وتقييد الثقافات المحليّة لحريّة التعبير يطرح مفارقة كبيرة وهي عدم تقييد "تأويل المتلقي" للتعبير المتنوّع. فكما يعني موت الكاتب ولادة القارئ يجب أنْ يعني موت المعبِّر ولادة "تأويل المتلقي". والمفارقة هنا تكمن في تقييد طرف واحد من العلاقة وترك الطرف الأخر حراً في تأويله وفهمه لما يتلقاه من تعبيرات متنوعة، الشيء الذي يجعل المتلقي حراً في إقامة الحدّ على التعبيرات التي يتلقاها كيفما اتفق. وهذه المفارقة تدعو إلى إزالة القيود المفروضة على حريّة التعبير ولا تدعو إلى فرض قيود مماثلة على المتلقي.
مما لا شك فيه أنَّ الثقافة تُحدِّد حريّة التعبير كما تحددها الحرب والفوضى والإرهاب والاستبداد والسلطة. إنه القمع نفسه ولكن بأوجه مختلفة. وأيضاً عدم القطع المعرفيّ يجعل الجمهور متطابقاً مع الفقه فلا يرى عقبة الفقه أمام صعود حريّة التعبير في التاريخ. فالعقبة الفقهيّة المعرفيّة تستدعي القطيعة المعرفيّة معها. وتكون القطيعة المعرفيّة مع الفقه، بعدم مناقشة حريّة التعبير فقهيا، إنْ كان لصالح تبريرها أو للدفاع عنها أو لمحاسبة ما ينتج عنها أو لتحميّل المسؤوليّة.
(تنشر هذه المادة ضمن حملة اليوم العالمي لحرية الصحافة 2017، بالتعاون مع شبكة الصحفيات السوريات).
(الصورة الرئيسية: لوحة للفنان جوان زيرو لصالح مؤسسة "دولتي". المصدر: مؤسسة دولتي والصورة تستخدم بموجب رخصة المشاع الابداعي)