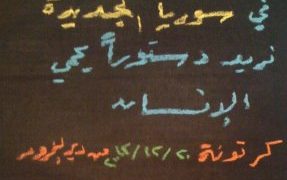(دمشق)، "كيف سأهتم بطلابي وأقدم لهم أفضل ما لدي وأنا مضطر يومياً للعمل خارج دوامي المدرسي لثمانية ساعات، تسلبني طاقتي وقواي وتؤثر على أدائي كمعلم؟".
هو سؤال يطرحه المدرس محمود (مستعار/ 42 عام) الذي اضطر للعمل محاسباً في مطعم، بدخلٍ يقدر بـ 130 دولار، يعينه على أعباء الحياة، بعد أن بات دخله المدرسي، وهو 42 ألف ليرة (ما يعادل 70 دولاراً)، لا يكفي ربع متطلبات المعيشة اليومية.
"كيف سأتمكن من النجاح ولا أجد وقتاً للدراسة؟، كيف سأتعلم وأنا مهدد وعائلتي بالفقر والجوع كل يوم؟".
سؤال آخر يطرحه الطالب عبدالرحمن (مستعار/ 15 عام)، عامل توصيل الطلبات (ديلفري) في مطعم للوجبات السريعة، والذي يعمل فيه نحو 9 ساعات مقابل دخلٍ لا يتعدى 45 ألف ليرة (75 دولاراً)، وذلك ليعين عائلته التي فقدت المعيل.
مرّبي الأجيال بين السخرية والشفقة
واقع المدرس محمود يشبه واقع معظم المدرسين، الذين يزاولون عملهم اليوم، فهم يعيشون في ظل واقع اقتصادي متردٍ، أفرزته ظروف الحرب، يُجبِر معظمهم على العمل خارج أوقات الدوام في أعمال مختلفة، تلاقي كثيراً من الاستهجان ونظرات السخرية والشفقة في بعض الأحيان، كالعمل في المعامل والبقاليات والمطاعم أو كسائقي سيارات أجرة، وذلك ليتمكنوا من تأمين لقمة عيشهم، إذ أن دخل "مربي الأجيال" اليوم أصبح يتراوح ما بين 70 و80 دولار، وفي أفضل الحالات لا يصل إلى 100 دولار، وهو مبلغ لا يكفي لدفع إيجار منزل مناسب للعيش.
ويحاكي واقع الطالب عبد الرحمن واقع الكثيرين من الطلاب النازحين وفقراء الحال، الذين أجبرهم تردي الواقع المعيشي على العمل والتسول خلال فترة الدراسة، ليتمكنوا من تأمين مصاريف المدرسة ومساعدة أفراد عائلاتهم في الحصول على ما يسد الرمق، حيث يعيش اليوم أكثر من 80% من السوريين تحت خط الفقر .
عمل المدرسين يضعهم في مواقف محرجة
خارج أوقات دوامه المدرسي يعمل المدرس سليم (45 عام، مدرس في مدرسة ثانوية بدمشق) بائعاً في دكان. عمله هذا يضعه في مواقف محرجة أمام بعض طلابه، إذ يقول لحكاية ما انحكت "كثيراً ما يأتي طلابي ليشتروا من دكاني وهناك من يأتي من حارة أخرى متقصداً رؤيتي بشكل مغاير لشكلي في المدرسة. بعض المشاغبين منهم يتمشّون مساءاً أمامي ويدخلون كل حين ليشتروا شيئاً، محاولين التعامل معي كمجرد بائع".
ويضيف "في المدرسة أشعر أحياناً ببعض الخجل إذ أرى بعضهم يتغامزون ويتهامسون ساخرين مني أنا "الرجل ذو الشخصيتين"، وذات مرة أحرجني أحد الطلاب بسؤاله: استاذ بقديش عم تبيع علبة العصير بدكانتك؟ سعرك أرخص من سعر دكانة المدرسة، فيما علق طالب آخر: والله يا استاذ بضاعتك أفضل من بضاعة المدرسة".

ويحدثنا المدرس غسان (44 عام)، والذي يعمل سائق سيارة أجرة خلال ساعات المساء، عن بعض المواقف التي صادفته: "خلال عملي كسائق كثيراً ما أصادف طلاباً درَّستهم في السنوات الماضية، فيشعرني ذلك بشيءٍ من الخجل، ولكن الموقف الأكثر خجلاً، والذي لن أنساه، حصل معي حين أوقفتني امرأة وفتاة، لأتفاجأ بأن الأخيرة طالبة من طالباتي في صف الحادي عشر، فكان موقفاً لا أحسد عليه، حيث كانت نظرات الدهشة والتفحص تطل كالسهام من عيون تلك الطالبة لتمطرني بالتساؤلات المحرجة، حتى احمرَّ وجهي من شدة الخجل وارتبكت وبدأ العرق يتصبب من جسدي".
ويضيف المدرس "بعد عدة أيام اتصلت بي الأم، التي أخذت رقم هاتفي لتطلبني إذا ما احتاجت لوسيلة نقل، لأفاجئ بطالبتي تلك وثلاثة طالبات أخريات ينتظرنني أمام البيت لأوصلهن لحضور عيد ميلاد زميلتهن".
يتابع بقهر ووجع: "لا يمكن وصف شعوري يومها وأنا أقود السيارة المكتظة بضحكاتهن، كم تمنيت أن تبتلعني الأرض، وما فاقم الأمر سوءاً هو انتشار خبر عملي هذا بين معظم الطلاب، فأصبحت أخجل من النظر في عيونهم التي تحمل نظراتها الكثير من الاستهجان والسخرية".
"انت شقفة مدرس ما خرج تفتح بيوت"
بعد أن كان المعلم في الماضي يحظى بقيمةٍ اجتماعية كبيرة، تجعل منه ثروة وطنية، بات اليوم خارج أي مكانة مرموقة، يخجل من مهنته التي يستخف بها الجميع، في ظل انعدام أبسط مقومات الحياة التي قد تمنحه شيئاً من التوازن النفسي، وهو ما جعله في حالة دائمة من الاستياء والشكوى والتذمر من واقعه المؤلم والمرير.
في الساحل... أولاد "الشهداء" و"اﻹرهابيين" في مدرسة واحدة
09 تشرين الثاني 2019
واقع المعلم يؤثر على أدائه
التخلي عن المدرسة هو الحل

اللون الخاكي للإهانة
الطلاب النازحون يدفعون الثمن الأكبر
معاناة أخرى
العمل ينافس الدراسة

(الشخصيات الواردة في التحقيق اكتفت بذكر اسمها الأول لأسباب شخصية وأمنية)