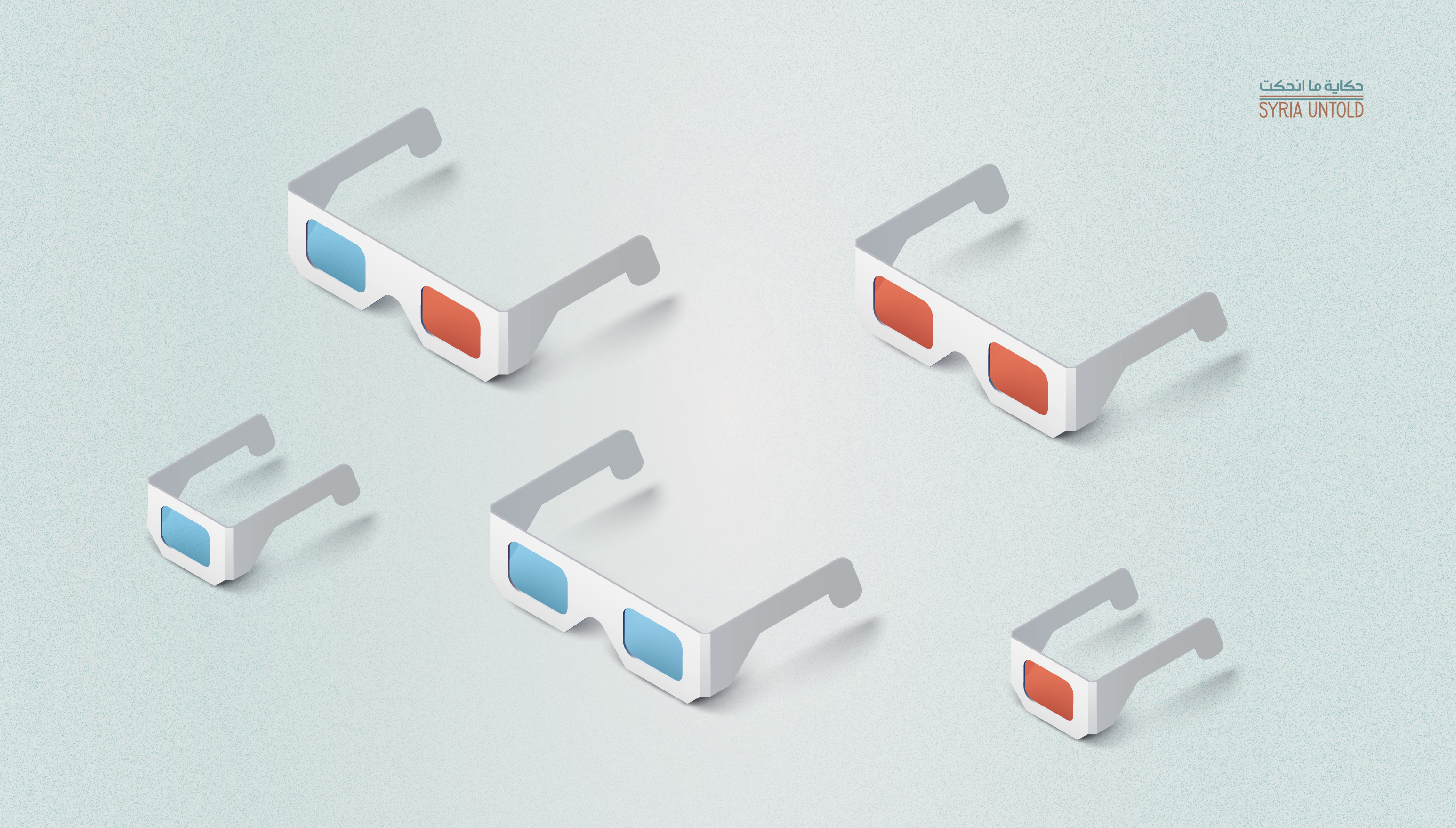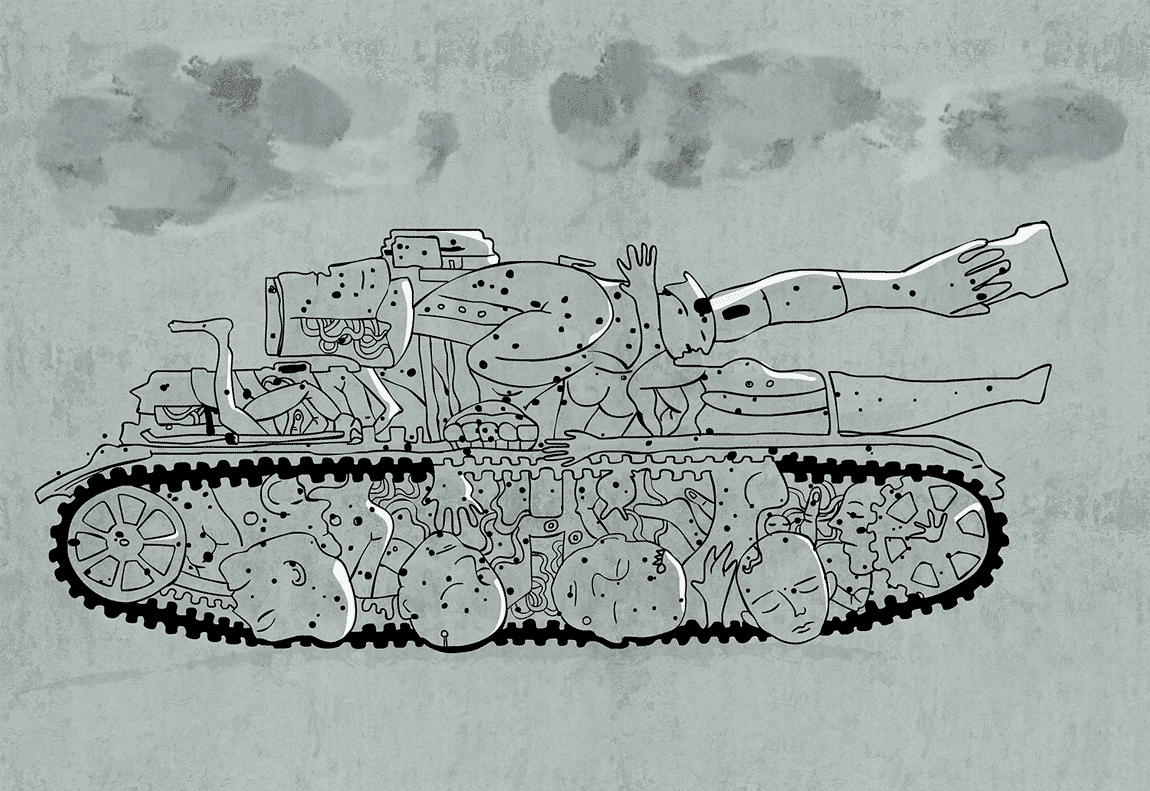(هذا المقال جزء من ملف بالشراكة بين حكاية ما انحكت وأوبن ديموكراسي، حول السينما السورية الصاعدة منذ عام ٢٠١١: السياسة، التحديات الانتاجية، الرقابات، الجمهور، وإلى أين قد تتجه الآن؟)
ينسق هذا المشروع مايا أبيض وإنريكو دي أنجيليس ووليد الحوري، بدعم من مؤسسة فريدريش إيبرت.
تهدف هذا المقالة إلى المقارنة بين السينما اللبنانية خلال سبعينيات القرن الماضي والسينما السورية بعد عام ٢٠١١ من خلال معالجة بعض القضايا التي تثيرها السينما السياسية بشكلها المعاصر. في الحالتين، تتخذ الأفلام موقفاً ضد الحرب والقمع والترهيب. ومع ذلك، تأثيرها السياسي قد تحوّر.
مرحلتان أساسيّتان
مرحلتان أساسيّتان أعادتا تصميم العلاقة بين إنتاج السينما والسياسة في العالم العربي. المرحلة الأولى شهدت بعد هزيمة إسرائيل عام ١٩٦٧ ظهور جيل جديد من المخرجين والفنانين العرب الذين اجتمعوا في دمشق والقاهرة وحاولوا إيجاد طريقة إبداعية جديدة أكثر انسجاما مع مُثُلهم.
أدى ذلك إلى ولادة "سينما الشباب" أو "السينما البديلة". ظهرت في لبنان عام ١٩٧٥ ما يسمى "السينما اللبنانية الجديدة"، بقيادة صنّاع السينما الشباب. لم يكونوا بالضرورة مدربين تدريباً جيداً في هذا المجال، ولكن لديهم أفكارا جديدة أرادوا التعبير عنها مدفوعين بحماسهم الإيديولوجي. وحلموا جميعًا بصناعة أفلام خيالية، لكنهم شعروا أيضًا بالحاجة إلى إنتاج أفلام وثائقية. باع هؤلاء المخرجين الشباب أفلامهم إلى القنوات التلفزيونية الدولية لإيصال قضيّتهم إلى العالم. ويمكن اعتبار هذه الأفلام أفلام تعبئة.
نقطة تحوّل
شكلت انتفاضات عام ٢٠١١ نقطة تحوّل أخرى، حيث بدأت أشكال جديدة من اللغة والأسلوب السينمائي في الظهور. سوف أتّخذ هنا سوريا كمثال على هذه الحالة، تحديداً بسبب الانقطاع الصريح بين نماذج الإنتاج التي كانت موجودة قبل الانتفاضة وبعدها. وسأتكلّم عن صانعي الأفلام الذين يعارضون النظام السوري ويرون السينما كوسيلة للتعبير عن أفكار الثورة السورية وأهدافها.
الجمهور السوري والسينما التي تخصه: قصة تغييب (1)
28 تشرين الثاني 2019
معظمهم لم يكونوا صانعي أفلام نشيطين في ظل النظام قبل عام ٢٠١١، عندما كان العمل السينمائي يخضع دائمًا لرقابة صارمة. إنما بدؤوا في التصوير في فوضى الحرب. وإذ عارضوا النظام وقمعه، انتفض الكثير من هؤلاء المخرجين الشباب على جيل أسلافهم.
تحدّت الأشكال السينمائية التي يستخدمونها السينما التقليدية. وهذه الأفلام هي في الأساس أفلام وثائقية، غالبًا ما يتم تصويرها ارتجالياً، بمعدّات محدودة، وأحيانًا دون أي تجربة سينمائية. ورغم عدم إصدار هؤلاء السينمائيين لأي موقف موّحد من السينما، إلّا أنّ جميع أفلامهم تجتمع على شيء مشترك:
أولاً، تأخذ الأفلام جميعها أشكال السرد الشخصي للمخرج و/ أو أصدقائه وأقاربه، غالباً كطريقة للعيش بشكل فردي في قلب الفوضى.
ثانياً، يتم تداول هذه الأفلام بشكل رئيسي في المهرجانات، ونادراً ما يتم توزيعها خارج هذا السياق، وبالتالي يتم مشاهدتها بشكل أساسي من قبل النخب.
سينما في خدمة الإيديولوجيات
خلال الحرب الأهلية اللبنانية، قرر جيل جديد من المخرجين، تحديداً اليساريين، أن يصوّروا أفلاماً للمضطهدين: الفلسطينيون، أهالي الجنوب اللبناني، والنازحون بشكل عام. لم يرفض المخرجون الشباب في السبعينيات إظهار حقيقة تجربتهم الشخصية، لكنّهم شعروا بالحاجة الملحة لوضع أفلامهم في المقام الأول في خدمة أولئك الذين يتم تصويرهم: شعوب ممّزقة، أو أفراد تم سحقهم، أو أيتام لم يكن لديهم أي فرصة للتعبير عن أنفسهم.
في السبعينيات والثمانينيات، شكّلت القنوات التلفزيونية والتنظيمات السياسية أهم الجهات المنتجة لهذا النوع من الأفلام التي كانت أكثر بكثير من مجرّد تغطية للحرب. كان على صانعي الأفلام الوثائقية مثل مارون بغدادي وجوسلين صعب ورندة الشهّال صباّغ إنشاء لغة سينمائية جديدة للتعبير عن يأسهم. وقد عبّرت هذه الأفلام عن "النحن"، حتى حين تمّ إنتاجها للقنوات التلفزيونية الدولية: إذ تحدّث صنّاع الأفلام عن وطنهم وعن شعبهم. علاوة على ذلك، كان يُعتبر خيار بيع الأفلام للتلفزيون الأوروبي فرصة جيدة للعمل السياسي، فقد أفسحت وسائل الإعلام الغربية المجال لتجربة أنماط جديدة في إخبار الحقائق وخلق خطابات بديلة بطرق مبتكرة. كان هذا هو الهدف الواضح لجوسلين صعب، المخرجة الأكثر غزارة بين هذا الجيل، والتي بدأت بعد منع فيلمها الوثائقي القصير عن النساء الفلسطينيات في إنتاج أفلامها الخاصة بشكل مستقل. وبدأت صعب في بيع أفلامها الوثائقية إلى القنوات التلفزيونية الفرنسية والألمانية والسويدية وغيرها.

أضحت اليوم فكرة التحدث عن "النحن" أقل انتشارًا في السينما العربية السياسية المعاصرة. في سياق الحرب الأهلية السورية، يفضّل المخرجون الشباب شهادة شهود العيان، حيث تصبح الكاميرا امتدادًا لمخرج الفيلم الذي غالبًا ما يكون الشخصية الرئيسية لفيلمه. ترفض هذه الأفلام، التي يغلب عليها الطابع الشخصي، اتخاذ نظرة بعيدة عن الحرب. بدلاً من ذلك، تقترح شكلًا آخر من أشكال السينما السياسية بطريقة تكون أكثر جامعة، ولكن في الوقت نفسه أكثر إشكالية بتحديد موضوع سياسي أكثر شمولية وجماعية.
شاجبة لهذه النظرة البعيدة عن الحرب، غالبًا ما تميل قواعد صناعة هذه الأفلام إلى الفصل بين المخرج و/ أو مجموعة من الأفراد الذين تم تصويرهم من جهة وبقية الناس من جهة أخرى.
ويبدو أن الدافع نحو الانعكاسية الذاتية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتغيرات التكنولوجية الحديثة. ففي عصر شبكات التواصل، الأدلة المصوّرة موجودة دائماً بمجرد النقر على فأرة الحاسوب.
استجابة لتدفق الصور التي وثّقت أو تصدّت لتوثيق تطور الحرب، يبدو أن صانعي الأفلام قد تحوّلوا إلى الفضاء الخاص للفرد أو مجموعة من الأفراد باعتباره السبيل الوحيد الذي يمكن من خلاله إيجاد سرد حقيقي.
فجوة بين الأجيال
رفضت أفلام السبعينات الوثائقية التي صُوِّرت خلال الحرب الأهلية اللبنانية اعتبار الفيلم الوثائقي الكلاسيكي محايد أو موضوعي. وعلى ضوء صورة المدينة المنهارة، عرضت العديد من هذه الأفلام التعليق الصوتّي بصيغة المفرد، لإستحالة دمج شخصية المخرج بالكامل في المشهد المصوَّر.
الجمهور السوري والسينما التي تخصه: أولويات التمويل (2)
04 كانون الأول 2019
في بعض الحالات، يظهر المخرج في الفيلم كتجسيد للدراما الناجمة عن الحرب، مثلما فعلت جوسلين صعب من خلال الوقوف وسط أنقاض منزلها في "بيروت مدينتي" (١٩٨٢). ومع ذلك، فإن "الأنا" في هذه الحالة لا يزال "النحن": إنه لبنان وشعبه. تقوم رندة الشهال صباغ في "خطوة خطوة" (١٩٧٨) أو جوسلين صعب في "Lettre de Beyrouth" (رسالة من بيروت، ١٩٧٨) بتصوير جدران بيروت كما لو كانت المدينة تكتب شهادتها الخاصة.
في الحالة السورية المعاصرة، فإن الروايات الفردية، بغض النظر عن قوتّها، لا تدفعنا للتفكير في الوضع ككل، وبالتالي لا يمكننا التحدّث عن تعبئة. المنظور الشخصي لا يشجّع المشاهد على اتخاذ موقف ضد الواقع الذي يتم فيه شجب العنف. والخلفية السياسية عموما لا تظهر في الإطار العام. الأطر المختارة تروي حقائق معيّنة (القمع، العنف، المنفى)، لكنها لا تعطي مساحة كافية لبعد جماعي أوسع، وهو شرط مسبق لتشكيل الذاتية السياسية الجماعية، والدعوة إلى موقف سياسي محدد.
السينما والمنفى
من بين الأسئلة العديدة التي أثيرت بصيغة المفرد، يتكرر موضوع المنفى مرارًا وتكرارًا. ومع ذلك، فإن حقائق معيّنة تستبدل التساؤل العام حول حالة المنفى، كما فعل على سبيل المثال فيلم "Lettre d'un temps d'exil" (رسائل من زمن المنفى) للمخرج برهان علاوية (١٩٨٨)، وذلك بالحديث باسم "أنا" خيالي لكنّه يفتح على القضايا الجماعية.
في فيلم مسكون (٢٠١٣)، تركّز لواء يازجي على العلاقة بين أماكن العيش وأولئك الذين يشغلونها. من خلال تصوير سوريا من المنفى عبر صور من شاشة الكمبيوتر الخاص بها أثناء الاتصال بوالديها عن طريق السكايب، عبّرت لواء عن مرونة أولئك الذين قرروا البقاء. وغالبًا ما تكون المرونة في قلب هذه الأفلام، وتصوّر على أنّها فعل مقاومة. وكذلك الحال بالنسبة لياسر كساب الذي يروي في فيلم "على حافة الحياة"* (٢٠١٧) ألم منفاه في تركيا مع زوجته ريما، بينما قرر العديد من أفراد عائلته البقاء في سوريا.
إذ تسيطر الحاجة إلى استمرار التواصل. يروي ميلاد أمين من بيروت في "أرض المنشر"* (٢٠١٧) قصة صديقه غيث، الذي بقي في حلب أثناء الحصار. كلاهما نشطاء، علاقتهما هي في صميم القصة. يتواصل الرجلان عبر سكايب، وتصل الصور التي صوّرها غيث إلى بيروت على فترات متقطعة، فتبقى تحت رحمة وسائل الإتصال.
من المهم بالنسبة للذين غادروا أن يثبتوا أنهم لم يتخلوا عن أي من معتقداتهم. وبعض الأسئلة تبدو أساسية في هذه الأفلام. كم من الوقت سيستغرق الأمر قبل أن نستسلم للمنفى؟ إلى متى سنكون قادرين على مقاومة أعدائنا؟ هذه الأسئلة لا تملك إجابات واضحة.
تتّبع عروة المقداد في "٣٠٠ ميل"* (٢٠١٦) مجموعة من مقاتلي المقاومة في حلب لمدة عامين. يركّز الفيلم أكثر على التطّور النفسي للشخصيات، بدلاً من السياق التاريخي، ويشكّك مرارًا في معنى الثورة ونتائجها المحتملة.

يروي سامر سلامة في "١٩٤. نحنا، ولاد المخيم"* (٢٠١٧) انطلاقه للتدرّب مع جيش التحرير الفلسطيني في سوريا عشية الحرب. فيصّور نفسه، وهو يقصّ شعره الأشعث، ويعلن في تعليق صوتي: "ليس لدي أي خيار. [...] أترك كاميرتي، لتسجل منفردةً، بينما أقع أنا في بئر قصتي". ستعاود الظهور هذه الكاميرا مرارًا وتكرارًا كشخصية في الفيلم. وتشكّل قصة الفيلم، مرة أخرى، تأريخًا للحياة اليومية، في هذه الحالة داخل المجتمع الفلسطيني في سوريا. ويصبح التصوير إثباتا للوجود، وإظهار لتدمير الحياة الشخصية. يبدو أن هذا النهج ناجم عن رعب الحرب الذي تسحق كل شيء في طريقها، دون تمييز.
في "بلدنا الرهيب"* (٢٠١٤)، إخراج محمد علي الأتاسي وزياد حمصي، يدين المفكر والمعارض ياسين الحاج صالح الجدران الفاصلة بين المثقفين والمجتمع في سوريا البعثية.
تُستعرض هنا الدراما الكاملة للسينما السورية المعاصرة. إن قرار مخرجين مثل عروة المقداد، طلال ديركي، سعيد البطل.. باتباع المقاتلين في الجبهة يستجيب بوضوح لضرورة خلق تقارب بين الناس والأفكار. ومع ذلك، يبدو أن استحالة تعميم مواضيع هذه الأفلام يحتّم فشل لا مفر منه لكافة هذه الجهود. إن الالتزام المحدود والصارم بوجهة نظر فردية يجعل من الصعب وضع سردية أكثر شمولية وجماعية.
علاوة على ذلك، كيف يمكن لهذه الأفلام أن يتردد صداها في المجتمع الذي ينتمي إليه المخرجون، إذا لم تصلها؟
وهذا يمثل فرقاً ملحوظًا مع الأفلام التي تم صناعتها أثناء الحرب اللبنانية، والتي كانت تشتريها في كثير من الأحيان القنوات التلفزيونية الدولية، ويتم بثّها كجزء من برامج تلفزيونية شعبية جدًا، والتي قد شاهدها المغتربون اللبنانيون الذين يتذكرون هذه الأفلام حتى الآن.
الفن للفن؟
من المثير للاهتمام أن نلاحظ المدى الذي تتّبعه هذه الأفلام، التي أنتجت في سوريا منذ عام ٢٠١٢، في اتباع أنماط وديناميات متشابهة.
فقد تم إنتاج هذه الأفلام بفضل إنشاء مؤسسات جديدة مخصصة تحديداً لدعم صناعة الأفلام السورية في سياق الانتفاضة. من بينها، جمعية بدايات، وهي جمعية أسسها سوريون في بيروت عام ٢٠١٣ (بدعم من الصندوق الألماني هاينريش بول)، وهي واحدة من أكثر الجمعيات أهمية. تحدد بدايات أهدافها على موقع الجمعية:" تأمل بدايات في تسليط الضوء على تعقيدات وغنى الواقع السوسيولوجي للمنطقة، من خلال لغة سينمائية وثائقية، تسائل الواقع بقدر ما توثقه، وتنحاز للفن في مواجهة البروباغندا، وللناس في مواجهة الحكام، وللثورة في مواجهة العطالة (ستاتيسكو)[1].
يشمل هذا التصريح كافة الأفلام التي نناقشها هنا. وعند قراءته، نسأل أنفسنا: من هم "الأشخاص" الذين تصفهم هذه الأفلام، وما هي "الثورة" التي يصوّرونها، وإلى من يتوّجه هذا "الفن"؟

ويظهر جلياً هنا التباين مع الخلفية الثقافية والإيديولوجية للأفلام الوثائقية التي أنتجت خلال سبعينيات القرن الماضي في لبنان. في ذلك الوقت، كانت المقاومة موجودة في معظم الإنتاج الوثائقي. والقضية الرئيسية هي إعطاءُ صوتٍ لمن تم إنكار وجودهم، وخاصة الفلسطينيين.
يختفي المخرج وراء كاميرته لعرض زاوية واسعة على بؤس الشعوب الملتزمة. نبيهة لطفي، طالبة في كلية السينما في القاهرة، تم تعيينها في عام ١٩٧٤ من قبل منظمة التحرير الفلسطينية لإنتاج فيلم وثائقي عن النساء اللائي يدرّن مخيم اللاجئين في تل الزعتر. بعد العديد من الرحلات والعمل الوثيق مع زوجات وأمهات الذين ذهبوا الى الجبهة، وجدت المخرجة نفسها أمام المحنة التي أثارتها المجازر على أيدي الميليشيات المارونية. ومع ذلك، سرعان ما قررت أن تسلّط كاميرتها على الناجين وأطفالهم.
ويشكّل استخدام تقنية تثبيت اللقطات وسيلة لتعزيزهم كرموز للمقاومة، فيبدو كأنّ المخرجة قد أخذت خطوة إلى الوراء، لكي لا تفرض وجودها: إذ إنها تسعى فقط إلى إعادة سرد حقيقة مجردة حيث لا يمكن نقلها سوى من خلال كلمات الضحايا.
في السينما السوريّة بعد آذار ٢٠١١
27 كانون الثاني 2017
يوضّح التوّجه الأساسي لفيلم غياث أيوب وسعيد البطل "لسة عم تسجّل"* (٢٠١٨) هذه الديناميكية. في بداية الفيلم، يجتمع المخرجان ويطلبان من رفاقائهم المقاتلين في الجيش السوري الحر، التصوير في كل الأمكنة بمجرد أن يشعروا أن اللحظة يمكن أن تشكّل جوهر فيلم محتمل. يطرح الفيلم إذاً عملية صناعة الفيلم: يلعب سعيد على تقنية تثبيت الصورة. تصبح بذلك الصورة وسيلة لمناقشة مسألة إنتاج الفيلم بشكل كامل، بينما يكون وجود الكاميرا طاغي.
عبر ٤٥٠ ساعة من لقطات فيلم مدته ساعتان، ارتأى المخرجان أهمية طرح خطاب فوقي مهيمن حول بناء شهادة سينمائية، مشدّدان على جرأة أولئك الذين يقومون بذلك. هذا الموقف حيال "الفنان المقاوم" ليس جديدا. وعلى رغم أنّه لا جدال على شرعية هذه الصور والمصورين في قلب النزاع، لكّنه من الممكن مناقشة بناء الحوار السينمائي. فمن خلال فرض الذاتية الكاملة على موضوع الفيلم، يخاطر صناع الأفلام بالوقوف وحدهم أمام العالم، غير قادرين عن إعلان أنفسهم كممثلين لأي شخص.

ولا يهدف هؤلاء المخرجون إلى شرح سياق الواقع وخلفيته. ففي فيلم "استعراض الحرب" (The War show، ٢٠١٦)، تكرّر عبيدة زيتون طوال فيلمها أن "أكثر ما يخشاه النظام هو شخص لديه كاميرا". لذا يشكّل وجود الفيلم بحّد ذاته دليل على أهمية مقاومة حامل الكاميرا، حيث يسبق خطابه السياسي.
خلال الحرب الأهلية اللبنانية، لم يكن تأكيد الموقف السياسي مرتبطاً بالوجود على أرض الواقع والتصوير، بل في القدرة على إظهار حقيقة القتال بأسرع ما يمكن. كان التحدي هو تغيير النظرة العامة للصراع. لا يستثمر صناع الأفلام في سوريا أفلامهم لنفس المهمة. نظراً لتوقيت صدوره وتوزيعه المحدود، يهدف الفيلم بدلاً من ذلك إلى إنتاج وقائع خاصة بالجوانب الشخصية وزوايا الحرب.
إلى من تتوّجه تلك الأفلام؟
إن جمهور صناع الأفلام السوريين المعاصرين يختلف عن جمهور الأفلام الموزّعة على القنوات الرئيسية خلال السبعينيات[2].
والأهم من ذلك أنه لم يتم اختيار الصور أو تركيبها من أجل خطاب سياسي وفنّي موحد كما كان الحال في أفلام الحرب اللبنانية.
وتشكل المهرجانات السينمائية الدولية الكبرى، كمهرجان كان، والبندقية، وبرلين، وروتردام، ولوكارنو أماكن تقدير هذه الأفلام، وهي بمعظمها تتوّجه لنخب أوروبية واعية لأهميّة الإبداع الوثائقي، وتبحث عن طليعة فنية. ولكنّه لا يُتَوقّع أن يجلس المشاهد السوري العادي أمام شاشات السينما في العواصم الغربية.
السينما السورية الجديدة تزدهر اليوم، ولا يمكن إنكار قيمتها الفنية والوثائقية. بالإضافة إلى الإنتاجات الوثائقية، هناك عدد متزايد من الأفلام الخيالية التي تجد مكانها في الأسواق الدولية. في عام ٢٠١٨، مُنِحت جايا جيجي جائزة في مهرجان كان لفيلمها "قماشتي المفضلة" ("Mon tissu préféré") وحصلت سؤدد كعدان على جائزة في مهرجان البندقية لفيلمها "يوم أضعت ظلّي" (٢٠١٨).
لذا يبقى السؤال معلقاً حول متانة عملية إبداعية تجريبيّة قادرة على تجاوز الحدود التي رسمتها لنفسها، وحول قيمتها السياسية اليوم.
المراجع:
[1] https://bidayyat.org/ar/about.php#.XcXhtDJKjMI
* الأفلام التي تحمل علامة النجمة انتجتها بدايات للفنون السمعيّة والبصرية أو استفادت من منحة بدايات الوثائقية.
[2] تمّ عرض معظم الأفلام المذكورة على شاشات التلفزيون قبل جولتها في المهرجانات الدولية.