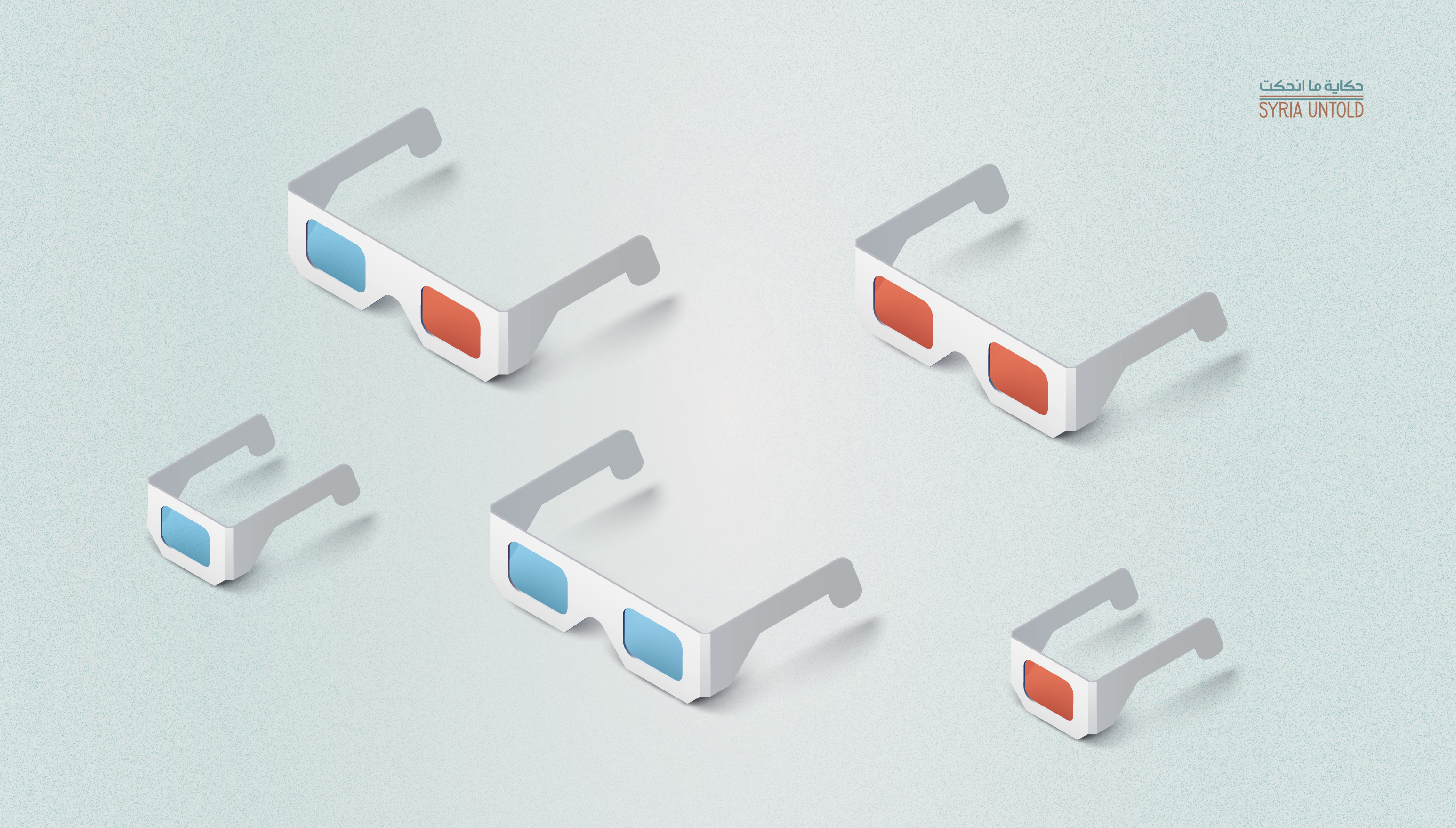(هذا المقال جزء من ملف بالشراكة بين حكاية ما انحكت وأوبن ديموكراسي، حول السينما السورية الصاعدة منذ عام ٢٠١١: السياسة، التحديات الانتاجية، الرقابات، الجمهور، وإلى آين قد تتجه الآن؟).
ينسق هذا المشروع مايا أبيض وإنريكو دي أنجيليس ووليد الحوري، بدعم من مؤسسة فريدريش إيبرت.
مقارنة بأية أعمال فنيّة سوريّة، قد تكون الأفلام الوثائقية أكثر الأعمال إثارة للجدل في السنوات الأخيرة، ليس فقط بين طرفي الصراع التقليديين من مؤيّدين للنظام السوري والمعارضين له، بل أيضاً ضمن صفوف معارضي النظام أنفسهم، ودائماً بالعلاقة مع أفلام أنتجت أصلاً من مخرجين ينتمون إلى صفوف معارضي النظام السوري. هذا الجدل المتجدّد حول بعض الأفلام الوثائقية السورية يطرح أسئلة عن انفراد هذا النوع الفنّي بالحصّة بالأكبر من الجدل، وعن ماهيّة متلقّي الفيلم الوثائقي السوري اليوم، بعد أكثر من ثمان سنوات على انتفاضة السوريّين.
السوريون والأوسكار
تزامناً مع ترشحّه لجائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي، أثار تسريب الوثائقي السوري "عن الآباء والأبناء" مطلع العام الجاري جدلأ في بعض الأوساط السورية. مخرج الفيلم طلال ديركي كان قد قدم إلى قرية في ريف مدينة إدلب السوريّة الخاضعة لسيطرة تنظيمات إسلامية مختلفة، وقضى وقتاً في منزل عائلة أبي أسامة المتبني لفكر السلفية الجهادية، منتحلاً شخصية مخرج متحمّس للفكر الجهادي، ليعود المخرج بعد ذلك وينجز فيلماً يدين أبي أسامة وأفكاره، بعد تصوير عائلته وأطفاله.
بعد تسريب الفيلم ومشاهدته من قبل عدد كبير من السوريّين، ربط جزء من الرأي العام السوري المعارض، بين ترشّح الفيلم للجائزة الشهيرة، وبين استغلال محتمل من صنّاع الفيلم لتطابق توجهه مع سياسة أولوية مكافحة الإرهاب المتبنّاة من قبل إدارات أمريكية مختلفة، الأمر الذي يعني في الحالة السورية أولوية محاربة جماعات متطرفّة محتملة في إدلب السورية، على حساب الضغط على النظام السوري لتحقيق تغيير سياسي في البلد المنكوب.
ما يهمّنا في حالة الجدل حول "عن الآباء والأبناء" ليس مدى وجاهة الآراء المؤيدة أو المعارضة لتوجّه الفيلم، وإنّما علاقة الجمهور السوري الإشكاليّة مع الأفلام الوثائقيّة السورية، سواء إن كانت الإشكالية على شكل علاقة غاضبة مع أفلام تمّ تسريبها، أو على شكل علاقة غائبة أصلاً مع المشاهد السوري، كما في حالة الطيف الأكبر من الأفلام السوريّة.
مركزيّة أوروبيّة
على الرغم من الشهرة الواسعة والنجاح التجاري الذي حققته أفلام وثائقية سورية كثيرة عقب الثورة، إلا أنّ معضلة وصول الفيلم الوثائقي السوري إلى الجمهور السوري ليست مشكلة جديدة ناشئة، بل قديمة مرتبطة بالقمع السياسي الخانق من جهة، وبغياب منصّات العرض التي قد تعيد جزءاً من أموال منتجي الأفلام من جهة ثانية، مثل صالات السينما أو القنوات التلفزيونيّة التي من الممكن أن تشتري حقوق العرض التلفزيوني.
الجمهور السوري والسينما التي تخصه: قصة تغييب (1)
28 تشرين الثاني 2019
ضريبة الإنتاج الكبير
وبما أنّ مدى نجاح الفيلم الوثائقي يعتمد على طول دورة حياته بين المهرجانات والعروض الحصريّة، فإنّ الأفلام الأقل تمويلاً ونجاحاً بمعايير السوق هي الأكثر عرضة للوصول في النهاية إلى العرض المجّاني على الإنترنت، ذلك بعد أن تفقد فرصها في العرض في الصالات أو المحطات التلفزيونية، وفي الحالة السوريّة يعني ذلك أنّ الأفلام الأضعف إنتاجاً وتسويقاً هي الأكثر حظاً في الوصول إلى المشاهد السوري العادي عن طريق الأنترنت.
تقاليد الالتباس
إضافة لبنية سوق التوزيع بصورتها الحالية، يبدو أنّ العلاقة الإشكاليّة بين الجمهور السوري وأفلامه الوثائقية تتغذى أيضاً من حالة التصاق الفيلم الوثائقي السوري بصيغته الحالية بحياة السوريين، مقارنة بأية أعمال فنية أخرى كالأدب والسينما التخييلية التي تساعدها مساحة المتخيّل لخلق مسافة أمان مع الواقع، حيث تصوّر الأفلام الوثائقيّة حياة أفراد سوريّين من لحم ودم، وتنقل قصصهم على الشاشة ربّما دون كثير من التعديل، وفي الوقت ذاته يميل الفيلم الوثائقي بسبب بنية سوق الإنتاج والتوزيع الحالية للبعد الشديد عن المشاهد السوري.
هذه العلاقة الملتبسة ترفدها أيضاً تقاليد، أقترح تسميتها بـ"تقاليد الالتباس"، وهي مرتبطة بالخيارات الفنّية للمخرجين السوريين، أكثر منها ببنية السوق. تقاليد الالتباس هذه، يبدو أنّ بعض أشهر مخرجي الجيل الحالي من السينمائيّين السوريّين قد ورثوها من الراحل عمر أميرالاي، مخرج السينما الوثائقيّة السوريّة الأكثر شهرة.

أميرالاي الذي كانت أفلامه مسيّسة إلى درجة كبيرة، كان اعتمد في أحد أشهر أفلامه "طوفان في بلاد البعث" علاقة ملتبسة مع الأفراد السوريّين الذين صوّرهم، ذلك من خلال تصوير أفراد خائفين ومؤدلجين يكرّرون طوال الفيلم شعارات حزب البعث الحاكم في سوريا، ليعود المخرج ويصيغ هذه المشاهد خلال عملية المونتاج مع تعليقاته الشخصية النقدية على علاقة هؤلاء الأفراد بالسلطة وقمعها لهم. الأمر الذي يخلق علاقة ثلاثية الأطراف: السلطة، السوريون المقموعون، والمخرج النقدي الذي يكشف هذه العلاقة عبر تصوير هؤلاء السوريين أنفسهم كأصوات أيديولوجيّة، لا كأفراد لديهم حساسيات وسلوكيات مركّبة.
تحولات السينما السياسية السورية واللبنانية (3)
11 كانون الأول 2019
الأسلوب ذاته تقريباً كان قد تكرر مؤخراً مع فيلم "عن الآباء والأبناء" وبدرجات أقل مع أفلام مثل "طعم الإسمنت" و"العودة إلى حمص" حيث يفرض شرط التصوير المؤقت وغير الحميمي مع شخصيات الأفلام علاقة سطحية مع هذه الشخصيات، تردّد خلالها شعاراتها السياسية العامة كما في حالة الخطاب السلفي في "عن الآباء والأبناء" أو خطاب الثورة عند الراحل عبد الباسط الساروت في "العودة إلى حمص" أو خطاب التعاسة وانعدام الأمل في سلوك العمال السوريين في فيلم "طعم الإسمنت".
وسواء كانت علّة غياب الفيلم الوثائقي السوري عن جمهوره هي بنية السوق المستبعدة لهم، أو فلسفة بعض المخرجين في صناعة أفلام تتحايل على إرادة بعض الأفراد السوريّين، يبقى أنّ النتيجة هي علاقة شبه غائبة بين الجمهور السوري، سواء داخل سوريا أو خارجها، وبين الفيلم الوثائقي السوري. وهو غياب لا يبدو أنّ السنوات القادمة كفيلة بحلّه، في ظلّ اتساع الفجوة بين سوريا الداخل والخارج من جهة، وانخفاض أسهم القضيّة السوريّة في أسواق القضايا العالميّة من جهة ثانية.