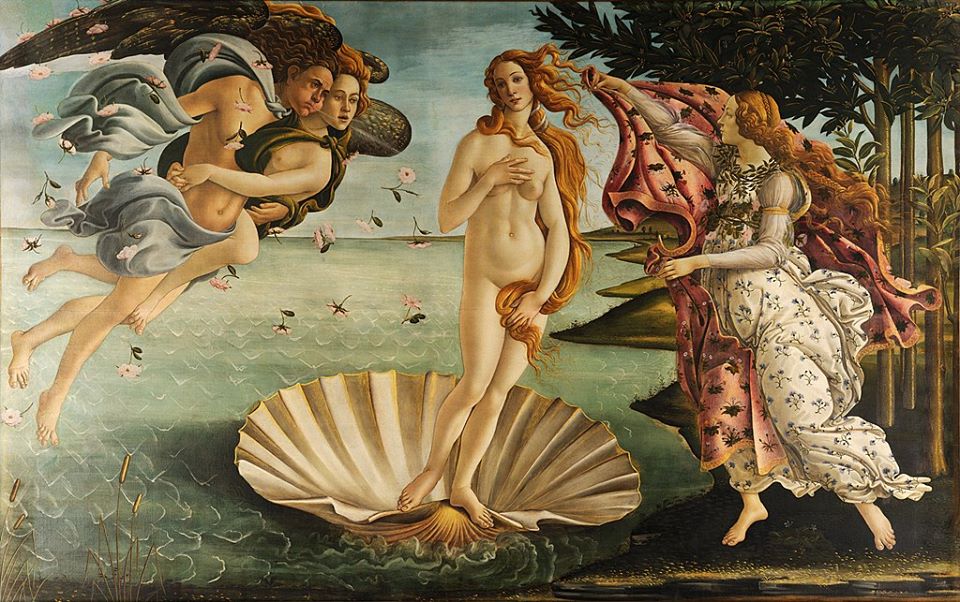(هذه المادة جزء من ملف حكاية ما انحكت "أصوات كويرية". بإداة وإشراف المحرّر الضيف، فادي صالح، وينشر هذا الملف بدعم من مؤسسة: Hannchen-Mehrzweck stiftung)
لم يكن أمراً مستهجناً في طفولتي أن أؤدّي تحية العلم لثلاثة أعلام، وليس لواحد كما هو متعارف عليه، في كل خميس وسبت في مدارس وكالة التشغيل والغوث للفلسطينيين في سوريا، الأول علم الأونروا والثاني علم فلسطين، أما الثالث فهو العلم السوري.
شرخ الإنتماء الأول!
في البداية ظننت أنّ هذا هو الحال مع الجميع، فأنت لاتدرك اختلافك إلا حين تقارن نفسك بالآخرين. ثم في درسٍ ما، وكنت لا أزال حينها تقريباً في السابعة من عمري، قالت لنا المعلمة في الصف أنّ هذا البلد إسمه سوريا، ونحن نعيش فيه، لكنّنا لسنا سوريين، نحن فلسطينيون واسم بلدنا فلسطين.
نحن ضيوف هنا! أذكر جيداً، أنّ ذلك أحزنني مع أنّي لم أفهمه، لكنني أذكر إحساسي بالحزن. أردتُ أن يكون هذا مكاني. فسألت أبي عندما عُدت للمنزل ما اسم هذا البلد، فقال "سوريا". قلت ومن نحن قال "فلسطينيون". فكرّرت السؤال وتكرّرت ذات الإجابة. وحين سألت: لماذا إذا كنّا فلسطينيين لا نكون في فلسطين؟ بدأت القصة. الشرخ الأول في مفهوم الانتماء والضربة الأولى في عالم الرمادي.
ليس الواقع بهذه البساطة بالنسبة للجميع، فهناك من لا يناسبه اسمه ولا يقتنع بدينه ويكون وطنه ليس إلا معتقلاً كبيراً يسعى دائما للهرب منه. فأنا لم أكن أمشي في شوارع وطني، بل كنت دائما أهرب فيها.
يحدثُ أن تولد في الوسط، لا تطال البياض ولا تكون من مع السواد، تراوح في برزخٍ بين الضفتين.
"أنا فلسطيني سوري، هويتي الأولى تتكون من أكثر من وطن". كنت أستخدم هذه الجملة في التعريف عن نفسي، وحين هاجرت أصبحت فلسطيني سوري يعيش في السويد! في الواقع كثيراً ما استخدمت كلمة سوري لوحدها متجنّباً الشرح المطوّل عن القصة، وربما هذا هو السبب وراء شغفي بفكره سوريا الكبرى، ربما هي حيلة مني لأحصل على انتماء لمكان واحد وأكون شخصاً كالغالبية دون قصة.
"هل أنت شب أم بنت؟"
مقدمة الملف: الكويرية والثورة: نحو أرشيف سوري بديل (الجزء الأول)
29 أيلول 2020
الانتماء تلك الكلمة الرحم، والتي تحدّد معظم السلوك الإنساني وتقف وراء الكثير من المواقف التي قد يتبناها الإنسان، والتي تؤثر على سير حياته. يولد الإنسان وقد اختاروا له اسمه ودينه ووطنه، ثم يُلقى به إلى الحياة وتبدأ المعركة. كل ما عليه هو النجاة مع الحفاظ على ما آُعطي له من أدوات، ويصرف عمره وهو يدافع عمّا فُرض عليه، وهو في الغالب لا يكون عارفاً بأنه قد يكون مدافعاً عمّا لا يريد. لكن ليس الواقع بهذه البساطة بالنسبة للجميع، فهناك من لا يناسبه اسمه ولا يقتنع بدينه ويكون وطنه ليس إلا معتقلاً كبيراً يسعى دائما للهرب منه. فأنا لم أكن أمشي في شوارع وطني، بل كنت دائما أهرب فيها. معظم الأحيان كنت أضطر لاستئجار سيارة تكسي لطريق يعدّ المشي فيه خياراً أفضل، صرفت في سبيل ذلك نصف دخلي الشهري من الوظيفة تقريباً، كي أتجنّب ما استطعت تحديق الآخرين بي وسؤالهم لي: "هل أنت شب أم بنت؟". كنت عابساً معظم الوقت كي أبعد عني الكلمات، جلفاً في المعاملة كي لا أتيح لأحد السؤال عن خصوصيتي. أما المعركة الحقيقية، فكانت في المراهقة حين كان المشي خياراً مفروضاً، فأنا كنت لا أزال طالباً وتكلفة التاكسي غير متوفرة. كنت أختار الطرق الفرعية للسير عوضاً عن المزدحمة المسلية لأمشي وحيداً دون تنمّر أو نظرات متطفلة. كل مشوار يحمل في جوفه عقوبة، فلماذا يحدث هذا إن كنت أنتمي لتلك الشوارع ومن سكانها؟
"هذه البلد ليست لنا"
مع تقدمي في العمر، اكتشفت أنني لست الوحيد في سوريا الذي لديه هذه المعضلة. والغريب في الأمر أنّ الجميع تقريباً كان لديه تشوّه ما في هذه النقطة على اختلاف الخلفيات والطوائف. حين قامت الثورة مثلاً، وفي حديث لي مع صديقة مسيحية عن الوطن قالت لي حرفياً "هذه البلد ليست لنا"، وهي جملة تكرّرت من سني ومن درزية (أعتذر عن ذكر أسماء الطوائف لكني أحاول أن أبيّن أن المشكلة هناك لم تكن يوماً طائفية). وجِد دائماً إحساسٌ مشترك عند الجميع أو لنقل لا شعور جمعي بالتهديد الدائم بالخطر. كان هذا الإحساس يزداد حيث الكثير من الخطوط الحمراء التي ليس عليك المساس بها.
هناك نوع آخر من الانتماء لا يكون فقط بتحية العلم والمسيرات الجماهيرية الغفيرة في الاحتفالات بالمناسبات الوطنية. هناك الانتماء للذات فأنت حين لا تنتمي لك لن تستطيع أن تنتمي للوطن.
من أنا؟ مثلاً، سؤالٌ طرحته كثيراً على نفسي. لماذا أنا لست كالبقية؟ لماذا لا أنتمي لهم؟ الانتماء... مرّة ثانية، الكلمة السر. وأنا هنا أتحدث عن نوع آخر من الانتماء (الانتماء للذات)، إذ أنّ مفهوم الهوية لا يكون فقط بالأرض وحدودها كما فرضت علينا دكتاتورياتنا الحاكمة، والتي جعلت الانتماء للوطن هو الأسمى، وفي كثير من الأحيان الأوحد، يُقاس به ولاء الشخص أو عدمه. من خلاله يعزّزون في داخلك التبعية، فأنت تحت مظلّة القطيع. الكل بقالب واحد وعقل واحد وأدوار محدّدة مسبقاً، ليس عليك أن تكون خارجها، وغير مسموح لك بالاختلاف عنها. كأن تكون مثلاً شاباً في جسد فتاه، تتصرف، تتكلم، تفكر، تلبس كرجل ولك وجه فتاة. إن ذلك يجعلك متميزاً وسط دائرة الأدوار المعروفة مسبقاً للذكر والأنثى. والقبول بك يعني القبول بفردانيتك، أنت لست من العوّام، وذلك ما يجعلك خطراً مباشراً على آلية سير القطيع والتحكّم به. لذا وجبت محاربتك، لا لذاتك، بل لأنك فرد مستقل. لما يشكله وجودك (بشكل طبيعي) في المجتمع كوجه من وجوه الحرية وتعدّد الهويات من خطر على شرخ القطيع وتشتته. هناك نوع آخر من الانتماء لا يكون فقط بتحية العلم والمسيرات الجماهيرية الغفيرة في الاحتفالات بالمناسبات الوطنية. هناك الانتماء للذات، فأنت حين لا تنتمي لك، لن تستطيع أن تنتمي للوطن. فالوطن لا يعني الأرض فقط. فكيف يمكنني أن أنتمي لمكان يفرض عليّ الخروج للاحتفال بمعجزات الحركة التصحيحية (وأنا أرى عرائش الخراب تتسلّق كل حائط) وأْمنع كشخص من مجتمع الميم - عين من الاحتفال بزواجي ممن أحب؟
استراتيجيات التمرد: قراءة كويرية في الثورة السورية
للهويه مفهوم أوسع، هي كعنقود العنب، متفرّعة وكل حبّة منها جانب أساسي لا يجب إلغاؤه. وهذا ما جعل الثورة السورية حلم يتحقّق للأقليات على اختلاف أنواعها. فالثورة في جوهرها هي انقلاب فكري ثقافي اجتماعي سياسي. أي أن يصبح الوطن للجميع.
الوطن لكل من يعيش به ويعمل من أجله، وذلك يعني الفردانية، أي أن يُقبل بك كفرد من النسيج دون التماهي به أو قطع أطراف من نفسك حتى تلائمه. والنضال من أجل ذلك، هو نضال في سبيل الوجود، فأنت حين تلبس ما يفرض عليك ليقبلوا بك، هم لا يقبلون بك بل يقبلون بقناعك والقناع عقيم ولا يصلح لأن تبنى الأوطان عليه. إن تحرّر الفرد أساس لتحرير الوطن.
"هي معركة كل واحد فينا مع حالو"
الثوره سُرقت وتقسّمت من الناحيه السياسية، وتمت المتاجرة بها وبقضية السوريين على كافة الأصعدة. لكن كان لها انعكاس داخل كل فرد سوري، فقد خرجنا عن الرتم وجربنا جمال النشاز. كل منّا خرق جدار الخوف بينه وبين ذاته. تمّ تكسير التابوهات وأصنام الخوف داخلنا. لازلت أذكر صراخ صديقتي بي وأنا أحدثها عن سرقة الثورة وفسادها وهي تقول "لا، هي ثورتنا كلنا، هي معركة كل واحد فينا مع حالو". وهذا حقيقي ليس المطلوب من الثورات الانتصار وليس من مهامها البناء، بل هي مخاض طويل يحدث دون تخطيط أو دراسة. لا تخضع للمعايير الثابتة المفروضة، والتي تحاول الأكثرية حشرها بها. مخاضٌ كل ما عليه هو أن يحدث، وقد حدث .
كنّا جميعا داخل خزانات مختلفة
هناك مفهوم متعارف عليه في مجتمع الميم – عين، يدعى "الخزانة". والخزانة هي أو حالة الخزانة، تعني السرية. أي أن تكون من مجتمع الميم - عين دون أن تعلن عن هويتك. تكون مختبئاً كمن يجلس في خزانة مجازياً، ولربما أرادوا منك أن تخلع حقيقتك وتخبئها لترتدي ما يناسب النمط المفروض عليك مجتمعياً وقانونياً. وكسوريين كنّا جميعا داخل خزانات مختلفة، لم نكن نعرف أنفسنا ولا نعرف بعضنا. اليوم خرج الجميع من خزاناتهم، ولا بد من الفوضى، فأنت تعيد خلق ذاتك من جديد وتخلق معها أسماءك، جسدك، هويتك، ووطنك.
"لا، هي ثورتنا كلنا، هي معركة كل واحد فينا مع حالو". وهذا حقيقي ليس من المطلوب من الثورات الانتصار وليس من مهامها البناء. بل هي مخاض طويل يحدث دون تخطيط أو دراسة. لا تخضع للمعايير الثابتة المفروضة، والتي يحاول الأكثرية حشرها بها. مخاضٌ كل ما عليه هو أن يحدث وقد حدث
انتهى الزمن الذي لم تكن تملك جسدك فيه ولا تعرفه، بل تحركه بما تمليه عليك القوانين والأعراف والمصلحة العامة. وانتهى الزمن الذي تدافع به عن وطن مسروق، تدرك في أعماقك أنك لا تملكه. اليوم أجسادنا لنا وهويتنا هي ما نحدده نحن، والوطن هو لنا، وهو ما يتسع لجميعنا، ونكون فيه أحراراً ومقبولين على اختلافاتنا.
لذاك اليوم الذي لا يضطر فيه طفل أن يمضي أيامه خائفاً يبحث عن ذاته ويخبّئ أسئلته وراء أقنعة يخترعها كما كنت أفعل، ولكي لا يضيّع طفل آخر ثلاثين سنة من عمره ليستطيع أن يقول أنا رجل دون أن يرتجف صوته ودون أن يكترث لخياله في المرآة، أكتب اليوم. وسأكتب دائماً إلى أن أحصل على وطني وأحيي فيه العلم بذات الإيمان الذي كنت أفعله وأنا طفل صغير قبل أن أعلم ما الذي يخفيه ظلّه.