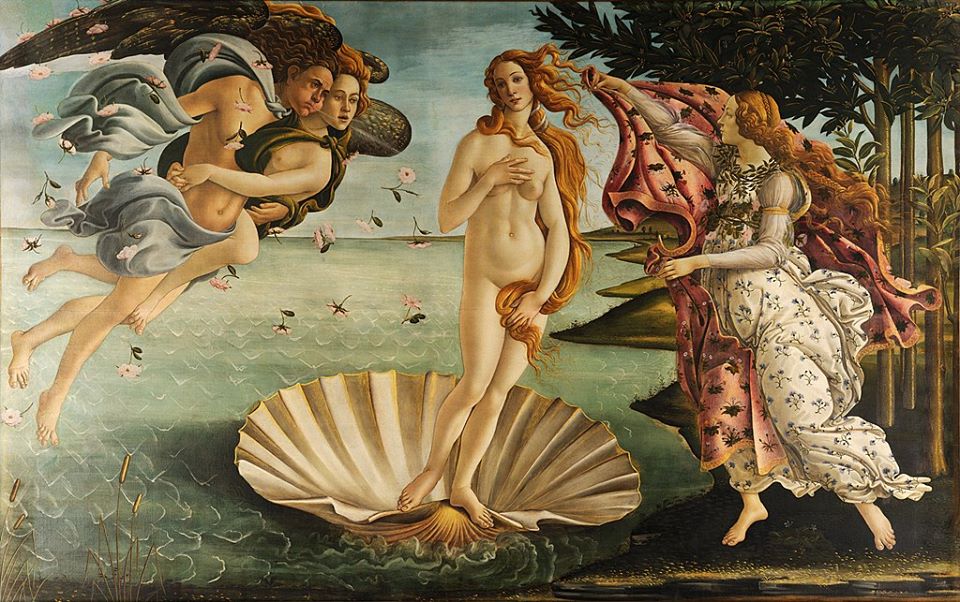(هذه المادة جزء من ملف حكاية ما انحكت "أصوات كويرية". بإداة وإشراف المحرّر الضيف، فادي صالح، وينشر هذا الملف بدعم من مؤسسة: Hannchen-Mehrzweck stiftung)
أتذكر:
في أواخر أشهر 2010، قبل بداية ثورة جميلة ومفجعة، كنت أصارع بعض الأمور: شَعري، البكالوريا السورية، والتصالح مع أنني كويري. شعري كان مُجعدا ومشعّثا، لم يناسب معايير الأناقة والرتابة لدى جدتي المُحبّة، فكانت تقول لي كلمات مثل "شو هالكباش هاد" أو "ليش متخانق مع الحلاق" ما جعلني أقتصر وأبقيه قصيراً. شعرتُ بكويريتي واختلافي لمدّة، وكي يخف التنّمر، أجبرت ذاتي على تعلّم بعض الأمور التي ستجعلني أبدو ك "رجل". أشياء بسيطة كطريقة مشيي ونبرة صوتي أو حتى اختياري لكلمات معينة. وما بين هذا وانجذابات مشوّشة، كان آنذاك التقبّل القليل الذي طورته لنفسي ثوريا.
لم أدرك آنذاك ما التسميات التي تناسبني، أنجذب للرجال بشدّة، ولكن أقع بحب الجميع. لم أشعر بأنني رجل ولا امرأة. كرهت أي شيء ذكوري بحت، ولم يكن عندي اهتمام بأي شيء أنثوي بحت. أحببت الرمادية بكل شيء. وبعد سنين من تنمّر وتعنيف من عدّة نواحي، كصراخ شباب الحارة "أجى الطنطة" في وجهي كلما احتجت المرور أمامهم، أو نشر إشاعات عني في المدرسة، أو حتى اعتراض عائلتي على الفروع التي رغبت دراستها لأنها أنثوية! اكتشفت أنني لن أستطيع تحقيق ذاتي في مدينتي. لم يكن لدي فرصة تقبّل نفسي، فأنا لم أجدها بعد. انطويت أكثر وأكثر، والتجأت لكتبي وقلمي وبعض الأصدقاء.
الغنج في دمشق!
مقدمة الملف: الكويرية والثورة: نحو أرشيف سوري بديل (الجزء الأول)
29 أيلول 2020
في يوم دمشقي خريفي، ركبت الحافلة للذهاب إلى درس الرياضيات وأنا مختبأ داخل سماعات رأسي. المقعد الخالي الوحيد داخل الحافلة كان بجانب شاب وسيم، يظهر أنه أكبر مني بسنوات قليلة. كان من الواضح اختلاف خلفياتنا، ومع أننا لم نُكلِّم بعضنا على متن الحافلة، كان هناك توتر جنسي بيننا لا يمكن نكرانه. نهضنا سوياً عند نفس المحطة، وبعدما بدأت المشي أوقفني الشاب الوسيم، والذي اكتشفت في تلك اللحظة أنّ اسمه الحقيقي وسيم، وطلب أن نتبادل الأرقام! هل هذا يحصل حقا أو أراد أن يفضحني؟ أعطيته رقمي الحقيقي واسم زائف وأنا في قمة التشوّش، ما بين إثارة وقلق. تكلّمنا هاتفياً لمدّة، وبعدما تطورت ثقتي به، التقيت به لمرات قليلة فقط بسبب قسوة البكالوريا، قبل أو بعد دروسي، وفي مناطق أعرف أني لن أصدف فيها أهلي. عقّدنا أيدينا في حدائق دمشق بالليل وسَرقنا قِبَلا مُكهربة في مصاعد بعض البنايات القريبة.
وبعد عدّة أشهر، دعاني وسيم لمنزله. عائلته سافرت وهو بقي في دمشق بسبب التزامات عمل. كذبت على أهلي بأنني أدرس مع أصدقائي وذهبت إلى منزل وسيم. لم أكن أعرفه جيداً، لكن شعرت بالأمان معه، فهو رغبني كلّي مع أنوثتي المتنمّرة، وأعطاني فرصة شعوري كذاتي، أعطاني مساحة استطعت من خلالها أن أتعرّف على جسدي ورغباتي من دون أقنعة. كل لمسة أخذتني لعالم آخر، عالم استطعت أن أوجد بحرية به.
كل قبلة حرّرتني بطرق لم أعرف وجودها من قبل. لمسات لحيته على وجهي الناعم كانت كالعودة لمنزل دافئ بعد سنين شاقة. توقف الوقت ذاك المساء ولم يكن لشيء، غير ملمس شفتاه على جسمي، أية أهمية: لا غرفته، ولا الرموز الدينية العديدة فيها، ولا حتى دمشق وكل قسوتها. كنّا أحرارا كما ولدتنا أمهاتنا، نتحدى معا كل المعاير المحلية. آذان المغرب نبّهني إلى أنني يجب أن أعود إلى منزلي. أوصلني وسيم إلى شارعين بعيداً عن منزلي كي لا يرانا أحد من أهلي أو الجيران. بقي التواصل مع وسيم لفترة، ثم جذبتني دراستي وجامعتي لاحقاً، وبعدها اشتد الوضع السياسي في البلد فتلاشى تواصلنا ببطء. لكن حافظت على ما وجدت في سرير وسيم من قوة وحرية.
الثورة وبداية الأمل
استراتيجيات التمرد: قراءة كويرية في الثورة السورية
أُفكِّر: لم أفهم مشاعري المتخبّطة عند اندلاع الثورة. تربيت على أنّ الأسد تابو لا يجب ولا يمكن التكلّم عنه إلا في المنزل. راقبت أهلي وأجدادي وهم يتداولون بهمس قصصا غير منتهية عن فظائع النظام. كاختفاء أحد من أعمامي منذ الثمانينيات بسبب كلمة قالها لبائع البطيخ عن حافظ الأسد. كنت أتطلع لهذا النوع من الحراك الشعبي بكل بساطة، لأن سورية تريد أن تكون حرّة وشعبها يستحق الحرية. كمية الطغيان والدكتاتورية كانت واضحة بشتى الطرق منذ طفولتي، وهي ما سبّبت خوفا كبيرا في بداية الثورة، خصوصا في دمشق. لم يكن أحد يعلم كيف سيكون الرد. ومع زيادة الغضب والحراك ومراقبتي اليومية للأخبار، اكتشفت أنّ تخبّطي في الحقيقة هو مزيج من الخوف والأمل، أمل بأن يوما ما، أستطيع الوجود على أرضي بكل حرية، كشخص سوري وكويري. ففي أول مظاهرة عفوية لي صرخنا "واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد". وما بين دموع وضحكات، خطر وسيم على بالي، وأردت أن ينمو سِحر ليلتنا في وطني.
قابلت الكثير من السوريين الكويريين في السنوات الأولى من الثورة من شتى الأطياف الجنسانية والجندرية. هذا غير أنّ معظم أصدقائي في المدارس تبيّن أنهم كويريين أيضا، صراعاتنا متشابهة ودوائرنا حميمية. خارج دوائرنا، نعود إلى عائلاتنا وديموغرافياتهم الدينية والطبقية. لم أكن أظن أن التقبّل للكويرية سيهطل على الشعب السوري بشكل مفاجئ بعد نجاح الثورة، ولكني آمنت بأن الدولة التي سنبنيها بعد الثورة ستحمينا وتحمي حرية الجميع، أي أننا سنستطيع على الأقل الوجود من غير أقنعة، وبالتالي سيبدأ النشاط المحلي، إن كان توعية أو وجود منظمات لدعم الكويريين، أو حتى ببساطة، إن حرية الصحافة والفن ستكون بداية جيدة ومساعدة لوضع الكويريين على الخريطة السورية. لكن، وللأسف، لم يكن الشعب السوري واحد واتخذت الثورة طابعا محافظا وذكوريا قبيحا.
لم أكن أظن أن التقبّل للكويرية سيهطل على الشعب السوري بشكل مفاجئ بعد نجاح الثورة، ولكني آمنت بأن الدولة التي سنبنيها بعد الثورة ستحمينا وتحمي حرية الجميع، أي أننا سنستطيع على الأقل الوجود من غير أقنعة
راقبت تحوّل إثارتنا لخوف، حيث أنّ محاولات تنظيم المظاهرات تحوّلت للبحث عن أصدقائنا في المعتقلات. وبعد سماع بعض من القصص عمّا يحدث هناك واجهت واقعية أنّ دخول طنط مثلي يعني الموت حتما. فابتعدت عن الشارع وحاولت أن أبقي نشاطي آمنا. لكن سرعان ما تحوّل أي نشاط إلى تعزية، ومحاولة تفادي القذائف، ومن ثم مساعدة بعضنا البعض بطلبات تأشيرات السفر والطرق الممكنة للهروب. خلال سنتين، تلاشى الأمل وحلّ محله غضب وشجن. وفي النهاية، وبعدما خَطَرْ بقائي وصل باب داري، استطعت بأعجوبة تأمين منفى يبعد آلاف الكيلومترات من جذوري.
آلام المنفى اليومية
تحت ظلّ ذاك العلم
لم أطلق على منفاي اسمه الحقيقي في البداية، لكن بعد صعوبات، وإدراكي القاسي بأنه لم يكن لدي أي خيار آخر، أحتفل اليوم بتواضع براحة عثوري على التعبير الملائم. فاتت عدّة سنوات منذ أن لزمنا منازلنا بدمشق خوفا من الآتي، وها أنا أجد نفسي في الحجر مرّة أخرى. أفكر ملياً بالسنين الطائرة وأتكلم مع أصدقائي السوريين. هم من اعتدت أن يكونوا على بعد اتصال من أركيلة سوياً، أصبحت علاقاتنا عبارة عن اتصالات هاتفية. فها نحن مبعثرون في شتى البلدان والقارات، صراعاتنا مجدّدا متشابهة: نواجه العنصرية والفقر والطبقية. وحدانية قاتلة، تعقيدات قانونية غير منتهية وسلوان أهالينا في الوطن. نجد راحة عند اعترافنا بهذه الآلام لبعضنا البعض، وفي معظم الأحيان لا نتكلم عنها خارج اتصالاتنا خجلاً مما يواجهه أحبائنا في الوطن يومياً.
أجد حنينا عميقا وشوقا معقدا عند كل سوري أتكلّم معه. أحيانا يكون الحنين لذكريات معينة، وأحيانا ببساطة لسماع كلمة "نعيما". حنيني شخصياً ليس لدمشق وياسمينها، أو لوسيم وغيره، شوقي هو لما كان أن يكون، ولشبابنا المسروق. أرغب برحلات إلى شواطئ وجبال سورية مع أصدقائي، أريد الوقوع في الحب بلغتي الأم، نتغازل بلكناتنا ونتضاجع على وقع أغاني اسمهان ووردة. أحلم بدمشق وشوارعها يوميا مع أنني مدرك أنها ليست المدينة التي عرفتها من قبل. أريد أن أرى خالاتي بالصدفة وأن أزور جدتي كلما رغبت. أريد لأشياء غير الصعوبات والمعاناة أن تجمعني بأحبائي السوريين. هناك خلل حقيقي بين موقع جسدي وعقلي في معظم الأيام، والحالة ذاتها عند معظم من أعرف.
استعادة الخسارات
سارة حجازي في سوريا
عبر السنين، تعلّمت ببطء استعادة ما خسرت. استعدت شعري، فهو الآن طويل، مجعد وشرقي للغاية. بنفس الوقت استعدت كل الأنوثة التي خسرتها بسبب التنمر، كإعادة استخدام تعابير "أنثوية" (ك يبعتلي حما، أو يؤبشني) ومفردات عديدة ك "طنط" لأفرغها من عنفها المجتمعي ولأحتفي بالأنوثة التي تحاول أن تقمعها. قدّست جسدي بإدراكي أنه ليس جسد رجل، ولمفاجأتي، اكتشفت أن استعادة أنوثتي ساعدتني على أن أستعيد بعض الصفات الذكورية التي هي بالفعل كانت لي، لكن لطالما ظننت أنها أقنعة حماية. ومن خلال كل هذا، استعدت جندري بعدما وجدته غير ما عُيِّنَ لي عند الولادة. أنا قليلٌ من كل جندر وغير جندري بنفس الوقت. أكحل عيناي وأحب أن أرتدي بناطيل ذكورية وقمصان أنثوية. لن أنسى سعادتي في أول مرّة اشتريت كنزة من محل خاص بالنساء. سألتني الموظفة عند الحساب "من السيدة المحظوظة؟" ضحكت وقلت "أنا". لم أجد اسم جندري بلغتي بعد، ولا تهمني التسمية للغاية. أنا أعرف أن جسدي لي وأنه لا ينتمي الى هذا المنفى.
أيضا، استعدت سوريتي، الهوية التي تسبّب معظم آلامي. بعد سنين عديدة من الأقنعة والهروب من الهوية التي لم أرى فيها مساحة لشخص مثلي، أنا الآن أخلق هذه المساحة لاستعادة ما سلب مني. أقرأ وأكتب باللغة العربية، أبقى مطلعاً على الفن والأعمال السورية وأُقضي ساعات في المطبخ أتعلم أطباق وحلويات سورية تعيدني لشفاه وسيم. أهم ما فعلتهُ هو تعلّم كيفية التخلص من كل سموم العنصرية والطبقية والطائفية والذكورية التي مازالت مزروعة في أرضنا كالتين والزيتون. لا زِلتُ أتعلّم، فهو عمل شاق ويومي وغير مريح أبدا. عشر سنوات بعد أول سرير لي مع الخليل الذي رآني كما أنا، وجدتُ واستعدتُ نفسي.
علاقة معقدة مع الأمل
الميم – عين في سوريا... وأصوات تكسر الصمت
03 تشرين الثاني 2020
عزائي السوري اليومي يتضمّن متابعة سوريين كويريين وتَقدُّميين آخرين. أقرأ كل ما ننشر، أتابع كل ما أستطيع من فن يُصنع، وأحاول أن أحافظ على معرفتي بمواقع وأحوال أصدقائي. آمل وأتخيل اليوم الذي سنعيد فيه أعمالنا السورية. أنا ببطء أستعيد وطني، عمل لن يتحقق بسياسة تجاهل المشكلة حتى النسيان أو التعايش. أستخدم عدة طرق، منها المحادثات الصعبة مع أفراد من العائلة والأصدقاء، كمحادثات عن طائفيتنا وطبقيتنا. بعض الأحيان عن طريق النشاط الثقافي والسياسي الرقمي أو إظهار أطيافنا الكويرية بشتى الطرق، وأحيانا ببساطة عن طريق التأكد من أن الرفاق الكويريين في سورية بخير على قدر استطاعتي. نحن الآن في كل مكان ولكن كُنّا يوماً ما في سورية، بكل ألواننا وأطيافنا. كثيراً من أمثالنا كانوا قبلنا والكثير بعدنا. سورية وطننا ونحن نستحق استعادته.
علاقتي بالأمل كمعظم السوريين معقدة، فنحن بحالة مستمرة نتوقع الأسوأ دائما. أقضي أيامي القاسية عندما يغلبني الشوق لدرجة عدم النهوض من سريري مشاهداً بعض الفيديوهات من المظاهرات المبكرة من الثورة. أرى ابتسامات وأمل على وجوه جميلة غالباً لا توجد معنا اليوم. أشاهد مقاومة مدن سورية عديدة. أتذكر تلك الأيام عندما تكون المظاهرة مليئة، أو "مكتدسة" وفق تعبيرنا السوري، وأصواتنا تصدح في أحيائنا البسيطة. الفيديوهات تدهشني وكأنها من زمن آخر لم أكن داخله يوما! أدرك بقسوة وبهجة أن أي ثورة بدأت بذاك الجمال ولاقت ما لاقت من قمع شنيع، لم ولن تموت. يوماً ما سأشارك عائلتي من الكويريين والطنطات النشاط والأمل. ومن غير خوف، سنستعيد ثورتنا أيضاً.