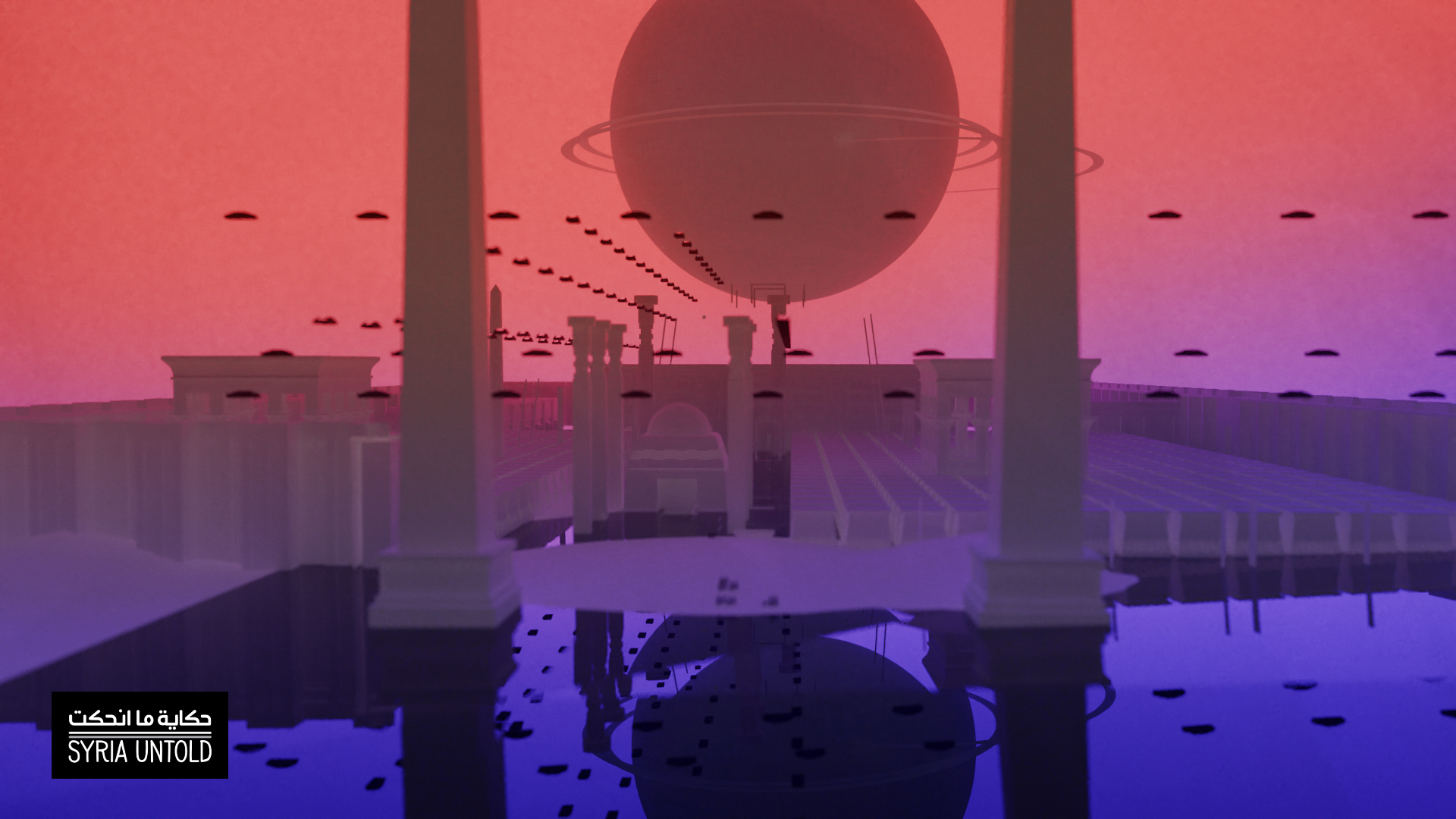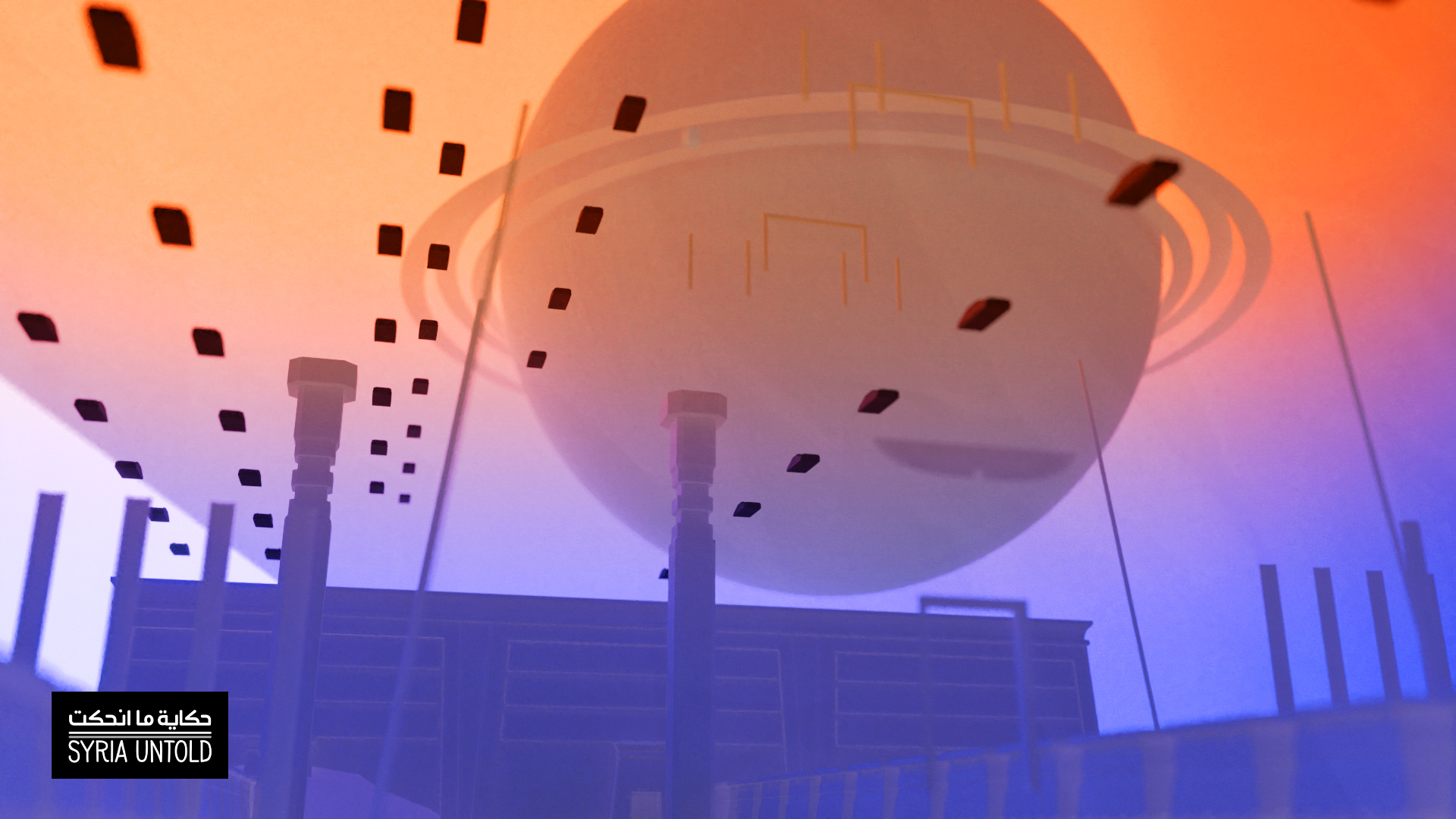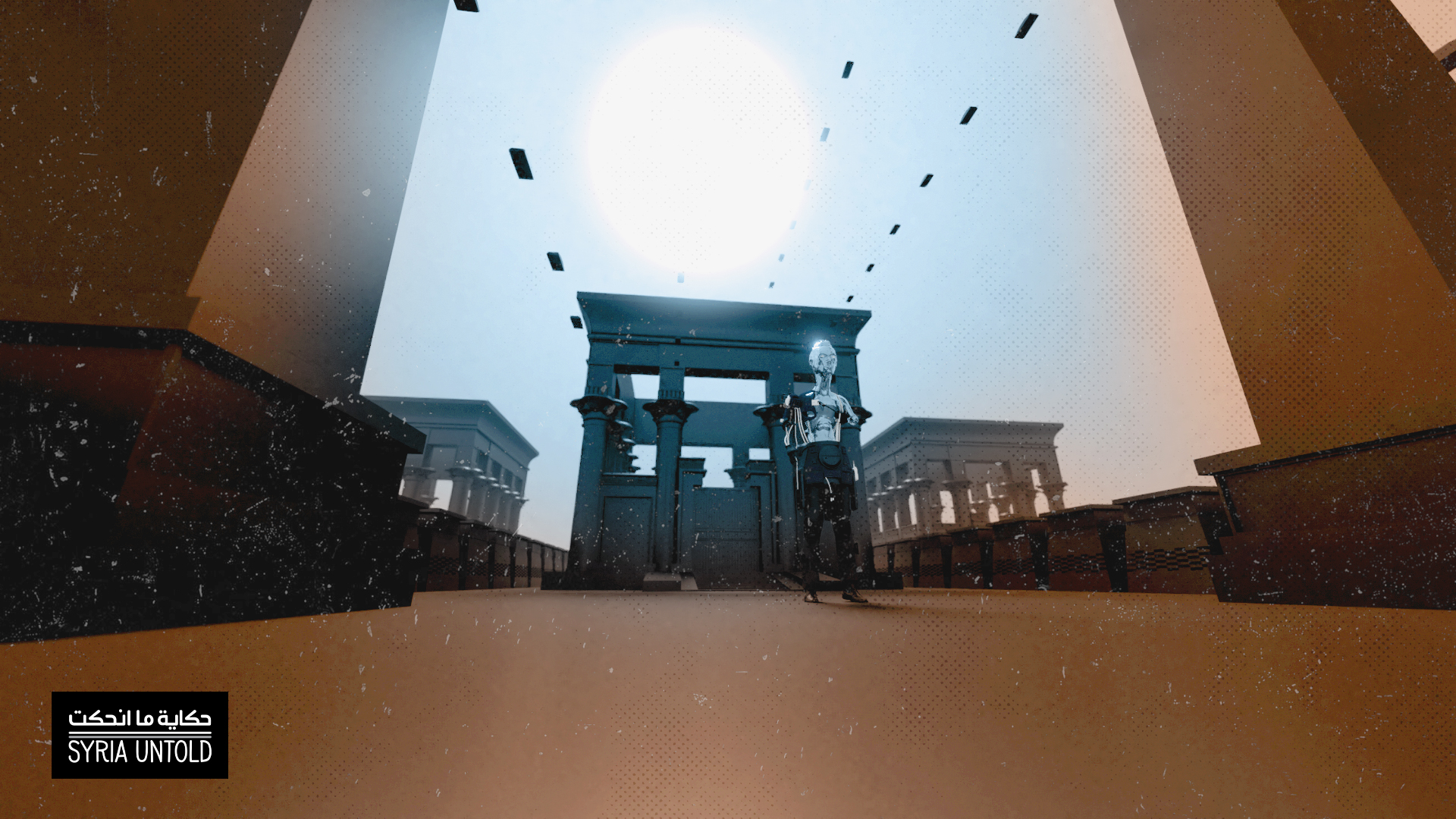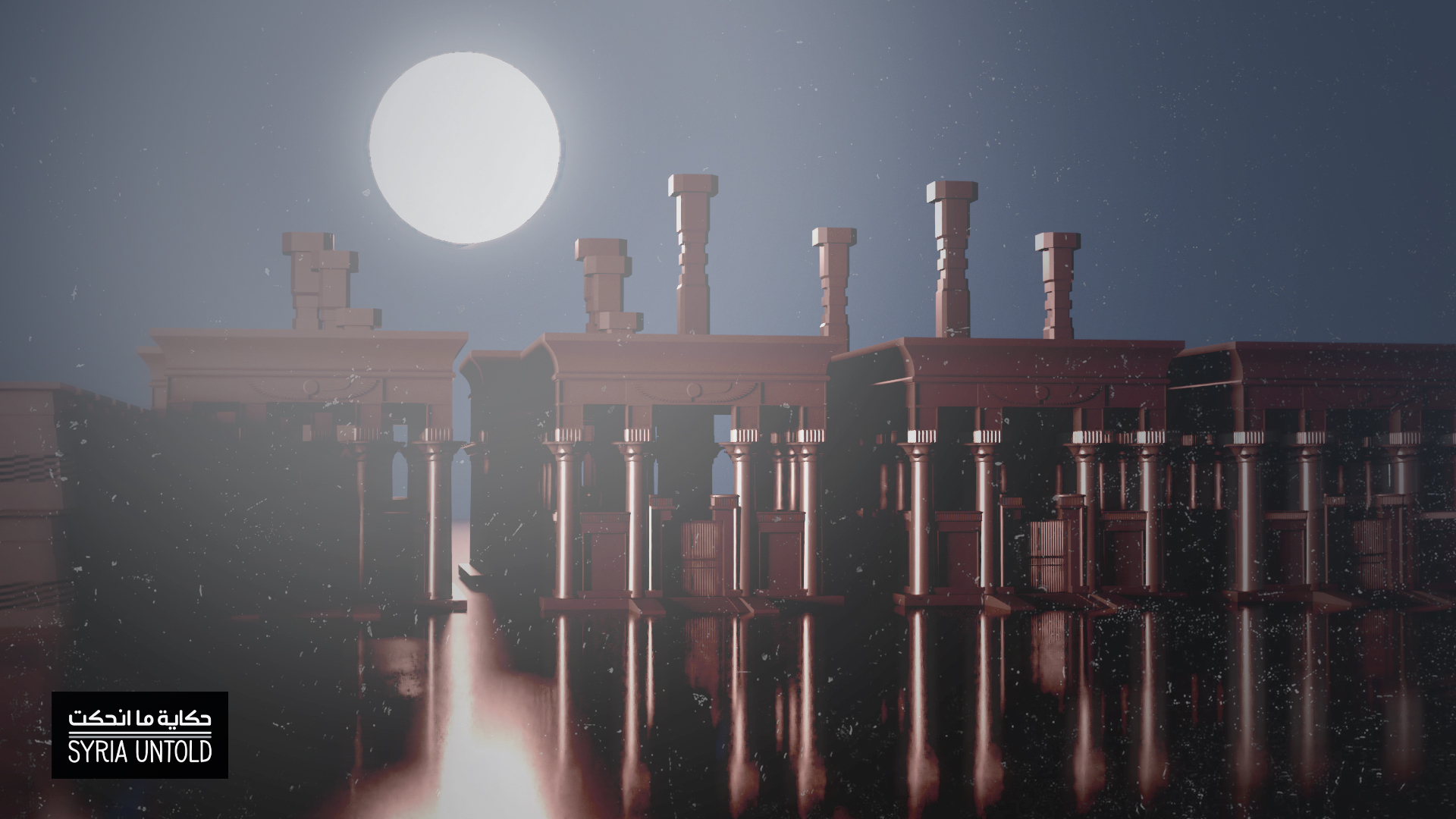المستقبل لا يمكن أن يُكتب، المستقبل يمكن فقط أن يُقرأ. هذا ما عرفه العرّافون والمُنجمون منذ قديم الأزل. فهُم فهموا أنّ المستقبل لم يُكتب بعد، وإنّما يختفي بين السطور، لذلك تعلّموا كيف يقرؤونه بين النجوم والأفلاك، وكيف يستطلعونه بين الأرقام والمصادفات.
المستقبل هو في الأساس مسألة قراءة لا كتابة، ولا يُمكن قراءته سوى هناك، حيث لم يُكتب بعد. لذا فإنّ الأدب لا يستطيع أن يكتب المستقبل حتى ولو حاول ذلك، كلّ ما يستطيع أن يفعله هو أن يمد القارئ بعمل أصيل قد يستطيع أن يلمح بين سطوره طيف الآتي، أو بالأحرى يستطيع أن يسمع إشارة إنذار تدق بين جنباته؛ إشارة إنذار تنتظر أن يضعها أحدٌ موضع العمل.
الأدب لا يمكنه أن يتخيّل المستقبل ولا أن يشتغل عليه، وإنّما يمكنه فحسب أن يسعى لعِتقه وجعله ممكنًا مرة أخرى بعد أن تمّ تجريفه وذلك عبر الاشتغال على الواقع بكلّ ما تحمله كلمة الواقع من معاني، فالواقع ليس هو العالم المادي المحسوس فحسب، ولا يقتصر على اللحظة الحاضرة أو الوضع السياسي الراهن، بل يضم في ثناياه عوالم كثيرة متراكبة ولحظات تاريخيّة متداخلة.
الواقع الذي يعمل عليه الأدب ليس مُعطىً ولا يوجد سلفًا، وإنّما يُخلق خلقًا عبر محاولات الاشتباك المُتعدّدة معه، لذلك فإنّ الأعمال الأدبيّة الحقيقيّة تنبع عن ضرورة ملحّة لتحريك الواقع حركة صغيرة على أمل أن يظهر بعدٌ جديد لم يكن أحد يراه، ولعلّ المستقبل يكمن في هذه الحركة الصغيرة.