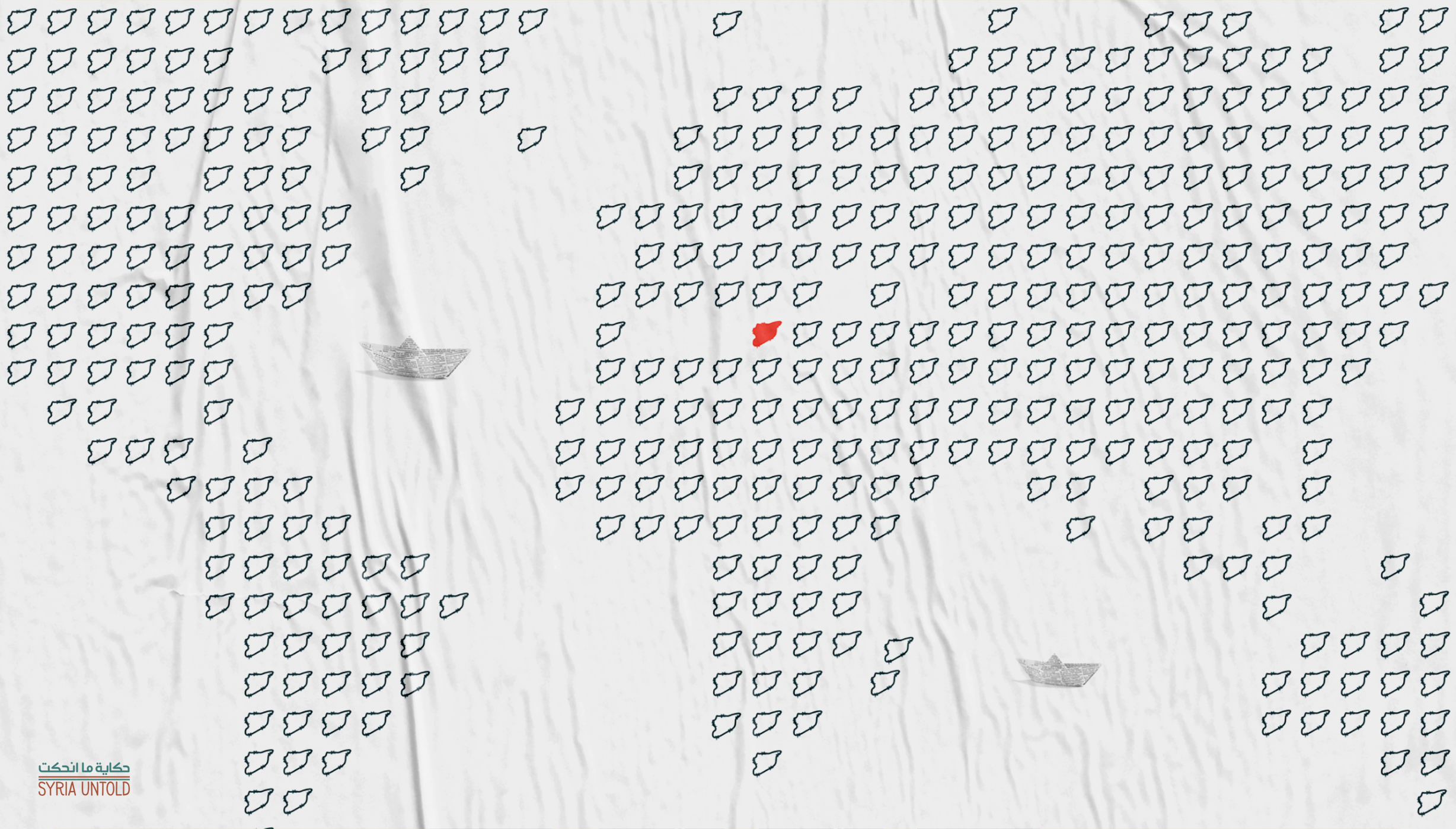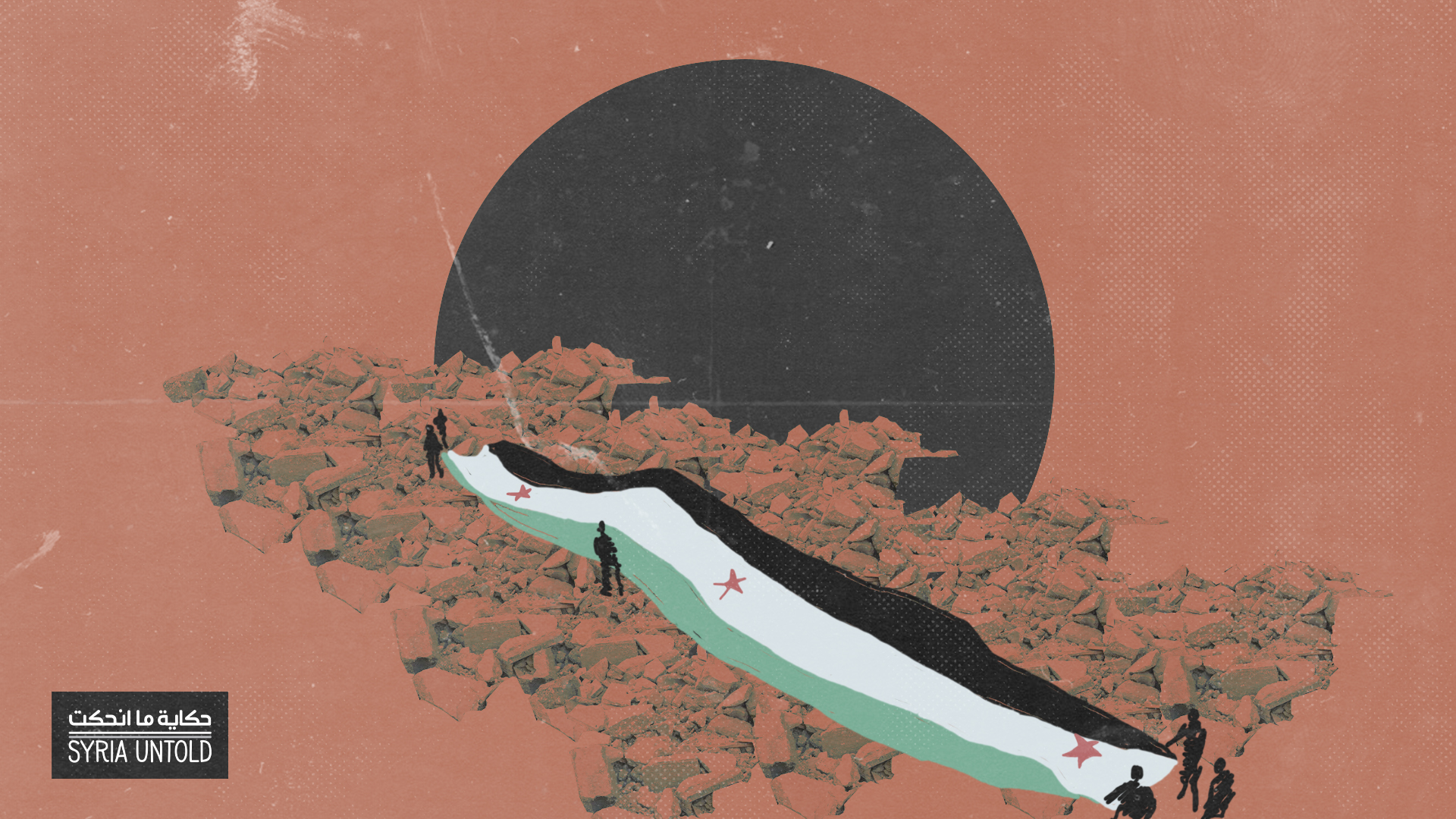نتعرف على الدنيا في نقائضها، فلا نختبر المفاهيم والأفكار إلّا بما يقابلها من نقيض أو مخالف. وعليه تلجأ الأنظمة والمجتمعات لتصوّر الضدّ لوجودها، يحاول دائمًا تهديدها -وإن فقط بالأفكار- في مواجهة لا نهائيّة. ما الذي يدفع للتشبّث بالتصورات والأفكار والايمان والمعتقدات وكافة التقاليد والعادات؟ ما سرّ ذاك الاحساس والشعور بتواجد دائم لما يهدد ويحاول النيل من كيان الناس في استهداف لا يكف عن المناورة بأشكاله وأساليبه، يحاول زحزحة الوعي والأحكام، وتحطيم أرضيّة بديهيات، هي ما تقوم عليه حياتهم؟
يُعرّف الشيء بضدّه، وهو ما قد يكون محيطًا ووسطًا يتمايز عنه. هي صفة انسانيّة تكمن في عدم الاستقرار، تلك الأسئلة التي تدور وتطال كل شيء، والبحث عن الاجابات يستهلك الكثير من مخزون الوعي في توالد يعزّز فرادة الإنسان ككائن متعالٍ بفكره عمّا حوله من وجود. حين يكون ذاك الانسان متماهيًا مع وسطه، سيكون كأيّ جماد، عبارة عن عنصر يكمّل كمًّا مجتمعيًا لا حياة فيه، سوى حركة تدور في مكانها. بالرغم ممّا يحويه من عادات وأفكار متوارثة، يتبعها بشكل آلي دون إعمال ايّ منطق، أو انزياح عنها.
الربيع العربي، العلمانيّة والإسلام (السياسي) والديمقراطيّة والمسألة الكرديّة
25 كانون الثاني 2022
يأتي أحدهم في وقت ما ويكسر التقليد والعادة، يختار طريقًا آخر للحياة وسط مجتمع سيُذهل من هول جرأته! يفكّر بمنحى مختلف، يتصوّر الأمور بمنظار يفترق عن محيطه. سيتم وصمه بخطيئة الابتعاد عن المتعارف عليه والسائد في المجتمع، وما يُعمَل به من فكر وعادة. ولأنّ طرحه غير مسبوق ولا يشبه ما اعتاد عليه الجميع، يكون الخوف ما ينتاب الذين حوله، لأنّه ينال من صورة حياتهم المكررة كبديهيّة لا يرقى إليها الشك. الخوف يستجمع الشعور باقتراب خطر محدق، لا يمكن في وقتها استيعاب آثاره الخفيّة على أيّ شخص قد يصيبه في كيانه، وأحيانًا بديهياته الحياتيّة. سيكون عندها الاحساس بالتخلّي والفقدان أحيانًا موازيًا لفقد الذات نفسها.
إنّ التمرّد هو جوهر الفكر في صراعاته مع القوالب الجاهزة والجمود، فالتغيير الدائم هو ناموس الحياة بمواجهة طوطم السائد من مفاهيم. ذاك التصادم بين رؤية التغيير على أنّه محرّك الحياة والارتقاء بها في كافة الأصعدة والاتجاهات، ومحاولة البقاء في الوضع الراهن كونه المعقل والبديهية، وهو الثبات المعفي من الفكر، ما هو إلّا جوهر مسيرة الحياة الإنسانيّة.
يبدو السكون في المجتمع المُمعن في تمسكه بعاداته، كصفحة مياه راكدة. وحين ينتاب أفرادها بوادر التغيير تبدو كمن ألقى فيها حجرًا محدثًا صخِبًا ورذاذًا عبثيًا يُنبئ بالفوضى التي لا يمكن تصوّرها، أو استيضاحها بسهولة. ثمّ تتحوّل إلى موجات تتوالد من المركز متجهة خارجًا بتناسق منطقي، تنتظم فيه لوحة متحرّكة تبدو كأنّها تضجّ بالحياة. يماثل هذا ما يفعله الذين قرّروا التميّز والتحرّر من قيود راسخة ومقيمة، تُملي عليهم ذاك النمط المتعارف عليه في أسلوب حياة مَن حولهم. ومهما يكن طرحهم هادئًا وعقلانيًّا، إلّا أنّه انزياح صريح عن المحيط الاجتماعي الذي سيصيبه الاضطراب لحدث جلل اخترق كيانه وأخلّ بمنظومة موروثة، ربّما تمّ ايجادها منذ أجيال غابرة.
الكاتب -غالبًا- هو المثقف الذي يسعى في كتاباته لعرض ذاك الخلل الكامن في الرتابة، وإضاءة جوانب كامنة تستدعي التناقض بين ما هو كائن، وذاك التطلّع إلى الحركة والتحرّر من أغلال قد لا تكون ضمن معايير الصواب والخطأ، لكن لا بدّ من ترقيتها لتناسب إنسانيّة في تبدّل مستمر.
يجري تعريف المثقف -أحيانًا- على أنّه ذاك المتمايز عن محيطه الاجتماعي بطرحه -نظريًا وعمليًا- ذاك التغيير الذي يبقي على حياة المجتمع في حركته المستمرّة لإيجاد سبل التفاهم بين الاختلافات الكامنة أفراده، وكشف إرادتهم الحرّة في اتخاذ أسلوب الحياة لكلّ منهم، والاعتراف بها. ضمن منظومة مبادئ جامعة قد تكون بهيئة قانون أو أخلاق ومفاهيم تكون معيارًا للتصرفات، ووضع آليات تغييرها وتصحيحها دائمًا لتلائم ما لا حصر لتنوعه من سلوك إنساني وبشري في تطوره الحضاري المتغيّر والمستمر. قد يكون التغيير هادئًا عبر مؤسسات قائمة وُجدت لهذا الغرض درءًا للتصادم، لكن البدايات لم تكن كذلك بالتأكيد.
الكاتب -غالبًا- هو المثقف الذي يسعى في كتاباته لعرض ذاك الخلل الكامن في الرتابة، وإضاءة جوانب كامنة تستدعي التناقض بين ما هو كائن، وذاك التطلّع إلى الحركة والتحرّر من أغلال قد لا تكون ضمن معايير الصواب والخطأ، لكن لا بدّ من ترقيتها لتناسب إنسانيّة في تبدّل مستمر. هذه الأفكار المختلفة عمّا حولها، أعملت الكثير من التغييرات في المجتمع، ونتجت عنها مفاهيم جديدة تؤصّل الإنسانيّة وتُعليها عن القيود الرازحة فيها. وإن كانت الطروحات مغلّفة بروايات حول أحداث تكون إسقاطًا لما يُركّز الفكرة لدى القارئ، أو تلك المحاكمات العقليّة التي تُلقي الضوء على تناقض المجتمع بأفراده، والسعي لصورة الارتقاء به إلى مسار التطوّر في كافة المجالات، والتي ستُشرع الأبواب للخروج من براثن الإنزواء.
استغلال العلمانيّة وتقوية النزعة المُحافظة
18 كانون الثاني 2022
للكتب الفضل الكبير في إسباغ الوعي على حياة المجتمعات، فهي تُنشئ الأرضيّة الصلبة للمفاهيم الإنسانيّة، والاتجاه نحو الأفضل في العلاقات وأساليب الحياة، والنهضة بالمجتمع الى التجدّد. في مسيرة التاريخ والحضارات، كان للكتب دور مهم في التحوّل، سواء بقراءة ما كُتب، أو تناقله. وليست الحضارة العربيّة، والأوروبيّة إلّا مثالًا عن انهماك الكتّاب برفض الانصياع والاستسلام للظلم المتلفّع بما كان عليه السابقون. لذلك كان الكتاب خطرًا على القوى السائدة، والتي تكرّس السكون وتحكم بالجمود ضدّ الحركة والتغيير ابتغاء بقاء مصالحها، والحفاظ على مكانتها. أُحرق الكثير من الكتب، والكتّاب أيضًا، جرّاء ما دعوا إليه من تنوير واختلاف، وما مثّلوه من تمايز. كانت تهم الزندقة والهرطقة جاهزة.
يكمن التمرّد في رفض ما يُحاصر الإنسان الذي يحاول التحرّر، وهي قيود المفاهيم الجامدة التي تحدّ من تحرّكه، وتحّدد تعامله وطبعه، وبالتالي تمسك بزمام حياته وتكوّن غمامة فوق رأسه، يحسبها أحيانًا ثقلًا ينوء تحتها بهيئة التزام بقيم اجتماعيّة ضروريّة للاستقرار. ذاك الاستقرار الهشّ، يُراد بموجبه تكريس صور مكرّرة للأفراد بسلوكهم وأفكارهم وولاءاتهم. لا ألوان فيها أو اختلاف، وعلى نسق لا يخرج عن خطوط حمراء مرسومة لا يُسمح بتجاوزها، حيث ينعدم الخيار الذي يجسّد الإرادة.الك
يساير الكاتب المشاعر المتهافتة الى خضمّ الصراع، يستجمع العبثيّة الكامنة في التمرّد، محوّلًا تلك الحركات العفويّة الى منظومة فكريّة مفاهيميّة. لا فشل هنا وإنّما محاولات هي جوهر الفعل وخطوات واثقة تُمعن في الحياة.
لا نلبث أن نسمع صوت ارتطام حجرٍ في الماء ليملأ الفضاء بالرذاذ، ما أن تستقر هذه الدنيا على نمط ونسق واحد وتغرق في السكون.