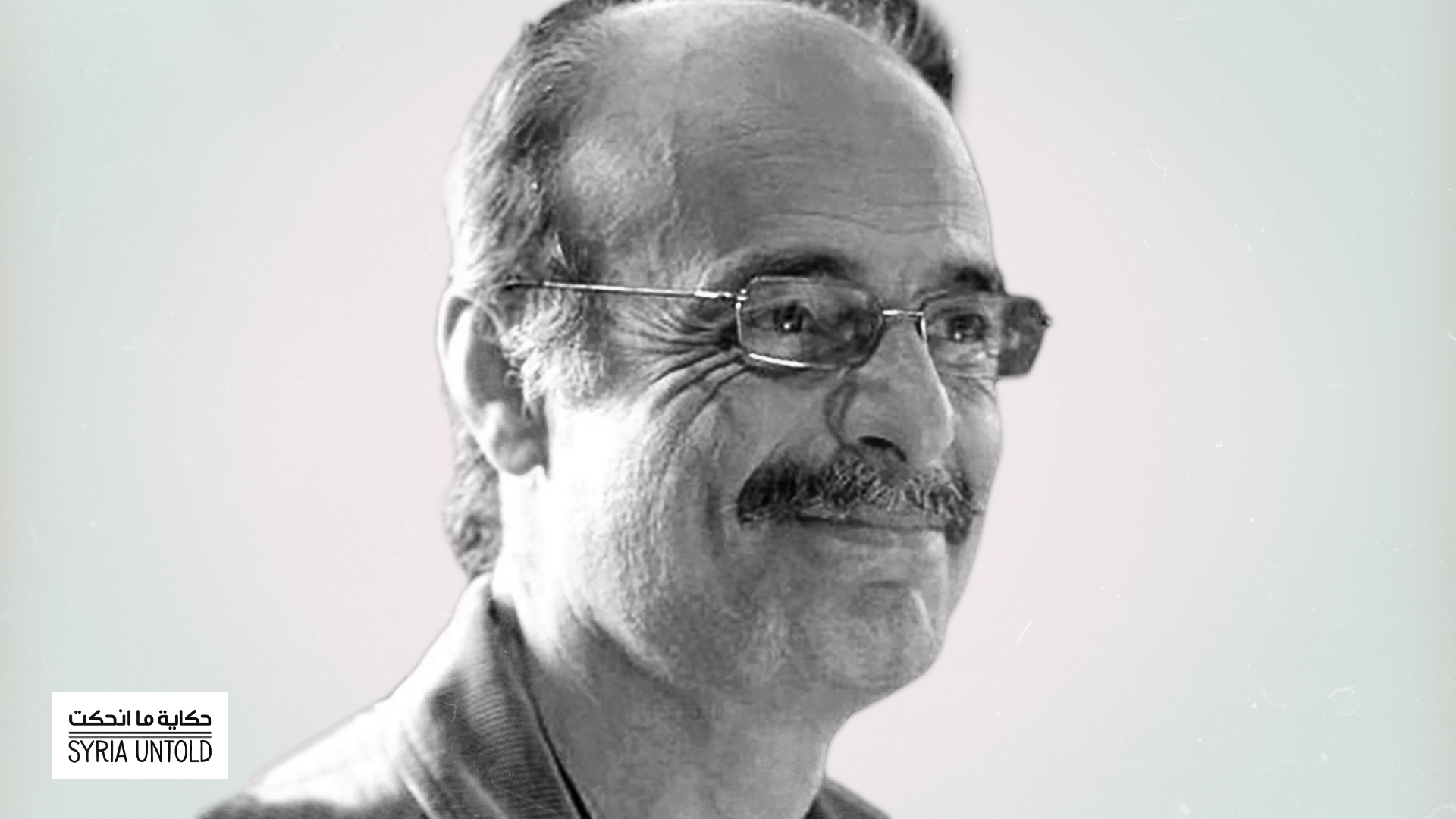هل يستحق فيلم واحد كلّ هذا البحث وكلّ تلك الأسئلة؟
الفن السينمائي هو فنّ مركّب يعتمد في بنيته على اجتماع عدد من التقنيات السمعيّة والبصريّة لإنتاجه، وبالتالي لا بدّ من توّخي الدقة في دراسة الأفلام السينمائيّة ذات الهدف الثقافي والفكري والبعيدة عن الترفيه وأساليبه. لذلك، ومن خلال هذا الحوار مع الممثلة الرائعة حلا عمران نتابع الحديث عن فيلم "صندوق الدنيا" لصانعه المخرج السوري، أسامة محمد، و الذي آُنتج من قبل المؤسسة العامة للسينما في سوريا في العام 2002.
كما ذكرت في الحوار السابق مع أمل عمران، إنّ فيلم "صندوق الدنيا" يشكّل وثيقة بصرية شديدة الأهمية، ويحمل في أسلوبه الفني عمقًا فريدًا، فكان لا بدّ من تشبيع حالة البحث حول هذا الفيلم وخصوصيّة صانعه. إنّ مشاركة الفنانين لكواليس تجاربهم الفنية كثيرًا ما تجيب على أسئلة نقديّة وفكريّة مرتبطة بالعمل الفني وبأسلوب صناعته.
الجزء الثاني من الحوار: الممثلة حلا عمران
حلا عمران فنانة مسرحيّة وممثلة ومغنية مقيمة في فرنسا. تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحيّة في دمشق في العام 1994، وواصلت تدريبها مع أوجينيو باربا، أريان منوشكين، ماتياس لانغوف.
لعبت أدوارًا مسرحيّة بارزة مثل دور "نينا" في مسرحيّة النورس لتشيخوف، ومثلت في مسرحيّة "عربة اسمها الرغبة" لتينيسي ويليامز، و"أندروماخ" في مسرحيّة أندروماخ لسوفوكليس، و"أوينون" في مسرحيّة راسين فيدري، و"السيدة كابوليت" في مسرحية شكسبير الشهيرة، روميو وجولييت، ولعبت دورًا دورا في مسرحيّة ألبرت كامو "العادل"، ولعبت دور "ألماسة" في مسرحيّة طقوس الاشارات والتحولات لـسعد الله ونوس، ودور "ميديا" في مسرحيّة "آي ميديا" لـسليمان البسام.
ذلك إلى جانب عملها مع مديري مسرح ومصمّمي رقصات مثل Cherif وباسكال رامبرت ومارسيل بوزونيت وديفيد بوبي ونولو فاكيني وسليمان البسام وج. كريستانوف سايس ومهدي ذهبي وأوليفييه ليتلييه وعلي شحرور، ومهدي جورج الحلو.
كذلك لعبت أدوارًا رائدة في أفلام مثل دورها في فيلم باب الشمس من إخراج يسري نصر الله (الاختيار الرسمي لمهرجان كان 2004)، وفي فيلم صندوق الدنيا (التضحيات) من إخراج أسامة محمد (اختيار رسمي لمهرجان كان 2002)، وفي فيلم "تحت السقف" للمخرج نضال الدبس.
كما تعاونت مع ملحنين وموسيقيين مثل منعم عدوان وعبد قبيسي وساري موسى وعلي حوت، وحازت على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان أيام قرطاج في العام 2021 عن أدائها في مسرحيّة آي-ميديا لسليمان البسام، وأيضًا على جائزة أفضل ممثلة فى مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر عن نفس الدور.
سعيد جدًا بإجراء هذا الحوار معك. لقد مضى وقت طويل على آخر لقاء بيننا. كما يسعدني أن أهنئك على العرض الجديد "آي-ميديا" من إخراج سليمان البسام، و على حصولك على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان أيام قرطاج المسرحية، ومهرجان القاهرة للمسرح التجريبي. أنتِ ممثلة مدهشة و تستحقين إضاءة المهرجانات على موهبتك الاستثنائيّة.
أود إعطاءك المساحة لتعريف القرّاء على حلا عمران، و ما الذي جاء بها إلى مهنة التمثيل، وشيئًا فشيئًا يمكن أن نمضي أبعد في حوارنا.
أنا من مواليد دمشق 1971، من عائلة قدمت من مدينة طرطوس في ستينات القرن الماضي مع موجة هجرة الناس من الأرياف والمدن الصغيرة إلى مدينة دمشق. والدي، محمد عمران، كان شاعرًا، وكان محرّرًا لمجلة المعرفة ولمجلة الموقف الأدبي، ثمّ أصبح رئيس تحرير ملحق الثورة الثقافي. ولدتُ لتلك العائلة القادمة من مدينة أخرى، ومن طائفة مختلفة (الطائفة العلويّة).
في ذلك الوقت لم يكن سائدًا ذلك المنطق الطائفي. في ذاكرتي لا وجود لذلك المنطق على الإطلاق، حتى أنّي كنت أظن نفسي مسيحيّة، وذلك لأنّنا كنّا نقيم في حيّ القصاع ذي الغالبيّة المسيحيّة. لقد ذهبت بدايةً إلى مدرسة خاصة، لكنني نُقلت بعدها إلى مدرسة حكوميّة. هناك يتم فصل الطلاب بحسب ديانتهم بسبب وجود مادة التربية الدينيّة. كلّ أصدقائي قالوا إنّهم مسيحيون، فقلت أنا أيضًا. كان أمرًا طبيعيًا بالنسبة لي، لكن المعلمة طلبت لقاء والدتي، و قالت لها إنّ عليها أن تشرح لي أنّه من غير الممكن أن يكون والدي اسمه محمد وأن يكون مسيحيًا ( تضحك)… كانت لحظة وعي بكلّ تلك الاختلافات الموجودة حولي. لم يؤثّر فيّ هذا الأمر كثيرًا، كنت أريد فقط البقاء مع أصدقائي. أعتقد أنّ حيّ القصاع الذي كبرت فيه أثّر على حياتي كثيرًا. كان حيًّا مختلطًا، الجيران في البناء الذي سكناه كانوا من كلّ الطوائف (مسيحيون، مسلمون، ويهود… إلخ). الطابع العام للحيّ كان مسيحيًا، لكن في السبعينات أذكر عددًا كبيرًا من العائلات اليهوديّة. أستطيع القول إنّني محظوظة لأنّني عشت طفولتي في ذلك التنوّع الطائفي والديني لأقليّات دينيّة قد تكون انقرضت من سوريا. اليهود كانوا يعيشون في حيّنا حياة اعتياديّة حتى التسعينيات؛ لحام يهودي، صيدلي يهودي، طبيب يهودي... إلخ. في التسعينيات بدؤوا بالاختفاء بشكل تدريجي من الحيّ.
بحكم عمل والدي في المجال الثقافي، جعل هذا من بيتنا ملتقى للمثقفين. كان بيتًا مفتوحًا على الدوام: فنانون وأدباء ومفكرون من كلّ أنحاء سوريا والوطن العربي. البيت كان مفتوحًا لأولئك الناس. كان بيت سهر وحفلات وغناء ورقص وشعر. كان هذا يوميًا حتى العام 1982. كانت تصل الأمور إلى درجة أنّه لا مكان لنا نحن الأولاد لننام، لأنّ هناك أحد ما نائم في غرفنا. كانت حياة تشبه كثيرًا حياة الأفلام، ضجيج و ألوان وصخب وضحك وصراخ ومشادات كلاميّة. كان لأمي صوتًا جميلًا يملأ السهرات غناءًا، قصائد جديدة تملأ فضاءك السمعي، ملحنون جاؤوا مع ألحانهم الجديدة، والكثير من الدخان. كان جوًا صاخبًا، وكان هناك بعض الممثلين الذين يزوروننا في المنزل. إلى جانب أنّ أهلي كانوا يأخذونا إلى المسرح لمتابعة عروض مسرح الأطفال والعرائس، إلى جانب عروض المسرح القومي التي كنّا نواظب على حضورها.
أمل عمران: "سوف أعلمكم التمثيل"
18 آذار 2022
لقد شاهدت عروض مسرحيّة شارك فيها كلّ من منى واصف وأسعد فضة، وعروض من إخراج فواز الساجر. كلّ ذلك دفعني مذ كنت صغيرة إلى الشعور بأنّّني أرغب في أن أكون ممثلة. لم أمثّل في حياتي ولم أقف على الخشبة قط. كنت خجولة جدًا في التعبير عن نفسي. ما أذكره أنّ تلك الجملة كانت في رأسي طوال الوقت "أرغب أن أكون ممثلة". في المدرسة كانوا يقيمون حفلات سنويّة ويقدّمون عروضًا سخيفة، لكني أذكر جيدًا خجلي وأبتعادي عن كلّ ذلك. في الصف التاسع على ما أذكر، قرّروا أن يقدّموا لنا في المدرسة ورشة عمل في التمثيل، جاء حينها الممثلان "حسام عيد" و"زياد سعد" (إن لم أكن مخطئة) لإعطائنا تلك الورشة. أذكر أنّي ذهبت مرّة أو مرّتين، في الحقيقة لا أذكر جيدًا. تلك الفترة غائمة في ذاكرتي، وتذكرت ذلك التفصيل فقط الآن.
في المقابل في المنزل، كنتُ صاحبة الأجواء الخاصة، وجمهوري هو أبي وأمي. كنت أضع في المسجل شريط موسيقى أذربيجانيّة وأرتدي أشياءً غريبة. كنتُ أنسّق إضاءة الصالون قبل أن أبدأ الرقص. ما أعنيه أنّ التمثيل لم يكن أمرًا أمارسه، بل كان في مخيلتي لكنّني لم أقترب منه. كنتُ أمارس الرقص، كنتُ أختار لأبي وأمي مكان جلوسهما ثم أقدّم رقصاتي التعبيريّة. كما أنّني كنتُ أكتب الشعر في بداية المراهقة.
دائمًا ما كنتُ أكتب قصائد حزينة مأساويّة، وكنت أبكي كثيرًا في غرفتي. أكتب الشعر وأبكي، دون أيّ سبب، وليس عندي أيّ فكرة لمَ كانت تنتابني تلك المشاعر. مرّة، تجرّأت وأطلعت والدي على أحد قصائدي، فوّبخني وقال: أنت فتاة في الثالثة عشر أو الرابعة عشر، لماذا تتحدثين عن الموت؟ وما علاقتك به؟ ما كلّ هذا الحزن؟ من أين جاء؟
كنت حينها أقرأ الشعر كثيرًا، شعر لوركا ورافاييل ألبيرتي، وشعر والدي وغيره. في تلك القصائد، كان هناك الكثير من مشاعر الحزن والألم. قرأت الكثير من الشعر الإسباني، ثم تلاشى ذلك بشكل نهائي. حصلت على البكالوريا وكنت مجتهدة في المدرسة، وكان قراري الواضح أنّي أريد التخصّص في الفن. تقدّمت للحصول على منحة وكانت في الرقص وتمّ قبولي للسفر إلى تشيكوسلوفاكيا. بدأت التحضير للسفر وسجلت أثناء تلك الفترة في الجامعة. وبحكم أنّي حصلتُ على مجموع عالٍ في البكالوريا، سجّلت في كلية الصيدلة. بدأت الدوام في كلية الصيدلة وأنهيت السنة الأولى في انتظار السفر لمباشرة المنحة. في نهاية تلك السنة قرّرت عدم السفر لأجل دراسة المسرح في المعهد العالي للفنون المسرحيّة في دمشق.
لو أنك سافرتي لدراسة الرقص، لربّما كنت ستصبحين أحد أساتذتي الذين علّموني في المعهد العالي للفنون المسرحيّة - قسم الرقص التعبيري.
(تضحك)، كان هذا ممكنًا، لكن للأسف لم أسافر. قلت لنفسي إنّني لست في حاجة إلى لسفر، فأنا أرغب في دراسة المسرح، و رغب في دخول المعهد العالي في دمشق، وهذا ما كان. تقدّمت إلى فحص القبول بعد أن أكدّ والدي أنه لن يتدخل في هذا الأمر حال عدم قبولي (أي أنّه لن يتوّسط لي لأُقبل). لكن تمّ قبولي للدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحيّة دون واسطة. في ذلك المكان، كانت أول تجارب التمثيل في حياتي. كنتُ قد قرأت الكثير من المسرحيات قبل دخولي المعهد من مكتبة والدي. أتحدّث هنا عن كلّ ما قد نشر ضمن سلسلة المسرح العربي المطبوعة في الكويت. عندما بدأت الدراسة في المعهد كنتُ في السنة الثانية في كلية الصيدلة.
آه، لقد درست حتى السنة الثانية في كلية الصيدلة؟
حتى السنة الرابعة. توقفت عن دراسة الصيدلة في السنة الرابعة. في السنة الثانية من المعهد قرّرت إتمام دراسة الصيدلة. لكني توقفت بعد إتمام السنة الثانية. ثمّ وبعد تخرّجي من المعهد، قرّرت مجددًا إتمام دراسة الصيدلة بسبب ضغط والديّ. أنهيت السنة الثالثة وبمعدل عالٍ، لكني توقفت مجددًا، وبعد قرابة أربع سنوات قرّرت العودة. أنهيت الفصل الأول وامتحاناته، ومن الفصل الثاني فقط امتحانات العملي، والمتبقي كان فقط الفحص النظري. جاءني سفر سخيف جدًا إلى تونس مع عرض للأطفال من إخراج عدنان سلوم. السفر كان في نفس وقت الفحص النظري لكلية الصيدلة. لم تكن المسرحيّة بتلك الأهميّة لتغيّر مسار حياتك من أجل التمثّيل فيها. لكني قرّرت الذهاب إلى تونس وعدم تقديم الفحص النظري. قرّرت أنّ المسرحية أهم من الامتحانات، وقرّرت التوقف نهائيًا عن إتمام دراستي في كلية الصيدلة.
لنتحدث عن التقدّم إلى المعهد. في حالتك أنت قريبة من تلك الأجواء. لنتحدث قليلًا عن ذلك المكان. من كان في دفعتك في المعهد؟
كنّا في دفعتي عندما بدأت الدراسة في المعهد ثلاثة عشر طالبًا وطالبة، تخرج منّا ستة فقط. الستة كانوا أنا ومحمد آل رشي ورمزي شقير وسمر كوكش ورولا ذبيان وهناء نصور. في أيامنا كان امتحان القبول هو امتحان واحد. لم يكن في زمننا تلك فكرة أن يقيموا ورشة عمل لعدّة أيام، يُقبل بعدها الطلاب الأفضل في تلك الورشة.
في أيامنا، كنّا نقدّم المطلوب منّا أمام لجنة كمونولوج مسرحي من مسرحيّة عربيّة أو عالميّة، ومشهد إيمائي، ويجب أن تقدّم أغنية أيضًا. إنّك تذكرني الآن بأشياء نسيتها فعلًا. وكان يجب أن نقدّم قصيدة شعريّة، ثمّ يقومون بطرح أسئلة على المتقدّم حول معرفته المسرحيّة والفنيّة.
كنت في حيرة، من أيّ نص يجب أن أختار المونولوج الذي يجب تقديمه. مسرحية "عرس الدم" للوركا الذي كنت أعشق شعره، أو أنطوان تشيخوف الذي أكنت أحبّه أيضًا. الغريب في الأمر أنّني لم أختر شيء من النصوص التراجيديّة، لم يخطر في بالي استخدام أيّ منولوج من أعمال وليم شكسبير، أو من المسرح الإغريقي. كان هذا فعلًا غريبًا بالنسبة لي، لأنّ حياتي المهنيّة بعد ذلك باتت أكثر في ذلك الحيز ( المسرح التراجيدي). تخيّل أنّني بعد تخرجي لم أعمل في عمل واحد من كتابة تشيخوف، أو في أي عمل واقعي. في النهاية اخترت تقديم شخصيّة "نينا" من مسرحيّة "النورس" لأنطوان تشيخوف. أتذكر أنّ اللجنة طلبت مني تقديم المونولوج مرّتين، مرّة مع حركة، وفي المرّة الثانية دون حركة. لا أزال أذكر مشاعري عند تقديم تلك الشخصيّة أمام اللجنة.
محمد الرومي: السينما دائمًا ضروريّة
07 كانون الثاني 2022
حتى هذا اليوم، عندما أعود لقراءة ذلك المونولوج تسيل دموعي. تلك الشخصيّة التي قدمت في فحص القبول كانت من أكثر الشخصيّات المسرحيّة التي أثرت في حياتي الشخصيّة. لا أدري لماذا، لكني أشعر أنّ شخصية "نينا" تشبهني بشكل من الأشكال. أو أنّي عشت شيئًا في حياتي مشابه لما عايشته تلك الشخصيّة المسرحيّة. هذا الإحساس راودني مذ قرأت النص أول مرة، وكان ذلك قبل التقدّم إلى المعهد. أذكر من أعضاء لجنة القبول "وليد قوتلي" و"جمال سليمان"، الذي صار أستاذي فيما بعد، و"نعمان جود" وأحد الخبراء الروس (المعلّمين الروس) و"مانويل جيجي" على ما أذكر. كان من أكثر الأمور صعوبة عليّ هو المشهد الإيمائي، كانت تلك الطريقة في الأداء غريبة عليّ، ولم أعرف كيف يمكن تنفيذ مثل تلك المشاهد. كان يراودني شعور بأنّني لا أملك الخيال الكافي (خيال صفر)، وقد بقي ذلك الاعتقاد مرافقًا لي لفترة طويلة من الزمن.
هل تعرفين لماذا كان لديك ذلك الاعتقاد؟
حقيقة لا فكرة لديّ لماذا كنتُ أشعر على هذا النحو، حتى أنّني لم أبحث في الأسباب التي دفعتني لذلك. اكتشفت لاحقًا أنّني أمتلك الخيال المطلوب للعمل (تضحك). أفكر الآن بهذا وأٌُرجع الأمر إلى فكرة الحريّة، كنت حرّة عندما كنت طفلة، والآن أشعر مع التقدّم في العمر أنّي أقترب أكثر إلى حريّة تلك الطفلة التي كنتها. أرى ذلك مهمًا جداً، وهذا ما يجعل إحساسي نحو مهنة التمثيل أجمل، لأنّها مساحة حرّة و فيها الكثير من اللعب. ذلك الإحساس باللعب في الحياة، وفي التمثيل، هو الغالب على مشاعري الآن. ذلك الإحساس بدأ ينمو أكثر فأكثر. عندما كنت في المعهد، كان عندي إشكاليات في بعض الأشياء، كالأداء الكوميدي على سبيل المثال.
إذا عُرض عليّ أيّ دور فيه كوميديا يبدأ قلبي بالخفقان بسرعة، فورًا يتبادر إلى ذهني عدم قدرتي على لعب ذلك النوع من الأدوار. كنت في تلك المرحلة جديّة أكثر من اللازم على ما يبدو. البكاء بالنسبة لي كان أمرًا يسيرًا (إذا بتطلع فيني ببكي فورًا). كان جمال سليمان يطلب مني التوّقف عن البكاء في العروض التي عمل معنا فيها. كان عندي مشكلة حقيقيّة في كلّ أنواع المسرح التي تتطلب أداءًا مبالغًا فيه أو أداءًا حركيًآ (كوميديا ديلارتي مثلًا) أو غيرها من تلك الأنواع الكوميديّة الهزليّة. كنت أشعر أنّني غير قادر على أداء ذلك النوع من الأداء الذي يتطلب الكثير من اللعب.
المرة الأولى التي فهمت فيها قيمة اللعب في التمثيل كانت في السنة الرابعة في مشروع الفصل الأول، والذي أخرجته مخرجة روسيّة زائرة في المعهد في ذلك الوقت. العرض كان مسرحيّة "النورس" لأنطوان تشيخوف، وللمصادفة البحتة، الدور الذي أسندته إليّ كان شخصيّة "نينا". الطريقة التي عملت بها معي على تنفيذ تلك الشخصيّة كانت مليئة باللعب. تحوّلت شخصية "نينا" إلى شخصيّة مضحكة. في كثير من المواقف في المسرحيّة تواجه "نينا" مواقف تراجيديّة، إلّا أنّها شخصيّة خفيفة، ومُضحكة. الطريقة التي أدارتني بها المخرجة غيّرت علاقتي وفهمي لفن التمثيل. هي من جعلني أفهم المعنى الحقيقي للّعب في المسرح. ظهرت تلك العلاقة مع اللعب كثيرًا خلال الخمسة عشر سنة الماضية، وتحديدًا على خشبة المسرح.
هل تذكرين اسم تلك المخرجة الروسية؟
اسمها تاتيانا آركيبتفسوفا (Tatiana Arkhibtsova).
لقد ذكرت سابقاً أنك رأيتِ الكثير من العروض المسرحيّة، لكن هل تذكرين أول فيلم سينمائي شاهدته؟
لا أذكر أول عرض سينمائي شاهدته. في الحقيقة لم يكن هناك الكثير من العروض السينمائيّة عندما كنت صغيرة. أذكر مهرجانات السينما التي كانت تقام، لكن ذلك جاء في مرحلة لاحقة. لكنّي أذكر جيدًا مهرجانات المسرح. بالنسبة لأهلي كانت السينما أمرًا مهمًا جدًا. لقد اكتسبوا تلك الثقافة في مرحلة الشباب. أمي تحديدًا كانت تعشق السينما. لقد كانت سينما الخمسينيات والستينيات، السينما الأمريكيّة والفرنسيّة إلى جانب السينما المصريّة، كانت جزءًا أساسيًا من ذاكرتهم و ثقافتهم.
في أي سنة انضممت للمعهد العالي للفنون المسرحيّة؟
في العام 1990
في تلك السنوات كان الوضع السياسي و لاقتصادي خاصًا في سوريا: نهاية الحرب الأهليّة في لبنان، وسيطرة النظام السوري على ذلك البلد، وبعدها حرب الخليج الأولى. كيف تصفين وعيك السياسي في تلك المرحلة؟
صفر ( تضحك). لم يكن لديّ وعي سياسي في تلك المرحلة. لم تكن لديّ أي علاقة بأيّ حزب سياسي، حتى أنّي لم أنتسب إلى حزب البعث العربي الاشتراكي رغم المحاولات الحثيثة من الأساتذة في المدرسة لتنسيبي إلى الحزب. رفضي الانضمام للحزب لم يكن موقفًا سياسيًا، كنتُ أشعر أنّني غير مهتمة بذلك الأمر.
هل كنت متأثرة بموقف والدك من ذلك الأمر، ربّما؟
والدي كان من البعثيين القدماء، المناضلين. تعرّض للاعتقال بسبب انتمائه للحزب في فترة الستينات قبل سيطرة الحزب على الحياة السياسيّة في سوريا. لقد كان رجلًا مناضلًا كمثل جميع أفراد العائلة كأخوالي وخالاتي، لكنّه انسحب في السبعينيات من الحزب. فقط للتوضيح، والدي لم يكن في حياته معارضًا، ولم آتي من عائلة معارضة على الإطلاق. فقط إنّ فكرة الانتماء لحزب سياسي لم تكن موجودة في عائلتنا. كما تعلم إنّ التعاطي السياسي محرمّ في بلد كسوريا، و قد يودي بك إلى المجهول.
أنا لم أسأل هذا السؤال مفترضًا أنك قادمة من عائلة معارضة. والدي فُصل من حزب البعث بسبب توّقفه عن حضور الاجتماعات الحزبيّة و دفع الاشتراكات، الغريب أنّه قُبل في كليّة الشرطة فيما بعد، وهو غير حزبي. كان والدي ذو توجهات يساريّة، وانتسب إلى الحزب في أواخر الستينات. كما تعلمين فإنّ مناطق حوران وريفي حماة و حمص كانوا الخزان البشري لحزب البعث. قريتنا "غصم" فيها قادة لحزب البعث، أحدهم "محمد طلب هلال" البعثي الشوفيني وعضو القيادة القطريّة الذي سجنه حافظ الأسد لمدة 27 عامًا، وخرج من المعتقل ليموت. والدي جاء من هذا الإحباط السياسي، لذلك كانت تعليماته لنا واضحة: عندما يبدؤون بتنسيب الطلاب في المدرسة إلى الحزب لا تتردّدوا في الانتساب، مبرّراته كانت أنّ عضويتك في هذا الحزب الشمولي العنصري لا يعني أنّك مؤمن بأفكاره وموافق على سلوكيّات قادته، الأمر مرتبط بمستقبلك في هذا البلد، فإذا ما أردت أن تحصل على وظيفة يجب أن تكون عضوًا في الحزب. كلّ ذلك مع وعينا التام بمعارضة والدي الفكريّة لحافظ الأسد الذي كان يطلق عليه لقب (أبو راسين) لحجم جمجمته. هذا ما كان عليه الوضع في سوريا، الكلّ متواطئ مع تلك السلطة، مع علمهم التام بفسادها. لكن تغيّر كلّ شيء بعد أن دخلت إلى المعهد، بتّ معرضاً لأفكار سياسيّة جديدة عليّ. كنت في زيارة لأحد الزميلات في بيت عائلتها في العام 2000 لأكتشف بعد مرور بعض الوقت على الزيارة أنّني كنت في اجتماع لأشبال ربيع دمشق. المعهد كان مكانًا مختلفًا عن كلّ ما عرفته سابقًا من الناحيّة الفكريّة السياسيّة.
طبعًا… طبعًا.
هالة العبدالله: معياري الوحيد هو الحريّة
05 أيار 2021
عدد الطلاب القليل في المعهد يخلق حالة حميميّة بين المتواجدين في ذلك المكان، فنحن هناك لم نكن نتبادل تلك المعارف الأكاديميّة والفنيّة فقط، بل هناك أيضًا تبادل لتجارب الحياة والتوّجهات الفكريّة والتأثر بحضور وشخصيّة بعض الأساتذة. سؤالي هو: كيف كان وعيك بذلك المكان وبالأشخاص الموجودين فيه؟ لا أعتقد أنّك كنت منبهرة بالحريّة الموجودة في المعهد العالي بحكم أنك قادمة من عائلة متحرّرة و مثقفة. ذكرت أمل عمران في الحوار الذي أجريناه سويّة، كيف أنّ طالبات المعهد كنّ يرتدين جوارب طويلة بيضاء مع تنانير سوداء، ذلك اللباس الموّحد الذي أحضره الخبراء الروس (المعلمين الروس).
ذلك صحيح، لكن هذا كان في أيامهم. تغيّرت الأمور خلال زمن دراستي في المعهد. لقد كنت في المعهد كعجينة مستعدة للتشكيل. وبطواعيّة مطلقة، ورغبة حقيقية (عملوني، زبطوني) وهبت نفسي حرفيًا، وهبت نفسي لهذه المهنة منذ تلك اللحظة. كان أكثر ما يهمني في ذلك المكان هو: "ما الذي أكتسبه و أتعلمه؟"، ذلك كان الشيء الأكثر أهمية في الحياة. لم يكن عندي انبهار بالأجواء في المعهد. صحيح أنّه كان فضاءً هائلًا من الحريّة، كواحة أو جزيرة. شيء متفرّد. أكثر ما أثر بي هي تلك العلاقة القريبة بين المتواجدين هناك والزمن الذي قضيناه سويّة، حيث تعيش مع زملائك وأساتذتك طوال الوقت. من الأشياء التي تغيّرت في شخصيتي بعد الدخول إلى المعهد، وبحسب والدتي التي تذكرني بذلك دائمًا، أنّني صرت استخدم ألفاظًا بذيئة في كلامي (تضحك).
تلك كانت من التغيّرات الأساسيّة، قول كلمات غير معتادة على قولها. سمعتها سابقًا، لكن كنتُ غير معتادة على قولها. صرت بعدها، أقول تلك الكلمات بشكل طبيعي. هذه واحدة من المتغيرّات المضحكة، المرتبطة بي اجتماعيًا وبالعلاقة مع عائلتي، لكن حدثت الكثير من المتغيرات العميقة على الصعيد الفكري والفني. واحدة من مشاهداتي التي لم أنسها قط، كانت في فحص القبول. كان ذلك في المعهد القديم في دمر، أنا من الدفعات الأولى التي بدأت الدراسة في مبنى المعهد الجديد في ساحة الأمويين. كنت أنتظر دوري للدخول على اللجنة عندما رأيت شابًا وشابة من طلاب المعهد القدماء يسلمان على بعض بشوق ظاهر وبحميميّة، لكن اللغة التي تخاطبا بها كانت شديدة البذاءة، الطريقة التي بتنا نستعملها في سلامنا على بعض لاحقًا (اشتقتلك يا حقير، كيفك يا كلب) (تضحك)، قلت لنفسي: يا إلهي، كنت منبهرة. كنت منبهرة أكثر شيء بمظهرهما وبطاقتهما الجميلة و الظاهرة، كان هذا ما رفع الأدرينالين في جسمي. كان بين سكان ذلك المكان طاقة مختلفة. كما تعلم أنّه في أيام مسابقة القبول إلى المعهد لا يوجد دوام للطلاب، لكنهم كانوا هناك. ذلك الأمر الذي بتنا نقوم به نحن لاحقًا، نذهب في أيام امتحانات القبول لنقوم بالتنظير على المتقدمين الجدّد ونسدي النصائح لهم كأساتذة مختصين. كان المكان و البشر في ذلك المكان جميلين في عينيّ. يشبهون أولئك الذين يظهرون في الأفلام و في صور المجلات. كنت سعيدة ولديّ شعور بأنّي محظوظة لأنّني سأصير جزءًا من هذا المكان. منذ تلك اللحظة شعرت أنّ كلّ ما أملكه في داخلي بات مِلكًا لهذه المهنة.
من هم الأساتذة الذين أشرفوا على دراستك لفن التمثيل في المعهد؟
كان الأستاذ المشرف علينا خلال السنوات الأربع هو الأستاذ "جمال سليمان". في السنة الثالثة عملنا مع الأستاذ "مانويل جيجي"، وفي السنة الرابعة عملنا مع المخرجة الروسيّة، تاتيانا آركيبتفسوفا، في مشروع الفصل الأول، ثم عملنا على مشروع التخرج النهائي مع الأستاذ جمال.
أي مسرحيّة قدمتم في مشروع التخرج الذي أخرجه و أشرف عليه الأستاذ جمال سليمان؟
كان عرض "خادم سيدين" لكارلو جولدوني.
تخرجتِ الآن من المعهد العالي للفنون المسرحيّة، هل لك أن تطلعيني على تجربتك بعد التخرّج، علاقتك المحترفة بالتلفزيون والمسرح و السينما، وصولًا إلى اختيارك للمشاركة في فيلم صندوق الدنيا مع أسامة محمد؟
كحال جميع الخريجين من المعهد العالي للفنون المسرحيّة، بعد التخرج تشعر بالمسؤوليّة التي كانت مقتصرة في أيام الدراسة على تنفيذ المهام المطلوبة منك. بعد التخرج تبدأ في مواجهة الواقع، أنت بحاجة لمباشرة العمل، وتحصيل عيشك من المهنة التي اخترت. بعد تخرجي مباشرة عملت في عمل تلفزيوني.
هل تذكرين ذلك العمل؟
قبل التخرّج عملت في دور صغير في مسلسل "أبو كامل" و كان دورًا لامرأة مجنونة وكان مشهدًا واحدًا. بعد التخرّج عملت في مسلسل من إخراج المخرج الأردني "محمد عزيزيّة"، و كانت حلقات المسلسل منفصلة، وكان دوري فيه أساسيًا، إلى جانب مجموعة من الممثلين مثل "رشيد عساف" و"عباس النوري"، لا أذكر بشكل جيد. أول مسلسل مترابط الحلقات كان مسلسل "نهارات الدفلي" من إخراج "محمد زاهر سليمان"، و قد صوّرناه في محافظة درعا، في قرية بصير. في نفس الوقت كنت أعمل في المسرح مع المسرح القومي، وفرقة المعهد. في تلك الفترة عملت في أكثر من عمل من إخراج الدكتور "رياض عصمت".
هذا أمر لا يعرفه الكثيرون. كان هناك فرقة مسرحيّة للمعهد العالي للفنون المسرحيّة؟
نعم.
لم تكن تلك الفرقة موجودة عندما درستْ في المعهد. كنتُ أطالب عندما كنت أدرس في المعهد بتأسيس فرقة رقص تابعة للمعهد العالي ولم يكن ذلك متاحًا.
عندما كنّا طلابًا لم تكن تلك الفرقة موجودة، تشكلت الفرقة عندما كنّا في السنة الأخيرة في منتصف التسعينات. وعلى ما يبدو أنّ تلك التجربة لم تستمر طويلًا. أنتجت تلك الفرقة عددًا من العروض لكن بعد ذلك لم أعد أسمع عنها شيئًا. عملت أيضًا في بعض الأعمال التي أنتجتها شركة الشام التي كان يديرها فنيًا حينذاك الممثل "أيمن زيدان"، وعملت في مسلسل "إخوة التراب" الجزء الأول، من إخراج "نجدت أنزور"، و باقي الأعمال كانت أعمالًا كوميديّة لم أتابعها ولم أرها حتى يومنا هذا. كنت أشعر بالتسلية في تلك الأعمال، لكني لم أشعر يومًا أنّه مكاني أو ما أرغب في تأديته. عملتُ في تلك الفترة في كم لا بأس به من الأعمال التلفزيونيّة. عملت مع المرحوم الأستاذ "علاء الدين كوكش" في عمل حلبي اسمه "حي المزار". استمر ذلك حتى العام 1998، بعد ذلك بدأت زياراتي لفرنسا تتزايد.
ما السبب الذي جعلك تسافرين إلى فرنسا؟
لقد ذهبت هناك من أجل ورشة عمل مع مخرج عملت معه لاحقًا في العام 2000. المخرج جاء إلى سوريا في العام 1998 بهدف البحث عن ممثلين لصناعة عرض "جلجامش"، والذي أنتج من قبل مهرجان أفينيون المسرحي. المخرج أراد أن يؤلف فريق العمل من ممثلين أمريكيين وفرنسيين وعرب. لتلك الغاية جاء إلى سوريا، واختارني للعمل معه إلى جانب "أمل عمران" و"محمد آل رشي" و"رمزي شقير" و"جمال شقير". أمل عمران كانت قد عملت مع نفس المخرج في ورشة عمل قبل عام من سفري إلى فرنسا. ثمّ اختارني مع محمد آل رشي للذهاب إلى مارسيليا للعمل معه في ورشة عمل ضمّت الممثلين الفرنسيين والأمريكيين الذين اختارهم لعرض "جلجامش". كانت ورشة عمل طويلة قمنا فيها بالكثير من التدريبات على الصوت والحركة والرقص. في العام 2000 كانت اللحظة التي اجتمع فيها كلّ الممثلين لتكوين عرض "جلجامش". قدمنا العرض في فرنسا، ثمّ بدأنا جولة فنيّة لتقديم العرض في بلدان أخرى. بعد تلك التجربة بتّ أقضي وقتًا أطول في فرنسا من الوقت الذي كنت أقضيه في سوريا.
في ربيع أو صيف العام 1998 وأثناء تصوير أحد الأعمال للمخرج "علاء الدين كوكش"، كانت الممثلة "يارا صبري"، والتي كانت تعمل معي في نفس العمل التلفزيوني عندي في المنزل، وقد أخبرتني أنّه لديها اختبار أداء في المؤسسة العامة للسينما لفيلم ؛أسامة محمد" الجديد. في ذلك الوقت لم أكن أعرف أسامة محمد شخصيًا. كنت أعرفه كفنان ومخرج، وكنت قد رأيته مرة واحدة خلال عرض فيلمه "نجوم النهار"، والذي رأيته خلال فعاليات مهرجان دمشق السينمائي، وأذكر جيدًا أنّني أحببتُ الفيلم كثيرًا. بيتي كان قريبًا من المؤسسة العامة للسينما، لذلك قلت ليارا إنّي سأرافقها إلى هناك. سألتني يارا: "ألم يخبرك أحد بموضوع اختبارات الأداء التي كان أسامة محمد يجريها؟"، فكان جوابي بالنفي، لم يخبرني أحد بذلك. يارا علقت: "كلّ ممثلات سوريا قد تقدّمن لاختبارات الأداء لهذا الفيلم". دخلت إلى المؤسسة مع يارا صبري، وأخبرت المسؤولين هناك برغبتي في عمل اختبار أداء لفيلم أسامة محمد. سألوني: هل اسمك موجود في القوائم؟ فكان جوابي بالنفي، لكني أصريّت على الدخول.
نضال الدبس:لماذا نحن دائماً وراء الكاميرا، بينما السلطة تقف أمامها؟ (17)
23 كانون الثاني 2021
هكذا، بالصدفة البحتة. وافقوا على تسجيل اسمي بعد سؤال أسامة، وأعطوني موعدًا للقيام باختبار الأداء. إنّ اختبار الأداء مع أسامة محمد هي تجربة بحدّ ذاتها، بكلّ لحظات صمته وتأمله وهدوءه ومحاولاته لاستفزازك. كانت الكاميرا تسجّل طوال الوقت كلّ ما يحدث. كان يقوم بتجارب على اللهجة والحركة. لا أذكر الكثير من التفاصيل، لكني أتذكر جيدًا أنّها كانت جلسة طويلة امتدت لما يقارب الساعتين. شعرت خلال الاختبار أنّ هناك تواصل وكيمياء نشأت بيني وبين أسامة في الطريقة التي كان يعطيني فيها الملاحظات، وفي الكيفيّة التي كان يدير بها الاختبار، وفي طريقة تفاعلي معه. كان ذلك في العام 1998. بعد انتهاء الاختبار لم أسمع شيئًا عن تحضيرات الفيلم.
في العام 2000 كنت في فرنسا مشغولة بجولات عرض "جلجامش" بعد الانتهاء من الجولة استأجرت بيتًا في باريس وقرّرت البقاء في فرنسا. تلقيت اتصالًا من أسامة محمد الذي قال لي إنّه قادم إلى فرنسا، وإنّه يرغب في مقابلتي في مقر شركة الإنتاج الفرنسيّة التي ساهمت في إنتاج فيلمه "صندوق الدنيا". قابلته في المكتب ليعطيني حينها نص الفيلم. في اختبارات الأداء لم يكن لدينا أيّ فكرة عن السيناريو أو عن الأدوار التي سنلعبها في الفيلم. حتى بعد توزيع أسامة لنص الفيلم على الممثلين، لم يكن لدى الممثلين الشباب أيّ فكرة عن الأدوار التي سوف يؤدونها في الفيلم، وذلك خلق إشكاليّة لديهم.
أخذت السيناريو بعد حديث قصير حول الشخصيّة التي لعبتْ في الفيلم. كان ذلك في نهاية العام 2000 وبداية العام 2001. كنت شديدة السعادة لأنّني كنت راغبة، وبشدّة، بأن أحظى بتجربتي السينمائيّة الأولى. كان لديّ شعور عميق بأنّ هذا ما أريده.
في باريس كان لدي اشتراك في السينما. في الأيام التي لم يكن لديّ فيها أيّ عمل للقيام به، كنت أذهب صباحًا إلى السينما وأبقى هناك حتى حلول الليل. كنت أشاهد فيلمًا، أخرج لاحتساء القهوة، ثمّ أدخل لمشاهدة فيلم آخر، ثمّ أخرج لشرب شيء ما أو للأكل، ثمّ أعود إلى الصالة، وهكذا دواليك. كنت أشاهد أحيانًا أربعة أفلام في اليوم الواحد. فجاء فيلم أسامة في اللحظة التي كنت أشعر فيها بصدق الرغبة في أداء دور ما في السينما. بعد لقائنا في باريس اختفى أسامة، و تّ في ضياع تام، لا فكرة لديّ إذا كانوا سوف ينفذون المشروع أم لا، هل يجب أن أعود إلى سوريا أم لا. بعد عدّة شهور يتصل بي أسامة لإعطائي مواعيد التصوير وبضرورة عودتي إلى سوريا للقيام بالتحضيرات اللازمة لذلك.
عدت حينها إلى سوريا من أجل الفيلم تاركة خلفي كلّ شيء في باريس. في دمشق أجرى أسامة عددًا من الاجتماعات التي ضمّت الممثلين المختارين للفيلم. أنا كنت واحدة من الممثلين الذين كان أسامة يعرف ما الدور الذي سألعب في الفيلم، ليس كبعض الممثلين الآخرين. الشخصيات النسائيّة كانت واضحة بالنسبة لأسامة، لكنه لم يكن متأكدًا من شخصيات الرجال التي لعبها "فارس الحلو" و"زهير عبد الكريم" و"بسام كوسا". وزّع على الممثلين الشباب السيناريو، لكنهم لم يكونوا على علم بالشخصيّة التي سيلعبون حتى اليوم الأول للتصوير.
هل طلب أسامة إليهم أن يعملوا على كلّ شخصيات الرجال في الفيلم؟
ليس لديّ فكرة عن هذا الموضوع، لكن بالعموم لم يكن هناك طلبات من أسامة للممثلين لتحضيرها. الدور الذي لعبته لم يكن فيه الكثير من الحوار، هي كلمات قليلة جدًا، أقصد الكلمات المكتوبة في النص. الطلب الوحيد الذي طلبه مني هو أن أطلق العنان لحاجبّي كي يصبحا كثين. ذلك كان التحضير الوحيد الذي قمت به لفيلم "صندوق الدنيا"، جعل حاجبي عريضين (تضحك).
بالنسبة للممثلين الشباب، أعتقد أنّه طلب منهم أن يقرؤوا كلّ شيء. أسامة يعمل في موقع التصوير، يقوم بتحضير كلّ شيء، ويعرف بالضبط ما يريد، لكنه يخلق تلك اللحظات مع الممثلين في موقع التصوير أثناء العمل. تلك كانت طريقته بالعمل معي، يعرف حجم اللقطة و صيرورتها وما يجب أن توصل تلك اللقطة، لكن فيما يخص طريقة أداء الممثل، فإنّه يخلق المحفّز المناسب للوصول إلى المطلوب من الأداء، لكنه لا يطلب منك تحضيره بشكل مسبق.
عملية اكتشاف لتلك الشخصيات أثناء التصوير.
بالضبط، عملية اكتشاف. كان التصوير في منطقة قريبة من مرمريتا. ذهبنا إلى هناك قبل عدّة أيام على بدء التصوير. كان وقتًا جميلًا جدًا، لا أدري إذا كانت "أمل عمران" قد أخبرتك بذلك، كان في الموقع هناك الشجرة الكبيرة التي ظهرت في الفيلم. وقد بُني مكان لاستراحة الممثلين، إلى جانب البيت الطيني الذي دارت فيه أحداث الفيلم. في ذلك اليوم ومع وصولنا إلى هناك، قمنا بالقياسات الأخيرة لأزياء الفيلم. في تلك اللحظة اجتمع فريق العمل كاملًا، كان هناك شعور بالحماسة والغبطة، والجميع يتساءل في داخله عن الكيفيّة التي ستدار بها الأمور. أسامة معروف بغموضه في العمل، كلّ شيء هو سرّ بالنسبة له. كنّا فعلًا غير عارفين بما يجب القيام به. فترة التصوير كانت طويلة، عدد من الشهور. بدأ التصوير في شهر أيار 2001 انتهينا من التصوير في نهاية الصيف على ما أذكر.
هناك شيء أعتقد أنّه استثنائي في بنية الفيلم، وهو الحديث عن هرم السلطة الذكوري الموجود في مجتمعنا بشكل عام وموجود في شكل السلطة الحاكمة لهذا البلد (سوريا). فعاليّة الأدوار النسائيّة في القصة، التشكيلات الجسديّة لتلك النساء في الفيلم هي الأكثر جاذبيّة، الفعالية والحركة الخاصة فيها جاذبيّة، وطريقة أَدَاؤُهُن المؤسلبة، تعطي ذلك البعد التغريبي والسوريالي للفيلم. طريقة أدائك واللوازم الحركيّة والصوتيّة، أو طريقة أداء أمل عمران و الأسلبة في حركتها و تعبيراتها الصوتيّة، كان ذلك أقل حضورًا في أداء كاريس بشار بالمقارنة مع نمط أدائك و أداء أمل عمران، و ذلك راجع في الأصل للنمط الأدائي الخاص بك وبأمل كممثلتين، و المختلف عن نمط أداء ممثلة مثل كاريس بشار. إلّا أنها كانت مؤسلبة في الفيلم من خلال التصميمات الحركيّة التي كانت مضطرة لتأديتها. ذلك الثلاثي النسائي المؤسلب في الفيلم إلى جانب الأم "مها الصالح" والجدّة (لعبت دورها نهال الخطيب) مقابلة للكتلة الذكوريّة (الإخوة الثلاثة) والأب و الجدّ، تظهر مستويّات من الصراع الرمزي، وتظهر هرميّة أخرى بين النساء أنفسهن داخل ذلك المجتمع الذكوري. هل لك أن تطلعيني على كيفيّة بناء ذلك الهرم السلطوي الأنثوي في الفيلم المحجوب بالهرم الذكوري، و كيف بنيت ذلك الأداء المؤسلب، والذي أعتقد أنّه مبالغ فيه في بعض المواضع، لكن وفي نفس الوقت، خلقت تلك المبالغة، ذلك العالم السردي الخاص للفيلم؟
أستطيع الحديث على الأقل عن الطريقة التي عمل فيها أسامة معي. لقد كان هناك الكثير من الكوريوجرافيا في شكل الأداء وشكل الحركة (التصميم الحركي الراقص). وهذا راجع أيضًا للطريقة التي أعمل بها، والتي تعمل بها ممثلة كأمل عمران، ونوع الأداء الذي ننتمي إليه. يدفعك أسامة للتفكير بتلك الطريقة. يعمل أسامة كثيرًا على الايقاع، وعلى الكوريوجرافيا وحركة الجسد ضمن الفضاء. لم يكن ما فعلنا في أيّ لحظة من قبيل المصادفة، أو نفذّ بشكل واقعي و عادي. لم يكن أبدًا في أدائي أيّ حركة يوميّة، دائمًا هناك أسلبة في الأداء وقريبة من الرقص. حتى الحركات و الانفعالات الصغيرة مدروسة ومبرمجة، لم تكن بالصدفة. وكان ذلك مبنيًا على ملاحظات أسامة وعلى الطريقة التي كان يرى فيها أداء الممثلين للشخصيّات. كان يرى الطريقة التي تعمل بها أجسادنا أمام الكاميرا ويقوم هو بتطويره وتوظيفه و التأكيد عليه.
عمل أسامة معي كثيرًا على الأشياء الحسيّة، وذلك راجع لطبيعة الشخصيّة التي كنت ألعبها. حسيّة بمعنى أفعال الشم والتذوق واللمس. لم يكن هناك أيّ ملاحظات لها علاقة بالتفكير على الإطلاق. دفعني لتقديم أدائي بشكل كامل من خلال تلك الأفعال. حتى الأصوات المصاحبة للأفعال كانت مهمة له، وكان يأخذها ويعمل عليها. كنّا نعيد تصوير اللقطات كثيرًا، وسبب ذلك أنّ أسامة محمد مخرج متطلّب بشكل كبير، وهذا أمر أحبّه فيه، لأنيّ ممثلة متطلبة بشكل كبير. كان يشكل ذلك لي متعة شديدة. كنت لا أقتنع بأدائي و أعتقد دائمًا أنّ بإمكاني القيام بما فعلت بطريقة أفضل مع الإعادة. كان ذلك الإحساس مرافقًا لي على طول الخط، وأسامة كان لديه نفس الشعور. كان يجمعنا ذلك التطلّب من العمل.
فارس الحلو: أحلامي هي مشاريعي
14 كانون الأول 2021
تحدثت أمل عمران في حواري معها عن بدائيّة اللغة التي تستعملها شخصيات الفيلم، وهذا أمر ذو دلالة عميقة. هلّا حدثتني عن كيفيّة تشكّل تلك اللغة البدائيّة، واللوازم الصوتيّة للشخصيّة التي قدّمت في الفيلم، من أين جاءت؟
إنها فعلًا لغة بدائيّة. كان التوجيه الأساسي من أسامة: تلك الشخصيات شبيهة بالسحالي والعضاءات والأفاعي. قلت لك سابقًا إنّ الموضوع كان حسّيًا غرائزيًا بشكل كامل، وليس فكريًا، كلازمة اللسان التي استخدمتها في الفيلم، والتي تشبه الطريقة التي تحرّك السحالي بها ألسنتها. لم تكن المرأة التي أديت دورها مجنونة، لكنّها كانت بدائيّة وقريبة إلى عالم الحيوان أكثر منها إلى الآدميّة. لم نتعامل مع تلك الشخصيّة في أيّ لحظة على أنّها مجنونة. أسامة لم يفكر بتلك الشخصيّة على أنّها مجنونة، ولا حتى أنا. إنّها امرأة بدائيّة لا تجيد الكلام، ولم تتعلمه.
لا تنطق تلك الشخصيّة في الفيلم سوى ببضع كلمات، وتكرّر تلك الكلمات على طول زمن الفيلم. لقد سمعتْ تلك الكلمات سابقًا، وتقوم بتكرارها. ما ينتمي إلى الشخصيّة من الأفعال هو طريقة التنفس، لقد عملنا على طريقة تنفس تلك الشخصيّة، وعلى حركة اللسان التي تشبه السحالي، وعلى الحركة القلقة لجسدها. إنّها في حالة اكتشاف مستمر. على سبيل المثال المشهد الجنسي بيني وبين زهير عبد الكريم. ذلك المشهد الذي كان فيه زهير عبد الكريم على الشجرة فوق، وأنا أقف في الأسفل، ثم يمد يده ليلمس صدري. في ذلك المشهد كانت الشخصيّة التي لعبتها تكتشف الجنس لأوّل مرة. لقد كان شيئًا حسيًا فقط، وقد تقاطع ذلك الأسلوب بالعمل في تلك المرحلة مع توّجهاتي الشخصيّة في تدريب نفسي كممثلة، فقد كنتُ أمارس الكثير من تمارين التأمل وتمارين التنفس والجسد.
أنا أتفق معك أنّ الشخصيّة التي لعبت دورها ليست مجنونة. وقد تكون أكثر براءة من باقي الشخصيات. يبدو أنّها أكثر النساء الموجودات صلة بالعوالم الماورائيّة.
الشخصيّة لديها صلة بالطبيعة، وهذا ما يوصل الشخصيّة إلى قدرتها على التواصل مع العوالم الماورائيّة. تلك المرأة قادمة من مكان مجهول، وتعتبرها الشخصيات الأخرى في الفيلم متوحشة وبدائيّة. تلك الشخصيّة سوف تصير صاحبة السلطة فعليًا لأنّها والدة الطفل الذي تتقمّصه روح الجد المتوفى، والذي يصبح صاحب السلطة المطلقة على البيت بمن فيه. سوف ترى تحوّل تلك الشخصيّة البدائيّة والساذجة، إلى شخصيّة صاحبة سلطة، لا بل تتلاعب بالشخصيّات الأخرى من خلال امتلاكها لتلك السلطة (الشخصيّة التي أدّتها حلا في الفيلم قرّرت إنهاء الصيام في رمضان. تقوم بإقناع ولدها المتسلط أنّ العيد قد حلّ، وأنّ رمضان انتهى. وهي التي تقرّر احتكار فيروزة لابنها. وهي التي تتسبّب بعقاب أحد الأحفاد لأنّه تعارك مع الولد الطاغية. كلّ ذلك دلالة على قدرة تلك الشخصيّة على التلاعب بالآخرين).
تلك المرأة الغريبة التي تزوجها الابن الأعزب في بداية الفيلم. جاءت إلى بيت شبيه بالمعبد أو المزار. أسميه معبد بسبب السلطة الدينيّة والروحيّة التي يمتلكها الجد. في ذلك المشهد الملحمي عند نزول المطر واجتماع أهل القرية للنواح على الجد المحتضر. هل يندرج ذلك تحت عنوان "الطقوس الدينيّة"؟
طبعًا… طبعًا. ذلك البيت المنعزل، استمد خصوصيته من المكانة الروحيّة والدينيّة للجد.
كان من الواضح أنّ الشخصيّة التي قدّمت في الفيلم تنحدر من عائلة ذات مستوى اجتماعي أقل.
أقل بكثير، فهي ابنة سارق الكرارى (سارق البغال). جاءت من تلك الخلفيّة لتمسك بالسلطة. تلاحظ ذلك من تغيّر حركة عيونها بعد تقمّص روح الجدّ لجسد ولدها. ذلك دفعها للتفكير بأنّها باتت صاحبة السلطة، فهي من أنجب ذلك الولد الذي تقمّصته روح الجدّ المباركة (أو كما يذكر في الفيلم ”قدس الله سره“) ذلك التحوّل في الشخصيّة هو تحوّل ساحر. وهذا جزء أساسي مما يريد الفيلم وصانعه قوله: عن هذا العالم، وهذه الطائفة، وتلك الشخصيات، وتحوّلاتها الإنسانيّة والسلوكيّة.
حدثيني عن أدائك لشخصيتك إلى جانب الشخصيات الأخرى في الفيلم. كيف بُني ذلك التناغم الإيقاعي في الحركي والأداء مع زملائك من الممثلين. مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ الشخصيّة التي لعبت دورها، والابن الذي تزوّجت، كانا من المنبوذين. ففي ذلك المنزل هناك مجموعة تعيش داخله، وهي المجموعة الأكبر. و المجموعة التي تعيش خارجه (الشخصيّة التي لعبتها حلا تعيش مع زوجها وابنها في عرزال بُني على الشجرة الكبيرة قبالة البيت الطيني الذي تسكن فيه أغلب أفراد العائلة). كيف تلخصين تلك العلاقة مع الشخصيّات الأخرى في الفيلم؟
كان ضروريًا بالنسبة إلى أسامة أن يكون كلّ الممثلين حاضرين دائمًا في موقع التصوير. لم يكن الأمر كما يجري في العادة، تأتي فقط لتصوير مشاهدك، وتغادر حين تنتهي. فعلًا كنّا متواجدين طوال الوقت أثناء التصوير. كما نفعل في المسرح عمليًا. كنّا نتواجد طالما الكاميرا تعمل، في النهار أو في الليل. نشأت تلك العلاقة بسبب ذلك.
كنتم تشاهدون تصوير مشاهد بعضكم البعض؟
تمامًا. أنا تفرجت على أغلب المشاهد واللقطات أثناء تصويرها. الكلّ فعل ذلك تقريبًا. أضف إلى ذلك أنّ المشاهد الجماعيّة في الفيلم كانت كثيرة. صحيح أنّ الشخصية التي لعبت كانت تعيش على الشجرة خارج المنزل. إلّا أنها كانت متواجدة في كلّ المشاهد الجماعيّة تقريبًا. كمثل ذلك المشهد الجميل الذي نكون فيه أمام البيت، نقوم بعجن روث الحيوانات بأرجلنا لكساء الجدران الداخليّة للبيت الطيني المتهالك. أخذ تنفيذ هذا المشهد زمنًا طويلًا. كنا نصوّر في درجة حرارة عاليّة، حتى أنّ أمل كادت تفقد وعيها بسبب ذلك. كان جوًا حارًا، والطين الذي ندوس فيه حار وقد خرج منه الدود. حدث ذلك لأنه تُرك لأكثر من يوم حتى تمكنا من إتمام المشهد. كلّ هذا خلق حالة تقارب شديدة، وهذا ما خلق الروح الواحدة للعمل. الطريقة التي يشكل فيها أسامة الكادر خلقت تلك الحالة التلقائيّة والتواصل الظاهرة في الفيلم. عليك أن ترى النص كيف كان مكتوبًا. الإحساس الإيقاعي للمشاهد محسوس وواضح من النص المكتوب. يتوّجب عليك فقط تنفيذ المكتوب بطريقة جيدة، وهذا ما حصل. فأسامة كان يدير العملية كما كانت تدور في رأسه، و كما كتبها في السيناريو. هذا ما أنتج ذلك التناغم في الصوت والحركة. الحركة في الفيلم لم تكن ارتجاليّة. كلّ شيء كان مرسومًا بعناية. كنا نعيد كثيرًا لتحقيق البنية التي يتطلع إليها أسامة من اللقطة.
حدثيني عن المشاهد التي جمعتك بالطفلة التي لعبت دور فيروزة. أعتقد أنّ تلك المشاهد شديدة الأهمية في الفيلم. بعد أن حلت روح الجد في جسد حفيده، بدأت الأم (الشخصيّة التي لعبتها حلا) القيام بكلّ شؤون ولدها كأنّها خادمة الملك.
ليس ذلك فقط، لقد بدأت تعتبر نفسها هي السيّدة على كلّ شيء، و أنّها تمتلك الحق بتلك المكانة. فعلًا تلك المشاهد مع تلك الفتاة التي لعبت دور فيروزة كانت مُدهشة. والفتاة نفسها التي لعبت الدور كانت مدهشة. لا أدري أين هي اليوم، لكنها مع الأطفال الباقين كانوا جميعًا مدهشين، لكن تلك الفتاة كانت ساحرة بشكل استثنائي.
تلك الفتاة كانت ابنة سائق الباص الذي كان يقل ممثلي الفيلم.
ذلك صحيح على ما أعتقد. أعرف أنّهم قد جاؤوا بها مع الأطفال الباقين من القرى المحيطة بموقع التصوير. قاموا بصبغ شعرها بالأحم، لقد كانت ساحرة الجمال. كان لديها ابتسامة ونظرة لا يمكن أن أنساها في عمري. لا أدري إذا كان أسامة متقصدًا تمامًا لكلّ ما قد فعلناه في المشاهد التي جمعتنا. لقد برز جانب جنسي في بعض تلك المشاهد. شيء ما ملتبس في علاقة تلك المرأة مع فيروزة.
كان واضحًا ذلك الالتباس في العلاقة، فيختلط علينا ما إذا كانت شخصيتك تشتهي فيروزة لابنها، أو لنفسها.
تمامًا. هذا لم يكن واضحًا في النص، ولم يكن مقصودًا مئة بالمئة، ولم يكن هناك توجيه من أسامة للذهاب إلى تلك القراءة للشخصيتين في علاقتهما. لكني متأكدة أنّه ناتج عن الطريقة التي كتب بها المشهد. عندما انتهينا من التصوير، اتصل بي أسامة ليقول لي إنّه في أحد تلك المشاهد مع فيروزة صدر عني صوت معبّر جدًا، وذلك لم يكن مكتوبًا أو مطلوبًا. هناك شيء ما خرج منّا لأنّ العلاقة كانت حسيّة. في ذلك المشهد أقترب من فيروزة وأمسك بها، تقول لي: أبَدي… ثمّ تغادر. خرج مني ذلك الصوت الغريب الذي كان صوتاً حيوانيًا، وليس آدميًا. يمكنك تأويل ذلك الصوت بعدّة طرق. كلّ ذلك جاء لأنّنا نعمل على شخصيّة ذات رغبات غير واضحة. هي التقطت أن ابنها يرغب بالفتاة، ولأجل ذلك بدأت بالعمل على تحقيق تلك الرغبة له. خلال عملها على تحقيق تلك الرغبة لولدها، تقترب أكثر من فيروزة لتصبح صديقتها. الشخصيّة التي لعبت دورها ليس لديها إدراك لفارق العمر بينها وبين فيروزة. هي أصلًا طفلة بذاتها. طفلة بجسد امرأة. و بسبب ذلك الإحساس الطفولي الموجود لدى تلك المرأة، تقبل أنّها تحاول أن تلعب وتضحك معها، تريد أن تكون بالقرب منها، تريد أن تصبح صديقتها. ويندرج داخل تلك العلاقة الرغبة والاشتهاء.
تغيّرت علاقة الشخصيّة التي لعبت في الفيلم بولدها بعد عملية التقمّص، فهو بات المتحكّم، وخرج عن سلطتها كأم.
طبعًا، طبعًا. ابنها بات السيد، وبات يتعامل معها باحتقار كما هو حاصل في التراث العلوي، أي أنّ المرأة محتقرة في بعض المواضع في السلسلة الهرميّة، عدم أحقيّة المرأة بتلقي تعاليم الدين، وأشياء أخرى. عندما يتربّع ذلك الولد على عرش السلطة تتحوّل أمه إلى شيء حقير. في نفس الوقت، هي كانت سعيدة بأن تكون ذلك الشخص المُحتقر لأنّها أم ذلك السيد.
أقرب الحقراء إلى السيد.
بالضبط، أقرب الحقراء إلى السلطة ( تضحك).
منذ ما يزيد على العام و أنا أسأل هذا السؤال: هل هناك سينما سوريّة؟ أم هناك أفلام سوريّة؟ سألت ذلك السؤال لنضال الدبس، ولمحمد الرومي ولأمل عمران و تحدثت كثيرًا مع أسامة حول الموضوع. باتت الإجابة على ذلك السؤال غير مهمة بالنسبة لي. لكلّ فيلم تجربته الذاتيّة وظروفه الفنيّة والإنتاجيّة. و كلّ فيلم يخلق عالمه الخاص مبنيًا على مرجعياته الفكريّة والفنيّة. كما فعل أسامة محمد في تجربة فيلم "صندوق الدنيا"، فهو بنى فيلمه على مرجعيّة فنيّة سينمائيّة واضحة، ولم يسع إلى إخفاء ذلك، بل على العكس، قام بالتدليل على الفيلم المرجع، فأسامة عنون فيلمه باللغة الفرنسيّة بـ"التضحيات"، لربطه بالعمل الأخير الذي صنعه المخرج السوفيتي أندريه تاركوفسكي، الأضحيّة. لكنه عاد وأَصّل فيلمه بالعناصر الفنيّة التي بنت فيلم "صندوق الدنيا" عبر حكايته المحليّة ورموزه ذات المرجعيّة الثقافيّة المحليّة. بذلك تحوّل الفيلم إلى عالم كامل، محمّل برموزه التي تصنع لغته الفكريّة والمعرفيّة. والفيلم ينتمي إلى الفن السينمائي. كيف ترين تجربتك بهذا الفيلم؟ كيف تقيمينها من موقعك كفنانة سوريّة مطلعة على التجارب السينمائيّة السوريّة الأخرى، من ناحية جديّة المخرج في تعامله مع مشروعه الفني. يقول نضال الدبس في حديثه عن تجربته مع أسامة محمد إنّ أسامة متصوّف سينمائي، يعطي نفسه بشكل كامل لمشروعه السينمائي، ويفترض أنّ كلّ الذين يعملون معه سوف يقومون بنفس الأمر. و كان نضال واضحًا برفضه لتقمّص حالة أسامة السينمائيّة رغم تقديره لها. يمكننا ربط تقييمك لتجربتك في فيلم صندوق الدنيا و تجربتك مع أسامة محمد بتجربة فيلم آخر وهو فيلم "تحت السقف" من إخراج نضال الدبس، فأنت قمت بتأدية دور جميل في ذلك الفيلم أيضًا. أعتقد أنّ أسامة قد أثر كثيرًا في الأعمال التي شارك فيها كمتعاون فني مع مخرجين آخرين، وذلك واضح في تجربة فيلم "الليل" لمحمد ملص، وفيلم "تحت السقف" لنضال الدبس.
ما قلته في توصيف أسامة صحيح جدًا، وهذا ما جعلني سعيدة بتجربة ذلك الفيلم. وهذا ما خلق حالة التفاهم بيننا كمخرج وممثلة. أنا أيضًا مثل أسامة، أعطي نفسي بشكل كامل للعمل. التمثيل هو حياتي، وأيّ شيء آخر في هذه الحياة لا يملك نفس القيمة، وأفترض من الأشخاص الذين أعمل معهم بأن يكونوا كذلك. لذلك تجاربي الفنيّة باتت محدودة بأشخاص يفكرون ويعملون بنفس طريقتي. على سبيل المثال في المسرح أنا أعمل مع شخصين منذ ما يقارب ست سنوات، وهما "سليمان البسام" و"علي شحرور". أعمل مع غيرهم من الفنانين المسرحيين، لكني أعمل بشكل أساسي مع هذين الشخصين الذين يشبهاني تمامًا بمبدأ العمل. لا أستطيع العمل في مشروع إذا لم أكن منخرطة فيه بشكل كلّي. تفكيري وروحي وجسدي وعواطفي ومعرفتي وذاكرتي، كلّ شيء يتمحور حول العمل الذي أقوم به. أسامة كذلك، لدينا شيء من الهوس بما نقوم به، وهذا هو الجميل في عمل أسامة وفي العمل معه. فيلم "صندوق الدنيا" يعنيني كثيرًا لأنّه أول عمل سينمائي عملت فيه، ولأنه أول عمل سينمائي سوري يوجد في مهرجان كان السينمائي ضمن الخيارات الرسميّة للمهرجان. بغض النظر إذا كان فيلم أسامة فيلمًا سوريًا، إلّا أنّه فيلم سينمائي بلغة سينمائيّة عالية، من ناحية السينماتوجرافيا والشعريّة والفكريّة العالية. هو ليس فيلمًا عاديًا برأيي الشخصي، وهو ليس بالفيلم السهل، فأنت بحاجة لمعرفة الرموز التي بُني عليها الفيلم، وأتفهم كثيرًا موقف الناس الذين لم يفهموا الفيلم أو لم يتواصلوا مع القصة. هناك الكثير من الناس اعتبروا الفيلم شديد التعقيد. لكني ما أزال أعتقد أنك تستطيع التواصل مع الفيلم دون فهم كلّ رموزه، لا بدّ أن تلتقط شيئًا من معاني الفيلم من المشاهدة الأولى. هناك شيء حسّي لا بدّ أن يصلك. على الأقل من خلال تشكيل الكادر أو الألوان والإضاءة في الفيلم، أو في الحركة.
من بين الأفلام السوريّة التي أنتجتها المؤسسة العامة للسينما أرى أنّ هذا الفيلم هو الأكثر تميّزًا في تاريخ تلك السينما. أنا لم أكن موجودة في تجربة فيلم "الليل" لمحمد ملص وأسامة محمد، لكنّني أستطيع القول إنّ هناك شيء في فيلم "الليل" يشبه الكيفيّة التي يعمل بها أسامة. نفس الأمر كان في تجربة "تحت السقف" أيضًا، فأسامة كان متواجدًا في تلك التجربة، وأثّر فيها. بكلّ تأكيد أنّ فيلم "تحت السقف" هو فيلم لنضال الدبس، لكن أسامة قدّم مشورته لنضال في كثير من المواضع فيما يخصّ تشكيل الكادر، أو الأداء. كان تواجد أسامة في موقع تصوير فيلم "تحت السقف" يعطيني الكثير من الثقة، فأنا لم أكن أعرف نضال الدبس كمخرج حينها. كنتُ أشعر بتلك الثقة بسبب معرفة أسامة للطريقة التي أعمل بها والطريقة التي يمكن بها تحفيزي، والتواصل معي. نعم أعتقد أنّ تأثير أسامة في الأعمال التي تعاون فيها فنيًا مع مخرجين آخرين شديد الوضوح. لقد تعلمت كثيرًا من خلال تجربتي في فيلم "صندوق الدنيا" لأنّني عشتها. كان هناك الكثير من الاكتشاف والمشاعر القويّة التي عايشتها في تلك التجربة. أدّينا مشاهد شديدة الصعوبة، و كنّا نعيدها كثيرًا لنتمكن من تأدية المطلوب منها. هذا الفيلم فتح لي أفقًا جديدًا، فقد حظيت بفرص أخرى للعمل في السينما مع مخرجين آخرين. استطاع المحترفون والناس رؤية ما يمكنني فعله من خلال فيلم أسامة.