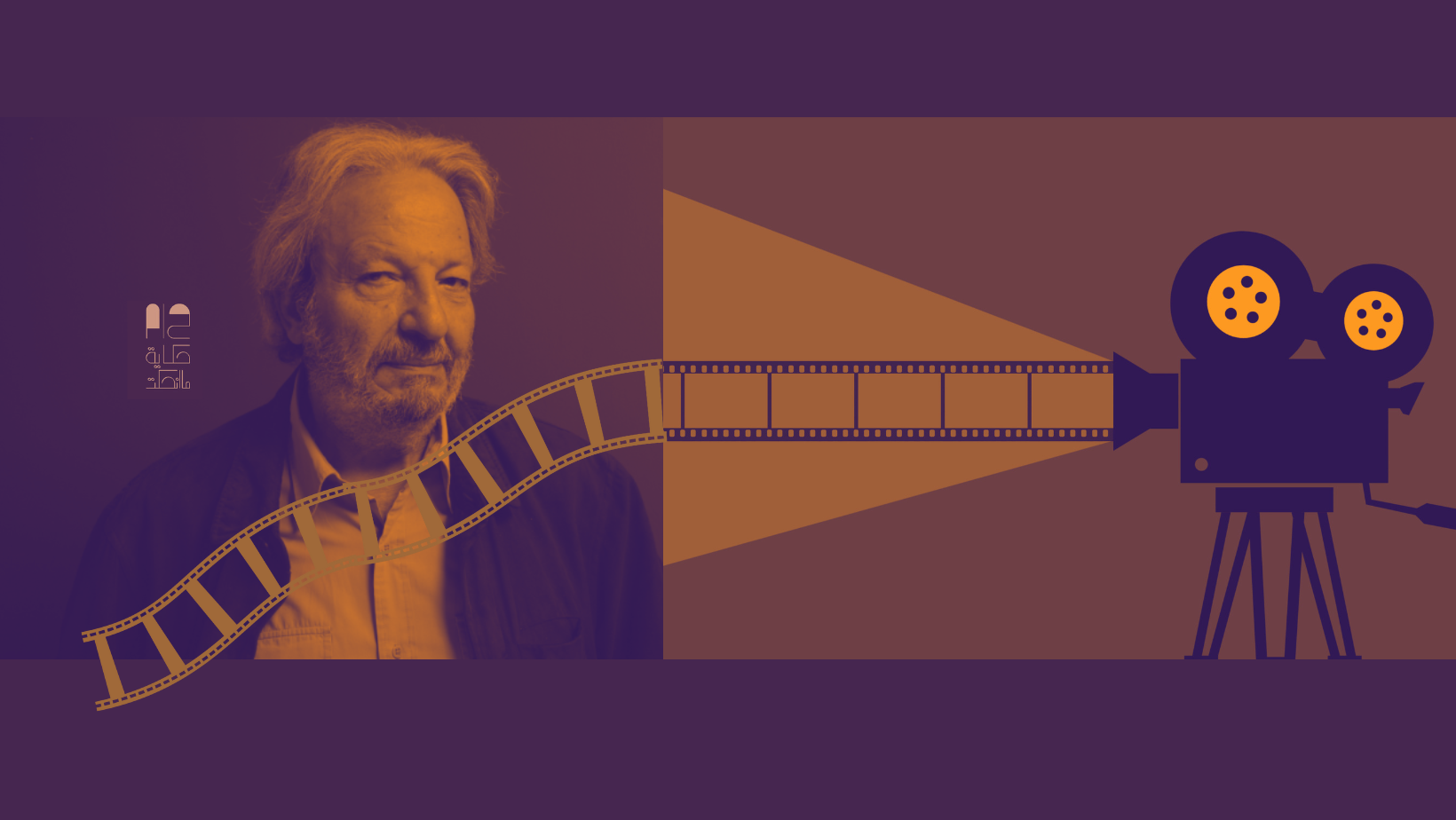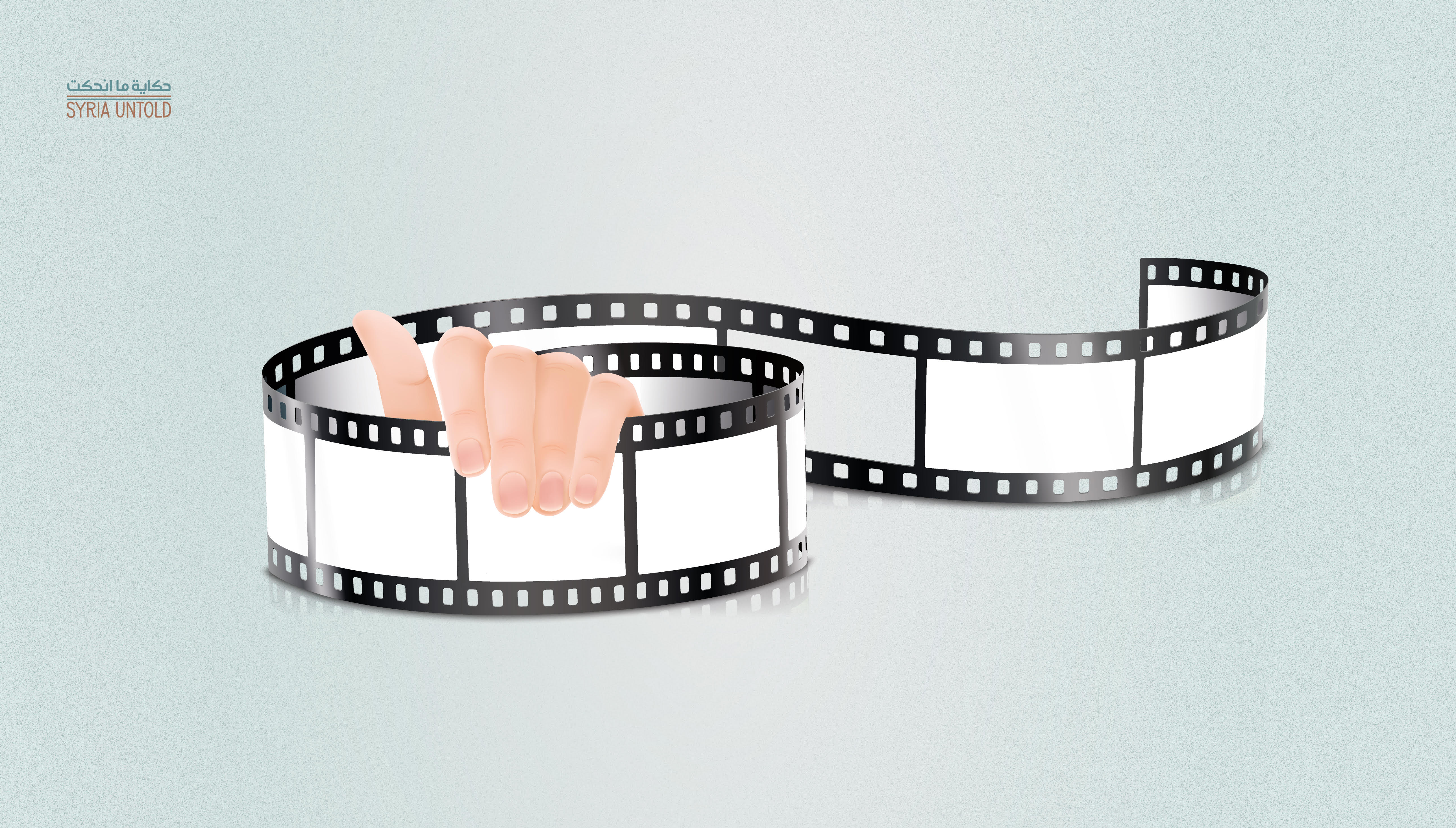"لم تكن هذه الرواية ممكنة لولا عشرات النساء والرجال، في مخيمات برج البراجنة وشاتيلا ومار الياس وعين الحلوة، الذين فتحوا لي أبواب حكاياتهم، وأخذوني في رحلة إلى ذاكراتهم وأحلامهم".
(إلياس خوري / الصفحة الأخيرة من رواية باب الشمس).
في شهرِ نيسان الفائت، وضمن برنامج مهرجان الفيلم العربي في برلين، جلستُ في قاعةِ "سينما أرسنال"، وسط برلين، مع العشرات من مُحبّي السينما لمشاهدةِ فيلم باب الشمس، رائعة المخرج المصري يسري نصر الله المقتبسة عن روايةِ الروائي اللبناني، إلياس خوري، والتي تمتدّ لأكثر من أربع ساعات ونصف.
شاهدنا، بعد عشرين سنة من عرضِ الفيلم للمرّةِ الأولى في مهرجان كان السينمائي، النسخة المُرمّمة من الفيلم الذي قُدّم بنسخته الجديدة في العام الماضي في مهرجان لوكارنو السينمائي، وكأنّنا عثرنا على كنزٍ فقدناه، على الأقل كأنّني عثرتُ شخصياً على كنزٍ افتقدته.
المرّة الأولى
شاهدتُ الفيلم للمرّةِ الأولى رفقةَ أمي واثنين من إخوتي، بشّار ونوّار، سنة ٢٠٠٤ أو بدايات ٢٠٠٥، لا أذكر بالتحديد، لكنّ بالتأكيد قبل التاسع من تشرين الأول ٢٠٠٥، يوم مات أخي نوّار، وهو في الحادية عشر من عمره.
استأجرَ بشّار الفيلم من متجرٍ يؤجّر ويبيعُ الأفلام المنسوخة على أقراصٍ مُدمجة. ربّما شاهدنا أولاً الجزء الثاني من الفيلم (الفيلم، مثل الرواية، مُقسّم إلى جزأين. في الرواية يكون عنوان الجزء الأول: مستشفى الجليل، وعنوان الجزء الثاني: موت نهيلة. في الفيلم يكون عنوان الجزء الأول: الرحيل، وعنوان الجزء الثاني: العودة).
لا أستطيع التذكّر بدقة، لكن أعتقد أنّنا أستأجرنا الفيلم لنشاهد فيلماً سينمائياً لباسل خياط (يلعب دور الدكتور خليل في الفيلم)، والذي كان يبزغ نجمه كأحد أبطال المسلسلات السوريّة الشباب. وبعد الجزءِ الثاني الذي أحببناه كثيراً أستأجرنا الجزء الأول، لتكتمل الصورة.
حلا عمران: التمثيل مساحة حرّة وفيها الكثير من اللعب
19 نيسان 2022
لا أعرفُ كيف أصف مشاعري وأنا أهمّ بالدخولِ إلى قاعةِ السينما بعد عشرين سنة من مشاهدة الفيلم للمرّة الأولى. تذكرت أخي الصغير الذي رحل عن عالمنا مبكراً؛ تذكرتُ تململه من الفيلم وعدم إكماله مشاهدته معنا. تذكرت أمّي وحديثنا عن الفيلم بعد نهايته. تذكرت أخي بشار وضحكاتنا خلف ظهر أمّي كلّما ظهر مشهد جنس أو تقبيل؛ كنّا مراهقَين نضحك خبثاً أو خجلاً. تذكرت أمي وهي تقول إنّ الحبّ فعلٌ لا نخجلُ به، أو منه.
تذكرتُ المرّة الأولى التي قرأتُ فيها الرواية، التي اشتريتُ نسخاً كثيرة منها على مرّ السنوات ووزعتها على أصدقائي. تركتُ واحدة مع شاب فلسطيني شاركني غرفتي لشهورٍ في مخيّم اللاجئين أوّل قدومي لألمانيا. أعطيتُ نسخةً مترجمة للألمانية لشريكتي، ونسخ أخرى لأصدقاء في ألمانيا ولبنان ومصر.
كان الدخول إلى قاعة السينما، يشبه الدخول إلى ماضيّ الشخصي.
في البدء كانت الرواية
أحببتُ الفيلم أولاً، ومن ثمّ أحببتُ الرواية. حين شاهدتُ الفيلم، لم أكن قد سمعتُ بإلياس خوري، ولا بيسري نصر الله، ولا بالكثير من الكتّاب والمثقفين والفنانين العرب. كنتُ أعيشُ في بيتٍ ممتلئ بالكتب، لكنّ ثقافة البيت كانت سوفيتيّة. أبي وأمي وثلاثة من أعمامي درسوا في دول الاتحاد السوفيتي، وأخي الأكبر وُلد هناك. حينها كنتُ قد قرأتُ في مراهقتي مكسيم غوركي وبوشكين ودوستويفسكي وغيرهم من عظماء الأدب الروسي، لكنّني لم أعرفْ إلياس خوري.
مع مرورِ السنوات قرأتُ روايات إلياس خوري، ومقالاته في الصحف اللبنانية، وصار من كتّابي المُفضلين وواحدٌ من أبطالي الشخصيين. لا أتذكر موقفاً سياسياً أو مقالاً صحفياً أو رواية لإلياس خوري حاد فيها عن قيم الحق والخير.
أحببتُ رواية باب الشمس. تأثرت كثيراً بشخصية خليل. أعتقدتُ لسنوات طويلة أنّ جزءاً من شخصيتي صارت تشبه خليل. لاحقاً أحببتُ رواية "يالو". قرأتها عددًا من المرّات، قبل أن ألتقي بإلياس خوري ويوقّع لي على نسخة خاصة لي.
حدث ذلك في القاهرة صيف العام ٢٠١١. عُقِدتْ لإلياس خوري ندوة في الجامعة الأمريكية في القاهرة بالقرب من ميدان التحرير، عقبها حفلٌ لتوقيع كتبه لمن يرغب. لم أستطع حضور الندوة بسبب التزامات العمل، وتأخرت على حفل التوقيع. صديقة لي طلبتْ منه انتظاري. بتواضعٍ كبير انتظرني حوالي نصف ساعة. وصل واشتريتُ نسخةً من رواية "يالو" وطلبتُ منه توقيعها لي. مازحني بشأن انتظاره لي، ثمّ سألني عن اسمي. دلير، أجبته. سألني عن أصل الاسم. وحين أجبتُ، قال مازحاً: "سوري وكردي واسمك دلير، لازم أنت توقعلي، مو أنا وقعلك." كانت ثورة سوريا في أوجها.
بعد ثلاث سنوات صدر كتابي الأوّل، حكايات من هذا الزمن. بعد أن أنهيتُ كتابة الكتاب لم أستطع العثور على اسمٍ مناسب، حتى قرأتُ مقالة لإلياس خوري في صحيفة القدس العربي معنونةً بنفس العنوان. أحسستُ بأنّني عثرتُ على ما أبحث عنه. طلبتُ منه استخدام عنوان مقالته عنواناً لكتابي. فوافق بتواضعِ الكبار.
قرأتُ "باب الشمس" أربع أو خمس مرّات، وفي كلّ مرّة كنتُ أجدّ شيئاً جديداً فاتني في القراءة السابقة، مثل كلّ الكتب العظيمة. في الرواية حكاية تنبثق من قلب حكاية. تدخل الحكاية في حكاية أخرى وتنتج حكايات لا تنتهي في دوائر تدور وتدور وتدور.
قبل فترة قصيرة سمعتُ بمرض إلياس خوري، وقيل إنّه أُدخل إلى المستشفى. أردتُ أن أكتب له رسالة أقول له فيها كم أثّر فيّ ككاتب وكإنسان، ثم عدلتُ عن ذلك، لأسبابٍ ما زلتُ أجهلها.
بابٌ على فلسطين
في المشاهدةِ الأولى للفيلم أحسستُ، وأنا المراهق الذي يعيش في واحدةٍ من عشوائيات دمشق، أنّ باباً على فلسطين قد فُتح. لم نكن نعرف عن فلسطين شيئاً سوى ما تقوله لنا نشرات الأخبار وقصائد الشعر: العدو الغاشم، الأرض المحتلة، الانتصار، الصمود، أطفال الحجارة، سجّل أنا عربي.. الخ.
"باب الشمس"، كان الباب الذي أظهر لنا، أو بالأحرى أظهر لي، فلسطين أخرى. فلسطين الناس، فلسطين التي فيها حكايات حبٍّ لا تنتهي، فلسطين المُعقّدة، فلسطين الأطفال الصغار والعائلات والعشّاق، فلسطين العادية الخالية من الشعارات.
يبدو لي أنّ تلك السنة (٢٠٠٤)، والسنة التي تلتها حملتُ انفتاحاً كبيراً على فلسطين. في تلك السنة أُنتج المسلسل الملحمي، التغريبة الفلسطينيّة، وصارتّ تصل إلينا أغنيات لريم بنا ولفرقة دام. صرنا نعرف، ولو بجزءٍ بسيط حكايات الناس الذين يبعدون عنّا كيلومترات قليلة، وتفصل بيننا حدود وجيوش واحتلالات وديكتاتوريات.
محمد الرومي: السينما دائمًا ضروريّة
07 كانون الثاني 2022
في الرواية/ الفيلم ظهرتْ لنا بلاد أخرى، بلاد تشبهنا. أشخاص يشبهوننا. يعيشون مثلنا. يُحبّون ويأكلون ويشربون مثلنا.
علّمتنا هذه الحكايات معنى أن نحبّ الفلسطينيين، لا أن نحبّ فلسطين الأرض فقط. أراد منّا نظام الأسد أن نحبّ فلسطين دون أهلها، أن نقدّسها، في الوقت الذي كان يعتقل فيه الفلسطينيين والفلسطينيات ويعذّبهم ويقتلهم ويحاربهم.
تعلّمنا من هذه الحكايات أنّ حبّ الأرض لا يعني شيئاً دون حبِّ الفلسطينيين. كانت جدّتي سلطانة، الأميّة والتي تحكي بالعربيّة بصعوبة، تقول إنّ الفلسطينيين يشبهون الأكراد، يحبّون الحريّة والرقص لكن أرضهم قد سُلبت منهم.
أتذكرُ وأنا أكتب قصةً حدثت خلال جلسة في البرلمان التركي، حين نطق النائب الكردي أوصمان بايدمر، النائب عن حزب الشعوب HDP، لفظ اسم" كوردستان" خلال مداخلته. تعالى الصياح الرافض بين النواب الجمهوريين ونواب حزب العدالة والتنمية، حتى سألت رئيسة الجلسة آنذاك النائب بايدمر باستعلاء: وأين تقع كردستان هذه؟ ردّ بايدمر (مشيراً إلى قلبه): هذا المكان نفسه هو كوردستان... كوردستان هنا.
أفكر وأقول لنفسي، كردستان هنا، وفلسطين أيضاً هنا (وأشير إلى قلبي). أفكّر أنّ هذا الكلام لن يفهمه أعداء الحلم والحبّ والحريّة.
في عام ٢٠١٣، بعد نشرِ الرواية بخمسة عشر سنة، أنشأ عشرات الشبان والشابات الفلسطينيين قرية في فلسطين لمواجهة الاستيطان الإسرائيلي في القدس، وأطلقوا على قريتهم اسم "باب الشمس". ربّما يكون هذا أكبر تكريم يحصل عليه كاتب في العالم. ما الذي يريده المرء من الكتابة أكثر من ذلك؟ أن تعيش حكاية الكاتب/ة في قلوب قرّائها، وحين يقومون بفعلٍ مقاومٍ في وجهِ احتلالٍ بغيض، يطلقون عنوان الحكاية اسمًا لفعلهم المقاوم. يا لجمال الأدب!
صبرا وشاتيلا
في عامي ٢٠١٢ و٢٠١٣ سكنتُ في مدينة بيروت، نجمتنا التي ضلّت الطريق. معظم الوقت كان بيتي في "الجبل الصغير"، في حيّ الجعيتاوي في منطقة الأشرفية، وكنتُ أعمل مع منظمات تُعنى بشؤون اللاجئين في مخيّمي صبرا وشاتيلا وتجمّعي سعيد غواش والداعوق الملاصقين للمُخيّمَين.
في تجمّع المخيّمات ذاك، تعلّمت أنّ فلسطين أكبر من حدودها، وأكبر من خيالي. شاهدتُ كيف تعيش فلسطين في قلوبِ أحفاد من تهجّروا في النكبة أو النكسة. شاهدتُ رجالاً ونساءً نجوا من نكبة، فنكسة، فحرب أهلية، فمذبحة صبرا وشاتيلا، فحصار المخيمات، فالعنصرية والكره، فالاعتقال والتعذيب، وما زالوا يحتفظون بحبِّ فلسطين.
كنتُ قد شاهدت فيلم "باب الشمس" عشر مرّات ربّما، وفي كلّ مرّة كانت الدقة منخفضة أو سيئة أو نسخة مقرصنة من مكانٍ ما موجودة في موقع إلكتروني غير معروف. لكن هذه المرّة، في صالة سينما أرسنال، في وسط برلين، في الساحة التي بُنيت بعد توحيد المدينة لتكون مركزها، تملكتني الصورة، تملّكني المكان.
وأنا أشاهد المشاهد الأولى للفيلم، حين تُظهر لنا عين الكاميرا حارات وبيوت مخيّم شاتيلا، سألتُ نفسي إن كان هذا الفيلم سبباً غير مباشر في ذهابي إلى بيروت وعملي مع الفلسطينيين/ات والسوريين/ات الذين لجؤوا إلى بيروت وعاشوا في صبرا وشاتيلا.
هل كان الفيلم الذي شاهدته للمرّة الأولى قبل عشرين سنة سبباً خفياً ومحرّكاً دفعني للذهاب إلى شاتيلا دون وعي مني؟
أقول ربّما كان الفيلم/ الرواية سبباً من أسباب تعلّقي، وتعلّق جيلي والجيل الذي يكبرني بمدينةِ بيروت، فصار عندنا ما يُمكن أن نسميّه "متلازمة بيروت". المقاطع التالية مقتطعة من نص كتبته سابقاً عن مدينة بيروت، تشرح ما أعنيه بمتلازمة بيروت:
«كبرت وأنا أستمع لـ"توت توت ع بيروت" ولـ "رمانه رمانه عخصري وكلاشينكوف بإيدي" ولـ"اشهد يا عالم علينا وعبيروت". كانت صورة بيروت في رأسي هي مدينة الثورة الحلم. مدينة الموت من أجل فكرة. مدينة كبر جيلي والجيل الذي يسبقني، ممن ينتمون إلى يسارٍ ما، على أسطورتها. بيروت النضال والحركة الوطنية واليسار والثورة. بيروت التي جمعت مثقفين وكتّاباً من سوريا ولبنان وفلسطين والعراق. كبرنا ونحن نحفظ أغنيات وقصائد خُلقت في زمن بيروت الحرب الأهلية وبيروت الاجتياح. كبرنا ونحن نحلم بأنّ نعيش في تلك المدينة وفي ذلك الزمان، حين كانت "بيروت خيمتنا". كبرنا ونحن نحمل "متلازمة بيروت" معنا».
«كبرنا واشتعلت ثورتنا، الثورة السورية، وصار جيلي فاعلاً فيها بشكل أو بآخر. حلمنا بأبو عمار"نا". كان أبو عمار غيفارا"نا". حلمنا بقائد مثله يمشي في مخيّمات بيروت، يقود المقاتلين ويحاور الأعداء وينتصر ويستسلم ويربح وينتهي ويعود لبلاده ويُحاصر في رام الله، لا يتنازل إلّا إن رأى مصلحة لشعبه. يقف في وجه حافظ الأسد ولا يخشى أحداً. قضيته بوصلته».
«لم نعثر على قائد ولم نعثر في بيروت على ثورتنا المشتهاة. اغتالت بيروت أحلامنا. الزمن تغيّر، ونحن بقينا حالمين بعالم أجمل. مرّة في بيروت كنّا نغني "اشهد يا عالم علينا وعبيروت"، الأغنية الأشهر لفرقة العاشقين، أنا ورامي سليمان وخالد بكراوي (الشابان فلسطينيان سوريان). لاحقاً قُتل خالد تحت التعذيب في أقبية مخابرات الأسد، ورامي مختف في تلك الأقبية منذ أكثر من سبع سنوات (صاروا إحدى عشر سنة الآن) وأنا نجوتُ بذاكرةٍ ثقيلة وقلب مقبرة جماعيّة ينام فيه الكثيرون ممن أحببتْ، وعلى أطرافه معتقل كبير يزوره الكثيرون من أصحاب القلوب/ المقبرة».
فيلم يسري نصر الله
في قاعة السينما هذه، في سينما أرسنال، شاهدت قبل سنوات، وبشكلٍ يومي لمدّةِ شهر أفلاماً مُرمّمة ليوسف شاهين. تذكرت ذهابي اليومي إلى الصالة وأنا أهمّ بمشاهدةِ "باب الشمس". تذكرت انبهاري ببعض أفلام شاهين التي لم أعرفها قبل تلك العروض، مثل فيلم "اسكندرية كمان وكمان".
في فيلم باب الشمس شاهدتُ روح يوسف شاهين تطوف فوق شاشة السينما. رأيت روحاً منه في بعض المشاهد، وخاصة مشاهد الجموع. رأيتُ بعضاً من جرأةِ شاهين وعدم خوفه من الصورة تنبعث من جديد مع مشاهد يسري نصر الله. أذكر أنّني سمعتُ نصر الله يقول في حوار ما إنّه تأثر بشاهين كثيراً، وهو الذي تتلمذ على يده.
أكتبُ هذا المقال وأنا أسترجع مشاهد الفيلم بعد مرور أسابيع على مشاهدتي الأخيرة له. أحاولُ أن أكتب نقداً موضوعياً للفيلم. حسناً، هناك بعض الأشياء التي لم أحبّها في الفيلم، مثل لهجة بعض الممثلين والممثلات. أيّ فلسطيني أو سوري، سيعرفُ مثلاً أنّ هذا الممثل مصري ويحاول الحديث باللهجة الفلسطينية، ويبدو أنّ المصريين لا يتقنون لهجات الدول الأخرى. لكن لا، من ناحية أخرى لا أشعر بأنّ هذا أنقص من قيمة العمل، ربّما العكس كان صحيحاً. ماذا لو كان كلّ الممثلين والممثلات فلسطينيين/ات؟ ربّما ساعد هذا التنوّع الفيلم (كاتبه لبناني ومخرجه مصري) ليقول لنا إنّ قصص الحبّ والمقاومة ليست فلسطينيّة فقط، بل تنتمي إلى كلّ البشرية، مثل أيّ حكاية عالمية، مثل حكايات ألف ليلة وليلة، تنتمي إلى العالم بأسره لا إلى جغرافيةٍ ضيّقة.
حكى لي أحد أصدقائي مرّة عن العلاقة بين باب الشمس وألف ليلة وليلة، قال إنّ شهرزاد كانت تحكي كي لا تموت، وإنّ خليل في باب الشمس كان يحكي كي لا يموت يونس، هكذا أبقت الحكايةُ الحياة حيّة. ربّما من أجل ذلك، وبعد أن مات يونس، وماتت شمس، وماتت نهيلة، بُعث خليل إلى الحياة مرّة أخرى، فرأيناه يسبح في الماء، ويُعمّد بماء فلسطين معلناً العودة، العودة إلى أرض نهيلة ويونس، إلى أرضِ حبيبته شمس، إلى أرض أمّه التي فقدها صغيراً، إلى أرض الحبّ، إلى فلسطين.
أنهيتُ الكتابة عند كلمة فلسطين في نهاية المقطع السابق. وحين أعدتُ القراءة شعرتُ بأنّ هناك نقص ما في النهاية. يحتاج هذا النص إلى نهاية ما… لكنّ، ربّما لا يحتاج كلّ شيء إلى نهاية. ربّما هناك أشياء لا نهاية لها، مثل حبّ يونس لنهيلة، مثل حب خليل ليونس، مثل حبّ أم حسن لفلسطين.