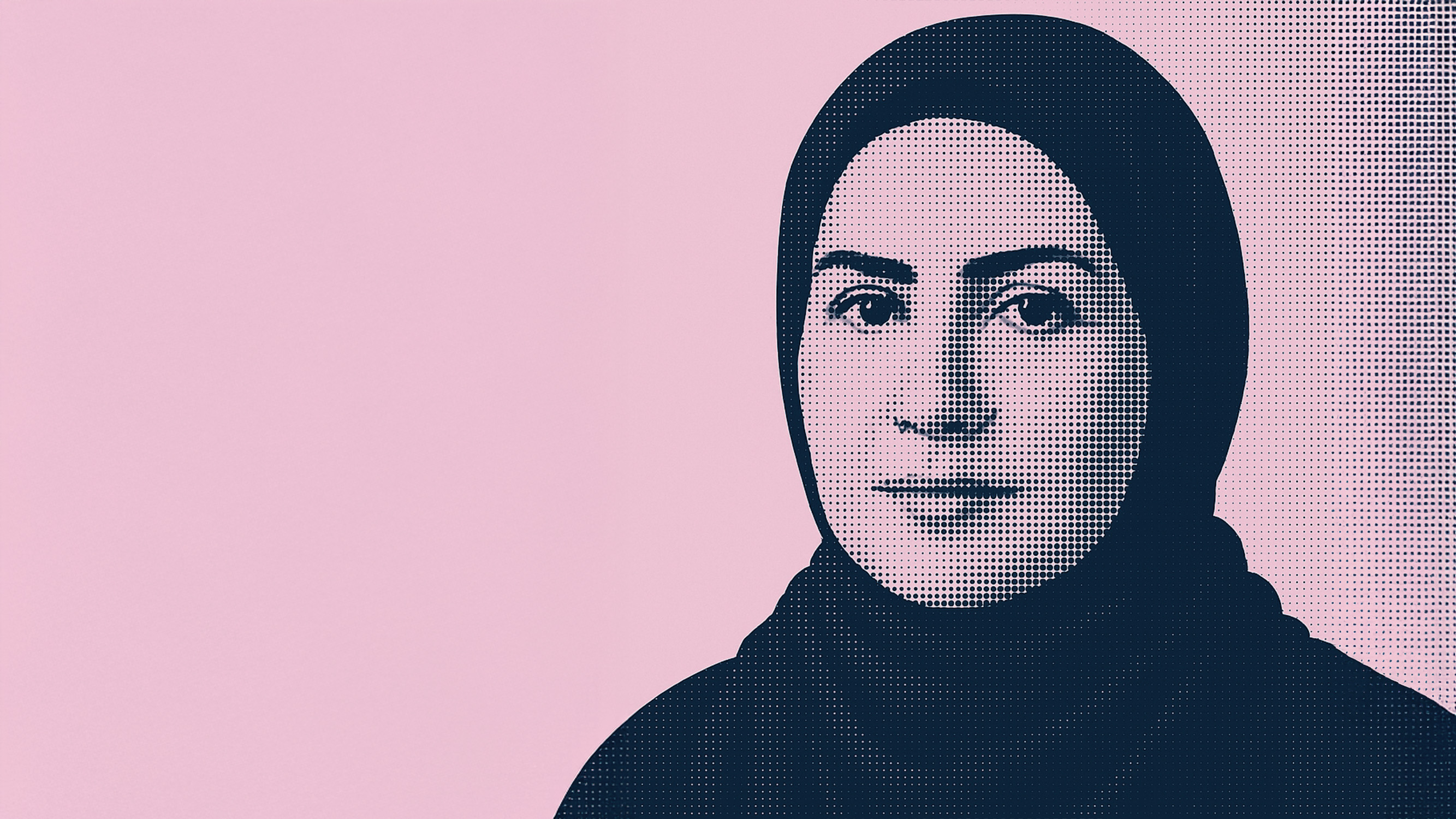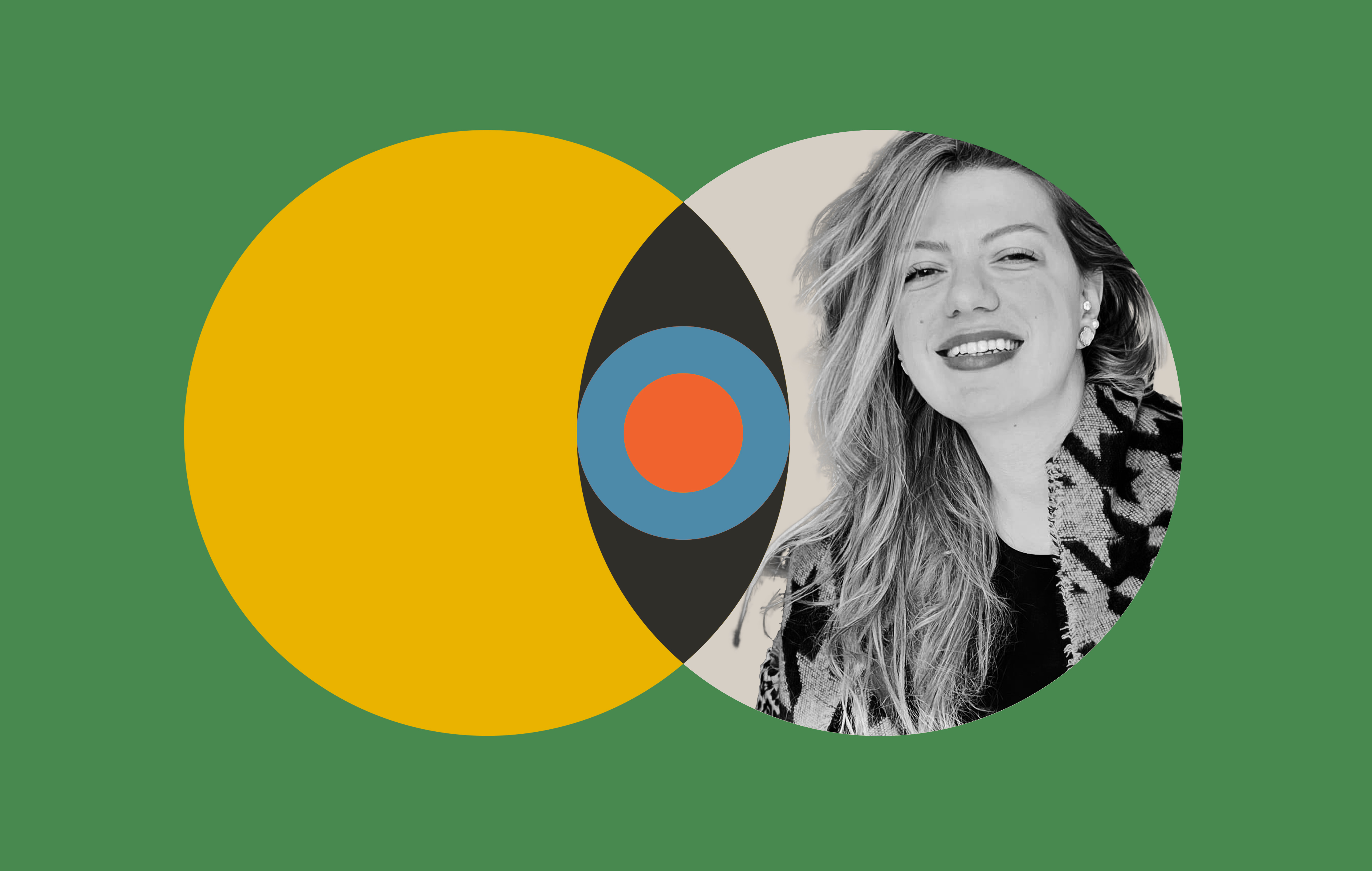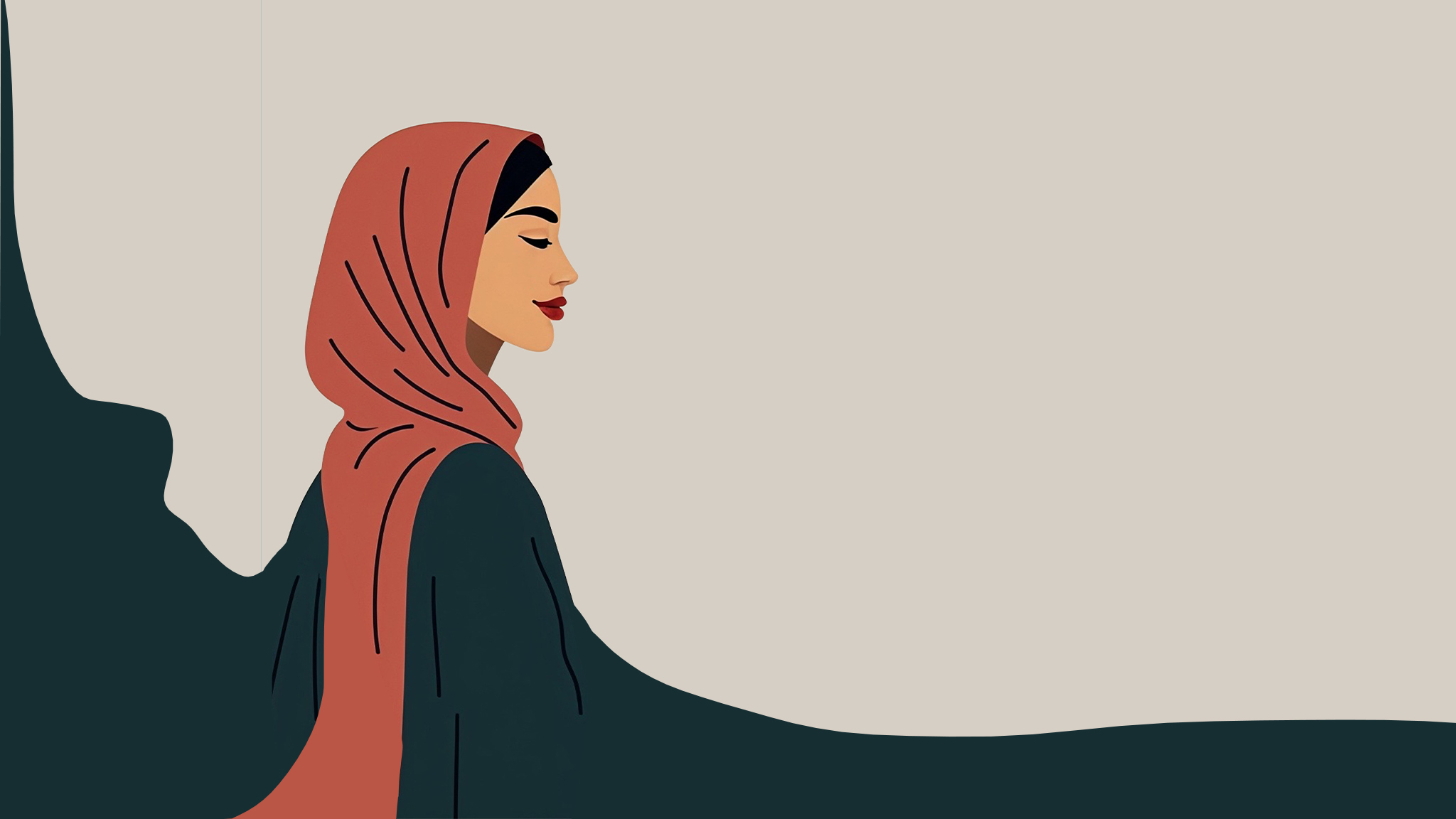"شعرت ببردٍ شديد ودفنت نفسي في الأغطية رغم حرّ الصيف، فلا شيء بعد فراق ابني يدفئني. أراه في كل مكان، وما زلت إلى اليوم أجمع أشياءه، جلاءاته المدرسية، وملابسه." هذا ما تقوله هدى عن ابنها الذي استشهد على يد داعش. امرأةٌ لا تطالب بلقب "أم شهيد"، ولا ترفع صورة ابنها فوق كتفها، بل تحتفظ بها قرب وسادتها. وهي واحدة من آلاف الأمهات اللواتي لم ينصفهن الإعلام ولا منحهن الوقت الكافي للحزن.
في سياق الحرب السورية، لم تَسْلَم صورة "أم الشهيد" من التوظيف الرمزي. فوفقاً لدراسة شبكة الصحفيات السوريات، غالباً ما قدّم الإعلام المعارض الأم بوصفها تمثيلاً للتضحية الصامتة، يضعها في موقع الفخر لا الألم، بينما تُختزل معاناتها في سردية الفقد البطولي. أمّا الإعلام الرسمي حسب الدراسة نفسها، فقد أعاد إنتاج صورة الأم "الوفية للوطن" بينما سكتَ عن أمهاتٍ فقدن أبناءهن على يد مؤسّساته (في السجون والمعتقلات).
لا يُنكر هذا الخطاب الإعلامي الألم بقدر ما يُفرّغه من سياقه الإنساني؛ إذ يتم تجميله ليخدم الرواية السياسية لا الفردية. هُنا تكسر السيدة زهور، أمٌّ لثلاثة "شهداء" هذا الإطار، وتعيد الحزن إلى مكانه الطبيعي.
تَحدثنا مع السيدة زهور من سراقب عبر تطبيق واتساب. نسّقت في صورة حسابها وجوه من رحلوا عنها، أبنائها الثلاثة وزوجها، كأنها تُحاول أن تُبقيهم مجتمعين، ولو افتراضياً. صوتها كان خافتاً، لهجتها إدلبيةٌ ثقيلة، وفيه نبرة نساءٍ تجاوزن الخمسين واحتملن أكثر ممّا يُحتمل.
تستحضر تلك الصورة الرقمية مباشرةً لوحة "أم الشهيد" للفنان يوسف عبدلكي؛ الوجه المحفور بالتجاعيد، والعينين الغارقتين في الحزن مع صور الأحبّة معلّقةً على جدار.
بعيدا عن عيون داعش.. التعليم سرًّا
16 تموز 2025
من منزلها في سراقب، بعد سنواتٍ من التهجير، روت لنا زهور كيف خرجت تحت القصف في عام 2014، "طلعنا ومو آخدين معنا غير عِزبة خفيفة." لتستقرّ في مخيم قورقنيا شمال غرب إدلب ولتعود إلى حيّها في سراقب بعد سقوط نظام بشار الأسد بشهر. حين عادت، لم تجد في البيت إلا الجدران والسقف، وقالت بمرارة: "تعالي شوفي بَرِكْتي، ما ضلّ لا شبابيك ولا بواب ولاشي."
في عام 2012 فقدت أحمد، أصغر أبنائها، وكان في السابعة عشرة. بعدما خرج مع رفاقه لمنع أرتال الجيش من دخول المدينة. "اتصلوا عليّ إنه ابنك متصاوب بالمشفى، طلعت وصرت اركض، وكل ما اركض يطول الطريق أكتر حتى وصلت خالصة من التعب، بعد نص ساعة خبرني الدكتور إنّه استشهد."
ابنها الثاني، حسن، كان طالباً في كلية الشريعة. كانت كلّما سألَته، يجيبها مطمئنًا: "ما عم فوت على معارك، أنا بالإمداد بس". لكن قلب الأم لا يُخدع. وفي إحدى المرات طال غيابه، فتحت هاتفها ووجدت صورته مرفوعة على الفيسبوك: "شهيدًا في قرية كوكب في ريف حماه عام 2016". الشاب الذي أخفى عنها رصاصه، لم يُخفِ نفسه عن الموت. كان "انغماسياً"، في الصفوف الأولى.
والثالث، محمود، كان متزوجًا وله ابنةٌ صغيرة. أصيب عدّة مرات، وفقد سمعه في إحداها، لكنه ظلّ يخفي معاناته كي لا تُفجع والدته. طلب من رفاقه ألا يُخبروها بأيّة إصابة، قائلاً: "إذا ما شافتنا بعينها... بتهبل". التحق بأخويه في العام 2022 في ريف حماة.
بصعوبة، استرجعت السيدة زهور ذكرياتها مع أبنائها كيف كانوا يوقظونها للسحور، يضحكون، و"يدللونها". قالتها باللهجة نفسها: "كانوا حنونين عليّ... كبرت معن، بس راحوا قبلي".
غاب الصوت الشخصي للأمهات في التقارير الإعلامية لإعلام المعارضة، ففي تقرير بثّته قناة "الغد العربي" عام 2014 بمناسبة عيد الأم، تظهر "خنساء المعرّة"، التي فقدت اثنين من أبنائها، كرمزٍ للصبر الجمعي، فيما تُطغى على الحكاية لقطاتٌ احتفالية بعيد "ثورة الشعب". الأم، في هذا السياق، لا يُحتفى بألمها بل بـ "دورها التعبوي"، وتُختزل إلى تمثالٍ صامت في مسرحٍ وطني، تتكلّم الكاميرا فيه بدلًا عنها.
على الجهة المقابلة من الحرب، لم تكن صورة "أمّ الشهيد" الموالية أكثر إنصافاً. فالإعلام الرسمي بدوره، كما توضّح دراسة شبكة الصحفيات السوريات، أعاد تشكيل الأم في قالبٍ دعائي، يجعل منها صوتاً تعبوياً يحثّ أبناءها على القتال، ويحتفي بصلابتها من دون أن يلامس هشاشتها.
وبينما وجدت زهور نفسها تحت علم المعارضة، كانت فاطمة (اسم مستعار) تحت علم النظام السابق. علمان مختلفان، وخطابان متناقضان، لكنّ كلتيهما تعرّضتا لتجميل المعاناة وتجاهل السؤال الأعمق: كيف تعيش أمٌّ بعد أن تنهكها الحرب في أولادها؛ في بلاد تُرفع فيها الصور على جدران العودة، وتُخفى في أخرى حفاظاً على من لم يُقتَل بعد من الأبناء؟!
لوحةٌ أخرى لعبدلكي تتبدى أمامنا. عبدلكي، الذي قال في حوار سابق مع حكاية ما انحكت، حول ألم الأمهات "تخيل "أمٌّ"، لديها ولد شاب في عمر الورد وعلى درجةٍ من البهاء والجمال والطموح... ثم خرج في مظاهرةٍ جرت في حارته، ولم يقل سوى كلمة واحدة خفيفة ويتيمة، كلمة من أربعة أحرف: (حـ .. ـر .. يـ .. ـة!) ثم يعود إليها جـ .. ـثـ .. ـة ها .. مـ .. ـد .. ـة .... هل تتخيّل درجة ألم الأم التي سيستمر معها حتى آخر يوم من حياتها. لا علاقة لهذا بالسوريالية. منذ اثنتي عشرة سنة وأنا أرسم لوحات الأمهات. أعتقد أنّ هذا الألم الذي سبّبه استشهاد الأبناء سيظل.. ويظل.. حتى قبورهنَّ. هذا الشيء، سمِّه ما شئت، لا أقدر على ابتلاعه، بل هو يبتلعني ويبتلع كلّ صرخة كتومة فيَّ... بغض النظر عن الرسم (يلعن ... الرسم). أنا كإنسانٍ لا يمكنني ابتلاعه، أعتبرهُ جريمة".
كيف تعيش أمٌّ بعد أن تنهكها الحرب في أولادها؛ في بلاد تُرفع فيها الصور على جدران العودة، وتُخفى في أخرى حفاظاً على من لم يُقتَل بعد من الأبناء؟! لوحةٌ أخرى لعبدلكي تتبدى أمامنا.
على خلاف زهور، يظهر الحزن واضحاً على فاطمة؛ خاماً، ثقيلاً، متكرّراً، ومن دون مقابل. حين تحدّثنا إليها عبر اتصالٍ هاتفي، جاء صوتها واهناً، لهجتها الساحلية رخوة متعبة، تختلط فيها نبرات الأمهات المتقدّمات في العمر، ممن كبرن في الزمن والحرب معاً. في كلّ جملة، كانت تُمسك أنفاسها كمن يسحب ذاكرةً مؤلمة من عمق صدره.
روت لنا قصة ابنيها، اللذين قُدّر لها أن تشهد موتهما البطيء. بطءٌ قاتل تستعيده وكأنه يحصل تواً. قالت: "باسل اتصل فينا إنه نازل إجازة، وقال بدنا نتغدى عندْكِن ورق دويلي. قلت لبناتي لفوا الورق، يمكن خيكن يوصل بكير... ما وصل". ثم تتابع بصوتٍ خافتٍ متهدّج: "ضلّ محاصر ببناية محروقة... الساعة عشرة الصبح بلّش يتصل بوحدته، برفقاته، بخيّو، بس ما حدا كان فيه يساعدوا".
يوم كامل من الانتظار، والوعود، والخوف، ثم انقطع الاتصال. تقول: " تاني يوم الصبح الساعة سبعة دقّ التليفون، قال لي: إنتِ أم باسل؟ ... قلت له: إي أنا أم باسل." ولم يعُد باسل.
استنزفتها وفاة باسل، لكنها تهمس أنّ فقدان مازن كان أصعب. تتذكر ليل رأس السنة كيف صوّر لها طاولة العشاء وهو يشير إلى الطعام الذي يتناولونه: "كانوا قاعدِين وعم يمزح... قال لي هاي من الجيش السوري (يشير إلى الأطباق) وهاي من حزب الله، أكِلْنا بس بطاطا وبيضة." ثم تضيف: "تصاوب، وضلّ بالمشفى شهر وخمسة أيام. عمل شي 3 عمليات. آخر مرة شفتو طلع فيني، وقال لي: أمي، ليشت عذبتي حالك وإجيتي، قلتلو واللّه شوفتك بالدنيا."
هل مازلنا نُقدّم صورة حالمة عن المرجلة؟
13 آذار 2025
لم تكن إصابته قاتلة، لكن مازن لم ينجُ بسبب سوء الرعاية الطبية والإهمال، رحل مازن وترك ندبة جديدة في قلب أمّه. وعلى عكس الخالة زهور التي قالت: "اللي بواسيني إنّه انتصرنا"، قالت الخالة فاطمة: "راحوا عالفاضي". لا شيء يواسي الخالة فاطمة.
صورةٌ مختلفة تماماً لـ"أم الشهيد" قدّمتها وسائل الإعلام الموالية في تقاريرها الأولى عن الحرب في تقرير للميادين من بدايات الحرب السورية، تمّ توظيف صورة أم الشهيد بشكلٍ واضح لتعزيز خطاب الولاء والصمود والتحشيد. ظهرت الأم وهي تعبّر عن حزنها العميق وفقدها المؤلم، لكن في الوقت ذاته يعلو خطابها بالدعاء والصبر والتشبّث بالأرض، كأنّ الألم شخصي لكنه ينسجم مع واجبٍ وطنيٍّ مقدّس. أظهر ذلك الخطاب الإعلامي الموالي للنظام السابق كيف استُغلّ وجع الأم لتثبيت فكرة التضحية من أجل الوطن، وتبرير استمرار الصراع تحت شعار "الثبات مهما كلف الثمن".
في الإعلام الرسمي والمعارض، كثيراً ما استدعيتْ صورة الأم بوصفها تجسيداً للفداء. لكن عندما كان الابن مُعتقلاً، مجهول المصير، تحوّل حضور الأم إلى ظلٍّ صامت، أو يُقصى تماماً عن المشهد. وفقاً لما كشفته دراسات نقدية لخطاب الإعلام السوري، فإنّ تمثيل أمهات المعتقلين يفتقر إلى العمق والاعتراف، ويُختزل في صور البكاء. خلف هذه الفجوة الإعلامية، تعيش أمهات مثل السيدة مزكين؛ لا يعلمن متى فُقدت آثار أبنائهن، يسألن سؤالاً واحداً: كيف ماتوا؟
بدأت السيدة مزكين، والدة الشهيد المُعتقل محمد النابلسي، كلامها في اتصالٍ هاتفيّ مع حكاية ما انحكت، بوصف ما رأته في مشفى ابن النفيس في دمشق، "كانوا يملؤون الأقبية بالجثث، ثم يأخذونها ليدفنوها في مقابر جماعية". كانت تروي امتداداً لما عاشته بعد حين، عن أمنية أن يكون لابنها المِرْضي قبر، تزوره وتترحّم عليه. ابنها الذي اعتُقل تعسفياً بلا تهمةٍ ولا نشاطات سياسية، اُعتقل بتهمة النخوة والإنسانية، عندما سألهم وهم يعتقلون جاره "لماذا تعاملونه هكذا؟"
"قلنا لحالنا شغلة أسبوع أو أسبوعين بيطلع، ما فكرنا إنه بحياتنا ما بقا نشوفو." قالت السيدة مزكين.
عرفت بوفاته بعد رؤية صورته في ملفات قيصر، لكنّ الإشاعات لم تكن رحيمةً على قلبها فبدأت تعرض صورته على خبراء الفوتوشوب وتسأل هنا وهناك بلا أيّ جواب. ابنها محمد الذي اعتقل في 2013 توفي حسب سجلات سجن صيدنايا تحت التعذيب في عام 2015.
"كل شي بتمناه أعرف كيف قتلوه". روت لنا السيدة مزكين بنَفَسها الدمشقي القوي قصّة ابنها اللطيف الذي لم يؤذِ أحداً يوماً، وعن إيمانها عندما صلّت ركعتي شُكر عندما وصلها خبر استشهاده بعد عامين من الاعتقال. "الحمدالله يا خالة إنّه ما تعذب كتير بين إيديهم."
في زاويةٍ أخرى من الخريطة السورية، وفيما برزت المقاتلات الكرديات كرموزٍ للتحرّر والصمود، بقيت وجوه الأمهات خلف الكاميرا. من بينهن السيدة خولة (اسم مستعار)، التي لا تروي فقط ألم الفقد، بل ألم النسيان.
في محادثةٍ على تطبيق واتساب تحدثنا إلى السيدة خولة التي روت لنا قصتها. من عفرين إلى حلب، ثم الحسكة، خاضت خولة رحلة نزوحٍ طويلة أنهكت جسدها، ورافقتها خسارة أبنائها. بدأ الشعور بالفقد لابنها في عام 2014، الذي لم تره لعشر سنوات، سوى لمحةٍ خاطفة في حلب أو "شهبا" كما كرّرت التسمية قبل استشهاده بأيام. فخورةً به كانت، لكنها حين زارت قبره عام 2023، بعدما هدأت المعارك، كسرتها تلك الزيارة وبدأ بعدها المرض ينهش جسدها.
قالت: "فدا الأرض يا بنتي، الأرض أهم من الولد، الولاد متل الورود بنزرعها لنقدمها للوطن"، ثم أضافت بصوتٍ مكسور: "بس خسارة الضنى مو سهلة، والله حرقوا قلبي."
أظهر ذلك الخطاب الإعلامي الموالي للنظام السابق كيف استُغلّ وجع الأم لتثبيت فكرة التضحية من أجل الوطن، وتبرير استمرار الصراع تحت شعار "الثبات مهما كلف الثمن".
لم تنتهِ الحكاية هنا. ابنتها الصغرى، التي حملت السلاح في سن الـ 15، بقيت بعيدةً عنها ثماني سنوات. سمعتْ صوتها في مكالمةٍ قصيرة، قالت فيها إنها ذاهبة في مهمةٍ إلى جبل قنديل. وهناك، رحلت في سن ال22 إثر قصفٍ جوي. قالت خولة: "الحمدالله اللي استشهدت وما وقعت بين إيديهم يا بنتي"، ثم وصفتها: "كانت متل الفراشة، حكولي عنها رفيقاتها إنّها كانت تحب القراية، وتقضي وقتها بين الشجر وإنّه كان عندا فكر وذكية."
بعد الفقد الثاني، لم تعد خولة قادرةً على حمل الذكريات. انقطعت للحظاتٍ عن الحديث، ثم أرسلت رسالةً صوتية قالت فيها: "كنت عم دخّن... بشرب سيجارة بتجمع أفكاري". تحارب النسيان بالحبوب، وتتردّد على الأطباء، لكنها لا تفارق صور أولادها. شاركت معي صور أبنائها، راقبتها طويلاً وتأمّلت في صورة ابنتها الشابة؛ تلك الشابة صاحبة العينين المتعبتين والابتسامة الجميلة لم تعد معنا اليوم.
خلف هذا الصوت الشخصي، تظهر حدود الخطاب الإعلامي في تمثيل الأمومة ضمن السياق الكرديّ. فكما في تقرير نشرته وكالة "هاوار" عام 2024، يُلاحظ حضور الأمهات ضمن سرديةٍ نضالية واضحة، حيث تُقدَّم مشاركتهن في الحيز العام باعتبارها امتداداً لدور أبنائهنّ في الجبهات.
غالبًا ما تظهر الأم بصفتها صوتاً داعماً للمقاومة، يتحدث من موقع الفخر والاستمرارية. هذا النوع من التمثيل لا ينكر الخسارة، لكنه يعيد توظيفها ضمن خطابٍ تعبوي يُركّز على المعنى الجمعي للتضحية.
شهادة خولة لا تُعارض هذا الخطاب بشكلٍ مباشر، لكنها تكشف بُعداً مغيّباً فيه وهو لحظة ما بعد التشييع، عندما تنحسر اللغة العامة وتبقى تفاصيل الحياة اليومية، والصمت، والانقطاع المؤقّت عن الكلام. وهو بُعد لا يحضر كثيراً في التغطية الإعلامية، رغم مركزية الفقد في التجربة الأمومية.
التمييز ضدّ النساء الحوامل
29 تشرين الثاني 2024
في ختام الرحلة بين وجوه الأمهات، التقيت بهدى، وهي الأم الأخيرة التي تحدّثنا معها عبر تطبيق واتساب، والتي طلبت ألّا يُذكر اسمها احتراماً لكلّ أمهات الشهداء في هذه البلاد. روت لنا تفاصيل حياتها وكيف تعيش وكيف تعمل لتحلّ مشاكل أسرتها العالقة، وقصّة استشهاد ابنها ذي ال19 عاماً على يد داعش.
قالت: "كان متفوق بدراسته، كنت مستنية يكبر وشوفو ضهر استند عليه بالحياة." وأخبرتني عن يوم استشهاده "رأيته في منامي، يزورني بعد مدّةٍ طويلة من الغياب يحمل حقيبته السفرية ويقول لي لقد عُدت إلى المنزل يا أمي. استيقظت وأنا أشعر أنّ شيئاً كبيراً ينقصني، حاولت أن أذهب من الحسكة إلى كوباني لأسأل عنه إلّا أنّ مرض زوجي منعني من الحركة. في اليوم التالي زارتني أمي وأختي حينها تأكدت أنّه رحل... أتذكر كيف كان ينظر إلى السماء ويراقب النجوم في مساءات الصيف، وقتما افترشنا السطح، أتذكره وهو يشير إلى النجوم ويسألني إن كان يسكنها أحد، وإن كان الأموات يروننا من الأعلى، أتذكر بكاءه على وفاة والدة شخصية كرتونية في التلفاز. أنظري كيف تتلاعب الأقدار بنا، هو رحل وأنا بقيت حيّة."
ابنها الشاب اختار هذا الطريق ربما لأنّ ظروف الحرب لم تخلق له خياراتٍ أفضل، فقد اختار أن يكون مقاتلاً ليحمي حيَّهُ أولاً، ثمّ ليدافع عن شعبه وبلاده، لكنّ هذا القدر آلم وما زال يؤلم هدى. "تمنيت لو أنّه عاش متل كل هالشباب، يحمل موبايل ويعيش حياته، بس هيك قدرنا." عشر سنوات من الفقد غيّرت الكثير في حياة هدى التي أكدت لي أنّ لا شيء يعود كما كان بعد فقدان الابن.