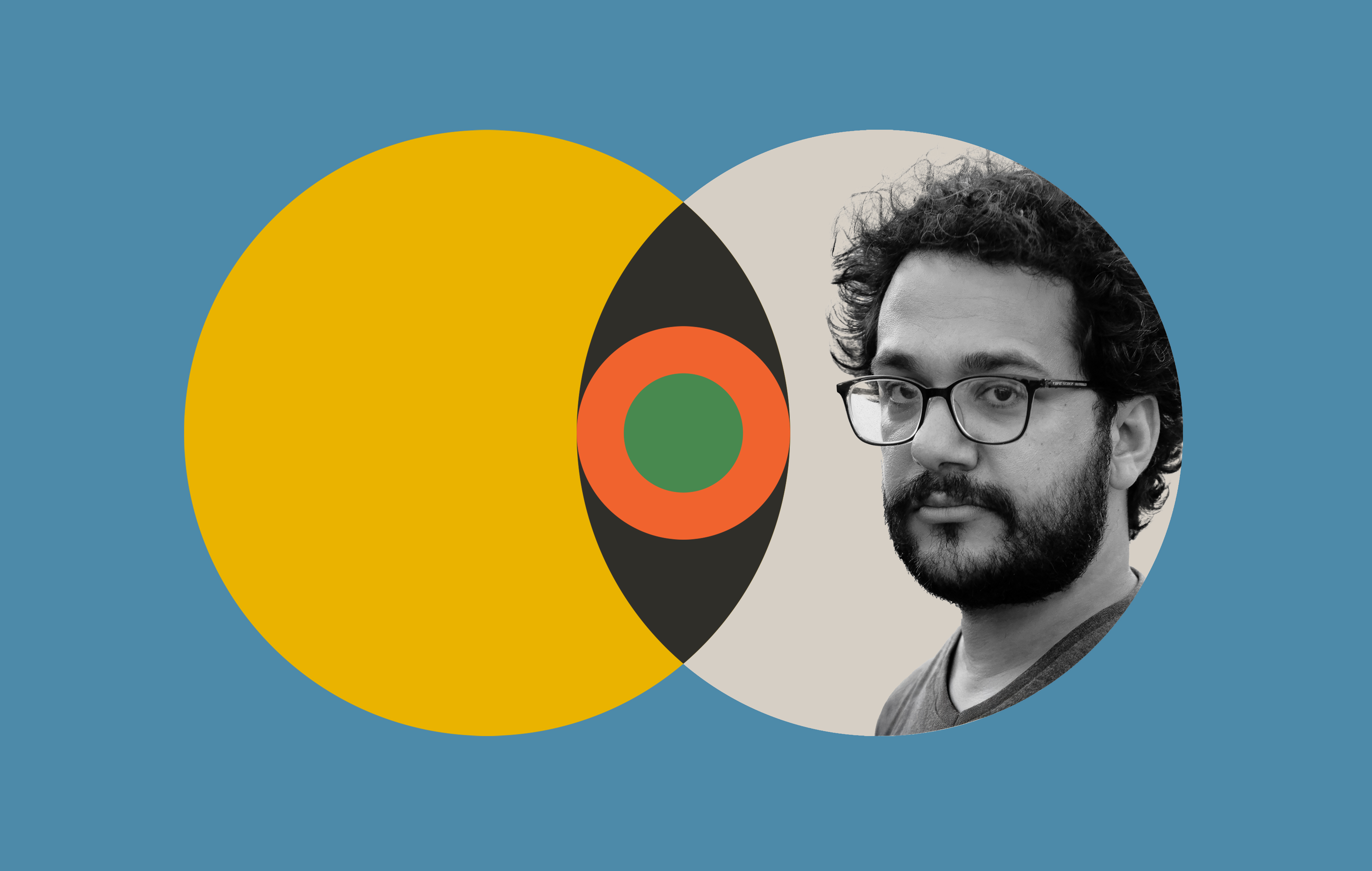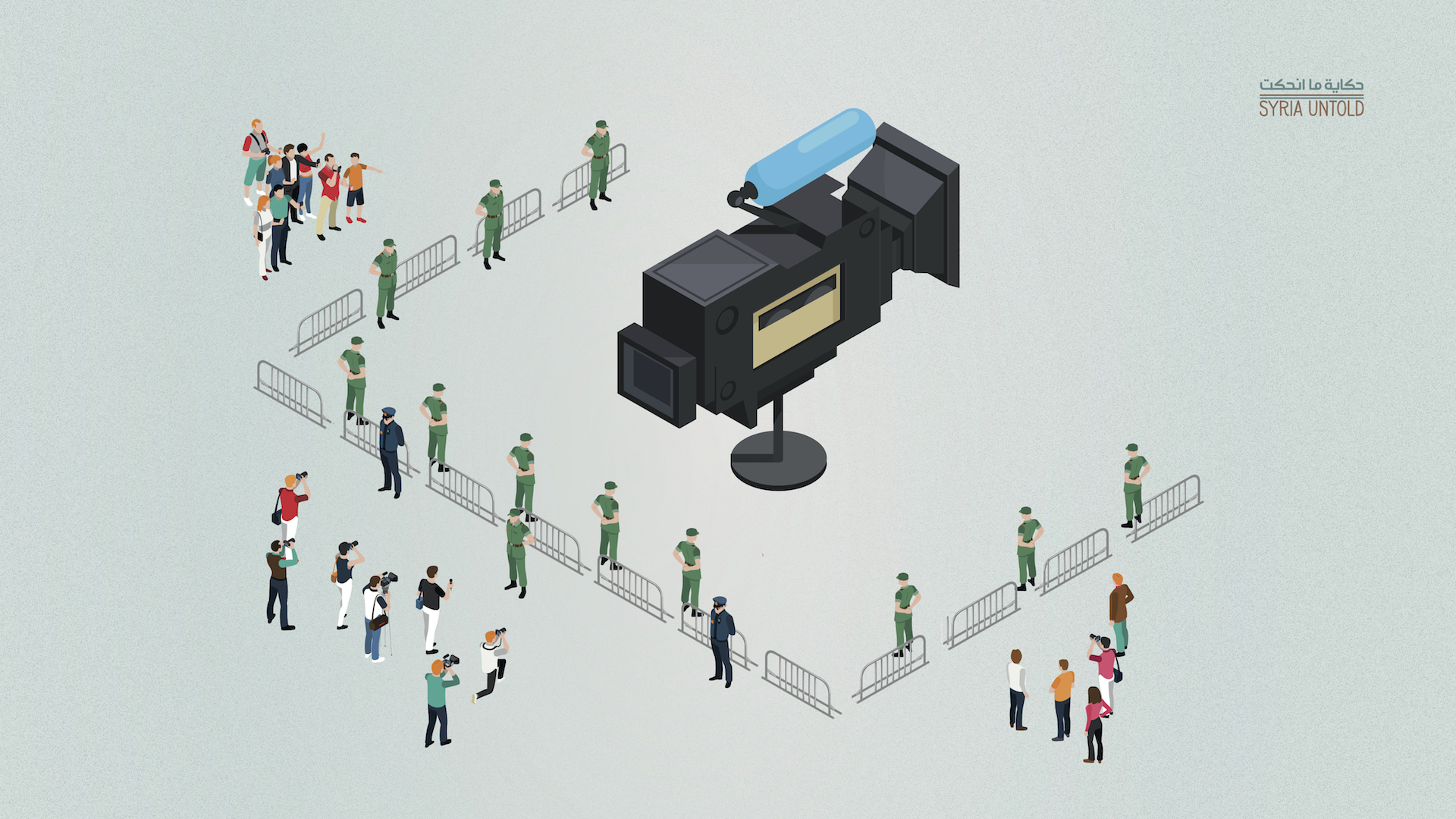مادونا أديب، مخرجة وناشطة سوريّة مقيمة في بيروت، درست الفنون الجميلة في جامعة دمشق، وحصلت على بكالوريوس من جامعة كونكورديا في كندا (مدرسة ميل هوبنهايم للسينما). منذ عام ٢٠١٧، تعالج في أعمالها الفنية، متنوّعة الوسائط، العلاقة بين الجسد والأنوثة والكويرية. مادونا ناشطة داعمة أيضاً لمجتمع الميم عين لام، داخل سوريا وخارجها.
في هذه المقابلة نعرج على فيلمها الوثائقي القصير "رقصة لأجل عيوني"، المشارك في مهرجاني بالم سبرينغس و إدفا، والذي يدور حول القمع السياسيّ والاجتماعيّ الذي عاشته في طفولتها، وفيلم "بين هنا وهناك" الذي تعمل على عمليات ما بعد إنتاجه، ويتعلق بحياة نساءٍ سوريات من مجتمعاتٍ سورية متوازية، مختلفة الظروف، وفيلمها الأخير "ليلة"، المعروض حديثاً على تلفزيون آرتيه الفرنسي الألماني، وأخيراً عند واقع المجتمع الكويري خلال الثورة وفي الأثناء.
عزيزتي مادونا، أهلا بك في هذا اللقاء مع سيريا أنتولد، الذي نتوقف فيه عند فيلمك الأخير "ليلة"، الذي بدأت شبكة آرتيه بعرضه مؤخراً، وكذلك عند مشاريعك السينمائية السابقة، ونشاطك في دعم مجتمع الميم عين لام السوري. بداية، نفضّل أن نترك لك تعريف المتابعين/ات بنفسك.
شكراً. أنا مخرجة سورية نسوية كويرية، مهتمة بالعمل عن الجسد، تحديداً جسد النساء والكوير من سوريا، لأنني اعتبر الجسد انعكاساً للواقع الاجتماعي، ويحكي قصة المكان، كيف تتقبل المجتمعات المختلفة الجسد، سواء أكان ذلك في المنطقة، أو من الناحية الدينية أو الاجتماعية، فاهتممت بالعمل على ذلك منذ سنوات.
نودّ لو نعرف مدخلك إلى عالم السينما في سوريا، وهي البلد الفقير سينمائياً، يُنتج فيها عددٌ قليل جداً من الأفلام، وكانت تخضع للرقابة في عهد النظام السابق، ولم يكن هناك بيئة سينمائية محرضة على المشاركة..
لم يكن هناك حدثٌ ما، بل كان الأمر تراكمياً، السؤال بالنسبة لي هو كيف بدأتُ التفكير على هذا النحو؟، إذ ليس هناك أمرٌ أو حدثٌ ما أثر فيّ، بل تأثرتُ بفنانين/ات من مختلف المجالات، ليس مخرجين فحسب، كما أن ما شكّل محتوى أعمالي هو تغيير وعيي السياسي مع الوقت. درستُ الفنون الجميلة في جامعة دمشق، قسم الحفر، فكنت أعمل يدوياً، ثم بدأت بالتصوير الفوتوغرافي لسنوات بكاميرات قديمة، وقمت بتنفيذ ورشات فيديو آرت، واهتممت بالصورة المتحركة وتحريك اللوحات، فدرست السينما، تحديداً اختصاص الأنيمشن، في مونتريال، كندا، ثم قمت بمزج الأنيمشن مع التصوير التمثيلي (لايف أكشن)، بعدها بدأتُ بالاهتمام بالسينما الوثائقية.
هذه الرحلة هي التي ذهبت بي إلى ما أنا عليه. إذ لم أكن أشاهد في سوريا على التلفزيون أو في السينما أفلاماً جعلتني أفكر بالرغبة في صناعتها.
لا أتذكر أول فيلمٍ شاهدته مثلاً. بعد مضي وقتٍ طويل، بدأت أهتم بالسينما الوثائقية أكثر من السينما الروائية. الأمر بالنسبة لي بأن هناك الكثير من الكوارث في هذا العالم التي يجب أن نتحدث عنها.
ولكن في النهاية، محتوى الموضوع المطروح هو الذي يحدد الوسيط الفني المناسب له، سواءٌ أكان وثائقياً أم روائياً لكن عموماً، لا أعرف كيف بتُّ هنا. في الحقيقة عندما بتُّ أعرف ما الذي أريد قوله سياسياً، بدأتُ أعرف كيف سأقوله، أنا شخصٌ بصريّ، أتلقى المعرفة ليس عبر القراءة فقط، لذا فالفنون البصرية هي الاختيار الذي أتوجه إليه تلقائياً.
بالحديث عن طفولتك والجسد، لنتحدث عن فيلمك الوثائقيّ القصير الأول "let my body speak"، الذي تعالجين فيه فترة الطفولة والمدرسة، والتراوما التي مررت به، كشأن آخرين، في المدارس البعثية ..
في "رقصة من أجل عيوني"، أحكي عن القمع السياسي والاجتماعي للجسد في سوريا، في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، ولجسدي على نحو خاص، لأن الجسد، كما قلت، يحكي قصة المكان والمجتمع، حرية الجسد تأتي بدايةً من حرية المجتمع. فعندما اتحدث عن مجتمعٍ لا يتقبل جسمي وأجسام الكثير من الناس، هنا تبدأ القصة كقضيةٍ خاصة، لكنها في الوقت نفسه قضيةٌ عامة، حيث أؤمن عموماً بأن العمل السياسيّ الخاص هو بالنتيجة عام.
أعتقد بأنني خسرت الكثير من الأشياء في سوريا، لكنني كسبت نفسي في النهاية. خروجي من سوريا مزّقني من ناحية، لكنه أراحني من ناحيةٍ أخرى.
تقولين في الفيلم "بعد مغادرة بلدي، جسدي هو موطني الوحيد". يتمّ ربط الوطن عادة بمنطقة جغرافية، هل خروجك من سوريا "حررك"؟
في هذا الفيلم أتكلم عن استرداد ملكية الجسد من مجتمعٍ ذكوريٍّ وقمعي، سياسياً واجتماعياً، وقد صوّرته بطريقة بوديسكيب (أسلوبٌ يلتقط شكل الجسد عن قرب، ويركّز على المنحنيات) فالكاميراً تمرّ ببطء وبقربٍ شديدٍ من الجسد، ليعطي إيحاءً وكأنه أرضٌ أو سهل. أعتقد بأنني خسرت الكثير من الأشياء في سوريا، لكنني كسبت نفسي في النهاية. خروجي من سوريا مزّقني من ناحية، لكنه أراحني من ناحيةٍ أخرى.
في الفيلم الوثائقي الذي تعملين عليه "بين هنا وهناك"، تواصلين العمل على ثيمة استعادة السيطرة على الجسد، في عوالم متوازية، بيئات مختلفة..
أعمل على هذا الفيلم منذ العام ٢٠١٨، وكلما توقفتُ وهممت بالعمل على المونتاج، أعود إلى التصوير مجدداً. قررت مؤخراً أن أتوقف عن التصوير فعلاً، لكن جديداً حدث مرةً أخرى، وصورتُ. آمل أن تكون هذه نهاية التصوير فعلاً. عند تصوير الفيلم الوثائقي الطويل، الشخصيات هي من تقودك، أذهب إلى التصوير معتقدة بأنني أعرف ما ستقوله، لاكتشف بأنني لا أعرف حقيقة، وهو ما أحبه في السينما الوثائقية، إذ أفكر، إن كنت أعرف ما الذي سأقول، سأكتب مقالاً.
في هذا الفيلم لا أحكي عن تجربتي الشخصية، ولكن هناك بعض التوازي في التجربة بيني وبين الشخصيات الأخرى، هن نساء من منطقة مختلفة من سوريا، لهن تجربة مختلفة. منذ العام ٢٠١٨، تغيرنا جميعاً، كنا نحكي بطريقةٍ مختلفة، وتغيرنا، وتغيرت ظروفنا، وسافرنا مراراً.
حدث تغييرٌ في الخيارات الفنية أيضاً. عندما بدأتُ، كنت مهتمةً بالجانب الجمالي من العمل، آخذ لقطاتٍ جميلة، وأصور مع مديرة تصوير، وكانت الظروف مواتية لذلك، في الأثناء اهتم بالقصة، وأشعر بأنه إن كانت القصة جميلة، لا يهم مهما كانت جودة الصورة سيئة. لذا صورت بعدة كاميرات وأحياناً بكاميرا موبايل، كذلك استعين بأرشيف الشخصيات المنزلي. الفيلم في الأثناء بات خليطاً من الناحية البصرية ومن ناحية المحتوى.
يتمحور فيلمك الأخير overnight/ ليلة، حول شابةٍ عائدة إلى سوريا مع بداية اندلاع ثورة ٢٠١١، كما فعل العديد من الناشطين/ات في الغرب، هل لك أن تقدمي الفيلم باختصار .. وإلى أيّ حدّ شخصيات الفيلم مأخوذة من تجربتك الشخصية؟
الفيلم يدور حول مجموعةٍ من الناشطين/ات في بداية الثورة في سوريا، الطموحات والأحلام التي خابت، ثمن الثورة، والتغيرات التي حدثت على الصعيد الشخصي.
الفيلم هو قصة حبٍّ بالتوازي مع الثورة، وهو ليس قصةً حقيقية، بل مبنيٌّ على أحداث حقيقية. وكنت حذرةً في اختيار كلماتي، أنا أصنع أعمالاً واقعية، واقعاً مألوفاً بالنسبة لي.
شخصيتا يمنى وورد، ليستا مادونا، ورد تشبهني في بعض المراحل، ويمنى في مراحل أخرى، والشخصيتان تشبهان أناساً أعرفهم، بمعنى أن هذه الأحداث وقعت فعلاً، لكن الفيلم ليس وثائقياً في النهاية.
لماذا اخترت العودة إلى تلك الفترة، سينمائياً؟
أعمل على الفيلم منذ وقت طويل، منذ العام ٢٠١٨. وفكرتُ في العودة إلى تلك الفترة، لأنني شعرت بأن هناك جانباً اندثر في خضم الأحداث والمآسي، وأنه بعد مضيّ الكثير من الوقت، أصبحتْ لدي كلماتٌ لأحكي عنه، إذ تغيرتُ شخصياً كثيراً، اليوم أستطيع أن استخدم الكلمات الملائمة للحديث عن تلك الفترة بطريقة ألّا تكون رومانسية، ولا ناقمة.
بعد العمل على الفيلم لفترةٍ طويلة، تم التصوير في شهر نيسان/ أبريل ٢٠٢٤. عملت على مونتاج الفيلم في باريس، ثم عندما عدت إلى بيروت، شعرت بالرغبة في تغيير بعض الأمور البسيطة في المونتاج. وفيما كنت أنهي العمل عليه في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٤، بدأ سقوط النظام، فقررت تغيير نهاية الفيلم كلياً.
جرى تصوير الفيلم في لبنان، وشهد وقائع مضحكة وأخرى صعبة. كنت حريصةً على أن تشبه مواقع التصوير دمشق والأماكن الحقيقية التي جرت هذه الأحداث فيها، هذا كان مجهداً قليلاً، قمنا بالتصوير في حارات صيدا القديمة، التي كان من المستحيل خلق هدوءٍ فيها، ما تسبب بعرقلة التصوير.
إصدار التراخيص أيضاً لم يكن سهلاً، كما صورنا مثلاً مشهد المظاهرة قرب جامع في منطقة الأشرفية (بيروت)، تخيل أن ترى ٥٠ شخصاً سورياً يصيحون "الشعب يريد اسقاط النظام" هناك. أيضاً صورنا حاجزاً سورياً على الاتستراد، فظهرت فيديوهاتٌ على وسائل التواصل الاجتماعي عن "عودة السوريين" إلى لبنان.
الفيلم يحكي عن رغبة الناشطين/ات في تغيير النظام، لكن ضمنياً، كان هناك رغبةٌ في تغييرٍ مجتمعيّ. نرى علاقة حب مفترضة بين ورد العائدة من الخارج وشابٍ يحاول فرض نمط حياةٍ معينة عليها. هل لك أن تحدثينا عن مدى رغبتك ألا يكون الفيلم سياسياً بحتاً.
الفيلم يحكي عن ثورةٍ صنعت تغييراً لا عودة عنه، وثورة شخصية لا عودة منها. سقوط النظام، الذي اتحدث عنه في الفيلم، لا يعني بالضرورة النظام السياسي، نظام بشار الأسد، لذلك هناك توازٍ بين قصة الحب والثورة. الثورة لم تخرج لأهداف تتعلق بالهوية الشخصية.. الكوير والنساء لم يخرجوا فيها لأنهم كوير ونساء، بل لأجل أهداف مشتركة، ضد الديكتاتورية والإقصاء والقمع، لكن كل الفئات كان لديها تطلعات لحدوث تغيراتٍ ضمن التغيير العام.
شخصياً لستُ متوهمةً بأنني سأقوم بالتغيير، لن أغير شيئاً وحدي، لكن تراكم هذه الأعمال قد يتسبب بتغيير، وأريد أن أكون فرداً من مجموعاتٍ تحاول العمل بطرق مختلفة، كمحامين أو فنانين. أرى أنه ليس من الضروري أن يكون المرء فاعلاً ليلعب دوراً، فوجود الأفراد بحد ذاته مقاومة.
ببحث شخصيّ، فيلمك الأول ليس متوفراً للمشاهدة، فيلمك الأخير يتوفر على التلفزيون وعلى موقع آرتيه، ما الذي يعنيه أن يصبح فيلمٌ مرتبط بعلاقةٍ مثلية متاحاً لمشاهدة العموم، ألا ينحصر عرضه في المهرجانات …
فيلمي "رقصة من أجل عيوني" يتضمن تعرياً بالمعنى المجازي والحرفي، لذا كان من الصعب علي أن أجعله متوفراً أونلاين. كذلك، عُرض في الكثير من المهرجانات، لذا كخيار فني، لم يكن من المفيد أن أجعله متوفراً على الإنترنت. اليوم ولأنه عُرض في المهرجانات الكبرى بات عادياً وضعه على الإنترنت، حيث أُثير هذا الموضوع مؤخراً من قبل عددٍ من الأشخاص، وفي الحقيقة كنت مترددة وصاحب ذلك انشغالي بمشاريع أخرى، لكنني أنوي وضعه على الإنترنت قريباً.
فيلمي الأخير "ليلة"، سيكون متوفراً على آرتيه مجاناً لمدة شهرين تقريباً (حتى نهاية آب/أغسطس). الجانب الجيد في هذا هو فرصة مشاهدته من قبل الكثيرين وتواصلهم معي، هذا أمرٌ لا يكون متاحاً عادة، يهمني أن يُشاهَد الفيلم، ففي النهاية أنا لا أصنعه لنفسي أو للمهرجانات. وبالمقابل، فعرضه على آرتيه قبل عرضه الأول في مهرجان، له جانبٌ سيء، لأن بعض المهرجانات الكبرى لا تقبل أيّ فيلم ما لم يكن عرضاً أوّل، لكن بعض المهرجانات تقبل إن كان ذلك العرض حدث في بلد الإنتاج فقط. في النهاية، وبالنسبة لي، طغى الجانب الإيجابيّ على السلبي.
عرضه، هو فرصةٌ لمشاهدة أفلام متعلقة بمجتمع الكوير، إذ تعدّ الأفلام السورية منها نادرة، أعني الجمهور يريد مشاهدة أفلام مختلفة عن تلك السائدة، التي تقدم العالم بعدسات ذكورية.
أرى أن فيلمي ينبغي أن يُرى لا لكونه فيلماً كويرياً فقط، فأنا أحكي عن التغيير الذي لا رجعة عنه والأمل والخيبة من خلال واقعٍ معين.
برأيي، الظهورية تتسبب بالتغيير في النهاية، وهذا الفيلم يمثل موقفاً، لكن الأمر لا يتعلق بذلك وحده. الحديث عن القضايا المحظورة مهمّ، لأن أناساً من هذا المجتمع يتعرضون للأذى، وهناك انتهاكاتٌ يومية وإعدامات.
شخصياً لستُ متوهمةً بأنني سأقوم بالتغيير، لن أغير شيئاً وحدي، لكن تراكم هذه الأعمال قد يتسبب بتغيير، وأريد أن أكون فرداً من مجموعاتٍ تحاول العمل بطرق مختلفة، كمحامين أو فنانين. أرى أنه ليس من الضروري أن يكون المرء فاعلاً ليلعب دوراً، فوجود الأفراد بحد ذاته مقاومة.
كيف تتوقعين أن يكون مصير شخصيات فيلمك الرئيسية، يمنى وورد، في سوريا اليوم؟
لو كانتا موجودتين اليوم؛ يمنى التي بقيت في سوريا ستسافر بعد أن نال منها الإرهاق، وستعود ورد، التي كانت في الخارج.
كناشطةٍ في مجتمع الحقوق الكويريّ، الذي لم يكن وضع أفراده مثالياً في سوريا تحت حكم النظام أو في المناطق الأخرى، في مجتمعٍ غير متقبّل، كيف هي أحوالهم في هذه الأثناء، تحت حكمٍ إسلامي الطابع.. ما الآليات التي قد يتبعونها لتفادي الملاحقة؟
في عهد النظام الساقط، وعلى مدار السنوات، طور المجتمع الكويريّ نمطاً من الحماية لنفسه عبر تراكم الخبرة المستندة على الانتهاكات والتجريم. فكانت هناك لغةٌ سريّة بكلماتٍ مشتقّة من لغاتٍ ثانية مثلاً، تُستخدم للتنبيه من وجود الشرطة أو احتمال حدوث عنفٍ في واقع اجتماعي معين.
كان هناك أيضاً العوائل البديلة، حيث يكوّن الأشخاص عوائل بديلة عن عائلاتهم/ن، تقدم لهم/ن دعماً اجتماعياً ومادياً ..الخ. تكون الأم في هذه العائلات غالباً امرأةً عابرة جنسياً، لديها الخبرة في هذا المجتمع والحياة، وتساعد الأشخاص الأصغر سناً. تتخذ المساعدة أشكالاً مختلفة، كالحماية من التعنيف الأسري والاقتصادي، أي أنها دوائر دعمٍ اجتماعي. هناك أيضاً الأسماء البديلة. لكن للأسف، الطريقة الأكثر شيوعاً كانت محاولة إخفاء الهوية، وهي مطبّقة حتى اليوم.
اليوم لم يتغير شيء. التجريم ما زال على حاله، الفرق هو عدم توافر وسائل حمايةٍ كانت موجودةً سابقاً.
خلال الثورة، لم تعتبر قضية الكويريين كأولوية، واختفى النقاش الكويري، مثلاً مجلة موالح، التي كانت أول مجلة كويرية سورية، توقفتْ عن الظهور في ٢٠١١. كان هناك أيضاً تنسيقية المثليين، تشكلتْ وانتهت في العام ٢٠١٢. مع مرور الوقت، تشكلتْ فصائل دينية مسلحة، وحدثت إعداماتٌ ضد الكوير، فبدأ النشاط الكويري يتوقف شيئاً فشيئاً.
هل أنتِ متفائلة أم متشائمة، حيال إمكانية تصوير أفلامٍ مرتبطة بمجتمع الكوير في سوريا اليوم، وأن يحدث التغيير الذي كانت شخصيات فيلمك تحلم به؟
لا أدري، لكن هناك الكثير من الأمور البعيدة عن التغيير، منها السياسات حيال الهويات، لا على المدى القريب ولا البعيد. لا أدري أيضاً كيف يمكننا الحديث عن توافر مساحةٍ للحرية الفنية دون حريةٍ سياسية كاملة. لا يمكننا تقسيم القضايا على أساس أولويات، والقول مثلاً أنّ قضايا النساء ليست أولوية، قضايا الكوير نؤجلها لفترة لاحقة. بالنسبة لي، ليس هناك قيمةٌ للحرية السياسية، إن لم تكن تتضمن كل الحريات.
لن تكون غالباً مدعومة من المؤسسات الرسمية…
السورية؟! بالتأكيد كلا.
بالحديث عن التمويل، ما مدى صعوبة صناعة فيلمك الأخير، القصير ؟
لم تتعلق الصعوبة بموضوعة الفيلم، بل بتمويل الأفلام المستقلة والقصيرة عموماً. فترة التمويل كانت طويلة، صاحبَها تأخيرٌ متعلق بأزمة كورونا، وبتطويري للسيناريو أيضاً، الذي كان يتغير مع تقدمي في العمر. وفيما كنا نهمّ بالتصوير، حدث تضخمٌ اقتصاديٌّ كبير في لبنان، فبات المبلغ المتوفر لدينا غير كاف، وتوجب عليّ وعلى المنتج أن ننفق من حسابنا الخاص أيضاً.
ماذا عن مشاريعك القادمة؟
أنا أعمل حالياً على مشروعين: فيلمي الوثائقي الطويل "بين هنا وهناك" في مرحلة ما بعد الإنتاج ، وفيلم آخر عن الحياة الكويرية في سوريا من ١٠٠ عام إلى اليوم، وهذا ما يزال في مرحلة البحث.
انتهيتُ من أسئلتي، إن كان لديك جانبٌ تودين الحديث عنه، لك حرية الإضافة.
مقابلة مع أنس زواهري، مخرج "ذاكرتي مليئة بالأشباح"
05 أيار 2025
كما قلت لم تخرج الثورة لأجل مسألة الهويات الشخصية، لكن عامي ٢٠١١ و٢٠١٢ شهدا نشاطاً كويرياً عالمياً، وكان هناك أمل بحدوث تغيير ٍفي حقوق الكويريين/ات هم/ن في سوريا ضمنه. خلال الثورة، لم تعتبر قضية الكويريين كأولوية، واختفى النقاش الكويري، مثلاً مجلة موالح، التي كانت أول مجلة كويرية سورية، توقفتْ عن الظهور في ٢٠١١. كان هناك أيضاً تنسيقية المثليين، تشكلتْ وانتهت في العام ٢٠١٢. مع مرور الوقت، تشكلتْ فصائل دينية مسلحة، وحدثت إعداماتٌ ضد الكوير، فبدأ النشاط الكويري يتوقف شيئاً فشيئاً.
النظام السابق كان يستخدم الكوير كأجندةٍ غربية قادمة لتخريب المجتمع، وفي النهاية ليس هناك مجتمعٌ كويريٌّ واحدٌ صلب ليشّكل كتلة سياسية، لذا توقف النشاط الكويري تماماً بين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٩.
كان نظام الأسد يقدم الكويرية كموضة من موضات الليبرالية الجديدة، وكان خطابه "رجعياً"، رغم الترويج لذاك النظام بأنه علمانيّ ويدعم حقوق الأقليات.
كان رجعياً في الكثير من المجالات، لكن كان لديه هوسٌ بالكويرية، في السنوات الأخيرة خصوصاً، إذ كان يضعف ويريد امساك المجتمع بمسألة ما، لذا كان يواظب على استخدام الليبرالية الحديثة وربطها بالمثلية وتخريب المجتمع وقيم الأسرة.
كان نظام الأسد قمعياً ومجرماً على مختلف الأصعدة، ليس بوسعه أن يكون قامعاً من جهة، ويعطي الحرية من جهة أخرى، مهما تحدث في خطابه.
شكراً جزيلاً على الاجابات، وبالتوفيق في مشاريعك القادمة. رابط الفيلم متاح هنا للمشاهدة في ألمانيا وفرنسا، أو عبر خدمة "في بي إن".