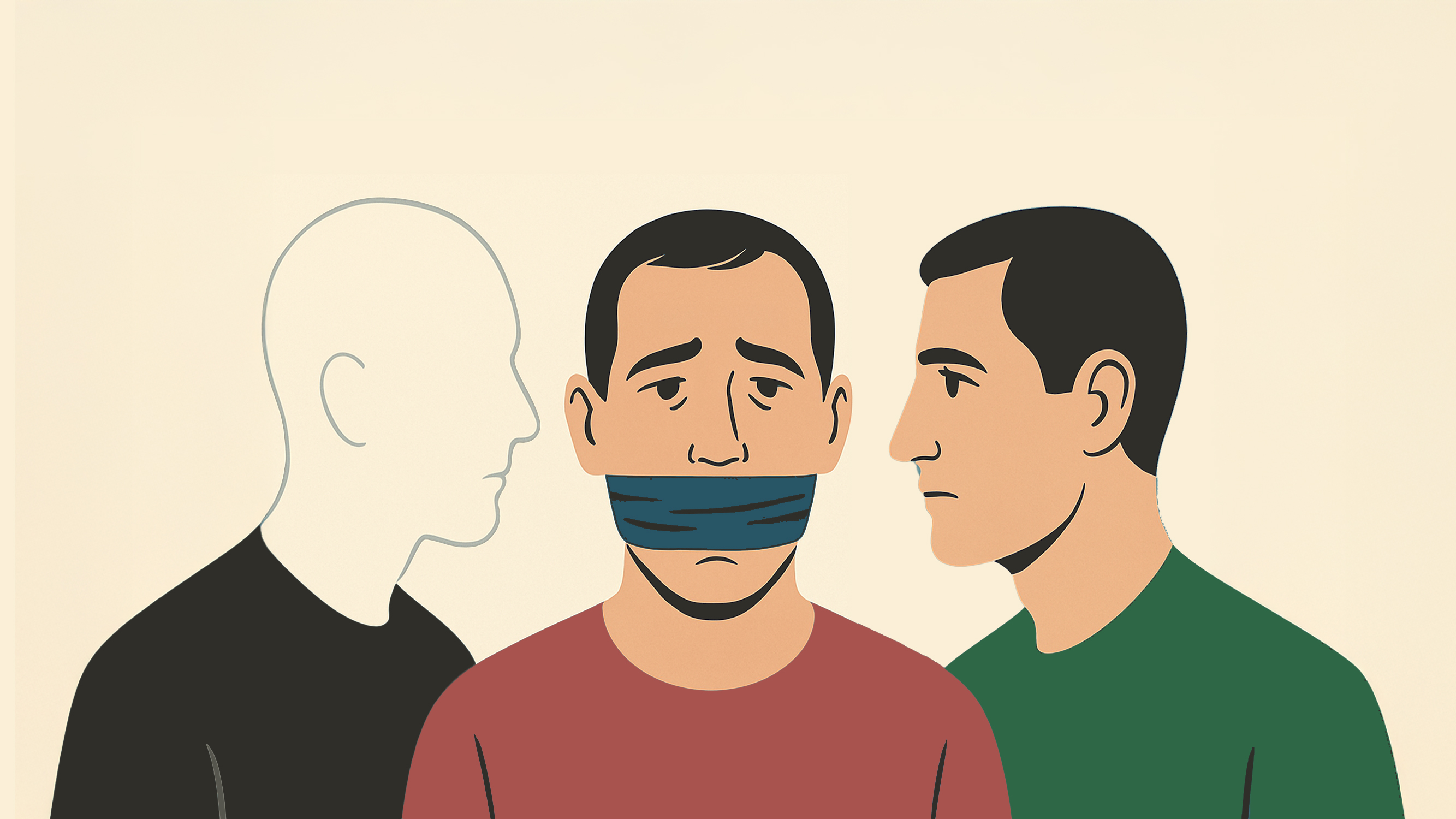(طرطوس)، "كل يوم أمشي بين البيوت، أحمل الجردل والممسحة، كأنّني أمسح عن الناس آثار الحرب والخوف". وإذا كانت الحرب قد انتهت، فإنّ الخوف لم ينتهِ عند العاملة المنزلية هِند التي تقول "قبل التحرير كنت أعرف كلّ الجيران وكنت مؤتمنةً على بيوت الناس، كنت أدخل وأطلع وما حدا يشك فيني. بس اليوم هالدنيا تغيّرت، وصرت أمشي كأني ضيفة بكلّ شارع بمشي فيه.. ما بقي معي غير الممسحة والجردل؛ هِنّي اللي بخلّوني أصحى الصبح، وأروح.. يمكن اليوم بلاقي بيت يقبلني، ويمكن لا."
تحدّثنا مع هِند (62 عاماً/ اسم مستعار) عبر مكالمة واتساب مرئية بتاريخ 15 آب/أغسطس 2025، وذلك بسبب صعوبات التنقّل في مدينة طرطوس، خوفاً من الخطف الذي يطال النساء والقتل العشوائيّ الذي يحصل في مناطق مختلفة من الساحل السوري ويترك أثره على الناس؛ خوفاً وانكماشاً وعدم حركة، إلا للضرورات القصوى. كانت ترتدي عباءةً قاتمة اللون، فوقها معطفٌ رماديّ رخيص، حجابها موارب يغطّي شعراً فضّياً خفيفاً، ووجهها مُخطَّطٌ بتجاعيد كثيرة. لهجتها طرطوسيّة رخوة تميل إلى المدّ، وصوتها رخيم، لكنّه ينخفض حين تذكر الحواجز والجيران، وتعلو نبرته فجأةً عند الحديث عن الأحفاد.
تعمل هِند منذ عام ٢٠٠٩ تقريباً في تنظيف البيوت، مذ طلّقها زوجها قبل نحو خمسة عشر عاماً: "أنا ما اشتغلت طول فترة زواجي برا البيت، التنظيف صار لازم لأنو ما في حدا يدفع عني حسابات البيت، وما في دولة تصرف لنا مساعدة". وهو ما أصبح أكثر صعوبةً بعد بدء الثورة السورية عام ٢٠١١ قبل أن تتحوّل إلى حرب، تركت أثرها على كلّ شيء، حدّ أنّ نسبة الفقر ازدادت بشكلٍ كبير. جاء في تقريرٍ لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (شباط/فبراير 2025) أنّ "أكثر من عشرين مليون سورياً، أي 90% من السكّان فقراء مالياً"، فيما جاء في تقرير البنك الدولي (أيار/مايو 2024) أنّ "الفقر شمل 69% من السكان في 2022، وبلغ الفقر المدقع 27%". ورغم اختلاف الأرقام بين التقارير، فإنّ الفقر واقع حالٍ دفع نساءً كثيراتٍ إلى العمل، كما يبيّن تقرير في صحيفة لو موند (أيلول/سبتمبر 2024) جاء فيه: "مع الحرب، اكتسبت السوريات قدْراً من الاستقلالية.. وأصبحن في حالاتٍ كثيرة يُدِرْن الأُسَر، لكن المجتمع ما يزال مُهيمَناً عليه من الرجال" حدّ طمس حكاياتهنّ وأوجاعهن كما حصل مع هند.
في حيّ الإنشاءات
رحلتي القصيرة في فروع أمن سوريا (الجديدة).. إعادة معايشة التراوما أم تراوما جديدة؟
27 آب 2025
في حيّ الإنشاءات القديم، كانت هِند مؤتمنةً وموثوقةً لدى الجيران، فهي تعيش في هذا الحيّ منذ عام 1998 تقريباً. لكن مع بداية التحرير وسقوط النظام البائد بدا وكأنّ شيئاً قد تغيّر، إذ تقول لسوريا ما انحكت: "قبل 2011، كنت أشتغل بانتظام، يوم هون ويوم هنيك، الناس بتحترمني؛ واستمرّ الأمر حتى لحظة سقوط النظام، حيث بدأت الأوضاع تتغيّر فجأة؛ الأمن تهدّم، الناس خافت، وصار في خطوط غير مرئية بين الجيران. أنا كنت عايشة بحيّ الإنشاءات لسنين طويلة؛ حيّ مُختلط، بس بعد الأحداث، نفس الحي انقسم، وصارت المصطلحات الطائفية تُطرح بصوت عالي. كل كلمة "من وين إنتِ؟" بقت كلمة تقتل الراحة".
وحيّ الإنشاءات واحدٌ من أحياء مدينة طرطوس، بناؤه قديم نسبياً وتتجاور فيه عائلاتٌ نزحتْ من ريف المحافظة مع عائلاتٍ مدينية. قبل 2011 كانت العلاقات اليومية تقوم على جيرةٍ مديدةٍ وثقةٍ متبادلة، وبعد عام ٢٠١١ كان العامل الاقتصاديّ هو الشاغل الأهمّ للناس بسبب تراجع مستويات المعيشة، قبل أن تتوسّع بشكلٍ كبير وتتبدّل خرائط الثقة أكثر بعد سقوط النظام. يقول جارٌ مسنّ تحدّثنا معه عبر الهاتف الأرضي (لهجة ساحلية واضحة ومدّ في الألف): "كنا نحسبها (يقصد هند) من أهل البيت، بس بعد الأحداث (سقوط النظام) القلب يوجع واللسان ينعقد، مو لأنو غلطتها بس لأنو الخوف قلَبَنا على بعضنا".
تقول هِند: "قبل السقوط كنت أنضّف بيت لجارتين عمرهن فوق الستين، كانوا مستأمنين بيوتهم معي. بعد فترة، واحدة منهن صارت تتردّد وترفض وجودي داخل البيت لما يكون عندهم ضيوف. قالوا لي: "مش مرتاحين هالفترة والوضع تغيّر"، وفعلاً، قلّوا اللي يدعوني ويطلبوا مني اشتغلهم. لما الكره دخل باسم الطائفة، صرت أسمع جُمَل متل: "ما بنقدر نقبل حدا من غير طايفتنا". وهون حسّيت إنّي انسلخت من حياتي".
تعود جذور هند الدينية إلى الطائفة العلوية، ولكن أغلب عملها خلال السنوات الماضية (وخاصةً بعد عام ٢٠١١) كان في بيوتٍ لسكان تعود جذورهم الدينية إلى الطائفة السنية بنسبة ثمانين المئة تقريباً، وهو ما تغيّر بعد سقوط النظام. وقد وثّقت منظماتٌ حقوقية ومصادر مستقلة أنّ تفاقم النزاع ولّد موجات فصلٍ اجتماعيٍّ وطائفيّ في مناطق مختلطة، وأجبر كثيرين على تغيير سكنهم أو نمط حركتهم بفعل الخوف أو التهديدات أو همس الجوار. تتحدّث منظمة العفو الدولية في تقرير لها (آذار/مارس 2025) عن موجة قتلٍ جماعي استهدفت مدنيين علويين في الساحل: "قتلت ميليشياتٌ تابعة للحكومة أكثر من 100 شخصٍ في مدينة بانياس الساحلية يومي 8 و9 مارس/آذار 2025، وفقاً لمعلومات تلقتها منظمة العفو الدولية. حققت المنظمة في 32 عملية قتل، وخلصت إلى أنها كانت متعمّدةً وموجهةً ضدّ الأقلية العلوية وغير مشروعة".
وبعد عام ٢٠١١ كان العامل الاقتصاديّ هو الشاغل الأهمّ للناس بسبب تراجع مستويات المعيشة، قبل أن تتوسّع بشكلٍ كبير وتتبدّل خرائط الثقة أكثر بعد سقوط النظام.
خلال هذا الوقت تلقّت هِند المساعدة من بعض البيوت التي تعمل فيها حالياً، من ملابس لأحفادها إلى بقايا الطعام أو نقود إضافية لتستمرّ في التنقّل بين أحياء المدينة كلّ صباح، إذ تقول: "سيدة تعطيني مبلغ رمزي، بتقولي خدي 5000 ليرة!! صحيح مبلغ زهيد بس هو ثمن ربطة خبز اليوم. وفي جيران بيعطوني ملابس لأحفادي وهذا يفرحني كأنّو عيد. أحفادي هِنّي اللي يخلّوني أستمر؛ لما بلبّسهم هدوم جديدة عطوني ياها الناس، بفرح وكأني أعطيتهم عيد".
تعيش هند اليوم في منزلٍ واحد مع ابنتها المطلقة وابنها الذي طلقته زوجته وذهبت إلى دمشق بحثاً عن عمل بسبب الفقر، وله منها ابنتان (13 سنة/ تسع سنوات) وصبيٌّ بعمر السادسة. لدى ابنها إعاقةٌ في قدمه اليمنى ولا يمكنه تحمّل الأعمال الشاقة أو حتى التنقّل براحة، لذا فـ هند هي المُعيلة الأولى للعائلة بالإضافة إلى ابنتها المطلّقة التي تعطي حصصاً تعليميةً خاصةً لأبناء الحيّ الذي يقطنونه حالياً (راس الشغري).
وعن علاقتها مع أولادها تقول: "لما طلّقت، حسّيت إني خسرت سندي الاجتماعي مو بس الزوج بل شبكة الأمان الصغيرة من الجيران والأهل. حتى الوقوف بالمطبخ صار صعب.. لما صرت اشتغل ببيوت الناس، صاروا أولادي يكرهوا يزوروني بالليل لأني بكون مرهَقة، وما بقدر أعمل لهم طبخة يفتخروا فيها".
عن خمسة أيام جرشت روح السويداء؛ بشراً وسكناً وزرعاً وضرعاً.. ومزقت روحي الحبيسة في برلين
04 آب 2025
حاولت هِند أن تبقى صامدةً في الحيّ، تنتقل من بيتٍ إلى بيت، وكأنها تنظّف جراحاً لا يراها أحد. تلك الجراح التي كان فقدان الثقة أحدها، إذ تقول: "الناس اللي كانوا يوثقوا فيي قبل الحرب صاروا يتشككوا، وبيوت صارت تُغلَق بوجهي. قلت يمكن الخوف!! بس الخوف صار يبرّر التمييز".
بدأت هند تشعر بأنها غريبة في حيّها كما تقول "ناس ما عاد رضيو يخلّوني فوت على بيوتهم، بحجة الظروف أو إنو ما عاد بحاجة، بس كنت سامعة من جاراتي إنو السبب إنو أنا ما من طائفتهم ولأن طليقي (المتوفّى) كان بالجيش العربي السوري قبل سنين برتبة عقيد وها لشي صار تهمة. كأني تحوّلت لحدا غريب وخطر".
تصف كيف صارت تمرّ في الزقاق الذي كانت تضحك فيه مع نساء الحي، فتتلقّى نظراتٍ باردة: "كانوا بالأول يندهولي: تفضّلي اشربي قهوة؛ وصارت نظراتن تقول: ليش بعدها هون؟".
كلام هِند تؤكّده إحدى جاراتها (رفضت ذكر اسمها)، قالت لنا عبر اتصالٍ هاتفي قصير (صوتها حادّ ولهجة مدنيّة): "هاد ظلم، المرأة كل عمرها بتتعب بشرف واللي صار معها ما إلو علاقة بأمانتها، بس الجو اللي انفرض علينا خلّى حتى الطيبين يسكتوا". وتقول جارةٌ أخرى (رفضت ذكر اسمها): "هِند كانت معروفة، بس الناس صارت تخاف، الطائفية لعبت دور كبير، حتى لو إنسانة نظيفة وطيّبة، بس وجودها صار يحرج بعض العائلات، كأنها وصمة. هاد الشي وجّعنا لأنّو خسرنا جارة حنونة، وشُفنا قديش الطائفية بتقتل علاقات بَنتها السنين".
وتتذكّر هِند أحد البيوت: "كنت مسؤولة عن كل شي من الغسيل للطبخ فجأة قالتلي صاحبة البيت: الله يعطيكي العافية هِند، بس هلأ ما عاد في شغل!! وبعد فترة سمعت إنو جابوا وحدة تانية من بعدي".
هذا التمييز لم يكن مسألة عملٍ فقط بالنسبة لهند، بل مسألة كرامةٍ أيضاً؛ لم تخسر دخلها الشهري فحسب، بل خسرت إحساسها بالثقة بالنفس: "الوجع مو إنك تنقطعي من الشغل، الوجع إنو يطلعوك من حياتن كأنك خطر، بعد كل هالعمر وأنا مؤتمنة على أسرار بيوتهم".
ولم يحدث هذا لهِند وحدها. إذ تقول ندى (55 عاماً/ اسم مستعار) التي تعمل في تنظيف البيوت في مدينة اللاذقية: "اشتغلت عند عيلة كبيرة 12 سنة. كنت أحمل مفتاح البيت مثل أولادهن. بس مع الأحداث الأخيرة بلّشت تلميحات: الوضع تغيّر، وبالأخير قالولي صراحة: 'إنتِ ما بتشبّهينا، والناس بلّشت تحكي علينا ليش حاوينِك لهلأ".
صار لبسي مُحتشم أكتر مو من باب التديّن، بس لأني مو حابّة يسألوني بالحواجز وين كنتِ ووين رايحة. بالحواجز ما بينتقدوك بس بالأسئلة، بيطلعوا يحكّوا عنك. فخفّفت الكلام، زوّدت الاحتشام، وصرت أمشي بلا لفت نظر".
تصف ندى كيف شعرت بالخذلان بعد سنواتٍ طويلة من الخدمة: "كانوا يتركوني مع دهباتون وأوراقن الرسمية، معقول كل الوقت ما خطر على بالهن بيوم إني آذي أو اسرق أو؟ بس هالحرب ما بعرف شو عملت فينا وكيف علّمت الناس يخافوا من بعض أكتر من الخوف من السرقة؟ وفجأة الطائفة صارت أهمّ وأولى من الثقة"
ندى تؤكد أيضاً لحكاية ما انحكت أنّ الألم لم يكن بخسارة الدخل فقط، بل بخسارة مكانتها الاجتماعية: "ما وجعني بس إنو خسرت شغل، اللي وجعني إنو البيت اللي كنت أعتبره مثل بيتي، فجأة صار يخاف مني كأنو الحرب فتحت بيني وبينن جدار كبير ما عاد ينكسر".
وهو الانكسار الذي لامس قلب هند أيضاً، لتتخذ قرارها بالرحيل نحو حي الشغري، "لأن كنت حس حالي ضيفة مو جارة، حتى وأنا ساكنة بينهم. عشت عزلة صعبة كتير، وطلعت من الحيّ وقلبي مقسوم نصين: نص مع البيوت اللي كنت بعتبرها أهلي، ونص عم يصرخ ليش صار هيك؟".
وتضيف: "أذكر بيتاً كنت أنظفه لسنوات. بيت رجل كان دايماً يقول: "أهلا أمّ ماجد، ادخلي أمانة". بعد انتصار الثورة عاد ابنه المغترب لسنين وصار يتدخل بأمور البيت وسمعته عم يحكي لأن صوته عالي بقصد؛ قال لأبوه: " أنا ناوي استقرّ بالبلد لهيك نحنا ما بصير ندخّل غرباء على بيتنا". قالها بلا مراعاة لمشاعري وأنا سكتت، لأن السكوت ضمان لخبز اليوم". هذا الخبز الذي أملت أن تحظى به في الحيّ الذي رحلت إليه في شهر مارس/ أذار 2025 بعد مجازر الساحل السوري، وبعد أن ازداد خوفها على عائلتها، عسى أن تجد من يشبهها في معاناتها.
إلى حيّ الشغري
"لما الناس بدأوا يرفضوا اشتغل ببيوتهم، كان الاختيار بين البقاء تحت الجرح أو الرحيل، واخترت الرحيل. رُحت لمنطقة رأس الشغري طالبة بس الأمان. ظنّيت إذا غيّرت الحي بينتهي الإحراج. بس حتى رأس الشغري ما كان صفحة بيضا؛ الاقتحامات، المصادرات، وتخريب البيوت صار واقع بعد التحرير وسيطرة فصائل مسلّحة؛ مرات كنت أجي على بيت لأنظّفه ألاقي الباب مكسور أو الشبابيك مهَدّمة، أو أصحاب البيت يقولولي: احذري، كانوا كل الليل مستنفرين ويدقّقوا على الحواجز".
حكاية الساعات الأخيرة في حياة الحزب القائد
29 آب 2025
ورأس الشغري ناحية ساحلية جنوب طرطوس تُعرَف بتداخل الريف والمدينة فيها، وكثيرٌ من عائلاتها أقرباء متصاهرون، ما يمنحها شبكة حمايةٍ محلية متماسكة نسبياً. بعد 2011 شهدتْ موجات دخولٍ وخروجٍ للنازحين، وتوتراً منخفضاً يعلو حين تتبدّل السيطرة العسكرية. يقول أحد سكّانها (نبرة ريفية وتمطيط في الواو): "هي هون بيننا؟ إي نعم، يا حرام تشتغل بصمت ليل نهار. في ناس هون بتعطيها حسنة؛ وجودها بركة وما بنقدر ننكر تعبها".
تشهد لنا هند: "هنا ما حدا سبّني علَناً، بس في تلميحات، في مرة حدا قال: 'الله يعينك، لهيك صرت انتبه أكتر، أشتغل وأسكت".
أنا لم أعد أنا..
ما جرى مع هِند لم يترك أثره على عملها فقط، بل على حالتها النفسية وجسدها وتحرّكاتها. فالخوف أضحى ملازماً لها إذ تقول: "الصبح بكير أوقف السرفيس، كلّ راكب يشوفك بنظرة؛ شُغلك واضح من الممسحة. بالحواجز يسألوني: وين رايحة؟ وين هويتك؟ أحياناً بيزودوا الأسئلة لحدّ ما تنزل الأحاسيس بقلبك. أنا ما بعرف أحكي سياسة، بس بعرف أمشي بوقار". وهو الخوف نفسه الذي طبع الجميع بطابعه، إذ تقول إحدى جاراتها القديمات من حي الإنشاءات: "هِند كانت دايماً نظيفة وطيبة؛ بس إحساس الحرب خلّانا نخاف، وما كان سهل نشوفها راحت وتركت بيتا بس صارت الحياة صعبة ومُوجعة ".
بعض البيوت فيها ضحكات أطفال، وبعضها فيها بكاء أمّ فقدت حدا. كل بيت يستجيب لي بطريقته؛ بيت بيشوفني كأم ثانية، بيت تاني بيشوفني غريبة، وثالث بيسكّر الباب بوجهي".
وتذكر هيومن رايتس ووتش في تقريرٍ لها (كانون الأوّل/ديسمبر 2024) عن حالات تحرّشٍ وإساءةٍ على الحواجز بحقّ نساء وفتيات، بينها شهادات عن "إساءة لفظية ومضايقات على الحواجز".
كما يورد تقرير الخارجية الأميركية (2024/نُشر آب/أغسطس 2025) أنّ السلطات وأطرافاً مسلّحة "تحرّشتْ واعتدت لفظياً على نساء… وتكرّرت الانتهاكات على الحواجز".
يقول سائق سرفيس التقيناه قرب الكراج القديم (لهجة طرطوسية): "النسوان بخافوا يحكوا بالحاجز، بيطَوّلوا عليهم بالسؤال بتشوفيهن ماسكات الهويّة بإيدٍ ترتجف".
ليس الخوف وحده رفيق هِند؛ تغيّر لباسها أيضاً "صار لزومي ألبس حجاب وحياكة أطول، حتى بالنهار. صار لبسي مُحتشم أكتر مو من باب التديّن، بس لأني مو حابّة يسألوني بالحواجز وين كنتِ ووين رايحة. بالحواجز ما بينتقدوك بس بالأسئلة، بيطلعوا يحكّوا عنك. فخفّفت الكلام، زوّدت الاحتشام، وصرت أمشي بلا لفت نظر".
هذا السلوك ليس فردياً فقط؛ تُشير تقارير حقوقية إلى أنّ العنف والتهديدات دفعت نساءً إلى العمل بمزيدٍ من التحفّظ والتنازل عن بعض الحريات البسيطة صوناً للأمن الشخصي. تذكر هيومن رايتس ووتش أنّ نساءً "تعرّضن لقيود تمييزية على لباسهنّ وحركتهنّ" خلال النزاع.
الآن تعمل هِند لدى سيدة اسمها فاطمة (اسم مستعار)، قالت لنا عبر مكالمة واتساب قصيرة (صوتها هادئ ولهجة ريف طرطوس): "هِند بعرفا من زمان، بس لما وصلت راس الشغري صار في ناس تعطيها شغل. أنا شايفتها أمينة، بتقلّب البيت نظيف مهفهف وما بتطلب زيادة. مرات بعطيها بقايا طبخة، مرات ملابس لأولادها، لأنّي بعرف قلة إمكانياتها؛ الناس الطيبة بتساعد حسب الإمكان".
لا زالت هند حتى الآن تمضي أيامها بين الخوف الذي يحاصر الجميع والعمل حين يتاح لها، عملٌ تصف تفاصيله بالقول: "أفتح الصندوق اللي فيه أدواتي؛ ممسحة، دلو، فرشاية قديمة، قماش. أطبّق الطقس المعتاد لشغلي كأنّه طقس صلاة. بدخل البيت بعزيمة؛ أبدأ بالغبار، أطلع الزوايا؛ أرتّب الطاولة، أمسح آثار الأقدام. بعض البيوت فيها ضحكات أطفال، وبعضها فيها بكاء أمّ فقدت حدا. كل بيت يستجيب لي بطريقته؛ بيت بيشوفني كأم ثانية، بيت تاني بيشوفني غريبة، وثالث بيسكّر الباب بوجهي".
وعن أحلامها تقول لنا: "أجمل حلم إني أبقى آمنة يومياً، وأقدر أجيب لأحفادي لقمة كافية. وأحلم إن الناس ترجع تشوفني كإنسانة، مو كرمز طائفي أو مطلّقة. ما بدي شفقة بدي شغل بسيط وحماية بسيطة. المرأة العاملة لازم تُنشاف كإنسانة بتستحق الأمان".
تختم هِند حكايتها:
"لو الناس صاروا ينظّفوا قلوبهم متل ما أنضّف بيوتهم… يمكن نرجع نِحب بعض من جديد".