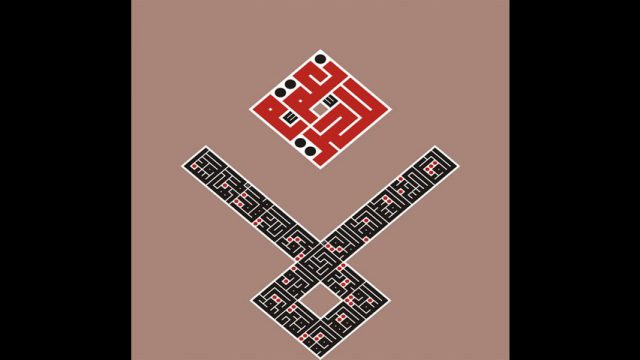في عام 1937، فرضت وزارة الثقافة الشعبية، خلال فترة الحكم الفاشي على دور النشر الإيطالية تعميماً مفاده بأنّ القاتل في الروايات البوليسية الإيطالية يجب ألا يكون إيطاليًا، وأنه لا يستطيع أيضاً الهروب أو الإفلات من العدالة.
نمط هذه الرقابة كانت تقول "أذا أردت منع سلوك ما، عليك الامتناع عن التحدث عنه". بالمقابل كانت الصحف المحلية كصحيفة "الشعب الإيطالي" تقوم بجمع حوادث الانتقام والانتحار، مشيرة باستمرار بأنّ هذا الفعل الشنيع من اختصاص المهاجرين الألبان والرومانين والغجر. باختصار الخطر يأتي من الخارج!
لمحاكاة الواقع الاجتماعي الداخلي، كان على الروائيين أن يتبنوا استراتيجيات سردية لا تتماشى دائماً مع توقعات القارئ الإيطالي. فكان يمنع من نشر حكايات وقصص تشير إلى جرائم القتل أو العنف وعملوا على استبدالها بإسلوب حكائي يطغي فيه الحس التشويقي أو الجاسوسي، وهي محاولة لإسباغ محتوى الرواية على أنها بوليسية.
ماذا تربح الدولة سياسياً من الإبقاء على الغموض؟ فهو العامل الوحيد الغير عقلاني الذي لا يستطيع العقل البرجوازي إزالته من الخريطة الذهنية خشية "الضياع " في متاهات النقاشات المتناقضة، خاصة في ظلّ سعي الناس باستمرار للبحث عن تفسير سياسي واجتماعي متزن وهي جرعة الأمن المطلوبة بدون خوض أي معركة شخصية ومباشرة مع الشعب.
كما أنّ هذا الأسلوب كان فيه نوعا من رمي المسؤولية على كاهل البرجوازية الميلانية وتحميلها تدهور أخلاقيات المجتمع كجنوح الشباب إلى الانحراف والبغاء وصناعة الجريمة لصرف النظر عن تجاوزات السلطة المستبدة.
ومن هنا يمكن أن نفهم، بأنّ السينما والفضاء السردي في الحقبة الموسولينية، ليسا مجرد ثنائيات حشو في الوحدة والكثرة أو العقل والخيال، أو الحس والمثال، إنما هي شريحة بروباغاندية مكثفة، تشحن الدولة بها الشخص الفضولي من الطبقة البرجوازية في أوقات بحثه عن أجوبة وبراهين.
نقل معارك الخارج إلى الداخل أو اللعب على "القضايا الكبرى"
ما أفظع هذا الأرث: لقد ورثنا نظاماً بوليسيا يختزل المسافات والإجابات بين الواقع والوهم مع الإبقاء على الحقيقة المخفية والغامضة ذو الطابع الملغز للشيء. يتمتع النظام السوري بطريقة سادية في لعبة الكشف والحجب، يكشف عن المرموز إليه، ويحجبه في الوقت نفسه، ليحافظ على جانبه السري والجيمس بوندي الملغز.
ثمة مجموعة من الخصائص تميّز الأنظمة البوليسية عن غيرها، من بينها خاصية جنونية متعالية لا طبيعية، ففي كل أزمة داخلية حتى قبل عام 2011، كان يسعى النظام لتوريط الفضاء العمومي ضمن ألاعيبه ومساوماته في السياسة الخارجية، سعيا منه لتشويش الرأي العام الداخلي الذي كان يطالبه بالإصلاح الإداري والسياسي ومحاربة الفساد وإبعاد تسلط الأجهزة الأمنية في الحياة اليومية ليترك وراء السوري، البحث عن الخفي والضمني لفهم ما يجري في لعبة الأمم، وفي كل بحث عن الخفي والضمني ثمة سعي نحو المختلف والمتميّز.
مبدأ السطوة والاستعباط السياسي
لتكريس مبدأ السطوة والاستعباط السياسي، ففي عام 2005 وبعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، أعلن بشار الأسد عن تعليق مشروعه في "التطوير و التحديث" بحجة أنّ سوريا تتعرّض لمؤامرة كبيرة وضغوطات خارجية بدأت منذ احتلال العراق عام 2003، وحدّد لنا خريطة جغرافية جديدة لعين الطامعين في لحم الدولة السورية، مع العلم أنّ هذه الخريطة كانت تتطور وتتغير من فترة إلى أخرى حسب قيمة الصفقة السياسية مع الغرب. كما أنّ الاغتيالات السياسية لها نصيب وافر في إحداث تعديلات أو توزيعات جديدة لألوان الخريطة السياسية. فبعد اغتيال مغنية في دمشق في عام 2008، نتذكر كيف استغل النظام الحادثة لفك عزلته الخارجية والتقرّب غرباً عبر البوابة الفرنسية التركية.
خطر التغيير لا يأتي إلا من الخارج!
ذاكرة سورية في معسكر نازي
31 تموز 2019
وجه شبه المقارنه هنا، مع ما يوحيه أي كاتب متمرّس في الرواية الجاسوسية، بأنه يقوم بإعطاء إشارات وإيحاءات تفسيرية غامضة وفضفاضة لا تلمس بالضرورة الواقع المحلي. فالحبكة هنا تكون بربط الحدث الداخلي تارةٍ بالشأن السياسي الخارجي للدولة (الباب مفتوح ويستوعب كل أشكال نظريات المؤامرة وما أبسط سردها) وتارةٍ أخرى بفشل المنظومة الأخلاقية للمجتمع (دودة الخل منه و فيه، أي الشعب). بالمفارقة مع بنية الروايات الجاسوسية، تتحول مشاعر التشويق في القراءة إلى الشعور المستمر بالخوف من استنتاج المجهول، كما تتحول نظم السرد في الرواية المتماسكة إلى رقعة شطرنج مفتوحة لكل الاحتمالات السياسية، والتي تهدد بدورها أوراق الكتابة بالضياع والنسيان.
يتجاهل رأس السلطة الخوض في مجريات الحدث اليومي السوري كالحديث عن برنامج زمني فعال لمحاربة أي شكل من أشكال تفشي الفساد في مفاصل الدولة، بل يعمل دوما على إهدار الوقت والحد من ترجمة آلام الشعب، ساعيا إلى عملية ربط الشأن الخارجي بالداخلي أو العكس، أي اللعب على "القضايا الكبرى" حسب تعبير الماغوط. وعبر هذا التمرين الماكر يسمح لهولاء الساسة الرسميين وغير الرسميين في حكومته "الشكلية" بإهدار كل الوقت لبناء أكثر ما يمكن من سياسات الانتظار لما لا يأتي أبدا ولن يتحقق؟
بهذا المنطق الحججي، النقاش صار فريسة سهلة للتورط، حيث يمكن للنظام صياغة تاريخ بدء تفشي الفساد الإداري في مؤسسات الدولة باعتباره متلازم بالضرورة مع لحظة انطلاق جريان قانون تطبيق العقوبات الأمريكية. من هذه النافذة الجدلية، إن الاستيلاء على أملاك رامي مخلوف في هذا الظرف الزمني يمكن أن يستغل للترويج بجدية السلطة القائمة في محاربتها للفساد "لقد فعلت ما بوسعي و لكن؟". وبعد فترة، سنرى كيف انسحبت معه كل كلمات الوعود التي أطلقها النظام بمستقبل إعادة الإعمار بعد معركة حلب. سيسحب نفسه مثل الشعرة من العجين أو كالطفل البريء من أي مسؤؤلية أخلاقية من تحويل البلاد إلى كوم من الرماد. وبالتأكيد الجواب التلقيمي الجاهز سيكون "فلقد منعتنا الإمبريالية العالمية من فعل ذلك!".
طبعاً وهذا لا يلغي صحة القول بأنّ المتضرر الأول والأخير من قانون سيزر هو الشعب في الداخل لكن من وجهة نظر ما نناقشه، أنّ المسؤؤلية تقع على من سعى، منذ عقود، إلى رفض إقامة أي حوار حقيقي داخلي في البيت السوري، بل إصراره على جرّ البلاد إلى كل المعارك والمساومات الإقليمية والدولية، والتي مازلنا نشاهد بعض من فصولها.
سياسة خلط الأوراق
تمرست السلطة القائمة في سوريا على المراوغة في خلط الأوراق والزئبقية في التعبير، وهي الطريقة الوحيدة التي تحميها من أطماع المشككين من أبناء جلدتها، والذين يريدون العبور من أفق الدولة البوليسية الأمنية الى ضفاف الدولة المدنية. في ظل سعي النظام المستمر لنقل معركة الخارج إلى ساحة الداخل، أنشأ لنا منهجاً للتفكير وحولنا إلى ذوات متسلحة بأكبر قدر من أجهزة الأقصاء والمفرغة جسدياً من كل الأدوات المناعية، فلم نعد نستطيع ترتيب بيتنا الداخلي أو البدء بإعادة ترميم بنية نسيجنا الاجتماعي بعد ما حولنا الأخير إلى شراذم بشرية و كانتونات طائفية وعرقية.
هذا الكلام يعيدنا للتذكير، كيف حولت بثينة شعبان بداية الاحتجاجات في درعا إلى نقاش لانهائي عن الطائفية الآتية من خارج الحدود؟ كيف انقلبت آمال الحرية في مدينة ومحافظة حمص إلى سجال حول معابر الأسلحة والطرقات المؤدية إلى القدس؟ وأمثلة أخرى لا تنتهي.
في عملية سحب محاور الصراع الخارجي نحو الداخل،هو اعتراف ضمني مستمر للنظام بنظرته الدونية للجماهير، فتلك الحشود البشرية، بالنسبة له، لا وقع حسي لها، ومعنى ذلك أنّ الشعب ليس إلا جهاز عمومي يصنعه على قياسه.
والحال أنّ معطيات اليوم وأوليات الداخل الاقتصادية تغيّرت، بل أنّ معارك الخارج انتقلت كلها نحو الداخل. لكن سيبقى من يطالب بالإصلاح والتغيير، حتى لو كان من صفوف الموالاة، عرضة لأي شبهة أو تهمة أو عقوبة أو ضغينة من أبواق "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة" أو حتى من تجار الحنين إلى ماضي قريب، وهم والجاهزون أصلاً، ودوما، لإنتاج الريبة والغلو في الانتماء الذي يهدّد نمط العيش المشترك.