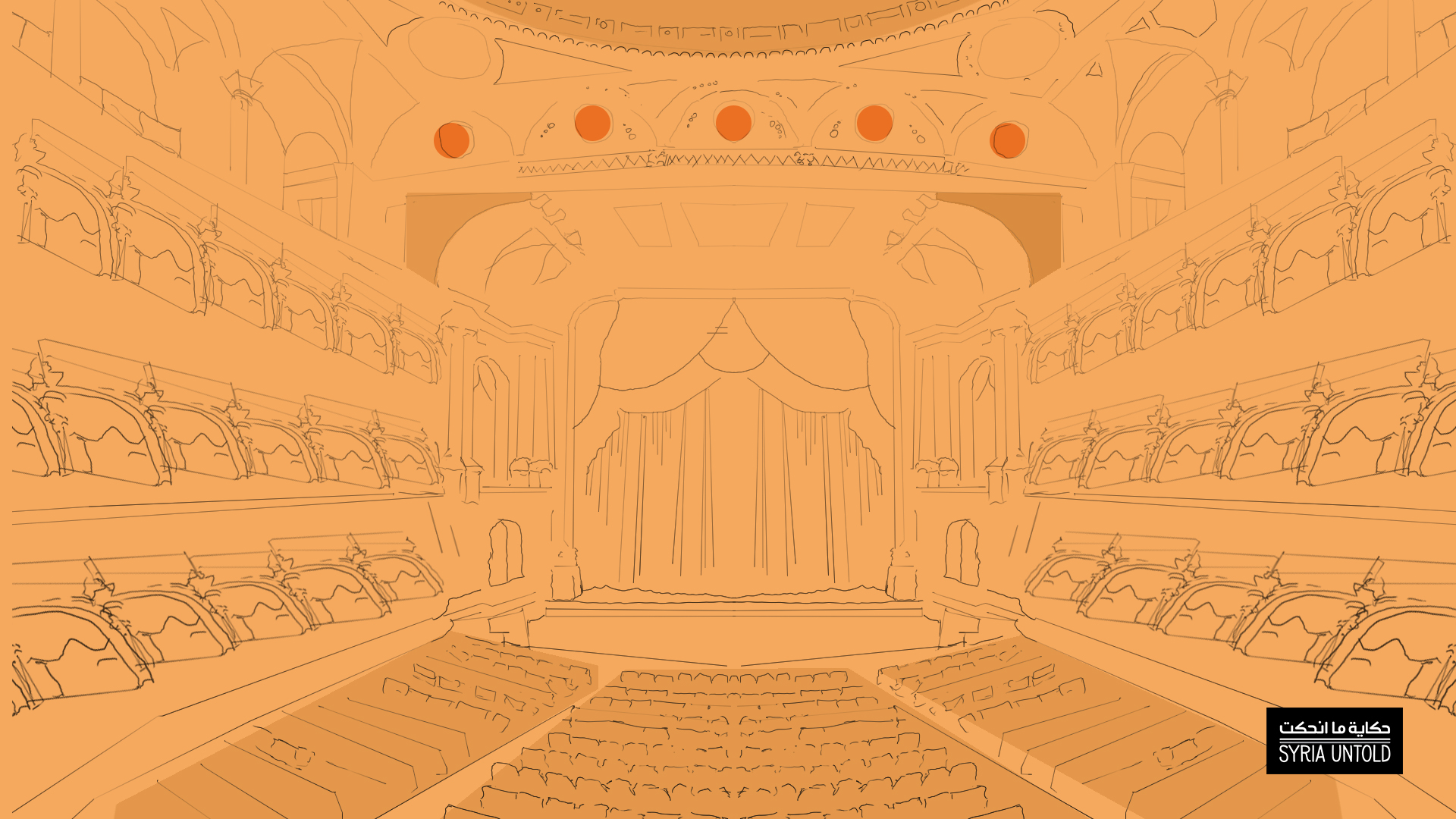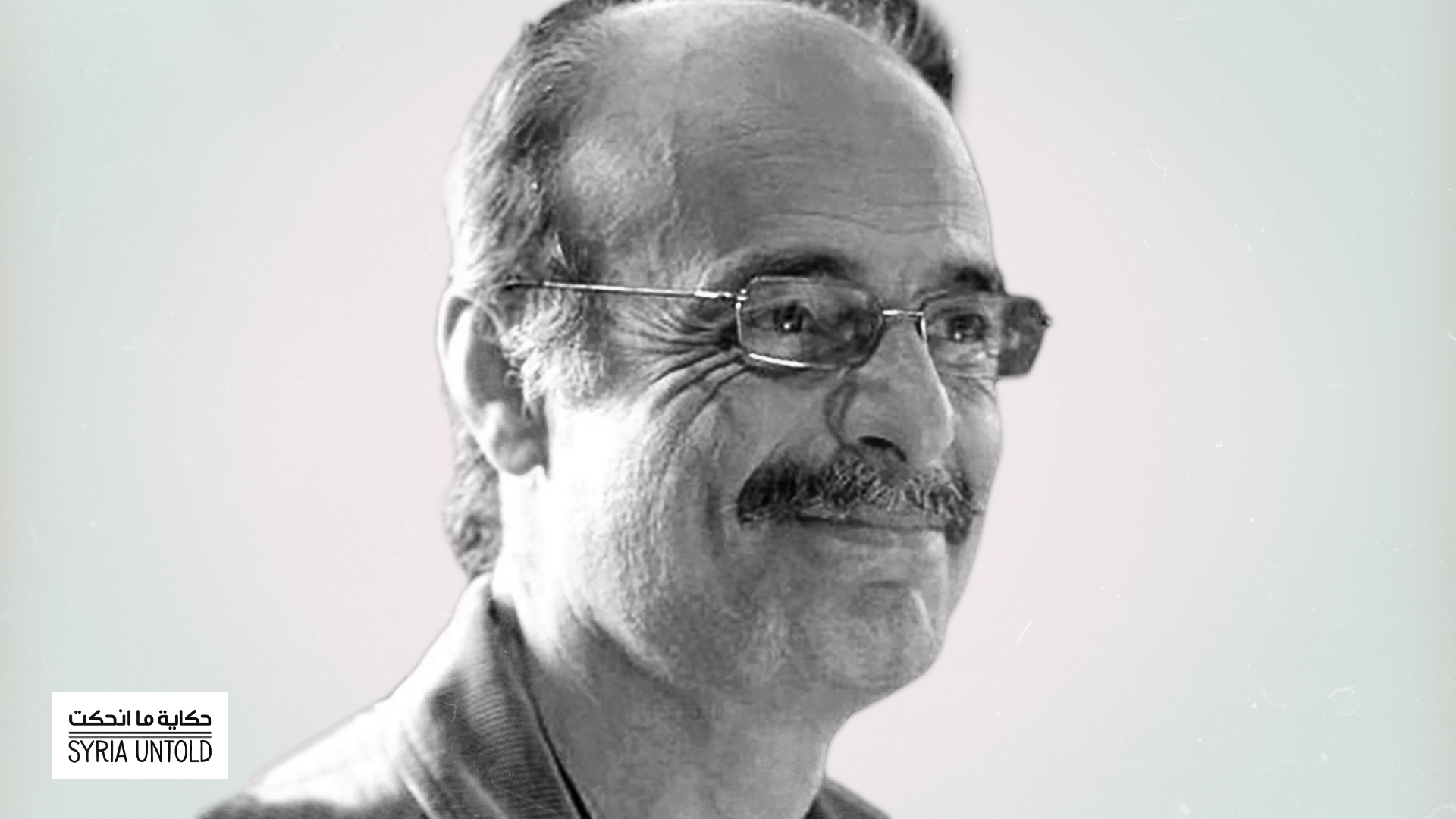خلال بحثي في تاريخ السينما السياسيّة السوريّة، كان لا بدّ من الوقوف عند أهم التجارب السينمائيّة الإنتاجيّة التي قدّمت خلال سنوات تأسيس وعمل المؤسسة العامة للسينما السوريّة قبل العام 2010. لا شك أنّ هناك العديد من التجارب السينمائيّة التي يمكن الوقوف عندها، لكن التجربة الأكثر تميّزًا بين تلك التجارب، بالنسبة لي، هي تجربة السينمائي أسامة محمد، وتحديدًا فيلمه الاستثنائي "صندوق الدنيا - إنتاج العام 2002".
يعدّ الفيلم من أكثر الأفلام نضوجًا على الصعيد السينمائي في التجربة السينمائيّة السوريّة؛ فالفيلم يحمل في صنعته لغة سينمائيّة عالية، إلى جانب الإغراق في المحليّة على صعيد القصة. قد يكون هذا الفيلم من أكثر الأمثلة وضوحًا على فكرة تأصيل السينما العربيّة، وكيف أنّ الفن السينمائي ذو اللغة العالميّة يحتاج إلى سينمائي حرفي وشاعر ليستخدم تلك اللغة العالميّة في سرد قصص محمّلة بلغة سيمولوجيّة محليّة، وبنوازع الصانع الثقافيّة والفكريّة، ثمّ تصديرها إلى العالم.
لم يشكل منع فيلم "صندوق الدنيا" عن العرض من قبل السلطات السوريّة مفاجأة لأحد، فالفيلم على صعيد مقولاته السياسيّة، وعمق تحليله للسلطة بأنواعها المختلفة، يشكّل وثيقة تاريخيّة، لا بل نبوءة سينمائيّة لصيرورة تاريخ سوريا المعاصر، فكان من الضروري دفن الفيلم حيًا.
في البحث عن آثار ذلك الفيلم، قرّرت إجراء حوارين منفصلين، مع ممثلتين سوريتين استثنائيتين هما "أمل عمران" و"حلا عمران" اللتين أدّيتا أدوارًا رئيسيّة في الفيلم. الحواران، محاولة لسرد جانب من قصة صناعة ذلك الفيلم الاستثنائي، والذي يتميّز بالحضور النسائي الفعّال والمؤثر. لن يكون حواري معهن فقط حول الفيلم، بل سوف نتعرف على جزء من تاريخ هاتين الممثلتين، الشخصي والمهني.
الجزء الأول من الحوار: الممثلة والمخرجة أمل عمران
تعتبر أمل عمران (مواليد 1967) من أبرز الممثلات في العالم العربي. تخرّجت من المعهد العالي للفنون المسرحيّة في دمشق عام 1989، وهي متواجدة بشدّة، سواء في المسرح أو التلفزيون أو السينما. عملت عمران مع أريان منوشكين (مخرجة مسرحيّة فرنسيّة) منذ العام 2004 حتى العام 2006 في مسرحيّة "جلجامش". علاوة على ذلك، عملت مع المخرج الكويتي الإنجليزي سليمان البسام، وقدّمت معه "ريتشارد الثالث- مأساة عربيّة" (2007) و"تقدم المتحدث" (2011)، وتمّ تقديمهما في العديد من المهرجانات العالميّة، وتلك الناطقة باللغة العربيّة. عملت مع المخرج الإنجليزي "تيم سبل" في مشروع "ألف ليلة وليلة" الذي عُرض في مهرجان إدنبرة في العام 2014، وعلى مونودراما "هاك" الذي عرض لأول مرة في مسرح كومباراشي 50 في إسطنبول. ومن أحدث أعمالها عرض "بينما كنت أنتظر"، وهو من كتابة محمد العطار وإخراج عمر أبو سعدة. منذ العام 2017، تشغل عمران منصب المدير الفني لـ COLLECTIVE MA’LOUBA.
علاقتي الشخصيّة معك كانت نتيجة للقاءات متعدّدة، و في أكثر من مناسبة. لكن الأكثر تأثيرًا بي، أنّك درستني "فن التمثيل" في السنة الثالثة في المعهد العالي للفنون المسرحيّة لفصل واحد (2002-2003). أذكر أمل عمران أستاذة المسرح التي شعرت معها بالكثير من الحريّة، و بقيمة ما أقدّم، وهو شعور لم أختبره كثيرًا مع أساتذة آخرين عملت معهم، باستثناء أستاذين، هما أنتِ، و الأستاذ غسان جباعي. أن يكون لدى الاستاذ حسّ الدهشة بما يقدّمه الآخر (الطالب)، أن يُحبّ ما يفعله الآخر، و أن يكون قادرًا على بناء شيء ذي قيمة معرفيّة و إنسانيّة مع طلابه، أن تكون عملية التعلم، عملية قائمة على البناء المشترك والاكتشاف بدلًا عن العمل على بنية جاهزة ومفصّلة بشكل مجرّد ومنفصلة عن شخصيّة المتعلّم وعلاقته بالمعلم ومادة الدرس. من هذه النقطة المتعلقة بذاكرتي الشخصيّة عنك، أود أن أسأل، ما الذي جعل أمل عمران هذا الشخص المختلف كممثل وكأستاذة مسرح. كيف اخترتِ مهنة التمثيل؟
بالغلط (تضحك). اسمع… في اللقاءات التي يجريها الصحفيون مع الممثلين، و في إجابتهم عن سؤال مماثل يقولون إنّهم جاؤوا إلى هذه المهنة بالصدفة. هذا فعلًا ما حدث معي. كنتُ قد اخترتُ أن أدخل "المعهد المتوسط الفندقي السياحي"، لأنّني لم أتمكن من إنهاء كلّ مواد السنة الأولى في كلية الحقوق، كما أنّ معاهد الموسيقى لم تقبل بي (كنت أعزف آلة الأوكورديون بشكل سيء)، وأقصى ما أعرفه هو عزف النشيد الوطني على تلك الآلة. لم يكن لديّ أي خبرة في أيّ شيء. إحدى صديقاتي اقترحت عليّ التسجيل في المعهد الفندقي، قالت لي إنه يحتاج إلى واسطة من شخص مهم في الدولة، كانت تعرف شخصًا اسمه (نبيل عمران) وتبرّعت بالتوسّط لي عنده. المعهد المتوسط الفندقي كان موجودًا قبالة المعهد العالي للفنون المسرحيّة القديم في منطقة دمر.
"وفاء محمد" كانت السبب في دخولي إلى المعهد العالي للفنون المسرحيّة دون أن تدرك ذلك. كان لديها صديقة اسمها ميادة ذيب، تدرس في السنة الرابعة في المعهد العالي للفنون المسرحيّة قسم التمثيل، قالت لي وفاء، لنذهب لشرب القهوة مع ميادة في المعهد المسرحي المقابل للمعهد الفندقي، و هذا ما حدث. قبل ذلك بفترة، كنت قد قرأتُ في الجريدة الرسميّة إعلانًا للمعهد العالي للفنون المسرحيّة يتعلق بفتحه باب التقدّم لفحص القبول. كانت الجريدة بيد ابنة جيراننا التي قالت لي إنّ هذا المعهد يقدّم رواتب للطلاب المقبولين فيه. سألتني: لمَ لا تتقدمين لفحص القبول؟ إنّهم يدفعون راتبًا شهريًا قدره 400 ل.س. كان هذا الإجراء يهدف إلى تشجيع الطلاب من الإناث على التسجيل والالتزام بالمعهد ودوامه.
في أيّ عام كان هذا؟
قرأت الإعلان بعد صدور نتائج الفصل الأول لكلية الحقوق عام 1985، وكانت نتيجتي هي الرسوب في كلّ المواد. كنتُ في حالة ضياع، لا أدري ما الذي يجب عليّ فعله. أهلي كانوا في صافيتا حين كنتُ أذهب لتقديم الإمتحانات في دمشق، كنت في الغالب أقدّم ورقة بيضاء خالية من أيّ إجابة، ليأتي اقتراح صديقتي بأن أتقدّم إلى المعهد الفندقي.
ذهبتُ مع وفاء للقاء الطالبة في المعهد العالي للفنون المسرحيّة، ميادة ذيب، ولشرب القهوة. لم يكن في بالي على الإطلاق التقدّم للدراسة هناك. كانت ميادة من دفعة غسان مسعود، وماهر صليبي، و دلع الرحبي، أولئك الأشخاص الذين تعرّفت عليهم لاحقًا. كان شكلي حينها غريبًا للغاية، أشبه كثيرًا الأولاد في عمر الثالثة عشر. رأس و كتلة، مع ساقين رفيعتين.
كنتُ قبل ذلك قد أجريت عدّة عمليات جراحيّة لساقي، وكنتُ قد استخدمت العكاكيز للتمكّن من المشي فترة من الزمن، وهذا أدى بدوره إلى ضمور عضلات جسمي بشكل عام، وعضلات ساقيّ على وجه الخصوص. كانت غريبة، بالنسبة إليّ، فكرة أنّهم يمثّلون في ذلك المكان.
عندما جلسنا لاحتساء القهوة مع ميادة، قرأت طالعها في الفنجان، كنت أتحدّث وأضحك كثيرًا في ذلك الوقت. ميادة كانت معجبة بضحكتي و بطريقتي في الحديث، قالت لي: لمَ لا تتقدّمين للدراسة في معهد التمثيل، إنّهم يبحثون عن طالبات. كان الأمر مفاجئًا بالنسبة لي، ولم يكن لدي أيّ فكرة عن المتطلبات التي يجب أن تتوّفر في المتقدمين إلى المعهد. اكتشفت حينها أنّ المعهد يحتوي على قسمين: قسم النقد والدراسات المسرحيّة، وقسم التمثيل. قلت لها: أنا لا أعرف أيّ شيء عن هذا الموضوع، فطلبت مني مرافقتها إلى مكتب المدير الإداري للمعهد العالي حينها، الأستاذ إبراهيم فيلو، وكان يوم خميس. طلب مني الحضور يوم السبت لتقديم طلب التسجيل في المعهد. قلت له: أتقدّم بماذا؟ أجابني، "ميادة تستطيع مساعدتك (دبري راسك)". بعد خروجنا من المكتب طلبت إليّ ميادة القدوم يوم الجمعة إلى منزلها للتدرّب على فحص القبول.
إياس، أنا لست شخصًا مثقفًا على الإطلاق (تضحك بمرح)، لولا الحوادث و العمليات الجراحيّة لم أكن لأقرأ كتابًا واحدًا في حياتي. في تلك الفترة أحضروا لي مجموعة من الروايات.
إذا سألتني في عالم الكتب، فأقصى ما أعرفه هو رواية زوربا أو روايات ماركيز وكولن ويلسون، كنتُ قد قرأت كلّ تلك الروايات، لكن قراءة المسرح؟ كان هذا أمرًا جديدًا عليّ. لم أكن قادرة على قراءة المسرح، ليس لدينا تلك الثقافة المسرحيّة في سوريا. فقط تلك التجارب المسرحيّة في المدرسة، كمسرحيّة أديناها في الصف الرابع بمناسبة عيد الأم. مسرحيّة تتحدّث عن مقدار حبنا لأمهاتنا، تلك كانت ثقافتنا المسرحيّة. حتى أنّه لم يكن هناك أيّ علاقة لعائلتي بالمسرح كي يكون لي شغف التمثيل. كان مفهوم التمثيل في عائلتنا هو امتلاك الشخص القدرة على الكذب و القدرة على إضحاك الآخرين، كانت المرجعيّة الموجودة عن التمثيل هو ما يقوم به عادل إمام وغيره من نجوم الكوميديا العربيّة؛ القدرة على إلقاء النكت والإفيهات. لقد شاهدت عروضًا هزليّة من هذا النوع، عروض لطلحت حمدي، و غيرها من العروض التي كنّا نشاهدها على خشبة المسرح التجاري كعرض "العز للرز والبرغل شنق حاله". شعرت ميادة بالعجز معي، قالت: يجب أن تحفظي مونولوجًا مسرحيًا. قلت لها "أنا لن أحفظ أيّ شيء"، تخيّل إنها تطلب مني حفظ مونولوج مسرحي. أكثر شيء استطعت حفظه هو قصيدة نزار قباني (إنّي خيرتك فاختاري)، كان حفظها ممكنًا لصغر حجمها فقط. تدربت على مشهد إيمائي يظهر شخصًا يقوم بخياطة ثوب ويوخز إصبعه بالإبرة (تضحك ساخرة).
أحوال المسرح السوري اليوم
17 أيار 2021
دخلت المعهد مرتديةً ثوبًا استعرته من أختي. كان شعري شديد القصر، مع القليل من أحمر الشفاه والكحل وحذاء بكعب متوسط. لم أكن قادرة على السير بسبب ذلك الحذاء. كلّ ذلك لإبراز أهميتي أمام اللجنة. عندما دخلت رأيتُ أشخاصًا لا أعرفهم، لكني حظيت بفرصة التعرّف إليهم لاحقًا: نائلة الأطرش، د.ماري إلياس، نونا تين، ستيلا خليل (رحمها الله)، صلحي الوادي، د. نبيل حفار، إبراهيم فيلو المدير الإداري للمعهد.
كان هناك كرسي فارغ على طرف سلسلة المقاعد التي كانوا يجلسون عليها، أنا وعند دخولي عليهم، اتجهت مباشرة إلى الكرسي الفارغ وجلست. صرخ بي أحدهم قائلًا: "قومي وقفي على حيلك، شو وين مفكرة حالك؟". هذا كان أول ما تعرّضت له أمام تلك اللجنة، كان ردّي أن قلت: "ليش عم بتعيط؟ إيه بوقف، شو خايفة منك؟". ثم سألت اللجنة الإذن بخلع حذائي ذو الكعب لأنّه يؤلم قدمي ويشلّ حركتي. سمحوا لي بخلع الحذاء، وسألوني عمّا جهزته لفحص القبول (تضحك من نفسها ساخرة). قلت "أنا ماني محضرة شي، أنتوا اسألوني، أو أخبروني بما يجب فعله وسأقوم به". ما أذكره أنّ الدكتور نبيل حفار أعطاني كتابًا لأقرأ منه، لم أتمكن من القراءة بالفصحى.
طرحت عليهم الكثير من الأسئلة البلهاء، كأن أسأل عن معنى كلمة "صامولة" و"بسطار"، لم أتمكن من القراءة بشكل صحيح، كنت أرتكب كلّ تلك الأخطاء مثل قول "إزا" بدلًا عن "إذا"، أو "زهب" بدلًا عن "ذهب"… إلخ. شعرت بالضيق، وسألت نفسي: ما الذي جاء بي إلى هنا؟ ثمّ مَن هؤلاء الأشخاص ليكون لهم الحق بسؤالي كلّ تلك الأسئلة؟
كان الأمر بالنسبة لي بسيطًا: اقبلوني أو ارفضوني وخلصوني. كنتُ أرى الأمر بهذه البساطة، كأيّ طالب تقدّم للدراسة في أيّ فرع آخر في الجامعة. تحصل على مجموع مناسب في البكالوريا، يُسمح لك بدراسة الحقوق، أو التمثيل (تضحك).
كنتُ قد بدأت بقراءة قصيدة نزار، و كنتُ في قمة غيظي، ونونا تين كانت تقوم بحركات غريبة على ظهري أثناء إلقائي القصيدة، عندما وصلت إلى الجملة التي تقول (فجبن ألا تختاري) نظرتُ إلى نائلة الأطرش وألقيت الجملة في وجهها. حمّلت الجملة كلّ غيظي. كنتُ أطلب من نائلة أن تختار، فهي المؤثرة في تلك المجموعة. خمسون دقيقة استمرت تلك المقابلة بحسب صديقتي التي كانت تنتظرني في الخارج. المشهد الإيمائي الذي قدمت كان ضعيفًا بالنسبة لهم، طلبوا مني أداء مشهد آخر، فاخترت الانتظار.
في ذلك المشهد أنا لم أمثل بل قمتُ باستحضار مشهدٍ من ذاكرتي. كنتُ أنتظرُ شابًا سوف يحضر لي بنطال جينز قد أوصيته عليه. كنتُ أنتظر في الحديقة، والشباب المتواجدون هناك تحرشوا بي. كنتُ غاضبة وأزفر بقوة، ثم بدأتُ بالردّ على تحرشاتهم (هي لأختك يا حيوان)، هذه كانت طريقتي بالردّ في تلك المواقف.
طبعًا أثناء أداء المشهد أمام اللجنة ردّدتُ تلك الشتائم، وهم يحاولون إفهامي أن أنفذ المشهد إيمائيًا (أيّ بدون أيّ كلام، فقط حركة). كنتُ وأنا أنفذ المشهد أستحضر كلّ تلك الوجوه والمواقف التي صادفتها في ذلك الانتظار في حديقة الجاحظ.
سألتني نائلة: لماذا اخترت التمثيل يا أمل؟ فقلت لها أنا لا أرغب بدراسة التمثيل، أريد دراسة النقد المسرحي. الدكتورة ماري إلياس علقت بصيغة سؤال: هل قرأت نصًا مسرحيًا واحدًا من قبل؟ أجبتها: لا، لكن يمكنك سؤالي عن "كولن ويلسون"، أسأليني عن الأسماء التي أعرفها، من هذا موليير؟ لم أكن أعرف شيئًا، حتى أبسط المراجع الأدبيّة. كان تبريري لرغبتي التقدّم إلى المعهد، أنّ الممثلين الذين يظهرون في المسلسلات التلفزيونيّة غير مقنعين. كان هناك مسلسل اسمه "الطبيبة" بطولة جيانا عيد، كنت أمقت تمثيلها، ورحت أقلّد لهم كيف أنّها تتظاهر بعزف البيانو بطريقة كوميديّة، لو أنّ هذه الممثلة درست فن التمثيل لكانت أقدر على تنفيذ المطلوب من الدور. قالت لي نائلة: "جيانا عيد خريجة المعهد". (تضحك) سألتني نائلة: إن قبلناكِ في المعهد، ماذا ستفعلين؟ كان جوابي مباشرًا: سوف أعلمكم التمثيل. كان هذا آخر ما تفوّهت به، وخرجتُ من الغرفة على ضحكات نائلة التي لا تضحك. بعد أن دخلت المعهد، وعملتُ مع نائلة ثم بدأتُ التدريس، كانت دائمًا تذكرني بتلك الجملة. في سنتي الأولى تسليت كثيرًا، حتى أنّني رسبت في الفصل الأول.
من هم أبناء دفعتك في المعهد؟
علي شهابي ونضال سيجري... رحمهما الله.
هل تعلمين أنّ أول عرض مسرحي عملتُ فيه في حياتي، و كان عملًا للأطفال (حكاية الوصّية 1998) من إنتاج المسرح القومي في دمشق، وكان من إخراج نضال سيجري. المسؤول عن تدريبي كان علي شهابي؟
نضال وعلي أصدقاء عمري. كانوا الزعران وأصحاب الأفلام الهنديّة.
علي شهابي هو من أفهمني المعنى الحقيقي للمسرح.
يا إلهي ما أجمل علي! هو أهم من أهم شخص تخرّج من المعهد بالمناسبة. كنت أسميه (الكحولي النبيل) لقد كان رجلًا نبيلًا.
بعد مرور سنة المعهد الأولى، تبدّلت حياتي بشكل تام. لا أعرف ما الذي حدث لي! الكثير من الحب للمكان الذي كنت فيه (أيّ المعهد)، ما هذا المكان الذي لا يشبه حياتنا في الخارج؟ تجربة الدراسة في المعهد لا تشبه ما نقوم به في الحياة الاعتياديّة مع العائلة والأقارب. تجد نفسك بين أشخاص مختلفين، مسيّسين. بذلت جهدًا كبيرًا في القراءة تلك الفترة، للّحاق بركب زملائي. أيامي في المعهد من أجمل وأصعب أيام عمري. المواد التي كنّا ندرسها مثيرة للاهتمام ومسليّة.
كنّا نتدرّب على الليونة، الرقص، التمثيل، الموسيقى، وإلى جانب دراسة الموسيقى كانت لدينا محاضرات في التذوّق الموسيقي. كان كلّ ذلك جميلًا وممتعًا. أين يمكنك إيجاد مكان مماثل في بلد مثل سوريا؟! قد تكون تجربة كلية الفنون الجميلة مماثلة لفرادة فضاء المعهد العالي، لكن بالمقارنة مع المواد في كلية الحقوق، فالأمر مختلف. القانون الدستوري كتاب حجمه أكثر من 800 صفحة، أو القانون الروماني.. إلخ. مواد جافة.
في المعهد كان الممتع هو الجانب العملي من التجربة. كان للمعهد لباس موحد خاص به. جلب ذلك اللباس إلى المعهد الخبراء الروس (المعلمين الروس). فتيات المعهد يرتدين تنورة وكنزة سوداء، مع جوارب طويلة بيضاء. إنّها حياة مختلفة. تعلّمنا فنّ الإلقاء والصوت. جاءتنا معلمة إنجليزيّة في السنة الأولى (سالي جريس) كانت تلعب معنا طوال الوقت، وتحفّز خيالنا. كنتُ صاحبة خيال خصب، وأصدّق ما أرى. إلى اليوم، لديّ صعوبة في أداء دور لا أستطيع تصديقه، أو مقتنعة به. أفقد القدرة على التمثيل في تلك الحالة. إذا لم أكن في شروط حقيقيّة تدفعني للتصديق، بالعلاقة مع الشركاء و الحوار، لا أستطيع التمثيل.
المعهد وبالنسبة لجيلي من الخريجين (2004-2005) كان مختلفًا عن كلّ ما عشناه خارج أسواره، أقول هذا للتأكيد على ما ذكرته عن تجربتك. كان المعهد العالي للفنون المسرحية مثل جزيرة معزولة شكّلت درجة مختلفة من الوعي الحسيّ والجماليّ والفكريّ، ونوعيّة النقاش المطروح، والاكتشاف لذاتنا الإنسانيّة عبر فنون الأداء.
بالضبط.
دعيني أركز في سؤالي التالي على فكرتين، قد ذكرتيهما في معرض الحديث، الأول هو موضوع التوّجه لإشراك أكبر عدد من النساء بين طلاب المعهد، والثاني هو التنوّع السياسي داخل المعهد، والذي يُخالف حالة اللون السياسي الواحد في الخارج؟ الشيوعي إلى جانب الليبرالي… إلخ. ذلك التنوّع في الفكر السياسي كان محسوسًا بالنسبة لي في الفترة التي درست فيها هناك. كان واضحًا أنّ الأساتذة غير مسيّسين، بل كلّهم بعثيين، ليس فكريًا بالضرورة، بل عمليًا. حدثيني عن حالة المعهد في فترة الثمانينات من وجهة نظرك كامرأة متواجدة في ذلك المكان.
في البداية لم يكن التنوّع الفكري السياسي محسوسًا بالنسبة لي. في السنة الأولى عملت مع المعلّمة "نونا تين"، وكان التحدّي الكبير بالنسبة لي هو تطوير نفسي لمجاراة زملائي. لقد كان جسمي عندما دخلت المعهد مُدمّرًا، لم أكن قادرة على تنفيذ تمارين الليونة كما كان يؤديها زملائي. تطلّب ذلك مني زمنًا طويلًا. قضيتُ العام الأول أنفّذ تمارين كانت تعتبر سهلة، كأن تجلس القرفصاء على سبيل المثال. يفترض أن يكون ذلك تمرينًا سهلًا، أنا لم أكن قادرة على تنفيذ تمرين بهذه البساطة. "نونا تين" المُدرِّسَة الروسيّة، قامت بإعادة تأهيلي الجسدي والفكري لكونها المشرفة على الدراما في قسم التمثيل. كانت أستاذة الليونة والرقص والقتال المسرحي والإيقاع الحركي… ثم درّستنا التمثيل كمشرفة على أيمن زيدان الذي كان يعطينا التمارين طوال الأسبوع، ثم تأتي هي في نهاية الأسبوع لإعطاء التوجيهات النهائيّة.
كنت أنا وعلي شهابي ونضال سيجري الأهم بين طلاب دفعتنا. لقد كنّا حقيقيين جدًا. أغلب الطلاب كانوا قد مارسوا المسرح في منظمة شبيبة الثورة مذ كانوا في الثانية عشر من العمر، هذا طبعهم بطابع أدائي (كليشيه) في الصوت والحركة. كان من الصعب التخلّص من ذلك أو تبديله. كانت تحاول تكسير تلك الطرق السطحيّة في أداء الطلاب طوال الوقت. كليشيه.. كليشيه.. كليشيه.. الأشكال الجاهزة للأداء (تمثيل العنف يكون بهذه الطريقة، القوة يجب أن تظهر بهذا الشكل) بينما كنتُ مع علي و نضال قد دخلنا في تقنية المونولوج الداخلي. كان هذا شيئًا مدهشًا بالنسبة لي، لأنّه كان يستطيع تحديد ما يدور في دواخلنا أثناء الأداء. المونولوج الداخلي ليس أن تضع مونولوجًا طويلًا لتتمكن من الحديث لمدّة ثلاثة ساعات. المونولوج الداخلي هو: النشاط الحاصل في الذهن. ما الفعل المرافق لذلك التفكير الداخلي؟ هل هناك توافق بين ما تفكر به، وبين ما تفعل؟ كان هذا مذهلًا بالفعل. بتّ أنظر إلى الصور لتحليل المونولوج الداخلي للشخص الظاهر في الصورة. كانت تلك التمارين مسليّة للغاية.
في السنة الثانية بدأتُ تحسّس الخلفيّة الفكريّة لمعلمينا في المعهد، مثل الفرق بين جهاد سعد خريج مصر، وفواز الساجر الشيوعي الذي بات رئيسًا لقسم التمثل. لم أعرف في حياتي الانتماء السياسي والفكري للدكتور نبيل حفار. نائلة الأطرش كانت ذات توجهات فكريّة واضحة. بدا واضحًا الصراع الفكري بين كلّ تلك المدارس الفكريّة، لأنّهم مسيّسين، ولأنّ معظمهم درس في دول اشتراكيّة. حينها يبدأ التفكير بمَن مِن الأساتذة هو الأقرب لتفكيرك. في الحقيقة، كلّ مناهج تدريب الممثل المنتشرة في العالم قائمة على تأثيرات المدارس الروسيّة في تدريس الأداء. هذا ما استثمرت فيه معلمتنا الروسيّة، العمل على ضبط الشخصيّة المؤداة، مع ترك هامش من الحريّة للمؤدّي. إنّ عملية الأداء وبناء الشخصيّة تتطلّب فهمًا عميقًا للحيثيات المرتبطة بتلك الشخصيّة. العملية ليست سهلة وتحتاج إلى وجود موقف فكري من الطريقة التي تؤدي بها شخصيتك المسرحيّة.
إذا ما طُلب منك أداء شخصيّة تنتمي لحزب ما، وأنت غير مطلع على أفكار ذلك الحزب فأنت غير قادر على تنفيذ الدور. لذلك يُطلب منك كمؤدّي أن تكون مطّلعًا ومثقفًا وباحثًا في الفترة التاريخيّة التي تعمل عليها. من غير الممكن فهم تشيخوف بمجرّد قراءة أعماله. وهذا ما كان يحدث لاحقًا، كأن تحوّل عملًا لتشيخوف إلى عمل سوري!! قبل أن تقوم بعملية الإقتباس وجلب العمل ليصبح سوريًا مع كلّ التابوهات الموجودة في مجتمعنا، عليك أن تفهم العمل الروسي ضمن سياقاته الفكريّة والتاريخيّة. يجب أن تفهم الدافع الذي حدا بالكاتب للتفكير بهذه الطريقة والكتابة بهذا الأسلوب، وهذا كلّه حدث قبل الثورة البلشفيّة. ما الذي تعنيه لنا تلك الفترة الزمنيّة التي كتبت فيها تلك الأعمال، قبل الثورة، وأثناءها وبعدها.
التجربة المسرحيّة السوريّة الناشئة في أوروبا
07 حزيران 2021
عندما أنجزنا مسرحيّة "النورس"، كنتُ حينها مساعدة مدرس لأستاذة روسيّة كانت تُدرّس السنة الرابعة، دفعة حلا عمران ومحمد آل رشي ورمزي شقير. في تلك اللحظة بدأت فهم الشخصيات الموجودة في المسرحيّة و دوافعها. إنّ هذا التحليل العميق للمجتمع الروسي قبل الثورة ومن خلال صراع الشخصيات في العمل سترى الثورة القادمة بالضرورة كنتيجة لكلّ ذلك. وهذا يمكن أن ينسحب على أعمال أخرى كـ"الخال فانيا"، و"بستان الكرز"، ومجمل أعمال تشيخوف. سوف تدرك فورًا إلى أين كانت تلك البلاد متجهة. حقيقةً إذا لم يكن لديك شكل من أشكال الفهم لذلك سوف تكون عمليّة الأداء صعبة. الأمر لا يتطلب موقفًا سياسيًا من الحدث، بل مجرّد فهم للظروف التاريخيّة والاجتماعيّة والسياسيّة للعمل المسرحي. كان هناك اختلافات سياسيّة وفكريّة بين الطلاب؛ ذلك الطالب الليبرالي وصراعاته الفكريّة مع زميله الشيوعي المُنظّم في حزب العمل الشيوعي السوري (الذين كانوا يتعرّضون للاعتقال حينها) سوف تفهم طبيعة ذلك المعهد الواقع على حافة مدينة دمشق، وسوف تتمكن من تأمل كلّ تلك التناقضات لتدرك المكان الذي تسير إليه الأوضاع في بلد كسوريا.
كان هذا كشفًا كبيرًا بالنسبة لي، أنا ابنة الضابط في الجيش السوري. كان من الصعب عليّ فهم كلّ ذلك التنوّع لولا أن دخلت إلى المعهد، و لولا أن كان لي رغبة حقيقية للفهم. أمّا موضوع تمكين النساء، فقد كان نابعًا من الحاجة لتواجدهن في مكان كالمعهد العالي للفنون المسرحيّة. في الدفعة التي سبقتنا لم يكن هناك فتاة واحدة. تخرّج من تلك الدفعة تسعة شباب، من تمكّن من البقاء في دفعتي فقط ثلاثة بنات. أنا، بثينة شيا، وليلى عوض. كان عدد الخريجات من المعهد قليلًا جدًا. ثلاثة في الدفعة الأولى، واحدة في الدفعة الثانية وهكذا. كان دائمًا عدد الذكور أكبر. بعد ذلك تغيّر الأمر، بات عدد النساء المتقدّمات إلى المعهد أكبر.
تخرجتِ في العام 1989، حدثيني الآن عن الاحتراف، هناك صناعة تلفزيون صاعدة، و لدينا المسرح القومي، و السينما.
دعني أقل لك إنّني لم أتعرّض للإغواء. عندما تخرجت من المعهد، كان من المفترض أن أبدأ العمل في التلفزيون، وهذا جاء بعد وفاة فواز الساجر الذي أثّر فيّ كثيرًا. كان قد درسني مبادئ الإخراج في السنة الثالثة، وتوفي في نفس السنة. كان لقاؤنا الأسبوعي يمتد لأربع ساعات، مدهشاً. كان الجلوس للاستماع إليه يتحدّث أمرًا مثيرًا للاهتمام. بغض النظر عن رأي الآخرين فيه بعد ذلك. المحاضرة مع فواز الساجر كانت، فعلٌ صغير يقوم به أحد الطلاب على الخشبة ليجلدك بعدها لمدة أربع ساعات مناقشًا الفعل واللحظة الأولى.
كان الممتع هو نقاش خلفيات ذلك الفعل البسيط لنتعلّم عدم وجود ثرثرة أو فعل مجاني على الخشبة. لقد تعلّمنا أن نجاوب عن كلّ تلك التساؤلات فقط من خلال الفعل الأول. إذا كان لدينا مكتبة كجزء من ديكور المسرحيّة، والإضاءة تُفتح على كتب المكتبة المتناثرة على الأرض، يجب أن نفهم دافع تناثر تلك الكتب قبل أن ينطق أيّ ممثل بكلمة. إنّ سؤال الفعل الأول في فن الأداء المسرحي من أصعب ما يكون. أنت هناك لتعرف، لماذا تقوم بتدخين السيجارة؟ ليس الأمر فقط متعلّق بحالة الشخصيّة النفسيّة. لماذا كتب الكاتب ذلك الفعل؟ ما الذي يرغب بقوله؟ ولديك كمؤدّي كلّ تلك الاحتمالات الجميلة لمحاولة الإجابة على تلك التساؤلات، حتى يصل الدور للمخرج لإنهاء الجدال حول المعنى المطلوب إيصاله. هذا كلّه كان بالنسبة لي شديد الإغواء. عملت في سهرتين تلفزيونيتين بعد التخرج ولم أتمكن من الشعور بتلك المتعة الموجودة في المسرح، على الرغم من أنّهم صفقوا لأدائي.
مع من كانت تلك التجربتين؟
مع هيثم حقي، كان شعري طويلًا في السنة الرابعة، وغضب مني كثيرًا بعد ذلك عندما قصصته قصيرًا مجدّدًا. ومع مأمون البني بعد قصّي لشعري. احزر ما هو سبب قصي لشعري؟ فقط لأنّهم قالوا لي إياكِ وقصّ شعرك، فهذا سوف يؤمن لك فرص أكثر في التمثيل التلفزيوني، فقمت بقصّه. هذا هو شكل عقلي. وبالتالي لم يكن ذلك مغويًا بالنسبة لي.
أنا شخصيًا لم يكن هذا ما أبحث عنه. كان في داخلي الكثير من الأسئلة، دعني أقل إنّ في داخلي اضطراب ما. لم أقبل أن ينتهي العمل في المعهد بعد أربعة سنوات، كان أمرًا سخيفًا بالنسبة لي. لم أجب بعد عن الأسئلة الموجودة في داخلي. وهذا ما جعلني أكوّن وجهة نظر، وهي أن أكون ضد فكرة الاحتراف، وألّا أدّعي الاحتراف على الاطلاق. دعني أقل إنّ مفهومي عن الاحتراف مرتبط بأمرين حاليًا: احترام مواعيدي، واحترام الأشخاص المتواجدين معي على الخشبة وكلّ الأشخاص المشاركين في العمل من صغيرهم لكبيرهم، ثمّ احترام فكرة الاستماع؛ الاستماع إلى المخرج، والاستماع إلى الجميع. هذا ما يعنيه لي الاحتراف. في تجارب سابقة، كان بعض المخرجين لا يستمعون إلى ما تقول، في بعض الأحيان ليس مسموحًا لك بالكلام. يناقشون ليومين ما يدور في العمل ثم يفرضون عليك إنهاء النقاش لتنفيذ أوامر محدّدة. في تلك التجارب لم أستطع التأقلم مع زملائي وكأنّني قادمة من عالم آخر.
كنت أشعر بنفسي أنّني أكثر حريّة من تسعين في المئة من الناس الذين تواصلت معهم. وبالتالي كان عندي بديهيات لم يكن يفهمها غير علي شهابي أو نضال سيجري. كانت بديهياتنا ليست بديهيات بالنسبة للآخرين. كنت أتحدث بلغة مغايرة للّغة المستخدمة من قبلهم. هذا ناهيك عن موضوع التحرّش الذي يمكن أن تتعرّض له. أستطيع التفكير بأنني من أقلّ الأشخاص الذين تعرّضوا للتحرّش من بين زميلاتي الممثلات لأنّني كنتُ قويّة جسديًا، فكنتُ أردّ بالضرب على المتحرّش بي. كنتُ أخلع حذائي وأنهالُ بالضرب على ذلك المتحرّش. لا أملك مقدرة التفكير قبل القيام بالفعل. كنت ببساطة أردّ ّبشكل مباشر. أن تكون لديك شخصيّة من هذا النوع لا يتيح لك الكثير من الفرص، و بخاصة عندما لا يكون هناك أيّ نوع من أنواع الإدانة لأفعال التحرّش واعتبارها عاديّة لا تستدعي ردّة الفعل تلك. أنا كنتُ أفضحهم، وأردّ عليهم بشكل قاسي (إيدك بكسرلك ياها إذا بعد بتمدا). تفاصيل من هذا النوع. أنا هنا لا أدين الزميلة التي قبلت بالتحرّش، لأنّني ببساطة كنتُ محمية من عائلتي ولم أكن في حالة عوز. هناك بعض الزميلات كنّ يتعرضن لتلك الأمور ويسكتن لأنهنّ في حاجة للعمل مع غياب دعم العائلة والأمان المادي، مع الغياب التام للنقابة في حماية أعضائها من السيدات. هناك الكثير من الأسباب التي تدفع النساء للسكوت عن تلك التجاوزات بحقهن. لذلك قررت السفر، حصلت على منحة وسافرت.
في أيّ عام وإلى أين؟
سافرت بعد عام من التخرج إلى الولايات المتحدة الأمريكيّة. بقيت عامين هناك، ثم ذهبت إلى جمهورية التشيك لقضاء عامين آخرين. حصلت على قبول في جامعة (كاليفورنيا ستيت - California State University CSU)، دبّر لي تلك المنحة "حاتم عقيل" الذي كان هناك، وقد كان خطيبي آنذاك. كانت منحة موّجهة للنساء من العالم الثالث. كانت تلك التجربة صدمة بالنسبة لي، كانوا يُدرّسون الطلاب تمارين تُعطى لطلاب السنة الأولى في المعهد العالي للفنون المسرحيّة في دمشق. كانوا متفاجئين من مقدرتي على التعبير، في الوقت الذي شعرت فيه أنّني لا أريد الاستمرار. طلبتُ إعطائي القيمة الماليّة للمنحة للبحث عن شيء ملائم أكثر لي. قلت لهم: سوف لن أقضي زمن المنحة ثلاثة أشهر، على تكرار تمارين بدائيّة. كنتُ أبحث عن شيء أكثر تقدّمًا. بدأت البحث. هناك تمكنت من العمل أكثر على جسدي. لم أعد تلك الفتاة ذات الساقين الهزيلتين، بات لي جسدٌ قوي مفتول العضلات. تعلمت الرقص (لا تعتبر أنّك الوحيد الذي تعلّم الرقص) أنا تعلمت ذلك أيضًا. تعلّمتُ الرقص مع معلمة أفريقيّة لستة أشهر. كنت سعيدة جدًا. إذا لم يكن هناك متعة في المكان الذي أذهب إليه، لا أذهب. لدي مشكلة حتى هذه اللحظة مع هذا الأمر، إذا لم أستمتع، سوف أجد الحجّة للمغادرة.
مشهور عنك ترك رسائل خلفك للمخرجين الذين تقرّرين تركهم.
هذا صحيح، تركتُ خلفي الكثير من الرسائل. فعلتها مع المخرج العراقي جواد الأسدي، قالوا إنه تعرّض لجلطة قلبيّة بسبب ذلك.
لم أستمتع. كنت مستمتعة بما أفعل، لكن المشكلة كانت مع الآخرين، كلّما قمت بفعل أعتبره حرًّا يتنطّح أحدهم لقتله. لقد فقدت القدرة على فهم ما هو التمثيل معهم. لم أستطع الاستمرار. قلت له إنّني لا أرغب في العمل مع نجوم. وفعلًا، إذا نظرت إلى تاريخي، سوف ترى أنّني لم أعمل كثيرًا مع "نجوم". نجوم في المسرح؟! لا وجود للنجوميّة في المسرح، ولا في التلفاز. فكرة النجوميّة فكرة مضحكة. إذا كان لديك تلك الشخصيّة المتعالية النرجسيّة لا أصدق أنّك قادر على صناعة الفن. لن تتمكن من صناعة الفن حتى تتمكن من إلغاء تلك المعادلة من ذهنك. قد يكون لها نقاط فائدة أن تكون نجمًا تلفزيونيًا أو سينمائيًا، كأن تتلقى أجورًا أفضل من الممثلين الآخرين.
الممارسات المسرحيّة السوريّة خارج حدودها الوطنيّة
21 حزيران 2021
بعضهم يتعرّض في بداياته لإذلال المحيط المهني، وعندما يصبح نجمًا، يبدأ بالانتقام منهم. في الولايات المتحدة الأمريكية، كنت متزوجة، لكنني انفصلت عن زوجي وغادرت إلى التشيك. هناك تقدمت إلى جامعة (تشارلس- Charles University) قمت بدراسات نظريّة.
بعد سقوط الاتحاد السوفيتي فرضوا رسومًا باهظة على الدراسة هناك، فعدت إلى سوريا. كنتُ قد قضيت عامًا مرافقة لأساتذة التمثيل، واكتشفت أنّني مولعة بتدريب الممثل. شعرتُ أن لا أحد يمكن أن يعطيك شهادة في تدريب الممثل. إذا سألني أحدهم ماذا درستي؟ فجوابي يكون: تدربت كصنايعيّة على يد معلمين في المسرح، هل حصلت على شهادة في تدريب الممثل؟ لا، لم أحصل على واحدة، لكني رافقت حرفيين، و تعلمت منهم. كان هذا في مسرح (ديفادلو- Divadlo theatre ) في العاصمة براغ.
هل تذكرين أول فيلم سينمائي شاهدته في حياتك؟
شاهدت الكثير من الأفلام في سينما راميتا، أهلي مرة أخذونا لمشاهدة فيلم سوري على ما أذكر (هذا الرجل في خطر) وأعتقد أنّهم ندموا على ذلك. كان الفيلم من بطولة منى واصف وهالة شوكت. في الفيلم مشاهد إباحيّة (تضحك) في أحد المشاهد يكون عبد اللطيف فتحي مستلقيًا في حوض الحمام، وزوجته أو عشيقته تقوم بتحميمه، ويظهر صدرها عاريًا في تلك اللقطة.
كما شاهدت خلال الرحلات المدرسية إلى السينما الأفلام المتعلقة بالمجازر الإسرائيليّة بحق الفلسطينيين كفيلم "كفر قاسم"، وشاهدت فيلم "سائق الشاحنة" والذي كان من بطولة عبد الرحمن آل رشي. كنّا ندخل في حالة بكاء جماعي عند مشاهدة هذه الأفلام. شاهدت كلّ المسلسلات بالأبيض والأسود، السوريّة منها والمصريّة. أتذكر منها مسلسل "الجرح القديم" ومسلسل "أسعد الوراق" و"حارة القصر"، كانت مسلسلات رائعة.
أشعر بأنّني محظوظة لأنّني ولدتُ في هذه الفترة. تفتّح وعيي فعليًا في العام 1973، لديّ ذاكرة عن شكل حياتنا، شكل حياة المواطن السوري العادي في تلك الحقبة. العائلة السوريّة في ذلك الوقت، والتي يوجد فيها موظف، أو أستاذ مدرسة تكون قادرة على قضاء العطلة الصيفيّة على شاطئ البحر. الكلّ قادر على استئجار شاليه، هذه كانت حقيقة. الكلّ لديه القدرة على الاستمتاع بالصيف، والقيام بنشاطات ترفيهيّة. أن ترى في أيامنا أناسًا يعانون من أجل لقمة العيش، هذا لم يكن موجودًا حينها. كان ربّ الأسرة لديه القدرة الماليّة على أخذ عائلته إلى البحر ولو لمدة أسبوع واحد.
كنّا نرافق جيراننا في بعض الأحيان في رحلة البحر. كان لدينا في المزة جيران من عائلة المارديني، والبيت الآخر من عائلة دمج. جيران متنوّعين طائفيًا وإثنيًا، عائلة دمج مسيحيّة، والمارديني مسلمين سنة. الكلّ على اختلافهم الدينيّة والإثنيّة كانوا يرتدون البكيني (رداء السباحة للنساء). كان هذا أمرًا عاديًا. الزوجات كنّ يرتدين ذلك الزي على البحر ويجلسن بشكل مختلط، بينما يلعب الأولاد من حولهم. السهر كان يستمر حتى ساعات الصباح الأولى مترافقًا مع الغناء والرقص والنشاطات الرياضيّة. كان هذا مثل السحر. كانوا يدفعون كلّ ذلك من رواتبهم. أمي معلمة مدرسة وأبي ضابط في الجيش ليس لديه سوى راتبه. وكان بيتنا مستأجرًا في دمشق. عمليًا، كنّا ننتمي إلى الطبقة المتوسطة في سوريا، وكانت تلك شريحة واسعة في المجتمع. ثمّ، حدث ما حدث في الثمانينات، النقلة الحقيقية كانت في الثمانينات، عندما نزل عناصر سرايا الدفاع إلى شوارع دمشق و حلب، وبدأوا بإجبار النساء على خلع الحجاب بالقوة، كنت حينها في الصف العاشر أو الحادي عشر، لم أكن صغيرة، أتذكر تلك الحوادث بشكل جيد. بعد ذلك اليوم، بات مفهوم الحجاب سياسيًا وليس دينيًا.
ردّة فعل الناس على فعل إجبار النساء على خلع الحجاب أن انكفأوا على أنفسهم. الجارات في الحيّ اللاتي لم يكنّ يرتدين الحجاب تحجبن. قائدة فريق السلة في مدرستي حينها، كانت تضع الحجاب في المباريات وهي ترتدي الشورت الرياضي، لم يكن أحد لينظر أو ينتبه أنّ ثمّة شيء غريب حدث. لا أذكر أنّه كان هناك فكر ديني متعصب. هذا التعصّب لم يكن موجودًا. كان هناك متدينين، لكن لا وجود للمتعصبين. الكلّ كان يصلي، والصيام في رمضان كان جميلًا جدًا. كان المسيحيون يوّقتون مواعيد غدائهم أو عشائهم على توقيت إفطار المسلمين في رمضان. هذه حقيقة. لم تكن عائلتنا تصوم في رمضان، لكننا لم نكن نأكل قبل موعد الإفطار، لأنّ هناك عادة (السكبة) وهي أن تحمل صحن من الطعام وتأخذه إلى جيرانك، الذين يفعلون الشيء ذاته معنا ومع الآخرين. فيما يخصّ اللباس، الناس كانت تتبع الموضة. الموضة ليست فقط في بيروت.
نضال الدبس:لماذا نحن دائماً وراء الكاميرا، بينما السلطة تقف أمامها؟ (17)
23 كانون الثاني 2021
كان هناك موضة في سوريا أيضًا، التنانير القصيرة والقصيرة جدًا كانت منتشرة في سوريا، وعلى مختلف المستويات الاجتماعيّة. عندما كانت الفتيات ترتدي التنانير القصيرة في شوارع دمشق، لم يكنّ يتعرضن للمضايقات. سرايا الدفاع غيّرت حياتنا. سرايا الدفاع أجبرت الناس على حبس أولادهم مع البنات في البيت. عندما أفلت النظام منظومته القمعيّة والأمنيّة في أواخر السبعينات على المجتمع السوري، رأيت التغيير بعينيّ، كان تغيرًا جذريًا. أنا ابنة منطقة المزة فيلات شرقيّة، وأستطيع القول إنّ سكان تلك المنطقة كانوا من الطبقة المتوسطة، وفيها أغنياء، لكن الأغلبية من الطبقة الوسطى. معظمهم كانوا ملاكين. توصيف ما جرى في حيّنا حينها، يعكس التغيرات الجذريّة التي كانت تحدث على مستوى سوريا بأكملها. جيراننا من بيت العظم على سبيل المثال، ربّ العائلة طبيب من أهم ما يكون، اتُهم بأنّه منتمي لتنظيم الإخوان المسلمين، وهذه قصة طويلة، لكن ما يهمني هو ابنته التي التحفت بالأسود من رأسها حتى أخمص قدميها، حتى أنّها صارت ترتدي القفازات أيضًا، صيفاً شتاءً. هذه كانت صديقة أختي المفضلة. هذا كان ردّ فعل الناس في الثمانينات. كان عناصر سرايا الدفاع يفعلون ما يريدون، إذا أعجبتهم صبيّة في الطريق يخطفونها. حوادث الاغتصاب باتت متكرّرة وكثيرة. كان رفعت الأسد يسكن حينا، ومركز السرايا التابعة له بات موجودًا عندنا في المزة فيلات. عناصر سرايا الدفاع ومرتين يوميًا في الصباح و المساء يخرجون لأداء تمارين النظام المنظم داخل الحيّ السكني لإفزاع الناس وتخويفهم.
أذكر جيدًا ما كان حاصلًا مع والدي الذي كان يراقب كلّ ذلك. كان يحضر أكواب الشاي الصغيرة المعبّأة بالوحل وينتظر على الشرفة حتى تمرّ إحدى سيارات سرايا الدفاع أو أبناء المسؤولين الذين كانوا يجوبون الحيّ بسياراتهم الفارهة ليقذفهم بتلك الأكواب. كانت هذه تسليته في الصيف (تضحك). لم يكن قادرًا على فعل أي شيء كبير، فكان يقوم بهذه الألعاب الإنتقاميّة الصغيرة، لأنّ الوضع بات فعلًا لا يُحتمل.
يجب أن تدرك أنّنا كنّا نواجه ذلك دون أيّة معلومات عمّا حدث في حماة وحلب. ما سمعنا عنه، هو تلك الحادثة في مدرسة المشاة، لكن لم نعرف ما الذي حدث قبل حادثة مدرسة المشاة. حادثة مدرسة المشاة كانت ردّة فعل. بدأت الحركة المسلحة للإخوان المسلمين، والتي قالوا إنّها كانت تتدرب في الأردن، وهذا ما أعطى الشرعيّة للنظام، أن يتحكّم بنا بحجة أنّ هؤلاء المسلحين سوف يدمرون الدولة. تمامًا مثل الحجة الفاشلة التي يستخدمها الآن بشار الأسد. في زمن والده حافظ الأسد تمكن من استخدام هذه اللعبة، و قام بارتكاب المجازر في معرّة النعمان وحلب وحماة بعد ذلك. لم نعرف بالتفاصيل حينها، لكنّنا سمعنا بعض الهمس من المعلّمات في المدرسة واللواتي اختفى بعضهن، ولم نعد نعرف عنهن شيئًا. لقد عايشت تلك المرحلة، كان بعض الطلاب مسلّحين في المدرسة، تخيّل استاذًا يعطي درسًا وأحد الطلاب يضع مسدسه على المقعد الدراسي! بدأت حينها مظاهر الانحلال المتطرف. قاموا ببناء بنايات الأربعين في المزة في الثمانينات. انتبه، هذه طريقة لحصار المحيط المدني في تلك المنطقة.
في بيتنا لم يكن عندنا ثقافة أو تربية طائفيّة، لم أكن أقول إنّني علويّة. لكنّني أعي جيدًا أنّ كلمة السب (اللعن) السريّة في نهاية السبعينات هي (علوي)-(علوي بعثي) إذا كنت تريد تنبيه أحدهم بقوة، كانوا يقولون: لا تتحدث إلى فلان إنّه بعثي علوي. عندما علمت أنّ والدي ينتمي إلى حزب البعث، وبأنّنا علويون، كان أمرًا عصيًّا على الفهم، كيف يمكنني مواجهة صديقاتي بهذه الحقيقة؟ كان لديّ صديقات كثر، وكان الكثير منهن إذا سمعت كلمة علوي ثلاث مرات تغيب عن الوعي. كلّ ذلك بسبب العنف الذي حدث حينها. كلّ من يقوم بالممارسات القمعيّة بات يُظهر حرف القاف في حديثه. أستاذ التربية العسكريّة في مدرستنا كان يستعملها على الرغم من أنّه لا ينتمي إلى المناطق التي تظهر حرف القاف في لهجتها المحليّة. لهجة القاف قبل ذلك التاريخ كانت تُعبّر عن البساطة. الناس في تلك القرى بالمناسبة، لا يتحدثون تلك اللهجة القاسية والمبالغ بها التي انتشرت فيما بعد. كانوا فقط يستخدمون القاف في الأحاديث، لكنك تستطيع فهم ما يقولون. ذلك التحوّل والتطوّر كان مقصودًا لدرجة أنّك فعلًا سوف تكره تلك اللهجة. باتت تلك اللهجة مرتبطة بالصباط العسكري. أوصلونا إلى مكان بتنا فيه غير قادرين على سماعها أصلًا. كان من يستخدم تلك اللهجة يتحوّل إلى مدان كابن للسلطة.
الخراب الحقيقي الذي شهدته كان بعد أن حصلت على البكالوريا ودخلت كلية الحقوق. كنّا نُضرب على باب الكلية إذا لم نكن نحمل بطاقة الطالب. والحزين في الأمر أنّنا كنّا نضحك عندما نتمكن من الدخول. كان مطلوبًا منّا ارتداء لباس موّحد في الجامعة، بالإضافة لبطاقة الطالب. تخيّل الازدحام في الصباح عند وصول الطلاب إلى باب الكلية، بينما هناك عنصريّ أمن يتحقّقان من التزام هذا العدد الهائل من الطلاب بالقواعد، لذلك بدؤوا بحمل العصي ليتمكنوا من تنفيذ المهمة. هذا كان طقسًا عاديًا ويوميًا. إذا كان هذا طقسًا اعتياديًا فتخيّل ماذا يحصل في البلد بشكل عام؟ إذا كان طلاب الجامعة يُضربون قبل دخولهم صفوف دراستهم ويتقبلونها، ليس فقط ذلك، بل نضحك على ما حصل ثمّ نذهب لشرب القهوة.
سادت مقولة "قتلة بتفوت و ما حدا بيموت" تلك السنوات، ورفعتْ عتبة الألم لدى المواطن السوري.
ونزلت عتبة الكرامة.
إذا صرخ رجل الأمن بأحدهم وقال "ولاه"، ثم ردّ الطالب بقول "ما بسمحلك تحكي معي بهل طريقة" فذلك يعني أنّه حتمًا سيتعرّض لضرب مبرح أمام الجميع، ولن يوقفوا ذلك العنف حتى يُدمى. ذلك كان الردّ الطبيعي. لم يعد أحد يجرؤ على قول "ما بسمحلك" لقد تنازلنا عن حقوقنا الأكثر بساطة. إلّا إذا كنت ستقول بعد تلك الجملة "أنا ابن فلان" وتقوم بتهديد عنصر الأمن. هذا أمر كنتُ أرفض استخدامه. كنت أسمح لأصدقائي باستخدام اسمي ومنصب والدي للعبور من بعض المواقف.
كانت صديقتي تستخدم بطاقتي وتقول إنّها ابنة اللواء علي عمران (تضحك). كانت صدمتي الحضاريّة كبيرة عندما سافرت في السنة الثالثة مع المعهد إلى فرنسا، كنتُ مندهشة ممّا رأيتُ هناك، بدأت بالصراخ (لن أعود إلى سوريا، لن أعود). الشرطة هناك تأتي إلى بيتك الساعة الثانية صباحًا لتطلب منك إخفاض صوت الموسيقى لأنّ الجيران يشتكون من الضجيج. تساءلت: "من هؤلاء الذين يقولون لك إنّ من حقك السهر لكن لو سمحت أخفض صوت الموسيقى؟".
في سوريا، الشرطة والأمن تداهم المنزل، والكثير من صديقاتي واجهن تهم بممارسة الدعارة لمجرّد وجودهن في سهرات حوار سياسي أو ثقافي. إنّ عدد المواقف اليوميّة من هذا النوع لا يمكن حصرها على الإطلاق. كان معتادًا في وسائط النقل العامة أن يأتي رجل مدني، لا يبدو عليه أيّ علامة على عمله في أجهزة الأمن، ويطلب من أحد الجالسين أن يترك مقعده ليجلس مكانه، الرجل قد يسأل: "لماذا علي فعل ذلك؟". الجواب سوف يكون بالضرب العنيف أمام الجميع لمجرّد أنّه سأل عن سبب تركه لمقعده. هذا كان يحدث بشكل يومي. إنّ عملية الترهيب التي بُنيت ابتداءًا من نهاية السبعينات إلى أواخر الثمانينات لم تكن عملية اعتباطيّة، بل كانت عملية منظمة. لقد تمّ تربية أجيال على فكرة أنّك قد تدفع حياتك وحياة أهلك لقاء كلمة واحدة. كان هذا واحدًا من أسباب سفري: الهروب من هذه الصورة العنيفة لهذا البلد.
دعيني أدخل في المحور الأساسي لهذا الحوار وهو محور السينما السياسيّة السوريّة. لنستند إلى كلّ الذي تحدثنا عنه. أنت الآن جزء من الوسط الفني و الثقافي السوري، لا بدّ أنك بتّ تعرفين مخرجين سينمائيين وفنانين ومثقفين. ضمن الظروف التي تحدّثنا عنها وكيف أنّ أيّ اجتماع عادي بين مجموعة من المثقفين أو المفكرين قد ينتهي بالاحتجاز والتشهير. إنّ أيّ سلطة قمعيّة تسعى إلى تفتيت كلّ شبكات العلاقات التي تنمو خارج نطاق سيطرتها ومراقبتها. واحدة من تلك الفضاءات التي نمت دون أن يكون للنظام سيطرة فعليّة عليها كان المعهد العالي للفنون المسرحيّة، لا أدري حاليًا ما هو وضع المعهد في السنوات الأخيرة لكنّني لا أعتقد أنّه حافظ على خصوصيته.
بكلّ تأكيد لا، عندما يقوم أستاذ بتهديد طلابه باستدعاء الأمن، فهذا دليل على سيطرة النظام على ذلك الفضاء.
الفضاء الثاني كان فضاء المؤسسة العامة للسينما، تلك المؤسسة التي أنتجت بالغالب أفلامًا غير متصالحة مع السلطة الحاكمة، وأعتقد أنّ تلك العلاقة الإشكاليّة ناتجة عن قرار الدولة على إبقاء ذلك الباب مواربًا، ليصبح الإنتاج ممكنًا، لكن العرض هو الممنوع، حتى أنّني سمعت أن حافظ الأسد كان يقرّر منع فيلم أو السماح بعرضه.
في الحقيقة، لم تكن علاقتي قوية بالسينما السوريّة. شاهدت فيلم "الفهد" لمخرجه نبيل المالح كما شاهده كلّ الناس. وشاهدتُ فيلمًا آخر عندما كنت طالبة في كلية الحقوق، قاموا بعرض الفيلم في الجامعة، وكان فيلم "أحلام المدينة" لمحمد ملص. أعتقد أنّ "أحلام المدينة" كان أوّل فيلم سوري رأيته في حياتي. كنتُ قبلها متابعة للأفلام الأمريكيّة والمصريّة، بالإضافة إلى الأفلام التجاريّة السورية بالطبع (أفلام دريد لحام على سبيل المثال). لكن فيلم "أحلام المدينة" كان الفيلم السينمائي السوري الأول ذو القيمة الفنيّة الذي شاهدت. دعوا المخرج محمد ملص، وبدؤوا معه نقاشًا بعد الفيلم، كان هذا أمرًا يحدث لأول مرة، وكان أمرًا غريبًا. كان الطلاب من مختلف كليات جامعة دمشق. كان الفيلم صادمًا بالنسبة لي. كان عندي سؤال في ذهني: هل هذه هي طريقة التمثيل في السينما السوريّة؟
فارس الحلو: أحلامي هي مشاريعي
14 كانون الأول 2021
في السينما المصرية عندما تتابع سعاد حسني وطريقتها في التمثيل، وكيف تتحول عند أداء دور ما، تشعر بالانجذاب إليها وإلى ما تفعل، بينما الممثلة الرئيسيّة في فيلم أحلام المدينة، ياسمين خلاط، والتي أشكّ أنّها تتحدث العربيّة بشكل جيد، كانت مختلفة، جذابة وجميلة. الفيلم كان جميلًا، والمدهش فيه أنّه سوريّ بالكامل. ثمّ ظهر في رأسي سؤال آخر: أين البطل والبطلة في هذا الفيلم؟ (تضحك)، أين قصة الحب المستحيلة تلك، والتي سوف تمزّق القلوب؟ كان هناك شيء جاهز في عقولنا نحن كجمهور عن شكل قصة الفيلم، ذلك التصوّر المسبق مرتبط بالمرجعيّة القادمة من الأفلام المصريّة والهنديّة والأمريكيّة التي تعوّدنا على مشاهدتها. تلك الأفلام التي كانت تعتمد في أغلب إنتاجاتها على الخط الرومانسي داخل القصة، والتي يتعلّق بها قلب الجمهور، وتكون حامل لقصة الفيلم. لم أجد ذلك في فيلم "أحلام المدينة"، لكن الفيلم كان شديد الجمال. معرفتي السطحيّة بالفن السينمائي في ذلك الوقت جعلتني أشعر أنّ هناك نقص ما في ذلك الفيلم.
الطريقة التي كنت أرى فيها الفيلم السينمائي والمرتبطة بوجود بطل وبطلة، تغيّرت بشكل تام مع أول عمل سينمائي عملت فيه. كنّا نقوم بعرض مسرحية "تقاسيم على العنبر" في بيروت في العام 1994 مع المخرج جواد الأسدي، حين جاءت مخرجة سينمائيّة لبنانية لحضور العرض، وأُعجبت بأدائي في المسرحية، وطلبت إليّ المشاركة في فيلمها الجديد. هذا دفع بالممثلات اللبنانيات على الاعتراض بحدّة على هذا الاختيار، الفيلم كان عن مجزرة صبرا وشاتيلا، وكان التساؤل لديهن: كيف تجلبين ممثلة سوريّة للعب دور رئيسي في قصة لبنانيّة؟ أقامت المخرجة معسكرًا لي في بيتها. لقد أتعبتني بمشاهدة عدد هائل من الصور والوثائق عن المذبحة. كلّ ذلك كان من أجل العمل على الشخصيّة. ثم أحضرت الكاميرا وبدأت بإجراء اختبارات أداء. ( بلهجة لبنانيّة) كان الممثل الذي لعب دور زوجي في الفيلم "ربيع مروة".
الجميل في الأمر أنّه لم يكن مطلوبًا مني الحديث بلهجة لبنانيّة في الفيلم، فلم يكن هناك حوار في السيناريو. قصة الفيلم تدور حول بحث أم عن قاتل ولدها، هذه هي كلّ القصة، وحول تلك الشخصيّة داخل الفيلم. تلتقي الأم بالقتلة وتسامحهم. هذا كلّ شيء، كان اسم الفيلم "زينب والنهر" ومن إخراج كريستين دبغي. استمتعت بهذه التجربة، بطريقة العمل، كان يشبه متعة التحضير لعمل في المسرح. لم أتمكن من فهم الفيلم المختلف عن الرواية المأخوذ عنها، لكني قرّرت بعد هذه التجربة ألّا أعمل مجدّدًا مع أشخاص أذكياء. ما أعنيه بالأذكياء، أولئك الفنانين المحترفين المستعدّين للتضحية بك كممثل من أجل العمل الفني. ما كان فنيًا ومعرفيًا مهمًا بالنسبة لي في تجربة الفيلم الأول، هي علاقتي، وما تعلمته من مدير التصوير السوري "جورج لطفي الخوري". توجيهاته لي كانت مفيدة جدًا. كان يرشدني إلى حجم ظهوري بالكادر والكيفيّة التي يجب أن أتصرّف بها داخله. لا معرفة مسبقة لديّ بتلك التقنيات السينمائيّة في الأداء.
لديّ تجارب تلفزيونيّة محدودة، وبالتالي كانت معرفتي معدومة بكلّ تلك التقنيات. كان تساؤلي دائمًا عن حجم أداء الفعل، كبيرًا كان أم صغيرًا. نحن ممثلو المسرح متهمون بالمبالغة في الأداء، لذلك كنت بحاجة لمعرفة ما أفعل، فكان الأستاذ جورج خير موّجه لي. كان التحدّي بالنسبة لي في تلك التجربة هو التقنية وليس المشاعر والأحاسيس. أحاسيسي متمكنة منها وأعرفها جيدًا. ما كان صعبًا هو التكنيك. في أحد المشاهد تقوم الأم بقص شعرها وهو مشهد لا يمكن أن يُعاد. كان حجم اللقطة قريب جدًا على وجهي. وجهي على حدود الكادر، فكان عليّ التركيز في زاوية نظري و طريقة الحركة داخل الكادر. بعد الانتهاء من المشهد، صرخ الأستاذ جورج قائلاً: أنت "آنا ماغناني" العرب (Anna Magnani 1908 – 1973). في أيام دراستي تابعت الكثير من الأفلام العالميّة، أعرف كلّ أفلام بازوليني وفيليني. في ذلك الوقت كان لدينا النادي السينمائي في منطقة الطلياني بدمشق، شاهدنا فيه أفلامًا شديدة الأهمية، لكنهم أغلقوه.
بعد تلك التجربة عرفت أنّني قادرة على الأداء والتعامل مع الكاميرا، بعدها أدّيت دورًا في سهرة تلفزيونيّة مع حاتم علي. وتلقيت الكثير من المديح والتصفيق. كانوا معجبين بقدرتي على استحضار المطلوب عاطفيًا من اللقطة، كالدمعة التي تأتي في اللحظة المناسبة. وهذا دلالة على الاحترافيّة بالنسبة لهم.
في العام 1998 كان أسامة محمد قد بدأ جلسات اختيار ممثلين لفيلمه الجديد. حينها كنت مشغولة بعملي بين المسرح والتدريس في المعهد، والدوبلاج والتلفزيون. ذهبت إلى أحد تلك الجلسات. ما أزال أذكر جيدًا، كان هناك عمر أميرلاي، و سميرة أخت أسامة، وهالة العبدالله. كان ذلك في اللقاء الأول. كنت في مظهر بشع ذلك اليوم، كان الوقت صيفًا وكنتُ قد سبحت كثيرًا وصار لوني داكنًا بسبب الشمس الحادة، وجلدي متقشّرًا. شعري مربوط إلى الخلف، مرتدية فستانًا، مع حاجبين غليظين، كبيرين جدًا. بدأ أسامة الحديث معي وهو يجلس خلف الكاميرا. كان السؤال الأول الذي طرحه علي: ما هو أكثر مشهد أو مشاهد من الحياة أثرت فيك؟ كنت حينها أعيش قصة حب، وكنت مُدمّرة بالكامل. كنت أنا الضحية في تلك القصة (تضحك). لا أدّعي بأنّني كنت متوازنة عاطفيًا حينها. تذكرتُ المرأة التي كان من المفروض أن تكون حماتي، والتي كانت تعترض على زواجي من ابنها بحجة أنّني مُطلّقة. حكيت لهم القصة كاملة، ثم بدأتُ باستحضارها أمام الكاميرا. نظرتُ بشكل مباشر في العدسة ورحتُ ألعب، وأتحدث بتلقائيّة. ضحكوا كثيرًا، ثم طلب مني أسامة تقليدها ولكن بصوت أوبرالي. "ما هذا الطلب الغريب؟". بحثت في ذاكرتي عن تفاصيل تلك المرأة، لأتذكر أن من جملة ما كانت تعترض عليه في شخصيتي، أنّني أدخن. قمتُ بإشعال سيجارة، تقمّصت شخصيتها، ثم صرخت بصوت أوبرالي (و بدخخخخخخخخخخخخخن). هذا كلّ ما فعلت.
نهض أسامة من خلف الكاميرا، وبدؤوا يلتقطون الصور لي من زوايا مختلفة في المكتب. بعد ذلك أخذوني معهم في رحلة استطلاع مواقع تصوير الفيلم في العام 2000. في تلك الرحلة أصبت بالهلع، كنتُ شديدة الخوف ولم أستطع تنفيذ أيّة مهمة، كنتُ مرعوبة من هالة العبدالله، تلك السيدة الناعمة واللطيفة ذات الصوت الهادئ التي تتحدّث بخشوع. كانت تطلب مني طلبًا بسيطًا كأن أنظر إلى جهة اليمين، أو أن أفتح الباب وأخرج منه راكضة، ليتخشّب كلّ جسدي وأصبح غير قادرة على فعل ما تطلب. إذا لم يكن عندي سبب للقيام بالفعل المطلوب، فأنا غير قادرة على القيام به. لم يكن لديّ محرّض في تلك الرحلة، لا أعرف دوافع ما يطلبونه مني، وبدأت الأمور تختلط عليّ بطريقة رهابيّة: هل يقومون بأخذ تلك اللقطات ليقرّروا بعدها إذا ما كنت صالحة للدور؟. كنت أشعر بفشلي الذريع. في طريق العودة إلى دمشق في الباص، وكنت قد جلست عند الشباك منزوية، أنظر إلى الباقين كأنهم أعداء (تضحك) كنت مقتنعة أنّني لم أكن سعيدة، وتلك المرأة، هالة العبدالله، امرأة مرعبة. لأكتشف فيما بعد أنّ الأمر ليس كذلك، تمكنت من فهم هالة أكثر، وعرفت بأنّه لم يكن اختبارًا لي. استمر أسامة في إجراء اختبارات الأداء ليختبر المزيد من الممثلين والممثلات. لم يكن محسومًاً بعد أيّ شخصية سوف ألعب. بدأ أسامة بجمع الممثلين/ات إلى بعضهم. في إحدى المرات دعا نهال الخطيب وأمل عرفة وكاريس بشار ومي سكاف. جمعنا كلنا لإجراء تمارين مشتركة.
هل وزع أسامة عليكم سيناريو الفيلم في تلك المرحلة؟
نعم. في تلك المرحلة وزّع علينا أسامة نص الفيلم. وسألني: في أيّ شخصيّة ترين نفسك؟ قلت له لا أعرف، أنت المخرج، قل لي أين يجب أن أكون، والمهمة التي يجب أن أعمل عليها. كانت مهمته الأولى لي هي: تمرير الشخصيّة المكتوبة على الورق من خلال شخصيتي الحقيقيّة، طلب مني أن أفكر بشكل شخصيّ بملامح وسلوك تلك الشخصيّة المكتوبة. كانت فترة جميلة جدًا. كنّا نلتقي مرة في الأسبوع في المؤسسة العامة للسينما، لندخل في نقاشات و ننفذ تمارين أمام الكاميرا. قمت بكتابة تاريخ الشخصيّة التي سألعبها، على دفتر مذكرات أهدتني إياه هالة العبدالله بعد أن تمكنت من كسر حالة الخوف منها.
صارحتها بأني لا أستطيع تحمّل أسلوب مديرات المدارس أو المعلمات، و ذلك بسبب علاقتي السيئة معهن طوال حياتي، فعدلت هي من طريقتها في التعامل، وجلبت لي ذلك الدفتر الأزرق الجميل من فرنسا. كتبتُ على ذلك الدفتر تاريخ الشخصيّة في فيلم "صندوق الدنيا". ما كتبت كان عن امرأة تدعى "خزامى"، ذلك الاسم الذي اخترته لنفسي. لم ترى تلك الشخصيّة في حياتها شيئًا سوى بطن أمها الذي كان دائمًا منتفخًا بمولود جديد. حياتها تتمحوّر حول استقبال وتربيّة كلّ تلك المواليد الجديدة. الحقيقة أنّني كتبتُ فيلمي الخاص على ذلك الدفتر الأزرق. كتبت أنّ "خزامى" لا تجيد سوى الطبخ والأكل والإطعام وتغيير الحفاضات. لا تفعل سوى أمور مثل حلب البقرة. هي فقط أم تنجب الكثير من الأولاد.
محمد الرومي: السينما دائمًا ضروريّة
07 كانون الثاني 2022
أسامة أحبّ ذلك كثيرًا، أحبّ أنّها لم تكن تعيش لنفسها، بل تعيش للقيام بذلك الدور، وتستمد وجودها من النموذج الموجود أمامها (الأم المُنجبة). كلّ تلك العائلة تنام في غرفة واحدة، والكلّ يعرف عندما الأب يختفي مع زوجته تحت الغطاء، ثمّ ينهضان بعد فترة ليغتسلا، يصبح ظاهرًا لباقي أفراد العائلة أنّ مولودًا جديدًا قادمٌ بعد تلك الخلوة. كلّ ذلك سيقع فوق رأس الابنة الكبيرة، التي ستتوّلى مسؤوليّة ذلك المولود الجديد. "خزامى" لا تفكر، بل تعيش، في الصباح تحلب البقرة، ثم تحضر البيض من مراقد الدجاج، ثم تبدأ بإعداد الطعام، ثم تذهب مع العائلة إلى الحصاد.. إلخ.
لقد بنيت حياة كاملة للشخصيّة قائمة على الأفعال الجسديّة. ثمّ سألت نفسي: ما هو مونولوجها الداخلي؟ ما الذي تفكر به؟ و لأجل ذلك بدأت بمراقبة بنات الجيران في ضيعتنا. علمتني "أم محمد" جارتنا كيف يتم حلب البقرة. أم محمد الجارة هي في مثل عمري، لكن لديها ستة أولاد. كانت تعلمني التمييز بين الأعشاب الضارة والأعشاب المفيدة، وتمييز الهندبة عن غيرها من الأعشاب. كان هدفي من هذا البحث هو أن أعرف أكثر، وألا يكون أدائي سخريّة من نساء شبيهات، وألا يكون هناك موقف ضدهم، لكنّني سأظهر طريقة رؤيتهن للحياة، لا يرونها كما أراها، لا أعتقد أنهنّ يستمتعن بلحظة الغروب بمصاحبة فنجان قهوة. لا وقت لديهن لكلّ ذلك.
أسامة أحبّ ذلك كثيرًا، وقال لي: "هي هية، إنّها تفعل كلّ ذلك في انتظار دورها لإنجاب الأطفال، لتصبح دورة الحياة متكاملة". أضف إلى ذلك أنّه في عائلتي لدينا جدّين كان الجميع يقول عند ذكرهما (قدّس الله روحه)، فنحن لدينا في العائلة هذه العلاقة بالما ورائي الذي تؤمن به مجموعتنا الدينيّة، ومعرفتي بفكرة التجييل أو التقمّص، والذي يغيّر مفهوم الموت بالنسبة لهذه المجموعة. الموت عند العلويين ليس لديه ذلك البعد الثقيل الموجود عند طوائف أخرى. الموت لا يخيف بالشكل المتعارف عليه، وهنا لا أتحدث بشكل شخصي، بل أتحدث عن الطريقة الذي تتعامل به هذه المجموعة البشرية مع فكرة الموت والحياة. المثقف في هذه المجموعة البشريّة هو الذكر، القادر على الكلام بشتى المواضيع. هو الشيخ، وهو الفهيم العليم، الذي يبيع ويشتري، ويذبح الأضاحي. أما نحن، فقط نساء. ننجب الأطفال و نربّي.
أكثر ما يميّز فيلم "صندوق الدنيا" بالنسبة لي، هو البنية الإيقاعيّة لمشاهد الفيلم. إلى جانب الأسلبة في أداء وحركة الممثلين كأنها كريوجرافيا (تصميم الرقص). على سبيل المثال ذلك المشهد الذي يجمعك مع كاريس بشار لغسل تابوت الجد، أو مشهد الولادة. الأفعال في هذين المشهدين، وغيرها من المشاهد، مؤلفة بشكل متزامن إيقاعيًا وكأنّها رقصة ثنائيّة. إلى جانب الكرويوجرافيا الخاصة بحركة الكاميرا، و التي تخلق تفاعلًا بصريًا و حسّيًا عالي المستوى، والظاهر في أغلب أعمال أسامة محمد، و الأفلام التي كان جزءًا منها، كفيلم الليل، وتحت السقف وغيرها. هذه القدرة على خلق تعاون مع الممثلين العاملين معه لخلق تلك العوالم الاستثنائيّة. عندما يحضر ممثل تصوّراته عن الشخصيّة للمخرج، والمخرج يوافق على تلك التصوّرات، فهذا يعني أنّ هناك اتساق على مستوى الرؤيا للعمل الفني، و يحتاج من المخرج الكثير من الانفتاح الفكري لتضمين تلك الاقتراحات وموازنتها مع العناصر الأخرى في الفيلم.
كلّ العمل الذي قمت به كان بتحريض من أسامة. في فترة التحضير والتدريبات، كان أسامة يدفعني للتفكير في السلوك والأفعال، واعتبار الكلام فعلًا أيضًا. كيف يمكن النطق بتلك الكلمات القليلة وألّا تكون مفتعلة. كيف يمكن تبني تلك الكلمات للأقصى. في المشهد الذي نجتمع فيه إلى فارس الحلو بعد عودته من الجبهة، ويبدأ الحديث عن كيفيّة دفاعهم المستميت أمام الإسرائيليين و كانوا فقط ثلاثة جنود تمكنوا من إيقاف لواء مدرع. يروي القصة وينظر إليّ ثم يذكر المرأة الإسرائيليّة التي تحمل البندقيّة وتحارب وتصرخ من داخل الدبابة "يا عربي، هيك وهيك بأمك". في ذلك المشهد، النساء جالسات منشغلات بتحضير القطن لتنجيد الفرشات والكثير من المهام اليوميّة الروتينيّة غير المنتهية. ليخرج تعبير تلقائي من المرأة التي كانت منفعلة وتبكي بسبب توجيه الكلام إليها بشكل مباشر، ثم تنزعج من مغادرة زوجها للغرفة، لتقول: "القحبة الشلكة، جعل هيك وهيك بأمها"، كان مونلوجي الداخلي الموّجه لشخصية فارس: "ما الذي تريده أنت؟ هل تريدنا أن نذهب ونقاتل؟". لكن هذا شيء لا تقوله، لأنّها لا تملك اللغة ولا الوعي لقوله بهذه الطريقة. الكثير من نساء تلك القرى النائية لا يمتلكن لغة للحديث بها، لدّي من أقاربي سيدة بسيطة جدًا و كانت جميلة جدًا. لا تقول سوى "إيه والله يا خالتي" و"لا والله يا خالتي" و"الحمد لله يا خالتي"، لا شيء آخر. لهذه الدرجة تصل محدوديّة القاموس اللغوي عند شخصيات من هذا النوع. عبارة عن 20- 30 كلمة تتكرّر. لا تستطيع الحديث معها عن حريّة المرأة مثلًا.
منذ قُدّم فيلم "صندوق الدنيا" والناس تتعامل معه على أنّه "الفيلم اللغز". أغلب من التقيتهم قالوا لي إنّهم لم يستطيعوا فهم المراد من تلك القصة. في الوقت الذي أعتقد فيه أنّ الفهم نسبي في الفن وغير ضروري لأنّنا نقوم بتأليف التأويل الخاص بنا بشكل حرّ. عندما عدت لمشاهدة "صندوق الدنيا" لم أواجه تلك الصعوبة في فهم كلّ ما هو موجود فيه. حتى ذلك المشهد الذي كنتم تستمعون فيه إلى جدال فارس الحلو المقاتل، كان مفهومًا حتى بمونولوجاته الداخليّة. إنّ اللحظة التي تسألين فيها "لماذا تنظر إلي؟" و كلّ سلسلة الأفعال المرتبطة بتلك اللحظة تظهر بالضبط ما قلته داخليًا "هل تريدني أن أذهب وأحارب؟". تلك الشخصية لديها عالمها الخاص ولا تستطيع تركه (البيت الذي يحتاج لإصلاح مستمر، الطقوس… إلخ). لنقل أنّ لديها مهمة خدمة هذه الأبرشيّة، تلك المرأة على رأس فريق الخدمة. وحتى في فريق خدمة تلك الأبرشيّة لديها رغبة في الارتقاء في سلم السلطة، تريد الارتقاء عن المرأة الأخرى (كاريس بشار)، زوجة الأخ الجندي (فارس الحلو) الجميلة والحساسة. لدينا ذلك الصراع بين تلك الشخصيات على الرغم من أنّ المعاناة واحدة، و التفوّق محدود كمحدوديّة اللغة. عندما تكون لغتك محدودة كإنسان فإنّ طموحك وتفوّقك محدود بالضرورة. ليظهر العنصر السحري في ذلك العالم وهي الحاجة إلى المعرفة والعلم.
مَن مِن الأحفاد سيذهب إلى المدرسة ويحصّل المعرفة؟ وبالتالي يصنع الفرق في ذلك المجتمع البوهيمي. تخيلي معي لو أنّ ترتيب إنتاج أفلام أسامة محمد كان مختلفًا. الفيلم الأول (صندوق الدنيا) والفيلم الثاني (نجوم النهار)، كان يمكن ربط الفيلمين مع بعض على أنهما متتابعين زمنيًا لنفس العائلة. ما يمكن تقديره بشكل عالي هو قدرة المخرج (أسامة محمد) على نقده الحقيقي لبنية المجتمع الريفي الذي جاء منه، مع الحفاظ على بعد إنساني شديد العمق. لقد وضع أسامة إصبعه على المعضلة التي تعاني منها تلك المجتمعات الريفيّة المنعزلة، فهي غير قادرة على التغيير من داخلها، بل تحتاج إلى دولة تساهم في انتشال تلك المجتمعات من التخلّف الذي تعيش فيه، لتأتي السلطة فعليًا في سوريا وتقوم بتعميق تخلّف تلك المجتمعات واستخدامها في معادلة السلطة والطغيان.
في فيلم "صندوق الدنيا" نرى غيابًا تامًا للدولة، بينما نرى في فيلم "نجوم النهار" الحضور الطاغي للدولة ومؤسساتها (عسكر ومدارس ومراكز هاتف ورجال حزب… إلخ) إلى جانب التحليل العميق لمفهوم السلطة الهرميّة في مجتمعنا وإسقاطاتها على هرم السلطة في الدولة السوريّة الديكتاتوريّة، والتي لا توجد فقط عند العلويين، بل هي موجودة عند كلّ مركبات المجتمع السوري. مجتمع أبوي يتمثل في أبوة الدولة للمجتمع و الوصاية عليه، وصولًا إلى الهرميّة في العائلة السوريّة. مشهد موت الجد في بداية الفيلم يحمل في طياته إدانة لكلّ أنواع السلطة، تحديدًا السلطة الدينيّة المتمثلة بالشيخ المحتضر، والسلطة التي تنعكس في صورة جمال عبد الناصر التي تظهر في المشهد، و التي تشبه كثيرًا صور حافظ الأسد، هذا ليس اختيارًا عشوائيًا، بل خيار دقيق لما يريد الصانع قوله.
حدثيني عن عملية تفكيك تلك العناصر الرمزيّة التي بُني عليها فيلم "صندوق الدنيا"، من خلال الدور الذي لعبته، مرورًا بموضوع الإيقاع و الحركة، وكيف أنّ الشخصيات النسائيّة في هذا الفيلم هي المحرّك للحدث داخل الفيلم.
بالحديث عن الهرميّة. حتى بين النساء هناك هرميّة مقابلة للهرميّة الذكوريّة. وموقعك التراتبي في ذلك الهرم النسائي خاضع لمركز الزوج في العائلة. الجد (رجل الدين) لديه زوجة، الابن لديه زوجة، والأحفاد الثلاثة لديهم زوجات أيضًا. تلك المجموعة من النساء تشكّل الهرم الأنثوي. الأكبر سنًا تعطي الأوامر للأصغر منها في تراتبيّة محدّدة، ضمن مبدأ الإلتزام بطاعة الأكبر. الوحيد الذي خرج عن ذلك المبدأ في الفيلم، هو الحفيد الذي حلّت به روح جده رجل الدين، ليتحوّل إلى طاغية يتحكم بمصائر الكبار والصغار من حوله. يعاد تشكيل هرم السلطة بشكل جديد بعد وفاة الجد.
ذلك الحدث الذي تحوّل إلى معجزة في مشهد اشتعال جسد الصغير بالنار، ليخرج سليمًا، محمّلًا بوعي ما ورائي لولادته الجديدة. النساء بهذا المعنى لم يكنّ حرائر في ذلك الفضاء. لا أحد حرّ في ذلك الفضاء على الإطلاق. الحريّة محدودة بمنطق عملهم، ماذا يفعلون؟ حريّة شخصيات الفيلم محدودة. كما تذكر في مشهد العائلة وهي تغطّ في نوم عميق، والكلّ مستسلم لأحلامه، يقترب الطاغية الصغير من وجوه النيام، كأنّه في عملية رصد لأحلامهم. هذه ليس قراءة. في المشهد الولد يستمع إلى ما يقوله النيام أثناء نومهم، وبما يهدسون. ما الشيء الذي يحتل لا وعي تلك الشخصيات؟ العلاقات النسائيّة في الفيلم لها أوجه متعدّدة، واحد منها العلاقات الظاهريّة وهي واضحة. أنفذ الأوامر المباشرة مِن مَن يعلوني في هرم السلطة، وأُعطي أوامر لمن هم أدنى من موقعي الشخصي. إنّ مركزك الاجتماعي يؤثر بشكل كبير في سلطتك: أنت ابن من؟ هذا مبدأ مطبّق في تلك العائلة التي ظهرت في فيلم "صندوق الدنيا"، أنا زوجة أحد الأبناء، لكن أنا ابنة من؟ هذا شديد الأهمية. كلّ تلك التفاصيل وعلى مستوى العلاقات بين الشخصيات، الجسديّة منها، والصوتيّة، والتي بُني على أساسها الفيلم، والتي لا علاقة لها بأسلوب المونولوجات الطويلة والكلام. رصد أدق التفاصيل كالرغبات الدفينة عند تلك الشخصيات. كتلك الرغبة الدفينة عند ابنة سارق الكرارا (أيّ سارق البغال) الشخصيّة التي لعبتها حلا عمران.
أتحدّث تحديدًا عن تلك الرغبة الموجودة عند تلك المرأة نحو "فيروزة". من غير الواضح فيما إذا كانت تلك المرأة تريد "فيروزة" لابنها، أم لها شخصيًا. فيروزة هي فتاة عُثر عليها رضيعة، لتكبر في ذلك المنزل القابع على رأس الجبل. تلك الفتاة الحلوة، والمؤثرة على فعاليّة الأولاد الثلاثة (الأحفاد)، لديها شيء مختلف عن باقي أفراد العائلة، فيها شيء من التمرّد. العائلة وعلى مدار الفيلم، مرتبطة بحكاية، إذا انتبهت إلى ذلك، الطفل الذي أخذته الماء، والظلم الذي وقع. تلك الحكاية ومرجعياتها الدينيّة، والتي تتحدّث عن أولئك المختارين الذين أُنقذوا من موت محتّم، ليخرجوا أنبياء في أقوامهم بعد ذلك. هذا يشبه كثيرًا الدراما التراجيديّة الإغريقيّة في معالجتها لمفهوم القدر والنبوءة. ذلك القدر الذي لا تستطيع الفرار منه. كما حدث مع أوديب، سوف تسلك ذلك الدرب، ستقتل أباك، ثمّ تتزوّج أمك. هناك شيء مشابه في لعبة فيلم "صندوق الدنيا"، تلك الشخصيّات القدريّة (أيّ المؤمنة بالقدر)، أولئك البشر الذين يعيشون على هامش الحياة، وخارج الزمن.
من أكثر العناصر التي أدهشتني في الفيلم هو المستوى البصري. ذلك العمق للصورة السينمائيّة. صورة داخل صورة داخل صور أخرى. أنت لا ترى شيئًا واحدًا، بل ترى شخصيّة في عمق الكادر هناك بعيدًا، تقوم بحفر قبرها، وفي المستويات الأقرب للكاميرا هناك أحداث جارية. ذلك الجانب كان ممتعًا و غنيًا بشكل كبير من وجهة نظري. فيه لغة شعريّة عالية جدًا. إنّ هذا النوع من الأفلام فيه مستوى عالي من التحدّي للممثل. لا يوجد في هذا الفيلم الكثير من الأشياء التي يمكنك التعكّز عليها في أدائك. لا حوارات طويلة، أو صيرورة علاقات بديهيّة واضحة. عكاكيزنا نحن الممثلون هي اللغة والحوارات. التحدّي يبدأ عندما لا يكون لديك تلك العكاكيز: ماذا يمكن لجسدك أن يفعل؟ ما الذي قد يقوم به صوتك؟
أسامة مخرج رائع في العلاقة التي يبنيها مع الممثل. لا يقول لك أسامة ماذا تفعل، هو يشعر بك، يقترب منك بحساسيّة العارف لما أنت بحاجة إليه من أجل فتح المزيد من الأبواب الموصدة. من الطبيعي للممثل أن يواجه لحظات من هذا النوع، حيث يفقد القدرة على تحديد الفعل المناسب، فيشعر بالعجز التام. اقترب مني أسامة في لحظة عجز ليهمس في أذني بصوت: "ايييه". هل ترى ذلك الصوت البسيط (إيييه)؟ لقد خلق في مخيلتي عوالمًا لا حدود لها. من خلال ذلك الصوت ومن خلال نبرته، تستطيع تحديد شكل المنافسة التي سوف تنشأ بين الشخصيات. تلك المفاتيح التي كان يقدّمها لنا أسامة فريدة. لم يكن الجميع قادرًا على التواصل مع ذلك الأسلوب، لاعتيادهم على طريقة الطلبات الواضحة والكلمات المفسّرة للفعل المطلوب. الناس معتادة على الكلام. مرجعيتنا في الأداء هي دائمًا لغويّة (بلا بلا بلا، قلي لقلك).
الممتع بالنسبة لي في تلك التجربة هو كوني فقيرة (تضحك)، فقيرة بمعنى الكلمة. بعد البدء بالتصوير، بتّ عاجزة تقريبًا عن الكلام بشكل عادي. عندما كنا نعود إلى الفندق لم نكن نخوض في نقاشات، بل كنّا نضحك فقط، أو نضع تلك الأغنية الشعبيّة (واعدتينا تحت التينة وما جيتينا) وأنخرط مع حلا عمران في رقصة طويلة. حلا كانت محبوسة في جملها البسيطة في الفيلم (والشو شكلو، والشو شكلا) وأنا بجملي المماثلة لبساطة جملها. لم تكن لدينا أيّة لغة نتحدث بها. ليس الكلام و الحوارات دائمًا ما تعبّر عن الشخصيّة. الإنسان ليس مملوءًا دائمًا بالكلام، قد يكون مملوءًا برغبات على شكل صور لا تستطيع التعبير عنها بالكلام، لكن من الممكن تحويلها إلى صورة. الرغبات الجنسيّة المكبوتة على سبيل المثال، تلك المرأة التي لعبتُ دورها في الفيلم، ليس لديها حياة جنسيّة مع زوجها.
هذا النوع من الناس ليس لديهم علاقات جنسيّة، أو متعة جنسيّة. هذا أمر فكرت فيه كثيرًا، الزوج في هذه الحالة يستلقي بالقرب من زوجته بغرض تلقيح زوجته ثمّ يغادر. في تلك العوالم تتساءل عن المسموح لتلك الشخصيات بفعله، ليظهر معك الطريق الأمثل للتعبير عنهم، كأن يكون مسموحًا لك بالاستمتاع بلمس ولدك، ليس على الوجه أن يعبّر، الكفان كافيتان للتعبير عن متعتك بلمس ولدك، و ذلك من خلال الطريقة التي تقوم بها بذلك الفعل، العناق، الطريقة التي تأكل بها، الطريقة التي تشعر بها بنفسك...الخ.
كنّا في ذلك الفيلم أقرب إلى الحيوانات، وهنا لا أعني التقليل من قيمة البشر أو من قيمة الحيوانات، ما أعنيه أنّ حياة تلك الشخصيات هي حياة تقودها الغرائزيّة. في الفيلم كانت شخصيات الفيلم تعيش جنبًا إلى جنب مع الحيوانات في نفس المنزل. الحيوانات في ذلك المجتمع هي جزء أساسي منه. وبالتالي الغريزة الكامنة عند تلك الشخصيات الآدميّة هي ليست بغرض المتعة، هي غريزة تناسل، غريزة البقاء وكلّ ما يرتبط بها من متطلبات. الدخول إلى تلك العوالم على مدى خمسة أشهر وفترة التحضير التي سبقت التصوير تجعلك منفصلًا عن الحياة وعن واقعك الشخصي.
هل كنتم تجرون تدريبات على اللقطات و المشاهد قبل تنفيذها؟
نعم بالتأكيد. تصوير المشاهد كان يأخذ وقتًا طويلًا. لم نجر تدريبات قبل التصوير، كانت تدريبات مع الكاميرا. نحضّر المشهد ونعمل عليه حتى يصل إلى المستوى الذي يريده أسامة. مشهد الولادة أخذ الكثير من الوقت. لا يمكنك تخيّل كمية التفاصيل التي كانت موجودة في الكادر. هناك المجموعة التي تشجّع كاريس بشار، والمجموعة التي كانت تشجعني. هناك الزوج الأول، والزوج الثاني. أتذكر أنّ كاريس بشار انهارت في هذا المشهد، لقد عملنا أكثر من 24 ساعة على تنفيذ المشهد دون نوم. أنا لم أنهر، لكنّني أُُنهكت. لقد تعبنا كثيرًا، لكنني كنت مستمتعة لأقصى حد، لم يكن يهمني النوم حينها، كنت أفكر أنّ الأمر بسيط، ننهي المطلوب ثم نذهب للنوم. كنت أعرف أنّ صناعة فيلم من هذا النوع شيء لا يتكرّر كثيرًا، وهذه الفرصة على الصعيد الشخصي لن تتكرّر كثيرًا في الحياة. أن تحظى بفرصة اختبار كلّ تلك العوالم داخلك كممثل، والتي لم تكن تعرف بوجودها. هذا أمر استثنائي ومهم بالنسبة لي. في سلّم السلطة النسائي كانت الجدّة على رأس الهرم، هي صاحبة الأمر والنهي، لكنّ الجدة (نهال الخطيب) كانت عجوزًا طاعنة في السن، لتحل مكانها زوجة الابن الاكبر (مها الصالح) لتصبح على رأس هرم السلطة فوق نساء أبنائها الثلاثة.
حدثيني عن النقاش حول النص المكتوب، عندما يكتب أسامة محمد رسالة لي على الفيسبوك، أعيد قراءتها عدّة مرات لاستيعاب ما الذي يودّ قوله لي، يكتب رسائل بسيطة بلغة شعريّة شديدة الجمال والتعقيد. حدثيني عن النص وكيفيّة العمل على تفكيك رموزه التي ظهرت بالشكل الذي رأيناه في الفيلم؟
عندما قرأت السيناريو لأول مرة تذكرت قريتنا "الطليعي" وتذكرت أخت جدتي "نهيل". "نهيل" تلك كانت تعيش في منزل في قريتنا مشابه كثيرًا للبيت الذي صوّرنا فيه "صندوق الدنيا". كانت تملك حمارًا وبقرة وبعض الدجاجات. كانت حظيرة الحيوانات فعلًا في الغرفة المجاورة لغرفة النوم والمعيشة. كنّا نذهب إلى تلك القرية في مناسبات عائليّة كالوفاة والزواج، وتفتّح وعيي الأول على ذلك المكان، على أنّه مرتبط بحالة الإعياء التي كانت تصيبنا عندما ننام هناك. عندما قرأت السيناريو، تخيلت بعض المشاهد المكتوبة في ذلك المنزل.
أتذكر تفاصيل ذلك البيت الطيني، المطبخ والتنور وكلّ تلك الأشياء. كلّ البيوت التي نمت فيها في طفولتي في تلك القرية تملك تنورها الخاص، والجميع عندهم حيوانات. خلال قراءتي للنص كنت أسمع صوت "نهيل" شقيقة جدتي. جدتي كانت حكّاءة، تجيد الكلام والتواصل مع الآخرين، بينما أخت جدتي كانت فقط تصدر أصواتًا في غالب الوقت (تأوهات) أصوات تعبّر عن الوجع أو عن الاهتمام، وعن أغلب أطوارها الشعوريّة. ما أقوله الآن هو تقييمي كبالغة لذاكرتي التي عشت، كيف أنّ الصوت بدون كلام قد يكون معبّرًا عن الرغبات والأحاسيس المكبوتة. التعبير الصوتي قد يكون الأداة الوحيدة لقول ما تريد للشخص الذي أمامك، دون الحديث إليه بشكل مباشر. كان النص مليئًا/ بالتعبيرات الصوتيّة التي كنتُ قادرة على التواصل معها بحكم وجودها في ذاكرتي. في النص أنت لا ترى فقط المكان، بل تسمع الأصوات الخاصة به، وكلّ صوت لديه تنغيمات مختلفة للتعبير عن معاني محدّدة في سياق الحديث. هناك صوتيات خاصة بالمكان والبيئة، لمعرفة وفهم تلك الصوتيات لا بدّ أن تتعرّف إلى البيئة الطبيعيّة التي جاءت منها.
تلك الأصوات هي كاللغة البدائيّة، مجموعة من الأصوات بقيت عالقة في لا وعينا اللغوي، كلّما زاد الاعتماد على تلك اللغة الصوتيّة، تضاءلت مساحة الفكري في الحوار الإنساني.
لديك هذه الكلمة المتكرّرة في الفيلم بتنغيمات مختلفة "شو؟"، "شو، شو؟"، "شو، شو، شو؟".
تلك الكلمة و تنغيماتها أخذت مكان حوارات كاملة في الفيلم.
"شو؟"، "شو، شو؟"، "شو، شو، شو؟"... كان ذلك مذهلًا.
عندما عُرض فيلم "صندوق الدنيا" في إحدى دورات مهرجان دمشق السينمائي الدولي، أخبرني زملائي عن دهشتهم بالفيلم، وكم يشبه إلى حد كبير فيلم المرآة للمخرج الروسي "أندري تاركوفسكي".
شاهدتُ فيلم "المرآة" عدّة مرات، لا علاقة له بفيلم أسامة.
بكلّ تأكيد، لا علاقة له بفيلم المرآة… الفيلم المرجع لفيلم "صندوق الدنيا"، والذي لم يخفيه أسامة هو فيلم "الأضحية" (The Sacrifice) (للجمهور الذي قد يقرأ هذا الحوار: لم يترجم "أسامة محمد" عنوان فيلمه إلى الفرنسيّة (صندوق الدنيا) بل اختار اسمًا جديدًا للفيلم و كان أضحيّة– Sacrifice). هذه دلالة على الخط السينمائي الذي يتبناه أسامة ولم يحاوّل إخفاءه بل دلّل عليه.
عندما يتحدث تاركوفسكي عن سحر الواقع، والنحت في الزمن، فإنّه يتحدث عن أسلوب سينمائي، عن طريقة فلسفيّة للنظر إلى الحياة والواقع وعن كيفيّة عكس ذلك الواقع السحري في السينما. وتلك الواقعيّة السحريّة قد تكون في فيلم تاريخي أو معاصر أو حتى في فيلم خيال علمي. تاركوفسكي صنع كلّ تلك الأنواع من الأفلام.
عظمة فيلم "صندوق الدنيا" بالنسبة لي تأتي من أصالة السينما الموجودة في الفيلم. عمل أسامة محمد على تأصيل أسلوبه السينمائي بلغة سيمولوجيّة تنتمي للثقافة التي ينتمي إليها، مع القدرة العالية على تبني فلسفة سينمائيّة عالميّة ينتمي إليها فكريًا وجماليًا. لا يعيب المخرج السينمائي أن يكون متأثرًا بأسلوب سينمائي فني ما، التقصير والمعيب يكمن في التقليد وتكرار لغة سينمائيّة غريبة على الثقافة المحليّة للصانع. إنّ كل الرموز التي استعملها أسامة في فيلم صندوق الدنيا هي قادمة من البيئة المحليّة، مثل شبكة العنكبوت الهائلة التي سدّت باب غرفة نوم الجد، الطفل الذي حلّت فيه روح جدّه، يتمكن من دخول الغرفة دون المساس بشبكة العنكبوت، هذه دلالة في الفيلم على قدسيّة ذلك الولد وتأكيد على المعجزة التي رافقت عملية الحلول. بدون شك تلك الدلالة قادمة من قصة الرسول محمد عندما لجأ وصاحبه إلى غار حراء. أسامة لم يتعال بفيلمه على الشخوص التي قدمها، ولا على ثقافة المجتمع الذي جاء منه. الفيلم أصيل بكلّ عناصره المكونة، فيلم سوري بكلّ ما للكلمة من معنى، وبالنسبة لي لا يقل فنيًا عن فيلم "الأضحية" لتاركوفسكي.
لقد استطاع هذا الفيلم النبش عميقًا في عوالمي الداخليّة، ولا أعتقد أنّني كنت لأكتشفها لولا تلك التجربة. في وعينا الجمعي الكثير من الأفكار والأفعال المكبوتة، فقط تحتاج إلى التحريض المناسب لإخراجها، وهذا ما نجح به أسامة محمد في علاقته الفنيّة معي شخصيًا. باتت المرجعية التي أعتمدها في العمل، أن أسأل نفسي: ما المتبقي في داخلي من تلك الشخصيّة المطلوب مني تأديتها؟ ما الذي أتقاطع فيه مع تلك الشخصيّة؟ أحاول الولوج إلى ذاكرة تلك الشخصيّة المكتوبة على الورق، وأبدأ بطرح الأسئلة حول مركبات وجودها. أحاول البحث عن صوتها ولغتها وعن مستواها المعرفي وعن كيفيّة حركتها. كل ذلك لأتمكن من تخيلّها، ثمّ لأكونها.