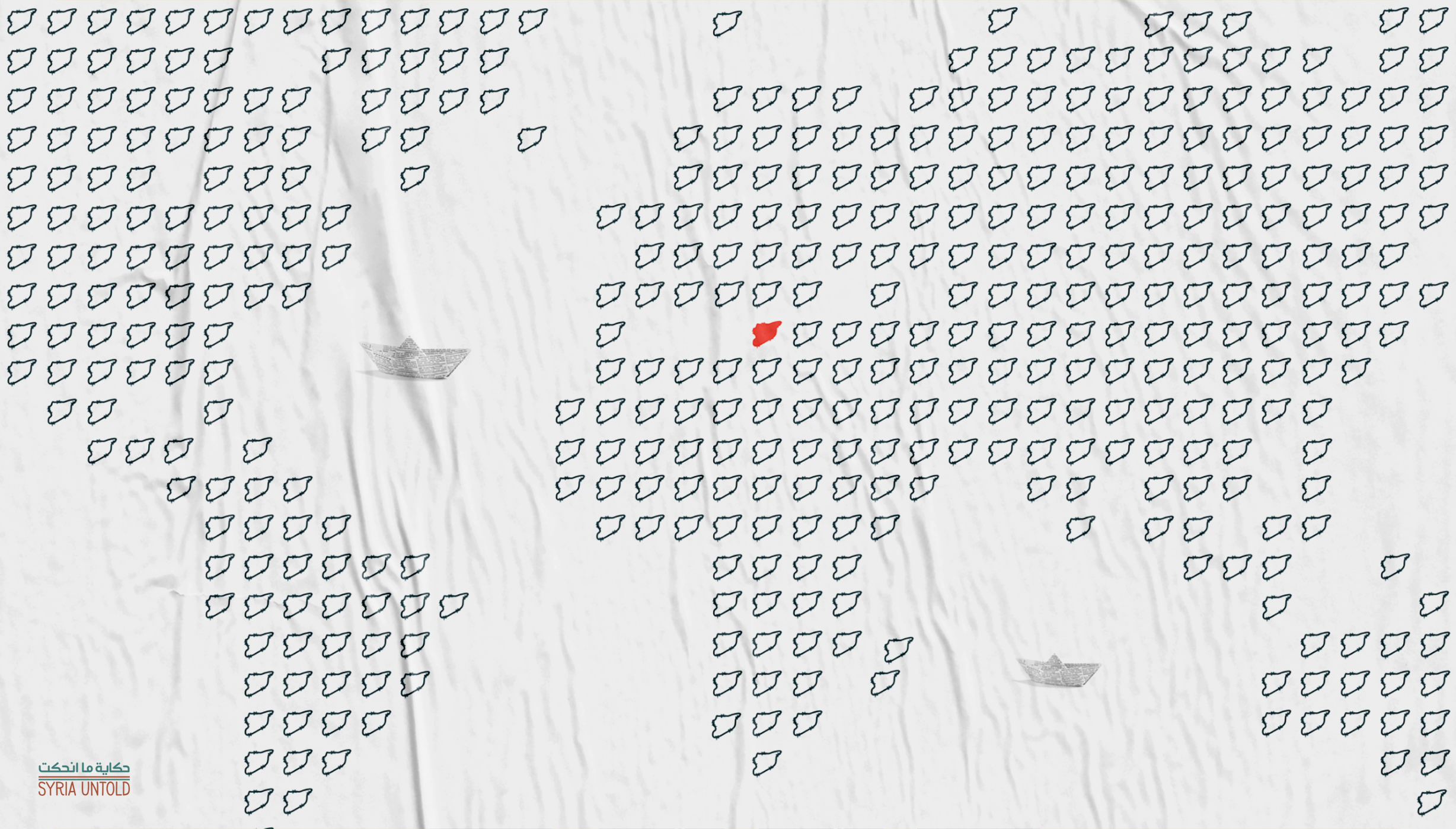"الدين زفرة المضطهدين"، هو قول لكارل ماركس، وهناك قول أخر يتم تداوله هو أنّ "الدين أفيون الشعوب". في الجزء الأول من الكلام، يُراد القول إن الناس تركن إلى النصوص الدينيّة الأصليّة والأنبياء، حينما تُغلق بوابات الحياة أمام الأفراد، وأيضًا حينما يتفكرون بشؤون الدنيا والأخرة، وإنّ ذلك من حقوق الناس في العبادة. القول الأخر، يتناول عملية توظيف الدين لصالح السلطة، فيتمّ تأويله بما تشاء، وتَصدر الفتاوى وفقًا لمصالح الحكم، وأيديولوجيته، وصراعات السياسة، وتنعمي الأعين عن رؤية الواقع المتأزم، ويَخمد الناس عن النقد والاحتجاج، وقد تكون الفتوى من أجل السلم الأهلي، حينما تتعمّق المشكلات الدينية، ويتقاتل الناس باسم الهويات الدينيّة.
الطعنات التي تلقاها الكاتب البريطاني، الهندي الأصل، سلمان رشدي، في نيويورك، هي نتيجة فتوى أصدرها الخميني في عام 1989 بعد نشر رواية "آيات شيطانية". لاحقًا في العام 1998 أعلنت الحكومة الإيرانيّة أنّها لم تعد تدعم هذه الفتوى، كما صبّت تصريحات الدبلوماسيّة الإيرانيّة الأخيرة (بعد حادثة الطعن) في الاتجاه ذاته، ولم تقم بدعم الفاعل، ولكنها أيضًا لم تعمل على شطب الفتوى ذاتها. هناك أمر أخر غير الفتوى القاتلة يجب الوقوف عنده، وهو الحرب المعلنة على الإرهاب منذ بدء الحرب على أفغانستان (2001)، والتي تطابقت في كثير من الأوجه مع الحرب على المسلمين. هناك حديث عن الصدام بين الحضارات والأديان، وبالتالي هناك تسييس عالي المستوى للأديان وللوعي الديني، بما يحدُّ كثيرًا من الحريّات العامة وحريّة الموقف من الدين، وحينذاك يصير تناول مسائل مرتبطة بالدين أو قضايا الدين نقديًا بمثابة الهجوم على روح المؤمن، وعلى المؤمنين، وهذه أسباب فاعلة في محاولة القتل الجديدة.
تسييس الأديان، فتح المجال واسعًا لاستغلال الأنظمة لهذه المسائل بما يهمّش الأزمات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة لتصبح أزمات دينيّة وطائفيّة في المجتمع، وإشادة بنى أكثر استبداديّة في إطار الأنظمة وفي بنى المجتمع وشكل الوعي السائد، وفي علاقات الناس وتعريف الهويّة الذاتيّة أو المجتمعيّة بالدين، وكأنّنا في لحظة ظهور الأديان بينما الأمر بمعظمه ناتجٌ عن التسييس.
الثورة والصراع على السرد
18 آذار 2021
أثارت محاولة القتل نقاشات واسعة، ووُجدت كتل شعبيّة أيدتها بثقةٍ عمياء، رغم أنّ رواية "آيات شيطانيّة" لم تترجم بشكل رسمي حتى الآن (هناك فقط نسخٌ مجتزأة باللغة العربيّة)، وبالعموم لا يغير هذا في الموضوع شيئًا، حيث أنّ الانصياع للفتوى والتجهيل وتطييف الدين بشكل أعمى هو السائد والشائع والمسيطر. عكس الكتلة السابقة هناك تيار حداثي يؤكد ضرورة الدفاع عن حق الكاتب، أيِّ كاتبٍ، بالإبداع والتعبير والنقد ومقاربة المقدس، وليس فقط قضايا الأرض؛ يبقى فقط الإسفاف والإستهزاء غير مقبولين ومرفوضين. إنّ موضوع رفض الإسفاف لا يتناول فقط الموضوع الديني بل والاجتماعي بكلّ أوجهه، وهذه مجالات القضاء، وهناك قوانين مخصصة له ولا مكان للفتوى فيها، أو للتيارات الجهاديّة والسلفيّة.
في عالمنا العربي لم يبدأ نقد النصوص الدينيّة الثلاث (المسيحيّة الإسلاميّة واليهوديّة) بعد، وليس الإسلامي فقط. عدم النقد يطال أيضًا حياة الأنبياء والفتاوى وأراء رجال الدين ومرحلة الحكم الراشدي وعلماء الدين عامة. هذا بوجه منه يسيء للدين، وكأنّ الدين ليس عزيزًا عند المؤمنين به، وليس هناك من يحفظه ويرى العالم من خلاله، وهو حال جماعات بشريّة كثيرة، منذ أن وُجدت الأديان، وربما سيلازم الأمر البشريّة بشكل دائم.
في أوروبا عادة ما يُشار إلى أنّ نقد الدين قد انتهى، وأنّ نقد الدولة والسياسة ومختلف جوانب المجتمع، وحقوق الناس هي المسائل التي وصل إليها مستوى التطوّر، وهي التي تَعني الوعي العام ويعمل عليها أصحاب الفكر والآداب؛ بل إنّ الغرب راح يناقش كيفيّة تشريع التعدّد والاختلاف المجتمعي، بحيث تشملها القوانين، وألّا تكون هناك أيّة مقدسات، أرضيّة أم سماويّة، فوق القوانين، وفوق آراء الناس المتعدّدة والمختلفة. المفارقة أنّ هذا النقاش لم يُحجّم من دور الدين وإيمان الناس به، بل هناك مؤشرات تؤكد العودة القويّة للدين وللإيمان. القضية هنا لا تتعلق، كما يشير بعض الباحثين، بكثرة المهاجرين المسلمين بالتحديد، كرّدة فعلٍ على قدومهم، وهو ما تشتغل عليه الشعبويات السياسيّة بصفة خاصة وجماعات التعصب القومي واليمين الأوروبي كذلك. المشكلة هنا أيضًا، ترتبط بوصول التيارات الليبراليّة إلى إفلاس كبيرٍ، ولا سيما الليبراليّة الجديدة، والتي قادت الغرب إلى أزمات كبرى، ولا سيما بعد عام 2008، والآن تجد نفسها بارتباكٍ شديدٍ في مواجهة الروس والصين الاستبداديين، ومحاولتهما إرساء نظام عالمي يشبههما، ويتغلب على النظام الديمقراطي الغربي "الليبرالي".
إذًا أفكار ما بعد الحداثة وتغييب مركزيّة العقل وسيادة التعدديّة والاختلاف أعادت التفكير الديني إلى الغرب، وترافق ذلك مع إخفاق الليبراليّة الجديدة، وسقوط الاشتراكيّة السوفيتيّة، وصعود الدول المستبدة في الصين وروسيا. وهناك اهتمام روسي خاصة بإنعاش الدين، وهو اتجاه شعبي كذلك كرّد فعلٍ على سياسات الإقصاء له تاريخيًا في روسيا؛ في الصين الأمر أكثر تحفظًا إزاء الدين، وفقط المسلمون يتعرضون لاضطهاد عنيف وبصورة كارثيّة في هذا البلد.
هناك ضرورة لفهمٍ جديد للدين
إذًا، نقد الدين في أوروبا لم يمنع من العودة إليه، وكذلك الأمر في روسيا، والأفكار التي واجهت الدين بصورةٍ تعسفيّة في العالم العربي لم تستطع تشكيل بيئات اجتماعيّة قويّة لها، قبالة ذلك تمَّ تسييس الدين وتطييفه وجعله عنيفًا تجاه الآخر، والسبب الأساسي لذلك يكمن في البنية الاجتماعيّة المُخلفة، وليس في الدين ذاته. بعيدًا عن هكذا تفكير قاصر، هناك ضرورة لفهمٍ جديد للدين، وهذا يقتضي العمل على نقده بالمعنى البحثي والتاريخي، حيث يكون الدين جزءًا من التاريخ، وهو حاضر بقوة وسيستمر كذلك، وقد لعب دورًا في تشكيل التاريخ، وهذا الأمر لا يستهدف قضيّة الإيمان الديني، فهي قضيّة شخصيّة بين الإنسان والله.
صناعة وعي قابيل وهابيل
03 حزيران 2021
نضيف أنّ تفسير الدين، والدول التي استندت إليه تاريخيًا، والتراث المتعدّد الأوجه الذي ورثناه، نحن من نعيش في العالم العربي أو الإسلامي، يَفترض التخلي عن أيّة شروط أو محاذير للتعامل النقدي معه، وهو ما حاول الاقتراب منه العرب منذ عصر النهضة، قبل أكثر من قرن ونصف القرن، وواجهتهم الكثير من التقييدات والتكفير والشروط والتوظيف السياسي، قُتَلَ خلالها أدباء ومفكرون. إنّ النقد ومحاربته، المشار إليهما أعادت لكلّ ذلك التراث أهميته، وسلّطت الأضواء على النصوص الدينيّة بكلّ أوجهها. القضيّة الآن تكمن في إرساء أُسس قانونيّة لتعزيز الحق الفردي في تناول الدين، وفي شكل الإيمان أو الخروج عن قواعده، وكما ذكرنا دون إسفافٍ أو استخفافٍ، وأيضًا دون تسييسٍ، ما يجعل منه قاعدة للتكفير والقتل.
تسييس الدين عربيًا
هناك توظيف سياسي كبير للدين، بل تكاد الأنظمة العربيّة تستند إليه بصورة كبيرة لحرف الوعي عن نقد الواقع، عبر الإشارة إلى أنّ واقع حياة الناس التعيسة، هي من تدبير ربّ العالمين، وليس من إمكانيّة لتغييرها؛ رغم أنّها تتغير بصورة مستمرة، والمؤمن وسواه يلحظون ذلك. إنّ تكريس الوعي الديني يُشوّش الوعي العام، ويمنع تشكله نقديًا بصورة مركزة أكثر فأكثر؛ هنا يصبح الدين أفيون الشعوب، كما أشرنا، ويصبح ضدّ مصلحة الشعوب كذلك، بل وضدّ الدين ذاته؛ الدين ضدّ الدين.
عربيًا، وفي المجتمعات التي تشبهنا، هناك مشكلة كبرى، لا تتعلق بالدين أو بنقده، بل بطريقة توظيف الأنظمة له. هذا التوظيف بالتحديد هو ما يغيّب دور الدين الإيجابي، الشعبي بامتياز، أو دفع المؤمنين به لتبني الحقوق الحديثة للمواطنين، ولهذا تسود القراءات السياسيّة والقاصرة عن جوهر الدين في النهوض والحداثة، وهو ما فعله الدين حينما ظهر، ولا سيما المسيحيّة والإسلام، فبُنيت الدول والإمبراطوريات على أساسه، ولكن الدول تلك بالذات، أعادت إنتاج الدين على مقاس الخليفة وأيديولوجيته، فتشكلت مسيحيات وإسلاميات جديدة، وفي إسرائيل هناك يهوديّة جديدة.
نقد الدين لا يتعارض مع الإيمان به، هذه خلاصة التطور التاريخي. عربيًا لا يمكن تجاهل دور الدين في النهوض العام لمجتمعاتنا، كما كان دور الدين تاريخيًا، أيّ لا بدّ من تحييد الدين عن السياسة وتركه شأنًا خاصًا بالأفراد والمجتمعات. بالتالي، إذا لم تستطع الدولة القروسطيّة إلغاء التيارات الدينيّة والمذاهب والجماعات الدينيّة الكثيرة، فإنّ تناول الدين نقديًا سيكون مفيدًا في إعادة الروح للدين "للأديان" ذاته، ولمجتمعاتنا كذلك. في هذا أيضًا، لا بدّ لمفسري الدين أن يتبنوا الحقوق الحديثة للأفراد، ولا سيما شرعة حقوق الإنسان بكلّ ملاحقها، وكذلك العدالة الاجتماعيّة ومسألة المواطنة.
إنّ مساواة الدين الإسلامي بالعنف أو بالقتل، لا علاقة له بالدين ذاته رغم وجوده آيات تتحدث عن ذلك، وهذا حال النصوص الدينيّة المسيحيّة واليهوديّة، وبالطبع فإنّ الفتاوى في معظمها سياسيّة. حين أصدر الخميني فتواه، كان خارجًا من حربٍ خاسرة، وقد جَمّدَ فاعليتها النظام الإيراني لاحقًا، واستمر الأمر تجاه محاولة اغتيال سلمان رشدي الآن؛ "الدين زفرة المضطهدين"، وقضية تتعلق بالإيمان أولًا، وثانيًا، وهي محنته الحقيقيّة، وأقصد البحث عن التوافق بين صيغته السابقة ودعم المجتمع في النهوض وضمان حقوق الناس بالتعبير والنقد ومقاربة المقدس والمدنس، وفقًا للدساتير والقوانين الحديثة، وبذلك لا يكون أفيونًا للشعوب، وفي خدمة الأنظمة.