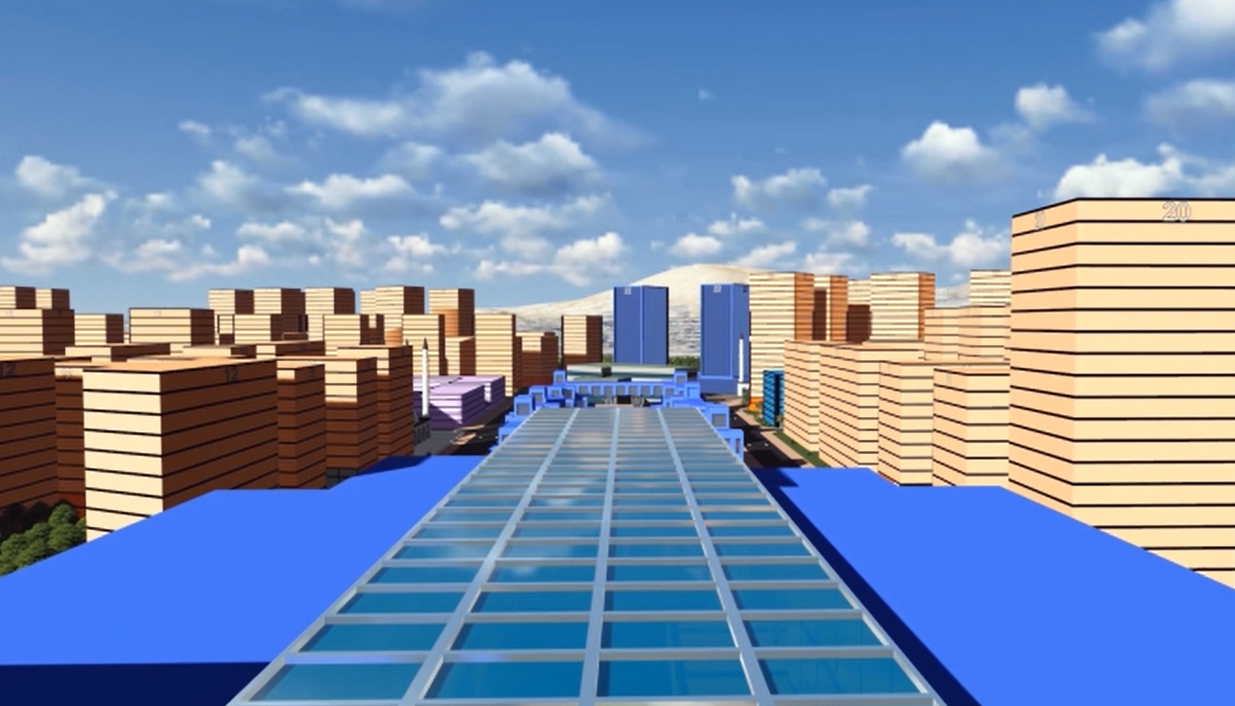العدالة الاجتماعية، هي إحدى شعارات الثورة السورية، وهي اليوم أكثر ما يفتقده السوريين. لم تُفقد بفعل ثورتهم، ولا بما آلت إليه فقط، بل ما كان ليُرفع هذا الشعار لو كانت متحقّقة. ترتبط مسألة العدالة الاجتماعية ارتباطاً مباشراً بسوق العمل؛ بالحق في العمل أولاً، وبتعويضٍ عنه يلبي تطلعات العاملين/ات. وبغيابهما، كان الإحباط واليأس قد عمّ بين من أقصاهم النظام عن حقهم في العيش الكريم، بانتظار يوم الـ15 من آذار 2011، يوم رفعت الأصوات مطالبة بالحق المسلوب.
نناقش في هذا البحث صيرورة سوق العمل في سوريا؛ محطات تحوّلاته في العمل الزراعي، والقطاع العام والخاص، في عمل المرأة وسياسات التوظيف، وكيف سار به نظام الأسد حتى بات العمل مهمة مستحيلة.
سوق العمل بين الحركة العمالية والفلاحين والبرجوازية الصاعدة
خضع سوق العمل في سوريا خلال حقبتي الانتداب الفرنسي (1920- 1939) وحكم البرجوازية الوطنية (1946- 1958) إلى آليات السوق، والصراع الدائر بين الحركة العمالية وصغار الفلاحين في سوريا وكبار الملاك والبرجوازيين من جهة، وسلطات الاحتلال الفرنسي من جهة أخرى، وخلال تلك الفترة كان دور المؤسسات الحكومية يتمثل في الإدارات العامة، ولم تكن تملك منشآت اقتصادية تلعب دوراً في سوق العمل، إذ كان دورها في التوظيف يقتصر بالكاد على الوظائف الإدارية.
كان الصراع بين الحركة العمالية والطبقة البرجوازية الصاعدة في سوريا، يتخلله فترات من التوافق المؤقت تخلقها الدوافع الوطنية المشتركة للطبقتين في نضالهم لتحقيق الاستقلال، ولعل الإضراب الستيني (1936) الذي دعت إليه الكتلة الوطنية لإجبار الفرنسيين للتفاوض على استقلال سوريا، من أبرز صور التوافق بين الحركة العمالية والبرجوازية الوطنية، إذ كان الأشمل والأطول في تاريخ سوريا.
محاولة لفك "شيفرة" الاتفاق النفطي بين الإدارة الذاتية وشركة "دلتا" الأمريكية (جزء 1)
12 تموز 2021
محاولة لفك "شيفرة" الاتفاق النفطي بين الإدارة الذاتية وشركة "دلتا" الأمريكية (جزء 2)
19 تموز 2021
لكن هذا التوافق كان محكوماً بالانتهاء بعد تحقيق المصلحة المشتركة بين الطرفين، فعشية الاستقلال في عام 1945 قاد الاتحاد الوطني للنقابات العمالية في دمشق تظاهرة بلغ عدد مشاركيها أكثر من 50 ألف عامل/عاملة طالبوا فيها بتمرير قانون العمل مهدّدين بإضراب شامل في حال رفضت الحكومة إصداره، وقد انتهت هذه الاحتجاجات بانتصارهم ليكون قانون العمل واحداً من أوائل القوانين التي تصدرها حكومة الاستقلال في سوريا عام 1946.
استمر سوق العمل في التحرّك بآلية العرض والطلب ذاتها بعد إنجاز الاستقلال، فعلى الرغم من تأميم حكومات البرجوازيات الوطنية المتعاقبة شركات الكهرباء والماء والسكك الحديدية والمواصلات، وغيرها من المنشآت الاقتصادية التي كانت بمعظمها ملكاً للشركات الأجنبية، وتحديداً الفرنسية منها، إلى جانب مشروعات الثروات الباطنية، والتي خلق بموجبها منشآت اقتصادية عامة، إلا أنّ دور القطاع العام ظلّ مقتصراً على تسيير وتنظيم النشاط الاقتصادي الذي تقوده البرجوازية الوطنية عبر منشآتها الكبيرة والمتوسطة، أي أنه لم يتحوّل إلى ممارسة النشاط الاقتصادي في السوق لغرض تحقيق الإيرادات.
وظل بذلك سوق العمل في سوريا خاضعاً لآلية السوق، والصراع السياسي بين العمال والبرجوازيين، الذي فاقم حدّته هجرة الفلاحين من الأرياف إلى المدن بحثاً عن العمل بعد المكننة الجزئية للزراعة في سوريا، والتي تزامنت مع نمو المنشآت الصناعية المتوسطة والكبيرة في الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين، فقد أدت تلك الهجرة إلى زيادة في عرض العمل، وهو ما مكن البرجوازية الوطنية من ضغط التكاليف، عبر تشغيل العمال/العاملات بأجور زهيدة. وقد نتج عن هذا الصراع في الكثير من الأحيان إضرابات واحتجاجات عمالية ساهم في تحريكها العديد من النقابات العمالية التي كانت قد تأسست في عهد الانتداب الفرنسي وساهمت في مقاومته، والدفاع عن مصالح العمال.
كما لعبت الحركة العمالية والاستياء العام للفلاحين من أوضاعهم الصعبة التي كانوا يكابدونها، في دفع قيادات البرجوازية الوطنية وكبار الملاك إلى طلب الوحدة مع مصر خوفاً من وصول الشيوعيين إلى الحكم من جهة، ومن جهة أخرى الخشية من انقلاب تقوده قوى متحالفة مع الولايات المتحدة بسبب مواقف الحكومة السورية الرافض للمشاريع الأمريكية في تلك الفترة.
يعتبر بعض المؤرخين والمحللين الاقتصاديين (منير الحمش مثلاً) أنّ تخفيض البرجوازية السورية للأجور كانت خطأ، بحكم أنه سبّب استياء الطبقة العاملة، ومن جهة ثانية أضعف الطلب الداخلي على السلع التي تنتجها. لكن في الواقع نجد أنه ليس من المنطقي وصف سعي البرجوازية لتخفيض الأجور "بالخطأ"[1]، فالغريب هو أن تمارس الطبقة البرجوازية ما يخالف طبيعتها، وهي الطبيعة التنافسية سواء مع المنتجين المحليين أو في الأسواق الأجنبية التي تصدّر لها بضائعها، هذه الطبيعة التنافسية هي ما تدفعها إلى تخفيض نفقاتها عبر ضغط الأجور. والأمر ليس حصراً على البرجوازية السورية، فهذا ما كانت تمارسه البرجوازية البريطانية الصاعدة في القرن التاسع عشر، فالظروف القاسية التي عاشتها الطبقة العاملة في بريطانيا لم تكن أفضل من تلك عرفتها الطبقة العاملة السورية.
أما توّسع السوق الداخلية، فإنه يحصل نتيجة لزيادة الإنتاجية والنمو في أعداد المشروعات الاقتصادية الجديدة التي ترفع الطلب على اليد العاملة، وبالتالي زيادة الأجور، وإن كانت تلك الزيادة تتطلّب في معظم الأحيان وجود حركات عمالية قادرة على مواجهة الطبقة البرجوازية وفرض شروطها في تحسين الأجور وبيئة العمل.
حقبة الهيمنة على سوق العمل
قطع وصول البعث باستيلائه على الحكم عام 1963 الحركة الجدلية بين العمال والفلاحين من جهة والبرجوازيين وكبار الملاك من جهة ثانية، وذلك بعد أن أحكم قبضته على سوق العمل، وهيمن على النقابات العمالية؛ حيث نجح البعث في بداية عهده في كسب شعبية كبيرة في أوساط العمال، إذ أظهر انحيازه لهم بعد إفراجه عن عدد من المعتقلين السياسيين، بما فيهم الشيوعيين، وإصداره المرسوم رقم 56 في 16 نيسان 1964، الذي أمّم بموجبه المصارف التجارية الخاصة وعدد من المؤسسات الصناعية الكبيرة التي توّلى العمال إدارتها. كما أصدر مجموعة من المراسيم تقضي بتوسيع صلاحيات النقابات العمالية وتنظيم الاتحادات الفلاحية[2]، واستتبع ذلك بمجموعة أخرى من مراسيم التأميم في عام 1965[3]، نقلت بفعلها جميع المؤسسات الصناعية الكبيرة والمتوسطة من ملكية البرجوازية إلى سلطة البعث، كما احتكروا تجارة وتسويق أهم السلع الاستراتيجية والاستهلاكية، خاصة لجهة التصدير والاستيراد، وذلك عبر تأسيس مجموعة من الشركات العامة توّلت هذه المهمة.
بدت ممارسة البعث في أعين الطبقة العاملة، وكأنها انقلاباً في علاقات الإنتاج، وأنهم، أي العمال، أصبحوا مالكين لوسائل الإنتاج، فقد سبقت تلك الإجراءات، إعلان البعث انتهاء دور البرجوازية في قيادة الاقتصادي السوري، وقد عبّر عن موقفه هذا في مؤتمره السادس عام 1963: "أصبحت الطبقة البرجوازية عاجزة عن القيام بأي دور إيجابي على الصعيد الاقتصادي، وأنّ انتهازيتها تجعلها مؤهلة للقيام بدور الحليف للاستعمار الجديد"، واعتبر البعث أنّ "العمال والفلاحين والمثقفين الثوريين من عسكريين ومدنيين والبرجوازية الصغيرة هي القوى التي تصنع بتحالفها الثورة الاشتراكية في مرحلتها الأولى".
بقرارات التأميم والدعاية الاشتراكية اكتسب البعث شعبية في أوساط الطبقة العاملة، التي تشكل عنصراً مهماً في المدن الكبرى حيث تتمركز معظم المنشآت الصناعية، فبدون كسب حوامل اجتماعية في المدن كان سيصعب على السلطة الجديدة أن يستتب لها الحكم.
على الرغم من أنّ مركز الثقل السياسي في سوريا يتركز في المدن الكبرى، وتحديداً دمشق وحلب، إلا أنّ الريف السوري اكتسب أهمية بالغة في الصراع على السلطة، ومنبع تلك الأهمية يأتي من مصدرين: أولهما التركيبة الاجتماعية الاقتصادية لسوريا؛ فحتى ستينيات القرن الماضي كان يعمل أكثر من 70% من السكان في الزراعة. وثانيهما هو الأهمية الاقتصادية للريف السوري، حيث كانت الناتج الزراعي يشكل ما بين 60% إلى 80% من إجمالي الصادرات السورية، كما تشكل حصته من الدخل القومي ما بين 33% و44%.
الصحافة في حقل ألغام الجيش الوطني وتركيا
27 تموز 2022
سجون ومعتقلات سريّة في مناطق سيطرة الإدارة الذاتيّة شمالي شرق سوريا
22 آذار 2022
لم يكن من السهل لأي سلطة في سوريا أن تكسب إلى صفها الريف السوري، إذ كانت العلاقات الاجتماعية الاقتصادية شديدة التعقيد، فالريف السوري منقسم بين إقطاعين يشكلون 2.7% إجمالي سكان الريف، ويملكون المال والنفوذ ويسيطرون على 37% من إجمالي مساحة الأراضي الزراعية، وبين جموع الفلاحين الذين يعمل معظمهم لدى كبار الإقطاعيين، وتبلغ نسبتهم نحو 97% من إجمالي العاملين في الزراعة، معظمهم فقراء ومعدومين، فنحو 17% منهم يملك أقل من 10 هكتارات، ونحو 45% منهم يملكون أقل من 100 هكتار[4].
أمام هذا الواقع لم تتجرّأ أيّ من السلطات التي تعاقبت على حكم سوريا على فتح معركة شاملة مع تلك القوتين (كبار الملاكين، وجموع الفلاحين)، فعملت جميعها على أن تظهر توزاناً في علاقتها بين الفلاحين والإقطاعيين. وقد ظهر ذلك في مسار العلاقات الزراعية بدءًا من عهد البرجوازية الوطنية (1946- 1957)، ومن ثم عهدي الجمهورية العربية المتحدة (1958- 1961) وعهد الحكم الانفصالي (1961- 1963)، وصولاً إلى التسوية البعثية.
منع تهجير الفلاحين
بدأت التغيّرات في مسألة العلاقات الزراعية تميل لصالح صغار الفلاحين في عام 1950، وهو العام الذي وضعت فيه الجمعية التأسيسية برئاسة رشدي كيخيا دستوراً للبلاد، جاء في مادته الـ21 "يعيّن بقانون حدّ أعلى لحيازة الأراضي تصرفاً أو استثماراً بحسب المناطق على أن لا يكون له مفعول رجعي". كما تطرقت المادة لمسألة توزيع أراضي الدولة "توزع الدولة أراضيها ببدل زهيد ومقسّط على غير المتصرّفين ما يكفيهم لمعيشتهم". وجاء أيضاً "تشجيع الملكيات الصغيرة والمتوسطة"[5]. على الرغم من أنّ دستور عام 1950 يشجع صراحة على الملكية الصغيرة والمتوسطة للأراضي، وهي تحديداً تستهدف فئة الـ17% من الفلاحين غير المالكين للأراضي الزراعية أو المالكين لأراضي أقل من 10 هكتارات، فإنها أيضاً تستهدف فئة الـ2% من كبار الملاك، وهي طبقة متنفذة مالياً وسياسياً وبعضهم يرتكز على قوة عشائرية، فإلى جانب ملكيتهم الكبيرة، فإن التقديرات تشير إلى أنّ 72% من أراضي الدولة (تشكل 20% من مساحة الأراضي المزروعة) كانت تؤّجر لكبار الملاك. وبذلك كان 15% من العاملين في الزراعة (كبار الملاك) يحصلون على نحو 60% من الدخل الزراعي، فيما لا تتجاوز حصة أصحاب الملكيات المتوسطة (يشكلون 10% من العاملين في الزراعة) الـ10%، بالمقابل فإن أصحاب الملكيات الصغيرة (بين 100 إلى 10 هكتارات أو أقل) والمعدومين الذين يشكلون نحو 70% من العاملين في الزراعية يحظون على 30% فقط من الدخل الزراعي[6]. وبسبب من نفوذ كبار الملاكين أحبط إصدار قانون للإصلاح الزراعي، كما أحبطت محاولة إصدار قانون يمنع بموجبه تهجير الفلاحين من الأراضي التي يعملون بها في عام 1955، وتأخر صدوره حتى عام 1957، حيث تبنى القانون ودعمه رشدي كيخيا (رئيس مجلس النواب في حينها) الذي كان مؤيداً للملكيات الزراعية الصغيرة، والكتلة التقدمية (التي يشكل البعث قوامها بزعامة أكرم الحوراني) التي كان لها الدور الأبرز في نجاح إصدار قانون يمنع تهجير الفلاحين من الأراضي التي يعملون بها[7].
حدود التغيير في العلاقات الزراعية
جاء أهم تغيير في العلاقات الزراعية في عهد حكومة الوحدة، بعد أن أصدر الرئيس جمال عبد الناصر مرسوم "تنظيم العلاقات الزراعية" (يعرف أيضاً بقانون الإصلاح الزراعي) عام 1958 لغرض معلن هو تنمية القطاع الزراعي وجعل العلاقات الزراعية أكثر عدلاً، إلا أنّ هذا القانون لم يكن جذرياً في تعاطيه مع مسألة الملكيات الكبيرة، التي جعلت قلّة من الأشخاص لا يتجاوز عددهم 10 آلاف يسيطرون على معيشة أكثر من 300 ألف أسرة فلاحية، فبحسب القانون كان من المقرّر مصادرة 1543635 هكتاراً من الأراضي، إلى جانب توزيع 1540 ألف هكتاراً من أراضي الدولة، على أن تكون مساحة الأراضي الموّزعة لكلّ أسرة لا تتعدّى الـ8 هكتارات للأرض المروية و40 هكتاراً للأرض البعلية، وبالتالي، وفي حال التطبيق الكامل للقانون، فستكون عدد الأسر المستفيدة منه هي 110 ألف أسرة فلاحية أو ثلث الأسر الفلاحية، أي سيبقى نحو ثلثي الأسر الفلاحية مستبعداً من الاستفادة من قانون "تنظيم العلاقات الزراعية". وعلى أرض الواقع، كانت التطبيق أكثر سوءً من القانون، فلم يصادر طوال عهد الوحدة الممتد لثلاث سنوات سوى 823 ألف هكتار، لم يوّزع منها سوى 61.2 ألف[8].
كما راعى القانون في العديد من جوانبه مصالح كبار الملاك، ومنحهم العديد من المزايا، فعلى سبيل المثال أعطى القانون لكبار الملاك الحق في طرد العاملين من أرضهم بدون إخطار مسبق أو تعويض، وذلك في حال "إذ جار 'العامل' على رب العمل، أو أتلف البذور أو الأسمدة، أو رفض القيام بعمله" كما جاء في المادة أربعين من المرسوم أنّ "العامل ملزم بالعمل بأمانة وجد، وفقاً لأسس فن المهنة ووفقاً لتعليمات أصحاب الأرض ووكلائه" كما أعطى المرسوم الحق للمالك بأن يمنح العاملين في أرضه بدلاً عينياً بدلاً من النقد، أما ساعات العمل فحدّدت بتسع ساعات في اليوم، مع إعطاء الحق لصاحب الأرض بتشغيل عماله لـ12 ساعة في اليوم، مقابل زيادة تبلغ 20% من أصل الأجرة عن ساعات العمل الإضافية، تلك الأجرة التي كانت تبلغ في المتوسط 3 ل.س، وفي بعض المحافظات لم تكن تتجاوز الليرتين، ولكي ندرك مدى ضآلة هذه الأجرة يكفي أن نعلم أنّ سعر كلغ الواحد من اللحم (الضأن) كان يبلغ 5 ل.س، وأنّ سعر زوجين من الأحذية يساوي 25 ل.س[9].
تعكس مواد قانون "تنظيم العلاقات الزراعية" والتباطؤ في تطبيقه خشية سلطة الوحدة من الاصطدام مع كبار الملاك، فمن الواضح من مواد المرسوم أنه لم يكن ليلغي علاقات الإنتاج الإقطاعية، بل جلّ ما يمكن أن يحدثه هو التحسين في شروط تلك العلاقة ومنح جزء من الفلاحين المعدومين أراضي ذات مساحة صغيرة يتعيّشون منها، كما أنّ التطبيق البطيء وتركه لثغرات تمكّن الإقطاعيين من تملّك مساحات أكبر، كان من بينها حق المالك أن يكتب جزءاً من أراضيه لحساب أولاده وزوجته لتكون مستبعدة من المصادرة، تدل أنّ الغرض منه هو كسب تأييد جموع الفلاحين، دون أن يكلف ذلك فتح حرب شاملة على كبار الملاك.
الإصلاح الزراعي في عهد البرجوازية وكبار الملاك
نجد محرّكات التوازن بين صغار الفلاحين والإقطاعين تفرض نفسها أيضاً في العهد القصير للحكم الانفصالي (أيلول 1961 وحتى آذار 1963)، إذ لم تمضي شهور قليلة على محاولتهم لاستبدال قانون "تنظيم العلاقات الزراعية" بآخر يحابي مصالح كبار الملاك، حتى وجد الحكام الجدد أنفسهم أمام استياءً شعبي واسع دفعهم للعودة إلى القانون القديم مع إجراء بعض التعديلات عليه، التي أتى بعضها لصالح صغار الفلاحين وغير المالكين للأراضي، منها تحديد الحد الأدنى للأجور بـ300 ل.س شهرياً، وهو ما يمثّل أكثر من ضعفي متوسط الأجور الذي كان سائداً. وبخلاف عهد الوحدة، فإنّ الحكم الانفصالي أخذ خطوات لتسريع توزيع الأراضي على الفلاحين، حتى بلغ إجمالي ما وزعه أكثر من 87 ألف هكتاراً من الأراضي المصادرة و100 ألف هكتار من أراضي الدولة[10]، ليكون بذلك قد وزّع من الأراضي على الفلاحين أكثر من ثلاثة أضعاف مما وزعته حكومة الوحدة طوال فترة حكمها.
الصحافة في روجافا (1)
29 آذار 2019
الصحافة في روجافا (2)
05 نيسان 2019
يعيدنا موقف الحكم البرجوازي من الإصلاح الزراعي، للأهمية الكبيرة التي يمثلها الريف السوري في ذلك الوقت وحساسية علاقات الإنتاج القائمة، فكبار الملاك والبرجوازيين الذين يشغلون مقاعد مجلس النواب والحقائب الوزارية، لم يلزموا أنفسهم تطبيق قانون الإصلاح الزراعي فحسب، بل سرّعوا من تنفيذه، وحسّنوا في بعض جوانبه لصالح الفلاحين! إلى جانب تعقيد المسألة الزراعية في سوريا، فإنّ سبب آخر دفع بالحكم الانفصالي لتطبيق الإصلاح الزراعي هو خلفيتهم الطبقية التي كانت لوحدها كفيلة في إثارة مشاعر الاستياء لوجودهم في الحكم، الذي وصلوا إليه بفعل انقلاب ضد أوّل دولة عربية موّحدة، في حقبة تلتهب فيها مشاعر القومية العربية. أي أنها كانت محاولة لاكتساب شرعية أمام جموع الفلاحين.
تسوية علاقات الإنتاج الزراعية في عهد البعث
سارت سلطة البعث على خطى من سبقوها في تنفيذ الإصلاح الزراعي، فلم تحدث تغييراً جذرياً في علاقات الإنتاج الزراعية، فعلى الرغم من تخفيضها لسقوف الملكية الزراعية في عام 1964، إلا أنها لم تحدث إجراءات جذرية في تطبيق الإصلاح الزراعي والتنمية الزراعية بوجه عام. وما يؤكد ذلك هي نسبة الأراضي التي شملها قانون الإصلاح الزراعي، فتشير إحصائيات عام 1975 (وهو آخر عام تفصح فيه السلطة البعث عن بيانات ملكية الأراضي الزراعية) أنّ نسبة الأراضي التي شملها الإصلاح الزراعي هي 22% فقط، لم توّزع منها على الفلاحين سوى 33.3%، فيما استبعدت وباعت 23.5% من الأراضي المصادرة، وخصّصت نحو 18% للوزارات والتعاونيات، أما الباقي فظلّ دون توزيع.
على الرغم من أنّ مسار تطبيق الإصلاح الزراعي ونتائجه في سوريا في عهد البعث، الذي لم يأت بجديد يذكر عما قدمه عهد الانفصاليين القصير، بل اتضحت عدم فاعلية القانون في تغيير علاقات الإنتاج لصالح صغار الفلاحين بشكل لا لبث فيه في عهده بالذات أكثر من أيّ وقت مضى، إلا أنّ البعث اكتسب جماهيرية واسعة بين جموع الفلاحين، خاصةً في محافظات اللاذقية وطرطوس ودرعا والسويداء ودير الزور، حيث تشير نسبة المنتسبين للبعث حتى عام 1992 لوجود حاضنة شعبية كبيرة له في تلك المحافظات. وتكبر المفارقة، إذا علمنا أنّ الإصلاح الزراعي في تلك المحافظات كان الأقل من بين جميع المحافظات الأخرى، بل إنه لم يحدث إلا تغييراً طفيفاً في الملكية الزراعية، فنسبة الأراضي التي خضعت للمصادرة في اللاذقية وطرطوس لم تتجاوز الـ5.5% و7% على التوالي، أمّا في درعا والسويداء فتصل نسبة الأراضي المصادرة إلى 3.4% و1.8%، بالمقابل تصل النسبة الأراضي المصادرة في دمشق والقنيطرة مجتمعتين إلى 38.7%[11].
إذن لا يمكن اعتبار أنّ للإصلاح الزراعي دوراً رئيسياً في اكتساب البعث لشعبيته في الريف السوري، فجلّ ما فعله هو إلغاء العلاقات الاقطاعية بصورتها القديمة، أي أنّ يكون الاقطاعي "مالكاً للأرض ومن عليها" أي مالكاً للفلاح وأسرته، وعلى الرغم من تقدمية هذه الخطوة، إلا أنّ إلغائها لم يكن بحاجة إلى حكم اشتراكي، فهذا الدور أنجزته الرأسمالية نفسها، والعلاقات الاقطاعية انتهت في كلّ دول العالم تقريباً في تلك الحقبة.
يشير العديد من الباحثينّ أنّ الاهتمام البعثي بتطوير البنية التحتية في الريف كان له دوراً في خلق حاضنة شعبية له، فقد جرت في عهد البعث معظم مشروعات البنى التحتية المتعلقة بمدّ خطوط الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وافتتاح الوحدات الصحية والمدارس، وهي مشروعات أحدثت خلال وقت سريع نسبياً إذا ما قورنت مع الفترات السابقة. إلا أنّ ذلك أيضاً ليس كفيلاً بتفسير وجود حاضنة شعبية عريضة للبعث في الريف، وهنا علينا أن نتوقف عند خطورة هذه السردية، التي تصوّر مشروعات البنية التحتية كمكتسبات للفلاحين، وهي في الحقيقة كانت ستجري، سواء في ظلّ سيطرة البعث أو أي سلطة أخرى، بما فيها سلطة الاحتلال الفرنسي. تطوير البنى التحتية من مدّ لشبكات الكهرباء وتعبيد الطرقات والجسور، هي أمور لا مفر من تطبيقها، فحتى في الدول التي لم تعرف يوماً حكماً اشتراكياً أو نموذج دولة الرفاه حدث فيها ما حدث للريف السوري، ولنا في الجوار السوري خير مثال على ذلك، من تركيا شمالاً إلى الأردن جنوباً، فكلاهما لم يعرفا يوماً حكماً اشتراكياً أو نموذج دولة الرفاه الاجتماعي، وبالمقابل، فإنّ حالة الريف التركي، ومن جميع النواحي كانت أفضل من الأرياف السورية، ووصلها من تعليم وطبابة ما وصل إلى فلاحي سوريا، بل أكثر منهم، وفي الحقبة ذاتها.
مع ذلك لا يمكن إهمال دوري الإصلاح الزراعي وتطوير الريف في إيجاد قاعدة شعبية للبعث، فإلى جانب الأثر الفعلي لهذا الدور، فإنّ هنالك أثراً نفسياً ومجتمعياً كبيرين في أبناء الريف الذين وجدوا أنفسهم في موقع الاهتمام على نطاق واسع لأوّل مرّة في تاريخهم المليء بالقهر والفقر والتهميش، خاصة أنّ ذلك الأثر كان معزّزاً بأمرين: الأمر الأول هو المشاركة الفعلية لأبناء الريف في النظام السياسي وتبوئهم لمناصب في الحكومة، أي كانوا مشاركين فعليين في تحسين أوضاعهم، والأمر الثاني هو الدعاية البعثية عن الإصلاح الزراعي وتطوير الريف بوصفه منجزات تقدمية ما كانت لتحدث لولا وجود البعث في السلطة، وهي الدعاية التي لطالما حرص البعث على بثّها على مدار عقود مضت.
نعتقد أنّ العامل هو سياسية التوظيف التي مارسها البعث على نطاق واسع منذ السبعينيات وحتى بداية الألفية، فمع بداية السبعينيات أجرى البعث توّسعاً هائلاً في مشروعات القطاع العام بشقيه الإنتاج والخدمي، بالإضافة إلى العسكري والأمني، مستفيداً من الاكتشافات النفطية في أواخر الستينيات والمساعدات العربية والسوفياتية التي كانت ترفد خزائنه بمليارات الدولارات سنوياً. إذ لعبت سياسة التوظيف دوراً رئيساً في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لأبناء الريف، خاصة المهمشين منهم، الذين لم يستفيدوا من سياسة الإصلاح الزراعي، أو الذين حصلوا على بضع هكتارات لا يكفي مردودها لسدّ الاحتياجات الأساسية، سيما مع توالي الأجيال اللاحقة وتشتت الملكية إلى مساحات أصغر بين الورثة. فكانت الوظائف التي وفرها البعث ومنح الأولوية لأعضائه فيها دوراً بارزاً في خلق حوامل اجتماعية داعمة له، لا في الأرياف فقط، بل في المدن أيضاً التي أصبحت خليطاً ما بين أبنائها الأصليين والقادمين الجدد من الريف.
جرحى انفجار مرفأ بيروت: السوريون يغرقون في الإهمال وعبء تكاليف العلاج بعد عامَيْن على الانفجار
03 آب 2022
يظهر تغيّر التركيبة الاجتماعية الاقتصادية في سوريا بين عام 1960 و1980 الدور الكبير الذي لعبته سياسة التوظيف في سوق العمل، حيث كان سكان الريف يشكلون أكثر من 61% من إجمالي سكان سوريا، ونسبة العاملين في الزراعة تبلغ 52%، أما في عام 1980 فقد انخفضت النسبة المئوية لسكان الريف لتصل إلى حوالي 53%، فيما وصلت نسبة العاملين في الزراعة إلى 24.2%، أي أنّ نسبة انخفاض العاملين في القطاع الزراعي قد انخفضت إلى أكثر من 54%، هذا الانخفاض الكبير لا يمكن تفسيره إلا بالهجرة الواسعة التي حدثت من الريف إلى المدن، لاسيما أنّ نسبة العاملين في الزراعة عام 1970 كانت 49.4%، أي أنّ الانخفاض الكبير في نسبة العاملين في هذا القطاع حدث خلال عقد واحد فقط! وهو العقد ذاته الذي شهد طفرة في توّسع القطاع العام الإنتاجي والخدمي.
بذلك أصبح نظام البعث هو المسيطر على سوق العمل، هذا السوق غير الخاضع للحركة العفوية للعرض والطلب، بل إلى أهداف وخطط البعث السياسية الاقتصادية، فآليات التوظيف في القطاع العام لا تخضع إلى معيار الاستثمار الأفضل للموارد، بل لأغراض سياسية تهدف للسيطرة على الاقتصاد والمجتمع.
على الرغم من أنّ صغار الفلاحين والمهمّشين وجدوا أنفسهم في القطاع العام، إلا أنّ سوء أحوالهم الزراعية كانت أكثر عمومية من أن يشمله توظيف القطاع العام، ومن جهة أخرى لم يكن حال العاملين في القطاع العام بأفضل حال، إذ كانت الأجور المتدنية تدفع الكثير من العاملين للهجرة إلى دول الخليج العربي الذي كان يمنح أجوراً أعلى، حيث سجلت المئات من حالات التسرّب الوظيفي، كما أن سرعة الدوران الوظيفي كانت عالية، ففي قطاع الغزل والنسيج لوحده انخفض عدد العاملين بنسبة 7.5% (أكثر من 1800 عامل) بين عامي 1974 و1978[12]. كما أنّ سياسات التوظيف التي تعطي الأولوية للولاء السياسي للبعث على الكفاءة المهنية والشهادات العلمية أقصت الآلاف من المتقدمين للوظائف الحكومية، فالمعيار الحزبي كان كفيلاً بوضع مدراء أقسام ومؤسسات من البعثيين، حتى لو اقتصر تحصيلهم العلمي على شهادة "السرتافيكا" (تعادل الشهادة الابتدائية).
مع ذلك، يجب علينا أن نضع بعين الاعتبار عملية المقارنة الذاتية، أي كيف هم يرون أوضاعهم الجديدة بعد أن وصل البعث إلى السلطة، فأولاً هم لم يكونوا يتضوّرون جوعاً، وثانياً كانت حالتهم الاقتصادية والاجتماعية في ظلّ حكم البعث أفضل من أيّ وقت سبق، وما يدل على ذلك هو ارتفاع مستوى التعليم ومتوسط عمر الإنسان عند الولادة وانخفاض معدلات الوفيات بين الأطفال.
أما عن دور الحركة العمالية في ظلّ تلك الأحوال، التي تفاقمت في العقود اللاحقة، فإنه كان مغيّباً. فعلى الرغم من ازدياد أعداد النقابات العمالية والمهنية وعدد منتسبيها، فإنّ سلطة البعث هيمنت على جميع مفاصلها، فالعدد الأكبر من منتسبي النقابات هم من العاملين في القطاع العام، وهم بحكم سياسة التوظيف بعثيين بمعظمهم، لذلك كان النشاط داخل النقابات، وخاصة في الأدوار القيادية، بالكاد محصور بالبعثيين، وبحصة ودور أصغر لأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية التي أحدثها الأسد في عام 1972.
لم تقطع هيمنة البعث جميع السبل لإعادة إنتاج حركة عمالية ومهنية تدافع عن حقوق منتسبيها فحسب، بل جعلتها إطاراً هلامياً يمتص ويبطل مفعول تحرّكات الأفراد النشطين داخل تلك النقابات، عبر إضعاف أدوارهم أو احتوائهم وإقصاء من لا تجدي معه تلك الحلول عبر التهديد وقمع الأجهزة الأمنية.
وعلى الرغم من أنّ الاحتجاجات العمالية في القطاعين الخاص والعام لم تتوقف منذ السبعينيات وحتى سنوات الثورة، إلا أنّ تلك الاحتجاجات تفتقر للطابع السياسي والعمومي، فهي لا تخرج عن نطاق مكان العمل، أي لا تنزل إلى الشوارع والساحات العامة، كما أنّ مطالبها محدودة بنطاق عمل أفرادها داخل الوحدة الإنتاجية أو المصنع، فلا تصل حتى للمطالبة بحقوق جميع العاملين في ذات القطاع الإنتاجي. إن غياب حالة التضامن العمالية والمهنية والصبغة السياسية على الاحتجاجات العمالية في سوريا يوضح غياب الدور القيادي للحركة العمالية السورية بعد عام 1970، وهو الدور الذي من المفترض أن تلعبه النقابات العمالية والمهنية.