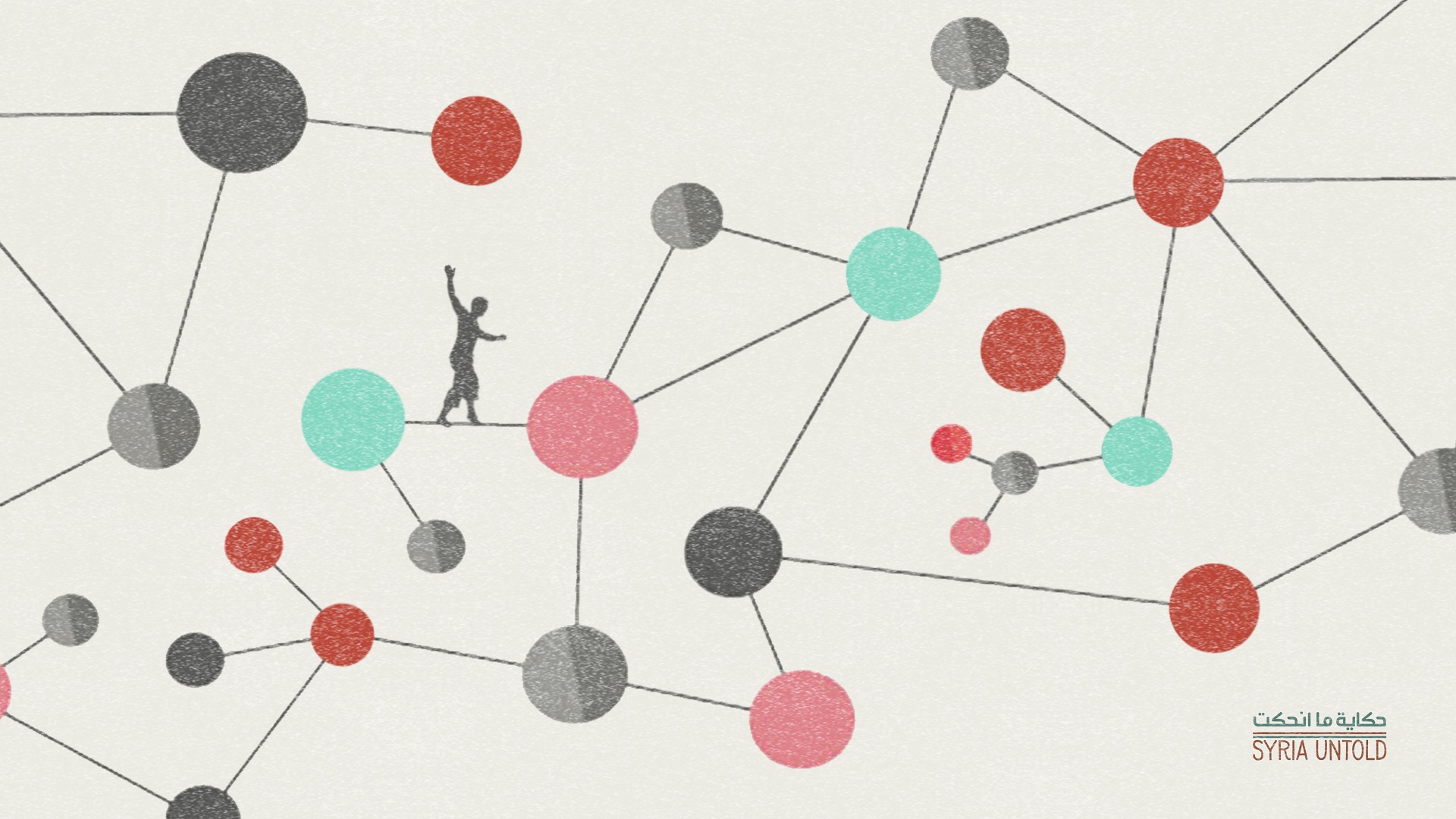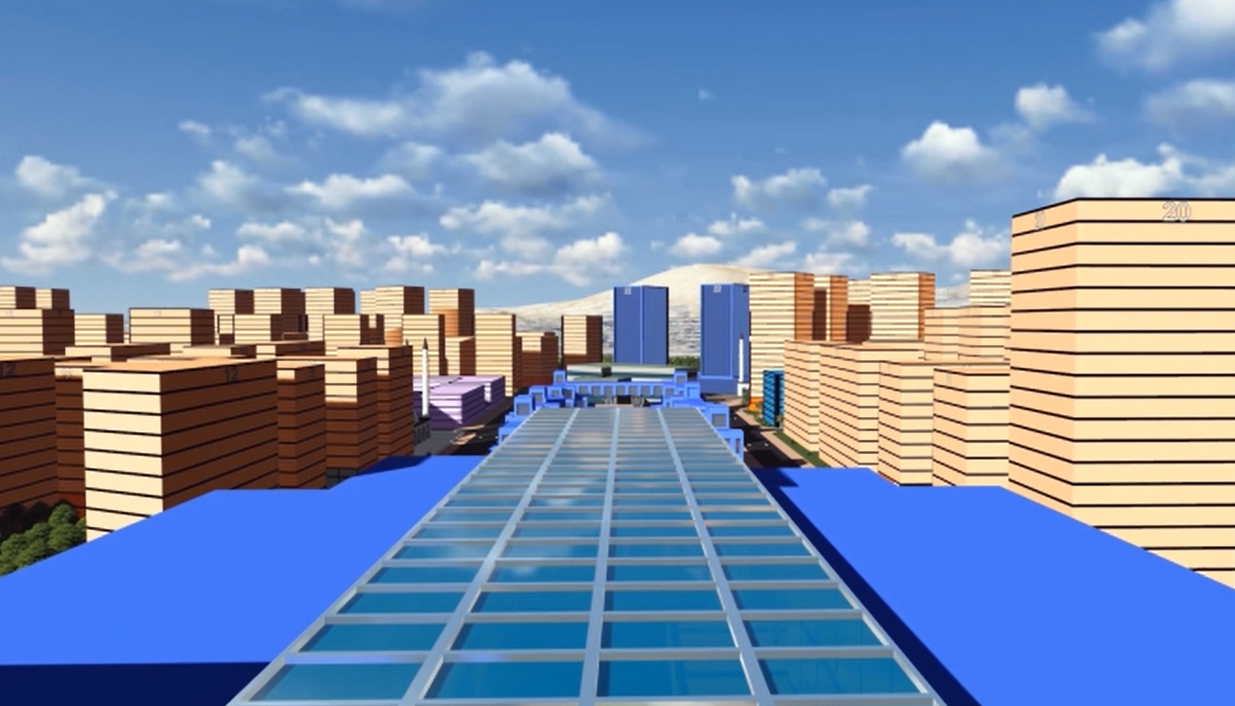يُمكنكم الإطلاع على الجزء الأول من هذه المقالة هنا.
صعود رأسمالية المحاسيب وتراخي قبضة البعث على سوق العمل
كان من اليسير على حزب البعث تحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة بالتزامن مع سياسة التوظيف الاستيعابي السياسي في بلد صغير يبلغ عدد سكانه نحو 6 ملايين و351 ألف نسمة (عام 1970)، وتحوّل في عهده إلى بلد مصدّر للنفط ويتلقى مليارات الدولارات من المساعدات إلى جانب تحويلات السوريين العاملين في الخارج. وبسبب من تلك الظروف الاستثنائية، تمكّن حزب البعث من تحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة في عقد السبعينيات، حيث وصل معدلها الوسطي لأكثر من 12%، كما انخفضت خلال هذا العقد نسبة وفيات الأطفال الرضع ووفيات النساء عند الولادة، وارتفع متوّسط العمر المتوّقع عند الولادة، ونسبة الأمية. وبفضل التوّسع الكبير في مشروعات القطاع العام خلال طفرة السبعينيات، لم تتجاوز نسبة البطالة خلال عقدي السبعينيات والثمانينات حدود الـ6% إلا بصورة طفيفة، إذ ظلت تتراوح ما بين 4% إلى 6% طوال السبعينيات والثمانينيات.
لأنّ هذه "النهضة" الاقتصادية-الاجتماعية كانت قائمة على عوامل غير مستدامة (المساعدات، صادرات النفط، تحويلات السوريين في الخارج...)، فإنّ الاقتصاد السوري سرعان ما دخل في أزمة ركود في منتصف الثمانينات، ظهرت انعكاساته في تباطؤ النمو في الناتج المحلي الإجمالي الذي لم يتجاوز معدله الوسطي طوال عقد الثمانينيات الـ2%[1]، وفي تجميد دور القطاع العام عند الحدود التي وصل إليها في القطاع الصناعي والزراعي، فتوّقفت تقريباً جميع الاستثمارات في المشروعات الجديدة، وكذلك الاعتمادات المرصودة لاستبدال وتجديد المعدات اللازمة للمشروعات القائمة[2]. فقد انخفضت اعتمادات الصناعات التحويلية من 15%-20% في عقد السبعينيات إلى 13% في عام 1980 و5.7% في عام 1985 وصولاً إلى عام 1989 الذي انخفضت فيه نسبة الاعتمادات إلى نحو 1.8%. أما الانفاق الفعلي، فكان يتراوح ما بين 26% إلى 52%، فيما لم تتجاوز نسبة استثمارات القطاع العام 3% في عام 1988[3].
كما انحسرت مساهمة قطاعي الزراعة والصناعة لحساب نمو قطاعي التجارة والخدمات اللذين استحوذا على 65% من تركيبة الناتج المحلي الإجمالي[4]، وتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الصافي بتكلفة عوامل الإنتاج من 7930 ل.س إلى 6880 ل.س بين عامي 1985 و1990، أي بنسبة 13.2%.[5]
وخلال عقد الثمانينات بدا من الواضح أنّ نظام البعث قد بدأ بتحجيم دور القطاع العام في الصناعة والتجارة الداخلية والخارجية، فكما أسلفنا توّقف توّسع القطاع العام الإنتاجي وظهرت بوادر إهماله، أما على الصعيد التجاري، فكسر البعث حصر استيراد العديد من السلع الاستهلاكية والاستراتيجية بمؤسسات الدولة، وفتح المجال للقطاع الخاص باستيرادها، فحدث تحوّل سريع في حصة كلا القطاعين في التجارة الخارجية تلك، إذ تشير بيانات التجارة الخارجية أنّ حصة القطاع الخاص من إجمالي المستوردات، ارتفعت من 25% في عام 1986 لأكثر من 46% في عام 1990، أي أنها ارتفعت 21% بغضون 4 سنوات فقط، الأمر ذاته ينطبق على الصادرات التي ارتفعت فيها حصة القطاع الخاص من 30% إلى 45% للفترة نفسها[6].
محاولة لفك "شيفرة" الاتفاق النفطي بين الإدارة الذاتية وشركة "دلتا" الأمريكية (جزء 1)
12 تموز 2021
محاولة لفك "شيفرة" الاتفاق النفطي بين الإدارة الذاتية وشركة "دلتا" الأمريكية (جزء 2)
19 تموز 2021
تبلور التحوّلات الاقتصادية للبعث، كانت الإرهاصات الأولى لانسحاب البعث من المسؤولية الاقتصادية الاجتماعية، والتي تبلورت في عام 1991 بعد صدور قانون الاستثمار رقم 10، الذي أفسح في المجال للمزيد من النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، الذي لم يحظى بفرصة حقيقية في النشاط الاقتصادي طوال العقود اللاحقة حتى بمعايير النيوليبرالية، فتراوح نشاط القطاع الخاص على مسطرة الأسد بين المقرّبين من الحلقة الضيقة، المحظيين باحتكار الأنشطة الأكثر أهمية وربحية، أبرزها احتكار قطاع الاتصالات واستيراد السلع الاستهلاكية، وبين كبار التجار والصناعيين المضطرين لمشاركة أعمالهم أو دفع الرشاوي للمسؤولين في السلطة أو من ينوب عنهم من أبنائهم أو واجهتهم الاقتصادية.
تفشي البطالة
على الرغم من صعود رأسمالية المحاسيب إلا أنّ مشكلة سوق العمل في سوريا ظلّت مستترة بفعل الريع السياسي وهجرة العمالة السورية إلى الخارج، وخاصة دول الخليج العربي، وذلك حتى منتصف التسعينات، حيث بدأت ملامح الكارثة الاقتصادية الاجتماعية التي كانت تسير إليها سوريا بالظهور، فالتدفقات المالية بفعل الريع السياسي تراجعت مرّة أخرى لحدود صفرية بعد حرب الخليج الثانية، ومستويات الهجرة إلى دول الخليج العربي بدأت بالانخفاض، بعد أن أخذت الدول الخليجية بسياسة زيادة توطين الوظائف محلياً منذ الثمانينيات، ولاحقا تفضيل العمالة الآسيوية على العمالة العربية، لأسباب اقتصادية أهمها رخص اليد العاملة الآسيوية مقارنةً بالعربية، وأسباب سياسية تتمثل بتزايد المخاوف من مخاطر التغيّر الديمغرافي مع ارتفاع نسبة العرب القادمين من بلدان ترفع شعارات القومية العربية، وما يترتب على ذلك من مخاطر سياسية، سيما بعد موقف جبهة التحرير الفلسطينية المؤيّد لغزو صدام حسين للكويت 1991، وما تلاه من عقاب جماعي لثاني أكبر تجمّع للفلسطينيين في الخارج دفع بهم تحت الضغوطات للخروج من الكويت، ليتقلّص عددهم من 400 ألف صيف عام 1991 إلى نحو 30 آلاف فقط بعد عام واحد من تحرير الكويت.
أما العامل الرئيسي، فكان النمو السكاني المتزايد، إذ عندما وصل حزب البعث إلى السلطة في عام 1963، كان عدد سكان سوريا نحو خمسة ملايين نسمة، ووصل في عام 1980 إلى نحو 8 ملايين 931 ألف نسمة، لكن حتى ذلك الوقت كانت عوامل الريع السياسي والاقتصادي والهجرة بإمكانها التغطية، ولو جزئياً، على المشكلات الاقتصادية، لكن مع تراجع تلك العوامل ووصول عدد السكان إلى أكثر من 12 مليون و400 ألف نسمة بحلول عام 1990، أي ما يقرب من ضعف عدد سكان سوريا في عام 1970، لم تعد أموال الريع السياسي والاقتصادي كافية للتغطية على المشكلات الاقتصادية، فهي ليست كبيرة بما يكفي ليستفيد منها الجميع. فسوريا لم تعد ذلك البلد الصغير (5 ملايين) الذي يمكن لتوزيع بضع مليارات في صورة خدمات وتوظيف اجتماعي من أن تشعر سكانه بارتفاع مستويات المعيشة، وإن بشكلٍ مؤقت. ومن هنا، راحت معدلات البطالة بالارتفاع إلى نسب غير مسبوقة منذ السبعينيات، ففي عام 1994 وصل معدل البطالة إلى نحو 6.7%، وارتفع عامي 1995 و1999 إلى نحو 7.93%. وقد ارتفعت معدلات البطالة مع الألفية الأولى لتبلغ في عام 2004 أكثر من 12%[7]، وتواصل ارتفاعها إلى أن بلغت ذروتها عشية الثورة السورية، حينما وصلت لنحو 25% وفقا لتقديرات غير رسمية.
جاء تفاقم مشكلة البطالة مع نمو تخلّف البنية الاقتصادية لسوريا في ظل رأسمالية المحاسيب، فالصناعة السورية التي نشأت أواخر القرن التاسع عشر كانت تنشط في صناعات تقود الاقتصاد العالمي في ذلك الوقت، وهي الصناعات النسيجية والغذائية، وتطورت لاحقا لتدخل في الصناعة الزجاج والأثاث وغيرها، لكن الصناعة السورية تخلّفت كثيراً في بنيتها، ففي الوقت الذي استمرت فيه الصناعة السورية عند حدودها السابقة تقريبا، باستثناء بعض الصناعات، فإنّ الاقتصاد العالمي بات يقوده الصناعة الإلكترونية في الستينيات، وصناعة الاتصالات والبرمجيات في التسعينيات، وصولاً إلى العقد الثاني من الألفية الجديدة التي تقودها صناعات الذكاء الاصطناعي، بينما تزال الصناعة السورية تعاني من مشكلات في الصناعة النسيجية والغذائية!
أدّى تخلّف البنية الصناعية إلى تحوّلات خطيرة في تركيبة البطالة والعمل في سوريا، وفي سياسة التوظيف التي سنأتي عليها لاحقاً. وكان من بين أهم آثار تخلّف البنية الاقتصادية في سوق العمل، الآتي: تركيبة سوق العمل بحسب المستوى التعليمي للقوى العاملة، وبطالة الريف والهجرة إلى المدن، ودور المرأة في النشاط الاقتصادي.
التعليم لأجل التعليم
بحكم تخلّف البنية الاقتصادية السورية، من حيث ضعف استخدامها لأدوات الإنتاج وأساليب العمل الحديثة، فإنّ حاجات القطاع المختلفة وبشكلي ملكيتها الرئيسيين (العام والخاص) إلى عاملين/عاملات مؤّهلين/ات علمياً باتت شبه معدومة، إلا في بعض الأنشطة المحدودة (مشافي ومصانع أدوية، ومدارس وجامعات خاصة..)، وهو ما تؤكده بيانات تركيبة القوى العاملة بحسب مستوى التعليم (2010)، التي تظهر أنّ معظم العاملين/عاملات في القطاع الخاص هم من غير المؤهلين علمياً، فنسبة العاملين/العاملات في القطاع الخاص من الحائزين على شهادة التعليم الابتدائي فما دون، تصل لأكثر من 72% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، يليهم الحائزين على الشهادة الإعدادية (التعليم الأساسي) بنحو 13%، والحائزين على الشهادة الثانوية بنسبة 7%. أما العاملين من الحائزين على شهادة التعليم المتوسطة والشهادة الجامعية وما فوق، فيشكلون مجتمعين أقل من 7%.
اقتصاد الحرب السورية
03 أيلول 2019
لا يختلف الأمر كثيراً في القطاع العام، فنسبة العاملين فيه من الحائزين على شهادة التعليم المتوسط أو الجامعية وما فوق هي أقل من 46%، يقابلها نسبة 54% من الحائزين على شهادة التعليم الثانوية أو الإعدادية (تعليم أساسي) أو الابتدائية فما دون. ومن الجدير بالملاحظة هنا أنّه حتى العاملين في القطاع العام من الحائزين على الشهادات المتوسطة والجامعية، يتركزون في قطاعين أساسيين، هما: التعليم والصحة، حيث تشكّل نسبة العاملين في وزارة التربية من الحائزين على شهادة التعليم المتوسطة أو الشهادة الجامعية وما فوق نحو 70%، أي نحو 265 ألف موظف/موظفة، يضاف إليهم نحو 22 ألف من الموظفين/موظفات ممن يعملون لصالح وزارة التعليم العالي، ويشكلون ما نسبته 61% من إجمالي الموظفين/ موظفات التابعين للوزارة. كذلك الأمر في وزارة الصحة التي يشكل فيها نسبة الحائزين على شهادة التعليم المتوسطة أو الجامعية وما فوق نحو 50%، أي أكثر من 47 ألف موظف/موظفة. وبالتالي، وبحسب بيانات عام 2010، فإنّ الموظفين/الموظفات التابعين لوزارات التربية والتعليم العالي والصحة من الحائزين على شهادة تعليم متوسطة أو جامعية وما فوق، يشكلون نحو 30% من إجمالي العاملين في القطاع العام، أي أنّ 70% من الحائزين/ات على شهادة تعليم متوسطة أو جامعية وما فوق من العاملين/ات في القطاع العام هم من المدرسين/مدرسات التابعين لوزارة التربية ووزارة التعليم العالي، ومن الأطباء/والطبيبات والممرضين/الممرضات التابعين لوزارة الصحة. أما الـ30% الأخرى، فهي حصة الموظفين/الموظفات من الإداريين الذين يتطلب مركزهم الوظيفي الحصول على شهادة تعليم متوسطة أو جامعية وما فوق، مثل العاملين/العاملات في وزارة العدل (غالباً من المحامين/محاميات).
إنّ التمعن في البيانات السابقة، يوصلنا إلى استنتاج مفاده أنّ أي خريج/خريجة في معهد متوسط أو كلية سيكون احتمال توظيفه في القطاع الخاص (وفقاً لشهادته العلمية) هي 7%، وفي القطاع العام هي 46% لكن وظيفته في القطاع العام ستكون بالكاد محصورة في عملين، إما الطبابة أو التعليم، والنسبة الأكبر تكون من حصة التعليم. إذّاك، يُحال الهدف من التعليم إلى التعليم إياه، فالخريج/الخريجة في المعهد أو الجامعة سيكون مدرساً/مدرسة لجيل قادم سيعمل (في أفضل الأحوال) مدرّس/مدرّسة. وهذا ما يفسّر لدرجة كبيرة القيمة الاجتماعية العالية (وغالباً المادية) لخريجي/خريجات الطب، فليس السبب الوحيد لارتفاع أجورهم هو طول سنوات الدراسة والتكاليف المرتفعة لها، بل أيضاً لأنّ فرصهم في العمل مضمونة، بسبب الحاجة الاجتماعية لعملهم، فيما باقي الخريجين/الخريجات في الاختصاصات الأخرى، فليس لهم مكان في بنية اقتصاد متخلّف.
ترييف المدن
أدّت جملة من الظروف إلى زيادة الهجرة من الأرياف للمدن، يأتي على رأس تلك الظروف، تشتّت الملكية الزراعية في سوريا بتوالي الأجيال، حيث أصبحت مساحة نحو 74.6% من الحيازات الزراعية أقل من عشرة هكتارات بحلول عام 1980 [8]، وهو ما أدى بدوره إلى ضعف إنتاجية العمل الزراعي وجدوى العمل به لتأمين الاحتياجات الأساسية، وهو ما ظهر بوضوح في عام 2008 عندما هاجر نحو 300 نسمة من الأرياف إلى المدن بالتزامن مع موسم الجفاف، يضاف إلى ذلك تمدّد الزحف العمراني إلى الأرياف المحاذية للمدن، وهو ما دفع الفلاحين لبيع أرضهم أو تأجيرها، سيما أنه خلال فترة السبعينيات كانت الوظيفة الحكومية مغرية للفلاحين المعدومين وأصحاب الملكيات الزراعية الصغيرة. وحتى مع تراجع سياسة التوظيف في القطاع العام، فإنّ الكثير من أبناء الريف لم يعد لديهم سبيل للعيش في الريف، وهو ما ظهر في تراجع نسبة العاملين في القطاع الزراعي، ففي الوقت الذي بلغت فيه نسبتهم نحو 28% في عام 1991، فإنّ نسبة العاملين في القطاع الزراعي، قد انخفضت لنحو 19% في عام 2006، وإلى نحو 14% فقط في عام 2010.
وبالمحصلة، بدلاً من أن تؤدي التنمية الزراعية وإجراءات الإصلاح الزراعي إلى تمدين الريف، أي تحويل الأرياف إلى مدن تُصنع فيها الزراعة، فإنّ المدن السورية تريّفت.
تظهر ملامح الترييف في العلاقات الاجتماعية والاقتصادية داخل المدن، فالمهاجرون من الأرياف إلى المدن جلبوا علاقاتهم الاجتماعية معهم، حيث اختاروا التوطين على أساس تلك العلاقات، فعلى أطراف دمشق استوطن المهاجرين من محافظة السويداء في منطقة جرمانا التي أصبحت أكبر تجمّع للطائفة الدرزية في سوريا خارج محافظة السويداء، كذلك فعل المهاجرون من الطائفة العلوية الذين تجمّعوا في مناطق محدّدة في دمشق، أبرزها المزة 86 وعش الورور، والحال ذاته ينطبق على باقي المدن السورية، منها مدينة حلب التي اختار فيها الأكراد تجمعين لهم، هما منطقتي الشيخ مقصود والأشرفية. وما يشير إلى حجم الانغلاق في تلك التجمعات الريفية هو أنها غير منقسمة طبقياً، فعلى الرغم من أنّ معظم تلك المناطق تصنّف بأنها سكن عشوائي، فإنّ أصحاب الدخول المتوسطة، وحتى الأغنياء منهم يفضلون العيش فيها، أي ضمن تجمعاتهم الاثنية أو الطائفية أو العشائرية... على الانتقال إلى مناطق السكن المنظم بين سكان لا ينتمون إلى نفس مجموعتهم.
دوافع ريادة الأعمال في فترات الصراع واللجوء
18 تموز 2019
توحي عملية الاستيطان المشار إليها بارتباطها بخلفية طائفية أو أثنية، إلا أنّ استمرار علاقات الارتباط للجماعات الأهلية، تنسحب أيضاً على المهاجرين من خلفيات سنية عربية، خاصة في الحالة العشائرية، من ذلك نذكر عشيرة البكارة التي استوطنت منطقة النيرب التي تقع على أطراف مدينة حلب، والماردل (نسبة إلى مدينة ماردين في جنوب تركيا) الذين يتجمعون في منطقة السيد على داخل مدينة حلب. وحتى في حالات الهجرة التي لم تأخذ شكل الاستيطان في مناطق خاصة، فإنّ علاقات الارتباط والتعاضد العشائرية أو القروية أو الأسرية، استمرت داخل المدن.
لم تؤدي هجرة أبناء الريف إلى المدن لتحسين أوضاعهم الاقتصادية، فهم في معظمهم غير متمرّسين على العمل الحرفي أو التجاري، أي يصعب عليهم، بخلاف أبناء المدن، ممارسة الأعمال الحرة والحرفية، وما يظهر حالة الفقر التي آلت إليه أوضاعهم، هو تجمعهم في الأحياء الفقيرة والعشوائية، مشكلين حول المدن الكبرى ما اصطلح على تسميته "أحزمة الفقر".
النشاط الاقتصادي المحدود للمرأة
ليس دور المرأة السورية الاقتصادي جديداً، فلطالما كانت حاضرة في العمل الزراعي تقوم بجميع الأدوار التي كان يقوم بها الرجل، كما برز دورها مبكراً في القطاع الصناعي الناشئ في سوريا في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، فقد شكلت العاملات في القطاع الصناعي عام 1937 نحو 32% من إجمالي العاملين/العاملات في هذا القطاع[9]، وهي نسبة مرتفعة للغاية في ذلك الوقت، سيما أنّ عمل المرأة في الصناعة، لم يكن محصوراً في الأعمال التي تنجز في المنزل، بل كانت تعمل أيضاً في المصانع الحديثة. هذا الى جانب دورها المبكر في القطاع الخدمي (تدريس، طبابة...).
لكن للمفارقة، فإنّ دور المرأة في النشاط الاقتصادي أخذ بالانخفاض مع الوقت، فمع التراجع السريع لحصة العمل الزراعي، وصل إجمالي عدد العاملين/العاملات في هذا القطاع الى نحو 14%، تراجعت معه نسبة عمل المرأة. وفي الوقت الذي من المفترض به أن تعوّض حصة عمل المرأة في القطاع الصناعي، فإنّ القطاع الصناعي نفسه أخذ بالتراجع أيضاً. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ عمل المرأة في المصانع لا يحظى بقبول اجتماعي واسع، فغالباً ما تقع المصانع خارج المدن، وفي بيئة عمل مغلقة وبعيدة عن الفضاء العام، وفي ظلّ غياب سيادة القانون، فإنّ بيئة العمل في المصانع غالباً ما تكون غير آمنة لعمل المرأة. وذلك بخلاف العمل الزراعي الذي كانت تنشط فيه المرأة السورية، فالعمل الزراعي يحدث في فضاء عام محلي، يعمل به أبناء عائلة واحدة أو أقاربهم أو أبناء القرية بصورة تعاونية غالباً، وفي ظلّ روابط اجتماعية تحكمها الأعراف، فتعتبر نسبياً أكثر أمناً.
أما في قطاع الخدمات، فنجد أنّ نسبة مشاركة المرأة أعلى، خاصة في قطاعي الطبابة والتعليم، سيما في القطاع العام، فالأخير يوّفر أمرين: أولاً، البيئة الآمنة نسبياً لعمل المرأة، وثانياً تمكين المرأة المتعلّمة من الحصول على فرصة عمل ملائمة، وهو كما أسلفنا بات ضيقاً للغاية في القطاع الخاص (7%).
طريق شاقة للوصول إلى بيئة عمل آمنة وملائمة للنساء في شمال شرقي سوريا
11 أيار 2022
إلى جانب ذلك، فإنّ انتشار العمل في اقتصاد الظل (يشكل نحو 30% إلى 40% من الاقتصاد السوري) من بائعين متجولين وبسطات وأعمال مهنية حرة وغيرها، ساهم في إضعاف حضور المرأة في النشاط الاقتصادي. باختصار كان حضور المرأة في العمل ينخفض في جميع القطاعات مع نمو تخلف البنية الاقتصادية.
يضاف إلى ذلك، القيود الاجتماعية التي تعيق عمل المرأة، والتي عزّزها عودة الصحوة الدينية المحافظة التي أعقبت أحداث الإخوان المسلمين، ولاحقا انهيار الاتحاد السوفياتي (1991)، وأفول الفكر الاشتراكي الذي أضعف حضور الأفكار التقدمية التي كانت تلاقي رواجاً في سوريا، وما لعب الدور الأكبر لعودة الفكر الديني والقومي هو غياب مشروع الدولة الوطنية في سوريا.
لطالما ساهمت الظروف المعيشية الضاغطة في كسر قيود عمل المرأة، لكن التدهور الحالي، فاق جميع الضغوط السالفة، فأصبح عمل المرأة السورية لدى الكثير من العائلات أمراً لا مفر منه، فتلك الضغوطات لم تجبر على قبول زيادة نشاط المرأة الاقتصادي، بل وضلوعها في أعمال كان حضورها فيها شبه معدوم مثل العمل في قطاع المطاعم والفنادق.. إلا أنّ هذا التحوّل في دور المرأة نابع عن ضرورات معيشة، وليس ناتج عن حركة اجتماعية مدنية، أو مدعوم بتوّجه من السلطة، كما أنه لم يتأتى عنه مكاسب اجتماعية أو قانونية. لذلك فإنّ هذا التحول بحاجة إلى وقت ليتحوّل إلى مكسب اجتماعي ويحدث تغييراً في العقلية المناهضة لعمل المرأة. بخلاف ذلك، فإنّ هذا التحوّل قد يتعرّض لارتداد ما لم يُشتغل عليه في الجانب الثقافي الشعبي.
كان لانخفاض مشاركة المرأة في العمل أثر "اليد الخفية" في زيادة النمو السكاني بصورة مطردة، فكلما انخفض معدل مشاركة المرأة في العمل خارج المنزل زاد ميلها إلى إنجاب المزيد من الأطفال. وعلى الرغم من أنّ معدل النمو السكاني لسوريا كان قد أخذ بالارتفاع منذ استقلال (شأنها شأن معظم الدول حديثة الاستقلال) مع انخفاض معدل الوفيات وتحسّن مستويات الطبابة..إلخ، إلا أنّ معدل النمو السكاني في سوريا قد أخذ بالارتفاع بمعدلات أعلى منذ العام 1970 حتى عام 1984، حيث كانت معدلات النمو السكاني تتراوح بين 3.44% و3.64%، لكنها بدأت تتراجع منذ العام 1985، فلم تعد تتجاوز الـ3% باستثناء فترة (2006-2008)، بل وهبطت ما دون الـ2% في عامي 2002 و2003[10]، إلا أنّ معدلات النمو السكاني الكبيرة خلال السبعينيات والثمانينيات تسبّبت بظاهرة "بروز الشباب" (Youth bulge)، حيث بلغت نسبة السكان بين 15 و64 عاماً نحو 60% من إجمالي السكان[11]، وهذا كان يعني المزيد من الباحثين أو العاطلين عن العمل. وهنا لا نقول إنّ معدل النمو السكاني بحدّ ذاته أمر مضرٌ بالاقتصاد، لكن النمو السكاني في اقتصاد متخلف قائم على الريع السياسي والاقتصادي، يعني نقص في إمكانية توفير الموارد والوظائف الكافية لتحقيق معدلات تشغيل معقولة.
سياسات التوظيف وعودت انتماءات ما قبل الدولة الوطنية
أدى التغيير الهيكلي في الاقتصاد السوري، ونمو تخلفه، من بين أسباب أخرى، إلى عودة بروز ولاءات ما قبل الدولة الوطنية، فمع تراجع دور مؤسسات الدولة بما تشكله من صيغة جامعة للسوريين من مختلف الانتماءات في عملية التوظيف، بعد أن فقد النظام القدرة على الاستمرار في صيغة توزيع المنافع الاجتماعية مقابل عدم المشاركة السياسية (العقد الاجتماعي الاستبدادي)، حدث تحوّل في معيار التوظيف من صيغة الولاء (الانتساب) للبعث إلى معايير أخرى، بحيث بات يصعب على أي فرد أن يصبح موظفاً في القطاع العام إلا بتوّفر إحدى تلك المعايير فيه، وهي: المعيار الطائفي (العلوية)، سيما في مؤسستي الجيش والأمن، حيث تشير التقديرات بأنّ نحو 85% من القوى العاملة من الطائفة العلوية تعمل في الوظائف الحكومية، وإن كانت النسبة تبدو مبالغاً بها إلا أنّ الوجود الكثيف لأبناء الطائفة العلوية في الوظائف العامة بصورة لا تعكس نسبتهم في المجتمع السوري (تقدّر بنحو 10 الى 15 بالمئة من إجمالي السكان) لا يمكن تفسيره إلا في هذا السياق، أي التمييز في عملية التوظيف. لكن أيضا يجب أن لا يُفهم من ذلك، بأنّ الحكم في سوريا كان حكما طائفياً (علوياً) فلم يكن وصول البعث إلى السلطة وصعود الأسد الأب لاحقاً، وتوريث الحكم لابنه إلا بدعم من "مراكز قوى" تنتمي لمختلف الجماعات في سوريا بفئاتهم المتنوعة (عسكر، تجار، عشائر، جماعات دينية..). كما لم يكن اتكاء الأسد على الطائفة العلوية نابعاً عن ممارسة عقائدية، فلم تعرف سوريا بروز طقوس عقائدية علوية في الفضاء العام كما لم تعرف "تبشيراً علوياً"، بل إنّ حافظ الأسد أبدى معارضةً لسياسة التشيّع، سواء ذلك الذي سعى إليه شقيقه جميل الأسد عن طريق جمعيات مرتضى، التي انتهى بها المطاف بالإغلاق بقرار من الأسد، أو التشييع الذي حاولت من خلاله إيران اختراق المجتمع السوري. بل يمكن القول إنّ اتكاء الأسد على الطائفة العلوية هو أقرب للاستناد العشائري، دفع الأسد ثمنه "رشاوي" اجتماعية تمثلت في التمييز في الوظائف والمناصب العليا. وإن كانت تلك الامتيازات لم تخرج أكثر العلويين من دوائر الفقر النسبي والمدقع، بل كانت ورطة تاريخية دفعوا ثمنها غالياً.
أما المعيار الثاني، فهو الانتماء أو القرب من شخصيات متنفذة في السلطة، وأبرز مثال على ذلك هو العماد مصطفى طلاس (وزير الدفاع بين عامي 1972- 2004)، فبوصفه فرداً من أفراد الحلقة الضيقة المقربة من الأسد الأب، استطاع نحو 3000 فرد من مدينة الرستن (مسقط رأس مصطفى طلاس) من الوصول إلى الجيش بصفة صف ضباط وضباط، على الرغم من أنّ تعداد سكان مدينة الرستن لا يتجاوز 87 ألف نسمة. وأخيراً الرشوة، التي بإمكانها إيصال أيّ شخص لأي منصب وظيفي تقريباً. وبذلك لا تكون سياسة التوظيف فقدت معيار الكفاءة في التعيين فقط، بل فقدت أيضا صيغتها السياسية (الانتماء للبعث) الذي كان متاحاَ لجميع السوريين أيّاً كان انتمائهم.
انسحبت تحوّلات معيار التوظيف، على القطاع الخاص أيضاً، فمع انحسار أهمية الكفاءة المهنية والشهادات العلمية (كما بيّنا سابقاً) وغياب سيادة القانون، باتت حاجة ربّ العمل لوجود موظفين/موظفات يأتمن لهم على أمواله، فأصبح معيار التوظيف قائماً على أساس الولاء للجماعة، باختلاف صورها، سواء أكانت الجماعة عائلة أو طائفة أو جماعة دينية (الحركات الصوفية) أو انتماءات قروية... يظهر ذلك بوضوح في إعلانات التوظيف التي كانت تجري بصورة شكلية في حين أنّ التوظيف يجري بالوساطة. بالمقابل أصبح اللا منتمون لجماعة؛ عائلة كبيرة أو المقربون من أفراد، متنفذين بالجماعة التي ينتمي إليها عمودياً (بالولادة) خارج سوق العمل، لا بحكم انعدام كفاءتهم بل بحكم عدم انتمائهم أو عدم انتمائهم الكافي للحصول على مكاسب، إن جاز القول.
بذلك انقسم المجتمع بين مستفيدين من النظام الاقتصادي الاجتماعي السائد بصيغته السياسية، وبين مبعدين بفعل وجوده، وإن كان هذا المعيار لا يرسم لوحده الحدّ الفاصل بين معارضي ومؤيدي النظام في لحظة الانفجار عام 2011. فمرّة أخرى، يضعنا تعقّد الظاهرة في مكان لا يسمح بتفسيرات سببية أحادية، فالبطالة، التي نأخذها هنا كمؤشر على حالة الإقصاء، كانت متفشية بمعدلات أعلى في محافظتي اللاذقية وطرطوس (اللتين توصفا بمعقل حاضنة النظام)، فوفقاً لنتائج المسح الإحصائي لعام 2004، فإنّ معدل البطالة في اللاذقية، بلغ أكثر من 24%، ووصل في طرطوس إلى نحو 21%، وهي أعلى نسبتا بطالة مقارنةً بباقي المحافظات (باستثناء الحسكة 26.5%).
من أزمة البطالة إلى أزمة الأجور
منذ منتصف الثمانينيات وزيادة الأجور محدودة التأثير في تحسين مستوى المعيشة، بل وفي الكثير من الأحيان في التخفيف من حدّة التضخم، فكانت الزيادات في الأجور لا تأتي عبر إعادة توزيع للدخل (فرض ضرائب مباشرة على أصحاب الدخول الأعلى) أو نتيجة للتوّسع في النشاط الاقتصادي، بل كانت تأتي عن طريق تخفيض دعم مشتقات الطاقة وسلع أخرى، وزيادة الضرائب غير المباشرة، بحيث تحمل الزيادة في أسعار الطاقة وغيرها من المواد على المستهلك النهائي، لتلتهم مفاعيل الزيادة في الأجور، وليصبح بين يديّ الموظفين المزيد من الأوراق النقدية بقوة شرائية قريبة مما كانت عليه قبل رفع الأجور. حدث ذلك بصورة متكرّرة في عام 1993 على إثر الزيادة في الأجور عام 1991، وفي عام 1995 بعد زيادة أقرّت في العام نفسه[12]. وتكرّر الأمر في العقد الأول من الألفية، لكن بدرجة تأثير أقل، حيث سعى النظام إلى إحداث تغيير في سياسة التوظيف في القطاع العام، فمقابل الضعف الشديد في مسابقات التوظيف، أخذ متوسط أجر العاملين/العاملات في القطاع العام بالزيادة، حيث ارتفع من 4923 ل.س في عام 2001 إلى نحو 9931 ل.س في عام 2007، ووصل في إلى 17044 ل.س في عام 2011، أي أنّ متوسط الأجور في القطاع العام، ارتفعت بنسبة 246%، وفي الوقت الذي كان فيه الفرق بين متوّسط الأجور بين القطاع العام والخاص في عام 2001 متقارب للغاية (أعلى بنسبة 2% في القطاع العام)، فإنّ الفرق بين متوسط الأجور في القطاع العام والقطاع الخاص بات يميل بصورة أكبر لصالح القطاع العام، فوصل الفرق بينهما في عام 2008 إلى نحو 33%، وفي عام 2011 وصل لأكثر من 51%.
شكلت الزيادة في متوّسط الأجور في القطاع العام عامل ضغط لرفعه في القطاع الخاص، فمع كلّ ارتفاع للأجور في القطاع العام، كان يحدث أن ترتفع الأجور في القطاع الخاص، ومن جهة أخرى، كانت الأجور حتى عام 2011، تلبي الاحتياجات الأساسية على أقل تقدير، أي لم تكن المشكلة الرئيسية في مستويات الأجور، بل في مستويات البطالة المرتفعة.
ليل القيامة الطويل
27 كانون الثاني 2021
مع موجات التدهور الاقتصادي في سوريا منذ العام 2011، تحوّلت المشكلة الاقتصادية الاجتماعية للعاملين بأجر في سوريا من بطالة إلى الأجر نفسه، إذ لا يمكن حصر المشكلة المعيشة التي يعيشها السوريين اليوم بالبطالة، بل ولا يمكن اعتبارها السبب الرئيسي، فمستوى تدني الأجور وصل إلى مرحلة تكاد يتساوى فيها العمل من عدمه، فحتى لو وصل الاقتصاد السوري إلى مستوى التشغيل الكامل (بافتراض ثبات العوامل الأخرى)، فإنّ الحدّ الأدنى للأجور البالغ نحو 92 ألف ل.س الذي حدّده النظام في عام 2021، لا يمكن بحال من الأحوال أن يلبي الاحتياجات الأساسية لأي أسرة، حتى لو كان جميع أفرادها يعملون. أي نحو 15.5 دولار أميركي (على أساس سعر صرف 6000 ل.س مقابل الدولار الواحد) وهو أجر لا يمكن أن يخرج شخصا واحدا من تحت خط الفقر المدقع (2.15 دولار أميركي في اليوم). هذا المستوى المتدني من الأجور، يثير سؤالاً عن جدوى العمل نفسه: أي لماذا يعمل السوريين إذا ما كان الأجر بهذا المستوى المتدني؟ فالحاجة الماسة لأي مبلغ لا تبرّر ذلك أيضاً، فالعمل يتطلب استهلاك المزيد من الثياب والطعام إلى جانب تكلفة المواصلات، وهذه التكاليف مجتمعة حكماً تفوق أجر العمل نفسه!
العمل بالإكراه أو العبودية الحديثة
أمام واقع الأجور الهزيلة في القطاع العام، باتت أعداد الراغبين في الاستقالة من العمل تزداد باطراد، إلا أنّ المتقدمين للاستقالة يصطدمون بعدم قبول طلبات استقالتهم، بحجة حاجة المؤسسات التي يعملون بها لخدماتهم، إذ ذاك لا يبقى مجال للعاملين في القطاع العام سوى الاستمرار في العمل رغماً عنهم، ففي حال التغيّب عن العمل لأكثر من 15 يوماً بدون مبرّر، فإنّ العامل/العاملة سيصبح بحكم المستقيل، لكنها استقالة غير مجانية، حيث سيتعرض لعقوبة السجن لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات، بالإضافة لغرامة مالية. وبذاك ينطبق على العاملين في القطاع العام، على الأقل الراغبين في الاستقالة منهم، وصف العمل بالإكراه، فهم يعملون رغماً عن إرادتهم تحت تهديد السجن.
لكن إذا كان العاملين/العاملات في القطاع العام مجبرين على العمل تحت تهديد السجن، فما الذي يدفع للعمل في القطاع الخاص؟ وذلك على الرغم من أنّ الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يمكن تقديره بأنه يتراوح ما بين 150 ألف ل.س و200 ألف ل.س (بحسب المحافظة)، أي هو تقريباً بحدّه الأدنى أعلى أو يساوي الحد الأعلى للأجور في القطاع العام، إلا أنه ما زال متدنياً للغاية، وغير كافي لتلبية الاحتياجات الأساسية للفرد، ناهيك عن إعالة هذا الشخص لفرد أو أكثر من أفراد أسرته/ا. بل يمكن لنا أن نذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، بالقول إنّ متوسط الأجور في سوريا اليوم يقل عن التكلفة (الأجر) التي كان يدفعها السيد للمستعبد، وهذا ليس تعبيراً مجازياً، ففي زمن العبودية كانت تكلفة أجر العبد سليم البنية، هي تكلفة بقاءه على قيد الحياة وضمان قدرته على ممارسة أدواره، وما يعنيه ذلك من تأمين مسكن وطعام وشراب وطبابة وكساء، كلّ ذلك كان يتكفل به سيده، وهذا ليس من طيب خاطره، فإنّ التقطير في دفع تكاليف المستعبد من غذاء وكساء أو حتى الامتناع عن إراحته، سيعني تراجعاً في أداءه، أي خسارة لسيده، خسارة في تراجع إنتاجيته، وخسارة محتملة في حال أنهى المرض حياته. إذن لماذا يعمل السوريين؟
في الحقيقة، الهدف من العمل في سوريا ليس تلبية الاحتياجات الأساسية للفرد أو للفرد ومن يعيله، بل هي تتمة لمجموعة من الدخول، التي تشمل إجمالي دخول أفراد الأسرة المقيمين تحت سقف واحد، والمساعدات العينية أو المالية التي تقدمها الجمعيات الخيرية والدولية ومنظمات الأمم المتحدة، و/أو مساعدات الأقارب والمتبرعين الأفراد والجمعيات الأهلية في الخارج. والأساس في دخل السوريين اليوم من العاملين ليس أجورهم، بل ما يتلقونه من المصدرين الآخرين، أي مساعدات الجمعيات والمؤسسات الخيرية والتنموية، وتحويلات السوريين في الخارج، وإن كانت لم تلب حتى المتطلبات الدنيا في معظم الحالات.
وإن كان العمل في القطاع الخاص اختياراً، فإنّ ذلك لا يعفيه من تهمة ممارسة أقصى درجات الاستغلال لليد العاملة السورية، مستفيداً من الغياب التام لدور النقابات، وقيود الاحتجاج ضده وغياب القانون، الذي يعمل لصالح الأقوى.
على الرغم من ذلك، فإنّ مسؤولية استغلال العاملين في سوريا تقع على النظام أولاً وأخيراً، فهو باحتكاره لاستيراد السلع يجعل من أسعارها مضاعفة، وهو ما يمكن أن نلاحظه في فرق الأسعار بين مناطق قوى الأمر الواقع شمالي سوريا، وبين مناطق سيطرة النظام. كما لم يعد يكفيه جباية "الخوات" من الشاحنات الناقلة للبضائع، بل بات أيضا يداهم المحال التجارية والمصانع، فارضاً على أصحابها مبالغ يحدّدها وفق تقديراته. تشكل الأجور الهزيلة في القطاع العام وإعاقة النشاط الاقتصادي عبر فرض "الخوات" عاملي ضغط كبيرين يمنعا زيادة الأجور في القطاع الخاص.
سوريا ودروس الربيع العربي
إنّ صيرورة الانهيار الاقتصادي الاجتماعي في سوريا، تكاد تكون متطابقة مع نظرائها في الدول العربية في نموذج متماثل هو نموذج رأسمالية المحاسيب المرتكزة على الريع السياسي والاقتصادي، إذ لم يكن مصادفة أنّ الانتفاضات الشعبية جاءت متزامنة فيما بينها مشكلة لوحة الربيع العربي.
كان الربيع العربي بموجتيه الأولى والثانية استباقاً لواقعاً يسير نحو تدهور أوسع، هو ما نعيشه اليوم، كان نبوءة الشعوب بيقين قادم، استبقته، فخلعت شخوص النظام أو بعضها، إلا أنه، أي النظام، عاد مموّها بشخوص جديدة.
يظهر جوهر النظام بنموذجه الاقتصادي، إذ لا تجتمع الديمقراطية ورأسمالية المحاسيب والريع، بنظام واحد، فضمان حكم الاستبداد هو الهيمنة على الاقتصاد، وإن كان حكم الاستبداد في سوريا موّحدا بنظام الأسد، فإنه اليوم بثلاث هيئات؛ الأسد، وقوتي أمر الواقع غربي وشرقي نهر الفرات. هناك حيث تظهر القوتين الجديدتين بمظهر أقل خشونة واستبداد، بانتظار أن يستتب لها الحكم، لتعيد عقارب الزمن إلى الوراء، إذ ذاك تتجلّى مهام الموجة التالية للربيع العربي، هي مهمة تغيير النظام لا شخوصه، والتي باتت تتكشف أكثر من أي وقت مضى في مصر وتونس والسودان، وإن كانت الخصوصية السورية بما هي بلد تعزّزت فيه انتماءات ما قبل الدولة كأداة للحرب، فإنّ قوى الأمر الواقع في الشمال السوري أظهرت إمكانية عودة النظام بشخوص جديدة.