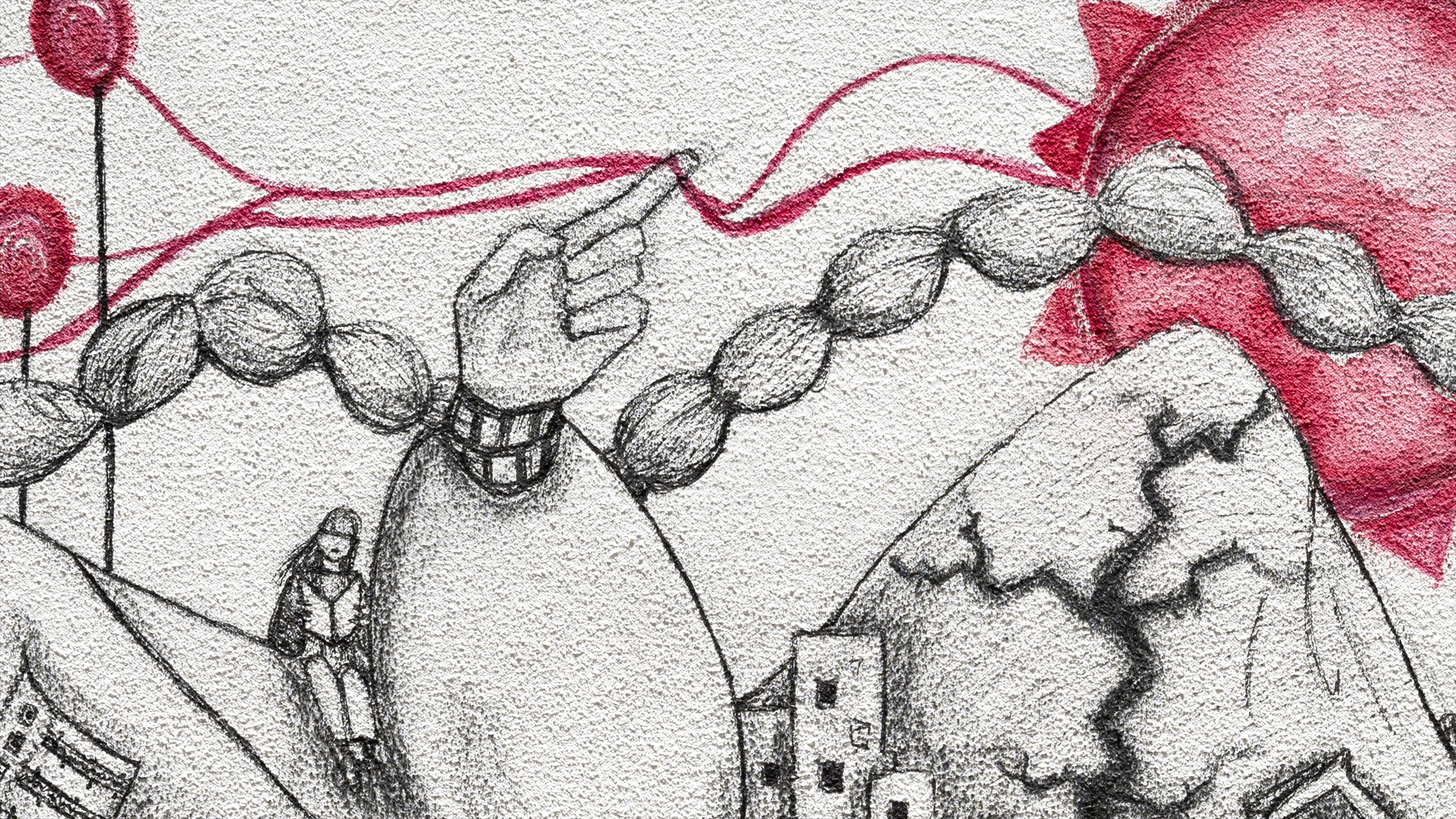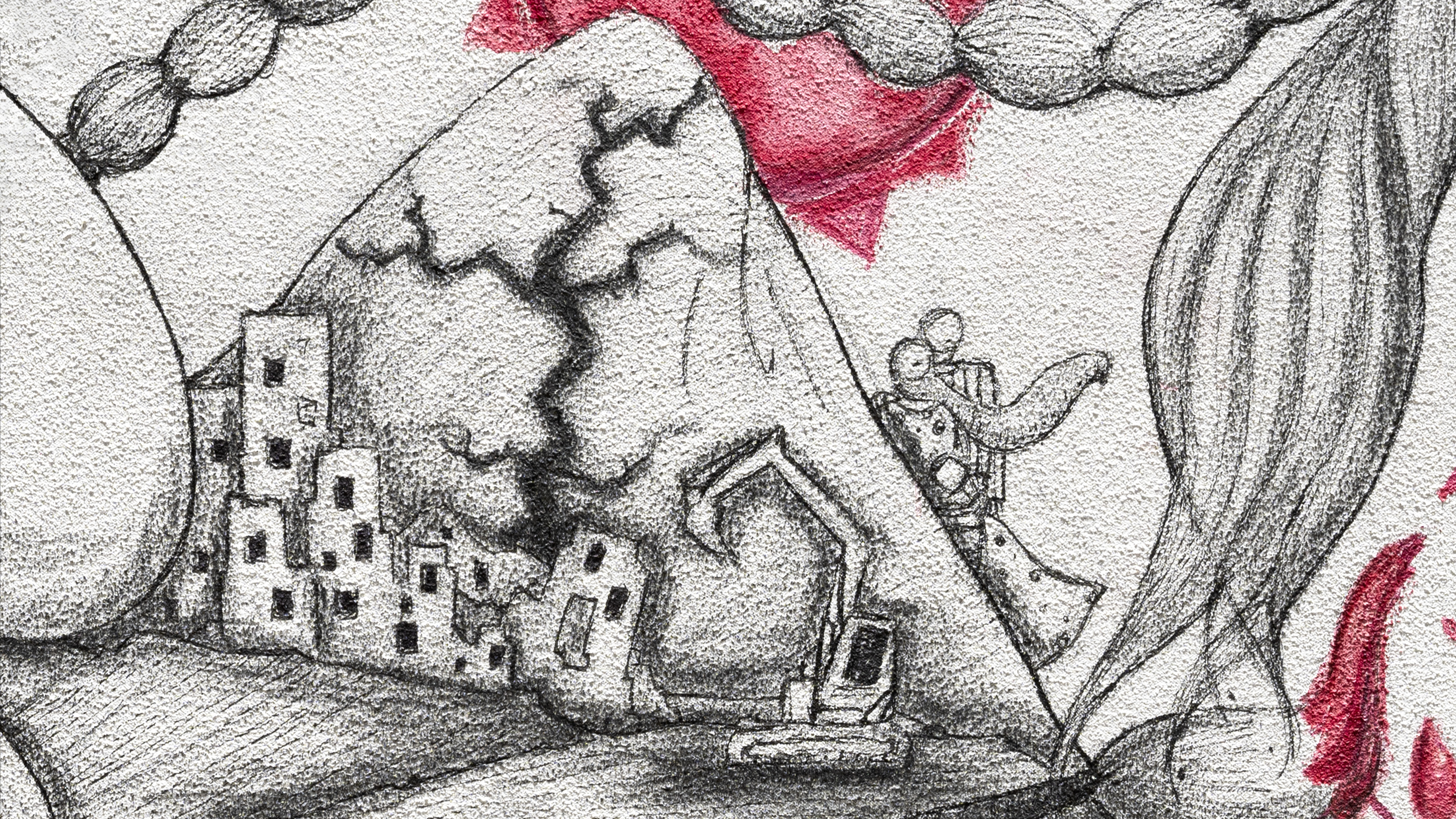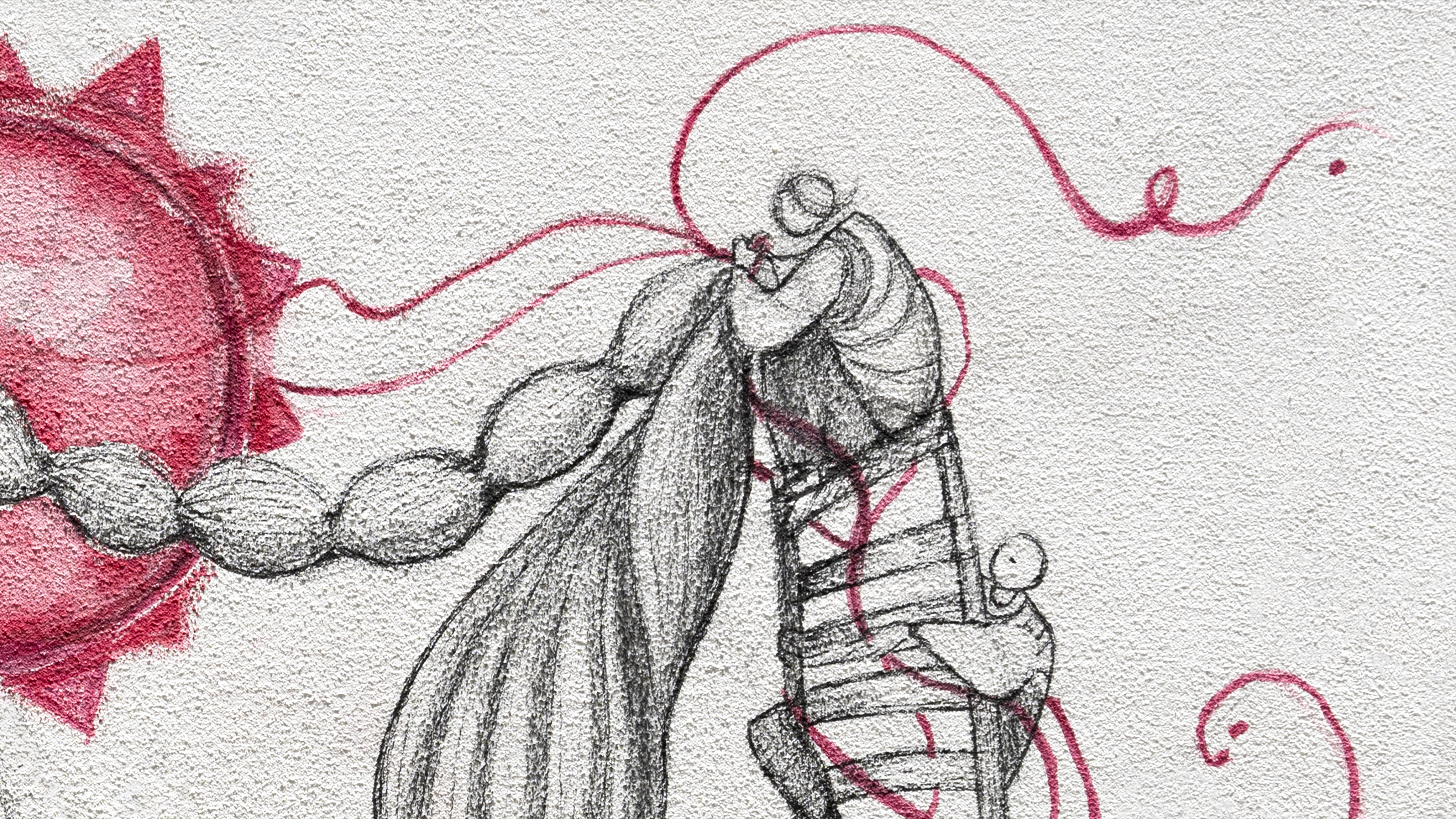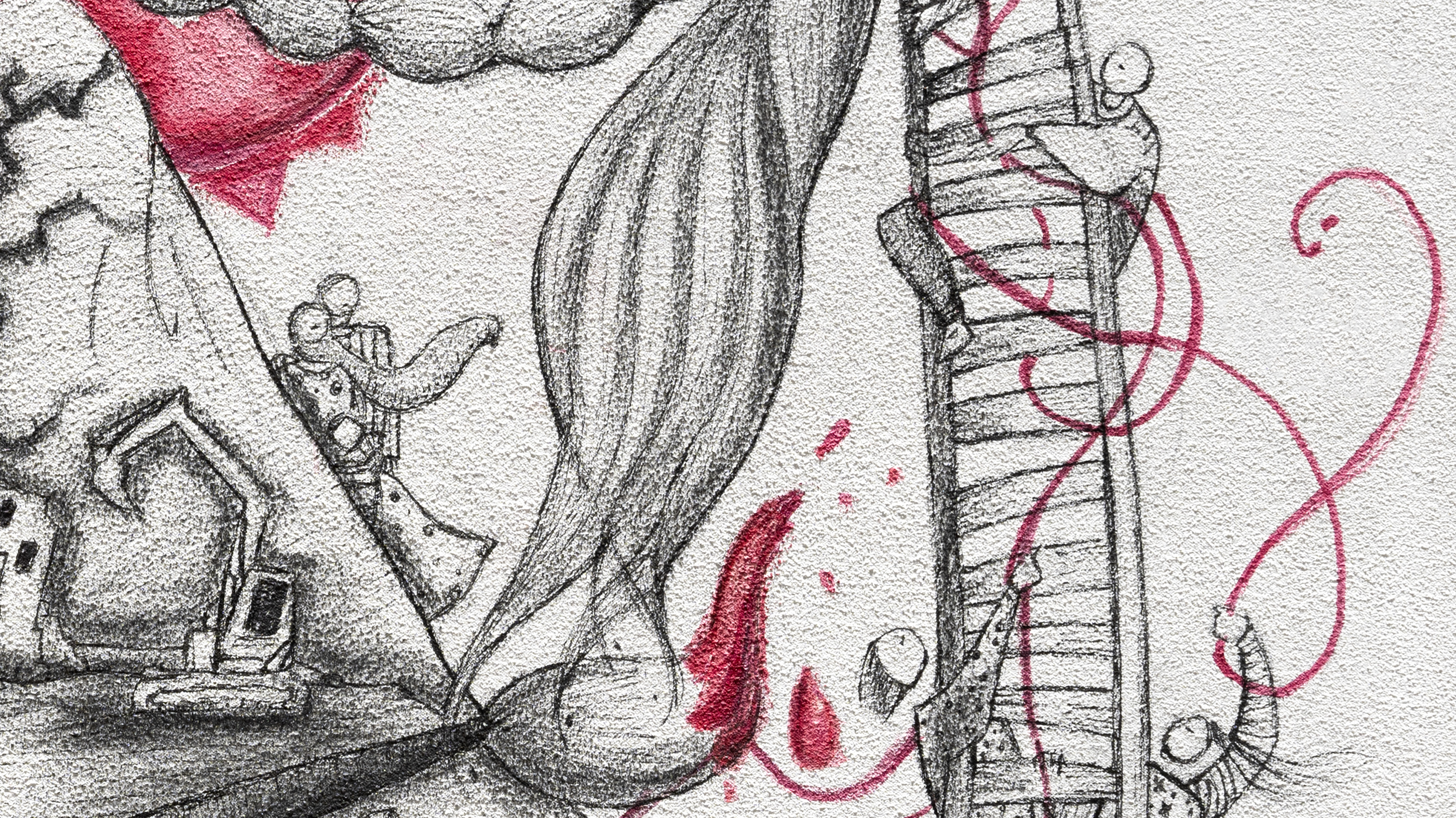(هذا المقال جزء من ملف بالشراكة بين "حكاية ما انحكت" و"أوريان ٢١"، يستكشف عواقب الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا في شباط ٢٠٢٣).
حين وصلنا، نحن مجموعة من الناشطين المجتمعيين، غداة زلزال السادس من شباط ٢٠٢٣ في سوريا وتركيا، إلى بلدة "الشلفاطية" الواقعة شمال اللاذقية بعدّة كيلومترات، تدافع أكثر من ثلاثين شخصاً للقائنا والطلب منّا تقديم مساعدة طارئة لهم، وغالبيتهم ممن تضرّرت بيوتهم بسبب الزلزال ولم تعد صالحة للسكن.
إلى هنا كان الأمر "طبيعياً" نظراً للطيف الواسع من الأضرار التي تسبّب بها الزلزال على مدى الساحل السوري والمناطق الأخرى. إلا أنّ ما لم يكن طبيعياً هو أنّ هذه البلدة هي مسقط رأس رجل الأعمال السوري المعروف، أيمن جابر، صاحب العديد من المنشآت والشركات ومنها معمل "آدكو" لدرفلة الحديد ورئيس إحدى الجمعيات الخيرية.
ووفقاً لأحاديث أهل البلدة والبلدات المجاورة، فإنّ البلدة لم "تر أيّة مساعدات من الجابر حتى بعد مرور أكثر من أسبوعين على حدث الزلزال". يقول الشاب، أحمد حسن، (اسم مستعار، من البلدة، طالب جامعي شارك معنا في عمليات الإغاثة): "لم يقترب الجابر (هو رئيس فخري لجمعية الوفاء للوطن التي تعنى بجرحى الحرب ولكنها غير نشطة منذ سنوات طويلة) ولا موظفيه من البلدة لا قبل الكارثة ولا خلالها، وعبر تاريخه لم يقدّم حسب ما يعرف أهل البلدة أيّة مساعدات تنموية أو إغاثية، فيما بقي قصر الجابر المُقام في طرف البلدة سليماً ولم يتعرّض للأذى".
قياساً بنسبة الأضرار في البلدة المذكورة، وهي أضرار تضمنت تهدّماً لعدد قليل من المنازل وتشقّقات لعدد آخر وعدد من حالات الإخلاء، يمكن لرجل الأعمال أيمن الجابر، التكفّل بها بشكل كامل دون أن يؤثر ذلك على ثروته. بل بالعكس، إنّ قيامه بإصلاح أضرار الزلزال ومساعدته أهالي بلدته، كما يفعل بعض رجال الأعمال في العالم، سوف تضيف له قيمة اجتماعية وثقافية وتنافسية في مجال الدور الاجتماعي لرأس المال المحلي، بغض النظر اﻵن عن مصادر ثروة الجابر وطرق جنيها.
ملاحظة عدم اقتراب الجابر من الأهالي أثناء الكارثة في بلدته "الشلفاطية"، تكرّرت في مناطق أخرى لبلدات وقرى ينتمي إليها شخصيات وازنة اقتصادياً واجتماعياً لم تتقدّم بأيّة مبادرات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في المجتمعات المحلية على امتداد الساحل السوري الذي لا زال حتى اللحظة أحد أهم المفاصل التي يعتمد عليها النظام السوري في ترسيخ حكمه وإدامة سيطرته على البلاد، خلافاً لمناطق أخرى، مدينةً وريفاً في سوريا. وإذ نتحدث هنا عن الشخصيات العامة، فإننا نتجاهل عن قصد دور الجمعيات والمؤسسات المدنية ﻷنها بغالبيتها ليست من البيئة الساحلية، مثل جمعية العرين والأمانة السورية للتنمية وغيرها.
في كلّ مجتمع هناك قوى مؤثرة لديها القدرة الكاريزمية على القيادة والتأثير على المجتمع وبشكل قوي ومؤثر، وهو ما بات معروفاً تحت اسم "الفواعل المجتمعية".
هذه الحالات تستوقف فعلياً وتدفع للسؤال عن الأسباب الكامنة وراء قطيعة هؤلاء الأفراد مع مجتمعاتهم التي لا تمتلك، أصلاً، الحدّ الأدنى من عناصر الأمان أو الكفاية المجتمعية الاقتصادية أو غيرها في الحالات الطبيعية فكيف في حالات الطوارئ؟ وإضافة إلى هذه القطيعة، فإنّ أسئلة أخرى تُطرح حول ظهور فواعل مجتمعية أخرى كردّ فعل على هذا التجاهل، سواء من الأفراد أو من الدولة ذاتها، فواعل قامت في الأشهر التالية من حدث الزلزال بلعب دور إيجابي في إغلاق هذه الثغرات وتجاوز الحاجة إلى هؤلاء الأفراد.
من هم الفاعلون المجتمعيون؟
في كلّ مجتمع هناك قوى مؤثرة لديها القدرة الكاريزمية على القيادة والتأثير على المجتمع وبشكل قوي ومؤثر، وهو ما بات معروفاً تحت اسم "الفواعل المجتمعية"، ويمكن مقاربة مفهوم الفواعل الاجتماعية انطلاقاً من أنه "أوسع من المؤسسات"، كما يقول مدير قسم الأبحاث في "حركة البناء الوطني" بدمشق الباحث، سامر ضاحي، وهو من أبناء محافظة طرطوس، "ويشمل (المفهوم) القوى والشخصيات والكيانات المؤثرة في مجتمع معيّن، لكلّ منها جمهور تعبّر عنه، وقادرة على تحويل هذا التعبير إلى فعل يحظى بقبول جمهورها أو تأييده، ولها مصالحها ومواردها وهويتها وعلاقاتها الداخلية التي تتميّز بها عن بقية الفواعل".
التضامن ما زال حيّاً بين السوريين...
04 آب 2023
تمتد شرائح هذه الفواعل من أبسط قدرات التأثير وأكثرها تقليديةً مثل رجال الدين، إلى أعلى مستويات السلم الاجتماعي، مثل رجال الأعمال، وعبر تاريخ سوريا وغيرها من الدول، كما يقول ضاحي: "حضر الفاعلون المجتمعيون اقتصادياً واجتماعياً في مجتمعات المدن والريف، وكان حضورهم يدعم دور الدولة ولا يهدف لتنحيتها، رغم أنه في أماكن معينة لعب هؤلاء دوراً في تبرير سياسات الحكومة المركزية، بالمقابل خلّدت المجتمعات المحلية هذه الأعمال، وفي حالات أخرى دعمت الفاعلين في طموحاتهم السياسية، وبعد أن ضعف دور الدولة في تنمية المجتمعات المحلية بشكل عالمي زادت فرص حضور الفاعلين المجتمعيين مدفوعين بتقدم الهويات الفرعية (المناطقية والطائفية على حساب الوطنية)، وتراجع الموارد".
في سوريا ما بعد العام ٢٠١١ زادت الحاجة إلى الفاعلين المجتمعيين للقيام بالعديد من الأعمال في المجتمعات المحلية نظراً لغياب الدولة وتقليصها لخدماتها العامة، ويشير الأستاذ الجامعي في المعهد العالي للتنمية اﻹدارية الدكتور، أيهم أسد، وذلك في محاضرة سابقة له في دمشق خلال شهر أيلول من العام الماضي أثناء تدريب حول القانون رقم ١٠٧ الخاص بالإدارة المحلية، إلى أنّ "تقليص ميزانيات المدن والبلدات والبلديات عزّز الحاجة لحضور أطراف أخرى في عملية التنمية المحلية منتمية إلى المجتمع نفسه باعتبارها تدرك حاجاته وما يمتلك وما يحتاج أكثر من غيرها".
يُعتبر هؤلاء الأفراد من رأس المال المجتمعي، ويتسع طيفهم من الناشطين الشباب والشابات وصولاً إلى أصحاب الرأي. ولكن يبقى لرجال الأعمال وأصحاب الثروات أهمية مضاعفة نظراً للحاجة إليهم من أجل تلبية بعض متطلبات البيئة المحلية، وخاصة في حالات الطوارئ مثل الزلازل والنكبات.
"هنا يختلف دور الفاعلين عن دور المجتمع المدني بأنّ للمجتمع المدني مؤسسات وجمعيات وأطر تنظيمية محدّدة، في حين أنّ الفواعل الاجتماعية بنت المجتمع وظروفه وعلاقاته البينية الاجتماعية، ومع ضعف حضور المجتمع المدني في الساحل السوري وجباله ضمن منظومة الحكومة مثل جمعية العرين، أو خارجها، تزيد الحاجة للفواعل المجتمعيين وتعزيز أدوارهم" كما يقول رئيس بلدية في ريف بانياس المهندس محمد عيسى لسورية ما انحكت.
وضع الفاعلين المجتمعيين في الساحل السوري
في مدينة حلب السورية، إثر كارثة زلزال، ووفقاً للعديد من الناشطين هناك، فإنّ "حلب قامت بنفسها"، ويقصد بهذا كما يقول الناشط المجتمعي الحلبي، أنطون بصمجي، إنّ "المدينة ككل لم تنتظر مساعدات الدولة، ومنذ اللحظات الأولى للكارثة، بادرت لوضع كلّ ما تملكه وتقدر على تأمينه للناس المحتاجين وبشكل مباشر عبر الجمعيات والشخصيات والهيئات الاجتماعية المؤثرة مثل الأفراد وغرف التجارة والصناعة والزراعة ومنظمات المجتمع المدني نفسها، وشملت الاستجابة الأولى تأمين الحد الأدنى من الحاجيات الضرورية من المياه إلى اللباس والكساء والمنامة وغيرها. ومن الطبيعي في ظلّ تزايد أعداد المتضررين أن لا يتمكن المجتمع من إغاثة كلّ أفراده ولكن بالحدود الدنيا كانت هناك تغطية للحاجات اليومية. وعند معرفة وظهور حالات جديدة كان المجتمع المحلي يشير إليها، أي كان هناك تحرّك مباشر من قبل الأفراد الفاعلين أو الجمعيات أو غيرهم".
هذه الاستجابة لم تحدث في الساحل السوري بهذا الشكل في وقت الزلزال، إذ شهد الأسبوع الأول من الحدث تخبطاً واضحاً في إدارة الاستجابة. تشير الناشطة المجتمعية، غراسيا أحمد (من إحدى المجموعات التي تشكلت بعد الزلزال) إلى أنه "كثيراً ما تصادمت جهود المجتمع المحلي مع بعضها بعضاً، حيث تمّت تغذية بعض مراكز الإيواء عدّة مرات في حين بقي بعض مراكز اﻹيواء دون إغاثة لأسبوع كامل، كما حدث في منطقة الرمل الجنوبي (اللاذقية). وفي ريف الساحل، شهدنا تأخراً عامّاً في إغاثة المنكوبين وعمليات اﻹنقاذ كما حدث في بلدة "اسطامو" التي كانت آخر المواقع التي جرت فيها عمليات الإنقاذ". ووسط كلّ هذا كان الفاعلين المجتمعيين من رجال الأعمال المعروفين في الساحل متفرجين على الكارثة.
في الأسبوع الثاني من الكارثة كان هناك خمسين حالة إخلاء لمنازل في بلدة القرداحة (وهي البلدة التي تعود إليها جذور بشار الأسد)، لم يتم تقديم أيّة خدمات لهم من قبل رجال الأعمال أو النافذين في تلك البلدة، ولعل المفارقة أنّ الوحيد من بين هؤلاء ممن تحرّك لتقديم العون هو أحد أمراء الحرب (نتحفّظ عن ذكر اسمه) وقد قدّم وجبات غذائية ومواد إغاثية طبية. وفوق ذلك ارتفعت قيمة الإيجارات أكثر من ضعفين، واختفت البيوت المعروضة للإيجار أيضاً في وقت كان السوق العقاري يعاني من تخمة قبل الزلزال.
في مدينة جبلة المجاورة لم يكن الأمر أفضل، إذ شهدت المدينة والريف تجاهلاً عاماً من قبل رجال الأعمال والنافذين في انتظار تحرّك الدولة ومؤسساتها الخدمية والإغاثية.
وعلى عكس نظيرتها في مدينة حلب، اكتفت غرفة تجارة وصناعة اللاذقية بفتح حساب بنكي للتبرّع لمتضرّري الزلزال (ولم يكتبوا لاحقاً على صفحتهم الرسمية أنهم تلقوا أيّ تبرع)، ولم تسيّر أيّة قوافل إغاثية كما فعلت غالبية الجمعيات أو الأفراد، كما أنها لم تتدخل في سياق أي نشاط يخصّ الكارثة ولو بملصق إعلاني، والأدهى من ذلك أنها (وفقاً لتاجر من اللاذقية)، فرضت رسماً قيمته مليون ليرة سورية على كلّ طلب تجديد أو شهادة سجل تجاري جديد ﻹجبار هؤلاء على التبرع لضحايا الزلزال.
بالمقارنة بين غرفة تجارة اللاذقية وغرفة تجارة وصناعة حلب، فإنّ الأخيرة قامت بكفالة كلّ الذين سقطت بيوتهم، وقدّمت لهم مبلغ مليوني ليرة سورية (حوالي ألفي دولار حينها) لدفع إيجارات سكنية لمدة عام واحد، ولم تكتف الغرفة الحلبية بذلك بل كانت شريكاً حاضراً في غرفة عمليات الإغاثة.
في حين أنّ من قام بالتعاون ﻷجل استئجار الشقق في اللاذقية ليس غرفة التجارة والصناعة بل أحد المغتربين السوريين (وهو رجل الأعمال غسان جديد، المقيم في أوروبا ويعمل في قطاع البناء)، حيث تم استئجار ما يقارب مئتي شقة سكنية.
حتى الوقت الراهن، ورغم كمية هائلة من المساعدات (من أكثر من ثلاثين دولة بآلاف الأطنان) والمنازل الجاهزة (وصل عددها إلى قرابة الألف ويجري تجهيز مواقع لوضعها في جبلة واللاذقية)، فإنّ هناك عائلات في المناطق الساحلية لم تتلق تعويضات لمنازلها المهدمة، ولم تقدّم بدائل سكن لها، وهو ما أشارت إليه سيدة من منطقة الرميلة في طرف جبلة أشارت إلى "وجود احتجاجات كثيرة على قوائم المتضررين من الزلازل التي صدرت قائمتها الثانية هذا الشهر (أيلول)"، كما لم تُقدّم بدلات إيجار للعائلات التي تركت بيوتها بعد الكشف الفني الثاني عليها (تمّ الكشف مرتين على البيوت) من لجان مختصة.
بالطبع قد يكون هناك حالات تحرّك فيها فاعل مجتمعي في مكان ما ضمن أماكن الضرر من الزلزال، ولكن ما تمكنا من توثيقهم هم من خارج مناطق الضرر من الزلزال، أبرزهم صاحب مدرسة الفينيق الخاصة في طرطوس، المهندس صالح محمد، الذي تحرّك منذ اليوم الأول من الحدث وأمّن أطنان من المساعدات لمدينة اللاذقية مع فريق عمل من المدرسة، ورجل الأعمال، محمد عثمان، من السويداء الذي تصرّف بطريقة مشابهة. وقد يكون هناك آخرين من البيئة المحلية، ولكنهم على العموم قلّة، مثل تجار جملة قدموا مواداً مجانية للناس، منهم السيد سعيد، من تجار منطقة بانياس الذي قدّم في الأيام الأولى مواداً غذائية لإحدى جمعيات الأطفال في جبلة.
يبرّر الباحث سامر ضاحي حالة اللا تنظيم في الاستجابة بأنّ مناطق الساحل لم تتعرّض بالمجمل لعمليات عسكرية كبيرة، ما جعلها بالعموم بعيدة عن النمط الإغاثي، واقتصر الأمر في مراحل الحرب على السلال الغذائية التي تقدمها المنظمات المختلفة"، ويشير إلى أن "الفاعلين المحليين لعبوا على وتر توزيع المواد الإغاثية الدولية عندما كان لهم تأثير في توزيعها لكن مع تراجع التمويل الدولي وحصر التوزيع بالأمانة السورية للتنمية، تراجع تأثير عوامل الجذب التي تميّز بها الفاعلون".
المراقبة القصوى والإفقار الممنهج
على مدار تاريخهم، "كان الفقر سمة الجبال الساحلية السورية الموسومة بالجبال العلوية رغم امتلاكها مقوّمات سياحية واقتصادية لا تقل عن جبال لبنان المجاورة"، وهذه الحقيقة تجد تفسيرها، كما يقول الصحفي وائل سليمان، من جبلة، "في جملة عوامل منها الاقتصادي والسياسي ثم الديني، فالفاعليات الاقتصادية العلوية قليلة ولا يوجد إلا بضعة عائلات محسوبة على السلطة. كما أنّ طبيعة المعتقد العلوي الصوفية أدّت لعدم ظهور فاعلين دينيين مؤثرين، ومنعت الخلافات ظهور شخصيات دينية ذات طابع تمثيلي عام".
توابع الزلزال في القرداحة وريفها
27 تموز 2023
مسألة أخرى، يشير إليها الصحفي وائل هي أنّ "السلطة نفسها لم تسمح عبر تاريخها بظهور شخصيات وازنة تقف بموازاتها أو ضدها في الساحل السوري، خاصة بكون السلطة تعتبر الطائفة تحت تصرفها، كما أنّ هناك قلّة في التنظيم والحوار اللذان يدفعان بالشخصيات الأهلية للسطح في حال وجودها، وينسحب هذا على المؤسسات والجمعيات الثقافية القليلة بسبب الموافقات الأمنية المطلوبة من فروع الأمن واشتراطهم عدم تلقي أي دعم خارجي تحت طائلة المسؤولية، حيث تحتاج هذه الجمعيات لتنشط الى موارد وهذه الموارد غير متوفرة، وعلى سبيل المثال لولا دعم أدونيس والحزب السوري القومي الاجتماعي ورعايته لجمعية العاديات ما استطاعت الاستمرار، يضاف لها عدم وجود وعي سياسي بشكل عام واعتبار أي قائد رأي عام محتمل في منطقته، أنّ شؤون الدولة لا تخصه".
يضيف الباحث سامر ضاحي إلى ما سبق أنّ "سيطرة حزب البعث ومنظماته الشعبية استطاعت استيعاب وتمثيل مصالح العمال والفلاحين في الساحل وغيره من المناطق، كما أنّ مراحل قوة الدولة أمّنت الموارد وأضعفت الهوية المحلية، مما أضعف جدوى وجود الفواعل المجتمعية الأخرى، كما أنّ الحزب حارب البنى البرجوازية والإقطاعية وحتى الأهلية في وقت ما في محاولة لتعزيز البنى الوطنية، وبسبب غياب البنى الكبيرة وارتباط بعضها بالمدن الكبرى، لم تستطع في وقت لاحق فواعل الساحل الاقتصادية النهوض من جديد".
إلى ذلك يقول ضاحي "مع مرور الوقت بقي التأثير الهوياتي ضعيفاً بينما زاد تأثير عامل الموارد إذ أدّت مركزية الدولة وغياب التنمية ونمط علاقات المصلحة إلى استنزاف بشري كبير في الساحل لصالح العاصمة، وتراجع دور الموارد المحلية بحكم السيطرة المركزية عليها، وبات التأثير المحلي مرتبط بتعليمات المركز، كما أنّ الوصول لدوائر صنع القرار في المركز لبعض الفاعلين المحليين لم ينعكس على تحسين الواقع الخدماتي والاقتصادي. بشكل عام، رغم أن هذا الوصول لمفاصل البيروقراطية والمسؤولية شكل في السابق شبكة الحماية الاجتماعية الحقيقية، عندما أمن موارد للفاعلين المحليين عن طريق تحميل عبئها على الخزينة العامة، فالخدمات الصحية والتعليمية المكلفة مرتبطة بعلاقات المحسوبية على الدوام التي يمرّ بعضها عبر الفواعل نفسها".
إذن، جاء الزلزال في ظلّ بيئة مفكّكة القوى ومنهكة الموارد وتبحث عن هويتها، "بعد اتجاه المشاريع الأممية والدولية لمناطق النزاع، توازياً مع تراجع الواقع الخدمي وزيادة استنزاف موارد الساحل، وعدم الاستعداد للتضحية بالمزيد لإنقاذ الحكومة بعدما تقدمت الهويات الفرعية في عموم البلاد. لذلك قد تكون الفواعل المحلية قد قرأت مرحلة الزلزال بأنها مرحلة استحقاق واجبة على الجهات المموّلة وعلى الحكومة المركزية بعدما بذلته المحلية الساحلية خلال الحرب، بدل استنزاف المزيد من مواردها. من هنا يمكن تفسير السيرورة التي دفعت ما تبقى من فاعلين للإحجام عن المساعدة" كما يقول ضاحي.
كيف تسبّب الزلزال بظهور فواعل مجتمعية مختلفة؟
كان حدث الزلزال استثنائياً تسبّب بظهور تفكير عام ناتج عن سياق تعاطي الدولة مع الكارثة والمحسوبية والفساد اللذان شهدهما الناس في هذا التعاطي، وبأنّ "لا أحد يحك جلدك سوى ظفرك"، وبأنّ كمية الفقر التي زادت في الجبال واتسعت كثيراً، نتيجة الظروف الاقتصادية الحالية في سوريا، بحاجة إلى إعادة التفكير الجماعي بخلق حلول من قلب البيئة المحلية، وكان العاجل فيها تقديم إغاثة للأكثر فقراً وتضرراً، وتغيير قواعد اللعبة الاجتماعية في هذا اﻹطار.
كان حدث الزلزال استثنائياً تسبّب بظهور تفكير عام ناتج عن سياق تعاطي الدولة مع الكارثة والمحسوبية والفساد اللذان شهدهما الناس في هذا التعاطي، وبأنّ "لا أحد يحك جلدك سوى ظفرك".
وعلى هذا فقد ظهرت جمعيات أهلية جديدة يقودها أفراد من البيئة المحلية ممن يلتمس المجتمع فيهم نوعاً من النزاهة والشهامة، أي باستعادة واضحة لنمط علاقات المجتمع في الحارات الشعبية في المدن قبل التهام الحداثة لها، وهذه الجمعيات رغم ارتباطها بالمؤسسة الرسمية حيث لا يسمح بالعمل الأهلي دون مراقبة، فإنها استأنفت من جانب عمليات الجمعيات القديمة وبنت عليها في ابتكار آليات جمعية للتعامل مع مشاكل مجتمعاتها المستجدة، وخاصة الفقر الذي ضمّ شرائحاً جديدة في سياق الوضع السوري الكارثي.
يقول السيد، عهد إبراهيم، وهو رئيس جمعية خيرية أنشئت حديثاً في إحدى قرى ريف بانياس: "إنّ الآليات الجديدة للعمل تمثلت في التوافق على قيام الجميع بدعم الجميع في الوضع الراهن وكلّ حسب قدرته، دون انتظار معونات من أحد، على مبدأ بحصة تسند جرة، حيث يقوم كلّ شخص بالتبرّع بما يقدر عليه، إن كان عملاً أو كان مالاً أو غير ذلك من خبرات قد تفيد المجتمع مثل التعليم المجاني لأفراد فقراء، المساهمة في تنظيف الشوارع وتقليم الأشجار... وغير ذلك من أعمال".
بعد الزلزال تمّ إحصاء نشوء أكثر من عشر جمعيات محلية في القرى والمزارع تعمل على هذا النمط، توّزعت في أرياف بانياس وجبلة، والعدد في تصاعد، وعلى ما يبدو وفقا لحديث السيد أحمد إبراهيم، وهو من وجوه فاعلي إحدى الجمعيات في جبلة، فإن "الناس وعت أخيراً أنّ لها دوراً يتكامل مع الجمعيات الأهلية". وفي أحدها عملت الجمعية على بناء أمكنة لتلقي العزاء بالوفيات. ويتحدث السيد يوسف علي، من قرية بستان الحمام، أنّ "الهدف من هذه المبرّات مساعدة الناس في تحمّل تكاليف الوفيات بالتعاون بين أهل القرية بعد أن باتت تكاليف التعازي بالملايين بين قراءة القرآن والقهوة وما يتبعها".
في حالة ثانية تمّ تأمين منظومة طاقة شمسية لتشغيل محطة مياه الشرب للبلدة، وفي ثالثة تمّ القيام بعملية تنظيف جماعية لمحيط القرية من الأعشاب اليابسة بهدف تخفيف احتمال الحرائق، أو تقديم دعم للسكان (مازوت) من قبل متعهد بناء، ويقول المتعهد إنّ هدفه من ذلك تشجيع الناس على التعاون لحلّ مشاكلهم التي لا يجب أن ينتظروا أحدا كي يحلها لهم.
من الممكن قراءة هذه التغيّرات الطفيفة على أنّها عودة للمجتمع الأهلي المحلّي للحضور في حياة الناس مع صعود الهويات المحلية، المناطقية والطائفية على حساب الوطنية، ونسيان أدوار الفاعلين المجتمعيين دون إلغائها أو الوقوف ضدها، وهؤلاء لم يستطيعوا تحقيق أدوارهم المطلوبة في المجتمع ولا البنى التمثيلية المعبّرين عنها، سواء ﻷسباب متعلقة بالسلطة ونوعيتها، أو لنوعية رأس المال نفسه الخاص بالفاعلين الاجتماعيين، وهو حقيقة يلعب دوراً بالنظر إلى أنّه مال نفعي وفاسد في كثير من الحالات خلافاً للمال الناتج عن عمليات اقتصادية حقيقية، كحال الصناعة أو التجارة التقليدية أو الزراعة، ويشير المهندس، أحمد إبراهيم، أحد الفاعلين في ريف جبلة إلى أنّ "الدرب طويل والجهد كبير كي تتمكن المجتمعات الساحلية من الخلاص من اعتمادها في كلّ شيء على الدولة ومنظوماتها، هذه إذا سمحت الحكومة لنا بالتحرّك والقيام بواجبنا، ﻷن هذا يخلصنا من التبعية ويجعلنا مستقلين وهذا لا يعجب الرفاق كثيراً".