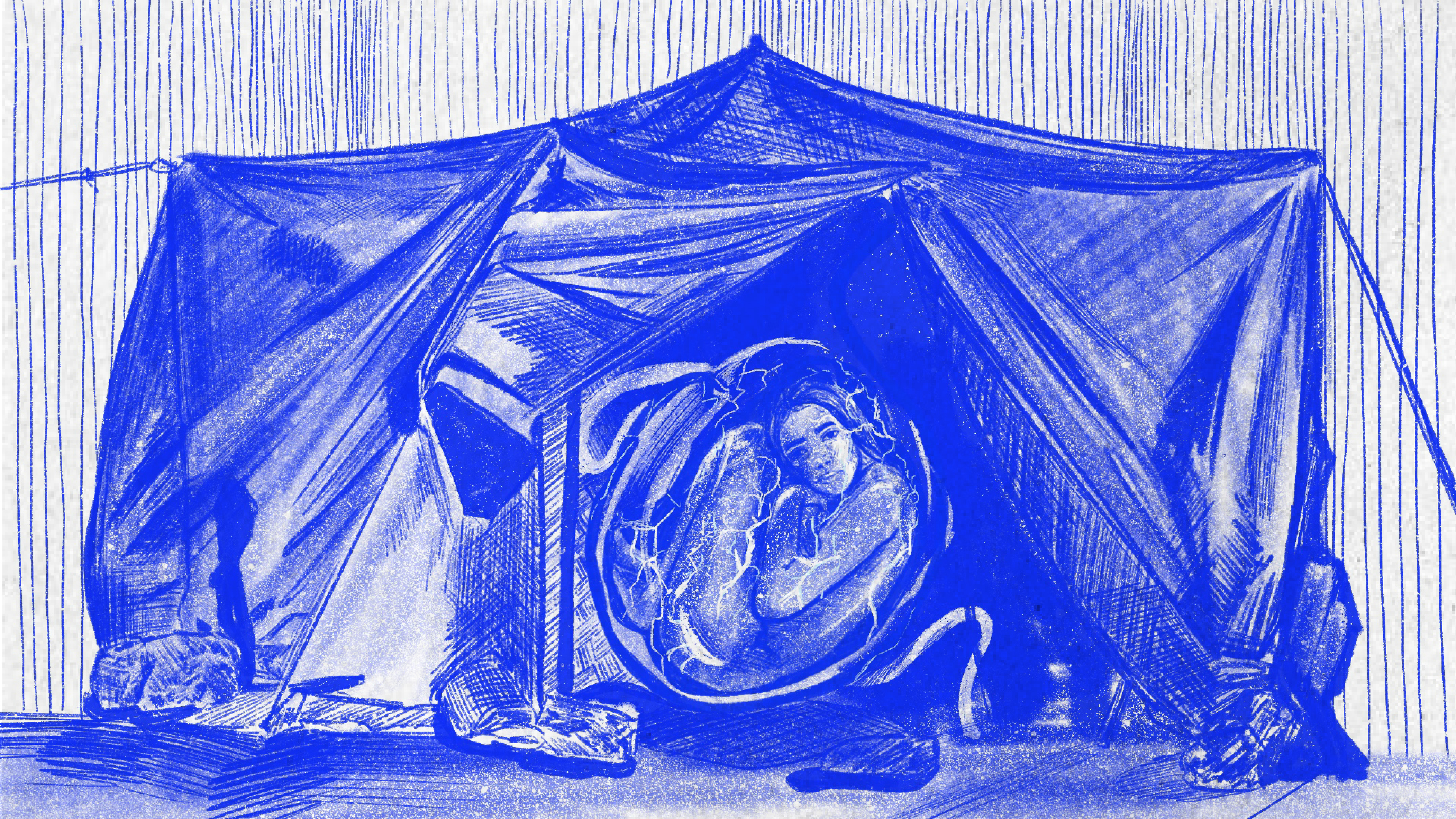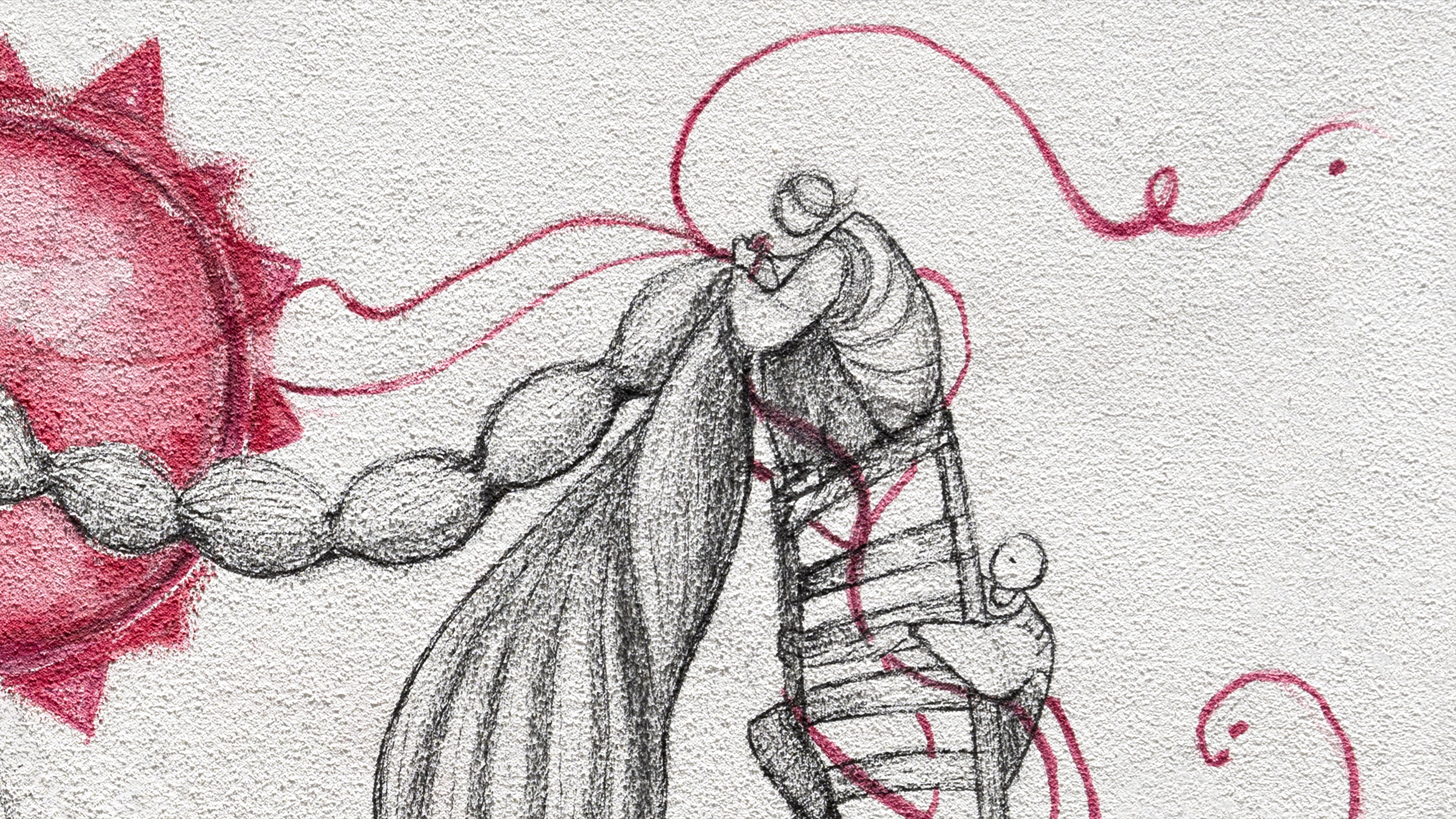لا يمكن فهم الواقع الفلسطيني عموماً والحالي خصوصاً دون تفكيك الجانب الاقتصادي وانعكاساته على القرار السياسي الفلسطيني، حيث أن الأرقام قد تعطينا مؤشرات عن شكل الواقع، إلا أنها غير كافية لتحليله بكل تفاصيله، تحديداً بعد الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول ٢٠٢٣. نحاول من خلال هذا الحوار مع طاهر اللبدي، الباحث في الاقتصاد السياسي حول فلسطين والشرق الأدنى في المعهد الفرنسي للشرق الأدنى (IFPO)، أن نفهم جذور هذه العلاقة والتفاصيل المُخبَّأة في جوانبها، ومدى تأثيرها على المشهد الفلسطيني في الداخل والخارج من جانب اقتصادي-سياسي.
في البداية أعتقد أنه من المهم أن تشرح لنا الصورة العامة للاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية بعد وقبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر؟
لقد وجد الاقتصاد الفلسطيني، أو ما تبقى منه، نفسه معزولاً بشكل متزايد ومقطوعاً عن طرق تجارته عدة مرات خلال القرن الماضي. أما فيما يتعلق بالضفة الغربية وقطاع غزة، فنحن نتحدث عن أراضٍ بُترت وقت النكبة عام ١٩٤٨ ثم احتلتها إسرائيل منذ عام ١٩٦٧، تعرضت خلاله الأرض لسياسة الاستعمار والاستيطان الإسرائيلي، من سلب الأراضي ونهب الموارد وفرض سياسات اقتصادية، نتج عن هذه السياسات تدمير النسيج الاقتصادي للقطاع الإنتاجي، ما انعكس على تراجع أهمية قطاع الزراعة والصناعة في الضفة الغربية وغزة. وتتحدث الكثير من التقارير الاقتصادية للمنظمات الدولية عن إفقار للفلسطينيين في آخر عشر سنوات، بعضها يتحدث عن اقتصاد غير قابل للحياة، اقتصاد مر بعملية التنمية المعكوسة، بمعنى أنه بدلاً من أن يكون هناك تنمية للوضع الاقتصادي، فإن العكس هو ما يحدث. تظهر هذه التقارير أيضاً أن الاقتصاد الفلسطيني قبل الحرب الإسرائيلية الأخيرة كان أسيراً للاقتصاد الإسرائيلي، بمعنى أنه تابعُ له. ونتيجة هذه التبعية ظهرت عندما بدأت الحرب على غزة في السابع من أكتوبر، حيث زادت إسرائيل الحصار على الضفة الغربية فخنقت اقتصادها. كان معدل البطالة قبل الحرب عند ١٣ بالمئة، وهو ليس رقماً قليلاً، وبعد الحرب زادت التقديرات في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٢٣ ووصلت إلى حوالي ٣٠ بالمئة في الضفة الغربية، وأصبح هناك انخفاضٌ كبيرٌ في حركة الصناعة والتجارة والسياحة. هذا الخنق بهذا الشكل السريع يشير إلى مدى سيطرة الاستعمار الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني.
أرحام تحت الانهيار، عن الإجهاض في لبنان في ظلّ الأزمة الاقتصادية
13 أيار 2024
"يصفون محاولة الإجهاض بأنّني أريد قتل طفلي، القطة تأكل صغارها حينما تشعر بالخطر المحدّق بهم، أعلم أنني لست هرّة، لكن عليهم أن يعلموا أيضاً أنّ الإنجاب في ظروف كهذه قتلٌ...
أرحام تحت الانهيار، عن الإجهاض في لبنان في ظلّ الأزمة الاقتصادية
13 أيار 2024
بدأنا الحديث انطلاقاً من السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، لكن واقع الاقتصاد الفلسطيني له جذوره الممتدة منذ عشرات السنين. كيف يمكننا أن نفهم جذور الأزمة الحالية وعلاقتها بالنظام الاقتصادي الذي أقرّته أوسلو، لو استطعنا اعتبارها نقطةً مفصليةً في تغيير الواقع الفلسطيني؟
نعم. في الحقيقة يُنظَر إلى أوسلو في الأدبيات كمرحلة فصل، بمعنى أن هناك ما قبل أوسلو وما بعدها، وهو صحيح إلى حد ما، لكن من المهم توضيح أن أوسلو لم تغيّر في جوهر العلاقة بين اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة والاقتصاد الإسرائيلي، ولم تغيّر في في سياسات الاستعمار تجاه الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧، وبالتالي فإنّ الأزمة قائمة من قبل أوسلو. الإشكالية هي التعامل مع الاقتصاد على اعتبار أنه منفصلٌ تماماً عن السياسة، وعلى هذا الأساس أيضاً يقيّم الاقتصاديون أثر الواقع السياسي على الاقتصاد وكأنه شيء منفصل تماماً. المقاربة التي أعتمدُ عليها هي أن الاقتصاد جزء من الصراع القائم على الأرض، وأن الحركة الصهيونية من قبل ١٩٤٨ كانت تنفّذ أهدافها من خلال الاقتصاد، وهناك ثلاثة محاور نستطيع من خلالها أن نوضح طبيعة الصراع بين إسرائيل وفلسطين: المحور الأول هو الاستبدال، وهو خاص بكل حركات الاستعمار الاستيطاني حول العالم، بمعنى الاستيلاء على الأرض وطرد سكانها، وبالتالي سيطرة الإسرائيلي على الأسواق بكل الجوانب، من العمل والصناعة والإنتاج، وهذه كانت طريقة لإقصاء الفلسطيني خارج المعادلة؛ المحور الثاني هو الاستغلال، عندما أصبح الفلسطيني جزءاً من التركيبة، فإسرائيل لم تستطع طرد كل الفلسطينيين من الأراضي المحتلة عام ٤٨ وأيضاً من أراضي ٦٧، حينها أصبحت إسرائيل مسيطرة على أراضٍ فيها مئات الآلاف من الفلسطينيين، فأصبح السؤال هو كيف ستتعامل مع هذا الوجود، وهذا الوجود قد يكون إيجابياً من ناحية استغلال اليد العاملة الفلسطينية كجزء من حركة الاقتصاد الإسرائيلي؛ المحور الثالث هو القمع ومكافحة التمرد من خلال الاقتصاد، بمعنى أنه في أي لحظة فيها «تمرد» يستطيع الإسرائيلي أن يخنق الاقتصاد الفلسطيني ليعاقب الفلسطيني ويقمعه ويمنعه من أن اتّخاذ أي حركة سياسية مستقلة. هذه المحاور الثلاثة قائمة منذ ما قبل أوسلو واستمرت بعدها، ولذا فإن سيطرة إسرائيل على الاقتصاد الفلسطيني بعد أوسلو استمرت، والنتيجة اليوم هي أن أكثر من ٦٠ بالمئة من الأراضي هي مناطق (C)، أي تحت سيطرة إسرائيل، كما أنها تسيطر على كل الحدود في الضفة وقطاع غزة، وتسيطر على القطاع المصرفي، فحتى البنوك الفلسطينية مرجعيتها البنك المركزي الإسرائيلي والعملة هي العملة الإسرائيلية. وبحسب بروتوكول باريس الاقتصادي، فإسرائيل لها اليد العليا، بالتالي لم تتغير الأمور مع أوسلو. الحقيقة أن الذي تغير هو وجود السلطة الفلسطينية، والسلطة هي «القطاع العام بموظفيه ومشاريعه». المهم أنه أصبح هناك تداخل بين الاقتصادَين الفلسطيني والإسرائيلي بعد أوسلو، والنتيجة أنه من الصعب على الأدبيات الاقتصادية اليوم الحديث أصلاً عن اقتصاد فلسطيني قابل للحياة، ما يجعلنا نفكر أن وجود «اقتصاد فلسطيني» يعني وفق الوضع الراهن فقط وجود مؤسسات فلسطينية تُنتِج إحصاءات وتحاول ترقيم نشاط اقتصادي فلسطيني وكأنه منفصل عن إسرائيل. والحقيقة أن هذه الأرقام تغشنا، فعملياً على الأرض لا يمكن الفصل بين الاقتصاد الفلسطيني والاقتصاد الإسرائيلي، وأكبر مؤشر على ذلك هم العمال الفلسطينيون الذين يعملون في الأراضي المحتلة عام ١٩٤٨ أو المستوطنات الإسرائيلية الموجودة في الضفة، وهنا نحن نتحدّث بشكل رسمي عن قرابة ١٨٠ ألف عامل فلسطيني، والتقديرات تشير إلى أن هذا الرقم من الممكن أن يصل إلى ٢٥٠ ألف عامل إذا أخذنا في عين الاعتبار العمال الذين يعملون دون تصاريح. إذاً نحو ٢٠-٢٥ بالمئة من اليد العاملة في فلسطين تعمل في الاقتصاد الإسرائيلي، وهذه مؤشرات تظهر التبعية للاقتصاد الإسرائيلي، وبالتالي أوسلو لم تغير كثيراً في هذه العلاقة.
عدنا مجدداً إلى السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، بعد توضيحك أن أوسلو لم يكن تماماً نقطةً فارقة، وإنما استمراراً لواقع قائم قبل ذلك، أعتقد أننا غير أكيدين اليوم إذا كان السابع أكتوبر سيشكل نقطةً فاصلةً اقتصادياً. ما رأيك؟
بعد السابع من أكتوبر نستطيع الحديث عن ثلاث نقاط رئيسية: الأولى أن إسرائيل زادت الحصار والقيود على حركة البضائع والناس، وضاعفَ أثر هذه القيود تزامُنها مع الاقتحامات وازدياد عنف المستوطنين. كل هذا أدى إلى تراجع الحركة الاقتصادية بشكل كبير؛ والنقطة الثانية هي العمال الفلسطينيون، ففي ٧ أكتوبر ألغت إسرائيل تصاريح كل العمال في الضفة، حتى العمال الذين لا يحتاجون إلى تصاريح لم يستطيعوا الوصول إلى أماكن عملهم، وهنا نحن نتحدث عن ١٨٠-٢٥٠ ألف عامل فلسطيني أصبحوا عاطلين عن العمل ويبحثون عن عملٍ في اقتصاد مدمر أصلاً؛ والنقطة الثالثة هي إيرادات المقاصّة التي لم تحوّلها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، وبالتالي أثّرت على دفع السلطة لرواتب الموظفين ما أدى إلى تراجع الحركة الاقتصادية.
تواجه السلطة الفلسطينية أزمة كبيرة في ما يتعلق بدفع رواتب الموظفين خلال السنوات الأخيرة، والأزمة تتزايد. ما هي الخيارات المطروحة على السلطة الفلسطينية لتمويل سداد الرواتب على الأقل في الفترة القريبة؟
تعتمد السلطة الفلسطينية، بشكلٍ عام، على موارد محدودة، و٦٠ بالمئة تقريباً تأتي من إيرادات المقاصة. عملياً، وبحكم واقع أن السلطة لا تسيطر على حدودها، فكل الضرائب الفلسطينية على الاستيراد تجمعها إسرائيل ثم تسلّمها للسلطة مرة أخرى منقوصةً نسبةً محددةً تعتبرها إسرائيل «مصاريف إدارية». والمقاصة أداة «جيدة» تستخدمها إسرائيل لمواجهة أي سيناريو لا يتماشى معها. منذ فترة كانت إسرائيل تُنقص من إيرادات المقاصة كل ما يمكن اعتباره «أموال تذهب لعائلات الأسرى والشهداء». بعد معركة سيف القدس في أيار ٢٠٢١ زادت هذه السياسات، ومع تراكمها لم تعد السلطة قادرة على دفع الرواتب كاملةً. بالمناسبة عدم قدرة السلطة على دفع رواتب موظفيها ليست جديدة، وحدثت سابقاً خلال حكومة سلام فياض ومستمرة إلى الآن من حينٍ إلى آخر. مع ٧ أكتوبر قررت إسرائيل أن تُنقص حصة غزة أيضاً، فرفضت السلطة استلام الأموال المنقوصة، بالتالي تجدّدت الأزمة بين إسرائيل والسلطة وتدخّلت أطراف أوروبية وأميركية. لاحقاً تم الاتفاق على أن إسرائيل لن تدفع أموال المقاصة بشكل مباشر للسلطة، وحولتها إلى بنك في النرويج، والنرويج ممنوع أن تسلمهم للسلطة إلا بقرار إسرائيلي، على اعتبار أنها أموال مجمدة.
سوريون في غزة: نازحون، قتلى، مفقودون تحت الأنقاض
13 آذار 2024
يوجد أيضاً الضرائب المحلية كمصدر دخل للسلطة. بعد ٧ أكتوبر قلّت هذه الضرائب تأثراً بالحركة الاقتصادية الفلسطينية. أما الجزء المتبقّي المتمثّل بالمساعدات الدولية، فهي منخفضة منذ ما قبل الحرب على غزة، تحديداً في السنوات الخمس الأخيرة، إذ خفّض الممولون الأجانب حجم المساعدات الممنوحة للسلطة، وتحوّلت نسبة كبيرة منها إلى مشاريع تنموية على الأرض. مع ٧ أكتوبر لاحظنا أن كثيراً من الممولين صرّحوا بأنهم من الممكن أن يقطعوا المساعدات أو يخففوا منها أكثر، وبالتالي السلطة الفلسطينية في أزمة اقتصادية كبيرة، حتى الرواتب التي تدفعها لموظفيها غير كاملة ومتأخرة قرابة شهرين. اليوم تلجأ السلطة الفلسطينية إلى الاقتراض من البنوك المحلية لتستطيع دفع رواتب موظفيها.
تحدثت عن المساعدات المالية من الدول المانحة، وهي نقطة مهمة ينبغي الوقوف عندها. برأيك كيف نستطيع قراءة التغيير في دعم الدول المانحة للسلطة الفلسطينية من أوسلو وحتى اليوم؟
عندما وُقّعت اتفاقية أوسلو، اتفقت الدول المانحة على ضرورة دعم التنمية الفلسطينية لضمان تراجع احتمال اندلاع انتفاضة أو غيرها من المظاهر الثورية. حينها كانت السلطة تحصل على قدرٍ كبيرٍ من المساعدات، قد تصل إلى مليار دولار سنوياً، وعندما نتحدث من منطلق اقتصادي فإن نسبة المساعدة لكل مواطن فلسطيني واحد كانت تعتبر من أعلى النسب في العالم. مع الوقت، وبعد الانتفاضة الثانية، ترسّخت الرواية الإسرائيلية بأن السلطة الفلسطينية لم تكن تؤدي دورها، أي الحفاظ على الأمن الإسرائيلي، بل كانت تساعد في «تمويل الإرهاب»، مما دفع المانحين الدوليين إلى تشديد شروط وضوابط الإنفاق، في حين طلب المانحون من السلطة الفلسطينية خفض إنفاقها، وأن عليها أن تتحمل مسؤولية نفقاتها. هذا الواقع رسم تغيرات في عقلية الممول، الذي بات فحوى خطابه للسلطة بأنه «لا يمكن أن نستمر بالدفع لعقود وأنتم لا تتحملون مسؤولية». وأصبح البنك الدولي يطالب الفلسطينيين إثبات أنهم شفافون في نفقاتهم، وقال إنهم يستطيعون خفضها، وأن عليهم وضع ضرائب يدفعها المواطن الفلسطيني ليشارك في الميزانية الفلسطينية. هنا جاء دور سلام فياض الذي تولّى رئاسة الحكومة بعد الانقسام الفلسطيني في ٢٠٠٦-٢٠٠٧، فقد أتى حاملاً خطةً من هذه العقلية الغربية التي تريد من الفلسطيني أن يثبت أن هناك شفافية ومسؤولية في الصرف، ووجوب التخلص من واقع أن السلطة مدعومة من الخارج بشكل أساسي. وجاء ذلك ليخفي حقيقة أن المساعدات الدولية كانت مقابل صمت عن سيطرة إسرائيل أكثر على الأرض، وتقييد للاقتصاد الفلسطيني أكثر، وعدم السماح للمزارعين بالوصول إلى أراضيهم، وسلب مستمر للأراضي، بالتالي كان التمويل يأتي مقابل تقليص البنية الاقتصادية الفلسطينية. هذه السياسات استمرت ولم يوقفها أحد، وفي نفس الوقت فإن المطالبات للفلسطيني بتحمّل مسؤولية نفقاته في ظل تقليص إسرائيلي للاقتصاد الفلسطيني أصبح طرحاً جنونياً. بمعنى أن الفلسطيني لا يستطيع أن ينشط اقتصادياً، ولكن مطلوبٌ منه أن يدفع لتمويل النفقات التي تهدف إلى منع التمرد، أي الإنفاق من أجل أمن إسرائيل. بالتالي منذ حكومة فياض عملت السلطة على خفض نسبة العاملين لديها، واليوم نسبة الرواتب أقل بكثير من النسبة التي كانت قبل عشر سنوات باستثناء القطاع الأمني. وفي الوقت نفسه زادت السلطة من دخلها المحلي المبني على الضرائب المحلية، والحقيقة أن ذهنية المواطن الفلسطيني تفكر بمنطق أن هذه السلطة لا تحميني من قبضة الإسرائيلي على النشاط الاقتصادي، وهناك فساد واضح ومعروف، فهل تستحق السلطة أن يدفع لها المواطن ضرائب؟ وهل هي دولة مثل باقي الدول ليتحمل المواطن مسؤولية دفع ضرائب لها، في ظل أن المواطن لا يعرف ماذا تنفق وكيف تنفق؟ استمرت هذه الذهنية لدى المواطن الفلسطيني بالازدياد خلال السنوات العشر الأخيرة وانعكست بشكلٍ واضحٍ من خلال الاحتجاجات، تحديداً الاجتماعية منها، وهذا أمرٌ جديدٌ على المجتمع الفلسطيني الذي تتركز احتجاجاته ضد الاحتلال.
انطلاقاً من كل ما سبق، هل تعتقد أن توقّف تمويل السلطة الفلسطينية أًصبح محتملاً؟ أم أن الغرب لا يمكن أن يترك السلطة الفلسطينية تنهار بشكل كامل؟
التعامل مع السلطة الفلسطينية بالنسبة لكل الأطراف المحيطة، تحديداً الممول الغربي وإسرائيل نفسها، تعامل فيه شيء من التناقض. الغرب وإسرائيل بحاجة لطرف فلسطيني قادر أن ضمان نوع من الأمان والاستقرار في المنطقة، وبالمنطق الإسرائيلي والغربي يعني استقرار وأمان لإسرائيل. في الوقت نفسه تستمر إسرائيل في استيطانها وسلبها للأراضي والموارد. أغلب دول الغرب عندما تتعامل مع السلطة لا تتعامل معها على أنها مشروع سيادة أو دولة حتى، ولا يعنيها موضوع الفساد والسلطوية الموجود في واقع حكم السلطة. ولكن من ناحية أخرى، لا شك أن إسرائيل والغرب لديهم انزعاج من السلطة كونها بشكلها الحالي نتاج للحركة الوطنية الفلسطينية، والحركة الوطنية كانت تطالب بدولة وسيادة، وهذا أكثر ما يزعج إسرائيل. إسرائيل تحتاج شريكاً يؤمن لها استقراراً على الأرض، لكنها لا تريد شريكاً يزعجها بمطالب الدولة والاستقلال والسيادة، ومن هنا نستطيع فهم توجهات إسرائيل من حين لآخر بتقليص أموال المقاصة ككرت ضغط وترهيب. اليوم السلطة شريك مثالي لأنها شريك ضعيف.
هل هناك سرديّة جديدة عن فلسطين في الإعلام؟
08 تموز 2021
إلى جانب موظفي القطاع العام، توجد فئة العمال الفلسطينيين الذين طردتهم إسرائيل من أعمالهم، ومنعتهم من دخول الأراضي المحتلة في ١٩٤٨. ما هو تأثير هذا المنع على الاقتصاد الفلسطيني؟ وما مدى قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على تحمّل غياب العمال الفلسطينيين أيضاً؟
إسرائيل حوّلت وجود الفلسطينيين اقتصادياً، بدءاً من الأسواق الفلسطينية التي تستوعب البضائع الإسرائيلية، إلى استغلال الموارد الفلسطينية مثل المياه والغاز واليد العاملة. تاريخياً يوجد عدة مراحل: مرحلة ما قبل الانتفاضة الأولى، حينها كان هناك عدد كبير من الفلسطينيين من غزة والضفة يعملون في أراضي ١٩٤٨ المحتلة، تحديداً في قطاع البناء والزراعة والخدمات؛ وبعد الانتفاضة الأولى وأوسلو انخفض الاعتماد على العمال الفلسطينيين؛ وأخيراً بعد ٢٠١٠ بدأ يزداد عدد العمال تدريجياً وصولاً لأعلى مستوى تاريخي في ٢٠٢٢-٢٠٢٣، بما يقدر نسبته ١٨٠ ألف تصريح عمل، يُضاف إليهم مَن يدخلون دون تصاريح، وبالتالي نتحدث عن نحو ٢٥٠ ألف عامل فلسطيني في الأراضي المحتلة سنة ١٩٤٨ وفي المستوطنات. هؤلاء العمال بالنسبة لإسرائيل يد عاملة رخيصة، فهم يتقاضون ما نسبته ثلثي الأجر عن الوظيفة نفسها التي يشغلها إسرائيلي. بالعودة إلى الانتفاضة الأولى حيث كان هناك حركة مقاطعة فلسطينية ودعوات تحضُّ على منع العمل في المصانع الإسرائيلية، ما ترك شعوراً لدى الإسرائيلي بأنه يعتمد بشكل كبير على الفلسطيني في اقتصاده، وبالتالي قد يتحول لورقة ضغط، حاولت إسرائيل خلق بديل من الأفارقة والآسيويين، لكن تبين مع الوقت أن تكلفتهم عالية جداً مقارنة بالفلسطيني الذي يعمل ويعود إلى منزله في الضفة الغربية، إذ يحتاج العمال من غير الفلسطينيين إلى تجهيز مناطق سكنية خاصة، كما يحصل في دول أخرى مع العمالة الوافدة. كذلك فإن هذا العامل، غالباً، سيرسل أجرته إلى بلده، بعكس الفلسطيني الذي يضخ أموالاً تعود في النهاية للاقتصاد الإسرائيلي. اليوم الأحاديث عن إحضار عمال هنود كبديل عن العمال الفلسطينيين هي مجرد دعاية، وفي الغالب لن تنجح. مفهومٌ ضمناً أن إسرائيل تستغل العمال الفلسطينيين، وهذا الاستغلال ليس فقط لدعم الاقتصاد الإسرائيلي، بل هو استغلال لمكافحة التمرد، بمعنى أن العامل الفلسطيني الذي يريد العمل في إسرائيل عليه أن يقدم طلباً للحصول على تصريح، وحتى يحصل عليه يجب أن يكون ملفه الأمني نظيفاً لدى إسرائيل.
منذ السابع من أكتوبر تشهد الضفة الغربية جرائم يومية متصاعدة بحق المزارعين الفلسطينيين الذين يسعون للوصول إلى أراضيهم. ما مدى تأثر هذا القطاع من الناحية الاقتصادية وانعكاسات ذلك على واقع الضفة بشكل عام؟
القطاع الزراعي هو المتضرر الأسرع. المزارع إن لم يستطع الذهاب إلى أرضه سيكون الضرر كبيراً في اللحظة الراهنة وما يليها. تاريخياً كان قطاع الزراعة من أكثر القطاعات المتأثرة بالتوترات لأنه يتصل بالأرض والمياه التي تستهدفها إسرائيل، وفي آخر ٣٠ سنة انخفضت الأراضي التي تُمارس عليها الفلاحة بشكلٍ كبير في الضفة الغربية، وتقلّصت المساحات المزروعة واقتربت من المدن، وهناك أيضاً مساحات عديدة لا يصلها المزارع بسبب الخطورة أو نتيجة تحويلها إلى مناطق عسكرية أو مستوطنات تسيطر عليها إسرائيل.