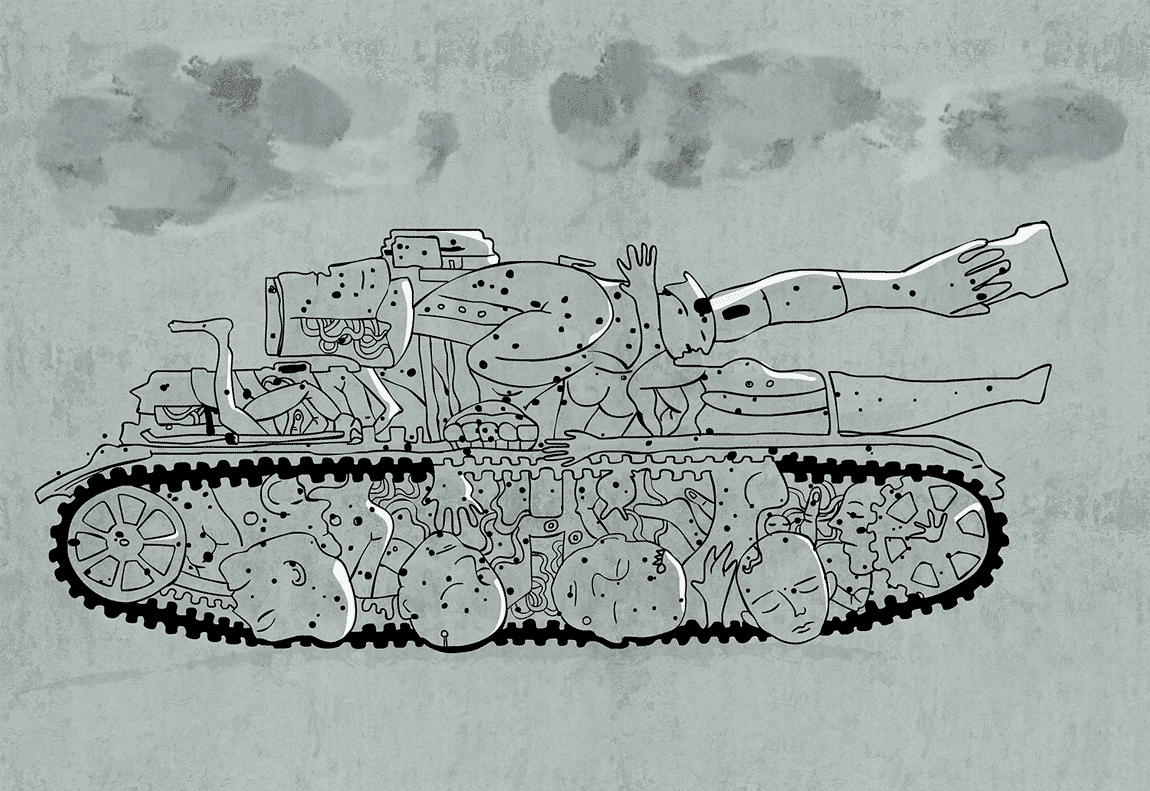قلّما نجد نحاتاً يدمّر طوعاً عملاً ضخماً، أمضى شهوراً طويلة يصنعه وينقله من مكانٍ إلى آخر، ويرمّمه. لكنّ النحات السوري خالد ضوّا، اعتادَ مقارعة الديكتاتوريّة وممكناتها في بلاده سوريا، أحياناً بالبناء، وأحياناً أخرى بالتدمير، ليتجنّب تبعات ملاحقة الأمن السوري أو ليلفت النظر إلى مأساةٍ يتهدّدها النسيان. هكذا وجد نفسه في ٣٠ أغسطس/ آب الماضي، يدمّر "ملك الثقوب"، الذي يزيد ارتفاعه عن ثلاثة أمتار، أمام مبنى الأمم المتحدة في جنيف، مع ذوي المعتقلين والمختفين قسراً من قبل النظام السوري، الذين يتجاوز عددهم مئة ألف شخص، أملاً في تنفذ الهيئة الأممية وعودها أخيراً في الكشف عن مصائرهم، عبر "المؤسّسة المستقلّة المعنيّة بالمفقودين" في سوريا، التي أسّستها (الأمم المتحدة) في حزيران/يونيو ٢٠٢٣. في هذه المقابلة التي أجريناها عبر الهاتف على مراحل، نقف عند مسيرة خالد ضوّا المهنية، في سوريا، لكن على نحوٍ خاص في المنفى منذ عقد، والتي حاول تكريسها للقضيّة السوريّة، محاولين معرفة ما إذا كان قد وجد نفسه، وهو المعتقل السابق، حبيس القِصّة السورية، التي يرى أنّها "لم تنته"، أم أنّه استطاع المضي في حياته في فرنسا.
تتحدّث في تصريحاتٍ صحفيّةٍ عن تركك تمثال "ملك الثقوب" في مكانٍ عام لتأكله الطبيعة وتظهر هشاشته، متى نحته، وكيف نشأت فكرة تدميره في عرض فني، أمام مقرّ الأمم المتحدة في جنيف في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، شارك فيه أهالي المعتقلين؟ كم كان تدميره صعباً عليك بعد سنوات من صناعته وعرضه في أماكن مختلفة؟
فادي يازجي: قلق التعبير والانتحارات المؤجلة
27 أيار 2024
بدأ مشروع عرض "ملك الثقوب" في مكان عام في العام ٢٠٢١، ضمن مسابقة مع مؤسّسة "لي سوكل le socle" في باريس. جاء هذا عند مشاركتي في مسابقة نظّمتها بلدية باريس لاستغلال المساحات في الأماكن العامة، وتوزيعها على مؤسّساتٍ فنيّةٍ، أو منحها لفنانين/ات ليعرضوا فيها أعمالهم مؤقّتاً. صُوِّت على الأعمال عبر الإنترنت من قبل الجمهور، ونجح مشروعي من بين مشاريع أخرى. عادةً ما يُعرض العمل لثلاثة أشهر، لكن "ملك الثقوب" بقي معروضاً مدّة ثمانية أشهر في مكان مميّز هو "سان مارتان". تطوّرت الفكرة من عرضِ نسخةٍ صغيرةٍ من "ملك الثقوب" إلى نسخةٍ ضخمة، بارتفاع ثلاثة أمتار.
فكرة التمثال كانت موجودة لديّ منذ وقت طويل، لكن كانت هذه المرّة الأولى التي أصنع فيها نسخة بهذه الضخامة بمواد غير صلبة ينبغي أن تبقى في الهواء الطلق. تعلّمت خلال الصناعة كثيراً وخاطرت، وانتهيت من العمل عليه بعد أربعين يوماً. تمّ عرض العمل في مدينة باريس لثمان أشهر، ثم نقلتُ العمل إلى حديقة النحت في منطقة النورماندي le jardin des sculptures de BG ، وبقي معروضاً هناك لسنتين. كنت مدركاً أنّ العمل لن يصمدَ طويلاً في الطبيعة لكونه مصنوعاً بمواد هشّة، ما اضطرّني لترميمه هناك في مراحل مختلفة. خلال هاتين السنتين نبت الشجر داخله، وباتت الديدان تعيش داخله. صوّرت كلّ مراحل صناعة التمثال، وكنت أفكر فيما إذا كنت أريد الحفاظ عليه وجعله من البرونز، أو أن يتم تصويره وأنا أكسره، ليصبحَ جزءاً من فيلم عن التمثال لاحقاً. هنا تواصلت معي منظمة "سيريان كامبين"، لتنظيم عمل مشترك في اليوم العالمي للإخفاء القسري في ٣٠ آب/أغسطس، خلال وقفة لأهالي المعتقلين/ات. لضيق الوقت المتبقي على موعد تنظيم الفعالية، وبعد تمحيص العديد من الأفكار، استقرّينا على فكرة تدمير العمل بمشاركةِ الأهالي كنوعٍ من الاحتجاج.
تعاونا على نحوٍ مكثّف ولوقتٍ طويل، تحضيرًا وتنسيقًا، مع أهالي المعتقلين لإشراكهن في الحدث. كانت مهمّة صعبة، توازي حجم الخذلان الذي يعيشونه على كافة المستويات. أردت أن يشعرن بأنّنا نتشارك المصير. لست فناناً فحسب بل أيضاً معتقلاً سابقاً، ولديّ أصدقاء معتقلين، وسبق لي أن اشتغلت أعمالاً تحت عنوان "مضغوط" في فرنسا عن تجربة الاعتقال.
كان هدفي الرئيسي من المشاركة تسليط الضوء على معاناة أهالي المختفين قسرياً، بعرض فنّي يجذب وسائل إعلام دولية، مع انحسار الاهتمام الدولي بقضيتنا.
ما الذي تريد قوله عبر تدميره؟ تذكرة بهشاشة الديكتاتور، مؤسّسات الأمم المتحدة العاجزة عن فعل أيّ شيءٍ للمعتقلين؟
عندما بدأت بتحطيم التمثال، كانت درجة الحرارة مرتفعة للغاية في جنيف. جفّ العمل بشدّة، وبدا التمثال، وهو ينهار كبناء، شبيهاً بالأمم المتحدة، والنظام، عملاً ضخماً ينهار بضربةٍ من مطرقةٍ صغيرة، كان تعبيراً عن الغضب..
يشغلني موضوع "رجل السلطة" بمعناه الأعم، وهذا ما ينعكس في الكثير من أعمالي. عندما يشاهده الأوروبيون يقولون إنّ التمثال لا يشبه بشار الأسد. أوضح لهم بأنّني لا أعالج قضيّة سورية فحسب، التمثال يجسّد الأسد أو أيّ ديكتاتور آخر، أو النظام ككل في سوريا، أو أيّ مكان في العالم، أو أيّ رب عمل، وأنّ هناك في قمة الهرم، نجد النظام العالمي، والأمم المتحدة. أعتقد أنّ نظام بشار الأسد وأشباهه هو نتاج نظام عالمي، نظام موجود ولكنّه ضعيف، مع ذلك تقف أمامه لا حول لك ولا قوة. ستجد من بين أعمالي، ما هو مائل نحو الأرض، دون ساق أو ساعد، متآكل الوجه، لكنه موجود، وهنا يكمن سؤالي، كيف لمثل هكذا شخص أو نظام أن يظلّ موجوداً؟
شهدنا في سوريا تدميراً لتماثيل حافظ الأسد وعائلته خلال الثورة كما تعلم، لكن الأسد ما زال على كرسيه، يخال لمن يشاهد تدميركم للتمثال، صرخة يائسة "لم لا تسقط ! لتسقط !" ترافقها. هل ينم التدمير أيضاً عن إحباطٍ ويأسٍ، فالديكتاتور الهش ما زال جالساً على كرسيه، وليس هناك تغيير ملموس فيما يخصّ مصير المختفين قسرياً؟
يشغلني موضوع "رجل السلطة" بمعناه الأعم، وهذا ما ينعكس في الكثير من أعمالي
نعم كان هذا من بين العديد من الخواطر التي كانت تمر في ذهني وأنا أدمّر التمثال، ما الجدوى؟ ما الذي أفعله الآن؟ لكنّني، وبوجود أهالي المعتقلين والمختفين قسريًا كنت أضع في المقام الأوّل أهميّة لفت الانتباه لقضيّة المعتقلين، وإمكانيّة تحقيق ذلك عبر الفن، في مجتمعاتٍ تحترم حريّة التعبير، ويتمتّع فيها الفنانون والمثقفون بصوتٍ قوي ومؤثّر. كان التحضير وتنفيذ العرض، رحلة صعبة بجانبها اللوجستي، وكذلك النفسي. هذا ما ستلاحظه إن دققت في الصور المنشورة للعرض الفني. كنت محاطاً بمجموعة أصدقاء (جلال الطويل، ودنيا الدهان، وشربل كانون). تعاونا جميعًا على تحقيق هذا المشروع. تحوّل التمثال، المصنوع من مواد الخشب والفلين والجبصين، إلى كومةِ حطامٍ في مكانٍ يُعَدّ وجهةً سياحيّةً معروفةً في جنيف، قرب تمثال الكرسي الشهير.
من يتابع أعمالك، يلاحظ انشغالك بموضوعة "رجل السلطة" منذ وقت طويل؟
أجل، بدأت هذا المشروع في العام ٢٠٠٧، الرجل الجالس على الكرسي. عندما بدأت دراسة النحت، صادفت استفسارات مُشكّكة من المحيطين بي، عن كيفيّة تصرّفي مثلاً، إن طُلب مني صناعة تمثال لحافظ الأسد، لا سيما وأنّ النحاتين الأكثر صنعاً لهذه التماثيل هما من مدينة مصياف، مسقط رأسي، هل سأنضم إليهما وأدخل باب صناعة التماثيل؟ لم تكن هناك آراء مشجّعة لاختياري هذا الفرع. فبدأت العمل على الموضوع، التعامل مع رجل السلطة الجالس بوضعيّته المعروفة على الكرسي، وتصويره بطريقةٍ ساخرة، أنتقم منه على نحو ما، وأصنع له ثقوب في كلِّ تفصيلٍ من تفاصيل جسده، أراه مرّة كأسفنجة وأرى الثقوب مرّة أخرى كتعبيرٍ عن الأمل، بأنّ هذه الثقوب ناتجة عن تآكله وهو في طريق الانهيار.
محمد الرومي: السينما دائمًا ضروريّة
07 كانون الثاني 2022
قبل أن أدرس في كليّة الفنون الجميلة في دمشق، كنت أعمل في مجال السينوغرافيا في المسرح والتلفزيون، تحديداً في إنتاج المسلسلات، وقرّرت اختيار النحت كاختصاص لن يتطلّب مني الكثير من الوقت، كي يتسنّى لي مواصلة العمل في التلفزيون. لاحقاً تعمّقت علاقتي مع النحت كثيراً، وخاصة خلال الثورة.
في العام ٢٠٠٧، عملت على مشروع تخرّجي، تحت مسمّى "انتظار"، في ذات الفترة التي شهدت عرض مسلسل "الانتظار"، كنتُ قد تعرّفت حينها على كاتبه نجيب نصير. حينها أدركت للمرّة الأولى كيف يعالج عمل فني مشكلةً اجتماعيّة. كان مشروعي يعكس حال البلد حينذاك، الجميع في حالة انتظار. كان يتضمّن حالات إنسانيّة، يظهر أناساً يقفون في وضعيّاتٍ مختلفة.
في الأسبوع الأخير من العمل على المشروع، شعرت بأنّ هناك ما ينقص المشروع، فصنعت "ملك المنتظرين"، الذي كان بمثابة إشارة إلى من يجعل كلّ هؤلاء الناس ينتظرون.
بعد تخرّجي، نظّمت إدارة الكليّة معرضاً للمتخرجين، وقيل لنا إنّ أسماء الأسد ستزوره، لنفاجئ لاحقاً بحضور بشار الأسد وأسماء. عندما وصلا في جولتهما على الأعمال إلى حيث أضع أعمالي، لمست عدم ارتياح على وجه بشار، ولم يستطع التفاعل معي كما فعل مع الآخرين، لا سيما عندما فهم إلى ما أرمي بعملي سريعاً. كان ذاك يوماً مفصليّاً في حياتي، لأنّ المعني بعملي شاهده بنفسه، وأدركت مدى قدرة الفن على التأثير. واصلت عملي مذاك حتى العام ٢٠١١ في التلفزيون، لكنّني بت أهتم بالنحت مُذّاك.
كيف أثّرت الثورة في عملك، وما هي الأعمال التي كنت تعمل عليها، حتى اضطرارك للهرب من سوريا؟
ظلّت محاولاتي في نفس الاتجاه السياسي، محدودة نسبياً، لكن الارتباط الحقيقي بالنحت بدأ مع الثورة، التي كانت تحوّلاً عظيماً. حيث تحرّكت الشخصيّات المنتظرة في مجموعتي، وكان آخر عمل لي من مجموعة الانتظار هو عمل "سنصحو يوماً"، الذي بدأت العمل عليه في العام ٢٠١٠ تقريبًا، ولم أنته من العمل عليه أبداً. بدأت الثورة وهنا لم نعد ننتظر، لقد تحرّك البشر .
تجاوزت "الانتظار"، وأنجزت عملاً، كان فارقاً له ما قبله وما بعده، هو مجموعة أعمال طينية تحت عنوان "أحرار المرسم". حينها كنّا نشهد الكثير من المظاهرات، فتخيّلت التماثيل وهي تخرج في مظاهرة أيضاً، ونشرته على وسائل التواصل الاجتماعي مع نصٍّ، وانتشر على نطاق واسع، وكان له صدى طيّب عند الناس، على ما لمسته من ردّات الفعل التي كانت تصلني. ثم واصلت صناعة أعمال تحاكي الشارع، كعمل "أعلن انشقاقي"، "مات من البرد" و"ملك الصناديق".
نظام بشار الأسد وأشباهه هو نتاج نظام عالمي، نظام موجود ولكنّه ضعيف، مع ذلك تقف أمامه لا حول لك ولا قوة
وقبل ذلك كنت قد بتّ جزءاً من مشروع البستان، الذي أسّسه الفنان فارس الحلو في العام ٢٠٠٧، وتطوّر مُذّاك حتى العام ٢٠١١ كمساحةٍ وكفكرةٍ، وبتّ مسؤولاً عنه بعد أن اضطر فارس للبقاء خارج سوريا. كنّا نحلم بأن تنجح الثورة ونحتفل بذلك في البستان. لم تكن ماهيّة المشروع واضحة بالنسبة للنظام قبل الثورة، حتى أعلن فارس موقفه المناصر لها. العديد من الذين كانوا جزءاً من مشروع البستان اختفوا قسرياً، كالسيناريست عدنان الزراعي. عماد سعسع ومحمد ديركي ومحمد لطوف.
أصبت وأنا في مرسمي ومكان إقامتي في البستان في منتصف العام ٢٠١٣، الواقع في بساتين جرش، جرّاء قصف من طائرة مروحية، ونُقلت إلى مشفى ابن النفيس، حيث اعتبروني فوراً عنصراً من الجيش الحر، قادم من بساتين الرازي، وتعاملوا معي كإرهابي. كنت متخلّفاً عن الخدمة الإلزاميّة منذ العام ٢٠٠٧. بقيت في سجن المشفى مدّة عشرة أيام، ثم حوّلوني إلى سجن القابون، منها إلى فرع التحقيق، والشرطة العسكرية، وبقيت حوالي ٤٥ يوماً، منتصف العام ٢٠١٣. كانت فترة عنيفة للغاية، يُكدّس فيها المعتقلون في الزنازين، ويموت فيها الكثيرون. ثم ألحقوني مباشرة بالجيش. بقيت هناك مدّة شهرين ثم هربت.
قضيت فترة ليست بالقصيرة في لبنان حيث أنجزت العديد من الأعمال هناك، اضطررت لتدميرها قبيل خروجك منها إلى فرنسا، خشية التبعات. تقول في تصريحات صحفية أنّك تعزّي نفسك بأنّها على أيّة حال "قامت بوظيفتها الزمانية والمكانية"، هل تنحت لليوم أم للمستقبل ... تعبر وتتفاعل مع الواقع أم تؤرّخ؟
أشعرُ بالمسؤوليّة، كنحات في المرحلة التي أعيش فيها، وأفكّر فيما يمكنني تقديمه عبر وسيطٍ فني. أحاول مثلًا ايضاح سبب تواجدي هنا، في أوروبا، عبر النحت. في الوقت نفسه ولكن بدرجة أقل، أسعى لتأريخ هذه المرحلة.
نصوح زغلولة: ثلاثون سنة وأنا أصوّر الشام… لم تعد الشام كما هي
18 شباط 2022
بدأ تدميري لأعمالي في سوريا. بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٣، صنعت ما يقارب خمسة عشر تمثالاً من الطين، في مشروع البستان، ودمّرت ما تبقى بعد أخذ صورة لها ونشرها على صفحتي الشخصيّة. كنت أتجنّب احتمال أن يقبض الأمن عليّ، ويكسرها على رأسي، كنت أتخيّل حدوث ذلك حرفياً. بعد اعتقال أصدقائي محوت حسابي الشخصي على موقع فيسبوك، خوفًا من تبعات التحقيق.
بعد وصولي إلى لبنان أنشأت صفحة "طين وسكين"، التي باتت مساحتي الوحيدة للتعبير في فترةٍ كان عليّ فيها أن أبقى متخفيًّا، معتبراً إياها وسيلة للبقاء على تواصل بالحدّ الأدنى مع ما يجري في سوريا ومع الناس. كانت أعمالي تحمل صبغةً ساخرة، أكثر من كونها أعمال نحتية، مُرافقة لفترة جرت فيها الانتخابات في سوريا. رغم تواجدي في بيروت، لم تكن ظروفي مريحة، حيث كنت هارباً من الخدمة الإلزاميّة، ولا أملك أيّ أوراق ثبوتيّة أو إقامة في لبنان، أعيش منعزلاً ولا ألتقي أحداً، وكان الإنترنت وسيلتي الوحيدة للتواصل، لم أكن مستقراً على نحو يمكنني من العمل بشكل طبيعي وعرض أعمالي في معرض، والحفاظ عليها. في الحقيقة أنجزتُ أعمالاً في بيروت، وتعرّضت للاحتيال من قبل شخص سوري، دون أن أستطيع التحرّك ضدّه، نظراً إلى وضعي الهشّ قانونياً.
كانت تجربة بيروت عنيفة وعكس الصورة الرومانسيّة التي تخيّلتها عن المدينة، متأثّراً بمحبتي لفنانيها. بقيت فيها لعام ونصف، وكنت أنوي البقاء فيها، قريباً من سوريا، لكن الظرف ككل كان لا يحتمل، فكان تكسير الأعمال بدافع الغضب أيضاً، لأنّني لم أكن أدري أين سأتركها هناك، عند مغادرتي إلى فرنسا.
لاحقاً وبعد وصولي إلى فرنسا، حرصت على استخدام البرونز في أعمالي، وبتّ أفكّر أكثر في الاحتفاظ بهذه الأعمال. ترتبط أعمالي أحياناً بتوثيق يوم واحد أحياناً ك "هنا حلب"، أو حدث جلل، مثل "هنا قلبي" الذي يوثّق الدمار في غوطة دمشق، والمعروض في متحف لوفر لينز حالياً. هو عمل للتاريخ، وثيقة أكثر من كونه عملاً فنياً، فنحن في صراع سرديّة. شعرت بواجب سرد الحكاية من وجهة نظرنا نحن.
في فرنسا، بدأتَ العمل على أعمال تحت عنوان "مضغوط"، هل جعلتك تجربة الاعتقال القاسيّة غزير الإنتاج بعد الافراج عنك، بلورة أعمال كنت تتخيّلها ربّما في المعتقل؟
حقّق وجودي في فرنسا لي حدّاً أدنى من الاستقرار، لديّ مرسم، وأنا أتمتّع بالحريّة، وهو أهم ما في الأمر. من المؤكّد أنّ تجربة الاعتقال، التي عشتها حتى أقصاها، كانت قاسية، أثّرت على عملي بطريقةٍ أو أخرى. كان احتمال الموت يحوم فوق رأسي كلّ يومٍ حينها، بسبب إصاباتي السابقة، وحجم العنف في المعتقل. عندما خرجت شعرت بمسؤوليّةٍ أكبر، لأنّ سؤالًا عريضًا كان يدور في رأسي وأنا معتقل، عمّا يفعله الآخرون لأجلي. وأظنّ أنّ هناك آلاف المعتقلين الذين يسألون اليوم "ماذا يفعلون من أجلنا؟"
أحياناً تداهمني أسئلة، عمّا أفعله، ولماذا لا ألتفت إلى حياتي. لكنّني لا أنظر إلى نفسي كفنان، وما إذا كان لديّ رفاهية أن أتحدّث عن بلدي أم لا، لا أرى نفسي إلّا كخالد، الذي لو كان طباخاً لذهب وعمل على مشاريع متعلّقة بالمطبخ تقدّم بلده وحكايته بطريقة ما، هي مسؤوليّة وليست رغبة.
يوسف عبدلكي: لا شيء يسير على ما يُرام وسط هذا الرماد
04 أيلول 2023
أخاف أن يخرج أحد أصدقائي من المعتقل يوماً ويقول ما الذي فعلتموه لأجلنا؟ لم تنته "القصة" في سوريا بالنسبة لي، خرجت يوماً في ثورةٍ وأعرف أنّ النظام عنيف للغاية، والفاتورة ستكون كبيرة، لكنّني لا أستطيع القول إنّني حاولت لفترةٍ ولا أقدر على المواصلة. وهناك الكثيرون مثلي، ممّن لديهم بصيص من الأمل.
عودة إلى عملك "هنا قلبي" الذي أشرت إليه آنفاً، ما هو دافعك للبدء بصناعته، أين وصلتْ رحلة عرضه، وهل تنوي المضي في نحتِ أعمالٍ مرتبطة بموضوعة الدمار؟
عندما سقطت حلب في يدِّ النظام السوري وحلفائه، صنعت عملاً بعنوان "هنا حلب"، يصوّر مجزرة. ثم عندما سقطت غوطة دمشق نهاية العام ٢٠١٨، فكّرت بأنّ عليّ صناعة عمل أيضًا. كان حدثاً لا أستطيع استيعابه، ووجدت في نفسي رغبةً في التعبير، وفكّرت في صناعة عملٍ شبيه ب "هنا حلب"، ثم ارتأيت أنّه ينبغي عليّ صناعة عمل مختلف، ولهدف مختلف.
كما نعلم، دمّر النظام نصف مدينة حماة في الثمانينيات، وأخفى كلّ ما دمّره خلال فترة قصيرة. وبالمثل كان لما جرى في غوطة دمشق في العام ٢٠١٨، عميق الأثر عليّ. خشيت أن يستطيع النظام الخبير في إخفاء آثاره، إخفاء ما فعله في الغوطة، وهنا بدأت العمل على عمل "هنا قلبي"، دون خِطّة مُسبقة وبدون الاستناد إلى صور أو فيديوهات. تخيّلت الحارة بكلِّ تفاصيلها. لم أكن أريد أن أنسخ حارة موجودة مسبقًا بل استعنت بخيالي وذكرياتي عن الغوطة والحياة السوريّة عموماً.
تصوّرت ذهابي إلى سوريا وجلب قطعة منها إلى فرنسا لأجعل الناس تشاهد ما الذي تعنيه الحرب، وأن تُدمّر حارة بأكملها، وما الذي دفع ملايين الأشخاص للقدوم إلى أوروبا، منهم سيدة مسنة سبعينية، لا تخطّط بالتأكيد للاستيلاء على الوظائف في الغرب.
أقول للزوّار بأنّني لم أصوّر الدمار بأقصى بشاعته، فالدمار أكبر من ذلك بكثير، ولكني سعيت إلى احترام أدق التفاصيل في كلِّ منزلٍ من أثاث، وإكسسوار، وصور، وجميع العناصر المتعلّقة بالحياة اليوميّة.
يقدّم العمل بطريقةٍ خاصة في المعارض، في غرفةٍ مظلمة نسبيّاً، مُضاءة بضوءٍ خافت، لأنّ العمل يصوّر المكان في ليلة صيفٍ مقمرة. أقدّم من خلاله ثقافة "الحارة" لدينا، بما فيها من مطاعم ومحال، حيث نسهر ونحتفل بليالينا. لا أخفيك بأنّني أحيانًا أجد نفسي مضطراً للإجابة على أسئلةٍ غريبة من الفرنسيين على نحو "هل هناك أبنيّة في سوريا؟ هل كنتم تحتفلون؟".
أنا أنحت ما أعيشه في الواقع، متبعاً الفطرة والغريزة، ولا أتبع منهجاً أو مدرسة فنيّة، على عكس عملي في السينوغرافيا، الذي أعتمد فيه على منهج. بدأت بالعمل على "هنا قلبي" على طاولة العمل خاصتي، التي لا يتجاوز أبعادها المترين في متر، وصنعت حائطاً من جبصين وحائطاً من طين، ثم تركت لنفسي الحريّة في المضي في العمل دون خِطّة. فقدت السيطرة على ما أصنعه إلى حدٍّ ما، وانتهيت بعملٍ من ستّةِ أمتار ومُكوّن من ثلاث طوابق، وتعلّمت الكثير خلال أعوام ثلاث، عملت فيها على التمثال. خلال تلك الفترة، كان يزورني فرنسيون ويتحدّثون عن مشاهدة شبيهة على التلفزيون، ثم يلاحظون عند إمعان النظر في التمثال، وجود كتب لمحمود درويش، وعبد الرحمن منيف، وغابرييل ماركيز، وسيّدة مسنة تجلس أمام باب، وسرير... مقاربة مختلفة لتصوير الواقع في سوريا، بعيدة عن المشاهد، التي أخذت شكلًا استهلاكيًا في سياقٍ يومي من مشاهد دمار متكرّرة.
كلِّ ما في العمل متخيّل. لكنّني ولدت وأمضيت جزءاً من طفولتي وشبابي في دمشق، وبدأت ببناء التمثال على النحو الذي تُبنى فيه العشوائيات هناك دون الرجوع لمهندسٍ أو دون اتباع طرق البناء. في مراحل متقدّمة من العمل، تخيّلت عائلات حقيقيّة تعيش في كلِّ بيتٍ من التمثال، منهم مثلاً علي مصطفى، أبو صامد، والد الناشطة وفا مصطفى، المُختفي قسرياً من قبل النظام السوري منذ أكثر من 11 عاماً. لأبو صامد دور كبير في تنشئة أجيال كاملة في مصياف. شخصيًا، كان يشجعني بشكلٍ دائم على ضرورة إنهاء دراستي والسعي لدخول كليّة الفنون الجميلة. أخذت صورته وصور عائلته وتخيّلت شكل بيتهم. وبالمثل عملت على تخيّل منزل المعتقلة المختفية قسرياً، رانيا العباسي وعائلتها، وبقيّة البيوت كذلك وساكنيها.
أخاف أن يخرج أحد أصدقائي من المعتقل يوماً ويقول ما الذي فعلتموه لأجلنا؟ لم تنته "القصة" في سوريا بالنسبة لي، خرجت يوماً في ثورةٍ وأعرف أنّ النظام عنيف للغاية، والفاتورة ستكون كبيرة، لكنّني لا أستطيع القول إنّني حاولت لفترةٍ ولا أقدر على المواصلة. وهناك الكثيرون مثلي، ممّن لديهم بصيص من الأمل.
عُرض العمل للمرّة الأولى فيما يسمّى "المدينة الفنيّة في باريس Cite des arts internationale، paris"في معرض نُظِّم من خلال "جمعية الأبواب المفتوحة " ثمّ تمّ اقتنائه من مؤسّسة فنية وتمّ منحه لمتحف (Mucem) في مرسيليا، ثم بات جزءاً من المجموعة الوطنيّة الفرنسية. لم أجعله في عهدة جهة واحدة، بل في عهدة فريق مكوّن من عدّة أشخاص وجهات، من دول مختلفة، أثق وأحبّ العمل معهم. عُرض حتى الآن في ثلاثة متاحف في السنوات الثلاث الأخيرة، ويتواجد الآن في متحف اللوفر لانس.
ما يميّز العمل، من زاويتي كفنان، أنّه يُعتبر "عملاً غير منته"، ما يعني قدرتي على العمل عليه ما دمت على قيد الحياة، ولهذا يحق لي العمل أو إضافة أيّ تفصيلٍ جديد في أيّ متحف جديد أذهب إليه أثناء التحضيرات النهائيّة للمعرض، ما يسمح لي بخوض تجربة خاصة في المتحف الذي يستقبل العمل. ما زلت عمومًا متحكّمًا في العمل والأماكن التي يُعرض فيها، لأنّ للعمل حكايته بالنسبة لي، ويعني لي ولأصدقائي الذين ساعدوني كثيرًا في نقله وإتمامه.
كنت أتخيّل خلال بنائه أين هبطت القذيفة وماذا حطّمت. أصمّم الكرسي كما يفعل النجار وأحطّمه، كي يبدو حقيقياً قدر المستطاع، وأفكر في ماهيّة سكان كلِّ بيتٍ، هل هم إسلاميون، أم يساريون، أم يمنيون. كان يشغل حيّزًا كبيرًا من مرسمي. تسعدني تعليقات الزوّار عليه، وتخيّلهم بأنّها حارتهم. كانت وسيلتي أيضاً لأدرك وأستوعب ما جرى في بلدي من تدمير بعد العام ٢٠١٥، وخاصّة في دمشق، التي تربطني بها علاقة خاصّة، لذلك كانت خسارة الغوطة وعودتها لسيطرة النظام خسارة فادحة بالنسبة لي. ما زلت إلى اليوم مشغولاً بالعمل، وأخصّص له الوقت اللازم. أفكر في إنجازِ عملٍ جديد ولكن لهدف مختلف، مرتبط بالسينما.
تقول بأنك ما زلت ذهنياً داخل البلد سوريا، وإن كنت تعيش في فرنسا، وتتفاعل مع الوضع هناك، هل تواجه مشكلة مع جمود الوضع السوري؟
هجرتنا الجماعية لم تكن قائمة على رغبة، ولكنّنا، كما تعلم، أُجبرنا على ذلك. بالتأكيد لديّ مشكلة مع حالة الجمود في الوضع السوري، كحال جميع السوريين، الراغبين في الانتهاء من هذا الكابوس. هناك مبادرات سياسيّة كثيرة، لا تكتمل، كما أنّ هناك إهمال للقضيّة السوريّة من قبل جميع الأطراف، لعلّ أهمها "نحن السوريون/ات".
أعود من وقتٍ إلى آخر إلى ثيمة الانتظار التي شغلتني قبل الثورة. الظروف المحيطة بنا أعادتني إليها رغماً عنّي، ولكن علينا نحن الموجودون في الخارج، ونتمتّع بمساحةٍ من الحريّة والأمان، تقديم طروحات مختلفة، مرتبطة بالنجاة، بالمستقبل، بصناعة الأمل، الاحتفاء بالحبّ والحياة. هو صراع أعيشه يوميًا بأعمالي، لا بدّ أن نستمر.
خشيت أن يستطيع النظام الخبير في إخفاء آثاره، إخفاء ما فعله في الغوطة، وهنا بدأت العمل على عمل "هنا قلبي"، دون خِطّة مُسبقة وبدون الاستناد إلى صور أو فيديوهات.
هذا ما يتبيّن للمتتبّع لأعمالك خلال السنوات العشر الماضية التي قضيتها في فرنسا، أنّها سورية خالصة تقريباً. هل حاولت أو فكّرت في التفاعل مع محيطك الفرنسي في أعمالك؟
أعمل أكثر مع الفرنسيين، من تعاوني مع معارض عربية. أعيش في هذا البلد منذ عشرة أعوام، قضيت فيها نصف شبابي، ويشغلني بالطبع هذا المجتمع، الذي بات يشغلُ جزءاً من ذكرياتي، لكنّني ما زلت مشغولًا بالهم السوري، وإيصال القضيّة السورية للوسط الفرنسي الذي أعيش فيه عبر أعمالي. أعتقد أنّ جلّ ما يرونه على وسائل الإعلام فيما يخصّ سوريا، مرتبط بالجهاديين والإرهاب، والقليل عن المجتمع السوري أو الثورة، وتُطرح القضيّة السوريّة في الكثير من الأحيان عبر ثنائيّة نظام الأسد وداعش. أعيش على نحو طبيعي، محاطًا بعددٍ من الأصدقاء السوريين والفرنسيين، لكن الحياة الاجتماعية هنا مختلفة. لم تعد اللقاءات مع الأصدقاء تشبه تلك التي عشناها في سوريا.
الفن والمجتمع في سورية.. ملامح أولية
من هو جمهورك في الأثناء، تصنع أعمالاً تتوجّه بها للجمهور الأوروبي أم تحكي مع جمهور الثورة؟
أعتقد بأنّني أتوجّه للطرفين. عندما أصنع أعمالًا مرتبطة بسوريا، أحاول القول عبرها لأهلنا في سوريا بأنّنا لم ننساهم. تعني لي الكثير الرسائل التي تصلني من سوريا، من أصدقاء أو أناس لا أعرفهم، عن تأثّرهم بعملي. لكنّني بتّ في هذه الأثناء أُولي اهتماماً بالجمهور الأوروبي، لأنّ أنظمة هذه البلدان هي التي تمكّن الديكتاتوريات من الاستمرار، ومن الأهميّة بمكان توعيتنا هذا الجمهور بمدى حساسيّة التطبيع مع الديكتاتوريّات في منطقتنا.
أفكّر أنّه إن عدت يوماً ما إلى سوريا، لن أعود هكذا ببساطة وأنهي أعمالي في فرنسا، بل سأحاول أن أفيد بلدنا عبر عقد شراكات مع جهاتٍ فنيّة فرنسيّة مثلاً، لتأسيس وتطوير مشاريع في سوريا. لذا أجد تواصلي وعملي مع المجتمع الفرنسي مفيداً على مختلف الأصعدة. أُؤْمِن للغاية بدور الفنان في المجتمع.
عطفاً على إيمانك هذا بدور الفنان، وتركيزك أكثر على الجمهور الأوروبي، هل يراودك شعور بأنّه بات من الصعب التأثير، وربّما المساهمة في التغيير في الوضع السوري، كما كان الحال قبل العام ٢٠١٤؟
الوضع صعب ومعقّد ليس بالنسبة لنا نحن السوريون/ات، وإنّما في كلِّ المنطقة العربيّة، مع ذلك أرى أنّه إن كانت هناك مساهمة حقيقيّة للتغيير، فيجب أن تكون سوريّة بامتياز. لا أرى أنّ لدينا رفاهيّة التفكير إن كان هناك من جدوى أم لا، ينبغي علينا العمل ومواصلة بناء خبراتنا ومعرفتنا. التغيير يأتي بالتراكم والإيمان بحقّك وقضيّتك، هذه ليست شعارات، بل وقائع ندركها بالتمعن في تاريخ نضالاتِ الشعوب وصراعاتها من أجل حريتها واستقلالها، لا بدّ لنا من الاستمرار في العمل. لذلك أعتبر أنّ الجميع مطالب بالمساهمة، وخصوصًا الطبقة المثقفة، التي لديها امتياز التأثير، لكنها تتحمّل مسؤولية أكبر في الوقت نفسه.