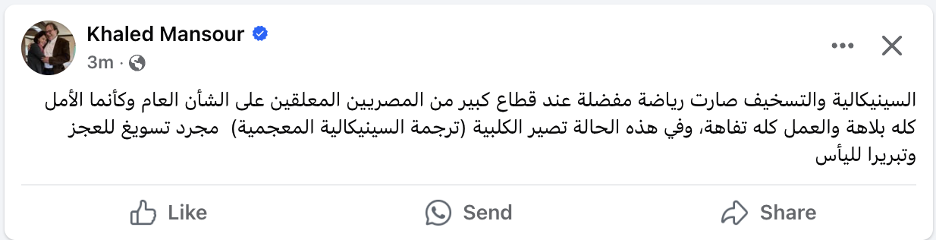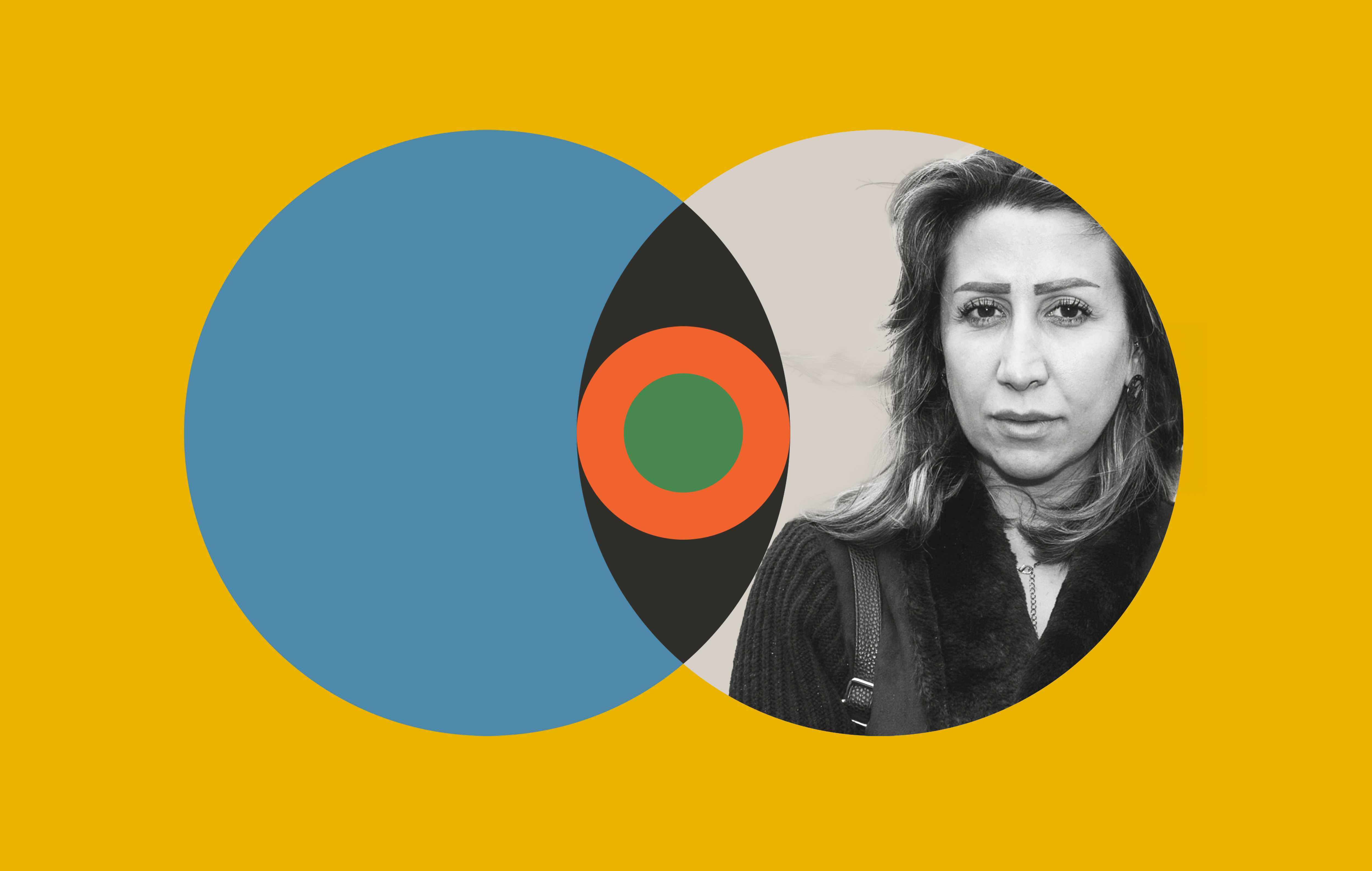اليوم ال 8894 من حكم بشار الأسد في سوريا، واليوم 412 من الإبادة الإسرائيلية لسكان قطاع غزّة
"كيف يحافظ السوري على عقله في هذا الجنون؟ مستوياتٌ غير مدركة من الجنون! كيف يحافظ الإنسان عمومًا على عقله في هذا الجنون؟"
بهذا السؤال الاستنكاري ختم المفكّر اليساري السوري، ياسين الحاج صالح مداخلته في أمسية ثقافية برلينية في الثاني والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر، حيث جلستُ ليلتها بين كومةٍ من الكراسي الخالية، إلا من عددٍ قليلٍ من الحضور الذين جاؤوا للاحتفاء باقتراب الذكرى الأربعين لرحيل الأديب اللبناني إلياس خوري. كان الصحفي والأكاديمي والروائي فارق الحياة عن عمر ناهز السادسة والسبعين، قبل أيّام قليلة من توسّع حرب الإبادة الإسرائيلية ضدّ سكان قطاع غزة، وامتداد العمليات العسكرية إلى لبنان، تحديدًا في الخامس عشر من أيلول/ سبتمبر.
"في تلك اللحظة من الحضيض السياسي"، كما وصفت الباحثة الفلسطينية همّت الزعبي، حاولت "شبكة فبراير" وموقع "الجمهورية" السوري تسليط الضوء علي إرث خوري الثقافي والنضالي الذي قدّم نموذجًا في توثيق ذاكرة النكبة الفلسطينية الموجودة خارج دفاتر التاريخ الرسمي على لسان معاصريها باستخدام تقنيات التاريخ الشفهي. وجاءت أعماله الأدبية كما وصفه المتحدثون "لتقدم نموذجًا عضويًا يربط بين فلسطين ولبنان وسوريا كمنطقة عابرة للجغرافيات في نضالها ضدّ استبداد الحكم البعثي والاحتلال الإسرائيلي"، مستطردين بوصفها ك "منطقة أكبر من الاختزال تحت كلمتي الشرق الأوسط".
الساعات الأول: سوريا بدون الفارّ - "الأبد خلص"
كان المنشور المُتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي كتبه الحاج صالح، مصحوبًا بصورة زوجته سميرة الخليل، والناشطة والمحامية رزان زيتونة، ونشطاء آخرين مؤيّدين للثورة السورية، والذين اختطفوا نهاية العام 2013. كان ذلك أوّل ما قرأت على وسائل التواصل في الساعات الأولى من تداول الخبر الحُلم؛ المستحيل.

على مدار الأيّام العشرة السابقة لتحقّقه٬ عايشتُ حالة انتظار يغلب عليها عدم تصديق إمكانية تحقّقه. من غرفة معيشتنا في برلين، كان زوجي السوري يقضي ليالي أرقه أمام التلفزيون، وعبر الهاتف في مكالماتٍ ورسائل متبادلة، متابعًا تحرير مدينة سورية تلو الأخرى من قبضة نظام بشّار الأسد مذهولًا من تسارع الأحداث، ومذعورًا من "تقسيم البلد" التي لم تطأ قدماه أرضها منذ عشر سنوات. وكان عليه مثل ملايين من السوريين/ات في منافي ما بعد ٢٠١١ التحايل على طوفان ذكريات الوطن، الحارة وبيته، ومحاولة تناسي استحاله زيارته، تحت حكم الاسد٬ هذا ما صارحني به لأوّل مرة عندما احتضنني وبكينا مع تأكّد الخبر: "بشار هرب!".
اليوم الأول: سوريا بدون الفارّ " - راجعين"
فهم التهديدات التي تواجه سوريا الديمقراطية والتقدمية اليوم
04 كانون الثاني 2025
كانت هذه الكلمة الأولى والأخيرة التي تردّدت في اللحظة ذاتها على لسان شابين سوريين تقدّما بخطواتٍ متسارعة نحو بعضهما قبل أن يشتبكا في عناقٍ طويل، ويبدآا بالنحيب، نحيب أسمعه من موقعي المجاور لهما، الذي سأبدو فيه من طائرة درون كنقطةٍ صغيرة تتوسّط ميدان أورانينبرغر بلاتز، وسط مدينه برلين، يمكن تمييزها فقط، ضمن بحر شاسع من البشر المُحتشدين حاملين أعلام الثورة السورية، عبر علمي المصري الذي يتدلى على ظهري.
لم أكن المتطفّلة الوحيدة على آلاف السوريين/ات الذين فاضت بهم شوارع برلين، سواء على الأقدام أو في مواصلاتها العامة أو في سيارات خاصة تطلق أبواقها، احتفالًا بالنصر٬ وتصدح من أجهزة الكاسيت فيها، أغاني عبد الباسط الساروت.
"أنا عشت في سوريا لثلاث أعوام". عبارة سمعتها بالإنجليزية تقولها شابة شقراء لمرافقتها، أثناء مرورهما قربي في أحد الشوارع الجانبية القريبة من مكان المظاهرة. وبالألمانية أكّد رجل خمسيني لمحدّثه " يعيش في ألمانيا أكثر من مليون سوري".
بدت برلين بحق في ذلك اليوم أقرب ما يكون إلى اسم صفحة فيسبوك "عاصمة السوريين في ألمانيا، وعندما أشير إلى السوريين في الشتات فأنا أعني “الفسيفساء السوري"، التعبير الذي وظّفه الأسد في خطاباته الملوّحة بالطائفية في حربه ضدّ الإرهاب وسخر منه السوريين مرارًا في أحاديثي معهن بدءًا من مجموعة السيّدات المُحجبات اللاتي التقيتهن في المترو، وبادلوني التهاني والابتسامات ب "مبروك للمسلمين جميعًا"، إلى إحدى معارفي، وهي خبيرة منظمات مجتمع مدني، تنتمي لمجتمع الميم. منتفخة الوجه، احتضنتني في منتصف الشارع قائلة: "ما عاد حدا يقول السوريين ما يقدروا على شي".
كلُّ حدثٍ، وكلُّ مشهدٍ، وكلُّ قصّةٍ نوثّقها كانت تضيف طبقة جديدة إلى ذاكرةٍ جماعية مُثقلة بالصدمة.
وعند الوصول إلى الميدان، حيث توافد المنتشون والمشتاقون إلى فرحةٍ غامرة كهذه، وجدت نفسي أتحرّك كنقطةٍ تكاد لا تُرى وسط آلاف السوريين/ات الذين شكّلوا دوائر متقاطعة. في كلّ دائرة، كانت الأصوات ترتفع بأغانٍ وهتافات تحمل طابعها الخاص . في إحداها، هتافات علي رقصة الجوفية المألوفة في الجنوب السوري وشبه الجزيرة العربية تصدح بقوّة، فأتركها وأتجه إلى أخرى. هناك، يردّد شبان على الأكتاف بصوت عال: "يلعن روحك يا حافظ"، ذلك الهتاف الذي طالما سمعته في مظاهرات مساندة لحراك السويداء الذي اندلع في آب/أغسطس 2023 . وفي دائرة أخرى، تردّد الجموع بصوتٍ واحد: "أرفع راسك فوق.. أنت سوري حر".
ما بدا غير مألوف لي، كمصرية متطفلة، كان أمرًا لا تكاد تصدقه آذان مرافقيّ السوريين: أغاني الثورة السورية، "جنة جنة" لعبد الباسط الساروت يدندنها شباب مراهقون بملامح عربية ولكنهم يتحدثون فيما بعضهم بالألمانية وهم يهمون بمغادرة عربة المترو، و"يا حيف" لسميح شقير، تُبث علنًا في شوارع برلين، وتُعرض على شاشاتِ المطاعم بينما ننتظر وجباتنا الساخنة في نهاية يوم الاحتفال. بالنسبة لهم، كانت تلك اللحظة أكثر من مجرّد احتفال؛ كانت إعلانًا صاخبًا باستعادة سوريا، وإن كان بشكل رمزي.
وفي طريق عودتي إلى منزلي، كنت أتابع منصّات التواصل الاجتماعي لأجد منشورًا للكاتبة السورية المقيمة ببرلين، على فيسبوك. وهو ما تردّد صداه في اقتباس من حديث الكاتبة السورية الإيرلندية سعاد الدرة لصحيفة آيريش تايمز، قالت: "في تلك اللحظة، أدركت أننا لم نعد لاجئين أو نازحين. نحن أحرار ولدينا وطن نعود إليه، ونري أطفالنا أن سوريا ليست مكانًا خياليًا."
اليوم الخامس: سوريا بدون الفارّ - "العودة إلى الحياة"
تجاورت وتتابعت هذه الكلمات الثلاث في محاولة لاختزال لحظة احتشاد عشرات الآلاف من السوريين في وضح النهار، تحت شمس دمشق الساطعة، مشكلين دائرة في ساحة الأمويين وخلفهم جبل قاسيون الشامخ. جاء ذلك الوصف مصاحبًا لصورة متداولة على فيسبوك للمحتشدين في العاصمة السورية. كنت أقرأ تعليقًا على تلك الصورة: "عنجد رجعت لنا الروح".
بينما كنت أستغرق في قراءة التعليقات، وصلني أخيرًا ردًّا على رسالتي للاطمئنان على إحدى معارفي في دمشق، شابة في منتصف العشرينات . التقيتها في رحلتي الأولى إلى سوريا قبل عام ونصف، وعرفت قصّة نزوح عائلتها من إدلب إلى السويداء، وكيف كانت تحاول أن تبدأ من جديد كطالبة سنّية ترتدي الحجاب في مدينة ذات أغلبية درزية، قبل أن تنتقل إلى دمشق لمتابعة دراستها الجامعية والعمل: "مسا الخير يا بسمة.. آسفة والله بس احتفالات."
اليوم الثاني: سوريا بدون الفارّ - طلة على جحيم "الآخرين"
كنت قد غادرت للتو غرفة مكتبي في استراحة قصيرة من متابعة التعليقات المتدافعة على فيسبوك من عدد من معارفي المصريين، تعقيبًا على مظاهر الفرح الغامرة للسوريين/ات في ربوع الأرض، داعين إلى التشاؤم من مستقبلٍ يحكمه الإسلاميون، في بلد سيُقسَّم طائفيًا كجيرانه العراق ولبنان، كما عبّر أحد الصحفيين: "أخيرًا رحل بشار... لكن المستقبل في سوريا ضبابي".
منشور على موقع فيسبوك للكاتب المصري خالد منصور تعليقًا على ردود فعل بعض المصريين على فرحه السوريين.
عن معتقل صيدنايا ووثائقنا .. هل كان بالإمكان تفادي الوضع الكارثي بُعَيدَ سقوط النظام؟
23 كانون الأول 2024
دفعت باب غرفة المعيشة حيث لم تنفض خيمة الثورة التي كان قد نصبها شريكي السوري أمام شاشة التلفزيون مع تقدّم قوات "ردع العدوان"، واستمرّت بعد هروب بشّار الأسد، فإذا به يصرخ في وجهي للمغادرة: "مش هتستحملي تشوفي الصور دي"، في إشارة منه إلى التغطية الإعلامية المباشرة من قاع الجحيم المعروف بسجن صيدنايا. في محاولة مني لتخفيف وطأة اللحظة، مزحت قائلة: "ما أنت عارف، يا ما دقت على الرأس طبول".
وإن كنت بالطبع لم أشهد في عملي الصحفي الميداني في مصر بين ٢٠١١ و٢٠١٦ شيئًا مشابهًا، إلا أنّ تحذيره لي من أثر الصور والشهادات المتدفقة من صيدنايا أعادني بالذاكرة لأكثر من خمسة عشر عامًا إلى الوراء، تحديدًا في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر 2011.
أرى أمام عيني الآن تلك الصحفية المستجدة ذات الثانية والعشرين عامًا، القادمة من الأقاليم، التي مضى بضعة أشهر على التحاقها بواحدة من أكبر الصحف المصرية الخاصة في القاهرة. كانت تجلس أمام اللابتوب على طاولة ممتدّة تأخذ شكل الغرفة المربعة، وعلى يمينها وعلى يسارها صحفيون/ات، وظهرها لغرفة أخبار تعجّ بالمحرّرين المُمسكين بهواتفهم لمتابعة الأخبار الواردة من المراسلين على الأرض، عن الأقباط المتجمهرين في محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون الحكومي (ماسبيرو) بوسط القاهرة، للتنديد بالاعتداءات المتكرّرة على الكنائس.
شرح فهمي أنّ تعامل النظام المصري وقطاع من الشعب مع ثورة يناير وكأنها لم تحدث يمكن فهمه ضمن سياق الصدمة. وأوضح أنّ المجتمعات التي تمرّ بصدمة تميل إلى التجمّد والتظاهر بأنّ الألم غير موجود، لأنّ مواجهة مصدر الألم بشكل مباشر تكون أشدّ قسوة من قدرتها على التحمّل.
في محاولة لربط الكلمات المتناثرة على ألسنة المحرّرين، مستعيدين ما ينقله المراسلون على الجانب الآخر من خطوط الهواتف المحمولة في تغطيّةٍ آنية للأحداث، حيث تحوّلت مظاهرة سلمية لاشتباك مع قوّات الجيش٬ بدأتْ تتصفّح وسائل التواصل الاجتماعي. رأيت صور ومقاطع فيديو لجثث وأشلاء بشر وآثار دماء على الجدران، في محيط المبنى الضخم المطلّ على كورنيش النيل الذي وطأته قدماي مرّة أو مرّتين في رحلةِ بحثٍ عن فرصة للعمل الصحفي قبل 2011.
ركلة في المعدة واختناق في النفس، هذا ما شعرتْ به قبل أن تُسرع إلى الحمّام للتقيؤ. لكن لم أتقيّأ حينها، ولا بعدها، رغم كلّ مشاهد العنف التي تلاحقت في مصر بعد 2011، كصحفية أو كمواطنة. في ذلك الحمام الرخامي الفاخر، ابتلعت "صدمتي" ابتلاعًا وعدت إلى غرفة الأخبار أزاحم صحفيين آخرين للفوز بتصريحات عاجلة من محللين سياسيين وناشطين ثوريين للتعقيب على الأحداث٬ التي سُجّلت في تاريخ ويكيبيديا، مرّة تحت "مذبحة ماسبيرو" ومرّة أخرى تحت "أحداث ماسبيرو". في كلتا الحالتين راح ضحيتها ثمانية وعشرين قبطيًا، تمّ التوثّق من أنّ اثني عشر منهم قتلوا دهسًا بمدرعات الجيش، وسبعة بطلقات نارية في الصدر أو الرأس، فيما أصيب مئتي شخص.
اليوم الخامس: سوريا بدون الفارّ - "السوريون سبق صحفي!"
منمنمات فكرية في مرحلة "ما بعد سوريا الأسد"
14 كانون الأول 2024
منذ تتابع الأخبار عن جحيم الأسد تحت الأرض من اليوم الثاني لفراره إلى روسيا، لا أتذكر أننا أغلقنا شاشة التلفزيون المعلّقة على حائط غرفة المعيشة على مدار الأيام التالية، إلى أن شاهدت تقرير مراسلة قناة الحدث، متجولةً في زيّها الأسود المتأنّق بكعب عالٍ كالمسمار، تزيح من طريقها باقي الملابس الرثّة للمعتقلين المفترشين الأرض والمعلّقة على حوائط الزنزانة!
تلك "الجولة الحصرية لقناة العربية داخل أحد سجون الأسد" أعقبها تقرير آخر من أمام صيدنايا مع معتقلين سابقين، حيث يسألهم المراسل السوري في ملابسه الشتوية المتواضعة، "أن يصفوا له بشكل دقيق كيف كانت تجربتهم في التعذيب".
سوريا التي كانت قُمقُمًا مغلقًا لسنوات أمام الإعلام العربي والغربي، باستثناء قلّة من المراسلين الحربيين، تحوّلت بين ليلةٍ وضحاها إلى "مكة"، فأصبحت شوارعها ومدنها المحرّرة من قبضة الأسد محجًا لعدد لا يُحصى من "مراسلي الباراشوت/المنطاد"، الذين كنت علمت بوجودهم واندثارهم في سوق الصحافة الدولية من محاضر بريطاني ومراسل سابق لبي بي سي أثناء دراستي ماجستير لصحافه الحرب والنزاع في بريطانيا قبل سنوات، ولكن ها هم يهبطون فجأة لتغطيّة "القصّة السورية"٫ ليتوارى الصحفيون/ات السوريون/ات المحليين إلى كواليس صناعة القصّة السورية، بعد أن خاطروا بالكثير لإخبار العالم بما يحدث منذ 2011، كما قال الصحفي السوري حسام حمود.
"أخذوا كل شيء بين ليلة وضحاها. غمرت وسائل الإعلام الأجنبية الساحة، وبدأت تكتب عن سوريا وكأنّنا لم نكن موجودين. وكأنّ سنوات تضحياتنا لم تكن تعني شيئًا"، كما أخبرت واحدة من الصحفيات السوريات حمود.
وهو ما استفز الكاتبة السورية/الإيرلندية سعاد الدرة فنشرت يوم الثاني عشر من كانون الأوّل/ديسمبر، على حسابها على إنستغرام منشورًا بالإنجليزية، جاء بمثابة بيان للردّ على طلباتِ الصحفيين/ات الذين تهافتوا عليها خلال الأيّام الخمسة الماضية. جاءت طلباتهم ضمن ثلاث موضوعات لا يحيدون عنها: السجون، والعودة إلى سوريا، والجهاديون/داعش.
كما هي الحال مع التغطية الإعلامية للقصّة السورية، غالبًا ما تضيع قصص شعوب منطقتنا وسط الأحداث التاريخية الكبرى، أو تُختزل بتعقيداتها في كلمتين مثل "الربيع العربي"، و"الانقلاب العسكري"، و"الانتفاضة الفلسطينية".
استهلت الدرة منشورها: "لطالما استخدمت صوتي الحر وقلمي لأشارك القصص المهمة وأغيّر السرد. لقد اعتدت على جميع أنواع ردود الأفعال أو الأسئلة التي قد تكون عنصرية أو غير حسّاسة أو ساذجة. ولكن مؤخرًا، ومنذ التطوّرات المذهلة الأخيرة في سوريا، تلقيت العديد من الطلبات الإعلامية بطريقة لا يمكن وصفها إلا بأنها غير مهنية."
واختتمت منشورها، الذي عنونته بـ "السوريون ليسوا سبقًا صحفيًا"، قائلة: "إذا كنتم تبحثون عن سوري عشوائي لإنهاء مهمتكم لهذا اليوم، فأنا لست متاحة. ولا، لن أوصلكم بسوري آخر للرد عليكم."
سقط النظام .. لكن عائلة كوردية سورية تواصل ماراثون نزوحها اللا منتهي (صور)
17 كانون الأول 2024
اليوم الرابع عشر: سوريا بدون الفارّ - القصص السورية ملتبسة
على بعد أميال من سوريا المنشغلة حاليًا بسؤال الانتقام والعفو والعدالة الانتقالية من المتواطئين مع عائلة الأسد لإحكام قبضتهم على الشعب لعقود، كانت صديقتي السورية، التي وُلدت لعائلة علوية في إحدى القرى المجاورة لمسقط رأس حافظ الأسد، القرداحة، تواجه إرثًا ثقيلًا في قلب برلين، بين زملاء مقاعد الدراسة السوريين في جامعتها.
"تريدين الآن أن تكوني ناقدة؟"، حسم هذا السؤال الاستنكاري على لسان أحد زملائها السوريين/ات نقاشًا محتدمًا حول تقرير بثته قناة سي إن إن، يُظهر الإفراج عن معتقل سوري زُعم أنه ضحيّة النظام. صديقتي، التي أبدت تشكيكًا في صحة التقرير، عُدّت على الفور مدافعة ضمنيًا عن النظام. تبيّن لاحقًا أنّ التقرير مفبرك، وأن السجين كان عنصرًا في أجهزة أمن النظام.
صديقتي، التي تقضي سنواتها الثلاثينية وسط محاولات متواصلة لإعادة بناء حياتها بعد رحلة لجوء خطيرة إلى ألمانيا، قالت لي: "المفروض ندفع الضريبة مرتين"! في إشارة إلى معاناتها الشخصية؛ نبذها وسط الطائفة العلوية بسبب انتماءات والديها الشيوعيين وسجنهم، ومواجهة أفراد عائلتها المتبقين في سوريا تهديدات واستفزازات مشابهة بسبب خلفيّتهم الطائفية مثل ما حدث مؤخرًا مع آخرين من الطائفة العلوية.
وأضافت: "كنت أعتقد أنه بذهاب الظلم، ستصبح القصص أوضح!". وبعد لحظة من الصمت، قالت: "أفهم طبعًا عندما تتسبّب لهجة ما لك بعقدة نفسية"، في إشارة إلى اللهجة العلوية المميّزة، التي باتت رمزًا للخوف أو الكراهية لدى كثيرين من السوريين/ات.
العام الأوّل: مصر بدون مبارك، "لا لهدم الذكريات"
(بطاقة بريدية حصلت عليها أثناء حضور ندوة أُقيمت في مبنى الجامعة الأمريكية بوسط القاهرة حيث حفلت أروقتها بالعديد من الفاعليات الثقافية حول تداعيات ثورة يناير تظهر فيها صورة للمقرّ الرئيسي المُحترق للحزب الوطني الحاكم، بعدسة المصور محمود خالد. على الجانب الآخر من التذكار، عبارة "لا لهدم الذكريات")
العام التاسع : مصر بدون مبارك، شعب مصدوم
كنت أجلس أمام شاشة اللابتوب في غرفتي ببرلين، في جلسةِ علاجٍ نفسي عبر الإنترنت تموّلها منظّمة دولية تعمل في مجال حماية الصحفيين. أوضح لي محدّثي اللبناني أنّ الحادثة التي وقعت قبل ثماني سنوات، والتي شهدتها عن بعد من غرفة الأخبار، محفورة بوضوح في ذاكرتي لأنها من المرّات التي تعرّضت فيها لما يُعرف بـ "صدمة بالإنابة" بسبب عملي الصحفي، أو كما تُسمّى بالإنجليزية "vicarious trauma".
وكحال الكثير من الصحفيين والمواطنين في مصر بعد 2011، تراكمت تلك الذكرى مع ذكريات أخرى، بعضها عشناه بشكلٍ مباشر، وبعضها شهدناه عبر عدسات الكاميرا وشاشات الكمبيوتر. كلُّ حدثٍ، وكلُّ مشهدٍ، وكلُّ قصّةٍ نوثّقها كانت تضيف طبقة جديدة إلى ذاكرةٍ جماعية مُثقلة بالصدمة. هذه الذاكرة التي تخصّ مصر، وجيلنا، والصحافة في تلك الفترة، تتأرجّح بين نقيضين: "ذكريات حاضرة بكلّ تفاصيلها أو "فقدان ذاكرة تام".
كنتُ الشريكة التي أرى نظام الأسد على سريري في برلين متسللًا إلى كوابيس شريكي السوري، ليوقظه في منتصف الليل من سباته.
كان هذا التوصيف الذي سمعته في سياقٍ مختلف تمامًا، عندما استمعت إلى سيدة سورية، في حزيران/يونيو 2023، تتحدّث عن محاولات إعادة بناء ذاكرتها وذاكرة خمس سيدات أخريات عن تهجيرهن من قراهن ومدنهن في ريف دمشق، من داريا، والزبداني، ومضايا. تحدّثت عن تفاصيل حياتهن اليومية المفقودة، وكيف كان شكل بيوتهن قبل التهجير. وجدت هذه القصص طريقها إلى مطبوعة تحمل عنوان "عدالة المكان"، مصحوبة برسومات تُعيد بناء البيوت كما يتذكرنها، من إنتاج المنظمة النسوية السورية، "المرأة الآن". كانت هذه إحدى محاولات السوريين/ات المتنوّعة للتعامل مع الصدمات الناتجة عن سنوات الحرب والتهجير، وهي محاولات صادفتها منذ أن وضعت قدمي في برلين في صيف ٢٠١٧، بعضها اتخذ شكل جلسات حكي وفضفضة جماعية.
على النقيض، لم أشهد محاولات مشابهة في مصر قبل مغادرتي خريف 2016. والأهم أنني لم أكن أعلم وقتها أنّ ذاكرتي عن مصر في تلك الفترة كانت "مصدومة"، ذاكرة بدأت من مدينتي الصغيرة في دلتا النيل، حيث شاركت كمواطنة في مظاهرات الأيّام الثمانية عشر، بعيدًا عن أضواء ميدان التحرير، ثم امتدّت إلى القاهرة كصحفية ميدانية من آذار/مارس 2011، وحتى مغادرتي.
السويداء قبل ١٧ آب… كُنتُ هناك
16 آب 2024
ذاكرتي "المصدومة" عن تلك الحقبة ليست تعيسة تمامًا، لكنها تقتصر على النقيضين. لا توجد منطقة رمادية فيها. كما لو أنّ الحياة صبغت نفسها بلونين فقط: نشوة النصر، أو كما وصف لي الصحفي المصري المقيم في برلين أحمد رجب تجربته في إحدى أهم الصحف المصرية آنذاك "نحن في لحظة كنا فيها أقوياء جدًا ولمسنا سقف العالم كله" ثم علقم الهزيمة والغضب.
أما المجتمع المصري، بعيدًا عن الصحافة والصحفيين، فقد كان يمرّ هو الآخر بحالة من الصدمة، وفقًا لتحليل المؤرخ المصري خالد فهمي الذي التقيته في خريف العام 2018 على هامش فعالية نظمها بيت ثقافات العالم (HKW) في برلين، لمناقشة علاقة الأرشيف بالثورات العربية. في حوار أجريته مع الرئيس السابق للجنة توثيق الثورة المصرية لصالح موقع "المنصّة" المصري، شرح فهمي أنّ تعامل النظام المصري وقطاع من الشعب مع ثورة يناير وكأنها لم تحدث يمكن فهمه ضمن سياق الصدمة. وأوضح أنّ المجتمعات التي تمرّ بصدمة تميل إلى التجمّد والتظاهر بأنّ الألم غير موجود، لأنّ مواجهة مصدر الألم بشكل مباشر تكون أشدّ قسوة من قدرتها على التحمّل.
فهمي حدّد مصدرين رئيسيين للألم في علاقة المصريين مع ثورة يناير: الأوّل هو تضرّر المصالح المالية والتجارية لقطاع كبير من الشعب، وهو ما عمدت الدولة إلى "تعظيمه وتكبيره". أما الثاني، فهو اكتشاف اختلافات عميقة بين أفراد المجتمع نتيجة الانفتاح في المجال العام بعد الثورة. "الناس تحدثت وعبّرت عن آراء لم تكن تُسمع قبل ذلك من كل الأطراف"، قال. هذا الخوف من الاختلاف، برأيه، أعاق قدرتنا على رؤية القواسم المشتركة بيننا، رغم أنّ المجتمع المصري يتمتع بدرجة عالية من التجانس مقارنة بدول المنطقة مثل لبنان وسوريا وليبيا. لكن، وكما أشار فهمي، هذا التجانس لم يكن كافيًا لتجاوز آثار الصدمة.
سوريا 2011-2024: من شريط العاجل إلى ذاكرتي المتخيّلة
"مظاهرات حاشدة ضدّ الأسد"، و"الكيماوي ضدّ المدنيين"، و"الحرب الأهلية"، و"القضاء على داعش"، و"أزمة اللاجئين"؛ هذه العناوين، وغيرها الكثير، تبادلت موقعها أسفل شريط الأخبار العاجلة على التلفاز، سواء على قنوات عربية أو دولية، مصحوبة بصور تهزّ الابدان. تلك العناوين والصور شكّلت ذاكرتنا، كأناس غير قادمين من سوريا، عن البلد خلال السنوات الأربعة عشر الماضية. كلّ منها يمثّل فصلًا مهمًا في قصّة سوريا بعد 2011، إلا أنها توارت سريعًا خلف عناوين جديدة. دون الحاجة إلى نبوءاتِ العام الجديد، ستلحق بها قريبًا أحداث جلل أخرى، مثل "فتح صيدنايا".
كما هي الحال مع التغطية الإعلامية للقصّة السورية، غالبًا ما تضيع قصص شعوب منطقتنا وسط الأحداث التاريخية الكبرى، أو تُختزل بتعقيداتها في كلمتين مثل "الربيع العربي"، و"الانقلاب العسكري"، و"الانتفاضة الفلسطينية"، أو مؤخرًا "السابع من أكتوبر". لقد عايشت ذلك بنفسي كمواطنة مصرية شاركت في مظاهرات الأيّام الثمانية عشر، عندما وضعتنا التايمز الأمريكية على غلاف مجلتها "الجيل الذي يغيّر مصر"، وقمت به كصحفية في تغطية لحظات مشتعلة مثل اعتصام رابعة العدوية، وحدث لي كعربية مهاجرة، عندما جلست أمام شاشات التلفاز الألمانية في برلين أتابع تغطيتها لحرب الإبادة على غزّة.
قبل أن أقترب من هذا العالم٬ كنت مجرّد عابرة بين المجتمعات السورية المهاجرة في برلين؛ أتعرّف عليهم من بعيد، من خلال قطاعات الثقافة والفنون والصحافة والمجتمع المدني. ومع الوقت، بدأت رتوش خيالية ترتسم في ذهني عن سوريا. رتوش صنعها طعامهم الذي كنت أتذوّقه، ولهجاتهم التي تعلّمت الاستماع إليها، وإعلامهم الذي أستهلكه في المهجر وقدودهم الحلبية التي رافقتني في أمسيات موسيقية تستدعي سوريا في المنفى.
ما أدركته لاحقًا أنّ جزءًا من هذا التفاعل السطحي يعود إلى ما كنت أعيشه في غرف الأخبار قبل خمسة عشر عامًا، عندما لم يصرخ أحد من زملائي من هول ما رأيناه من صور أحداث ماسبيرو. الأخبار كانت تصل إلينا وكأنّها "آلام تحدث للآخرين"، علينا تسجيلها وتحويلها إلى أرقام مجرّدة: "قتلى ومصابون" في سباق محموم مع مواقع إخبارية أخرى على سرعة النشر. العبارة التي فسّرت شعوري حينها لم أجدها إلا بعد سنوات، في شتاء 2017 في مكتبة جامعتي البريطانية٬ حين كنت أطالع كتابًا مقرّرًا في تخصّصي في تغطية الحرب والنزاع للصحفية الأمريكية سوزان سونتاغ "عن آلام الآخرين".
لم أكن أدرك ذلك حينها؛ كنت داخل الحدث، الخبر الذي أغطيه، وداخل الحدث الأكبر، مصر بعد 2011. لكن لم أخرج من ذلك الحدث الكبير حتى بعد مغادرتي مصر في 2016، حملت في حقيبة سفري قصاصة نيويورك تايمز مع ذكرياتي المصدومة ولم أفتحها إلا عندما التقيت السوريات في برلين في حلقه سلام للدعم النفسي للمهاجرات العربيات في 2018. حينها بدأت رحلة ممتدّة من محاولات عدّة لعودة روحي إلى جسدي: أشعر بكلّ ما لم أكن أسمح لنفسي بالشعور به، وأصنع قصصًا متماسكة من قصاصات ذاكرتي عن الماضي، وأشاركها مع الآخرين كما أفعل الآن، في محاولة لنسج ذاكرة أخرى، عما حدث في الماضي والمستقبل الموجود أمام عيني، والحاضر، متواجدة فيه بكلّ حواسي، قدر المستطاع.
حلقة السلام: عن خالاتي السوريّات وحمّامنا البلدي في الغربة
29 آذار 2024
لكن رفاهية وجود مسافة للتذكُّر والحكي لم تكن متاحة لديّ في مصر. كنتُ داخل الأحداث المتسارعة، أعيشها كمواطنة عادية، وكجزء من ماكينة إعلامية يومية. بمعنى آخر، كنت أدور في فلك متتالٍ من الصدمات التي ضربت المصريين/ات في مرحلة ما بعد 2011.
وكما أدركت لاحقًا أثر التحوّلات السياسية والاجتماعية الكبرى وبصماتها الشخصية عليّ، وجدت نفسي في موقعٍ غريب عندما تلاشت سوريا من شريط الأخبار العاجلة في السنوات القليلة الماضية، بقي السوريين والسوريات وحدهم مع وقع تلك الأحداث الكبرى عليهم وهنا التقيتهم!
لم يكن موقعي ثابتًا وأنا أشهد بصمات النزوح والحرب والانقسام متشابكة مع محاولات استعادة الحياة السورية بكلّ تفاصيلها الثقافية والاجتماعية في المهجر. كنت أدوّن، أستمع، أقرأ، وألاحظ، أتنقّل بين أدوار متباينة. أحيانًا كنتُ الصحفية والباحثة في الحياة الثقافية والاجتماعية للسوريين في برلين، وأحيانًا أخرى كنتُ الصديقة التي تشارك أريكة منزلها البرليني مع صديقات سوريات، ينسجن حكايات حميمية بدموع منهمرة عن بيوت غادرنها اضطرارًا في دمشق وريفها، وحنينٍ إلى حياة تركنها خلفهن، أو أهلٍ عالقين هناك. وأحيانًا في أوقاتٍ أخرى، كان موقعي أكثر حميمية، كنتُ الشريكة التي أرى نظام الأسد على سريري في برلين متسللًا إلى كوابيس شريكي السوري، ليوقظه في منتصف الليل من سباته.
أما قبل أن أقترب من هذا العالم٬ كنت مجرّد عابرة بين المجتمعات السورية المهاجرة في برلين؛ أتعرّف عليهم من بعيد، من خلال قطاعات الثقافة والفنون والصحافة والمجتمع المدني. ومع الوقت، بدأت رتوش خيالية ترتسم في ذهني عن سوريا. رتوش صنعها طعامهم الذي كنت أتذوّقه، ولهجاتهم التي تعلّمت الاستماع إليها، وإعلامهم الذي أستهلكه في المهجر وقدودهم الحلبية التي رافقتني في أمسيات موسيقية تستدعي سوريا في المنفى.
وهكذا، حفرت سوريا تحت حكم الأسد مكانها في ذاكرتي عبر قصص السوريين والسوريات الذين مروا بحياتي على مدار السنوات الست الماضية، محمّلةً بتناقضات الحياة والموت، المقاومة والمراوغة. لم أكن أعلم، حتى وقت قريب، أنّ هذه الحكايات التي رويت لي عن سوريا أو قرأتها وسمعت عنها قد صنعت نوعًا من "الذاكرة بالوكالة" المتخيّلة، أو كما يُطلق عليها بالإنجليزية "vicarious memory".
حفرت سوريا تحت حكم الأسد مكانها في ذاكرتي عبر قصص السوريين والسوريات الذين مروا بحياتي على مدار السنوات الست الماضية، محمّلةً بتناقضات الحياة والموت، المقاومة والمراوغة. لم أكن أعلم، حتى وقت قريب، أنّ هذه الحكايات التي رويت لي عن سوريا أو قرأتها وسمعت عنها قد صنعت نوعًا من "الذاكرة بالوكالة" المتخيّلة.
هذا النوع من الذاكرة يتشكّل أيضًا مع سماع قصص العائلة المُتداولة حول طاولة العشاء، حيث تُنسج حكايات تعبر بين الأجيال. وكما خلصت عالمة النفس الأمريكية روبين فيفوش، في أبحاثها عن قصص العائلة، فإنّ لهذا النوع من الذاكرة تأثيرًا عميقًا على أفراد الأسرة لأنها تقدّم لهم نماذج أو رؤى عن كيفيّة عمل العالم وكيفيّة انتمائهم إليه، خاصّة وقت الأحداث الجلل. كما وجدت فيفوش في دراساتها، التي تناولت العائلات التي تحدّثت بانفتاح وتعاون أكبر عن التجارب الصعبة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر أيلول، أنّ أطفال هذه العائلات كانوا أقلّ عرضة للمشكلات السلوكية والاكتئاب والقلق، كما أظهروا أعراضًا أقل مثل الغضب أو تعاطي المواد المخدّرة.
تجادل فيفوش في مقابلة بودكاست Hidden Brain بأنّ سماعنا لصراعات الآخرين ضمن إطار "السرد القصصي التشاركي" يساعدنا كما يبدو على أن نكون أكثر مرونة في مواجهة الشدائد. أليس هذا ما اختبرته شخصيًا في حزيران/ يونيو ٢٠٢٣؟ ففي قمّة اليأس، بعد مرور تسعة أشهر على الإبادة ضدّ سكان قطاع غزة، وثلاثة عشر عامًا ونصف على الأوديسة السورية، دون أمل في إزاحة الأسد عن السلطة، وجدت نفسي بين عشرات السوريين والسوريات في مقرّ شبكة فبراير في برلين٬ المجتمعين لسماع قصص سيّدات سوريات مهجرات من ريف دمشق في أواخر عام ٢٠١٦، ومن بينهن ياسمين شربجي من داريا، من مجموعة "عائلات من أجل الحرية" المطالبة بالكشف عن مصير المختفين قسريًا، التي تحدّثت عمّا وصفوه بـ"أرض الديار" التي سوّتها براميل بشار الأسد بالأرض. كانت هناك الكثير من الدموع ولحظات الصمت إزاء الخسارات التي تحملتها هذه العائلات، لكن في الوقت ذاته، "وأنت تسمع حكاياهن، لا يمكنك إلا أن تشعر بحماسهن"، كما وصفت الروائية السورية والطبيبة نجاة عبد الصمد خلال إدارتها لحدث إطلاق كتاب "عدالة المكان". كان هذا الكتاب محاولة "لملمة شتات العائلات"، وتشكيل ذاكرة "غير متخيلة" عن الحياة قبل التهجير.
"عندما تحكي النساء، يتحدثن عن كلّ شيء. وعندما تتحدث نساء من نفس المكان، فإنهن يصنعن ذاكرة جماعية لهذا المكان، ويظهرن وجهًا آخر للعدالة، إلى أن يحين وقت محاسبة المجرمين"، كان هذا مما تردّد صداه يومها.
وسط تلك القصص السورية في محاولة استعادة عدالة مفقودة، كانت هذه المرّة الأولى التي أفكر فيها بذاكرتي المصرية عن سوريا، وبمراحل تشكّلها: من رتوش متناثرة إلى ذاكرة متخيّلة، ثم إلى شبه متخيّلة عن الحياة تحت حكم الأسد، ومحاولات الفرار، وأمل لا ينتهي في بداية جديدة والسعي لتحقيق العدالة. لم أمتلك رفاهية استعادة الذكريات وإعادة بنائها إلا في موقعي وسط المنافي الإجبارية لكثير من السوريين آنذاك.

قبل عام ونصف، حظيت برفاهية أخرى لا تتوفّر لكثير من السوريين، بمن فيهم زوج؛ زيارة سوريا. كانت الزيارة التي كتبت عن جزء منها تحت اسم مستعار آنذاك، كانت فصلًا جديدًا وواقعيًا في ذاكرتي عن سوريا، واختبارًا لقوّة ذاكرتي "المتخيّلة" التي نسجتها حكايات السوريين والسوريات، تحديدًا عندما عبرت الطريق الممتد بين السويداء ودمشق، القاحل إلا من بعض أشجار الزيتون.
أسعى أنا، غير السورية، إلى التقاط الخيوط المتناثرة لأغزل بها وأرمّم ذاكرتي شبه المتخيّلة عن سوريا. أفعل ذلك على عكس ما تدربت عليه في دراستي الأكاديمية للصحافة وعملي الصحفي من اختزال والحفاظ على مسافة من الحدث.
للمرّة الأولى منذ وطأت قدمي سوريا في بيت أهل زوجي، كنت وحدي. شعرت بوطأة كلّ القصص التي صنعت خيالي عن سوريا. من مقعدي، ومن خلف الزجاج، تجمّع كلّ أصدقائي ومعارفي السوريين على جانبي الطريق، رأيتهم يقفون على أرضهم، يضربون جذورهم فيها كأشجار الزيتون. لعنت روح الأسد وأبنائه بشار وماهر مع كلّ صورة صادفتها على حاجز عسكري في طريقي إلى دمشق، بينما دموعي تنهمر بصمتٍ في مقعدي خلف سائق الحافلة.

اليوم، لديّ رفاهية وامتياز متابعة اللحظة الراهنة في سوريا، وإمكانية الدخول والخروج منها، كما خرجت من غرفة معيشتي في برلين، عندما صرخ زوجي في وجهي، محاولًا تجنيبي مشاهدة صور صيدنايا. هو امتياز لم أتمتّع به سابقًا عندما كنت في مصر بين 2011 و2016، وهو أيضًا امتياز لا يحظى به كثير من السوريين الذين يعيشون كلّ هذه المشاعر في آن واحد، كما كرّر على مسامعي صديقي السوري الذي يتابع سيل الأخبار المتدفقة من سوريا منذ الثامن من كانون الأول/ديسمبر. بينما يهبط الإعلام الدولي والعربي "بمنطاد" لتغطيّة القصّة السورية تحت عناوين مثل "العودة إلى البيوت"، كانت الأخبار العاجلة قبل سنوات قليلة تتحدث عن "تهجير من البيوت". ولكن قلّة من القصص تُروى، عن السنوات التي فصلت بينهم والمحاولات اللانهائية لاستعادة روحهم.
وبينما ينشغل السوريون/ات حولي بلحظتهم التاريخية، يصارعون حالة اللايقين مذعورين على وليدهم "الحرية"، أو كما تقول صديقتي زينة علي منشورها على فيسبوك "الجميع يشد شعر بعضهم البعض في الآونة الأخيرة." أتأمل هذا الظرف الذي عايشته بدرجة ما مع ملايين المصريين/ات في 2011 وما بعدها. أسعى أنا، غير السورية، إلى التقاط الخيوط المتناثرة لأغزل بها وأرمّم ذاكرتي شبه المتخيّلة عن سوريا. أفعل ذلك على عكس ما تدربت عليه في دراستي الأكاديمية للصحافة وعملي الصحفي من اختزال والحفاظ على مسافة من الحدث.
أحاول، بدون امتلاك الأدوات الحرفية، لأنّ "ما حدث كان يجب ألا يحدث لأهل سوريا أو لأي شعب"، ويجب ألا يُنسى وسط زخم اللحظة التاريخية الحالية. ولأني تعلمت من السوريين/ات المجتمعين في إطلاق "عدالة المكان" يوم كان الجميع يائسًا من إزالة الأسد، قولهم: "الصخرة لا يفتتها سيل، بل قطرة فقطرة".

وقبلها، تعلّمت أيضًا أنّ "الشاطرة السورية بتغزل برجل حمار"، وهو ما أحاول أن أفعله الآن، وأنا أتذكر الثمن الباهظ الذي دفعه المصريون لفقدان ذاكرتهم، حين هُدم مبنى الحزب الوطني في ٢٠١٥ ومعه الكثير من الذكريات المُطالبة بالتغيير.
"لا لهدم الذكريات"… ''المرة ده بجد بقى."