(هذا المقال جزء من سلسلة مقالات عن التصوير السوري والمصورين السوريين. بتمويل من مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية)
كان عمري 13 عاماً عندما بدأ الحراك السلمي في سوريا في عام 2011. في ذلك الوقت، بدأ أشقائي الذين يكبرونني سناً بتوثيق المظاهرات السلمية المطالبة بالحرية من جهة، وانتهاكات النظام السوري لقمع المظاهرات من جهة أخرى. بدأتُ حينها بمساعدتهم لشعوري بالحاجة إلى المشاركة في هذه الثورة رغم صغر سني
بعد فترة قصيرة، تطوّر الوضع بشكل سريع وأصبحت منطقتنا "الغوطة الشرقية" محاصرة بشكل كامل من قبل قوات النظام السوري في نهاية عام 2012، وذلك بعدما أصبحت تحت سيطرة مقاتلي المعارضة. بشكل رئيسي، فرض النظام قيودًا على حركة المدنيين، وصادر الطعام، وحرم المدنيين بشكل تعسفي من الكهرباء والماء كنوع من العقاب.
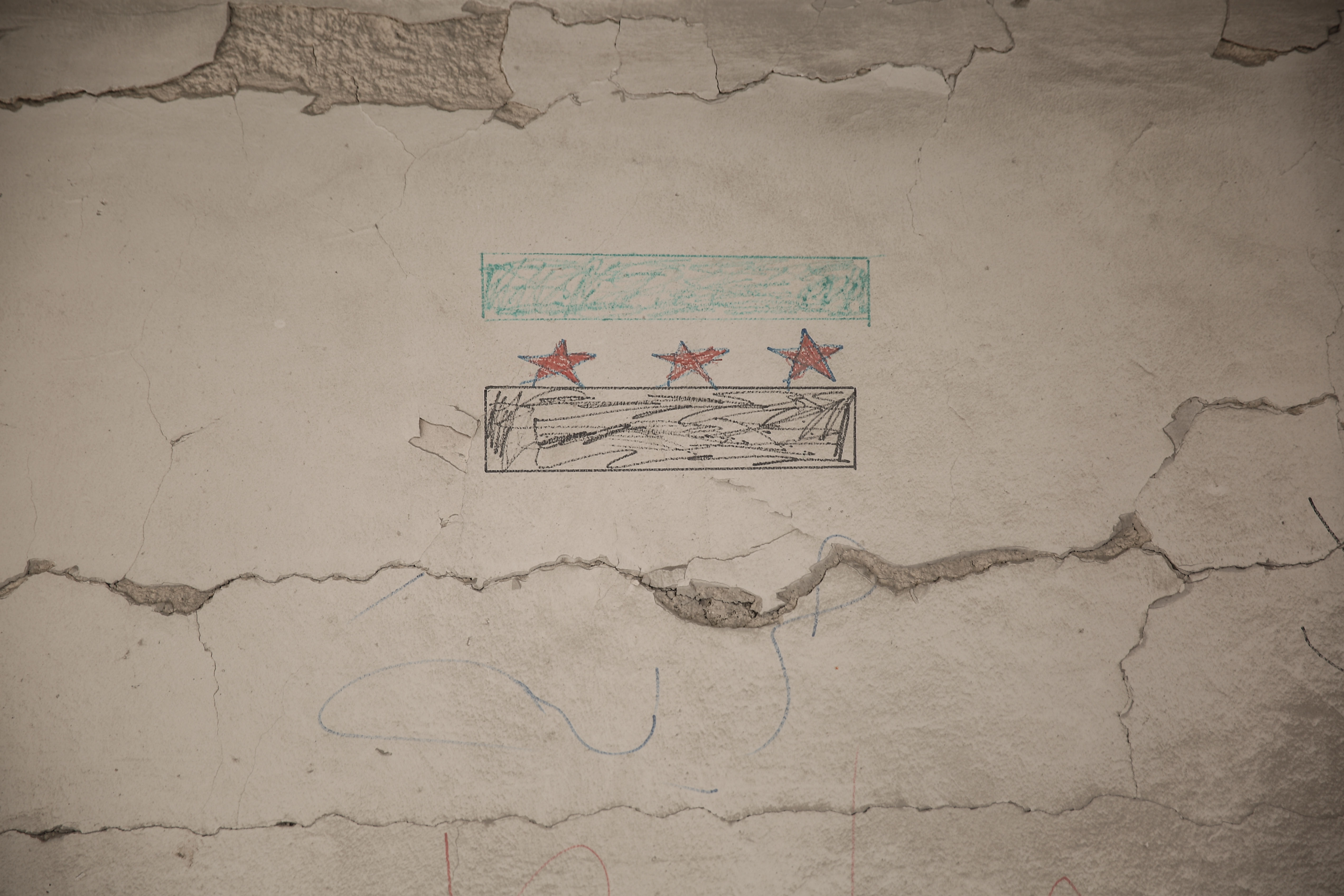
روتين الحصار
لم نكن مستعدين لحصار بهذه القسوة، لكننا أجبرنا على التعايش مع ذلك الوضع الصعب. بدأ الناس بمحاولة إيجاد بدائل لكل شيء من أجل النجاة. كانت أمي تعد لنا الخبز المصنوع من علف الحيوانات بدلاً من دقيق القمح الذي لم يكن متوفراُ. في المرة الأولى، بقيت بلا طعام مدّة ثلاث أيام لأنني لم أحب طعم ذلك الخبز. ولكن بعدها لم يكن لديّ خيار سوى أن آكله لكي أبقى على قيد الحياة. كما كنّا نقوم بقطع الأشجار لاستخدام خشبها للطبخ والتدفئة، ونستخرج الوقود والغاز بعد حرق المخلفات البلاستيكية. لقد دفع الحصار الناس إلى الابتكار والإبداع قدر الإمكان من أجل النجاة. الحرب ليست مجرّد آلة لصنع الموت، فأحياناً، رغم قساوتها تدفع الناس نحو الإبداع، وتدفع الصغار لأن يكبروا بسرعة وقسوة.

كان من النادر أن يتوقف القصف على منطقتنا يوماً واحداً. كان ذلك روتين حياتنا اليومي. بالإضافة إلى الحصار، كنت أصحو كل صباح على أصوات القصف وغارات الطائرات. كنت حينها أقوم بتوثيق تلك الفظائع: بيوت مدمرة، أشخاص يبكون ذويهم الذين فقدوهم في القصف، وآخرون يسعفون المصابين بعد غارات الطائرات. كما أنني تدربت في قلب الصراع السوري، أحاول دائمًا أن أكون على اتصال بالأشخاص الذين أصوّرهم، أتحدث إليهم، أهتم بمشاعرهم، وأحترم رغباتهم.

كنت أشعر بالخوف كثيراً كأي إنسان أو طفل، أحياناً أحاول إبقاء عيني داخل منظار كاميرتي علّ ذلك يخفّف عني هول صدمة تلك المشاهد. ولكن عبثاً. شاهدت الكثير من الموت حينها، أكثر مما يمكن أن يشاهده طفل عادي. ومع ذلك، كان التصوير بالنسبة لي هو طبيبي النفسي. عندما أمسك كاميرتي وأبدأ بالتقاط الصور، بشكل تلقائي أقوم بتفريغ مشاعري في تلك الصور لأعبّر عن غضبي وحزني. لم يكن لدي وسيلة أخرى لأفرغ كل تلك المشاعر حينها. رغم ذلك، كان لدي مخاوف..

طفل تحت الأنقاض
في هذه الصورة التي التقطتها في 16 من حزيران عام 2015 تتجلى أكبر مخاوفي. كان هذا الطفل عالقاً بين الركام عقب غارة جوية بأربعة صواريخ أدت إلى هبوط تكتل من الأبنية السكنية. كانت فرق الإنقاذ تعمل بكل جهدها لاستخراج الناس العالقين تحت الأنقاض، لكن لم يكن الأمر سهلاً وكان يتطلب وقتاً طويلاً نظراً للمعدات البسيطة المتوفرة، وقتاً أطول مما يمكن لشخص أن يحبس أنفاسه.

كنت أشعر بالاختناق أثناء التقاطي لتلك الصور بينما كان الجميع يحاول إخراج الطفل من تحت الأنقاض، كانت نظرات الرعب والخوف عليه واضحة تماماً. أكنت أتخيل نفسي مكانه وألتقط أنفاسي مجدداً مع كل صورة؟ تلك كانت أكبر مخاوفي حينها، أن أبقى عالقاً تحت سقف منزلي وأموت خنقاً. لحسن الحظ خرج ذلك الطفل من تحت الأنقاض، ولكن مع الأسف لم تكن عائلته محظوظة كفاية لتنجو.
قصف في منزلنا!
توثيقي لتلك الأهوال لم يكن بالأمر السهل، فمعاناة وألم شعبي التي كنت أوثقها كانت معاناتي أيضاً. قبل التقاطي لهذه الصورة بلحظات قليلة كنت في مقهى للإنترنت بالقرب من منزلي. سمعت صوت الطائرة الحربية فخرجت مسرعاً لأحاول رؤيتها لمحاولة تحديد المكان الذي ستنفذ فيه غارتها الجوية. ماهي إلا ثواني قليلة، وإذ بضغط عالي الشدّة يدفعني للخلف، عقبه دوي انفجار ضخم. نظرت إلى السماء وإذ بي أرى دخان القصف ينبعث من منطقة قرب منزلي.
كانت الطائرة لاتزال بالسماء، كنا نعلم حينها أنه إذا سمعنا صوت الطائرة بالأجواء بعد تنفيذها لغارة، فهذا يعني أنها ستعاود قصف المكان نفسه لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا من المدنيين وفرق الإنقاذ. كنت خائفاً متردّداً. ولكن ودونما تفكير، ركضت مسرعاً تجاه مصدر الدخان، وصلت إلى شارعي، كان الدخان يملأ المكان. ماهي إلا ثوانِ معدودة لتعود الطائرة لتنفذ غارة أخرى. ارتميت مباشرة في مدخل البناء القريب مني دونما تفكير أيضا، فقط للاحتماء من شظايا الصواريخ.

كانت الغارة بعيدة قليلاً، خرجت مباشرة وهرعت إلى منزلي، ملهوفاً، شارد الذهن خائفاً أشد الخوف، من أن يكون أصاب أي مكروه عائلتي. وصلت إلى منزلي. كانت الغارة في بنائنا تماما. صعدت لأتفقد أفراد عائلتي ولكن ما إن أصعد درجاً إلى أن أجد بين يدي أحد أبناء أخي وهو مغطّى بطبقة بيضاء من غبار القصف وبعض الدماء. بدأت بإجلائهم مباشرة خارج البناء وبدأ الجيران يساعدوننا.
كان كل تفكيري محصوراً بأني أريد الوصول إلى منزلي، أردت الاطمئنان على أمي وأبي. بعد بضعة دقائق صعدت لأجد جميع أفراد عائلتي في حالة صدمة ورعب، تعلو وجوههم طبقة غبار أبيض كثيف. كان الحظ حليفنا حيث كان الجميع مجتمعين على مائدة الإفطار في غرفة واحدة قبل دقائق من الغارة، وكانت تلك الغرفة هي الوحيدة التي لم تتهدم بفعل القصف!









