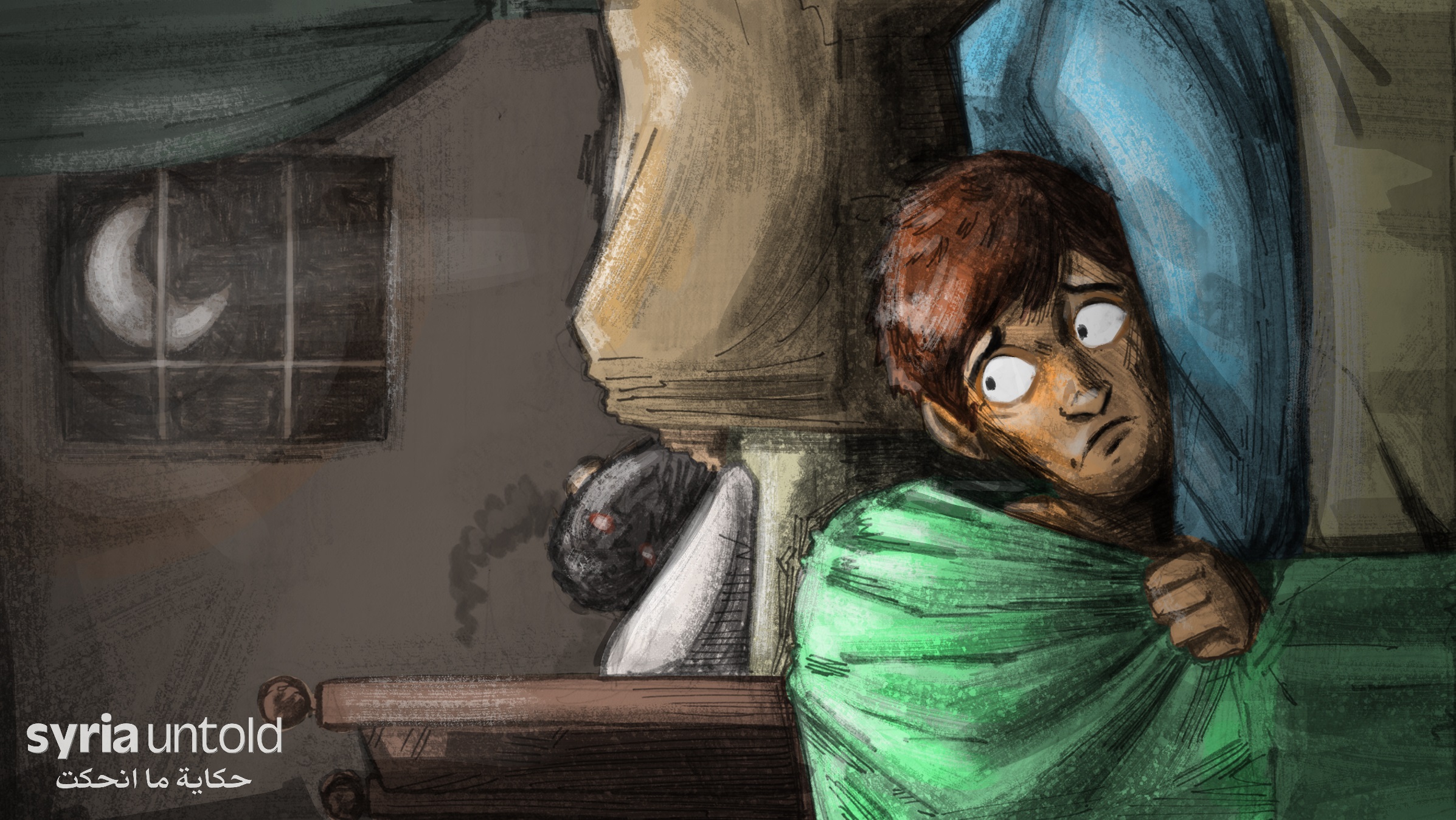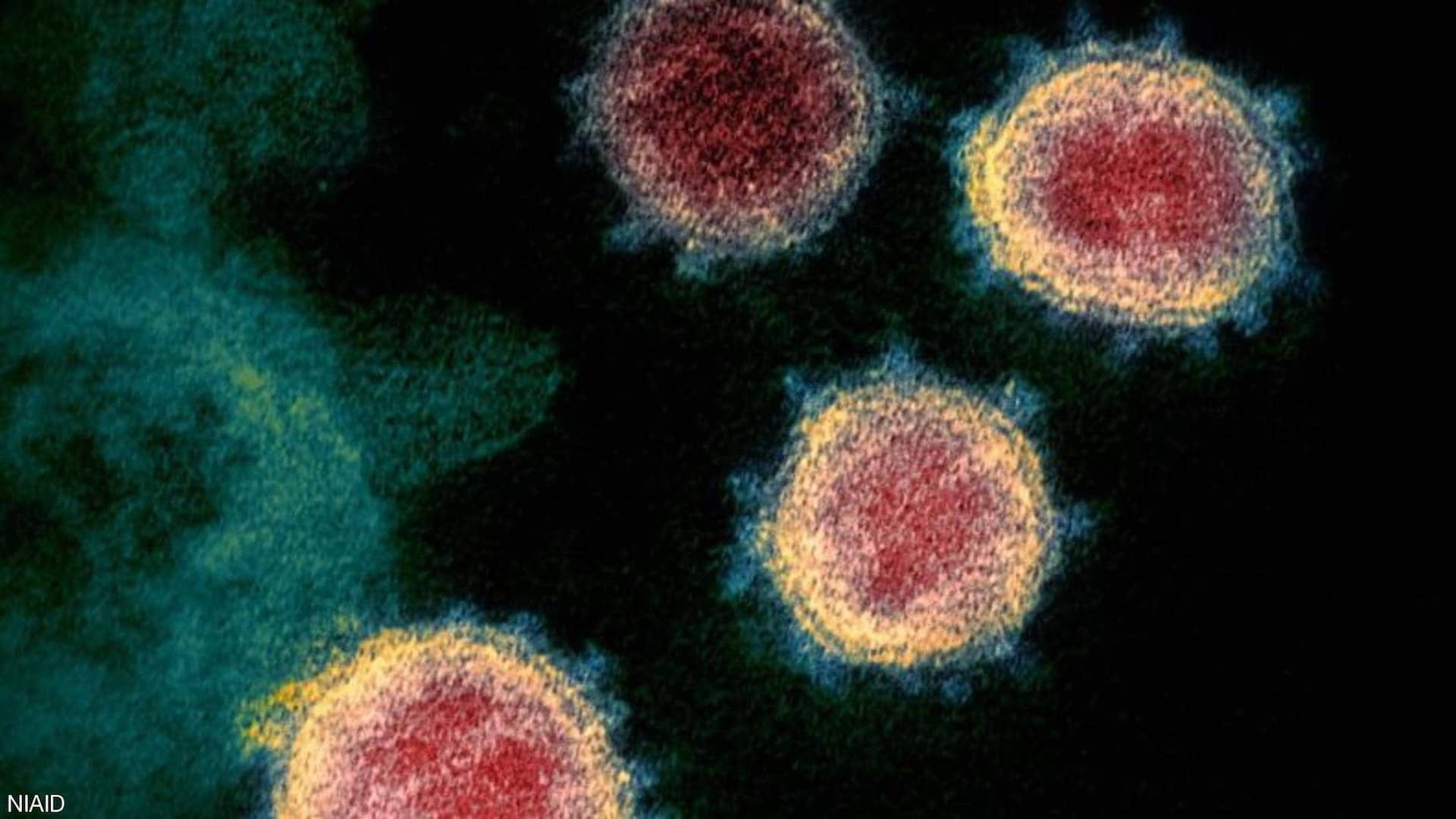أحاول في هذا النص البحث والتفكر في مفاهيم وتجارب الجسد، الذي أقرؤه وأعيشه كمصنع ومتحف للذاكرة، على حدّ سواء. أيّ أحاول أن أكون كمن يعيش الكون والتكوين في آن معًا.
لقد جعلني انشغالي بالذاكرة وعوالم الأرشيف في السنوات الأخيرة يقظةً، أو ربما مهووسةً بآلية عمل وتكوّن وإنتاج الذاكرة، الذاكرة التي من المجحف اختزالها بماضٍ مغلقٍ مستقل بذاته ولذاته، كما لو أنّها جملة ما تنتهي، بكلّ استلاب، بنقطةٍ متمثلة هي الآن بجسدي. أيكون الجسد حقًا محض نقطة في بحر الجملة؟ أم أنّه، كما أتخيله، تلك المسافة الحسيّة بين كلّ النقاط ومجال التماس بين الجملة، كتجمّع مادي للحروف، وبين معناها العابر لها؟
مخيالُ الحاضر هو أبجديّةُ ذاكرةِ الماضي وهو نبوءةُ ذاكرةِ المستقبل. أتخيلني مثلًا قصة عابرة للزمن تعيش عبر "آنيّة" الجسد والمخيال؛ جسدي إحدى تجلياتها الماديّة العديدة، ومخيالي محاولة لانتزاع زمامها ولو إلى حين. كثيرة هي آحايين عجزي في تمييز الذاكرة عن الخيال في خضم متاهات التفكيك والتركيب والسؤال عن معنى هذه القصة، هذه القصة بالذات. هل الجسد تجلٍّ مادي متجدد لذاكرة مخياليّة أم لمخيلة ذاكراتيّة؟
أتذكّر أنّني في وقت ما في شهور سنة 2020 الأولى، هذه السنة التي غابت ولم تغب بعد أوصاف العدو الفيروسي وأهواله وأسفاره وأشباحه عن أحاديثنا و يومياتنا، بالغت في التمعن بذاكرة جمعيّة بشريّة عن الفقد والتهديد والصدمة والألم، ذاكرة في طور تكوينها وولادتها الأولى. تساءلت حينها عن ماهيّة الجمعي والجامع حقًا في ذاكرة، يزعمُ البعض بقدرتها على توحيد العالم وخلق وعي جديد لمفهوم العدالة والتضامن وتبديد الفوارق بين البشر. هل تشاركيّة المُهدِّد كفيلة حقًا بخلق "نحن" ما جمعيّة بشريّة، بوصلتنا في إدراكها هي أجسادنا المحضة؟ "نحن" التي سرعان ما قضت في مهدها صريعةَ تباينات مواقعِنا من الـ"سيستم" ومعها بديهياتُنا والامتيازات والحقوق غير عادلة التوزيع.
مخيالُ الحاضر هو أبجديّةُ ذاكرةِ الماضي وهو نبوءةُ ذاكرةِ المستقبل.
وضعتُ نفسي أمام سؤال آخر: لماذا لم تسعفنا "أجسادنا البوصلة" ذاتها من قبل لالتماس حقُّ الآخر المختلف عنّا والأضعف منا، حقُّهُ بأن "يكون" وأن يحقق نفسه بعدالة؟
الطارئ الخانق مهدّد البلاد ومقيّد الأجساد ليس سوى استمراريّة لما كانت تعايشه بيننا فئات مجتمعنا المستضعفة والمضطهدة على أساس جنسها وجنسانيتها ومقوماتها الجسديّة والنفسيّة. مجرد استمراريّة ذات ظاهر جمعي اليوم لما قاسته تلك الفئات في خوالي أيامنا، المُشتهاة بحسرة وقهر اليوم.
الجسد و الخيال في مواجهة الوباء
أتذكر الآن كيف كنت اراقب هلع الناس وتوحشهم/ن للنجاة، أو ربما أقول احتكار النجاة، في شهر آذار من سنة 2020، عقب فرض الإغلاق الكامل وتجميد الحياة العامة في ألمانيا. كنتُ أراقب اغتراب ذاكراتهم/ن ومخيلاتهم/ن، التي كانت حتى قدوم الفيروس قادرةً على التكيّف مع يوميات الحياة والتسليم بحصانةٍ متخيلةٍ لألمانيا خالية من الأزمات. بداهة أصعبَت عليهم بدايةً التنازل عن، أو حتى تخيل الحرمان من، روتين الراحة والرخاء والمُسلّمات. أدرك الآن باستجلاب تلك الأيام أنّني حقا لم أكن مثلهم/ن وأدرك الآن أكثر فأكثر..لماذا لم أكن.
حياتي مع "الكورونا"
28 آب 2020
خلافًا لمن كان يعيش صدمة وقسريّة العزلة من حولي، "محظوظةً" اعتبرت نفسي لأني اخترت العزلة "طواعيّة" بعد أسابيع قليلة من حلول هذه السنة، أي قبل أن تطأ جسدَ أول ضحيةٍ قدمُ هذا الوباء. اخترت عزلتي. نعم. لكن، هل حقًا قمت بالاختيار؟ كان ألمٌ آخر قد أطبق الحصار على جسدي حتى استأثر به ببطئ وتلذذ، ألمُ ثمرةٍ لوباء خصب، عالميّ أيضًا. وباء يختلف عن نظيره الفيروسي بخاصيّة الانتقاء، فليس كلّ البشر في ناظريه سواء. وباءٌ مرئي ومحسوس ومسموع، لكن غالبًا فقط، من قبل ضحاياه. وباء له ماهيّة تقاطعيّة هيكليّة تشاركيّة انسيابيّة متعددة الوجوه والأشكال. وباء يعبر الجسد واللغة والقوانين واليوميات والمؤسسات والأجيال. وباء عابر للعصور ويُدعى: العنصريّة.
فريدٌ ذاك الألم الذي حلّ بي إثر مواجهتي في مكان عملي لأحد وجوه هذا الوباء، المتجلّي بذكوريّة بيضاء مُحصنة بالامتيازات. ذكوريّة مستترة بإتقان ومترافقة مع عنصريّة هيكليّة أكاديميّة بهيمنة بيضاء هرميّة نخبويّة مُحصّنة. مُحصّنة لكي تكون مرجعيّة إنتاجٍ معرفي وفكري -حول موضوعات مثل "الذاكرة المقموعة" أو"مكاشفة هيمنات وهيكليات الإستعمار المعرفي" أو "الجنوب العالمي كمُنتِج معرفي ونظري"- وتكون في الوقت ذاته عجلة لإعادة إنتاج هيكليات ما بعد استعماريّة وتفوّقية بيضاء.
فرادة ألم تجربةِ العنصريّة هذه بالذات تكمن في سلاسة استيطانه جسدي. حافلةٌ ذاكرتي الشخصيّة والعائليّة والتشاركيّة، مثل كثيرين غيري، بقصص وبتجارب مع العنصريّة في ألمانيا منذ مُنحَت عائلتي حق اللجوء السياسي عام 2006. لم يكن محجري حينها بيتي وحيزي الخاص، إنّما جسدي، خاضعًا كلّ الخضوع لعدو يغزوه من الداخل اسمه الألم، تلك المسافة الفاصلة-الواصلة بيني وبينه. لم يشغلني كثيرًا ما يجري في الخارج، فأنا هنا في الداخل أسيرة جسد هو محض استعارة أو استحضار مادي لأجساد سابقة صرعها يومًا ما ألمُ الفقد والعنصريّة والاستبداد. أجسادٌ واظبتُ دفنها في ثنايا ذاكرةٍ كان التناسي فيها قارب نجاة. قارب يعيدني أدراجي حيث تنتظرني استعارتي الماديّة على ضفاف الحاضر.
منحتني تجربة العنصريّة الأخيرة إكتشافًا يقول إنّ قاربي ذاك وهمٌ يتبدد بالتقادم. وهمٌ كلّما ثبّته أضعفته، وكلّما برهنته نقضته، وكلّما جدّفت به نحو برّ النسيان المشتهى زادَ للذكرى اشتهاءًا وأبعدَ الوصول أكثر.
منحتني تجربة العنصريّة الأخيرة إكتشافًا يقول إنّ قاربي ذاك وهمٌ يتبدد بالتقادم. وهمٌ كلّما ثبّته أضعفته، وكلّما برهنته نقضته، وكلّما جدّفت به نحو برّ النسيان المشتهى زادَ للذكرى اشتهاءًا وأبعدَ الوصول أكثر.
ارتجاء النسيان ترسيخ، ليس للذكرى بل لذاكرة الجسد الحسيّة، الممتلئة بالحنق والألم والاختناق والتخدير والحسرة والارتجاف والانكسار. لقد أيقظت هذه التجربة بالفعل أشباح ذاكرة جسدي الحسيّة. لقد أيقظت تجارب سابقة حسبتني وربما كنتُ قد تمنيت أن أكون، قد نسيتها دون عودة.
نعم، أجسادنا خاضعة لجاذبيات سياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة وحسيّة وذاكراتيّة متباينة. ففي ألمانيا أعايش اليوم، مثل الآخرين، ما يُسمى "قانون الطوارئ" وألامس يوميًا تبايني عن غيري في عوالم الخيال.
حين تظاهر الآلاف من أفراد المجتمع الألماني وخرجوا/ن إلى الشوارع ينددون/ينددن بتقييد السلطة لحريّة الحركة والحياة العامة والخاصة، كان قد امتنعت مخيلاتهم/ن عن تخيّل تحكم السلطة بهذا القرب وبهذه المباشرة بالحركة وبالجسد وبالحقوق "البديهيّة".
"يعني إذا قعدت أحكي معك بتنحل مشكلتي؟"
30 حزيران 2020
بالنسبة لي لم يكن الأمر قابلًا للتخيّل فحسب، بل عاديًا وغير صادم لأدوات وأركان مخيلتي وذاكرتي. ذاكرة تحملُ في طياتها تجربةَ مراكز اللجوء أو الإعتقال السياسي لأفراد من عائلتي ومن بلدي الأم و"بداهةَ" أن تتحكم السلطة بحركة جسدك وحريتك وأن تلقنك رقمًا اعتباطيًا يعبر عن كيلوميترات قطر المساحة التي لا حق لديك بتجاوزها، فأنت لست حرًا بنفسك ولا بأي شيء هنا أيضًا لأنّك لاجئ... لأنّك الأضعف، لأنّك بدورك قد هربت من ضعفك أمام أنظمة بلدك الأم المستبدة المتحكمة بجسدك وببلدك وبتاريخك وبمستقبلك.
كطيف وحش في ذاكرتي ومخيالي لم "أفلت" أيضًا من تذكر المعنى العملي لقانون الطوارئ بنسخته السوريّة الأسديّة. المعنى الذي يحول إلى بديهيّة حضور الخوف والتهديد والقمع والحجر الإعتباطي والتباعد الأسري القسري وعدم بديهيّة التمتع بالحريّات الشخصيّة والمدنيّة. نعم أتخيلها اليوم مراكز اللجوء والمعتقلات السياسيّة، وسابقًا معسكرات الإبادة، كمأسسة للطوارئ تصبح فيها الأجساد معالم وأرشيفات تاريخيّة عن الألم والحرمان والوحشيّة والظلم.
حقًا، إنّ مخيلاتنا وذاكراتنا وبيديهياتنا متباينة في مواجه الوباء، ولكن شعورنا متشابهٌ بأنّنا اليوم خارج التاريخ، غارقين جدًا في اللحظة الراهنة التي تحوّل فيها الزمن إلى "مكانٍ" نعرف أنّنا موجودون فيه بشكلٍ ما. عالقون نحنُ في "الآن" نتشارك عالم اللاخيال هذه المرة، عراةٌ عُزّل في علاقة تبعيّة وجوديّة متطرفة مع السلطة تجعلنا ملزمين/ات بالإنصات والطاعة لما تقول. طاعة نتواصل من خلالها كَـ "كُود" جَمعي في المجال العام، لغتها أجسادنا المتباعدة وأفواهنا المُكممّة وخوفنا من بعضنا البعض كمشتبه بنا بالمطلق.
تغريب العناق كتجلٍّ حسيّ للجسد
بعد مرور وقت ليس بإمكاني تحديده، إذ غيّب حاضر الحجر المنزلي الإحساسَ بالوقت، قررتُ، أو ربما تجرأتُ على، لقاء صديقتي الإيطالية المقيمة مثلي في برلين والتي إليها اشتقت كمن لم تَعرِف الشوق من قبل. فهو لقائي الأول على الإطلاق مع "أحد ما" غير عزلتي.
مختلساتٍ نفسَينا من عين الراهن التي لا تنام ممتناتٍ لشمسِ ذلك النهار العزاء، اخترنا متنزّهًا واقعًا في منتصف المسافة الفاصلة بين محجرينا، لقاءٌ ليس بهدف النزهةِ الترفِ، إنّما محاولةُ انتزاعِ بعضٍ من جسدينا اللذان استُلِبا في زمانيّة الحجر. انتزاعهما ولو لوهلة ولو كإغماضةٍ مهربٍ من إبصار واقع التباعد المحدق.
حّلت لحظةُ لقائها المُرتجاة المُشتهاة. لقاءٌ احتل صدارةَ وصفِ إحساسي فيه السلوانُ والحرمانُ معًا. حرمانٌ ضمنَت له صدارةَ الأوصاف لغةُ التحيّة في تاريخ انتمائي لها، والتي كان اغترابها وارتباكها حينها كاغتراب لغتي الأم عند وصولي إلى ألمانيا. إذ لم نحسب كلتينا أن نُلجم يومًا، مرغمتين، جسدَينا عن العناق. كابرنا بعناء وارتباك شديدين على اغتراب التحيّة وأخذنا طريق المتنزّه نتبادل الكلام والنظرات كأبكمٍ ينطق أو كفيفًا يُبصر للمرة الأولى.
يكون لمسُ الآخر لمسًا للذات أيضًا، فعتبةُ الذات تلك إذن لا تُدرك إلا بتجاوزها، إلا بتغريبها وتغييرها. فهل حقًا فقدت جسدي أم أني تملّكتُه باغترابِه؟
جلسنا على العشب وفيض هائل من البوح والدمع المؤجلين نفرغهما من حقائب روحينا المغتربتين. كان الألم طريقًا من الدمع نشقّه، أو يشقنا، إلى قاع روحينا. على هذا الطريق غرقنا بدوامات الحديث عمّا يحصل حولنا وعن أوضاع وطنها الأم، الذي استنزفَ هذا الوباء الإبتلاء العالمي أرواحَ وأجسادَ وقلوبَ شعبها، وعن وقع برلين علينا. وبكينا… بكينا كثيرًا.
كلّ نظرة إلى عينيها اللؤلؤتين الجميلتين أحدثت غصةً في قلبي وفي جسدي كلّه. جسدي الذي كان يتضرع لي كي يحتضنها ويضمها إليه، كما اعتادَ، كما أحَبَّ. شعرتُ به يقتفي ذاكرته متقنًا باحترافٍ لغتَه، يسحبني نحو احتضانها. وإذ بارتباكٍ وإقسارٍ أعيدُ سحبَه نحوي ليس لمتعة مازوشيّة بل لخوفي عليها من أذى ما قد يسببه لها دون أن يقصد. في تلك اللحظة بالذات شعرت بجسدي غريبًا عني وأدركتُ بهذا الفقد معنى العناق، كما أدركتُ ذاكرة جسدي عند اغترابها. عناقٌ لم يكن اغترابه اليوم، مَرَتَهُ الأولى.
"سلملي عليه" كانت أغنية فيروز التي كنا نرددها أنا وأمي وأخي الصغير مهيار على مدار رحلة سفر لامتناهيّة الطول والتعب والغبار من الجزيرة السوريّة، التي لم أعش في غيرها من مدن بلدي الأم، إلى العاصمة دمشق. لم نكن نقصد زيارة العاصمة لذاتها وما عليها، إنْما نقصدُ مكانًا، أو الأصح القول لامكانًا، تحت سطح الأرض اسمه سجن عدرا. والدي كان معتقلًا هناك لسنوات طويلة بتهمة "اقتطاع جزء من الأراضي السوريّة وضمها إلى دولة أجنبيّة" و"إثارة النعرات الطائفيّة"، أي أنّ تهمته هي كونه معارضًا سياسيًا كورديًا للنظام.
لم نكن نردد أغنية فيروز لذاتها، إنّما لرغبة أخي، ذو السنوات الست، الشديدة مفاجئة والدي وغنائها له عند لقائه. لم يكن يدرك مهيار حقيقةً سوى هذه الأمنية التي جعلته يصارع كلمات الأغنيّة طوال الطريق بفكاهة وبهجة. لم يكن، على عكسي، يدرك معنى هذه الزيارة أو مكانها.
ذاكرة سورية في معسكر نازي
31 تموز 2019
وصلنا "دمشق الياسمين" التي مهما حاولت تخيلَ رائحةِ ورونقِ ياسمينها المأثور اعترضتني تلك الرائحة دائمة الحضور في أنفي والغياب عن لغتي، الرائحة التي استقبلتنا بها مدينةُ الياسمين حين أسدلت الوشاحَ عن وجه لبلدي، كان الأبشع على الإطلاق، اسمه المعتقل. أذكرُ إحساس تخدير عام أصابني بسبب الحزن الذي استأثر ملامح وجه أمي أو ربما من تلك الرائحة أو من هول الوجوه الكثير المتجهمة المنكسرة التي اجتاحتني عند دخول سجن عدرا.
وصلنا قاعة الإنتظار مع غيرنا من الزوار. يُقسم القاعة في ثلثها جدارٌ حاجزٌ كان يصل حينها إلى كتفي تقريبًا. ومن كتفي عبورًا برأسي وصولًا إلى السقف امتدت قضبانٌ حديدية. على اليسار كان هناك رجلٌ ممسوح الملامح يرتدي بدلةً عسكريّة تتخصرها "بارودة". وقف ثلاثتنا بذهول وصمت نترقب خروج والدي من ذلك الباب خلف القضبان على الجهة اليسار، خلف الشرطي تمامًا.
خرج والدي من خلف الباب كشمسٍ تنيرُ عتمة انتظارنا وصمتنا. هرعنا نحو الجدار نقترب منه أكثر. كلما اقتربنا أكثر زاد الاحتراق. احتراقًا كان الصمتُ ومزيدُ الصمتِ هو أفصحُ بلاغاته. كان الصمتُ اختمارًا لضوضاءِ الألم. لا أذكر من هذا اللقاء إلا عينَا أبي، التي فيهما تمنيتُ أن أُسجن، والصمتَ بجدرانه التي اخترقها فجأة صوت أخي مهيار وهو يشتكي لعدم قدرته رؤية والدي من فوق جدار الفصل الأسري هذا. ترفعه أمي على ذراعيها وتسنده إلى حافة الجدار. ابتسامةٌ ترتسم على وجه أبي، كانت الأجمل في الوجود، ابتسامةٌ اخترقت هي الأخرى ملامحَ هذا المكان بمن فيه. لم يكتف مهيار بذلك فقط، كانت هذه فرصته الذهبية ليحقق أمنيته بالغناء لأبي، كأنّ الوجود كلّه توقف عن الوجود ولم يبق فيه سوى عناقُ أعينٍ، عابرٍ لقضبانٍ كان كفيلًا وحده بإذابتها، ومعه صوت مهيار يدندن في خواء الوجود:
"هيدا حبيبي اللي إسمي بيهمسو
تعبان على سكوتو و دارسو
واضح شو بو ما تقول شو بو
أعمل حالك مش عارف ما تحرأصو بتحرأصو
سلملي لي عليه وقلو إني بسلم عليه
بوسلي عينيه هو ومفتحهن عينيه
وبوسو بخدو طوللي عليه فهمت علي أيه وسلم"
لم يكن الغناء والصوت والكلمات يومًا امتدادًا حقيقيًا وحضنًا عطوفًا لأجسادٍ مغيّبةٍ، أجسادٌ استحالت هي نفسها زنزانات اعتقال. نعم كان اغترابُ واستلابُ العناق حينها هو من جعل الجسدَ مكلومَ الذاكرة وغريبًا في ذاته عن ذاته.
لكن، إن كان على جسدي أن يكون غريبًا عني، حتى يصبح جسدي، حتى يصبح لي أنا، كما وصفه الفيلسوف التفكيكي، جان لوك نانسي، في كتابه "كوربوس"، وإن كان حدث العناق، بتعبير رائد التفكيكيّة جاك ديريدا، هو حيزٌ تلامسُ فيه الذاتُ الآخرَ، الذي هو ذاتها في الوقت نفسه، إذ يكون لمسُ الآخر لمسًا للذات أيضًا، فعتبةُ الذات تلك إذن لا تُدرك إلا بتجاوزها، إلا بتغريبها وتغييرها. فهل حقًا فقدت جسدي أم أني تملّكتُه باغترابِه أم كانت كلمات "سلملي عليه" والنظرة والصمت والكتابة لاحقًا، أجسادي الملاذ؟
جسد النص… نص الجسد
عدتُ بعد لقاء صديقتي إلى محجري. شعرتُ أنّ جسدي كان مكممًا من الداخل. الأمرُ الغريبُ أنّ أول ما أردتُ فعله، بعد غسل اليدين، كان الكتابة. أردتُها بتعطش لا سابقَ له، رغم استعصائها مدة طويلة قبل ذلك اللقاء. أردتُ أن أكتب لصديقتي وعنها ولنفسي وعنها. وكأنّ اللغة كانت جسدًا أقربُ إليّ من جسدي الأسير وصوته بعد تكميمه.
عودة إلى جان لوك نانسي الذي يحرر مفهوم الجسد من مشابك ثنائيّة الجسد المادة والروح أو الداخل والخارج، وينقلنا من عبث الكتابة من، أو عن، الجسد إلى "فك كتابة" أو "استكتاب" الجسد(Entschreiben des Körpers).
بإغترابه يتفكك الجسد ويفكّكُ "ما كُتب فيه" من تجارب ومعانٍ وعادات ودلالات ورمزيات و ذاكرات وتاريخ ليستكتب نفسه من جديد دون توقف
بإغترابه يتفكك الجسد ويفكّكُ "ما كُتب فيه" من تجارب ومعانٍ وعادات ودلالات ورمزيات و ذاكرات وتاريخ ليستكتب نفسه من جديد دون توقف. فاستكتاب الجسد لدى نانسي هي تلك "العملية التي لا تعني فقط الحياة والموت، بل كل حدث جسدي حقيقي يمس معناه". إذن فالكتابة حدث جسدي. والجسد هيكليّة نصيّة وهو الكتابة بحد ذاتها أو بحسب تعبير نانسي: هو "هندسة المعنى".
تقفيت بعد استكتاب جسدي في ذلك اليوم معنى الكتابة واللغة في ذاكرتي والتي لطالما كانت جسدًا خارج كلّ القضبان. رسائلي إلى أبي في المعتقل التي لم يصله منها إلا القليل وكتابتي "الهستيريّة " في أولى سنوات وصولي إلى ألمانيا، والتي لم تكن لغاية الشعر أو النثر أو النص إنّما لغاية الكتابة... لذاتِها.
أحلم بألا أخاف
08 آذار 2019
ليس فقط في اللغة والكتابة إنما أيضًا رقميًا نعايش بتركيز أكبر اليوم تجسدات وتحليلات جديدة لأجسادنا. فقيود حركتنا وتحركاتنا جعلتنا مجبرين أو ربما معتمدين على سبل أخرى للتواصل العابر لجدران الحجر والزمن والجسد. مما أتاح للأخير أن يعيش ذاته حسيًّا وإدراكيًا في فضاء أوسع ومتعدد الوسائط والمداخل الرمزيّة والنصيّة والبصريّة.
نعايش أجسادنا اليوم إذن كحيز طيفي تمددي، تتلامس وتتقاطع فيه عوالم وامتدادات حسيّة ومخياليّة وإدراكيّة وذاكراتيّة. فهي ليست محض "حاويات" و أماكن محسومة الامتلاء قابلة للإنغلاق أو الأسر، إنّما أماكن للوجود لامتناهية الإنفتاح والتمدد والتداخل. أيقنتُ ذلك حين شهدتُني لاجئةً اليوم إلى تجارب جسديّة وعناقات جديدة، إلى نوعٍ من التلامس مع آخري ومع نفسي، تلامسٌ أعيشه مع جسدي نصيًّا ورقميًا.
جسد المستقبل
خصوصيّة وفرادة هذه الزمانيّة التي نعيش فيها لا تكمن فقط في استعصاء أجسادنا ومخيلاتنا في الراهن والحاضر، كما لو أنّنا سقطنا في "هوة" أو "ثغرة" بين الماضي والمستقبل، إنّما تكمن أيضًا في أنّها جعلتنا على احتكاك و تذكير يومي مباشر بمحدودياتنا وفنائنا من ناحية، كما ستجعل الخروج من هذه الهُوَة بداية جديدة بالمطلق من ناحية أخرى.
عن القادم مبهم الملامح أتساءل ختامًا: هل ستجعلنا الحياة رقميًا، والقائمة بحدِّ ذاتها على النص والصورة والرموز ومعها الحياة نصّيًا، أكثرَ يقظةً ووعيًا لإيماءاتنا ولمساتنا ونظراتنا وأجسادنا في حاضرها المادي بعد زوال هذا الطارئ؟
هل ستتيح لنا هذه التجربة رغم تفاوت امتيازاتنا ومواردنا إدراكَ َصيغٍ ومناحٍ جمعيّة جديدة للتذكّر والذاكرة والعلاقة مع الذات والآخر؟ وماهي ماهيّة هذا المستقبل الذي سيحمل فيه البشر ذاكراتٍ عن فقدانِ وحرمانِ سلطتهم ولو النسبيّة على أجسادِهم المهددَّة والمهددِّة، خاضعين وجوديًا كلّ الخضوع لسلطة الصدفة و حسّ المسؤوليّة وأمريّة السلطة؟
فإذا كانت البداية، حسب تعبير أفلاطون، هي "إلهٌ أيضًا، يحفظ وينقذ كلّ الأشياء، طالما كان بين الناس" فهل بإمكان هذا الإله برفقة هذه الذاكرة وهذه الإدراكات الجديدة أن تجعل من وعيٍ حسيّ وسياسي جديدًا ممكناً؟ ماذا سيحصل عندما نتجاوز هذا الوباء الفيروسي؟ هل سنعود حقًا إلى سابقنا مثلما فارقناه؟