هذا المقال جزء من سلسلة مقالات عن التصوير العربي والمصورين/ات العرب/ات، بتمويل من مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية، من إعداد المحرّر الضيف المصوّر مظفّر سلمان.
منذ بضعة وقت:
"آه، أختي! إنّ المجتمع الذي تكون وسيلة الترفيه الوحيدة فيه هي الخروج لاقتناء لوازم البيت أو المداومة على مطعم واحد لا يبشّر بالخير إطلاقا. فاذهبي قبل أن يكون لك أولادا. زيادة على ذلك، إنك مصوّرة فوتوغرافية، فمستقبلك في بلد آخر".
هذا ما قالته لي صديقتي جوجو أثناء انتظار دوري في وكالة تجارية لإيداع شكوى بشأن تركيب شبكة الإنترنت التي لا تشتغل. وبسبب عدم تحمّلي لشدّة البرودة السائدة في الوكالة المكيّفة خرجت وبدأت أنتبه إلى المارة.
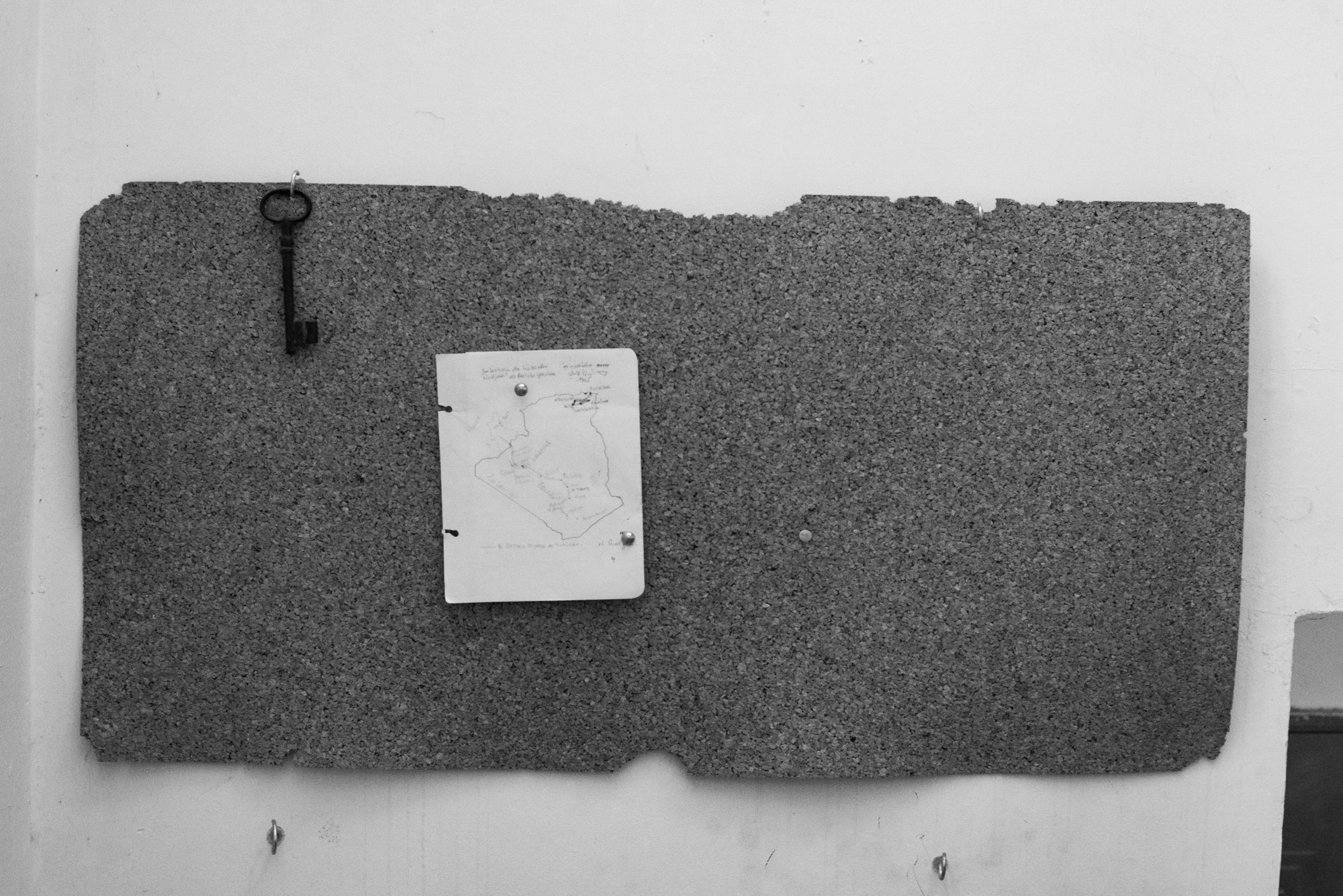
الرجال الذين يذهبون للتسوّق يسيرون لوحدهم أو بمرافقة رجل آخر، أما النساء، فغالبا ما يمشين في مجموعات برفقة سرب من الأطفال وهنّ متجهات إلى البازار الذي تُعرض وتُباع فيه كل أنواع المنتجات. ما لاحظته هو القلق الذي تعكسه عيونهن ونظراتهن الخافتة...
منذ عدة أسابيع
الحنين إلى حلب
- ألو!
- صباح الخير، كيف حالك؟
- أهلا، عادي... صراحة بسبب كل ما يحدث، إنني متعبة وأشعر بالإحباط .
- أجل، إنّي أفهم وضعك. وكيف هو الحل في المستشفى؟
- لايزال عدد المرضى كبير، وعلى غرار بقية مناطق الوطن هناك نقص في الأكسجين وعدد الأسرة غير كافي. كارثة، إننا نفقد كثيرا من مرضى الكوفيد 19 من أجل هذا، ليت الله يلطف بينا.
- حقا، قرأتُ النداءات لغرض شراء مكثّفات الأكسجين وغيرها في الأنترنت .
- وفي ظلّ أزمة المياه الحالية، أتساءل: كيف يمكن للناس احترام التدابير الصحية من غسل اليدين والتنظيف بشكل مستمر.
- لا ندري كيف وصلنا إلى هذا الوضع: أزمة اقتصادية، اجتماعية، صحية والآن أزمة الماء. حفظنا الله من أسوأ من هذا .
- هل تعلمين، في هذه الآونة إني أشاهد الفُكاهي فلاّق- Fella)، فهو يضحكني. وفي نفس الوقت أقول في قرارة نفسي: دائما، كان وضعنا هكذا على كل حال. إذن سننجو من الهلاك مثل كلّ المرات السابقة (ضحك).

لا أعرف لماذا عندنا في الجزائر لا شيء ينجح، لا أمر يسير على ما يرام ولا شيء يدوم. كل شيء يفشل. يُقال في العالم كله (والقول أصبح مثلا) أن يفشل شعب وينحدر إلى القعر فهو يطفو من جديد، ونحن عندما نصل إلى القعر... نحفر" (فلاّق - Fellag).
وقولنا من هذا المنظور، يمكن أن يدفع إلى الاعتقاد أنّنا نميل إلى الاستياء والشقاء ولا نقاوم. لكن، لا ننقطع عن النضال. يكاد يكون الجزائري نعتاً للنضال الدائم من أجلّ كلّ شيء.
يصح تصنيف العيش في الجزائر اليوم في إطار الرياضات العالية المستوى. نقضي أيامنا في النضال من أجل الحياة وأصبحت العبارة "سمحولنا كي رانا عايشين" المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي تحمل في طيّاتها معاني اللامعبّر عنه بنفس الشدّة التي ترمز إلى المعاناة اليومية من أجل العيش.

عندما أفكر في الأمر، يحضر في ذهني الحي الذي أسكن فيه منذ مدّة قصيرة. لا توجد فيه صناديق للقمامة ولا تُجمع النفايات كل يوم. فيما يخصني، يصعب عليّ اعتبار ترك كيس القمامة قرب العمارة أو التفريغ المرتجل في الحي حلّا. فالقطط والكلاب الضالة تمزّق الأكياس بحثا عمّا تأكله، بالتالي يصبح الحي وسخاً ونتناً وقبيح المنظر. أضحى العثور على مكان مخصّص لرمي النفايات معضلة يومية حقيقية.
غيفارا نمر: "التصوير يعني أنا"
05 تشرين الأول 2021
حدث لي أن أخذت معي في السيارة كيس النفايات إلى العاصمة التي تبعد عن مسكني 100 كلم، كي أرميها في حاوية القمامة في حي هناك، لأنني لم أعثر على مكان مخصّص لذلك على الطريق السريع.
إنني أتذكر أيضا الصباحات التي أشاهد فيها عشرات الناس يصطفون أمام مكاتب البريد التي تعاني من نقص السيولة لسحب رواتبهم، وعلى بعد ٤٠٠ متر من المكتب، أرى أناس آخرين يصطفون لاقتناء بعض أكياس الحليب الأرخص في السوق بفضل دعم الدولة، مقارنة بالحليب المعقّم والمعبّأ في علب من الورق المقوى (علب الكرتون) الذي ترتفع أثمانه 4 و5 مرات عن ثمن حليب الأكياس الذي يعاني من ظاهرة الندرة أحيانا. أجد هذه المشاهد مفجعة ومحزنة.
حاليا نعاني من ندرة متزايدة في الماء. تأتي المياه إلى بيتنا كل يومين لبضعة ساعات فقط. في أفضل الحالات من السادسة صباحا إلى السادسة مساء. وما عدا هذه الأوقات أستعمل ما أقوم بتخزينه أحيانا قبل أن أغسل وجهي مباشرة بعد استيقاظي من النوم. إلا أن ما أخبرتني به عمتي أول أمس كارثة: واجهت مشكلة انقطاع المياه لمدة 10 أيام... فهل عليّ أن أُشيّد بقدري (أتألم عن حظي السيء)؟


وهناك كل تلك المشاكل مثل تحديد موعد عند الطبيب، الحصول على عمل، العثور على حافلة بعد الساعة 6 مساءً... مجرّد التفكير في الأمر يجعلني أشعر بالدوخة.
قرأت كتابة جدارية (غرافيتي): "نزيدو زهر ونعيشو زكارة" أعتبرها نوعا ما انعكاسا لهذه الوضعية. تعني هذه الكلمات، وإن صعبت ترجمتها "نُولد بالصدفة ونعيش ضد كل شيء".
تختلف هذه الصراعات اليومية في طبيعتها عن الصراعات التي عرفها جيل آبائنا وجيل أجدادنا في شبابهم.

منذ زمن بعيد

كافح أجدادي ضد الاستعمار الفرنسي وتحمّلوا عذاب الحرب وآلام الأمراض القاتلة مثل التيفوس والطاعون. عانوا كثيرا من الفقر والأمية التي بلغت نسبتها في تلك الفترة 85%. عرف أبواي ويلات الحرمان ولم يكونا سوى أطفالا غداة استقلال البلاد.
الأطفال الأسعد حظا في جيلهما ناضلوا من أجل الدراسة، ونظرا لبعد المدارس، كان أغلبيتهم يقطعون مسافات طويلة مشيا على الأقدام وهم محرومون من ملابس دافئة في الشتاء ومعرّضون للشمس المحرقة في بقية الفصول.

أمي، أول امرأة حصلت على شهادة البكالوريا في عائلتها، قامت بنضالها النسوي لتأخذ حقها في متابعة دراستها الجامعية في العاصمة والعمل.
عندما أفكر في الأمر، أعي كيف كان جيل أبويّ يكافح من أجل تأسيس منظومة تربوية فعاّلة، أو من أجل القضية الأمازيغية والديمقراطية...

إنني على علم كذلك أنّ جيل أبويّ كافحوا خلال السنوات الثمانينات، من دون أن أتذكر شيئا مما حدث لأنني لم أولد إلا بعد أحداث أكتوبر 1988. لكن أتذكر السنة الدراسية 1994-1995 التي قضاها الأساتذة والتلاميذ في إضراب شلّ كل المؤسسات التعليمية في المناطق القبائلية لمدة سنة للمطالبة بالاعتراف بهوية الأمازيغيين ولتعليم اللغة الأمازيغية التي أدرجت في البرنامج التعليمي بعد ذلك 1995. سُميت هذه السنة اللادراسية 1994-1995 (بسبب الإضراب وعدم وجود مدارس) إن صح التعبير بــ "السنة البيضاء" وهي السنة الرسمية لدخولي إلى المدرسة. لحسن حظي، تناوب أبي وأمي على تعليمي برنامج السنة الأولى، فسُجلت في الدخول المدرسي لسنة 1995-1996 بعد نجاحي في امتحان المستوى الذي أجرته عليّ مديرة المدرسة مباشرة ضمن قائمة تلاميذ السنة الثانية.

بودّي أن أنوّه بأنّه في مرحلة التسعينيات الطويلة التي سُميت بــ "العشرية السوداء" عانى الجزائريون من عنف الإرهاب أشدّ معاناة. ومن بين الذكريات الراسخة في ذاكرتي، انفجار قنبلة أمام مدرستي. كنت في عمر 7 أو 8 سنوات.



سبقني ابن عمتي وأنا متوّجهة مع صديقتي نحو المدرسة. وعلى بعد حوالي 30 متر من المدرسة، هزّنا دوي الانفجار فهرعنا إلى بيت جدّيا حيث قضينا استراحة الغذاء.
أحياء حلب... صور من السماء
10 آذار 2021
رجوعنا إلى البيت دون ابن عمتي أذعر عمتي الصغيرة. فراحت تسألنا عن عدم رجوعه معنا: أين هو...؟ لماذا لم يأت معكما...؟ أجبتها: "ذهبنا متأخرين فجرى وسبقنا، لا أدري أين هو".
توجّهت عمتي وهي تجري في اتجاه المدرسة لتبحث عنه. حسب ذكرياتي، طال الانتظار كثيرا قبل عودة ابن عمتي آمنا ومعافى. لحسن الحظ لم يخلّف الانفجار موتى، ولكن لا أتذكر متى استأنفنا الدراسة.
أحيانا، أتساءل: كيف استطاع الناس العيش وهم مجبرون على تحمّل عبء الكوارث التي كانت تحدث يوميا؟
في 2001 صار صراع بين الشباب وقوات الأمن في منطقة القبائل بعد مقتل الشاب ماسينيسا قرماح في مظاهرات ذكرى 20 أبريل 1980، هو يوم رمزي للنضال من أجل الاعتراف بالهوية الأمازيغية (هناك من يشارك ومن لا يشارك في هذه المظاهرات التي أخذت نوعا ما بعد سياسي)، ونظرا لعدد القتلى الذي بلغ 162 شخصا، يُعرف عام 2001 بــ "الربيع الأسود". لا أتذكر بالتحديد عدد الأشهر الذي دامت فيه الاشتباكات (ربما من آذار إلى يونيو) ولكن رغم الظروف الصعبة، لم نعزف عن متابعة الدراسة إلا حين يعفينا منها المدير بسبب حدوث اشتباكات جديدة قرب الأكمالية (الإعدادية). كنت في هذه الفترة في التعليم المتوسط (الإعدادية)، زملائي الذين يسكنون بعيدا، كان عليهم الالتفاف لتفادي مناطق الصراع حتى يتمكنوا من العودة إلى منازلهم.
ها أنا أسترجع ذكرى الرائحة الكريهة لمطاط العجلات وهي تحترق، والتي تمتزج بالغاز المسيّل للدموع كما تحضر في ذهني صور الشوارع التي تشبه ساحة الوغى بعد انتهاء الحرب.

قبل حوالي 3 سنوات

في الأخير، ومن بين ذكرياتي القريبة لاتزال ذكرى الحركة السلمية لسنة 2019 المسمّاة "حراك"، حيّة.
لماذا تصوّر؟!
19 شباط 2021
كيف تشرح لطفل لماذا هو جائع؟ (7)
08 كانون الثاني 2021
بدأ الناس متحدين، التقى الجزائريون في الشوارع في جو احتفالي. كان يوم الجمعة هو يوم العلاج الجماعي، وكانت عيون الناس مشرقة بالأمل.
سنقول أن هذا "الحراك" هو النضال الأخير للأجيال الثلاثة التي لم تعرف طعما للراحة والسكينة منذ خروج الاستعمار الفرنسي من البلاد.
كلّ هذه الصراعات اليومية لاقتناء الحليب أو الدواء أو قارورة الأكسجين لمريض من الكوفيد 19، للعثور على وظيفة مستقرة أو مجرّد حافلة بعد الساعة 6 مساءً، هو نضال من أجل العيش الكريم.
حقا، قادتني هذه المعاناة إلى التساؤل: هل الأمر يستحق إنجاب الأطفال في ظل هذه الظروف المتأزمة؟
أنا أعلم أنهم بعد كبرهم سيضطرون للاختيار بين أمرين سلبيين: تحمّل معاناة البقاء في الوطن أو الهجرة التي تترتب عنها معاناة من نوع آخر. نحن كجزائريين نحب وطننا وأينما كنّا: الجزائر تعيش في أنفسنا لم نولد فيها.
فاجأت نفسي يوما بالقول: "اخترت البقاء في بلادي"، وأدركت حينذاك مدى صعوبة العيش فيها، لأن الذهاب هو الذي يتطلب الاختيار وليس العيش في وطني. ولكن الذهاب أصبح طبيعيا ويشكل مخرجا. لم أقرأ بعد كتاب "الصدمة الاستعمارية" لكريمة لا زالي، لعلني أجد فيه الأجوبة.
الأفكار تتزاحم في رأسي والمشاعر في قلبي. أفكر في غرافيتي آخر يقول: "كبرت فيك يا وطني وضاع فيك حلمي". يدوم السؤال عن إنجاب الأطفال يدور في خاطري، خاصة وأنّ العلماء كانوا يتحدثون عن الذاكرة الوراثية...
ما الذي نتركه لأطفالنا في هذا الجيل الرابع بعد الحرب.
في نهاية المطاف، لا يسعني إلا أن أقول في قرارة نفسي: هذه هي الحياة، وعلينا التكيّف والتقدّم إلى الأمام.


ترجمة من الفرنسية إلى العربية: الكيسة حمروني فضيل.













