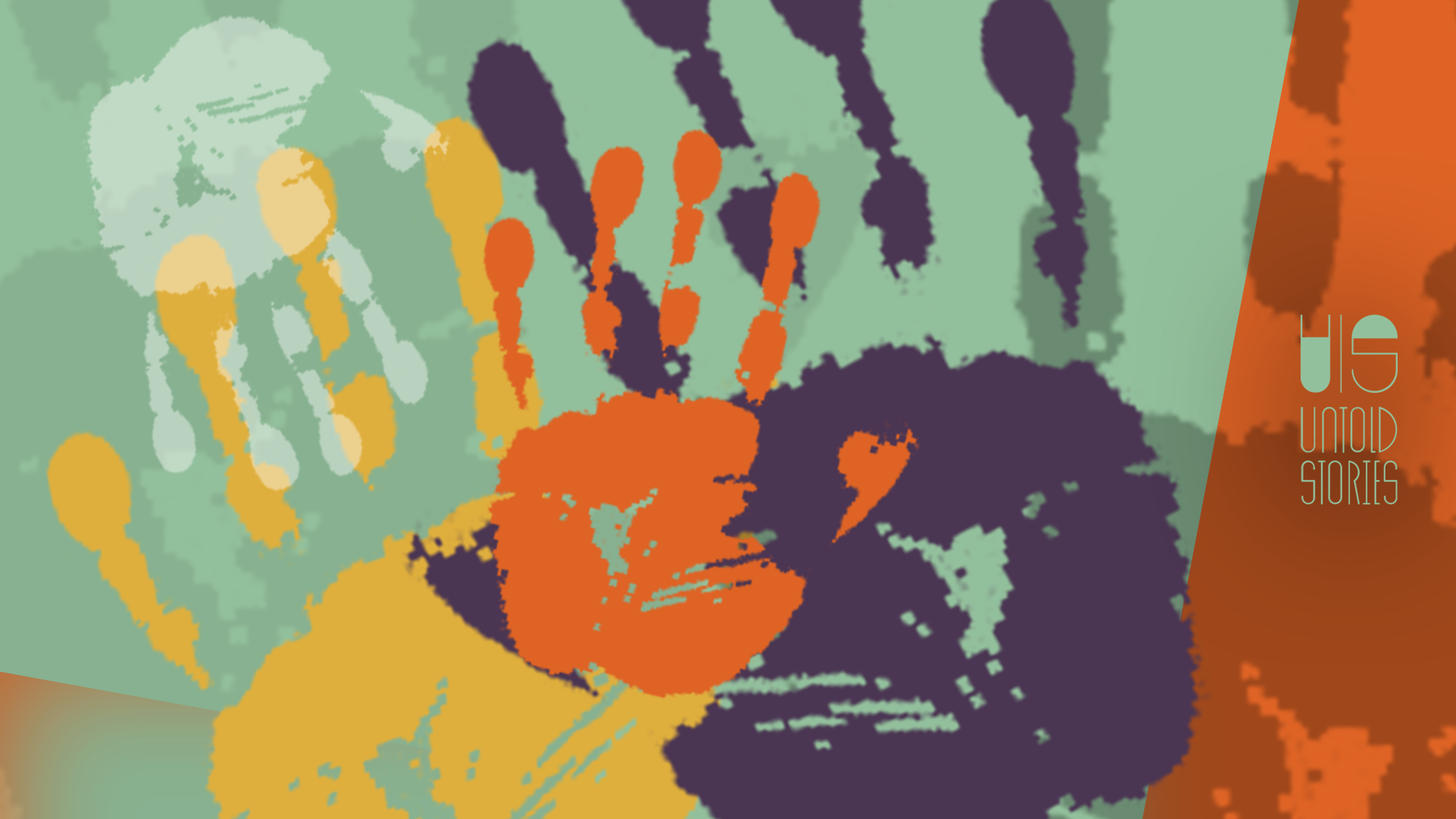"تم إنتاج هذه المادة ضمن مشروع «تمكين الجيل القادم من الصحفيات السوريات» بالشراكة بين مؤسستي «شبكة الصحفيات السوريات» و «حكاية ما انحكت». أُنتجت هذه المادة بإشراف الصحافية ميسا صالح".
وصلتُ متأخرة قرابة خمس وثلاثين دقيقة بسبب الزحام، بين شارع بلس المتفرع من شارع الحمراء إلى منطقة برج حمود في بيروت. كنا قد التقينا قبل يوم واحد، وتحدثنا بشكل سريع خلال نقاش جماعي مع نساء سوريات ولبنانيات وفلسطينيات، حكينا فيه عن ظروف العام الدراسي الجديد لأبنائهن، وعن شكل التعليم الذي يتلقونه، وعن دور الانهيار الاقتصادي في التعليم وتسرّب الأطفال من المدارس.
من أين أبدأ؟ من النقاش الجماعي مع النساء جميعهن؟ أم من حديثي مع جيهان؟
ذهبتُ يوم النقاش الجماعي برفقة صديقتي الصحافية الإسبانية. كنتُ مرتابةً. بدت لي جميع القصص متشابهة، لكن كلّ واحدة منهنّ عبرت عن ألمها بطريقة لا تشبه الأخرى؛ خوفهنّ على أطفالهنّ، حزنهن، قلقهن، محاولاتهن للمقاومة، جهوزيتهن للبوح. كنّ غير سعيدات وهن يتحدثنّ عن المستقبل.
كانت جيهان واحدة من الموجودات، أخذتُ رقم هاتفها وسألتها عن إمكانية إجراء مقابلةٍ معمقة، وافقت وأرسلت لي في اليوم التالي عنوان منزلها.
وصلتُ إلى برج حمود مكان إقامتها. صعدتُ طابقين. كانت تنتظرني. استقبلتني بابتسامةٍ عريضة، ثمّ جلسنا في الصالون. كنت أشعر ببعض القلق من هذه المقابلة بعد ما ذكرت لي قبل يوم تفاصيلاً، خشيتُ عليها وعلى نفسي من استذكارها وسماعها، فيما كان ابنها وابنتها يتناولان الإفطار في الغرفة الثانية، أما ابنها الكبير فهو في مكان عمله، في مسلخ للحوم الأبقار.
سرعان ما تحوّل ذاك القلق الجاثم على قلبي إلى راحةٍ، وكأن جميع المخاوف تبدّدت وتحوّلت إلى رغبةٍ للإصغاء فقط. الصالون صغير منظم وهادئ تحيطُ فيه سكينةٌ ما. تجذب العين صورة كبيرة لرجلٍ أربعيني وسيم مثبتةً على طاولةٍ تقع في إحدى زوايا الغرفة. هذه صورة زوج جيهان المُغيّب منذ سنوات، تصطف إلى جانبها ثلاثة مصاحف بأحجام مختلفة. تطل إحدى النوافذ على الشارع، وتتسلّل من خلالها روائح شحم، وأصوات طرق حديد، تشتد وتخفت من حينٍ إلى آخر، آتية من ورشة تصليح سياراتٍ تقع قبالة المنزل.
قصدتُ منزلها من أجل إجراء مقابلةٍ معها ومع طفليها كي نخوض في قضايا التعليم، لكنّي كلّما أردتُ أن أضيق زاوية النقاش أخذتني بحماستها في الكلام وبكثافة ما جرى معها نحو مواضيع أخرى. كلّ شيء كان مهماً لها، وكلّ تفصيل قادنا إلى آخر. أرادت جيهان أن تتحدث عن كل شي دفعةً واحدة، وكأنّني فسحتها الوحيدة والأخيرة. فكرتُ بأن تلك هي لحظات الحقيقة بالنسبة لها، وعليّ أن أقدَر ذلك، علينا أن نسمع حكايتها حتى النهاية، أو على الأقل أن نشاهد مشاهداً منها.
المشهد الأول: حلب ٢٠١٤
ذاكرة سكّان حيّ بستان القصر في حلب لا تنسى معابر الموت، ولا تنسى التضييق والحصار والجوع. تقول جيهان: "نزحنا من خراب إلى آخر، ومن موتٍ إلى آخر". نزحت جيهان مع عائلتها من حي بستان القصر إلى حي صلاح الدين. بقي قلبها وقلب زوجها معلّق في منزلهم المهجور. بعيون باكية تخبرني أنّه في "اليوم المشؤوم"، وبعد القصف العنيف على بستان القصر "ذهب زوجي للاطمئنان على المنزل، خشينا أنه قد تدمّر، لكنه لم يعد يومها من بستان القصر، تم خطفه من قبل فصيل مُسلّح". قالت جيهان إنّه فصيل "غرباء الشام". طلبوا منها فدية مالية، وأنّ تذهب وحيدة لتسليمهم المال. "خفتُ كثيراً، رفضت الذهاب لوحدي. وإلى اليوم زوجي مُغيّب، أو ميت، في الحقيقة لا أعرف عنه شيئاً".
بقيت جيهان تنتظر زوجها في حلب، لكن في عام ٢٠١٥، خشيتْ على أطفالها بعدما تمّ قام النظام السوري وحليفه الروسي بقصف المدارس في حي صلاح الدين. قالت "لا أريد أن أخسر أطفالي كما خسرتُ زوجي"، وقرّرت اللجوء إلى لبنان.
المشهد الثاني: بيروت ٢٠٢٠
"أذكرُ ذلك اليوم، حين اهتزّ منزلي، وتساقط كلّ الزجاج في المنزل، النوافذ والأبواب، حين تمّ تفجير مرفأ بيروت كنّا قد استقرينا في منطقة برج حمود بعد لجوئنا إلى لبنان"، تقول جيهان.
"الكارثة ممتدة، لا بداية لها ولا نهاية"، تقول المرأة المُتشحة بحجاب أسود اللون. أصيب ابنها الكبير في انفجار المرفأ، دون أن يستطيعوا إسعافه إلى أيّ مكان، "كان الوضع مرعباً في ذلك اليوم، وُجدت حالات لها أولوية أكثر من إصابة ابني". جُرح الشاب جرحاً عميقاً احتاج إلى التقطيب. ما زال جسده يتذكر الإصابة، ندبةً كبيرةً نافرة. "ابنتي الصغيرة ما زالت تخشى كلّ شيء. كلّ صوت يرعبها. بعد التفجير أصبحت تعاني من تبول لا إرادي، وما زالت تتلقى دعماً نفسياً. جميعنا نتلقى دعماً نفسياً. أنا مكتئبة".
تصارع جيهان مرض الاكتئاب، بسبب الوحدة والتعب والقلق، والخوف على أولادها، وبسبب الأعباء الاقتصادية التي لا تستطيع تحمّلها. بضع غرامات من "الزولابين"، وأخرى من "السيتوليس"، عقاقير مضادات الاكتئاب تساعدها كي تقف على قدميها، وتكمل حياتها.
المشهد الثالث: المدرسة في لبنان
تحدثتُ مع حمزة (١٤ سنة)، ووالدته جيهان تجلس إلى جانبه، محاولةً أن نكمل حديثنا قبل أن يحين موعد ذهابه إلى عمله في صالون الحلاقة الرجالية. أكثر ما أثار اهتمامه وأراد أن يتكلم عنه هو موضوع التعليم، الأحلام الكبيرة، ورغبته في التجول بدراجته بحريّة في الأزقة دون أن يترصد له شبانٌ في مكان ما. يريد حمزة أن يصبح طبيباً، لكنه ترك مدرسته قبل سنة، وصار يمسك المقص وماكينة الحلاقة ويتعلم هذه المهنة ليساعد والدته في النفقات.
على الرغم من الوضع الاقتصادي المتردي لكلّ اللبنانيين/ت والسوريين/ت، لكن في الوقت الذي كان فيه الأطفال اللبنانيون يذهبون إلى المدارس، كان الأطفال أبناء اللاجئين/ات السوريين/ات غير متأكدين إن كانوا يستطيعون التعلم أم لا.
أخبرني حمزة أنّ جودة التعليم في مدارس بعد الظهر المخصصة للاجئين/ات السوريين/ات غير جيدة، واللاجئون السوريون يعلمون ذلك أيضاً، لكن "على الأقل هناك المدرسة".
قبل فترة قصيرة، قمتُ بإجراء استبيانٍ على إحدى تجمعات اللاجئين السوريين في لبنان، وسألتهم عن التعليم. مئات الآلاف من الأطفال السوريين في لبنان لا يتلقون أيّ تعليم، نسبة كبيرة منهم تسربت من المدارس، عائلة من كلّ أربع عائلات على الأقل ترسل أطفالها للعمل كوسيلة للتكيف مع الظروف المحيطة. مئات الأصوات منهم/ن كانت مستاءة وخجولة. الأمهات قلقات بشأن مستقبل أطفالهنّ. عقبات بيروقراطية، وبروتوكولات أمنية خانقة. بالنتيجة هم غير قادرات على دفع أجور المواصلات، وتأمين المستلزمات المدرسية. قالت لي إحدى السيدات أثناء إجرائي لذلك الاستبيان: "كنتُ أقطع مسافات طويلة كي أوصل أولادي إلى المدرسة مشياً على الأقدام، الأهم أن يُسمح لأطفالنا بالتعلّم". الخوف ذاته الذي يعاود الناس كل سنة، ها هو من جديد.
المشهد الرابع: كلامٌ يجرّ الكلام
مايا، أخت حمزة، تجلس بهدوء وخجل شديدين إلى جانب أخيها ووالدتها، تصغي إلى ما يقولانه.
تحدثت جيهان عن تفاصيل حياتها اليومية، الأشياء التي يظنها العالم عادية، مثل مشاعر أولادها بالاختناق في المنزل. لقد فقدوا رفاهية التنزه. حين يشعرون بالملل يذهبون إلى شاطئ البحر، أقرب فسحةٍ لهم وتكاد تكون الوحيدة. تحدثت عن اتباعها استراتيجيات حياتية بديلة للتأقلم، كشراء الملابس من البالة، وعن استغنائها عن تناول اللحوم والدجاج، والفواكه والحليب.
قضينا بضع ساعات معاً، تحدثنا كثيراً وصمتنا كثيراً، في لحظاتٍ معينة أردتُ أن أمسح دموعها التي كانت تنهمر على خديها وهي تحكي عن زوجها، لكنني حملتُ في قلبي حزناً كبير ومضيت. بعدما خرجتُ من منزلها، نزلتُ الطابقين، أحنيتُ ظهري من كثرة الحزن. لا أعرف لماذا لا تفارقني ملامح وجه جيهان من بين كلّ النساء الذين قابلتهن. في اليوم التالي أرسلتُ لها رسالة عبر تطبيق واتسآب، أردتُ أن أعتذر منها في حال قد سببتُ لها حزناً ما، أو بأني نكأتُ جراحها. أخبرتني كم كانت مرتاحة، وبأنها كثيراً ما أرادت الكلام.
بقيتُ أسبوعاً كاملاً أتحدثُ عنها، لم أشأ أن تختفي هكذا. أفكر الآن ماذا لو أجريتُ هذه المقابلة* في الوقت الذي تُباد فيه غزة. يا الله كم من الخيبة والألم، ونحن نعتقد بأنّ النسيان سيأخذ مجراه، وكأنه هو العدالة المنتظرة.
* حدث اللقاء مع جيهان قبل الحرب على غزة بأسابيع قليلة.